أمّا عقولهم فقد ختم الله عليها بكفرهم وإذا ختم على العقل لم يمكن أن يدخله نور الهدى ابداً. وأمّا سمعهم فقد طبع الله عليه بعنادهم. وأمّا أبصارهم فقد أسدلت دونها غشاوة سميكة فلم يعد بإمكانها الرؤية أبداً. وفي تعبيرات الآية الكريمة تنزيل لفاقد الوصف منزلة فاقد الأصل...
الآيتان: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ*خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ)(1)
المفردات
(سَوَاءٌ): متساو في حقّهم الإنذار وعدمه.
(ءَأَنْذَرْتَهُمْ): الإنذار هو التحذير من نتائج العمل في زمان يتّسع للاحتراز عنه، فإن لم يتّسع للاحتراز كان (اشعاراً) ولم يكن (إنذاراً).
(خَتَمَ): الختم ضرب الخاتم على الشيء، لئلاّ يتوصّل إليه أحد أو يطلّع عليه، ومنه وضع الخاتم على الكتب والأبواب كي لا تفتح، والختم اليوم يستعمل في المنع من الاطلاّع على الشيء أو الدخول إليه، كختم سندات الأملاك والرسائل السرّية.
(قُلُوبُهُمْ): عقولهم.
(غِشَاوَةً): الغطاء الذي يشتمل على الشيء ويحيط به.
القراءة
قال في الكشّاف ما مؤدّاه: يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم وفي حكم التغشية، إلاّ أنّ الأُولى دخولها في حكم الختم لقوله تعالى (وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ) (وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً)(2) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم(3).
الإعراب
(سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) فيه وجهان:
1 ـ إن (سواء) خبر لـ(إنّ) و(ءَأَنْذَرْتَهُمْ) في موضع الرفع به على الفاعلية، والتقدير (إن الذين كفروا متساوٍ عليهم إنذارك وعدمه).
فـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) اسم لـ(إنّ) و(متساوٍ) خبرُها و(إنذارك) فاعل للخبر و(عدمه) عطف على الفاعل، فهو نظير أن تقول: (إنّ الذين كفروا يتساوى عليهم إنذارك وعدمُه) إلاّ أنَّ (يتساوى) فعلٌ و(متساوٍ) اسمٌ. وكذا (سواء).
2 ـ أن تكون جملة (ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) في موضع مبتدأ مؤخّر، وسواءٌ خبر مقدَّم. ومجموع هذه الجملة المركّبة من المبتدأ والخبر خبر لـ(إنّ).
والهمزة في (ءَأَنْذَرْتَهُمْ) مجرّدة عن معنى الاستفهام الحقيقي، ويطلق عليها (همزة التسوية) والضابط لها أنّها الهمزة الداخلة على جملة يصحُّ حلول المصدر محلّها، نحو: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ)(4). أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه(5).
فقوله تعالى (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) أي: سواء عليهم الإنذار وعدمه.
وقال في التبيان: (ومعناه: أيُّ الأمرين كان منك إليهم الإنذار أم تُرك الإنذار فإنّهم لا يؤمنون، وهذا لفظه لفظ الإستفهام ومعناه الخبر، وله نظائر في القرآن، كما تقول (ما أُبالي أقمت أم قعدت) وأنت مخبر لا مستفهم؛ لأنّه وقع موقع أيّ، كأنّك قلت: لا أُبالي، أيُّ الأمرين كان منك، وكذلك معنى الآية: سواء عليهم أي هذين منك اليهم حسن في موضعه، سواء فعلتَ أم لم تفعل).(6)
النزول
قيل: إنّ الآية الكريمة نزلت في (أبي جهل) وخمسة من قومه من قادة الأحزاب، قتلوا في معركة (بدر).
وقيل: إنّها نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود الذين يقطنون حوالَي المدينة.
وقيل: إنَّها نزلت في رؤساء اليهود والمعاندين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم يكتمون الحقّ وهم يعلمون.
وقيل: إنّها نزلت في مشركي العرب الذين جحدوا بعد المعرفة، وأنكروا بعد البيّنة.
والذي يتناسب مع عموم كلمة (الّذين) ومع سياق الآيات المباركة، أنّ الآية الكريمة تشمل كلّ الكفّار المعاندين الذين أغلقوا على أنفسهم (منافذ المعرفة) فاستوى في حقّهم الإنذارُ وعدمه، ولم يعد بإمكانهم ـ بسبب سوء اختيارهم ـ الوصول إلى طريق الهدى أبداً، وبتقرير آخر: القضية من قبيل (القضايا الحقيقية)(7) التي يكون الموضوع فيها هو العنوان الكلّي الجامع لكلّ ما ينطبق عليه من الأفراد، لا من قبيل (القضايا الخارجية) التي يكون الموضوع فيها الأشخاص الخارجية الجزئية، فتأمّل.
التفسير
بعد أن استعرض القرآن الكريم موقف المجموعة الأُولى من المجموعات الثلاث تجاه القرآن الكريم وما يحتوي عليه من مبادئ وقيم، يتعرّض إلى موقف المجموعة الثانية وهي (الكافرون).
معنى الكفر
والكفر من الناحية اللُّغوية هو (الستر) ويسمَّى (الزارع) كافراً، باعتباره يستر البذور تحت التربة، قال الله تعالى (أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ)(8) ويقال: (تكفّر فلانٌ بالسلاح) أي: تغطّى به، وكأنّ الكافر سُمِّي بذلك لأنّه يستر الحقيقة ولا يبديها(9)، أو لأنّه يستر عقله تحت ركاب الجهل أو العناد، فلا يسمح لعقله أن يكتشف الحقيقة.
أمّا من الناحية الشرعية، فالكفر عبارة عن إنكار الأُلوهية أو الرسالة أو المعاد، أو ضروريٌّ من ضروريات الدين، بحيث يعود إنكاره إلى إنكار الرسالة أو مطلقاً، على اختلاف المبنيين في ذلك(10).
ولكن يبدو أنّ هذه الآية ليست ناظرة إلى هذا المعنى الشرعي، بما له من السعة والشمول، بل هي ناظرة إلى تلك الشريحة الاجتماعية من الكفّار التي ظلَّت مصرّة على مواقفها الخاطئة تجاه الإسلام، وعلم الله سبحانه بعلمه الأزلي أنها سوف لن تؤمن بهذا الدين.
ثلاثة مواقف
فالناس الذين بلغتهم الدعوة، ووصل إلى مسامعهم نداء الحقّ على ثلاثة أنواع:
1 ـ الأفراد ذوو القابلية للفهم والتلقّي: وهؤلاء فتحوا نوافذ قلوبهم لنداء الحق، واحتضنوه وتفاعلوا معه، فهؤلاء كالتربة الخصبة التي ما إن تُلقى فيها البذور حتى تحتضنها وتتفاعل معها ولا تمرّ الأيام إلاّ وتملأ الآفاق بألوانها الزاهية، وأريجها الفّواح، وثمارها اليانعة.
2 ـ الأفراد الذين انعدمت فيهم القابلية ـ بسبب سوء اختيارهم ـ: وهؤلاء أغلقوا نوافذ قلوبهم على الحقّ فلم يعد يستطيع النفاذ إلى أعماقهم أبداً، فهؤلاء كالأرض السبخة التي لا تحتضن بذرة، ولا تنبت ثمراً.
3 ـ الأفراد المذبذبون بين هؤلاء وأُولئك:
والقسم الثاني يتساوى في حقّهم الإنذار وعدمه، والتبليغ وعدمه:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ) وذلك مثل (أبو جهل) و(أبو لهب) وأمثالهما من الكفّار.
وعلى هذا: يكون المراد من (الَّذِينَ كَفَرُوا) الذين استمروا على كفرهم وضلالهم، رغم وصول كلمة الحقّ إليهم، لا كل من تلبّس بالكفر، وإلاّ فالذين آمنوا بالرسول (صلى الله عليه وآله) كان أكثرهم كفّاراً، ثمّ أصبحوا بعد ذلك مؤمنين.
لماذا العناد؟
ويبدو أنّ الآية التالية تبيّن السبب في ذلك، فقد (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ) و(وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) فهؤلاء سُدَّت عليهم منافذ المعرفة؛ إذ إنّ منافذ المعرفة هي (العقل) و(السمع) و(البصر).
أمّا عقولهم فقد ختم الله عليها ـ بكفرهم ـ، وإذا ختم على العقل لم يمكن أن يدخله نور الهدى ابداً.
وأمّا سمعهم فقد طبع الله عليه بعنادهم.
وأمّا أبصارهم فقد أسدلت دونها غشاوة سميكة فلم يعد بإمكانها الرؤية أبداً.
وفي تعبيرات الآية الكريمة تنزيل لفاقد الوصف منزلة فاقد الأصل، وقد ينفى الأصل عند انتفاء الوصف بسبب أهمّية الوصف، أو كونه علّة غائيّة لوجود الأصل، ومن الواضح أنّ في السمع والبصر أمرين يترتّب أحدهما على الآخر:
أوّلهما: انكشاف المسموع والمبصَر لدى السامع والرائي.
وثانيهما: الجري العملي وفق هذا الانكشاف.
والانتفاع بالسمع والبصر إنّما يتمّ بالجري العملي، فإذا انتفى ذلك فكأنه لا سمع ولا بصر، فينزّل (عدم السمع النافع) منزلة (عدم السمع) لإفادة أنه بمنزلته في النتيجة، كما ينزل (عدم الإبصار النافع) منزلة (عدم الأبصار) لبيان أنّه مثله في المآل.
وهنالك احتمال آخر في قوله تعالى: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهو أن يكون بمنزلة المعلول للآية الأُولى ـ فهؤلاء قد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وغشي على أبصارهم جزاءاً وفاقاً على استهتارهم بالإنذار، حتّى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار، فتأمّل.
نتيجة العناد
أمّا النتيجة التي تترتّب على هذا الموقف العنيد المنبعث عن النفس المظلمة فهو ما يبينّه الله تعالى بقوله: (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فإنّ الانحراف عن الإيمان أعظم انحراف في حياة البشر، والأثر الوضعي الذي يترتّب على (الانحراف العظيم) هو (العذاب العظيم) بالطبع. وهذا العذاب العظيم لا يقتصر على نشأة الدنيا فحسب، بل يشمل نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، كما يدّل عليه قول الله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى).
قال: (رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا)؟
قال: (كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى)(11).
وقوله تعالى: (لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ)(12).
ولعلّ في تنكير (عذاب) اشارة إلى أنّ هذا العذاب عذاب مجهول لا يعرف كنهه البشر، أمّا بالنسبة إلى عذاب الآخرة فواضح؛ لاختلاف معادلات نشأة الآخرة عن نشأة الدنيا، فلا يستطيع الإنسان وهو محكوم بمعادلات هذه النشأة أن يدرك أبعاد تلك النشأة، كما لا يستطيع الجنين وهو في بطن أُمّه أن يستوعب معادلات هذه الحياة.
وأمّا بالنسبة إلى عذاب الدنيا؛ فلأن الإنسان محاط بإطار (الحاضر) وبأُطر (الحس) فلا يستطيع ـ عادةً ـ أن ينفذ إلى أغوار المستقبل، ولا أن يكتشف (الماورائيات) ـ كالروح مثلاً ـ(13).
ولذا فإنّه لا يستطيع أن يُحيط بأبعاد الآثار التي يتركها الانحراف عن خطّ الإيمان على الروح الإنسانية، ولا المضاعفات الخطيرة التي يخلّفها على مستقبل المجتمع البشري.
وما هذه المآسي الكبيرة التي تشهدها البشرية إلاّ (بعض) آثار الانحراف عن خطّ الهدى، ويوم تزاح حجب الغفلة وتكتشف الحقيقة كاملة، فلسوف يدرك الإنسان مدى عمق الفاجعة التي حلّت بالبشرية جرّاء ضلالها عن خطّ الإيمان بالله.
ما تهدفه الآيتان الكريمتان
لا يخفى أنّ في هاتين الآيتين تسلية للنبيّ (صلى الله عليه وآله) حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات(14).
فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) حريصاً على أن يؤمن الناس جميعاً(15) وكان يتألمّ لذلك أشدّ التألُّم حتى قال الله سبحانه (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)(16).
ففي هاتين الآيتين دلالة على أنّ هذه المجموعة لن تجدي معها المحاولات؛ لأنّها سوف تظلّ سادرة في غيِّها وضلالها، فلا ينبغي له (صلى الله عليه وآله) أن يهلك نفسه غمّاً وحسرةً عليهم.
ولا يختصُّ الأمر بالنبي (صلى الله عليه وآله)، بل يعمُّ كافة العاملين في سبيل الله؛ إذ المهم آداء (الوظيفة) وهي التبليغ ـ ضمن شروطه المقرّرة ـ وليس المهم الحصول على النتيجة ـ وهي شمولية الهداية لكلّ فرد ـ فإنّ هذه النتيجة سوف تصطدم بركام من التعصُّب واللَّجاجة والعناد في نفوس الكثيرين، ولن تجدي المحاولات معهم أبداً.
وعند هذه النقطة تستقر نفس المؤمن العامل ولن تعود تفّت في عضده قوة الضلال والانحراف؛ إذ المهمّ أن يكون على الحقّ. وأن يدعو إلى الحقّ. أمّا النتيجة، فإنها ليست مسئوليته، وإنّما يكلها إلى الله تعالى.
كما أنّ في هاتين الآيتين المباركتين تعرية لحقيقة موقف المجموعة الثانية ـ (الَّذِينَ كَفَرُوا)؛ إذ إنه لا ينطلق من قاعدة فكرية متينة.. وإنّما ينطلق من الهوى والتعصُّب والعناد.


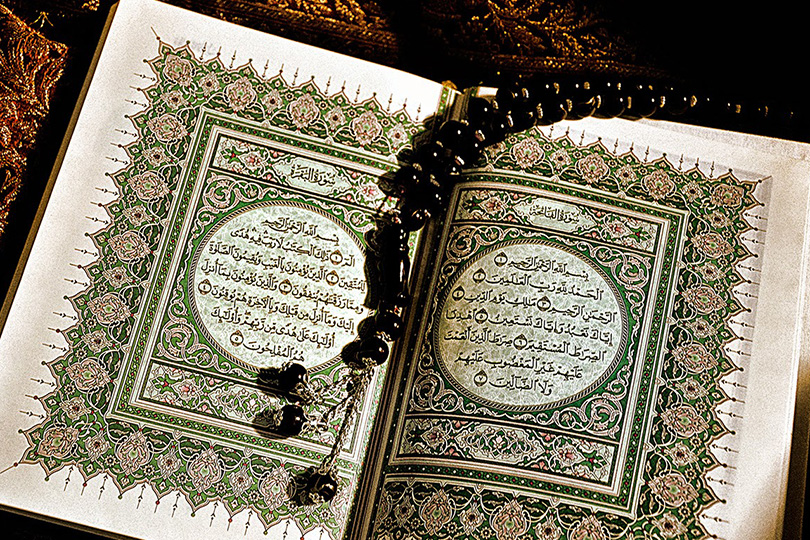

اضف تعليق