عندما تشمل الدراسات الجنسين، فإن النتائج قد تكون مهمة للصحة. على سبيل المثال، من المعروف أن جنس الشخص يؤثر في مدى تجاوبه مع العقاقير الشائعة، وبينها بعض المضادّات الحيوية؛ ويبدو كذلك أن خطر الإصابة بمرض قلبي وعائي عند ضغط دم أدنى هو أكبر بين النساء منه بين الرجال...
بقلم: إميلي ويلينجهام
في عام 2016، أعدَّت الباحثة في علوم الصيدلة، سوزان هاوليت، دراسةً عن تأثير مستويات الهرمونات خلال الحمل في عمل القلب، وأرسلَتها للنشر في إحدى الدوريّات، وعندما عادت إليها تعليقات المراجعين الثلاثة، وجدَتْ في تعليقات اثنين منهم سؤالًا غير متوقّع: أين كانت أنسجة ذكور الفئران؟
ونظرًا إلى أن هاوليت وزملاءها لدى جامعة دلهاوزي في مدينة هاليفاكس الكندية كانوا يدرسون مستويات الهرمونات العالية المرتبطة بالحمل، لم يكونوا قد استعانوا في دراستهم إلا بإناث الحيوانات. تقول الباحثة: "فوجئت بشدّة بأنهم أرادوا منا إعادة كل التجارب نفسها على الذكور"، ومع ذلك، فقد لبّت وفريقها الطلب، ونُشرت النتائج التي توصّلوا إليها عام 2017. وكما كان متوقعًا، لم يجد الباحثون أي أثر لهرمون بروجستيرون في عمل قلب الذكور؛ في حين وجدوا أنه أثّر في نشاط خلايا القلب في الإناث.
وأثار طلب إضافة الذكور إلى الدراسة مشاعر متضاربة لدى هاوليت، التي علَّقت على ذلك بقولها: "كان مطلبًا عسيرًا، ويتطلَّب جهدًا بحثيًا أكبر بكثير". لكنها تضيف أنه من المهم جدًا عمومًا أن يؤخذ جنس الحيوانات في الحسبان عند إجراء الدراسات، إذْ تقول: "أنا من أكبر مناصري إجراء الاختبارات على الذكور والإناث معًا".
وهذا ما يشعر به كثيرٌ من الجهات الراعية للبحث العلمي، وأعني هنا جهات المانحة والدوريّات الأكاديمية. فمنذ عقدٍ أو نحوٍ من ذلك، وقائمةٌ متطاولةٌ من الممولّين والناشرين، بينهم معاهد الصحة الوطنية الأميركية (المعروفة اختصارًا باسم الصحة الوطنية الأمريكية NIH) والاتحاد الأوروبي، تطلب من الباحثين إدراج الجنسين في أعمالهم الخاصة بالخلايا والنماذج الحيوانية.
وقد كان وراء هذه السياسات حافزان أساسيّان: أوّلهما، الوعي المتنامي بأن الفوارق التي أساسها جنس الحيوان، التي كثيرًا ما تكون مرتبطة بملفات الهرمونات أو الجينات التي تحملها الصبغيّات أو الكروموسومات، يمكنها التأثير في الاستجابات للعقاقير والعلاجات الأخرى. أما الثاني، فكان نابعًا من إدراك أن إدراج الجنسين في الدراسة يمكنه أن يجعل البحث العلمي أكثر رصانة، وأن يعزز قابلية إعادة إنتاج الدراسات، وأن يطرح أسئلة جديدة لتتولّى الدراسات الإجابة عنها.
وعندما تشمل الدراسات الجنسين، فإن النتائج قد تكون مهمة للصحة. على سبيل المثال، من المعروف أن جنس الشخص يؤثر في مدى تجاوبه مع العقاقير الشائعة، وبينها بعض المضادّات الحيوية؛ ويبدو كذلك أن خطر الإصابة بمرض قلبي وعائي عند ضغط دم أدنى هو أكبر بين النساء منه بين الرجال.
كما أن «كوفيد-19» يعطينا مثالًا جليًّا آخر، يوضح لنا السبب الكامن وراء ضرورة أخذ الجنسين في الحسبان؛ إذْ يقضي المرض على عدد أكبر من الرجال4، في حين يبدو أن النساء أكثر عرضة لمجموعة الأعراض المزمنة التي تخلّفها الإصابة، والمعروفة باسم «كوفيد الممتد».
ووفقًا للطبيبة سابينة أوتيلت برجونة، المتخصصة في طبّ الجنسين لدى المركز الطبي الخاص بجامعة رادبود في مدينة نايميخن الهولندية، تتمثّل الفائدة الكبيرة لمعاينة كلا الجنسين في أن "المرء قد يجد [بسببها] مسالكَ أو حلولًا أو أسئلة جديدة محتملة، ما كان ليجدها لولاها".
لكن التحسينات المأمولة في مجالَي قابلية إعادة إنتاج الدراسات والصرامة لم تتحقّق إلّا ببطء. فقد تسبّبت السياسات في حيرة كبيرة، وأثارت جدلًا في شأن وقت تمثيل الجنسَين في تصاميم الدراسات وكيفية ذلك؛ ويرى بعض الباحثين أن «الجنس»، بتعريفه الحالي، مغالٍ في ثُنائيّته وفجاجته.
وفي هذا السياق، قالت جنين كليتون، مديرة «مكتب البحث في صحة النساء» ORWH، التابع لمعاهد الصحة الأمريكية، في تعليقات أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى دوريّة Nature، إن "عدد العلماء الذين يقرّون بأهمية دراسة الجنسين في ازدياد. ولكن ما زال هناك مُتسَع للتحسين".
تمثيل الجنسَين في الدراسات دون المستوى المطلوب
بدخول النساء أكثر فأكثر معتركَ البحث العلمي في أواسط القرن العشرين، وأواخره، بدأ بعضهن يلاحظ أن كثيرًا من الدراسات الإكلينيكية أهمل تمثيل الجنسين.
ندرة المشارِكات الإناث ناتجة، في جانبٍ منها، عن ردّ فعل على مأساة اكتشاف أن استعمال مهدّئٍ يسمّى «الثاليدوميد» thalidomide خلال الحمل، تسبَّب في تشوّهات خلقية. وكانت من أثر ذلك أن أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) عام 1977 بأن يُستثنى جميع النساء اللواتي يمكن أن يحملن، إلّا قليلًا منهن، من تجارب المرحلة الأولى الإكلينيكية – وهي التجارب التي تختبر أمان العلاجات وفعّاليتها لدى متطوّعين أصحّاء. وهكذا، أدّت سياسةٌ أُريدَ بها حماية النساء في المحصّلة إلى خلق ثغرة في المعلومات عن كيفية تأثير العقاقير فيهن.
وشيئًا فشيئًا، أدرك الباحثون والمموّلون أنه ستكون هناك عواقب إكلينيكية لاستبعاد نسبة كبيرة من السكان من هذه الدراسات، أو الخلط بين الجنسين فيها. واستجابةً لذلك، أسّست معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، عام 1990، «مكتب البحث في صحة النساء». وبعدها بثلاث سنوات، بدأت الوكالة تشترط ضمَّ النساء في البحوث الإكلينيكية.
أما في دراسات العلوم الأساسية، فقد ظلّ الجنس يُنحّى جانبًا بعد ذلك بكثير حتى عهدٍ قريب. وقبل عشر سنوات، أخذ المموّلون والناشرون يعالجون الخلل في التوازن. وفي عام 2010، طبّقت المعاهد الكندية للبحوث الصحية مطلبًا بإدخال الجنس والهوية الجنسية أو النوع الاجتماعي (أو ما يسمّى «الجندر») في التحاليل. وفي عام 2013، طرح الاتحاد الأوروبي إرشادات مشابهة، عزّزها عام 2020 لتكتسب صبغة رسمية. وفي عام 2016، وهو العام نفسه الذي طُلب فيه من فريق هاوليت إضافة جنسٍ ثانٍ إلى عملهم، سنّت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية سياسةً تفرض إدراج الجنسين في الدراسات المتعلقة بالخلايا والأنسجة والحيوانات. وكان من أهداف ذلك، العثور على مؤشرات على تأثيرات مرتبطة بالجنس قبل وقت طويل من إجراء أي دراسات إكلينيكية.
ونلمس شيئًا مشابهًا في أوساط الناشرين؛ ففي عام 2016، كانت قد نَشرت الإرشادات الخاصة بالمساواة في البحث العلمي بين الجنسين، وكذلك فيما بين مختلف الهويات الجنسية المتصوّرة (وهي الإرشادات التي يُشار إليها بالاختصار «ساجر» SAGER)، التي حددت كيفية الإبلاغ عن فروقات على أساس الجنس في البحوث المنشورة. ولناشرين مستقلين، بينهم «سبرينجر نيتشر» Springer Nature (التي تُصدر دورية Nature)، سياساتٌ خاصة بهم، تشجّع الباحثين على الإفادة بالنتائج على أساس الجنس، الذي يُعرَّف بأنه مجموعة من السمات البيولوجية، وأحيانًا كذلك على أساس الهوية الجنسية المتصوّرة، التي توصف بأنها معرّفةٌ اجتماعيًا.
ولكن، حتى الوصول إلى تلك المرحلة لم يكن سهلًا. وقد ترأّست كليتون منذ عام 2012 مساعي «مكتب البحث في صحة النساء» لتمثيل "الجنس بوصفه متغيّرًا بيولوجيًا". وتعليقًا على ذلك، تقول لوندا شيبينجر، وهي مختصّة بتاريخ العلم لدى «جامعة ستانفورد» بولاية كاليفورنيا، وكانت طرفًا مشاركًا في مساعي كليتون: "راقبتُها وغيرَها وهم يتابعون المسألة كل عام. وقد تطلّب جعل الجنس بوصفه متغيرًا بيولوجيًا معتمدًا في المعاهد، أن تزور [كليتون] كلًا من معاهد الصحة الأمريكية وأن تدخل معهم في نقاشٍ بشأنها".
والمتوقَّع من الباحثين، بموجب سياسة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية الخاصة بتمثيل الجنس بوصفه متغيّرًا بيولوجيًا، أن يبحثوا عن تأثيرات الجنس، أو عن الفروقات بين الجنسين؛ وإلًا فعليهم تقديم مسوّغ واضح لدراسة جنس واحد دون الآخر. وقد كتبت كليتون عن ذلك قائلة: " البحث عن تأثيرات الجنس أو عن الفروقات بين الجنسين هو فرصة، وليس عائقًا"، ولكن، حتى في مرحلة إطلاق هذه السياسة، شعر بعض الباحثين أن البحث عائقٌ حقًا.
الجنس مفهوم معقد
تمثيل الجنسين في الدراسات المتعلقة بالحيوانات والخلايا ليس عملية سهلة، كما قد يبدو. فالتمييز بين الجنسين على أساس مؤشرات عامّة، مثل الصفة التشريحية، يتغاضى عن التعقيد الأعمق للهرمونات، وهي العوامل الأساسية في كثيرٍ من الفوارق المحددة، أو المحتملة بين الذكور والإناث. فالأشخاص الذين ليس لهم باع في تخصص الغدد الصمّاء "قد لا يعرفوا هذه الأشياء"، وفقًا للباحثة جيسيكا تولكون المختصّة بعلم الأحياء الجزيئيّ لدى مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك.
وتعريف الجنس على أنه ثنائيّةٌ صريحة، مبنيّة على الكروموسومات الموجودة، أو على تشريح معيّن، قد يكون تعريفًا مفرطًا في التقييد. فبعض أنواع المخلوقات، مثل الدودة الخيطية Caenorhabditis elegans، له جنسٌ واحد منتج للخلايا المنويّة، وآخَرُ منتِجٌ للخلايا المنويّة والبويضات معًا. وفي مجموعة واسعة من الأنواع، يتحدّد الجنس بتأثير البيئة، لا بتأثير الكروموسومات. وفوق ذلك، هناك مخلوقات يتغيّر جنسها خلال حياتها. وعليه، فإن تصنيف خلايا أو أنسجة أو حتى متعضّيات بحالها في فئتين يواجه مصاعب متراكبة في هذه السياقات.
كما احتجَّ منتقدو هذه السياسة بأنها تواجه مشكلةً لوجستية؛ إذْ إن إدراج جنسين في الدراسات يتطلب استعمال مزيد من الحيوانات.
وفي تعليق أدلَتْ به آيرين ميجيل-آلياجا، وهي عالمة وراثة لدى كلية لندن الإمبراطورية ساعدت على صياغة التفويض باستعمال الجنسين، الذي أصدره مجلس البحوث الطبية في المملكة المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، قالت: "هناك مَن يفترض أنه إنْ كان المرء يجري بحثًا يتضمن فئرانًا، ورغب في إدراج الجنسين، فإن عليه مضاعفة عددها". وتوضح العالمة أن مضاعفة عدد الحيوانات قد تكون ضرورية إنْ كانت الفروقات بين الجنسين هي الدافع وراء اختبار فرضيّة الدراسة؛ أما الدراسات التي تُجرَى لأغراضٍ استكشافية، "فلا يحتاج الباحث فيها إلا إلى عدد كافٍ من الحيوانات لمعرفة ما إنْ كانت النتائج التي توصّل إليها تنطبق على كلا الجنسين".
قد تحتاج أحجام العيّنات إلى أن تكبر بمقدار الثلث، في المتوسط، لتصل إلى هذا المستوى6. أما المشكلة التي تعترض تحقيق ذلك، وفقًا لرئيس قسم الغدد الصمّاء والداء السكّري والأيض لدى «مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي» في بوسطن بولاية ماساتشوستس، إيفان روزن، فهي أن "الاختبارات التي تتضمن فئرانًا اختبارات مكلفة؛ ومن دواعي الإحباط في هذا الموقف الجديد هو أن معاهد الصحة الوطنية الأمريكية كثيرًا ما تطالبنا بإجراء دراسات لإناث الفئران، لكنها تعترض على توفير تمويل كافٍ".
وكان روزن وفريقه قد نشر في وقت سابق من هذا العام أطلسًا موسّعًا عن نوع من الأنسجة الدهنية يدعى النسيج الدهني الأبيض لدى البشر والفئران7، فاصطدموا بمشكلة مثيرة للاهتمام، وهي أن معظم الدراسات الخاصة بالفئران في هذا المجال تُجرى على ذكورها، الميّالة بطبيعتها إلى اكتناز كمية من الدهون أكبر بكثير مما تكتنزه الإناث. وبخلاف ذلك، فإن معظم العيّنات البشرية تُجمَع في أثناء العمليات الجراحية لإنقاص الوزن، التي تمثّل النساءُ الغالبيةَ الساحقة ممن يخوضونها. وعندما أخذ أعضاء الفريق يعملون على تحضير أطلسهم، أدركوا أن نسبَتَي الفئران والبشر فيه تتجهان باتجاهين متعاكسين، فوجب عليهم ضمان أن تشمل دراستهم أنسجة من إناث من الفئران، وأخرى من ذكور من البشر. وفي المحصلة، وفق روزن: "وجدنا حقًا فروقًا بين الأشخاص الأميَل إلى النحالة وأولئك الأميَل إلى البدانة، وكذلك بين الفئران النحيلة والفئران السمينة، لكن دور الجنس انحسر بوصفه أساسًا للمقابلة.
من ناحيتها، تقول ميجيل-آلياجا إنه حتى النتائج «السلبية» التي أمكن التوصُّل إليها، بعدم وجود فوارق بين الجنسين، تمدنا بمعلومات مهمة. تقول: "من المفيد أن يعلم المرء أن الشيء الذي يدرسه، بصرف النظر عن طبيعته، لا يُبدي مثنويّة شكلٍ جنسيّة، أو أن العلاج الذي قد يقود إليه يمكن تطبيقه على كلا الجنسين"؛ فتطبيق هذه الدراسات "مكسَبٌ في جميع الأحوال".
طريق وعرة
كان المراد من هذه السياسات فرضُ التغيير، لكن كثيرًا من العلماء يجدون صعوبة في الامتثال لها دوريًا، أو في إدراج الجنسين في دراساتهم كما ينبغي. وفي الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها كليتون إلى Nature، تشير إلى أنه بحلول عام 2015، أي بعد 22 عامًا من إطلاق معاهد الصحة الوطنية الأمريكية مطلبها الخاص بالتجارب الإكلينيكية، كان أقل من ثلث التجارب العشوائية المراقَبة المقيَّمة التي موَّلَتْها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية يُدرِج كلا الجنسين في دراساتهم أو يعطي تفسيرًا لعدم إدراجهما. ووجدت مراجعةٌ أجريت في عام 2018 أن المؤشر ظلّ غالبًا في مكانه على مدى السنوات الأربع عشرة السابقة8.
وحتى عندما تشتمل التجارب على إناث، فإن ذلك يكون في كثير من الأحيان بنِسبٍ لا تتماشى مع التفشّي الواقعي لبعض الأمراض في تلك المجموعة. وقد وجدت مراجعةٌ أجرتها كليتون وزملاؤها عام 2020 أنه من بين 11 فئة من الأمراض حلّلها المؤلّفون بين عامي 2014 و2018، كان تمثيل النساء أقلَّ مما ينبغي في 7 منها، بينها أمراض الكبد والكلى.
أما الامتثال للسياسة الأحدث في دراسات الحيوانات والخلايا، فيعاني درجةً أعلى من التشتُّت. وكانت نيكول فويتوفيتش، وهي باحثة مختصّة بالجنس بوصفه متغيرًا بيولوجيًا في قسم العلوم الاجتماعية الطبية لدى كلية فاينبرج الطبية التابعة لجامعة نورث وسترن في مدينة شيكاجو بولاية إلينوي، كانت قد شاركت في كتابة تقريرٍ10 ينظر في كيفية تغيّر إدراج الجنسين في الدراسات الخاصة بالحيوانات بين عامي 2009 و2019. ووجدت هي وزملاؤها في تسع مجالات، من مجالات البحث في 34 دوريّة، أن نِسب الدراسات التي شملت الجنسين قد ارتفعت. ولكن في ثمانٍ من تلك الدراسات، لم يكن تحليل البيانات وفقًا للجنس قد ازداد، وقلّما أوضح مؤلّفو الدراسات سبب إغفال ذلك (انظر الشكل: موقف الدراسات من الجنسين).
وخصّت فويتوفيتش علوم الأعصاب بالذكر؛ فقد أظهرت دراسات في هذا المجال زيادة كبيرة في إدراج الجنسين، لكن أقل من نصفها لم يكلّف القائمون عليها أنفسهم عناء تحديد أعداد المشمولين من كل جنس على حدة. وتلك مشكلة عندما تتعلّق المسألة بقابلية إعادة الإنتاج. وتعليقًا على ذلك، تقول فويتوفيتش إن إدراج الدراسات الجنسين شيء "عظيم"، ولكن "إنْ لم نُجرِ تحاليل على أساس كل جنس على حدة، فإننا عمليًا نُغفِل نصف البيانات".
وألقت دراسة متابعة أجراها فريق آخر نظرة من كثب على كيفية تعامل مجموعة الدراسات نفسها مع البيانات11. فاتضح لهم أن قلةً منها فقط هي التي أفادت ببيانات على أساس الجنس، وأن تلك التي فعلت ذلك لم تُجرِ تحاليل على أساس الجنس كما يجب – إذْ إن 70% من الحالات لم تقابِل حتى بين تأثيرات العلاج بين الجنسين – أو أنها أساءت فهم النتائج.
وكان من الأخطاء الشائعة استنتاجُ فارقٍ على أساس الجنس إنْ كانت إحدى نتائج البحث ذات دلالة في أحد الجنسين دون الآخر، وذلك حتى إنْ لم يُقابَل الجنسان مباشرةً. فالأعداد يمكن أن يكون لها مجال أوسع، يتراوح حول المعدّل من مجال الأعداد في المجموعة الأخرى، لا لشيءٍ سوى وجود فوارق فردية مثلًا. فاختبار المجموعتين، كلٍّ على حدة، بحثًا عن دلالة لا يُظهر ما إن كانتا مختلفتَين؛ إذْ لا بد من مقابلتهما ببعضهما بعضًا باعتماد اختبار إحصائي.
لكن التقرير وصف كذلك الميل بالاتجاه المعاكس: متمثّلًا في خطر محوِ تأثيرات حقيقية للجنسين. وينشأ الخطر عندما يجمع مؤلفو الدراسة حيوانات من كلا الجنسين من غير أن يَعُدّوا الجنس عاملًا مؤثرًا، وهو ما كانوا يفعلونه أحيانًا حتى عندما كانت الحسابات الأولية تشير إلى فوارق على أساس الجنس.
ويقدّم «كوفيد-19» مجدَّدًا مثالًا من الآونة الأخيرة يوضح كيف يمكن للتحاليل الخطأ أن تقود إلى استنتاجات خطأ. فقد وجد تقرير12 صادر عام 2020 فروقات في مستويات المناعة والجزيئات ذات الصلة بالالتهابات بين الرجال والنساء المصابين بمرض «كوفيد-19». لكن تحليل متابعة13 أجْرته سارة ريتشاردسون، وهي مؤرخة علمية ومديرة مختبر «جندر ساي» التابع لجامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، بمعاونة زملائها، أشار إلى أخطاء في التحاليل. ففي ثلاث من النتائج، كانت الفوارق ضمن الجنس نفسه، وليست بين الجنسين. على سبيل المثال، كانت مستويات جزيء تأشيرٍ بعينه متفاوتة جدًا بين النساء عند خط الأساس بين تلك النساء اللواتي ساء وضعهن، وتلك اللواتي ظل وضعهن مستقرًا، ولكن هذا النسق لم ينطبق على الرجال.
وكان مؤلفو الدراسة الأصليّون قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن النتيجة مثّلت فارقًا "بين الجنسين"، وذلك مع أن الجنسين لم أحدهما الآخر مباشرة. وبخلاف ذلك، أجرت ريتشاردسون وزملاؤها مقابلة مباشرة، فوجدوا أن الفارقين لم يكونا متمايزَين بشدة، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن للجنس دور في الأمر. واستنتجوا أن عوامل اجتماعية، مثل الهوية الجنسية المتصوّرة (الجندر) والعرقية، أكثر من الجنس، قد تكون أساس بعض الفوارق المنسوبة بالأصل إلى الجنس.
ويقرّ بعض الباحثين أنه ينبغي تمثيل عوامل اجتماعية من هذا النوع في التجارب الإكلينيكية. لكن قياس هذه المتغيّرات وتضمينها أشد صعوبة. وتقول مادلين بيب، وهي اختصاصية اجتماعية لدى جامعة لوزان، إن عملية تضمين الجنس في الدراسات بوصفه أولوية بين سياسات معاهد الصحة الوطنية الأمريكية "كان سيكون أصعب بكثير للهوية الجنسية المتصوّرة، حتى لو كان من الصعب جدًا في المحصلة فصل الجنس عن الهوية الجنسية المتصوّرة بوصفهما عاملين محدِّدَين للصحة".
وتأمل شيبينجر – التي كانت مجموعتها قد أمضت سنوات عديدة في تطوير استبيانات تعالج الهوية الجنسية المتصوّرة للاستعمال في التجارب الإكلينيكية – تأمل في أن تُدرج معاهد الصحة الوطنية الأمريكية الهوية الجنسية المتصوَّرة بوصفه متغيّرًا اجتماعيًا ثقافيًا يومًا ما. لكن المسألة "تنتظر إجراءات أفضل"، على حد قولها.
ويُراد من إرشادات «ساجر»، والسياسات الخاصة بالناشرين، فيما يتعلق بالجنسين والهويات الجنسية المتصوَّرة أن تشجّع المؤلفين على إدراج كلا الجنسين وتناول موضوعهما. لكن التزام الدوريّات بالسياسات غير منتظم. وقد أشارت دراسة غير رسمية صادرة عام 2021 إلى أن بعض محرّري الدوريّات ظل يقاوم تبنّي السياسات الخاصّة بالجنس بوصفه متغيّرًا بيولوجيًا، مؤكدين أنها غير قابلة للتطبيق في مجالاتهم.
وتقول إليزا بليس-مورو، وهي مختصّة بعلم النفس لدى مركز كاليفورنيا الوطني للبحوث الخاصة بالرئيسيّات، التابع لجامعة كاليفورنيا في مدينة ديفيس، إن الشكاوي من الالتزام المتأخر والاعتماد البطيء ليست غير متوقعة؛ مشيرةً إلى أن "قدرة الأشخاص على الاستجابة للتغيُّر محدودة". كما تقول إن طول دورات التمويل من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أدَّى إلى إبطاء منظومة العمل في استجابة السياسات للاطلاع على آخر المستجدات. وعن ذلك تقول: "طالما كانت هناك أشياء كثيرة توضع في السياسات ويتذمّر منها الناس، فنجدها قد أصبحت بعد 10 أو 15 عامًا طريقة العمل الاعتيادية".
خطوة إلى الأمام
مع أن الطريق لم تكن ممهّدة، فإن الإرشادات الفيدرالية الأمريكية التي وُضعت موضع التنفيذ في أوائل تسعينيّات القرن الماضي أدّت إلى اكتشافات طبيّة مهمّة، ربما تمثل مؤشّرًا على أن تجلّيات أساسية قد تظهر من البحوث الأساسية في بضع سنوات.
مثلًا، هناك فوارق على أساس الجنس في التجاوب الكهربائي للقلب مع فئات عديدة من العقاقير، من بينها مضادّات الاكتئاب والمضادّات الحيوية. ونتيجة لذلك، يوصَى الآن بإجراء تعديلات على الجرعات على أساس الجنس في حالة بعض العقاقير.
ويُعتقد أن الهرمونات الاستيرويدية مثل الإستروجينات والأندروجينات عناصرُ فاعلة أساسية في العديد من الفوارق بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، يُلاحَظ أن أيض عقار «البروبرانولول»، وهو دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم من فئة تدعى «مُحصِرات أيض بيتا»، لدى النساء أبطأ من أيض الرجال له15. ويعتقد بعض الباحثين أنه يمكن للهرمونات الستيرويدية ذات الصلة بالجنس المؤثرة في الكبد أن تطبّق هذه التأثيرات. ومن العوامل الأخرى الممكنة، حجم الجسم وبنيته، مثل نسبة الدهن إلى العضل فيه، التي تكون في النساء عادةً أعلى مما هي عليه في الرجال.
كما أن عتبات الخطر قد تتفاوت بين الرجال والنساء. فقد أظهر تحليلٌ صدر عام 2021 للمخاطر القلبية الوعائية ذات الصلة بضغط الدم الانقباضي ما يحدث إنْ جُمعت بيانات الجنسَين جمعًا بدلًا من تحليلها كما ينبغي3. فقد وجد مؤلّفو التحليل أنه عند جمع البيانات، كان مجال الخطر المتزايد هو عند ضغط دم انقباضي، يتراوح بين 120 و129 ملّيمترًا زئبقيًا. لكن التحاليل الخاصة بكل جنس على حدة أظهرت أن الخطر على النساء يأخذ يتزايد في الواقع عندما يتجاوز ضغط الدم الانقباضي 110 ملّيمترات زئبقية. وفي حال تعزّزت هذه النتائج المتوصَّل إليها بدراسات أخرى، فإن النتيجة قد تكون تغييرًا جذريًا في طريقة حساب خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.
وبالصدفة، كانت تلك الدراسة "مستلهمة ومدفوعة إلى حد كبير بطلبٍ من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية بإجراء تطبيقات" عن الفوارق بين الجنسين في النتائج الصحية، وفق قول سوزان تشينج، وهي طبيبة قلب تعمل لدى «مركز سيدارز سايناي الطبي» في لوس آنجلس بولاية كاليفورنيا، ومشارِكةٌ رفيعة المستوى في إعداد التقرير. وتقول تشينج، إنه بغياب تلك الدعوة إلى البحث عن فوارق بين الجنسين "كانت لدينا أفكار كثيرة، ولكن بلا تركيز على موضوع بعينه". وأضافت أن النتائج التي توصّلوا إليها عن الفوارق بين الرجال والنساء في عتبات الخطر "كانت في الواقع لحظة كشف كبير، فقد وجدت نفسي أتساءل: لِمَ لَمْ نلاحظ ذلك من قبل؟". وتعزو تلك النتائج إلى التحدي الذي فرضته معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إذْ تقول: "إليهم يعود فضل تحقيق ذلك".


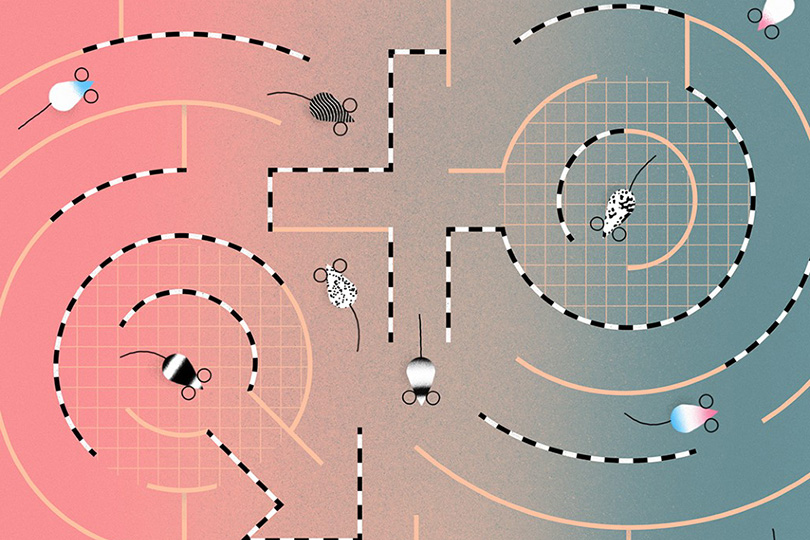

اضف تعليق