يلزم على المسلمين أن يتفقوا على أن لا يستوردوا أية بضاعة أجنبية، سواء من الغذاء أو الملابس أو غيرها من الكماليات وغيرها؛ لأن المسلمين ماداموا يستوردون البضائع وغيرها من الغرب، ولا يأكلون مما يزرعون، ولا يلبسون مما يخيطون وينسجون، فانكسارهم اقتصادياً حتمي لا محالة. أما إذا اعتمدوا على أنفسهم...
شمولية الإمداد الإلهي
قال اللّه تعالى في محكم كتابه العزيز: (كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا)(1).
إن اللّه سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة يقول: إننا نساعد جميع البشر، المؤمن منهم والكافر، وعطاء اللّه تعالى يصل إلى الجميع. حيث إنه سبحانه وتعالى لا يمنع لطفه عن شخص في الدنيا، فهو كما يعطي المؤمن يعطي الكافر، لكن الفرق في السعادة، فالكافر لا يهنأ بالسعادة، كما أن الآخرة خاصة بالمؤمن.
(كُلّٗا) من المؤمن والكافر (نُّمِدُّ) أي: نعطيهم من الدنيا (هَٰٓؤُلَآءِ) الذين يريدون الآخرة (وَهَٰٓؤُلَآءِ) الذين يريدون العاجلة (مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ) يا رسول اللّه، أي: من نعمته وفضله (وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا) أي: ممنوعاً، فإنه يشمل البرّ والفاجر.
والعلماء المفسرون يذكرون في هذه الآية بأنها تثبت الاختيار وعدم الجبر؛ وذلك لأنه لو كان اللّه تعالى لا يمد الإنسان إلّا بالحسنات لما تسنى للناس أن يُمتحنوا، لأن الناس يمتحنون في الخير والشر، بأن يعطيهم اللّه تعالى الحياة والقدرة والإمكان، فيتبين منهم الصالح ومنهم الطالح.
وقد يتساءل المرء: من أين تأتي قوة الإنسان التي يختار بها طريقه ويسعى بها فيه؟
الحقيقة إن قوة الاختيار وقوة السعي هي من عند اللّه، فحتى العصاة يستمدون قوتهم في الاختيار من اللّه، فليس عطاء اللّه ممنوعاً عن أحد، وهذا منتهى الحرية الممنوحة للبشر.
ولكن لماذا ذكرت كلمة (كُلّٗا) قبل (نُّمِدُّ) ولم تذكر بعدها، فقال عزّ وجلّ: (كُلّٗا نُّمِدُّ) ولم يقل: (نمد كلاً هؤلاء وهؤلاء)؟
والجواب: يحتمل أن تكون إحدى جهات التقديم هي التأكيد على عموم الإمداد الإلهي، وشموليته لجميع المؤمنين والكافرين، كما في (إِيَّاكَ نَعۡبُدُ)(2) حيث إن الأصل فيها (نعبد إياك) أي: (نعبدك)، ولكن لأن اللّه أهم من كل شيء في الوجود، فلذلك قدم (إِيَّاكَ) على (نَعۡبُدُ). هذا فضلاً عن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فتكون العبادة محصورة باللّه تعالى ومختصة به.
ورجوعاً للآية فإن الباري تعالى أعطى القدرة لجميع البشر بلا استثناء، للأشرار وللأخيار، لمعاوية ولأمير المؤمنين (عليه السلام)، وكذا ليزيد (لعنه اللّه) وللإمام الحسين (عليه السلام)، وكذا لهارون العباسي وللإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)؛ وذلك من أجل أن يتبين من هو هارون العباسي ومن يتبعه، ومن هو الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) وشيعته، وهكذا.
إذن، العطاء الإلهي مطلق غير محدود بشخص؛ وذلك لسنة كونية تمهد للجميع فرصة انتخاب الخير والفضيلة، ولمكان إطلاق العطاء ونفي الحظر والحبس عن أحد، قال تعالى في الآية: (وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا)(3). أما ما يوجد من التحديد والتقدير والمنع، واختلاف الناس في ما بينهم في الرزق والصحة والعلم وغير ذلك من موارد العطاء، فإنه من ناحية الناس أنفسهم وخصوص استعدادهم لقبول العطاء الإلهي، وليس من جهة المعطي الكريم. فالإشكال في القابل وليس في الفاعل على ما هو مذكور في علم الكلام.
كان هذا مدخلاً للحديث عن الاقتصاد في البلاد الإسلامية، ودور الشرق والغرب في التأثير عليه والعمل على تحطيم البنية الاقتصادية لدى المسلمين.
من هو المتقدم الفائز
قد عرف بهذه المقدمة أن سنة اللّه في الكون هي إمداد الجميع، فمن يعمل هو الذي يتقدم على من لا يعمل، وهذا قانون يجري في جميع مجالات الحياة والتي منها المسألة الاقتصادية. فبما أن الغرب أخذ يعمل ويعمل في المجال الاقتصادي انتصر وتقدم على المسلمين الذين كسلوا في هذا المجال، وقد ورد في الحديث الشريف: «من لا معاش له لا معاد له»، وهذا لا ينافي ما ورد في ذم الدنيا ومتاعها الفاني على ما هو مذكور في الكتب المفصلة.
حيث روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لما قبض رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أتاهم آت فوقف بباب البيت، فسلم عليهم، ثم قال: السلام عليكم يا آل محمد: (كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ)(4)، في اللّه عزّ وجلّ خلف من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودرك لما فات. فباللّه فثقوا، وعليه فتوكلوا، وبنصره لكم عند المصيبة فارضوا؛ فإنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، ولم يروا أحداً. فقال بعض من في البيت: هذا ملك من السماء بعثه اللّه عزّ وجلّ إليكم ليعزيكم، وقال بعضهم: هذا الخضر (عليه السلام) جاءكم يعزيكم بنبيكم (صلى الله عليه وآله)»(5).
فإن قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ) معناه: وما لذات الدنيا وشهواتها، وما فيها من زينة إلّا متعة تستبطن الغرور والخداع بشيء، فإنه لا حقيقة له عند الاختبار والامتحان؛ لأنكم تلتذون بما يمتعكم من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفضائح والمصائب فلا تركنوا إليه ولا تسكنوا إليه، فإنما الدنيا غرور وإنما أنتم منها في غرور. فمن الجدير بالإنسان أن يحصل بحياته ورئاسته وماله تلك الدار الباقية، لا أن يغتر بالدنيا ويعصي اللّه سبحانه حتى يدخل النار.
فإن الانسان قد يضيِّع الحقيقة ويتصور بأن الأمر انتهى، وقد وصل إلى هدفه ومبتغاه، كأن يتصور مثلاً: بأنه عندما ينتصر على عدوه أن المشكلات قد حلّت فيمضي في سبيله، ولا يدور في ذهنه بأنه من الممكن أن يكرّ عليه عدوه مرة أخرى ويقضي عليه وهو في غفلة! ولكن هذا غرور وغفلة لا تجر إلّا إلى السقوط والفشل.
إذن مثل هذه الروايات تدل على عدم الركون إلى الدنيا على حساب الآخرة، بأن يضيع الإنسان آخرته لأجل دنيا فانية، وهي لاتنافي ضرورة الاهتمام بالمسألة الاقتصادية لكي تكون الأمة قوية عزيزة، تقرر مصيرها بأنفسها، ولا تكون ألعوبة بيد المستعمرين.
غفلة المسلمين
وللأسف فإن المسلمين اليوم قد وقعوا في مشكلة الغفلة، التي هي أحد أسباب سيطرة دول الاستعمار القديم والحديث على بلدان العالم الثالث واقتصادها، من حيث نهب ثرواتهم وتحطيم بنيتهم الاقتصادية.
فالباكستان ـ مثلاً ـ هي إحدى دول العالم الثالث التي سقطت بسبب إنهيار اقتصادها، فعندما أرادت باكستان أن تنتزع استقلالها من الغرب قام الغرب بالقضاء على هذا الاستقلال عن طريق هدم اقتصادها، ففي عام (1948م) حصلت باكستان على استقلالها الظاهري(6)، ولكن منذ ذلك الحين ولحد الآن وقعت فيها عدة انقلابات عسكرية، راح ضحية تلك الانقلابات الآلاف من الناس، وهذا بسبب التدخل والنفوذ الغربي.
تحطيم البنية الاقتصادية
يتم تحطيم البنية الاقتصادية لأي مجتمع عبر طرق عديدة منها:
1- بواسطة إغراق السوق بسيل من البضائع الأجنبية، فيتسبب عن ذلك ارتفاع نسبة العرض وهبوط نسبة الطلب، والنتيجة تكون انخفاض قيمة البضائع والسلع المحلية، وسقوط اعتبارها في الأسواق.
2- بواسطة إخلاء السوق من البضائع، إلى درجة ارتفاع الطلب ارتفاعاً فاحشاً، وازدياد نسبة الأموال في أيدي الناس مما يعني انخفاض قوتها الشرائية، كل ذلك مضافاً إلى هبوط نسبة العرض، فتكون النتيجة أن تفقد الأموال قيمتها وقدرتها الشرائية، وهو ما يسمونه اليوم بـ(الركود الاقتصادي).
وهذا أسلوب معروف في علم الاقتصاد تقوم به الدول الغربية ـ غالباً ـ وتطبقه في أي مكان تريد السيطرة عليه، واحتلاله اقتصادياً وسياسياً. وقد يكون ذلك تحت سِتار: الإصلاح الاقتصادي وأمثاله. وذلك لأن الاقتصاد عصب الحياة، فإذا انهار الاقتصاد في بلد ما سيكون هناك مبرر كاف لتدخل الدول القوية في شؤون الدول الضعيفة والتحكم بها، بحجة الإصلاح الاقتصادي ودعم البلاد. هذه هي الحالة العامة التي نجدها في أغلب بلدان العالم الثالث.
الإنجليز ودورهم في تدمير الاقتصاد العراقي
حكى والدي (رحمه الله) عن أوضاع الاقتصاد العراقي إبان الاحتلال الإنجليزي فقال:
عندما دخل الإنجليز في العراق إبان ثورة العشرين، كانت عائلتي تتشكل من عشرة أفراد، وكنت أتقاضى شهرياً ليرة واحدة من آية اللّه العظمى الشيخ محمد تقي الشيرازي (رحمه الله)، وكانت الليرة في ذلك الزمان تساوي ثلاث عشرة روبية، وعندما دخل الإنجليز في العراق أعطوا لكل فرد في الجيش عشر روبيات لكل يوم(7)!
وقد ألزموا الجنود أن ينفقوها إلى المساء، فكان أفراد الجيش عندما يدخلون السوق يشترون ـ مثلاً ـ الدجاجة التي سعرها عُشر الروبية بروبية كاملة! وذلك لتوفر الأموال عندهم ولزوم صرفها إلى المساء.
وواضح أن هدف المحتل الإنجليزي ـ من هذه العملية ـ كان هو التلاعب بالاقتصاد العراقي وتقليل نسبة العرض ورفع نسبة الطلب أو العكس، فجعلوا الليرة التي كانت تكفي عائلة ذات عشرة أفراد لشهر كامل، تصرف من قبل فرد من أفراد الجيش في يوم واحد؛ ليصاب الناس بالفقر الفاحش؛ إذ ليس كل الناس كان يحصل على ما يحصل عليه جنود الاحتلال من رواتب.
ومن جهة أخرى أرادوا إجهاض قاعدة الاكتفاء والاعتدال الذاتي التي يقرها الاقتصاد الإسلامي، حيث جاء في رواية عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «المؤمن سيرته القصد وسنته الرشد»(8)، والقصد هو التوسط بين الإفراط والتقتير، ومن مصاديق ذلك التدبير في المعيشة، واستغلال الثروات الموجودة في ربوع البلاد الإسلامية، وتنميتها والعمل على تكثيرها.
وفي رواية أخرى عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وأنا عنده؟
فقيل له: أصابته الحاجة.
قال (عليه السلام): «فما يصنع اليوم؟».
قيل: في البيت يعبد ربه.
قال (عليه السلام): «فمن أين قوته؟».
قيل: من عند بعض إخوانه.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «واللّه للَّذي يقوته أشدُّ عبادة منه»(9).
وذات يوم رأى أحد الأصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصاب عن ظهره، فقال: جعلت فداك، أعطني أكفك؟
فقال الإمام (عليه السلام): «إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة»(10).
الاكتفاء الذاتي ضرورة
ومن هنا يعلم ضرورة تطبيق ما يوجب الاكتفاء الذاتي في البلدان الإسلامية؛ فلأجل تقوية الاقتصاد الإسلامي وتعديله: يلزم على المسلمين أن يتفقوا على أن لا يستوردوا أية بضاعة أجنبية، سواء من الغذاء أو الملابس أو غيرها من الكماليات وغيرها؛ لأن المسلمين ماداموا يستوردون البضائع وغيرها من الغرب، ولا يأكلون مما يزرعون، ولا يلبسون مما يخيطون وينسجون، فانكسارهم اقتصادياً حتمي لا محالة. أما إذا اعتمدوا على أنفسهم وهيئوا ما يحتاجون إليه من المواد الأولية من داخل بلادهم، واستغنوا عن الغرب ومنتجاته، وقنعوا بمنتجاتهم الوطنية كما فعلت الهند إبان نهضتها وثورتها ضد الإنجليز المحتلين، فإنهم سيكونون أسياد أنفسهم وسيقوى عصب اقتصادهم، ولن يحتاجوا حينئذٍ إلى الغرب والشرق أبداً.
فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «استغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأفضل على ما شئت تكن أميره»(11).
تجربة الهند مع الاحتلال البريطاني
قام غاندي بتطبيق الاكتفاء الذاتي على بلاده حتى حقق استقلال الهند عن الإنجليز اقتصادياً وسياسياً، وذلك عبر أساليب عديدة، أهمها أمران:
أحدهما: أنه منع صنع الخمر وشربه والتعامل به، وكان يقول: إننا بحاجة إلى العقل حتى نقف ضد الإنجليز والغرب، والخمر مزيل للعقل.
وعندما أعلن ذلك المنع قام أتباعه بحملة على أشجار العنب فأبادوا مليون شجرة عنب كانت تستغل لأجل تحضير الخمر، وذلك لأن القضاء على تناول الخمر لا بد له من القضاء على جذوره وهي أشجار العنب.
ثانيهما: مقاطعة البضائع الإنجليزية، ومن أهمها الامتناع عن لبس الملابس الإنجليزية واستعمالها؛ ليُفهم الإنجليز بأنه لم يعد لهم في الهند مكان، وتحسباً من عرقلة ذلك القرار قرر أنه كل من لم يلتزم بهذا القرار ـ واستعمل الملابس الإنجليزية مثلاً ـ لا يحق له الاشتراك في المؤتمر الوطني الهندي.
لقد كان في قصة الهند وابتلائهم بالمحتلين البريطانيين، وكيفية تخلصهم من سلطتهم الجائرة واحتلالهم المشين، عبرة لمن اعتبر؛ فإن البريطانيين كانوا قد احتلوا بلاد الهند مدة ثلاثمائة سنة، ولم يتركوا الهنود يتقدمون في شيء من أبعاد الحياة، لكن الهنود لما استقلوا وذلك منذ خمسين سنة، نفضوا عن أنفسهم غبار الاحتلال والتبعية، وعملوا بجد واجتهاد حتى تقدموا في إنتاج كل شيء، من الذرة إلى غيرها من الصناعات، وزرعوا كل شيء يحتاجون إليه من الذرة إلى غيرها من المزروعات، وبلغوا في كل ذلك درجة الاكتفاء الذاتي، على الرغم من أن نفوس الهند تقرب من مليار نسمة، ومع أنه قد صادر المستعمرون البريطانيون في هذه القرون الثلاثة التي كانوا يحتلون فيها بلادهم، كل خيرات وموارد وثروات البلاد، حتى افتقروا أشد الفقر، لكنهم لما اهتموا وعملوا تمكنوا من التقدم وذلك بهذا الشكل من التقدم الهائل.
السعي إلى الاكتفاء الذاتي
لذا يلزم على بلادنا الإسلامية أن تطبق برامج عديدة للاكتفاء الذاتي في جميع احتياجاتها اليومية ـ نعم الضرورات تقدر بقدرها حسب تشخيص الخبراء ـ فتوفر لنفسها جميع احتياجاتها الغذائية بدءً من البيض والدجاج واللحم والزيوت، وهكذا بالنسبة إلى الصناعات، وما إلى ذلك من المواد الأولية، من نفس أرضها وثروتها الحيوانية والزراعية، إلى استخراج المعادن الوفيرة المدفونة بأرضنا التي أنعم اللّه بها علينا، بحيث تبلغ درجة الاكتفاء الذاتي وتزيد كثيراً.
نعم، إذا التفت المسلمون الى أهمية الاكتفاء الذاتي من خلال برمجة دقيقة بإشراف الأخصائيين، وكذلك استغلال أوقات الفراغ أو الطاقات المعطلة في عملية البناء والتنمية، كان ذلك ـ قطعاً ـ يعود بالفائدة والرفاه على المجتمع الإسلامي ككل.
فعلى سبيل المثال: إذا امتلكت كل عائلة ماكنة خياطة، وحقل صغير للدواجن تربي فيه الطيور والدجاج والأغنام والماعز، وحوض لتربية الأسماك، وزرعت حديقة البيت ـ وإن كانت صغيرة ـ بالخضروات وأشجار الفاكهة وما أشبه. فإن مثل هذه الأعمال مضافاً إلى واردها وانتاجها قادرة على معالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية وغيرها؛ فهي تحل مشكلة الفراغ، وأيضاً بعض مشكلة الغلاء، وأيضاً المشاكل النفسية التي تعاني منها الأسر بسبب الضائقة المالية.
علماً أن التعاون هو السبيل لحل معظم المشاكل الإجتماعية، ولا يقتصر هذا البرنامج على الفرد والأسرة فقط بل يسري إلى المنظمة والهيئة وإلى المستويات الكبيرة الأخرى من تشكلات المجتمع. فإذا كان بمقدور الفرد الواحد أن يحقق قسطاً من الاكتفاء الذاتي فكيف بالمنظمة المشتملة على الآف الأفراد، وقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): «كلوا جميعاً ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة»(12).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يد اللّه مع الجماعة»(13).
وهذا أمر تكويني قبل أن يكون غيبياً.
وإذا كان بمقدور المنظمة إنجاز أكبر الأعمال الممكنة في نطاق الاكتفاء الذاتي فإن بمقدور السلطات عمل ما هو أكبر من ذلك؛ لأنها تمتلك من الإمكانات التي تتيح لها إنجاز أعمال أكبر من الآخرين، بشرط أن تكون حكومة قائمة على مبدأ الشورى المستندة إلى الأحزاب الحرة ذات المؤسسات الدستورية وبشكل تعددي بعيد عن أساليب الظلم والاستبداد.
وبغير ذلك فإن عدونا سيستفيد من نقطة ضعفنا هذه، وينفذ ويتسلل إلى داخل بلادنا الإسلامية تحت عناوين متعددة، مثل الإصلاح الاقتصادي وما أشبه؛ ليحطمنا ويهزمنا من الداخل.
لا لليأس
من أهم ما يلزم على الأمة في التخلص من الهيمنة الاقتصادية الغربية إبعاد حالة اليأس والإحباط وضعف الأمل عن نفوس الأمة، فهي جميعها تعتبر من أهم عوائق التقدم والرقي، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (وَلَا تَاْيَۡٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيَۡٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ)(14).
وقد ذكر في تفسير الآية الكريمة: (وَلَا تَاْيَۡٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ) أي: لا تقنطوا من رحمته، ولعل الإتيان بلفظ الرَّوْح، لأجل أن المهموم المكظوم المحتبس النفس، يحتاج الى رَوْح ونسيم ليُرَوِّح عنه، ويخفف وطأ الأنفاس المحترقة الموجبة لخنقه واحتباس نفسه، و: (إِنَّهُۥ لَا يَاْيَۡٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ) ورحمته (إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ) باللّه وبفضله، أما المؤمن فإنه يرجو من اللّه الفرج من الشدة، والخلاص من الكربة(15).
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كل قانط آيس»(16).
وقال (عليه السلام): «قتل القنوط صاحبه»(17).
وقال (عليه السلام): «للخائب الآيس مضض الهلاك»(18).
إن الشدة التي فيها انقطاع الأسباب وانسداد طرق النجاة؛ تشكل اختناقاً للإنسان، ويقابلها الخروج إلى فسحة الفرج والظفر، فالرَّوْح المنسوب إليه تعالى هو الفرج بعد الشدة، بإذن اللّه ومشيئته، وعلى من يؤمن باللّه أن يعتقد بأن اللّه يفعل ما يشاء؛ ولذا قال اللّه تعالى حاكياً على لسان يعقوب (عليه السلام): (إِنَّهُۥ لَا يَاْيَۡٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ)(19).
وقال حاكياً على لسان إبراهيم (عليه السلام): (وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ)(20).
وقد عد اليأس من رَوْح اللّه من الكبائر الموبقة؛ كما يعتبر اليأس والتشاؤم من أهم عوالم التأخر.
قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «الكبائر أربع: الإشراك باللّه، والقنوط من رحمة اللّه، والأمن من مكر اللّه»(21).
وعن صفوان الجمال قال: شهدت أبا عبد اللّه (عليه السلام) واستقبل القبلة قبل التكبير وقال: «اللّهم، لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تؤمني مكرك؛ فإنه لا يأمن مكر اللّه إلّا القوم الخاسرون». قلت: جعلت فداك، ما سمعت بهذا من أحد قبلك؟! فقال (عليه السلام): «إن من أكبر الكبائر عند اللّه اليأس من روح اللّه، والقنوط من رحمة اللّه، والأمن من مكر اللّه»(22).
إذن، ما دام المسلمون متشائمين ويائسين، وقانطين من رحمة اللّه، لا يمكنهم تجاوز مشاكلهم والتقدم ببلادهم نحو الأمام، وبالتالي هم عاجزون عن مواجهة الاستعمار وعملائهم الطغاة أمثال صدام ولا يتمكنون من مواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على المسلمين في العديد من البلاد الإسلامية كالعراق وليبيا، والسودان، وأفغانستان، وغيرها.
لذا يلزم أن لا يوجد في قاموس حياتنا مفردات التشاؤم واليأس وما أشبه، وذلك انطلاقاً من أوامر وتوجيهات القرآن الكريم والسنة المطهرة كما في الأحاديث الشريفة.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الفقيه كل الفقيه من لم يقنِّط الناس من رحمة اللّه، ولم يؤيسهم من روح اللّه، ولم يؤمنهم من مكر اللّه»(23).
قصة واقعية
عندما كنا في إحدى البلاد الإسلامية(24)، رغب أحد الأصدقاء في شراء شاتين، فطلب ذلك من أحد باعة الشياه. فقال: وأي نوع تريدون، شاة محلية أم أجنبية؟!
قال: وهل هناك فرق بينهما؟
قال: نعم، الفرق واضح وكبير جداً.
قال: كيف ذلك؟!
قال: سترون. وذهب وأحضر شاتين مستوردة من دولة هولندا، كأنهما ـ وبدون مبالغة ـ عجلان سمينان، وأحضر شاتين محليتين كان وزنهما لا يتجاوز نصف وزن الشاة الأجنبية، وبعد الاستفسار عن الثمن تبين أن قيمة الشاة المستوردة السمينة لا يزيد على ثلث قيمة الشاة المحلية الضعيفة!! يعني: إن الشاة الأجنبية الواحدة تعادل شاتين محليتين أو أكثر من ناحية الوزن، في حين أن قيمتها لا تتعدى الثلث إن لم تكن أقل من ذلك... ولماذا؟!
لأن الزراعة وتربية المواشي في البلاد الإسلامية دون مستوى الزراعة وتربية المواشي في الدول الأخرى بدرجات كبيرة، مع أن المفروض أن يكون العكس، وأن تكون البلاد الإسلامية هي المتطورة والمتقدمة كما كانت عليه سابقاً. وذلك لاشتمالها على مختلف الثروات في أراضيها ومياهها ومعادنها وغير ذلك، وهذا واضح وجلي عند أبسط مقارنة بين الثروات والنعم التي أنعم اللّه بها على بلاد المسلمين من: المياه والأنهار، والتربة الخصبة الغنية، وكثرة الأيادي العاملة، وبين غيرها من البلاد, ولكننا نجد الفرق شاسعاً في الإنتاج ونوعيته.
وهو الحال نفسه بالنسبة إلى الثروات الحيوانية والمائية، وما أشبه ذلك من موارد الطاقة، وكل ذلك حدث نتيجة التقصير والتقاعس من قبل المسلمين، وبتخطيط من قبل دول الكفر والاستعمار، وقبول من دولنا، وتطبيق من قبل حكامنا العملاء. إذ لا يخفى أن إحدى المخططات التي اتخذها الغرب من أجل القضاء على اقتصاد المسلمين، هو سلب الحرية الاقتصادية التي أمر بها الإسلام، أي: حرية الكسب والتجارة والزراعة وحيازة المباحات وما أشبه، فأصبحت البلاد الإسلامية تعمل بقوانين غربية وشرقية لا إسلامية، الأمر الذي كان له أشد الأثر في تجميد السيولة المالية لدى المسلمين التي كانت ترد إلى بلاد الإسلام بشكل رئيسي من خلال الحريات الاقتصادية ـ سابقاً ـ وشعار الباب المفتوح وفق حدود الإسلام وشروطه السمحة اليسيرة.
العلاج الإسلامي الاقتصادي
إن العلاج الناجع لحل المشكلة الاقتصادية يكمن في العمل ضمن إطار القوانين الإسلامية في باب الاقتصاد، ففي نظر الإسلام الناس أحرار في أن يتاجروا ويعملوا أي عمل، ويقوموا بأي كسب ـ باستثناء ما حرمه اللّه سبحانه وتعالى ـ وفي أي زمان ومكان شاؤوا، ولا يحق لأي شخص، أو دولة، أن تضيق أو تمنع من ذلك أو تشترطه بأخذ موافقة أو إجازة أو دفع ضريبة أو ما أشبه.
إن منطق الإسلام يتجلى أكثر من خلال أحكامه العامة السمحة، وقواعده الفقهية السهلة التي لا تقبل التبديل أو التحول، وإحدى تلك القواعد الفقهية المسلم بها، والتي ذكر بعض العلماء أنها من ضروريات الدين الإسلامي ولوازمه هي: (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)(25). وهذه القاعدة تضمن حرية الإنسان الاقتصادية وتقدمه في مختلف جوانب الحياة كما أنها تعبر عن مجمل (حقوق الإنسان) في الإسلام.
ولقد سعى الاستعمار جاهداً من أجل إبعاد المسلمين عن هذا المنطق الواضح الصريح، بعد أن أدرك أن في إبعادهم السبيل الأقصر لتقويض دعائم بلادهم، ومحاصرة قواهم المالية... فقام في سبيل ذلك بوضع قوانين وشرائط وقيود للكسب والتجارة، حتى لا يجد المسلمون حرية في معاشهم وكسبهم فيسلبوا بذلك فرصة التقدم والازدهار.
فإذا كان العجب يبطل بعد معرفة السبب كما يقولون؛ فإن: (الدواء لا يتعين إلّا بتشخيص الداء)، فعلينا أن نتعرف على الداء في مجتمعاتنا، ثم تشخيص الدواء على المنطق الإسلامي، فإن قوانين الإسلام الاقتصادية هي الدواء، كما يلزم علينا أن نتشبع بروح الإسلام ومبادئه أولاً، حتى يتسنى لنا مقاومة خطط الأعداء والمستعمرين، والاستغناء عن سيطرتهم الاقتصادية على بلادنا، وهو الداء المشخّص لنتحرر من أسر التبعية والحصار.
كذلك كان موقف الإسلام، وكذلك كان موقف من يؤمنون به، ويلتزمون بسننه وأحكامه؛ لذا لا بد لنا من الابتعاد كل البعد عن الإسراف بكل معانيه فكرياً كان أم مادياً، وإذا كان إهدار الموارد وتضييع الثروات يعد ترفاً وإسرافاً؛ فإن من الإسراف الفكري إهمال الفكر وتعطيل العقول، واليأس من الوصول إلى الحلول.
وعلينا أن نفعل نفس ما فعله المجدد الشيرازي (رضوان اللّه عليه)، حيث حرر إيران من الهيمنة الاقتصادية الإنجليزية بكلمة واحدة مختصرة، عندما أفتى بتحريم استعمال التنباك مطلقاً، ورغم أن كلمته وفتواه المشهورة كانت مختصرة، إلّا أن محتواها كان عظيم الخطر في معناه وأثره. وفتواه هي:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم: استعمال الدخانيات اليوم في إيران في حكم محاربة الإمام صاحب الزمان (عج)».
نعم، قاد المجدد ثورة التنباك ضد الإنجليز وحكومة ناصر الدين شاه القاجاري، بعد أن قادت بريطانيا جيوشاً جرارة على إيران، وذلك في ربيع الثاني سنة (1309ه)، وكان قوامها (400 ألف مقاتل)، وكان هدفهم السيطرة على اقتصاد إيران عبر أساليب عديدة، أهمها الحصول على امتيازات التبغ زراعة وشراءً وتصديراً مقابل (250) ألف ليرة إنجليزية، تقدمها لندن لناصر الدين شاه القاجاري أحد ملوك ايران في العصر القاجاري. فأحبط المجدد الشيرازي (رحمه الله) المؤامرة بعد أن أصدر فتواه الشهيرة، فاضطرت جيوش الإنجليز إلى حزم حقائبها، ثم الخروج من إيران تجر أذيال الخيبة والإنكسار.
كما أن المجدد الشيرازي (رحمه الله) قام بدور آخر في إنقاذ المجتمع الإسلامي وذلك بإيقاف الظلم الطائفي الذي قام به الحاكم المستبد (عبد الرحمن خان) في أفغانستان، الذي قام بقتل الشيعة وجعل من رؤوسهم منائر في كل مكان، فأوقف الفتنة الطائفية التي كان يريدها أعداء الإسلام، فكما قارع الاستعمار البريطاني في ثورته السلمية في قصة التبغ والتي أيقظت العالم الإسلامي وأعطته الوعي السياسي في تاريخه الحديث، كان ينبه المسلمين ويحفظهم من الأخطار التي يسببها النفوذ الأجنبي في بلادهم.
وهكذا يلزم أن يكون دور العلماء في إرشاد الناس نحو الخير والفضيلة في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها.
اقتصاد الدول المتقدمة
في إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً وهي اليابان وعلى أثر النظام الاقتصادي الناجح الذي اتبعوه، باعتمادهم على أنفسهم وتخلصهم من النفوذ الغربي، استطاعوا أن يستفيدوا حتى من قشور الباقلاء التي نعدها من الأوساخ وفضلات الطعام، فصنعوا منها ألواح الخشب المضغوط التي تستعمل في صنع الدواليب والصناديق والأدوات المنزلية الخشبية، وسائر الاستخدامات الاخرى.
وإنني أتذكر قبل الحرب العالمية كيف كانت الصناعة اليابانية معروفة بعدم الإتقان، ولم يكن يرغب فيها الناس. أما بعد أن جعلوا في بلادهم التعددية الحزبية، وانتهجوا منهج الإتقان في أمورهم، واتخذوا سياسة اقتصادية ناجحة، وصلوا إلى ما وصلوا إليه من القوة الاقتصادية المنافسة لأقوى الدول، حتى اشتهرت الجودة في مختلف صناعتهم، وأصبح الإقبال عليها والمشترون لها أكثر حتى مما يصنعه الغرب. وهذا كله بسبب الإتقان في الأمور.
كما إنني أتذكر ذات مرة أن أعداد الفئران تكاثرت بشكل مخيف في الكويت، ومهما استعمل الناس من أنواع السموم والمبيدات لم ينفع، فقلت لأحد الخبراء المسلمين وقد التقيت به في تلك الفترة: ما هو الطريق لحل هذه المشكلة؟
فقال: سآتي لكم بشيء جئت به من الصين، فذهب وعاد ومعه وسيلة عجيبة، ولكن فكرتها سهلة، وكانت عبارة عن مصباح كهربائي خاص، باستطاعته ـ للخاصية الموجودة فيه ـ أن يجذب الفئران نحوه كجذب المغناطيس للمعادن، ثم يقضي عليها!
الجد والاجتهاد في العمل
من أهم مقومات الاقتصاد الناجح هو الجد والاجتهاد في العمل، وعليه سار المسلمون فتقدموا، قال تعالى: (وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ)(26).
وفي خبر الشيخ الشامي، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا شيخ، من اعتدل يوماه فهو مغبون، ومن كان في الدنيا همته كثرت حسرته عند فراقها، ومن كان غده شراً من يومه فمحروم، ومن لم ينل ما يرى من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى، ومن كان في نقص فالموت خير له»(27).
وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «طوبى لمن طال عمره، وحسن عمله، فحسن منقلبه؛ إذ رضي عنه ربه. وويل لمن طال عمره، وساء عمله، فساء منقلبه؛ إذ سخط عليه ربه عزّ وجلّ»(28).
وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمتي، تعيشوا في أكنافهم، فالخلق كلهم عيال اللّه، وإن أحبهم إليه أنفعهم لخلقه، وأحسنهم صنيعاً إلى عياله، وإن الخير كثير وقليل فاعله»(29).
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل مماتك»(30).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما من يوم يمر على ابن آدم إلّا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل فيَّ خيراً، واعمل فيَّ خيراً، أشهد لك به يوم القيامة؛ فإنك لن تراني بعده أبداً»(31).
وعن علي الهادي (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إياكم والإيكال بالمنى! فإنها من بضائع العجزة»(32).
قصة من التاريخ
ولننظر أخيراً إلى هذه القصة، ونتعلم من صاحبها درس التدبير والجد والعمل، ولنتعرف على بعض الأساليب الاقتصادية الناجحة عنده:
يذكر أن شخصاً يدعى (أبو البركات)، كان من التجار الكبار المشهورين بتجارة الجياد، بعد أن كان قد رباها ودربها بشكل تكون مفيدة للحرب ضد الكفار؛ لذلك كان من ينوي الذهاب إلى الحرب يأتي إليه ويشتري منه ما شاء من الجياد.
يقول أبو البركات: ذات يوم جاءني شخص وقال: أريد أن آتي إلى محل جيادك لأشتري عدة أفراس للمجاهدين، قلت له: لا مانع من ذلك، وتوجهنا بالمسير نحو الإصطبل، وفي الطريق لفت نظري عمل كان يقوم به هذا الشخص، حيث كان كثيراً ما يهوي إلى الأرض ويأخذ شيئاً منها ويضعه في كيس كان معه، حتى وصلنا الإصطبل، فاشترى مني عدة جياد أصيلة قوية وسريعة وبأثمان غالية، فسألته قائلاً: إني رأيت منك في الطريق شيئاً عجيباً، فما هذا العمل الذي كنت تعمله؟
قال: هذا عملي وكسبي اليومي! حيث إني أطوف الشوارع والأزقة، فأينما عثرت على قشر رمان، أو خشبة، أو قطعة حديد، أو ما أشبه ذلك أجمعها، ثم أجعل الحديد في جانب، والخشب في جانب، وهكذا، وبعد ذلك أبيعها، فالحديد للحداد، وقشور الرمان للدباغ، والخشب للخباز أو لمن يستعمله، وقد جمعت من هذا العمل هذا المال الذي اشتريت به منك هذه الجياد لإعانة المجاهدين في سبيل اللّه والإسلام.
وهذه القصة تدل على أن العمل يثمر وإن كان في نظر البعض تافهاً.
لذا يلزم العمل والجد والاجتهاد حتى يرجع الاقتصاد الإسلامي إلى بلادنا، وتكون دفة الاقتصاد بيد المسلمين لا بيد أعدائهم، فقد ورد في وصايا الإمام الحسن (عليه السلام): «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»(33).
كما يجب العمل لاستعادة ثروات الأمة المصادرة، حتى يعود للمسلمين عزهم وغناهم، كما كانوا عليه في العصور الأولى للإسلام. وإلّا فإن «من لا معاش له لا معاد له» على ما ورد في الحديث.
«اللّهم صل على محمد وآل محمد، وأسألك الربح من التجارة التي لا تبور، والغنيمة من الأعمال الخالصة الفاضلة في الدنيا والآخرة، والذكر الكثير لك والعفاف والسلامة من الذنوب والخطايا، اللّهم ارزقنا أعمالاً زاكية متقبلة، ترضى بها عنا، وتسهل لنا سكرة الموت، وشدة هول يوم القيامة، اللّهم إنا نسألك خاصة الخير وعامته لخاصنا وعامنا، والزيادة من فضلك في كل يوم وليلة، والنجاة من عذابك، والفوز برحمتك»(34).
من هدي القرآن الحكيم
لزوم العمل
قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ)(35).
وقال سبحانه: (وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيۡنِۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةٗ لِّتَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا)(36).
الأنبياء (عليهم السلام) والعمل
قال عزّ وجلّ: (وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيۡهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مََٔارِبُ أُخۡرَىٰ)(37).
وقال جلّ وعلا: (وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ)(38).
التقدير في المعيشة
قال سبحانه: (وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا)(39).
وقال عزّ وجلّ: (وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا)(40).
أسلوب الكفار والمستعمرين
قال تبارك وتعالى: (وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا * وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا)(41).
وقال عزّ وجلّ: (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ)(42).
وقال جلّ وعلا: (لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ)(43).
من مقومات العزة
قال تعالى: (وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا)(44).
وقال سبحانه: (يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ)(45).
من هدي السنّة المطهّرة
لزوم العمل
قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة»(46).
وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «أوصيكم بالخشية من اللّه في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبراً، وصمتكم فكراً، وقولكم ذكراً، وإياكم والبخل، وعليكم بالسخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخي»(47).
وقال رجل لأبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام): إني لا أحسن أن أعمل عملاً بيدي ولا أحسن أن أتجر، وأنا محارف(48) محتاج؟
فقال: «اعمل فاحمل على رأسك، واستغن عن الناس؛ فإن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط من حيطانه، وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلّا أنه ثمَّ»(49).
الأنبياء (عليهم السلام) والعمل
قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «إن اللّه حين أهبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كده بعد الجنة ونعيمها...»(50).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالمر(51) ويستخرج الأرضين، وكان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته، وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده»(52).
وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي من يكفيني، ليعلم اللّه عزّ وجلّ أني أطلب الرزق الحلال»(53).
التقدير في المعيشة
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «حسن البشر بالناس نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة الصالحة أحد الكاسبين»(54).
وعن داود بن سرحان قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك، لو أمرت بعض ولدك، أو بعض مواليك فيكفيك؟
فقال: «ياداود، إنه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة»(55).
وقال (عليه السلام): «عليك بإصلاح المال؛ فإن فيه منبهةً للكريم واستغناءً عن اللئيم»(56).
وعن معتب قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ـ وقد تزيَّد السعر بالمدينة ـ «كم عندنا من طعام؟».
قال: قلت: عندنا ما يكفيك أشهراً كثيرةً.
قال (عليه السلام): «أخرجه وبعه».
قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام؟
قال (عليه السلام): «بعه».
فلما بعته، قال (عليه السلام): «اشتر مع الناس يوماً بيوم ـ وقال ـ يامعتب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة؛ فإن اللّه يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحبت أن يراني اللّه قد أحسنت تقدير المعيشة»(57).
آثار المال في المجتمع الإسلامي
قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، أو يتّبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا، وسأنبئكم المخرج من ذلك: أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأما العالم فانتظروا فيئته ولا تتبعوا زلته، وأما المال فإن المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه»(58).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «المال للفتن سبب وللحوادث سلب»(59).
من مقومات العزة
قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أتت الموالي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: نشكوا إليك هؤلاء العرب، إن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوّج سلمان وبلالاً وصهيباً، وأبوا علينا هؤلاء، وقالوا: لا نفعل.
فذهب إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فكلمهم فيهم، فصاح الأعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك!
فخرج وهو مغضب يجر رداءه، وهو يقول: يا معشر الموالي، إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك اللّه لكم؛ فإني سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يقول: الرزق عشرة أجزاء، تسعة في التجارة وواحدة في غيرها»(60).
وعن المعلى بن خنيس قال: رآني أبو عبد اللّه (عليه السلام) وقد تأخرت عن السوق، فقال لي: «اغد إلى عزك»(61).


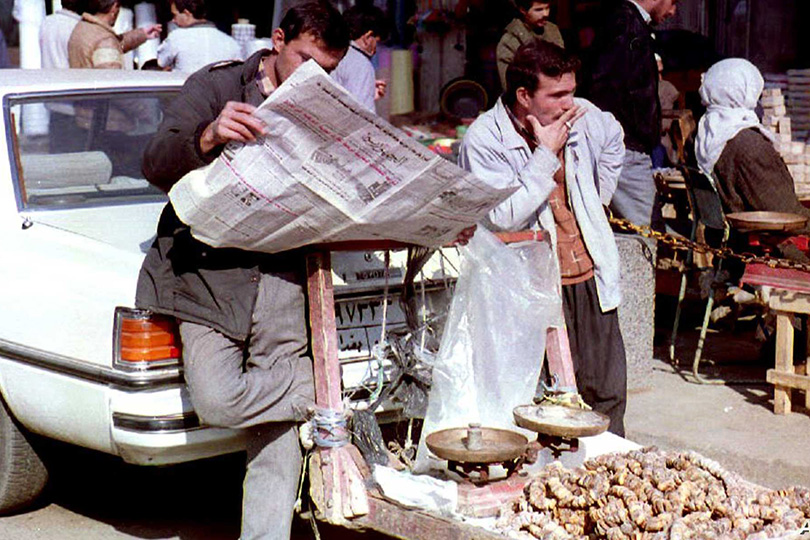

اضف تعليق