تبرز في مجتمعنا العراقي وتكاد تتكرر في عموم البلدان العربية، حالة الاستهلال بالمقدمات المعوِّقة، وفي الأغلب الأعم تتقدم الروح السلبية والرأي المثْبِط على نقيضه، مع أن الشخص المثبِط أو السلبي لم يدرك هو نفسه ماهية العوائق التي تقف في طريقه، ولا يعيها جيدا، ولا يسعى إلى فهمها وتحليلها حتى تسهل عليه خطوات المجابهة، فهو يضع التثبيط مقدما، ويلوذ بالسلبيات حتى يجد له مهربا من معالجة المعيقات التي تمنعه من التقدم أو المضيّ في مشروعة أو فكرته...
تبرز في مجتمعنا العراقي وتكاد تتكرر في عموم البلدان العربية، حالة الاستهلال بالمقدمات المعوِّقة، وفي الأغلب الأعم تتقدم الروح السلبية والرأي المثْبِط على نقيضه، مع أن الشخص المثبِط أو السلبي لم يدرك هو نفسه ماهية العوائق التي تقف في طريقه، ولا يعيها جيدا، ولا يسعى إلى فهمها وتحليلها حتى تسهل عليه خطوات المجابهة، فهو يضع التثبيط مقدما، ويلوذ بالسلبيات حتى يجد له مهربا من معالجة المعيقات التي تمنعه من التقدم أو المضيّ في مشروعة أو فكرته.
تكاد هذه الحالة من الإحباط تلفّ الغالبية من أفراد المجتمع بحبائلها، حتى اقتربت من أن تكون ثقافة تفكير وسلوك جمعي تراجعي هارب، لا يحبّذ المواجهة، بينما لو أن الفرد والمجتمع ككل يتحلى بروح المواجهة بعد الوعي والفهم والاستيعاب، واستغوار خفايا المشكلات واستبطان الثغرات لأمكن التحليل والاستنتاج ووضع المعالجات اللازمة ومن ثم التحول من حالة القنوط إلى المبادرة والفاعلية، وهذا دليل على أن التكوين الخَلْقي للإنسان لا يحمل معه أصلا بذرة اليأس وإنما هو الذي يختلقها أو يكتسبها بأسباب العجز والتراخي والتهرّب من سمة المجابهة، والحقيقة أن هذا النوع من السلوك تخلقه منظومات مجتمعية متآزرة تتصدّرها (الثقافة، والتقاليد البالية، وبلادة التفكير)، لذلك من أهم سبل المعالجات، أن نعي ماهيّة المعيقات، ومن ثم الانطلاق في مشروعنا بفاعلية أصيلة.
ويأتي الوعي بالمعوقات الموضوعية والذاتية بمثابة الخطوة الأولى الضرورية لإطلاق الطاقات الحية والانطلاق على درب الفاعلية كما يذهب مصطفى حجازي، وعلى عكس المتعارف عليه، فإن الوعي بالمعوقات الموضوعية لا يكفي لتوفير شروط الانتقال. هذه المعوقات الموضوعية معروفة ولا تحتاج إلى تحليل أو تدليل. الحديث فيها هو الشائع في ثقافتنا التي سرعان ما تركز على السلبيات وتنطلق في تعدادها وتضخيمها بشكل يسد آفاق كل فعل ممكن وكثيرا ما ننطلق في مي ما يسمى بعملية (عصف الملامات) في مقابل عملية (العصف الذهني) وبينما تستخدم عملية العصف الذهني لتوليد حلول وأفكار جديدة، قد تكون خارجة عن المألوف، لمشكلات يتعذر حلها بأساليب التفكير المألوفة، يستخدم عصف الملامات للقيام بجردة لكل المثالب والمعوقات التي تعرض قضية ما، بهدف التعامل معها في ثقافتنا نغرق في عصف الملامات ونقف عندها في تضخيم فعلي للسلبيات التي تسد آفاق التعامل الفاعل، وتقعدنا بالتالي عن القيام بمسؤولياتنا عن واقعنا وصناعة مصيرنا. هذا في حين أنه يتوجب علينا ممارسة (العصف الذهني) لفتح الآفاق واستكشاف الإمكانات والمخارج المتوفرة دوما، حتى في أقسى الظروف، وأكثرها مأزقية، طالما استمرت الحياة وتحوّلاتها.
إذاً نحن نقف بين قطبين متناقضين، عصف الإقدام يقابله عصف النكوص أو التراجع، وأيّاً كان اختيارنا ستأتي النتائج طبقا لذلك، ولعل الأكثر خطورة في هذا الأمر عدم قدرة الإنسان (فرداً أو جماعة) على وعي التعقيدات الذاتية التي تنطوي عليها شخصيته، في التفكير وطرائق المعالجة، فإن لم يفهم الفرد ما ينقصه، والعلل التي تحد من فاعليته، لن يكون قادرا على التقدم خطوة واحدة في طريق معالجة أسباب التراجع، فالمهم هنا المبادرة لفهم الممكنات الفردية، بصورة دقيقة، ومن ثم الانطلاق المدعوم بالثقة بالقدرات والنفس نحو الهدف، وستكون النتائج كما مرسوم لها
إلا أن عدم الوعي بالمعوقات الذاتية قد يكون هو الأخطر بحسب الكاتب نفسه، وبالتالي يتعين إيلاؤها الأولوية في التبصر بأحوالنا، فمن المعروف في طرق العلاج النفسي الكبرى: التحليل النفسي، العلاج المعرفي، أن الاضطراب والمرض هما نتاج كبت الصراعات والتناقضات والخبرات، وتعطيل إمكانيات الوعي بها واستيعابها ومكاملتها في عمليات الذهن الواعي. ذلك أن النفس الواعية تحتمي عادة ضد هذه المكبوتات من خلال الآليات الدفاعية المعروفة جيدا في أدبيات التحليل النفسي، والتي تقاوم بشدة الوعي بمكونات النفس التي تعطل السلوكيات الإنمائية.
وقد يكون الفرد أما خيار لا ثان له، لكي يفهم مكنونات نفسه، وينطلق من قاعدة قدراته التي عليه أن يعيها ويدرسها ويفهمها جيدا، فمن لا يفهم نفسه، ولا يتقن حجم وماهيّة قدراته، لن يكون مهيّئا للعب الدور المنوط به في كسر حاجز الخمول والتردد والركون إلى السلبية في التفكير والأفعال المطلوبة، من هنا ينبغي التصدي بمهنية وعلمية دقيقة لحالة التردد التي تكاد تكتنف حياتنا، فنحن أمة عاشت مرحلة السبات في مكانها طويلا، وإنساننا لا يزال يحسب ألف حساب لأبسط الخطوات التي ينبغي أن يتخذها في هذا السياق أو ذاك، وهو هنا لا يبحث عن مخارج وحلول دافعية، المشكلة أن الإنسان لدينا يبحث عن حجج ومبررات لمواصلة التراجع، ولإيجاد الذرائع التي تدفع به نحو السكون وليس الانطلاق، في وقت نحن بحاجة أساسية إلى الفاعلية الإيجابية التي يكون بقدورها الارتقاء بمجتمعنا إلى مستويات وصلتها مجتمعات كانت فيما مضى تحثّ الخطى وراءنا.
روح المبادرة، وتثوير النفس، وصقلها بما يضاعف الدافعية في مكنوناتها، هو ما يحتاجه الفرد منا والمجتمع ككل، وهي ثقافة مضادة تماما لثقافة تضخيم السلبيات، وقد أكد علماء النفس أن الشعور بالدونية والعجز كبّل الكثير من قدراتنا، فعلينا تفكيك أسباب هذا العجز وفهم ذواتنا والأمر الأساس في ذلك أن نردع عوامل الارتداد والتراجع واليأس، ونبعد المنطلق السلبي بعيدا عن وضعنا النفسي، ونفهم - كما سبق الذكر- قدراتنا جيدا، لنمضي باتجاه الإزاحة الدائمة للمعيقات والمثبطات وتقديم الدوافع الإيجابية دون سواها، لصنع فرد متأهب إلى الأمام على الدوام، تاركاً التردد والسلبية والعجز خلف ظهره إلى الأبد.


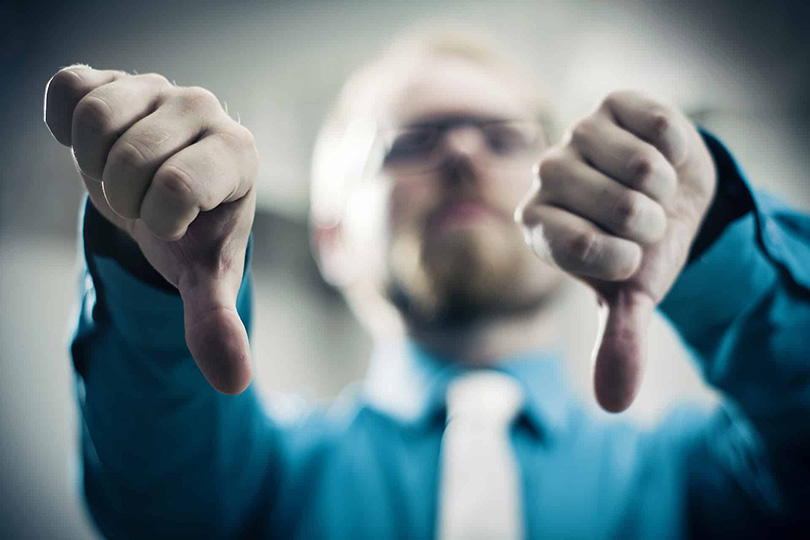

اضف تعليق