المقدمة
يعد البحث في العلاقة بين الدولة والشعب، بين الحاكم والمحكوم، من البحوث المهمة والحيوية، وذات الـتأثير الإستراتيجي، في مسار وبنية الحكم الرشيد، وتقدير شرعيته وصلاحه.
وترتكز هذه العلاقة على مبدأ الأمر المولوي بأداء الأمانة، وهي تستند إلى مجموعة من الخيارات، التي تشكل الأطر القانونية، في إعمال هذه العلاقة، وتأسيس شرعيتها، وصلاحية الحاكم أو الدولة، وبالتالي الحكم بين الناس بالعدل، عملاً بالآية الشريفة.
الغاية
سينصرف البحث في هذا الفصل إلى دراسة الأمر المولوي بأداء الأمانة، وبيان مفهومه ومعالمه، وأثره في تـأسيس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والحكم بين الناس بالعدل، ثم بيان الأطر والخيارات القانونية الحقوقية، التي ترتكز إليها هذه العلاقة، والتعريف بأبعادها وحدودها.
المبحث الأول، بصائر قرآنية
مفهوم الأمر المولوي في أداء الأمانة
جرى في الفصل السابق بعض التفصيل في كلمة [يَأْمُرُكُمْ] في الآية الكريمة، ومبانيها ونطاقها، واستكمالاً للدراسة، سيجري البحث لبيان طبيعة الأمر الوارد في [يَأْمُرُكُمْ]، لجهة كونه أمراً مولوياً أم أمراً إرشادياً.
المستظهر أن الأمر المذكور في الآية الشريفة، هو أمر مولوي، أي أنه أمر صادر من المولى جل وعلا، بما هو مولى معملاً مقام مولويّته، على ما ارتضيناه من التعريف للأمر المولوي، في كتاب "الأوامر المولوية والإرشادية".
فتكون هذه الآية [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا]، نظير تلك الآية القرآنية الكريمة التي تقول: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ][1].
ولما كان الأمر مولوياً، فإنه يتطلب بيان الثمرة من مولويته، إن من الثمرات: استحقاق العقاب بالمخالفة، واستحقاق الثواب بالموافقة. بمعنى أن الإنسان لو أدّى الأمانات إلى أهلها، فإنه يستحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ثناء الناس، ورضا الوجدان والضمير، وكذلك فهو يستحق الأجر الأخروي، ولو خان الإنسان الأمانة، فإنه سيستحق العقوبة والعياذ بالله.
تقييم بعض أدلة إرشادية الأمر بأداء الأمانة
لكن البعض احتمل، أو ذهب إلى أن الأمر في ذلك إرشادي، كأوامر الطبيب بقوله: "اشرب الدواء الفلاني" أو "كل المادة الفلانية"، فهذا الأمر ليس مولوياً، وإنما هو أمر ناصح وإرشاد.
أي: إنه إرشاد من الله سبحانه وتعالى لحكم العقل، وهذا سيؤول إلى عدم العقوبة بالمخالفة، فلو خالف الإنسان هذا الأمر، فعل قبيحاً لكن لا عقوبة تترتب على فعله، ويمكن أن يستدل لهذا الرأي بختام الآية الشريفة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: [إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ].
والموعظة ظاهرة في الإرشادية، كما يستظهر من قوله تعالى: [نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ]، وكأنه في مقام التعليل، والبعض يرى أنّ الأمر المقرون بذكر العلة إرشادي.
وهذا الاحتمال الثاني، لا نرى صحته من حيث المصداق والمفردة الخارجية، ومن حيث الكلّي والإطار العام والقاعدة الكلّية، وبعبارة أخرى: هذا الرأي مناقش فيه صغرى وكبرى.
وتوضيح ذلك:
إن الأصل في الأوامر الصادرة من المولى هو كونها مولوية، قد أمر بها الله بما هو مولى، وأما قرينة [إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ]، فيجاب عنها بـ: إن الموعظة لا تتنافى مع الأمر المولوي، فهما يجتمعان؛ لأن المولى إذا كان حكيماً، وكانت أوامره صادرة ونابعة من مصالح ومفاسد في المتعلقات ـ كما هو رأي الإمامية ـ لكانت فيها فائدة دنيوية وأخروية.
وعلى هذا فإن الصلاة فيها فائدة دينوية وأخروية، وكذا فريضة الصوم فيها فائدة دنيوية وأخروية، وأيضاً العدل فيه فائدة دنيوية وأخروية، والإحسان فيه فائدة دنيوية وأخروية.
بل نقول:
إن قوله تعالى: [إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ] مشيراً إلى الموعظة التي سبقت، أنسب بالأمر المولوي منها بالأمر الإرشادي، لجهة كونها تكشف عن مصلحة أخروية.
فإن "أعظك" و"الموعظة"، لا تستخدم عادة في المنافع المادية، فإن الطبيب لا يقول للمريض: "أعظك بأن تشرب الدواء"، بل يقول: "أنصحك بأن تشرب الدواء".
فالموعظة عادة تستخدم في الشؤون الأخروية، وهي التي تتناسب بشكل أكبر مع شأن المولى، فمبدئياً لم يقل الله: "إن الله نعما ينصحكم به"، بل قال: [إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ].
فمادة الموعظة أنسب بالأمر المولوي منها بالأمر الإرشادي؛ لأنها تشير إلى الجانب الأخروي، وتكشف عن الفائدة الغيبية المترتبة على ذلك أيضاً، مع عدم النفي للفوائد الدنيوية.
هذا من الناحية الكبروية، وأما من ناحية كبرى الكبرى: سنفترض أن الأمر هنا إرشادي، لكن هذا لا ينفي أن هذا الأمر الإرشادي تترتب على مخالفة المأمور به العقوبة؛ ذلك لأنه من المستقلات العقلية التي لو خالفها الإنسان، يستحق العقوبة لأن العقل حكم بها.
بمعنى أن العدل حسن وواجب، وأن الظلم قبيح وحرام. فلو أن حاكماً ظلم، فإنه حتماً يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولو أن أباً ظلم ابنه، أو زوجاً ظلم زوجه، أو جاراً ظلم جاره، فالكل سيستحق العقوبة.
فإن ما استقل به العقل لو خالفه الإنسان ـ حتى وإن لم يأمر به الشرع ـ يستحق عليه العقوبة، إنما لا يترتب استحقاق العقوبة إذا لم يستقل العقل بشيء، والمولى لم يأمر، فهنا لا استحقاق للعقوبة، كمثل أوامر الطبيب.
وبتعبير آخر: إن الإنسان يستحق العقوبة في صورتين: الأولى إذا خالف أوامر الشرع، والثانية إذا خالف الأوامر العقلية القطعية الصريحة؛ ذلك لأن الحجة لله سبحانه وتعالى على الإنسان، الشرع من جهة، والعقل من جهة ثانية.
فإذا خالف الإنسان هذه الحجة أو تلك الحجة استحق العقوبة، وقد ورد في الحديث الشريف: (إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة)[2].
الحجة الظاهرة هم الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام)، والحجة الباطنة هو العقل، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى ما دام قد احتج على الإنسان بالعقل في المستقلات العقلية، فلا يحق للإنسان أن يخالف ما يأمره به العقل، ولو خالف استحق العقاب.
ولو فرضنا أن هذه الآية الشريفة آية إرشادية، وأنه من حيث كونها كذلك، لا يستحق الإنسان الظالم العقوبة، لكن من حيث أن عقله، قد حكم بقبح الظلم وبحرمة الظلم، فإنه يستحق العقاب.
وهذا مما يشهد به الوجدان، بمعنى أنه لا يحتاج إلى هذا الاستدلال العقلي، الذي جرت الإشارة إليه، والذي تفصيله في مظانه، إذ الوجدان يحكم بذلك: إنّ الإنسان إذا خان الأمانة يستحق العقوبة، والإنسان إذا ظلم يستحق العقوبة.
ولذا نجد الحقيقة التالية في كل المجتمعات، وفي كل الأديان وكل المذاهب، وحتى من لا دين له، نجدهم جميعاً يحكمون بأنّ الظلم مرفوض ومدان، وقد يختلف في تحديد من هو الظالم، لكن أصل القضية: (أن ظالماً لو ظلم فهو يستحق العقوبة)، فالقضية إذاً قضية عقلية بديهية.
والحديث حول هذا الجانب طويل[3]، لكنه يخلص إلى أن من التدبّر في الآية الشريفة، يتبين أنّ الأمر فيها مولوي، بمعنى صدوره عن المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته.
ومع ذلك إذا سلمنا بأنه كان أمراً إرشادياً فرضاً، فإنه لا يخلّ بالمطلوب، كونه أمراً جزمياً حتمياً، قد حكم به العقل، الذي هو حجة من الباري سبحانه وتعالى، وأنّ الشرع عندما صرح به، سواء أ كان مرشداً إلى حكم العقل، أم مؤسساً، فإنه لا يضرّ ولا يخلّ بالمقصود.
المبحث الثاني، الأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب
سبقت الإشارة إلى شكل العلاقة بين الدولة والشعب، التي ترسم في تحديد ماهية ونوعية الترابط بين الدولة والشعب، واستكمالاً للدراسة، لابد من بيان الصيغة القانونية لعلاقة الحاكم بالمحكوم، وإطار هذه العلاقة من وجهة نظر حقوقية أو قانونية.
إنّ الاحتمالات في هذا الحقل عديدة:
الاحتمال الأول:
أن يكون الحاكم وكيلاً في تسيير الأمور، وفي تدبير شؤون البلاد، وإدارة شؤون العباد. أي: إن العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم، هي علاقة الوكالة، بمعنى أن الحاكم هو وكيل من قبل الناس، في أن يتولى تدبير شؤون المملكة والبلد.
الاحتمال الثاني:
أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة المأذونية، بمعنى أن الناس قد أذنوا للحاكم بأن يتصرف في مقدراتهم ومصائرهم، بالتي هي أحسن وبالحسنى، بالأفضل في شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، وإذن الناس أو أي مصدر آخر، هو المنشأ للشرعية.
الاحتمال الثالث:
في العلاقة هي الإجارة، بمعنى أن الحاكم أجير للناس، وبتعبير آخر موظف عندهم، كما يُستخدم الموظفون في الشركات، ويُعطون أجرة لقاء عمل يقومون به، فكذا رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، هؤلاء كلهم موظفون للناس براتب محدد. وأما احتمال (الجعالة) فمما لم يذكره أحد، وهو مستبعد جداً، وإن أمكن فرضه على عالم الثبوت.
الاحتمال الرابع:
أن يكون عقداً مستأنفاً، لا إجارة ولا وكالة، بل هو عقد مستأنف، وهذا العقد المستأنف قد يصطلح عليه بالعقد الاجتماعي.
الاحتمال الخامس:
هو (الهبة)، بمعنى أن الناس قد (وهبت) حقوقها للحاكم أو الملك، ووهبت مصائرها وممتلكاتها وثرواتها للسلطة.
الاحتمال السادس:
هو الولاية، بمعنى أن الحاكم هو مولى للأمة، وهو ولي على الأمة ومالك لشؤونها، مثله مثل السيد في ولايته على العبد، فالأمة بمنزلة العبيد والحاكم هو المولى، وهو الولي[4].
مقاربة في حدود الوكالة بين الحاكم والمحكوم
1-إذا كانت العلاقة بين الشعب والحاكم هي علاقة (الوكالة)، فلابد للحاكم أو الرئيس أن يتقيد بحدودها، وحدودها هي:
أ- التصرف في حدود الوكالة
التحرك والتصرف في حدود دائرة الوكالة، بمعنى أن الحاكم ليس له الحق في أن يتجاوز هذه الحدود، وذلك كما لو وكل بعض الناس شخصاً، في أن يبيع داراً لهم، فهو وكيل عنهم في هذا الحد، وليس له أن يهب الدار مثلاً، كما ليس له أن يؤجرها، أو أن يتصرف بها على نحو آخر، كأن يقوم بهدمها ليبني أخرى مكانها، فهو وكيل في حدود وكالته فقط.
وبعبارة أخرى:
إنّ كون الحاكم وكيلاً من قبل الناس، يعني أنه لا يحق له أن يتصرف زائداً على حدود الوكالة، في المعاهدات الدولية أو في الشؤون الداخلية: الاقتصادية أو غيرها.
فقد وكلّه الناس بهذا المقدار فقط في مصالحهم، وفيما يصلح شأنهم، فإذا تصرف في خارج هذه الدائرة، سواء راعى مصالحه الشخصية، أم انطلق عن اجتهادات فكرية، فإنه يكون عندئذٍ قد تحرك خارج حدود صلاحياته.
وعليه فإن الحد الأول للوكيل، أنه لا يحق له أن يتصرف في خارج حدود صلاحياته كوكيل، وإذا فعل ذلك فهو خائن؛ لأنه ليست له أية سلطة وصلاحية ذاتية، إنما الصلاحية نابعة من الموكّل.
ب- حق عزل الوكيل الحاكم
أما الحد الثاني للوكيل، فهو أن الموكّل يستطيع أن يعزله، كما أن الوكيل يستطيع أن يستقيل؛ وذلك لأن الوكالة عقد جائز، فإذا انتخب الناس الحاكم لمدة أربع سنوات مثلاً، وقلنا إن هذا العقد هو عقد الوكالة، كان لهم عزله متى أرادوا.
فإنه من زاوية الاحتمالات، يمكن للناس مباشرة كما يمكن لهم أن يخولوا مجلس الأمة أو النواب "البرلمان" أن يقنّن ذلك، بمعنى إبرام عقد الوكالة مع شخصٍ ليحكمهم، فبناءً على هذا فهو بعزل الأمة ينعزل، وباستقالته أيضاً تنتهي وكالته.
وفي هذا الإطار القانوني، فإن الأمة قادرة على عزل الوكيل (أي الحاكم) متى شاءت، حتى بدون مبرر من قصور أو تقصير. فليس بالضرورة أن يكون عزل الوكيل لصدور خيانة منه، وذلك كما لو كان لأحدهم وكيل في إدارة أعماله، فإنه لا يجب عليه أن يستمر معه في الوكالة، بل له متى شاء أن يعزله وينتهي الأمر، فالوكالة في حد ذاتها عقد جائز.
ج- حق نقض قرارات الحاكم
الإطار أو الحد الآخر للوكالة، هو أن الوكيل لو تصرف خارج دائرة صلاحياته، فهذا التصرف إما باطل وإما فضولي، فإنه إذا كان العقد عقداً فضولياً، فإنه موقوف على إجازة الموكلين، فإذا أجاز الناس بعد ذلك قراراته وعقوده وعهوده الدولية والداخلية، صح العقد وإلا فلا يصح.
ومن مفردات ومصاديق هذا الإطار وهذا الحد: الاتفاقات الأمنية، وهي من الأهمية بمكان، إذ يعقدها الكثير من الطغاة والمستبدين والحكومات الدكتاتورية مع القوى الاستعمارية، وبدون شفافية مع الناس، ومن دون إعلامهم بحدود هذه الاتفاقية الأمنية، أو العسكرية. فهذه كلها تعد خيانة في الأمانة، إذ ليس للوكيل الحق أن يخفي عن موكله أفعاله.
ومن المفردات والمصاديق: الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية في الاستيراد والتصدير، كماً وكيفاً ونوعاً وزمناً وأطرافاً.
كما أن من المفردات: الاتفاقيات الثقافية والعلمية، وتتضح الصورة أكثر بأن نمثل بها لو وكّل أحدهم شخصاً في بيع داره، أو في تزويج ابنته ـ برضاها طبعاً ـ أو في أي شيء آخر.
فليس للوكيل الحق في أن يخفي عن موكله الخصوصيات ونقاط الضعف أو القوة، أو أن يتستر على ما يصنع، فعليه أن يحيط الموكل علماً بأي تصرف يقوم به في دائرة الوكالة، مما يحتمل أن لا يكون الموكّل راضياً به.
إذ من الواضح أن إخفاء أفعاله، خلاف حكم العقل والقانون، عندما يكون في إطار باب الوكالة وشبهها.
ومن الواضح أن أكثر ـ إن لم يكن كل ـ الاتفاقات الأمنية التي تعقدها الدول خاصة في الحكومات المستبدة، لا يعلم الناس حقيقتها، ولا يعلمون أبعادها وحدودها، وقد أبرمها المسئول الأمني مع المسئول الأمني الآخر الذي يقابله، أو وزير الدفاع مع الوزير الآخر، وعلى أساس أنه اتفاق مبرم بين هذين البلدين.
عليه فالوكيل لا يحق له أن يتحرك، إلا في حدود الصلاحيات التي منحها له الموكّل، فلو فرض أن الوكيل أجرى عقد صلح أو عهد، أو تعامل اقتصادي، مع دولة أخرى بدون رضا الناس، وبدون علمهم، فإن هذا العقد هو في خارج دائرة صلاحياته.
فـ:
1- يكون فضولياً، إذا كان يتحمل الفضولية، فيحتاج إلى إجازة، وإلا فلا يكون نافذاً.
2- ويكون باطلاً بلا قيد، إذا لم يتحمل الفضولية كالإيقاعات.
د- لا يحق للوكيل الاستئساد على موكله
الإطار أو الحد الآخر في الوكالة، أن الوكيل لا يستطيع ولا يحق له أن يستأسد على الموكّل، كما تفعل الحكومات الدكتاتورية والمستبدة، وحتى التي تدعي الديمقراطية منها إذا استأسدت على الناس، فهي بهذا تخرج عن دائرة ذلك العقد، سواء أ كان العقد اسمه الوكالة، كما هو الحالة موضوع البحث، أم العقد المستأنف.
ففي العقد الاجتماعي أيضاً، لا يحق للوكيل أن يستأسد على الموكِّل كأن يقول له: "أطعني وإلا أسجنك" أو "أصادر حقوقك العامة أو الخاصة"، وهو منطق الطغاة.
وتتضح الصورة أكثر بالتمسك بمالك الدار الذي يقول له وكيله: بأنه ليس له حق التدخل في شؤونه، أي شؤون الموكِّل! وكأنه يعتبرها شؤونه هو ـ أي الوكيل ـ الخاصة به!!
فيمنعه من التدخل في شؤون داره، مانحاً لنفسه الحق في أن يبيع هذه الدار لمن يشاء وكيف يقرر، وبأية قيمة يراها، وإن كان بنصف قيمتها مثلاً، وإن تدخّل المالك، وطالبه بالعدل والإنصاف والحكمة والتقيد بحدود الوكالة أو العقد المستأنف، فإن الوكيل سوف يهدده بالسجن والتنكيل، وإن هذا تماماً هو حال الحكومات المستبدة في تعاملها مع شعوبها.
الماء الملكي وتعذيب الرازي
وإليكم هذا الشاهد التاريخي على نمط تعامل الطغاة مع الناس ومع الكفاءات، وقد نقله الوالد (رحمة الله تعالى عليه)، في كتاب "ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين"، وهو:
إن أحد أشهر وأبرز الأطباء والعلماء وهو "محمد بن زكريا"، الطبيب المعروف، كتب كتاباً لعلّه في الطب أو علم الكيمياء، وتطرق فيه إلى معادلة علمية دقيقة، لكيفية تحويل بعض العناصر إلى عنصر آخر، كمثل تحويل النحاس إلى ذهب.
هذا الأمل التاريخي الذي سعى كثير من الناس وراءه، حيث يعتقد بعض العلماء أنه من الناحية العلمية النظرية، يمكن لعنصر كالنحاس أن يتحول إلى عنصر آخر كالذهب، لكن توفّر الآليات لهذا التحويل، هو موضوع آخر.
فالطبيب محمد بن زكريا قد ضمّن كتابه، معادلة كيماوية تبين أنّ مادة كيماوية معينة لو مزجت بمواد كيمياوية أخرى خاصة وبمقادير محددة، ثم صهر النحاس حتى ذاب، ومزج بتلك المواد الكيماوية، فإن مركّب النحاس سيتحول إلى ذهب، وقد سمّيت المادة "بالماء الملكي".
والمهم في الأمر أن كتاب بن زكريا وصل إلى يد الحاكم أو الملك، فاستدعاه هذا الملك، وعرض عليه استلام أطنان من النحاس، ليحولّها إلى ذهب.
فقال له الطبيب محمد بن زكريا: بأن علومه نظرية، وليست علوماً مختبرية أو معملية، وأنه لا يملك معملاً، وأنّ هذا العمل يحتاج إلى إمكانات وخبرة عملية تجريبية.
إذ ليس كل إنسان يتوصل إلى معادلة علمية، بمقدوره تجربتها عملياً، وتعميمها للتطبيق؛ لأن ذلك يحتاج إلى أجهزة متطورة بمستوى المعادلة النظرية.
وهذا كلام منطقي كما هو واضح، إلا أن الملك كرر أمره لابن زكريا، بأنه يجب عليه أن يحوّل تلك الأطنان من النحاس إلى ذهب وهذا أمر ملكي.
فكرر بن زكريا الجواب بأنه غير قادر على ذلك، فأمر الملك جلاديه بأن يمسكوا هذا الطبيب، مع الكتاب الذي ألّفه ـ وكانت الكتب قديماً تغلف أحيانا بأغلفة جلدية ثقيلة ـ وكان هذا الكتاب ثقيلاً.
فهذا الحاكم المستبد، الذي يفترض به وكيلاً من قبل هؤلاء الناس، أمر الجلاد أن يأخذ الكتاب، ويضرب به رأس هذا الطبيب بقوة وشدة وعنف، مراراً كثيرة ولفترة طويلة، حتى فقد بصره جراء ذلك.
وبعد هذه القضية، عاش إلى آخر عمره أعمى كفيفاً، لا لشيء سوى أن تلك كانت هي رغبة هذا الحاكم الجائر المستبد.
وهكذا الآن حال حكومات بلادنا القمعية، تتعامل هكذا مع الناس، تحظر على الناس حتى حق الخروج في مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، مع أن التظاهر السلمي حق مكفول لكل إنسان، واستبدال الحاكم حق مكفول أيضاً، عبر صناديق الانتخاب، فكيف لا يكون للموكل الحق في أن يقول شيئاً، ويكون الوكيل مستبداً؟.
الإطار القانوني للإذن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم
أما الرأي أو الاحتمال الثاني، فهو أن يكون الحاكم "مأذوناً" من قبل الشعب في إدارة البلاد.
والفرق بين الوكيل والمأذون هو فرق لطيف، فإن الوكالة عقد، أمّا الإذن فهو إيقاع، وهذا يعني:
1- إنّ الوكالة تنعقد بشرط قبول الوكيل لها، في حين أنّ الإذن لا يشترط فيه ذلك، وذلك يعني أن المالك لو قال: "آذن لك بأن تجلس في داري، أو آذن لك بأن تبيع داري"، فإن المأذون لا ضرورة لأن يقول: "قبلت"، كي يتنجز الإذن أو يتفعّل، بل يصح (الإذن) حتى بدون قبول المأذون.
أما إذا قال المالك: "وكلتك في أن تبيع داري"، فإنه لا يصبح وكيلاً، إلا إن يقبل ذلك بقول أو بفعل.
2- والفرق الثاني أنّ المأذون لو قال: "لا أقبل هذا الإذن"، فإنه لا يسقط هذا الإذن؛ لأنه إيقاع. بمعنى لو عدل عن رفضه، وقبل بعد الامتناع، فله الحق ما دام الإذن موجوداً.
أما في الوكالة فإنه لو قال: "لا أقبل"، سقطت الوكالة، ولم يعد بمقدوره أن يقبلها، إلا إذا جدّد الموكّل الوكالة له.
3- (المأذونية) تعد عرفاً مرتبة أدنى من مرتبة الوكالة.
إن هذه الصيغة عادة، غير مطروحة في أوساط المقننين والمشرعين، ولكننا ندعو المقننين لدراسة هذا الخيار أيضاً في مناصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، أو ما أشبه ذلك، كلّهم أو بعضهم، وفي كل القضايا أو في بعضها، بأن يكونوا مأذونين لا غير.
بمعنى أن يكون لهم (إذن) من الأمة فقط، وأن يمارسوا صلاحيات معينة لا غير، وهذه الصيغة في العلاقة بين الدولة والشعب، تشترك مع الصيغة الأولى، في قواسم مشتركة واضحة.
الإطار القانوني للإجارة بين الحاكم والمحكوم
الإطار والمحتمل الثالث هو الإجارة، بمعنى أن يكون الحاكم "أجيراً" من قبل الناس.
وأما حدود الإجارة فهي:
1-الإجارة عقد يشترط فيه الرضا من الطرفين، فلا تنعقد مع الإكراه. فلو كان أحد الطرفين مكرهاً على الإجارة، فلا تنعقد الإجارة، وعندها لا حق للأجير بالتصرف.
وعند تطبيق هذه المعادلة على الحكام، يتبين أن الحاكم كونه أجيراً من قبل الناس، فإنه لا يستطيع أن يفرض نفسه عليهم دون رضا طوعي منهم، وذلك كمثل مالك الدار الذي يرغب بتأجيره إزاء مبلغ ما، فإذا كان مكرهاً، لا تقع هذه الإجارة، وتكون باطلة.
وعليه فالإجارة لا تقع إلا عن رضا وطوع واختيار الناس، بخلاف البلاد المستبدة، التي يحكم حكامها دون رضا الشعب، بدلالة تكميم الحاكم للأفواه، وامتلاء السجون، وعدم وجود الصحافة الحرة التي تقيّم أعمال الحاكم والرئيس والقائد، وتنتقده باستمرار، وبدلالة إسقاطهم للحاكم بعد حين.
2- والإطار أو الحد الآخر للإجارة، هو أنّ المستأجَر، يجب أن يكون واجداً لشرائط خاصة.
ومن الشرائط ما أشارت إليه الآية الشريفة، إذ تقول: [إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ][5]، ففي فرض استئجار رجل حرفي لعمل ما، ينبغي أن يكون:
أ- قوياً، أي أن يقوى على العمل.
ب- وأميناً لينجزه بإتقان.
ويجري وفق هذه القاعدة القرآنية تقييم الحاكم، وضرورة أن يكون بالفعل قوياً، بمعنى أن يقوى على تدبير البلاد وإدارة العباد أولاً، ثم كونه أميناً ثانياً.
فبهذا الإطار تقع الإجارة، وتتحدد العلاقة بين الحاكم والشعب، وهذا يعني أن (القوة والكفاءة والأمانة)، هي شروط بنحو العلة المبقية أيضاً، لا العلة المحدِثة فقط.
فلو فقد الحاكم أحد الشرطين، فلا يحق له التصرف الحكومي إلا بتجديد عقده مع الناس، على أن الفرق بين الإجارة العادية وإجارة الحاكم، هو: إن المؤجر في الشؤون الشخصية له أن يؤجر لأعماله (كخياطة ملابسه مثلاً) غير الأمين أو غير الكفء، والإجارة منعقدة ما لم تكن سفهائية ـ وإن حرم على الأجير الخيانة كما هو واضح ـ أما استئجار الحاكم فلا يصح إلا بالشرطين، كون أدلة الإجارة منصرفة عن الشمول لمثله مما ارتبط بمصائر الناس وحقوقهم العامة، فإنها من الشؤون الخطيرة.
إطار الولاية بين الحاكم والمحكوم
الإطار أو الاحتمال الآخر هو الولاية، وذلك أن تكون صيغة العلاقة بين الدولة والشعب وإطارها هو الولاية. وتلك هي الصيغة الأخرى للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
والغريب أن الطغاة يعتبرون أنفسهم ذوي ولاية على الناس، وأن الناس عبيد لهم، ولا يقولون إنهم وكلاء من قبل الناس، وإذا قالوا ذلك بألسنتهم فقد كذبوا بأفعالهم ومواقفهم.
إذ في مرحلة العمل والقرارات نجد أن الحاكم المستبد لا يعتبر نفسه وكيلاً، وإلا لما استأسد على موكليه" الناس"، ولما صادر حقوقهم.
كمثل ذلك الحاكم الطاغية الذي خرج قبل فترة للناس، وقال: (إنه الآن قد فهمهم)!، بعد ثلاثين أو أربعين سنة، لم يكن يفهم فيها الناس، الآن وقد ثار عليه الناس وبعد أن تجاوزه الزمن وجاءه الطوفان، يقول: (الآن قد فهمتكم!).
إن هؤلاء الحكام مطالبون قبل أن يجرفهم الطوفان، وقبل تأجج غضب الناس، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعملوا بمقتضى ذاك العقد الاجتماعي بينهم وبين الناس، أو أن يعملوا بمقتضى الوكالة أو بمقتضى الإجارة.
النموذج الباميلاكي في الحكم
والغريب أن حكام البلاد الإسلامية هم عموماً حكام على الطريقة (الباميلاكية) بشكل أو بآخر، وتوضيحاً لذلك نقول:
يذكر علماء الاجتماع وعلماء الحقوق، مثالاً معاصراً لهذا النموذج في الحكم ـ وهو مثال لطيف ـ ففي بلاد تسمّى "باميلاكي" تقع بالقرب من الكاميرون، نجد أن الذي يحكمها شخص يسمى "فو"، كناية عن ذلك الحاكم الذي يعتبر ممثلاً للأرواح كما أنه ممثل للإله، وتتجسد فيه السلطة الدينية والدنيوية معاً.
والبلد مقسم إلى مناطق، كل منطقة يسموها "غانغ"، ولكل منها رئيس مستبد مطاع، وتتجلى الصورة البدائية، في علامات ملكيته وإلوهيته، وهي مظلة أو محفة ملكية، وهناك منصة وهناك جواهر، وتاج وملابس مزركشة، وعصا معينة ترمز إلى ارتباطه بالأرواح، فهذه هي بلدة باميلاكي، لكنها في الحقيقة ترجع إلى عهد ما قبل ظهور الدولة.
والحقيقة أن البلاد الاستبدادية لا تختلف كثيراً عن النموذج "الباميلاكي" مع بعض التغيير، والرتوش والمظاهر والعصرنة، لكن هنالك الكثير المناظِر لها، مثل قصور الحاكم، وملكياته ورصيده المالي، التي لم يكن له منها شيء قبل تسلّمه الحكم.
وهو مظهر لهذا الطغيان ومظهر للولاية، وكذا القصور الفارهة الفخمة، وعلائم الكبرياء مثل: البساط الأحمر، والتحية العسكرية، والاستعراض العسكري، والموسيقى العسكرية، التي تلاحظ حتى في البلاد التي تسمى بالديمقراطية.
فهذه مظاهر قديمة، تعكس عقلية قديمة، وكلها بدائل عصرية لتلك العقلية "الباميلاكية" القديمة، وقد استبدلت العصا والأرواح، بالشرطة القمعية والسجون والمنافي، واستبدل التاج والجواهر بأرصدة في المصارف السويسرية وغيرها.
والحاصل: إن العقلية القديمة، هي نفسها الحاكمة في الأنظمة المستبدة المعاصرة، والدولة فيها ليست دولة مؤسسات، بل الموجود هو حكم الفرد، بغياب المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا بالمقدار الذي هو خارج عن اختياره.
وهكذا نجد أن هذه هي الصيغة الأخرى للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي صيغة (الولاية)، بصيغها المختلفة وألوانها وأطيافها المتعددة، والتي بموجبها يعتبر الطغاة أنفسهم ذوي ولاية على الناس، وأنّ الناس عبيد لهم، حتى إذا صرحوا بغير ذلك.
نختم كلامنا بكلمة لأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب (عليه صلوات المصلين)، حيث يقول في نهج البلاغة: (فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ؛ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ، وَسُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ)[6].
كما يقول في كتاب آخر: (وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ)[7]، فإن الحاكم أمين وليس ولياً على الناس ومالكاً لرقابهم.
إطار العقد المستأنف بين الحاكم والمحكوم
العقد المستأنف، هو الإطار أو الاحتمال الآخر، في العلاقة بين الدولة والشعب، وهو ما سيجري إرجاؤه للتفصيل به، في البحث القادم، إن شاء الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً، للعمل بهذه الآية القرآنية الكريمة، حيث يقول تعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا].
المبحث الثالث، إجابات على أسئلة فقهية ذات علاقة بالموضوع
السؤال: الحركات السياسية والإخفاق في التجارب الديمقراطية
في ظل تجارب مريرة عاشتها بلاد المسلمين، قد أخفقت الأحزاب العلمانية والإسلامية على حد سواء، في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية عملياً، فهل في الناهج تكمن المشكلة أم في المنهج؟.
الجواب:
هذا السؤال بدوره يقودنا إلى سؤال آخر، هو: هل يمكن للأحزاب والجماعات الثورية التي تصل إلى الحكم، إسلامية كانت أم علمانية أم غيرها أن تحقق الديمقراطية، أو تحقق حكم الإسلام والشورى؟.
في الواقع إن الأشياء تعرف بجذورها، والماضي هو مرآة المستقبل، فإذا أردنا أن نعرف هذا الإنسان، وكيف يتعامل إذا سلمنا بيده إدارة شركة معينة، فلننظر إلى ماضيه وكيف كان يتعامل سابقاً.
هل كان يتعامل بطريقة ديمقراطية أو استبدادية؟.
وهل عمل برواية: (أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله)؟.
وهل اجتنب الاستبداد الذي قال عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في المئات من الروايات: (من استبد برأيه هلك)[8] و(من شاور الرجال شاركها في عقولها)[9]، إلى غير ذلك؟.
وقد جمع الوالد (قدس سره) قرابة مائتي رواية، في كتاب "الحريات الإسلامية"، وفي كتاب "الشورى في الإسلام"، وهي موجودة في ثنايا (البحار)، وفي (الوسائل)، وفي (مستدرك الوسائل)، و(جامع أحاديث الشيعة)، وفي كتاب (العشرة)، وفي غيرها من الكتب.
والشاهد في هذا الحقل، هو أن الماضي يكشف عن المستقبل، فهذا الذي صار رئيس شركة، إذا أردنا أن نعرف كيف سيتعامل، فلننظر إلى سجلّ تعامله مع أهله وعائلته، أو لننظر إلى تاريخه وسيرته الذاتية (CV) عندما كان مديراً لمدرسة، أو شركة أخرى، أو كان في أي موقع آخر.
إن ماضي هذه الأحزاب أو الجماعات، إسلامية كان أو غير إسلامية، يكشف عن مستقبلها هو الآخر، وذلك في بحث موضوعي، وبدون تجريح أو تنقيص.
بل إن نفس هذا الحزب إذا أراد أن يعرف نفسه، وأنه بالفعل لو وصل للحكم، سيعمل بمبدأ الشورى الإسلامية أو الديمقراطية، ويعطي الحريات والحقوق للناس، فعليه أن يلاحظ تعامله الحالي في داخل حزبه.
هل هناك انتخابات حقيقة؟
هل هناك تداول سلمي للسلطة في داخل هذا الحزب، أو هذا التجمع، أو هذا الاتحاد، أو هذه النقابة؟.
وذلك لأن القاعدة العامة، هي أن الإنسان يعمل في مستقبل أيامه على نفس ما تطبّع عليه في ماضيها، فليست للإنسان طبيعتان. فلو كان لمدة عشرين سنة مثلاً من انتمائه للحزب أو الاتحاد أو النقابة أو الشركة، مسئولاً يتعامل بشكل استبدادي، فهل يعقل أنه بمجرد أن يصبح حاكماً، سيتحول إلى ديمقراطي؟.
إن هذا ليس معقولاً، إن هذا الانقلاب الماهوي مستحيل، (والمقصود المعنى العرفي للمستحيل).
وإذا عرفنا أن مستقبل أي حزب أو أية جماعة، يعرف وتعرف آفاقه المستقبلية، من كيفية تعامله في الماضي مع جماعته، فإن علينا وعلى المخلصين المنتمين لتلك الأحزاب، سواء كانت إسلامية أو غيرها ـ وأقصد المخلصين للإسلام أو للوطن منهم سواء كانوا قلة أو كثرة ـ أن يسعوا من الآن لتطبيق قوانين الإسلام، في العدل والإحسان والشورى، داخل الحزب أو النقابة أو الجامعة والمدرسة والمؤسسة.
فقد قال الله تعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى][10].
وقال جل اسمه: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ][11].
وقال جل جلاله: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ][12].
وقال سبحانه: [وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ][13].
وقال عز وجل: [إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ][14].
وقال تعالى: [وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ][15].
فهذه الآيات ونظائرها، على المنتمين لذلك الحزب أو الجماعة، أن يطبقوها في داخل جماعتهم، فإن صنعوا ذلك فعندئذ الأمل كبير، بأن المستقبل لهذه الجماعة، سيكون مشرقاً استشارياً عقلانياً، كذلك مثل حاضرها.
ومع ذلك سيحتاج الأمر إلى رقابة واحتياط، إذ [كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى][16]، فذلك يحتاج إلى توفير ضمانات أكيدة متنوعة.
وعلى الناس كافة أن يطالبوا الحكام، وأية جهة اجتماعية أو سياسية عاملة، أن تطبق قوانين الإسلام في أنفسها، وأن يراقبوهم بدقة بالغة وعندئذ سيغيّر الله بلطفه وكرمه ما بهم أيضاً، [إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ][17].


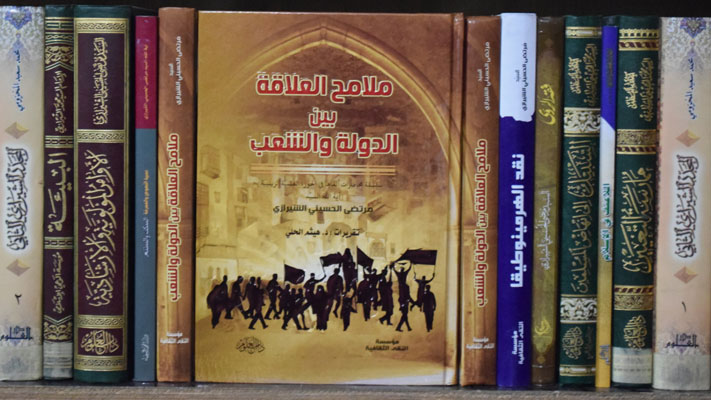

اضف تعليق