يجب على الإنسان أن يلتفت لذلك، ويحاول ترويض نفسه والاهتمام بالعمل الصالح، فأي عمل يقوم به ـ سواء كان من الأعمال الصالحة أم من الأعمال الاجتماعية المختلفة ـ ينبغي أن يضع في باله احتمال أن يكون هذا العمل غير صحيح، فلعل النفس في حالة خداعها تصور له...
قال اللّه تعالى في كتابه الكريم: {بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ * وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ}(1).
ذكرنا في ما مضى إن اللّه سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً، وإنّما خلقه لحكمة، وقد أشار سبحانه وتعالى لهذه الحكمة بقوله: {إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ}(2)، أي: إنه خلقهم للرحمة، فاللّه سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا لحاجة منه إليه؛ لأن اللّه غني عن عباده، وإنّما خلقه لكي يرحمه، وطريق هذه الرحمة هو العبادة، قال تعالى: {وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ}(3)، فإنه قد يكون غرض أدنى وغرض أقصى. مثلاً: قد يخرج الإنسان من بلده لزيارة الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكنه يمر بمدينة قم المقدسة، فغرضه الأقصى هو زيارة الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن له غرض آخر وهو أقرب من الأوّل، وهو زيارة السيد المعصومة (عليها السلام).
إذن، فالغرض الأقصى من الخلق هي الرحمة، وطريق هذه الرحمة هي العبادة وهي الغرض الأدنى. لكن هذا الإنسان يجب أن يكون قابلاً لتلك الرحمة؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل فعلاً من دون مصلحة؛ لأن معنى الحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها، واللّه سبحانه وتعالى رحيم وفي الوقت نفسه حكيم، وحكمته تكون السبب في أن يرحم عباده، فإذا وجدنا شخصاً لم يرحمه اللّه فلعدم الحكمة في رحمته؛ لأنه لم تكن له القابليّة لهذه الرحمة.
ولتقريب الفكرة نذكر المثال التالي: إذا كان هناك شخص كريم ورحيم، وجاء رجل فقير وطلب منه المال، وكان ذلك الرجل الكريم يعرف أن السائل سوف يشتري بهذا المال سلاحاً ويقتل به شخصاً، فهل من الحكمة أن يدفع له المال؟! إنه إذا دفع المال له فسوف يلومه العقلاء، ويقولون له: صحيح أنت رجل كريم ورحيم، ولكن في الوقت نفسه لا بدّ أن تكون حكيماً، وتجعل كرمك ورحمتك في إطار الحكمة.
والحاصل: إن اللّه سبحانه وتعالى حكيم، وحكمته تقتضي أن تكون رحمته الخاصة للمؤمنين فقط؛ لأن غير المؤمن ليست له قابلية لتلك الرحمة الخاصة، فإفاضة تلك الرحمة لغير المؤمن خلاف الحكمة، واللّه سبحانه وتعالى لا يفعل أمراً خلاف الحكمة.
بل للّه عنده رحمة عامة للجميع، ورحمة خاصة للمؤمنين فقط قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ...}(4)، فينبغي على الإنسان أن يجعل نفسه قابلة لتلك الرحمة الخاصة، حتى يفيض اللّه سبحانه وتعالى بحكمته عليه منها.
القابلية للرحمة الخاصة
ولكن كيف الإنسان يجعل نفسه قابلاً لتلك الرحمة؟
والجواب: إن ذلك يتم من خلال الإيمان والعمل الصالح؛ لذا نجد في الآيات الشريفة التأكيد على ذلك، قال تعالى: {فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِۦ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِي رَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡلٖ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَيۡهِ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا}(5).
إن المشكلة تكمن في الإنسان نفسه، حيث إن نفسه ترغّبه في الكسل والفرار من المسؤوليات والاستسلام للشهوات، قال تعالى: {إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ}(6)، ومن ذلك التسويف، حيث إن النفس تخدع الإنسان بالتسويف، وخلق الأعذار؛ لأن الإنسان بطبعه يريد أن يدافع عن نفسه، وإذا كان مداناً فلا تعجبه هذه الحالة.
مثلاً إذا لم يؤدِ الواجبات، وكان مقصراً في الفرائض، فسوف يدافع عن نفسه، ولا يريد أن يتحمّل المسؤولية، فالنفس تسوّل له ذلك، بحيث إنه يشعر أن ضميره مرتاح؛ لأنه إذا خدع نفسه ينام براحة بال، ومن تسويلات النفس أنها تأتي بالأعذار الواهية، لكي يقتنع الإنسان، ويكون مرتاح الضمير.
لذا على الإنسان أن لا يفرّط في الواجبات، ولا يصغي إلى نفسه الأمارة بالسوء؛ لأنها خدّاعة، فالنفس تخدع الإنسان وتصوّر له الأعمال السيئة بصورة حسنة: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنٗاۖ}(7)، وإذا ارتكب السيئات فسوف تبرر النفس فعله.
إنه يجب على الإنسان أن يلتفت لذلك، ويحاول ترويض نفسه والاهتمام بالعمل الصالح، فأي عمل يقوم به ـ سواء كان من الأعمال الصالحة أم من الأعمال الاجتماعية المختلفة ـ ينبغي أن يضع في باله احتمال أن يكون هذا العمل غير صحيح، فلعل النفس في حالة خداعها تصور له صحة العمل مع كونه رياءً مثلاً.
إن العمل السيئ له آثار، والعمل الحسن له آثار أيضاً، فإذا ابتلي الإنسان بسيئات عمله فالنفس دائماً تبرر له ذلك، وتقول له: إنك على حق، وهذا سوف يؤدّي إلى أن لا يقوم الإنسان بواجباته، ويسوّف في أعماله، وبعد ذلك يمضي عمره وينتهي، ويـوم القيامـة يكون فـي حسرة: {وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ}(8)، فلا يوجد هناك رجوع لتدارك الأمر: {حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ * لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ}(9).
نفس واحدة للحق
إن زيد بن علي بن الحسين رضوان اللّه عليه الشهيد أراد أن يثور ضد بني أمية في زمان الإمام الباقر (عليه السلام) فلم يأذن له، وفي زمان الإمام الصادق (عليه السلام) أراد أن يثور فأذن له(10).
وقد كان الإمام علي بن الحسين السجاد (عليه السلام) قد أخبر بأن ولده زيداً سوف يُصلب في كناسة الكوفة(11).
والذي يظهر من الروايات أن الإمام الصادق (عليه السلام) أجاز لزيد الخروج على بني أمية، بينما لم يرخّص لأصحابه الخاصّين أن يثوروا مع زيد، ولعل السبب في ذلك أنه (عليه السلام) كان يريد أن ينشغل أصحابه الخاصين بنشر العلم، من خلال انتهاز ضعف بني أمية ومن ثم زوالهم وضعف بني عباس قبل استحكام دولتهم، فإذا اشترك أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) في ثورة زيد فربما يقتلون، فلا يبقى منهم أحد يوصل هذا العلم إلينا(12).
إلّا أن زيداً (عليه السلام) لم يكن يدري أن الإمام الصادق (عليه السلام) منع أصحابه الخاصّين من المشاركة معه في ثورته، فجاء إلى أحد أصحاب الإمام (عليه السلام) وهو أبان، فدار حوار بينهما قال أبان: «فقال لي: أترغب بنفسك عني؟ قال: قلت له: إنّما هي نفس واحدة، فإن كان للّه في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناجٍ، والخارج معك هالك، وإن لا تكن للّه حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء»(13).
إن الإنسان لديه نفس واحدة، فإذا مات ميتة غير مرضية للّه سبحانه وتعالى فسوف يكون من أهل جهنم، وهنا ليس مجال للخطأ؛ لذا يجب على الإنسان أن يكون في بيّنة من أمره؛ لأنه إمّا أن يفوز بالجنة، وإمّا يخسر فيدخل النار قال اللّه تعالى: {فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}(14).
والإنسان المؤمن يكون مستعداً لبذل نفسه إذا كان مأذوناً له بالخروج، وأمّا إذا كان غير مأذون فلا يبذل نفسه، وهذا ليس جبناً وخوفاً، بل عمل بالتكليف لأنه يجب عليه أن يحتاط، فإن النفس خدّاعة وتأتي بالمعاذير المختلفة لتخدعه، فإن الباطل لو كان واضحاً لما خدع به الناس، ولكن المشكلة أنه يوجد هناك خلط بين الحق والباطل، وهذا ما أشار له أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: «إنّما بدأ وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب اللّه، ويتولى عليها رجال رجالاً(15) على غير دين اللّه، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفَ على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث(16) فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى»(17).
فأهل الأهواء لا يأتون مباشرة ويقولون: أيها الناس نحن نريد أن نسلبكم دينكم وإيمانكم، وإنّما يأتون بمظهر المتدين الحريص على هداية الناس ثم يبثون سمومهم، فإن فرعون عندما كان يعارض موسى (عليه السلام) كان يقول: أنا على الحق وأنا أهديكم للرشاد: {قَالَ فِرۡعَوۡنُ مَآ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهۡدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ}(18)، وأمّا موسى (عليه السلام) فكان يقول نفس الكلام، ولكن الفرق بينهما هو أن موسى (عليه السلام) كان يقول كلمة الحق ويريد بها الحق، وأمّا فرعون فكان يقول هذه الكلمة ويريد بها الباطل.
وهكذا حال الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد كان شعارهم آية قرآنية، وهي قوله تعالى: {إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ}(19)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «كلمة حق يراد بها باطل»(20)، فهي كلمة حق لأنها آية قرآنية، إلّا أنهم أرادوا بها الباطل.
والحاصل: إن للإنسان نفساً واحدةً، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ويحتاط لها في الحق المحض، وإلّا فأصحاب الأهواء والأفكار الباطلة يصوّرون الباطل حقاً، وكثير من الناس ينخدعون بذلك.


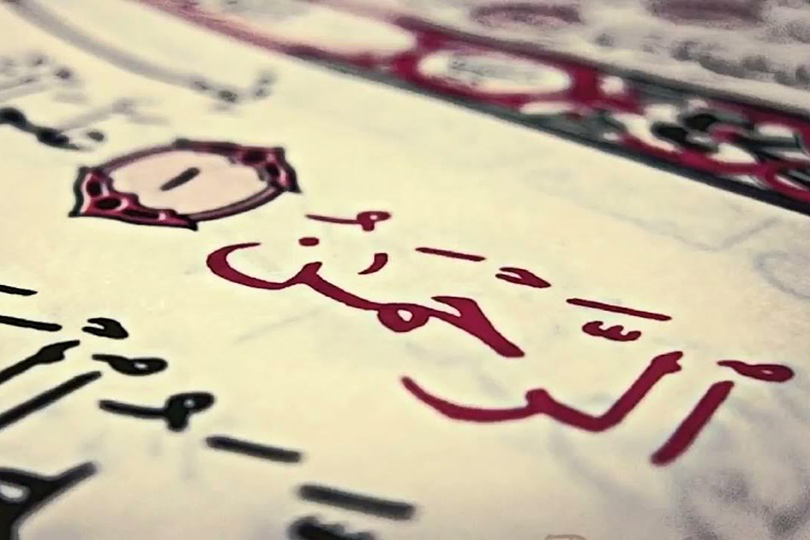

اضف تعليق