تخفيف الضرائب لا يخضع لمبدأ القدرة على الدفع بل إنه يخضع لمبدأ الرفق والرحمة وقاعدة التيسير، فإذا اشتكى الناس مجرد نوع من الثقل في الضريبة، كان على الحكومة تخفيفها إلى الدرجة التي لا يستشعرون معها ثقلاً أبداً. خاصة وأنه (قد تثبط الضرائب من حجم الاستثمار أيضاً، فقد يُقبل التاجر...
وعهد الإمام علي (عليه السلام) لواليه على مصر مالك الأشتر يشتمل على جوهر (السياسة المالية التوسعية expansionary fiscal policy) التي وصل إليها مينارد كينز بعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة من صدور هذا العهد من الإمام (عليه السلام)، ولكن مع بعض الفوارق كما سيأتي.
والسياسة المالية بشكل عام تعني: (مجموعة الإجراءات التي ينصب اهتمامها على دراسة النشاط المالي للدولة، وما يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي، وتتضمن تكييفاً كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، ونوعياً لأوجه هذا الإنفاق، ومصادر هذه الإيرادات، بغية تحقيق أهداف محددة، أبرزها تنمية الاقتصاد القومي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخول والثروات)(1)، بينما تعرّف المالية العامة، بأنها (تبحث في كيفية حصول السلطات العامة على الموارد الاقتصادية المختلفة واستخدامها لإشباع الحاجات العامة والآثار الاقتصادية المختلفة الناتجة عن ذلك)(2).
وأما السياسة المالية التوسعية فتعتمد بالأساس على:
أ ـ خفض الضرائب، وقد ارتأى كينز فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء ليعاد عبر ذلك توزيع الدخول ويتقلص التفاوت في توزيع الثروة والدخل، ويزيد بذلك الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية وينخفض حجم الادخار.
أما في منهج الإمام علي (عليه السلام) فـ:
1 ـ لا تفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، بل يجري خفض التفاوت الطبقي وتوزيع الدخول عبر أسس بنيوية منوعة(3).
2 ـ وتخفض الضرائب بحسب درجة الحاجة ونسبة الاضطرار لدى طبقات الرعية والقطاعات الاقتصادية.
ب ـ زيادة الإنفاق على الدفعات التحويلية Transfer Payments، والإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية المجانية أو شبه المجانية، مما يعني نوعاً من إعادة توزيع الدخول income redistribution، بين الناس وينتج خفض الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخفض التفاوت المجحف في توزيع الثروة والدخل الذي يميز الدولة الرأسمالية.
ج ـ الاستثمار في البنية التحتية Infrastructure، وأيضاً شراء الخدمات والسلع، وذلك يعني أنّ النفقات الكلية تتكون من: النفقات العامة إضافة إلى النفقات الخاصة على سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار.
د ـ والقضاء على الاحتكارات عامة كي لا تستمر أسعار السلع في الارتفاع، وبذلك تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية ويزيد الطلب عليها، والذي بدوره يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم، ومن ثم زيادة طلبهم على الاستثمار(4).
وذلك كله يعني تكامل أدوار كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، والذي يشكل نوعاً من أنواع الاقتصاد المختلط، ولكن مع بعض الفوارق.
وسيأتي الكلام عن البنود الأربعة على ضوء نصوص الإمام (عليه السلام) بعد قليل إن شاء الله تعالى.
هـ ـ ونجد في عهده (عليه السلام) للاشتر إضافة إلى تلك البنود الأربعة، الإنفاق الشعبي التطوعي(5).
و ـ كما نجد في كلماته (عليه السلام) إضافة إلى ذلك كله، ركناً سادساً وهو، إصلاح اللوائح التنظيمية الكابتة، وسنّ القوانين التي تتكفل بمنح الثروات للناس بالمجان، أي السماح لهم بحيازة الثروات وإحياء الأراضي من دون حاجة لاستحصال رخص وأُذون وروتين وبيروقراطية وشبهها.
ومزيد التفصيل:
إطلالة على السياسة المالية التوسعية في نصوص الإمام
والإمام (عليه السلام) في هذا العهد يشير صراحة إلى الأركان الأربعة التي أشّر عليها ـ فيما بعد ـ مينارد كينز، ويزيد عليها ركنين آخرين:
وهذا مخطط مبدئي عام للأركان الستة:
السياسة المالية التوسعية في نصول الإمام، المخطط العام
الركن الأول: خفض الضرائب حتى يصلح أمرهم
فعن تخفيف الضرائب والتي كانت تتجسد في الخراج، أو إلغائها قال (عليه السلام): (فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ، أَوْ بَالَّةٍ، أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ)(6).
من فقه الحديث: التخفيف بمقتضى الرفق.
وتتألق أمامنا عند استنطاق هذا النص الحقائق التالية:
التخفيف وفقاً لمبدأ الرفق والرحمة
أولاً: إن تخفيف الضرائب لا يخضع لمبدأ القدرة على الدفع princple of ability to pay، بل إنه يخضع لمبدأ الرفق والرحمة وقاعدة التيسير، فإذا اشتكى الناس مجرد نوع من الثقل في الضريبة، كان على الحكومة تخفيفها إلى الدرجة التي لا يستشعرون معها ثقلاً أبداً. خاصة وأنه (قد تثبط الضرائب من حجم الاستثمار أيضاً، فقد يُقبل التاجر على النشاط الاستثماري القائم على المخاطرة إذا كان العائد المتوقع يصل إلى 100 مليون دولار، لكنه لن يقبل على هذا النوع من النشاط إذا كان العائد المتوقع سيقل بسبب الضرائب ليصل إلى 60 مليون دولار فقط)(7).
بل وفوق ذلك فإن (الأمر الثاني، والأكثر عمقاً: هو أن فرض الضرائب يجعل الأفراد يغيرون من سلوكياتهم بطريقة تضر المجتمع، دون أن يعود ذلك ـ بالضرورة ـ على الحكومة بأي عائد. والضريبة على الدخل أحد الأمثلة على ذلك، فقد ترتفع لتصل إلى 50 سنتاً على كل دولار تكسبه خلال الفترة التي تتم فيها جدولة كل الضرائب الفيدرالية الخاصة بالولاية التي تتبعها. ولهذا، فإن بعض الأفراد ممن يفضلون العمل فقط، إذا احتفظوا بكل دولار يكسبونه قد يقررون ترك القوة العاملة عندما يرتفع معدل الضريبة الحدية إلى 50 بالمائة. "وجميع الأطراف في تلك الحالة خاسرون". فسوف يتوقف عن العمل من يضع العمل في قائمة مفضلاته (أو قد لا يكون العمل في المقام الأول)، ولن تجني الحكومة أي عائد.
وكما أوضحنا في الفصل الثاني، يشير علم الاقتصاد إلى ذلك النوع من اللافاعلية المصاحبة لنظام فرض الضرائب بعبارة "الخسارة القصوى". أي أنها ستلحق بك الضرر دون أن تسبب النفع لأي فرد... إن أي نوع من فرض الضرائب الذي يثبط النشاط المثمر يتسبب في نوع من أنواع الخسارة القصوى)(8).
التخفيف حتى التصفير
ثانياً: والتخفيف قد يصل إلى حدّ التصفير فيشمله، وليس خاصاً بإسقاط الزائد وإبقاء الأصل، وذلك لصدق التخفيف بالحمل الشائع الصناعي، على إلغاء الضريبة من رأس، فإنه تخفيف عن كاهلهم، فإن كل ضريبة تشكّل ثقلاً فيصدق التخفيف على الإلغاء والتصفير حقيقةً، وعلى فرض التنزل فهو مجاز معه قرينته، سلمنا لكن ظهور (أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ) أقوى من ظهوره فيتقدم عليه، بل الظاهر تقدمه عليه بالحكومة لا بمجرد الأظهرية(9)، وإن شئت قلت: (بما يصلح) كأنه واقع موقع التعليل فيكون معمّماً. بعبارة أخرى: المدار هو (أن يصلح أمرهم) وليس التخفيف من دون إصلاح أمرهم.
والسرّ: أن المزارعين لدى حدوث أية أزمة أو كارثة طبيعية أو غيرها كانخفاض الأسعار نتيجة زيادة العرض أو قلة الطلب، تتناقص بشدة محصولاتهم(10) أو المقدار الـمُباع منها(11) أو تنخفض أسعارها(12) بما يخلّ بقدرتهم على رعاية مزارعهم وتطويرها أو رعاية حيواناتهم التي تعد مصدر رزق لهم كما تكون وسيلة إنتاج أو آلةً مساعدة لهم في الحرث والنقل وغيرهما، من جهة، كما يخلّ ذلك من جهة أخرى بأمنهم الغذائي باعتبار كون الزراعة المصدر الوحيد الذي يعتمدون عليه، كما يخلّ من جهة ثالثة برعايتهم الصحية الجسمية والنفسية.
وتراجُع المحاصيل وانخفاض مردودها يؤثر سلبياً على قطاع الصناعة والخدمات وغيرها مما يزيد، بالتبع، من نسبة البطالة والفقر، وينتج انخفاض النمو وتراجع التنمية بشكل كبير، والسبب في ذلك هو أن انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المزارعين الذين يشكلون مع أسرهم شريحة واسعة جداً من الشعب، على شراء السلع والخدمات، ومع قلة المحاصيل أو انخفاض أسعارها ينخفض طلبهم على السلع الأخرى والخدمات إلى درجة كبيرة، كما يزداد الطلب لديهم مع وفرة العوائد طبيعياً.
وبذلك يظهر لنا بوضوح أن خسائر استيفاء الضرائب فيما إذا اثقلت عليهم، (فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً...) هي أكبر بكثير من الأرباح التي تجنيها الحكومة، فتندرج، وبشكل أشد، فيما اصطلح عليه علماء الاقتصاد بـ (خسارة الحمل الساكن)، وهي الخسارة التي يتكبدها المجتمع بسبب الضرائب أو الاحتكار، وبعبارة أخرى: هي الخسارة في الدخل الحقيقي أو فائض المستهلك أو المنتج الذي ينشأ بسبب الاحتكار، والتعرفات الجمركية والكوتات، والضرائب وغير ذلك من التحريفات. مثال ذلك، حين يرفع محتكر سعره، فإن الخسارة في إشباع المستهلك هي أكبر من الكسب في إيرادات المحتكر ـ الفارق هو خسارة الحمل الساكن الذي يدفعه المجتمع بسبب الاحتكار(13).
التخفيف حتى صلاح أمرهم
ثالثاً: إن تخفيف الضرائب، بحسب هذه اللائحة القانونية لا يعني فقط تخفيفها إلى الحد الذي لا يشعرون معه بثقلها فقط، بل إن القانون الذي قرره (عليه السلام) يقتضي تخفيفها إلى حدّ (أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ)، بعبارة أخرى: ليس الحد والهدف هو (أن لا يتضرروا) أو (أن لا يشق عليهم) أو (أن لا يفسد أمرهم) بل الحدّ هو (أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ).
منحنى لافـر
وبذلك يمنحنا الإمام (عليه السلام) الإطار العام الذي يتحكم في كمية الضرائب المفروضة، ويعد ذلك المبدأ الأساس التي يمكن أن يبتني عليه منحنى لافر Laffer Curve (ويؤكد الكثير من رجال الاقتصاد أن خفض الضرائب، وتقليل القوانين المفروضة سيؤدي إلى إطلاق قوى أكثر إنتاجية في الاقتصاد. وهذا صحيح. كما يؤكد أكثر المعنيين بآليات العرض حماساً أن خفض الضرائب يرفع بالفعل من حجم العائد الذي تجمعه الحكومة؛ لأن هذا يدفعنا لنعمل بجدية أكبر، ولنحصل على دخول أعلى، وسينتهي بنا الأمر بدفعنا ضرائب أكثر حتى مع انخفاض معدلات الضرائب. وتلك هي الفكرة وراء منحنى لافر Laffer Curve، الذي يُشكل الأساس الفكري للتخفيض الضريبي الضخم، الذي تم في عهد الرئيس ريجان. وضع أستاذ الاقتصاد أرثر لافر Arthur Laffer، نظريته عام 1974م، التي تفيد أن المعدلات الضريبية العالية تثبط أنماطاً عديدة من العمل والاستثمار، في حين يجني التخفيض الضريبي عائداً أكبر ـ وليس أقل ـ للحكومة)، لكن عهد ريجان تميز بأنه تجاوز الحد فانعكس أثر تخفيض الضرائب على الإيرادات الحكومية، إذ (يدل التخفيض الضريبي الضخم في عهد ريجان على عكس ذلك حيث لم يزد من العائد الحكومي، بل أدى إلى عجز ضخم بالميزانية استمر طوال خمسة عشر عاماً. فقد لا تكون نظرية لافر منطبقة على الأمريكيين الأثرياء الذين انتهى بهم الأمر بدفعهم ضرائب أكثر لخزانة الدولة بعدما حصلوا على تخفيض ضريبي)(14).
وبشكل أكثر تفصيلاً: فإنه (لفت لافر انتباه صانعي السياسة إلى مفهومه في عام 1974 عندما كان النهج العام لمعظم الاقتصاديين هو النهج الكينزي، ودعوا إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب، وهو ما يعني بدوره المزيد من الضرائب، وأثبتت السياسة أنها غير فعالة، وأكد لافر أن المشكلة لم تكن بسبب قلة الطلب ولكن بسبب عبء الضرائب الثقيلة واللوائح التي تركت المنتجين دون حافز لإنتاج المزيد.
تؤثر التخفيضات في معدل الضريبة على الإيرادات بطريقتين، يُترجم كل خفض لمعدل الضريبة بشكل مباشر إلى إيرادات حكومية أقل، ولكنه يضع أيضًا المزيد من الأموال في أيدي دافعي الضرائب، مما يزيد من دخلهم المتاح، على المدى الطويل، يزداد النشاط التجاري، وتوظف الشركات المزيد، والذين بدورهم ينفقون أكثر، وهذا يؤدي إلى النمو الاقتصادي. يخلق النمو قاعدة ضريبية أكبر ويولد إيرادات ضريبية أعلى.
يزيد معدل الضريبة المرتفع العبء على دافعي الضرائب على المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات بمقدار صغير ولكنه يحمل تأثيرًا أكبر على المدى الطويل.
إنه يقلل الدخل المتاح لدافعي الضرائب، والذي بدوره يقلل من إنفاقهم الاستهلاكي.
ينخفض الطلب الإجمالي في الاقتصاد وينتج المنتجون أقل. هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، وتنخفض القاعدة الضريبية للحكومة، وكذلك تنخفض عائداتها الضريبية(15))(16).
(ومنحنى لافر (Laffer Curve): منحنى ابتكره الاقتصادي الأميركي "آرثر لافر" (Arthur Laffer) خلال سبعينيات القرن الماضي، ويُعنى بالعلاقة بين العوائد الضريبية ومعدّلات الضريبة المفروضة على الناس، إذ وعلى عكس ما يتوقعه الأفراد، فإنّ ارتفاع معدلات الضريبة لا يزيد من تحصيل العوائد الضريبية، لأن الضرائب الكثيرة تُثقل كاهل الناس وتُثبِط عزيمتهم على العمل.
رسم لافر منحناه الشهير، وأوضح أن معدّل الضريبة عند 0% و100% لن يحصّل أي عوائد ضريبية، لأنه عند المعدل 0% لن تكون هناك عوائد ضريبية، وعند المعدل 100% لن يعمل أي فرد لأنه لن يحصّل أي أجر. ويُؤكد لافر أن في نقطة ما بين الصفر والمائة يوجد تحوّل في مسار المنحنى، إذ تتحول المعدلات الضريبية من تحصيل العائدات إلى انخفاضها كلما ارتفعت الضرائب)(17).
صلاح الأمر حتى مرحلة الانتعاش الاقتصادي
رابعاً: إن قوله (عليه السلام): (أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ) يعني، فيما يعني، وصول إنتاجهم ومحصولاتهم إلى الحد الذي يتكفل بإخراج الاقتصاد من دورة الهبوط، بل ودخوله إلى مرحلة الانتعاش، لأنه الذي يصلح به أمرهم، وذلك لأن القطاع الزراعي في الدول الزراعية (والدول النامية) يعدّ المحرك الأول للاقتصاد، فازدهار الاقتصاد وركوده يعتمد على ازدهار الزراعة وركودها، ولئن نوقش في شمول هذا النص لمثل ذلك فلا شك ظاهراً في شمول بعض النصوص الآتية له.
(أَنْ يَصْلُحَ) عِلّة للحكم
خامساً: إن قوله (عليه السلام): (أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ) علّة للحكم، فيكون معمِّماً، فيشمل ضرورة التخفيف أو الإسقاط لجميع أنواع الضرائب، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (ثم قال: (فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا) أي ثقل طسق الخراج المضروب عليهم أو ثقل وطأة العامل. (أَوْ عِلَّةً) نحو أن يصيب الغلة آفة كالجراد والبرق أو البرد. (أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ) بأن ينقص الماء في النهر أو تتعلق أرض الشرب عنه لفقد الحفر. (أَوْ بَالَّةٍ) يعني المطر. (أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ) يعني أو كون الأرض قد حالت ولم يحصل منها ارتفاع لأن الغرق غمرها وأفسد زرعها. (أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ) أي أتلفها. فإن قلت فهذا هو انقطاع الشرب؟ قلت: لا، قد يكون الشرب غير منقطع ومع ذلك يجحف بها العطش بأن لا يكفيها الماء الموجود في الشرب)(18).
وقال بعض الباحثين: (1 ـ إن شكوا ثقل الخراج: أي ارتفاع نسبة الخراج إلى حجم الإنتاج.
2 ـ أو علة: أي الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية والظروف الجوية والمناخية القاسية، التي تضعف أو تميت هذه المحاصيل.
3 ـ أو انقطاع شرب: أي نقص مياه السقي المتأتية من الأنهار، لقلة المياه فيها، الذي يؤثر على الثمار وعلى تيبسها.
4 ـ أو بالة: نقص مياه السقي المتأتية من الأمطار، لقلة الأمطار في موسم أو سقوطها في غير موسمها).
(يقدم لنا نظرية أخرى في الخراج، وهي "نظرية الخراج المعدل"، وتقول هذه النظرية، إن مقدار الخراج المفروض على الأراضي الخراجية، يعتمد على تكاليف الإنتاج، وعلى الظروف التي تحيط بالزراعة والمزارع نفسه، وبالتالي فإن نسبة الخراج المستخرجة من حجم الإنتاج الزراعي تبقى ثابتة، طالما كانت تلك الظروف والتكاليف ثابتة، وتتغير هذه النسبة مع تغيرهما، فعندما تزداد تكاليف الإنتاج، أو تتغير الظروف الطبيعية، فإن نسبة الخراج تقل إلى الحد الذي يغطي تلك التكاليف والخسائر، والعكس صحيح، بما يخدم أهل الخراج والمجتمع بكامله...
ثم يتم تخفيض مقادير الخراج إلى الحد الذي يغطي هذه التكاليف الإضافية، لعلم الإمام علي (عليه السلام) أن النشاط الزراعي له من الخصائص التي تجعله يختلف عن النشاطات الأخرى كالصناعة، ومن أهم ما يتميز به النشاط الزراعي:
1 ـ إن الطلب على كثير من المنتجات الزراعية والحيوانية، وخاصة الغذائية منها، قليل المرونة، بمعنى أن انخفاض أسعارها بنسبة، يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها بنسبة أقل من نسبة انخفاض أسعارها.
2 ـ خضوع النشاط الزراعي إلى ظروف طبيعية ومناخية أكثر من غيره من النشاطات الأخرى كالصناعة، وهذا يجعل المخاطرة فيه، وحالة عدم التأكد واضحة فيه، خاصة في الدول النامية، حيث يصعب السيطرة على مثل هذه الظروف مقارنة بالدول المتقدمة.
3 ـ طول الفترة اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني قياساً بالإنتاج الصناعي، إذ أن بعض المنتجات الزراعية تتطلب ثلاثة أو ستة أشهر للانتهاء من إنتاجها، كما أن بعضها دوري كالفواكه يبرز في بعض الفصول، ويختفي في الأخرى، ومن شأن هذه الفترة الطويلة، أن تبعد بين مستويات الأسعار واستجابات المنتج لها زيادة أو نقصاناً، بحيث إن نزول المنتوج إلى الأسواق، قد يكون في موعد لم تعد فيه الأسعار مشجعة، هذا قياساً بالمنشأة الصناعية، التي تستطيع أن تبدل إنتاجها بفترة أسرع استجابة لتقلبات السوق.
ويتضح من ذلك أن الإمام (عليه السلام)، يطلب من عماله على الخراج، أن يتعايشوا مع القوانين والإجراءات الضريبية، التي تحكم تنظيم الإنتاج، للتعرف على مدى انسجامها مع مصالح المنتجين وتفكيرهم، أي البحث عن مصالح هؤلاء المنتجين مثلما يبحث عمال الخراج عن زيادة الخراج، وهنا يقول الإمام علي (عليه السلام) في وصية لابنه الإمام الحسن (عليه السلام):
(يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِك)(19).
وبذلك قدم لنا الإمام علي (عليه السلام) نظرية في الخراج (الضريبة) تتجاوز في مضمونها أحدث النظريات في هذا المجال، وذلك لأنها تؤكد على جوانب قلّما تهتم بها النظريات المعاصرة)(20).


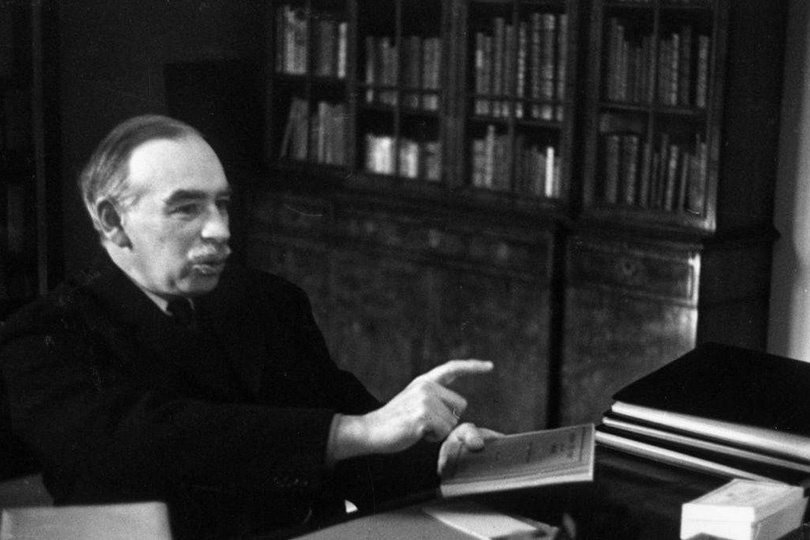


اضف تعليق