في عالم مثالي، يقدم الخبراء قائمة من خيارات السياسة التي يختار منها المواطنون بحكمة. لكن في العالم الحقيقي، لا يملك المواطنون الوقت ولا الميل إلى البحث عبر بدائل السياسة المعقدة والمملة. ومن المؤسف أن هذه أيضا حال الساسة. نادرا ما يُطلَب من أغلب خبراء السياسات...
بقلم: أندريس فيلاسكو
لندن ــ في خضم المناقشة الدائرة حول القرار الأكثر أهمية الذي تواجهه المملكة المتحدة في جيل كامل، صرح وزير العدل آنذاك مايكل جوف قائلا: "أعتقد أن الناس في هذا البلد لديهم ما يكفي من الخبراء". تلقى هذا التصريح قدرا من الاهتمام الإعلامي يكاد لا يقل عن الاهتمام الذي حظي به اعتراف جوف مؤخرا بأنه كان يتعاطى الكوكايين.
لكن تصريح جوف لم يأت في فورة ارتجالية مفاجئة، بل كان محاولة متعمدة ــ شائعة في أيامنا هذه بين الساسة الشعبويين ــ لبناء رأس المال السياسي من الغضب المناهض للخبراء. وتتباين المسميات ــ تكنوقراط، غير شعبيين، حمقى، متبحرون في العلم، متحذلقون ــ لكن المشاعر هي ذاتها عبر العديد من البلدان والسياقات: انعدام الثقة في أولئك الذين "يعرفون كل شيء" والسياسات العامة القائمة على الأدلة التي يفضلونها.
كان عنوان الكتاب الذي نشره في عام 2017 توم نيكولز من كلية الحرب البحرية في الولايات المتحدة، "موت الخبرة"، كاشفا إلى حد كبير. لقد أدرك نيكولز الأمر على النحو الصحيح. فذات يوم، عندما كان الأطباء أو المعلمون يفتحون أفواههم، كان الناس ينصتون. أما الآن، فإن كل من أجرى نصف ساعة من "البحث" على الإنترنت يزعم أنه يعرف كل شيء. وأي خبير يزعم بكل ثقة، مدعوما بعقود من الدراسة، أن الصحيح هو (x)، فربما يواجه الآلاف على موقع تويتر أو فيسبوك الذين يزعمون أن (y) هي عين الصواب في اعتقادهم.
الواقع أن النخب من الخبراء والتكنوقراط يستفزون كراهية الناس بسهولة. فهم يتحدثون غالبا في جمل عامرة برطانة الخبراء ولا يستطيع أحد أن يفهمها. وربما يتعاملون مع الناس بغطرسة، كما حدث عندما وصفت هيلاري كلينتون ناخبي ترمب بأنهم "سلة من البائسين". وفي أميركا اللاتينية، يصور المثقفون الناخبين من أبناء الطبقة المتوسطة عادة على أنهم أشخاص يميلون إلى اليمين كحال المتسلقين الاجتماعيين الاستهلاكيين الذين ضحوا بالتضامن الطبقي على مذبح الفردية الباحثة عن المال. وإذا كانت سياسات الهوية، وفقا لتعريف فرانسيس فوكوياما، لا شيء أكثر من مطالبة جماعية بالكرامة، فمن الواضح أن نُخَب المعرفة لم تكن تعامل المواطنين بقدر كبير من الكرامة.
علاوة على ذلك، لم يكن المتكهنون الخبراء بارعين في التكهن والتنبؤ. على الجانب الآخر من الشارع حيث يوجد مكتبي في كلية لندن للاقتصاد، يقع المبنى حيث تساءلت الملكة إليزابيث الثانية في خضم الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات: "لماذا لم ينتبه أحد إلى قدومها؟" ولم يتمكن أي من الأكاديميين اللامعين المحتشدين آنذاك تقديم أي إجابة.
على نحو مماثل، فشل كبار الأكاديميين في الأوساط الأكاديمية في التنبؤ بالحدث الآخر الذي حَوَّل العالم في السنوات الثلاثين الأخيرة، أو انهيار الكتلة السوفييتية. الواقع أن هذا الفشل حَيَّر فيليب تيتلوك، الذي كان آنذاك أستاذا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى الحد الذي جعله يؤلف كتابا كاملا عنه. وما خلص إليه هو أن الخبراء الذين يؤمنون عن يقين بنهج واحد فقط وينظرون إلى العالم من خلال عدسة مفاهيمية واحدة لا يجيدون التكهن أو التنبؤ على الإطلاق. في المقابل، نجد أن الخبراء الذين يدركون مدى ضآلة معرفتهم ويتعلمون بالتالي من خلال التجربة والخطأ، يعدلون ويكيفون توقعاتهم على نحو مستمر، تكون احتمالات انزلاقهم إلى الخطأ التام أقل.
لكن القدرة الفنية ليست القضية الوحيدة أو حتى الأساسية. ربما تكون الدوافع المتضاربة سببا أكثر أهمية لانعدام ثقة المواطنين في الخبراء على نحو متزايد. وينطوي الأمر على مفهوم خاطئ. إذ يرى خبراء السياسات أنفسهم على أنهم متعهدون غير منحازين للمشورة العالية الجودة والقائمة على الأدلة. يخشى المواطنون المطلعون أن يكون الخبير المعني مستعبدا لإيديولوجية أو منهجية بعينها؛ بالقدر الذي ربما يجعل مشورته مدفوعة سياسيا؛ أو أن يفصل المستشارون مشورتهم بما يتوافق مع اهتماماتهم ومخاوفهم المهنية (كيفية الحصول على الوظيفة المجزية في وال ستريت بعد ترك الحكومة على سبيل المثال).
يطلق خبراء الاقتصاد على هذا وصف "مشكلة الأساسي والوكيل". يحدث هذا عندما يستأجر المساهمون في شركة ما (الأساسي) مديرا (الوكيل)، حيث قد لا تتوافق مصالحه تماما مع مصالحهم. يشمل الاقتصاد حقلا فرعيا كاملا، أو نظرية العقد، وهو مكرس لوضع الترتيبات التعاقدية، والقواعد والضوابط التنظيمية التي تتغلب على مشكلة الحافز هذه. ولكن من الغريب أن خبراء الاقتصاد خصصوا وقتا قليلا نسبيا لحل المشكلة التي تؤثر عليهم بشكل مباشر: كيف يضمنون ثقة الساسة والناخبين في المشورة أو النصيحة التي يقدمها الخبراء.
من المؤكد أن إبداعات صغيرة، مثل مطالبة الأكاديميين بالإفصاح مقدما عن الجهات التي تمول أبحاثهم، من الممكن أن تساعد، ولكن بمقدار. فعلى مستوى أكثر عمقا، يواجه الخبراء مشكلة مألوفة للساسة: إقناع المواطنين بأنهم (الخبراء) يشاركونهم نفس القيم والشواغل، وأنهم بالتالي يدافعون عن السياسات التي قد يختارونها (المواطنون) إذا حصلوا على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأن ذلك الاختيار.
في عالم مثالي، يقدم الخبراء قائمة من خيارات السياسة التي يختار منها المواطنون بحكمة. لكن في العالم الحقيقي، لا يملك المواطنون الوقت ولا الميل إلى البحث عبر بدائل السياسة المعقدة والمملة. ومن المؤسف أن هذه أيضا حال الساسة. نادرا ما يُطلَب من أغلب خبراء السياسات تقديم قائمة بالخيارات؛ بل يطلب منهم غالبا الإجابة على سؤال بسيط: ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ في الإجابة على هذا السؤال، يجلب الخبراء حتما قيمهم وتفضيلاتهم إلى المعادلة.
وعلى هذا، فكما هي الحال مع العديد من القضايا السياسية في أيامنا هذه، يتلخص الأمر في الهوية: فهل من الممكن أن يتعاطف الناخبون مع الخبراء أو الساسة الذين يقدم إليهم الخبراء المشورة؟ وهل من الممكن أن يستشعر الناخبون أنهم ينتمون إلى نفس القبيلة ويحترمون نفس القيم؟
الإجابة عادة هي "كلا". وهنا تكمن جذور المشكلة. فربما يقضي معلمو السياسات والساسة وقتا أطول مما ينبغي مع آخرين من أمثالهم ــ كبار موظفي الخدمة المدنية، وكبار الصحافيين، ورجال الأعمال الناجحين ــ ووقتا أقل مما ينبغي مع الناخبين العاديين. ويشكل هذا نظرتهم للعالم بلا أدنى شك. فكما يقول مثال في اللغة الإسبانية، "حدثني عن أصدقائك، أقول لك من أنت".
كيف إذن قد يتسنى للخبراء استعادة ثقة المواطنين؟ الواقع أن الإجابة لا تخلو من مفارقة: من خلال المزيد من التواضع الفكري، والإقلال من التمسك بالأبراج العاجية وقاعات المحاضرات، والإنصات إلى الناس الذين لا يحملون شهادات دكتوراه. وإذا كان بوسعهم أن يصبحوا "أشخاصا متواضعين أكفاء على مستوى أطباء الأسنان"، كما اقترح جون ماينارد كينز، فسوف تسنح الفرصة على الأقل لأن يتفاعل الناخبون مع خبراء غير محبوبين ومتحذلقين فيجدونهم جديرين بالثقة.
إنها مهمة ملحة وعاجلة، لأن العالم يحتاج إلى خبراء جديرين بالثقة. فإذا شعر أحدنا بألم أسنان، فإنه لن يذهب إلى صديق لطيف حسن النوايا، بل إلى المحاقن والمثاقب المخيفة في يد أكثر أطباء الأسنان المتاحين كفاءة.


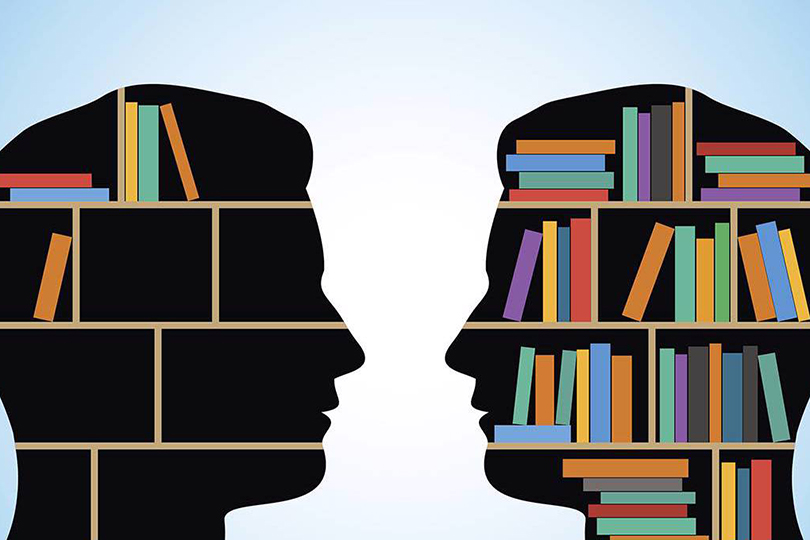

اضف تعليق