المقدمة
تبينت في المباحث السابقة، بعض المعالم من العلاقة الحقوقية، بين الدولة وبين الشعب، والحدود والأطر التي ينبغي أن تتحكم في هذه العلاقة، والمؤسسات الوسيطة بين الدولة وبين الشعب، وموقعها ودورها، وما الذي ينبغي أن تكون عليه، وتبيّن أهمية البحث والدراسة، في البصائر المتعلقة بالمسميّات الثبوتية والواقعية، وليس المتوهمة منها، خاصة لجهة الفهم الصحيح لمفهوم العدل في مقابل المساواة.
كما سيجري البحث والدراسة في الجزء الثاني من الدراسة، عن الجيش وموقعه في خارطة الدولة، من خلال البصائر القرآنية الكريمة، وعلى ضوء الآية القرآنية الشريفة، وبعض الروايات ذات العلاقة بالبحث، التي تشرع وتقنن حدود دور الجيش وموقعه وأداءه المهني، وطبيعة سلوكه في علاقته بالدولة والمجتمع والفرد.
الغاية
إيضاح الفرق بين المسمّيات الثبوتية الواقعية، والمسمّيات المتوهّمة، وبيان الضرورة المجتمعية والأمنية، في ضمان استقامة الجيش والقوات المسلحة، ونزاهتها المهنية، وليس فقط للحيادية في الأداء الوظيفي، وإلقاء الضوء على الضمانات لهذه الاستقامة والنزاهة والحيادية.
المبحث الأول: بصائر قرآنية
يقول الله سبحانه وتعالى: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، وتُرصد في هذه الآية الشريفة بصيرتان في خضم البصائر الكثيرة، التي يمكن أن تستنبط أو تستظهر أو تستشعر، أو تتخذ كلماتها منطلقا لتداعي المعاني.
فهذه البصائر هي بين استشعار في الحد الأدنى، وبين تأييد أو استدلال وبرهنة على المقام، وسنتخذ بعض المفردات في الآية القرآنية الكريمة، منطلقاً يثير معان متقاربة ولصيقة في فكر الإنسان.
ففي [تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، هنا بصيرتان، ونترك بقية البصائر في كلمة العدل لمباحث الفصل القادم بإذن الله تعالى.
البصيرة الأولى: المسميات الثبوتية للحكم بالعدل
هي أن هنالك قاعدة معروفة في علم الأصول وفي المبادئ اللغوية لعلم الأصول، تقول: إن الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية، وليست مجعولة للمسميات المتوهمة أو المتخيلة. واستناداً إلى هذه القاعدة يتضح لنا موقع كلمة (العدل)، وإن هذه الكلمة ملفوظة كانت أو مكتوبة أو مفهومة ـ أي في وجودها الذهني والكتبي واللفظي ـ هي موضوعة للمسمى الثبوتي (النفس أمري) العيني.
فهذه اللفظة كأنها مرآة تكشف عن المصاديق الحقيقية، التي هي مكشوفة بهذه اللفظة، وليست الألفاظ مجعولة للمسميات الإثباتية، بمعنى أن العدل المتوهم ليس عدلاً أبداً، وذلك في متن الأمر ونفس الأمر.
وتوضيح ذلك بالمثال، أنه لو قال الطبيب: إن الدواء الفلاني هو علاج المرض الكذائي، فإن هذا الدواء هو اسم للمسمى الثبوتي للدواء الذي فيه الشفاء.
أما الدواء المتوهم فإنه ليس حاملاً لخصوصية المعالجة والشفاء؛ لأن المسميات الثبوتية هي الحاملة للغرض، والمنتجة للمصلحة، والمحققة للغاية.
ومن هنا نجد أن العدل الحقيقي، هو الذي يولد السعادة في المجتمع، ويستتبع رضا الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن عدلاً في واقع الأمر، وكان ظلماً ولكن توهم كونه عدلاً، فإنه لا يحقق السعادة في المجتمع، وإنما سينتج النتائج السلبية للظلم دون النتائج الإيجابية للعدل.
من ثمرات هذه القاعدة
إن الذي نستنتجه ونستفيد منه في هذه الكلمة والقاعدة المذكورة، هي نتائج عديدة تبحث في محلها، ونشير ها هنا لبعض تلك النتائج، وهي أن الإنسان المكلف العاقل أو المتدين، عليه أن يبحث عن المسميات الثبوتية والواقعية لكي يحققها، ولا يكتفي بمجرد توهم معنى خطر بباله عن كلمة هي موضوع تكليف من التكليفات العقلية أو الشرعية.
وينتج من ذلك أن الإنسان لو خطرت بباله معاني للكلمة، وسار وراءها وكانت سراباً في الواقع، فإن الأصل هو عدم سقوط التكليف من ذمته، وعدم الاجزاء بالمأتي به، بل يتوجه إليه العقاب والمحاسبة إن كان مقصراً في المقدمات وفاته التكليف الواقعي.
فلو أن المولى قال لعبده: اشتر دواءاً معيناً كالكمون أو حبة البركة أو المضاد الحيوي (الأنتي بيوتيك)، فجال بباله من كلمة الكمون ـ مثلاً ـ معنى معين، فاشترى شيئاً لم يكن هو الكمون، فإن المرض لا ينقلع، وتكليفه بشراء الكمّون لا يسقط، وهو بذلك يستحق العقوبة.
وبعبارة أخرى: إن الآثار المرجوة من الدواء سوف لن تترتب، فلا يماثل المولى الأمر للشفاء؛ لأنه دواء غير حقيقي، كمثل السراب في تخيله ماءاً. ثم إنه لو كان مقصراً في التعرف وفي التعلم وفي الاستكشاف لما هو المسمى الثبوتي لهذه الكلمة، فإنه معاقب أيضاً.
انطلاقاً من ذلك يجب علينا أن نبحث عن المصاديق الثبوتية الواقعية للعدل، كما يستخلص منه أن الله سبحانه وتعالى حيث قد أمرنا بالعدل، فيجب علينا (الفحص).
ولا يحق لقائد الجيش، أن يقول أنا أعرف العدل، كما لا يحق لرئيس الجمهورية أن يقول أنا أعرف العدل، دون أن يبحث ويفتش، ويرى ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله وأوصياؤه، في تشخيص وتحديد مصاديق العدل ومفرداته، وما هو عدل حقيقة في نظر الشارع، وإلا سيكون عدلاً متوهماً، وقد يكون ما يقوم به هو الظلم بعينه.
ولا ينبغي هذا الكلام على الحقيقة الشرعية في العدل، بل يجري حتى على عدمها؛ إذ الرجوع للشارع هو (للكشف) لا للقول بالوضع.
على العلماني أيضاً أن يسأل الأديان
وهذه الأمر جارٍ أيضاً حتى في شان القائد غير المتشرع، ومن لا يقبل ديناً من الأديان، فإن عليه أن يبحث لكي يرى ما الذي تقوله الأديان ـ وإن كان لا يعتقد بها ـ حيث يوجد أولوا العلم والحكمة في أوساط المتدينين، والعقل البشري يحكم بالاستماع إلى قول العالم والحكيم وإن كان في اختلاف معه من حيث المبدأ.
فإذا كان هذا الإنسان الذي تأمره فطرته كذلك عقله ـ بأن يتبع العدل وأن يحكم العدل في حياته الشخصية والاجتماعية ـ غير متدين ولا يعترف بدين من الأديان، فإن عليه مع ذلك أن يبحث عما الذي يقوله المتدينون عن مصاديق العدل، فلعله يرشده إلى تغيير قناعته المبدئية التي تشكلت في مكنون ذاته، ضمن منظومته المعرفية.
وهذا بحث عام وهام، وهو أن كل إنسان حتى إذا كان علمانياً، عليه أن يعرض منظومته المعرفية على المتدينين أيضاً، ليرى ما الذي يقولونه في هذا الحقل فلعله يتغير، ولعله يرى بأن معرفته كانت مجهلة، وعلمه جهلاً، وأيضاً عليه أن يعرض معلوماته، والأسماء التي يتوهمها للمسميات الثبوتية على سائر العقلاء، فليس كل شيء توهمه عدلاً فهو عدل، أو توهمه ظلماً فهو ظلم وهكذا، والبحث في هذه النقطة مفصل، ونكتفي في هذا المبحث بهذا المقدار.
من هنا نستنتج في محل كلامنا: أن رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمانيين وقائد الجيش وكبار الضباط فيه، والقضاة وسائر المسئولين في الدولة وأي موظف فيها، من ذوي المرتبة الرفيعة أو الدانية، عليهم أن يسعوا ليطلعوا على آيات القران الكريم حول مادة البحث، وليطلعوا على كلمات الرسول الأعظم محمد المصطفى J، وأن يطلعوا ويطالعوا عهد أمير المؤمنين ومولى الموحدين (عليه صلوات المصلين) لمالك الأشتر، ورسالة الحقوق للإمام السجاد (عليه السلام).
وما تضمنت عن العدل وما الذي تقوله عن الحق، وما هي المصاديق التي يحددها القرآن الكريم، وكذلك العترة الطاهرة لكل من ذلك.
البصيرة الثانية: العدل لا المساواة
ومن البصيرة الثانية نلاحظ الدقة في الآية الشريفة: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، حيث أن المأمور به هو الحكم بالعدل وليس بالمساواة. ومن هنا نعرف أن ما يتوهمه الكثيرون، من أن المساواة لها قيمة ذاتية يجانب الصواب، والصحيح أن العدل له قيمة ذاتية.
وأما المساواة فإنها إن كانت عدلاً فهي مطلوبة، وإن كانت جوراً وظلماً فهي مرفوضة، فليست للمساواة قيمة ذاتية، وإنما القيمة الذاتية للعدل وهو: أن تضع الأشياء في مواضعها.
والمثال الواضح لذلك، ما إذا كان لشخص ما ولدان، أحدهما طويل والآخر قصير، فالعدل أن يعطي الطويل قماشاً يمكن أن يفصّل على قدّه، وللقصير قماشاً أقل من حيث الأمتار ليفصل على قامته، وهذا هو العدل.
أما المساواة فهي أن يعطي لكل منهما قماشاً مساوياً للآخر، وهذا واضح البطلان، وكذلك الأمر في عامة القضايا الاجتماعية.
[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ] لا بالمساواة، ولا بالمحاباة، ولا بالممالاة، ولا بالموالاة. فعلى الرئيس أن يحكم بالعدل لا بالممالاة، بأن يمالئ الرئيس قائد الجيش، وهو بدوره يمالئ رئيس الجمهورية؛ لأن بيده السلطة وهو الذي عين قائد الجيش.
ففي أية مشكلة أو نزاع، تحدث بين الشعب وبين الحكومة، فعندها ما ينبغي أن يتخذه الجيش من موقف حكومته، هو أن يحكم ويحكّم القواعد الشرعية أو العقلية في هذا النزاع الحادث بين الدولة والشعب، فيحكّم العدل في موقفه، لا الممالاة والموالاة والمحاباة.
فلو أن شخصاً ترافع إليه متنازعان، أحدهما ابن عمه والآخر خصمه فرضاً أو أجنبي عنه، فعليه التزام العدل في حكمه بينهما، وكذلك الجيش الذي قد يكون منتفعاً من الدولة، عليه أن يرعى جانب ذي الحق، من هو ذو الحق، ليقف بجانبه وهكذا طبيعياً.
المبحث الثاني: ضمانات استقامة الجيش ونزاهته وحياديته
يقول تعالى: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، وقد ذكرنا أن ذلك يعني الحكم بالعدل، لا بالممالاة أو المحاباة أو المساواة أو الموالاة.
والجيش والقوات المسلحة، وهما القوتان الأقوى في البلد على الإطلاق، فإذا أردنا أن تكون هاتان القوتان، مصداقاً لهذه الآية الشريفة، فما هي الضمانات التي ينبغي أن نوفرها في قائد الجيش ـ بالمعنى الأعم الشامل للقوات المسلحة ـ لكي يكون عند منعطف الطرق، وعند المعترك وعند حدوث المشاكل والفتن في البلد، ضمانة عمل الحكام بالعدل والحق وعامل تكريس الحقوق والحريات المشروعة.
وما الذي ينبغي أن نوفره من قبل ومن بعد، بنحو العلة المحدثة وبنحو العلة المبقية في قائد هذا الجيش، لكي يكون في ساعة الصفر متمسكاً بالعدل في الرعية، فلا يوالي ويمالي جانب السلطة؛ لأنها تدر عليه بعض النعم، وتمنح له بعض القوة والصلاحيات والامتيازات، التي هي في الواقع ليست ملكاً للحاكم أو رئيس الوزراء، وإن كان هو الذي عيّنه قائداً للجيش.
هنالك ضمانات عديدة في تصورنا، ينبغي أن تتوفر في الجيش وفي قائده، وهذه الضمانات لو تحققت فإنها ستبعث عندئذ اطمئناناً عقلائياً، بأن الجيش سيكون أداة ووسيلة لضمان العدل والاستقرار في البلد، وتكون العلة الغائية من وجود الجيش، هي التي يحققها الجيش لا عكسها.
وقد جرى التطرق في المبحث الماضي، لضمانتين منها:
الضمانة الأولى: انتخاب قائد الجيش وليس نصبه
أن يكون تنصيب قائد الجيش بالانتخاب لا بالتعيين، ويعني ذلك أن لا يكون تعيين قائد الجيش، بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بل يكون تعيينه ونصبه بالانتخاب، وقد أشرنا إلى أن هنالك صوراً عديدة للانتخاب، منها: أن تجري انتخابات داخل الجيش لانتخاب القائد الأعلى للجيش.
ومنها: ضرورة إجراء انتخابات عامة، لأهمية هذا الموقع وحساسيته، إذ ليس موقع رئيس الجمهورية هو حساساً جداً فقط، مما يستدعي الانتخابات العامة، وليس موقع البرلمانيين حساساً جداً فحسب، مما يستدعي الانتخابات العامة أيضاً، بل إن قائد الجيش أو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة, كذلك موقعه لا يقل خطورة عن ذينك الموقعين، ولا عن موقع السلطة القضائية، فكان من غير الصحيح دمج الجيش في السلطة التنفيذية؛ لأنه قد زاد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية قوة على قوة، وبذلك تميل الكفة وبقوة، لصالح السلطة التنفيذية، فلم يتحقق توزيع القدرة كما ينبغي.
وقد أشرنا إلى أن منهج (مونتيسكيو) ـ توزيع القدرة على السلطات الثلاثة ـ ناقص وقاصر عن تحقيق الهدف المنشود في الحيلولة دون الاستبداد والطغيان، بل كان ينبغي على التوزيع أن يكون أكثر تفصيلاً وحكمة؛ وذلك من خلال شق رابع يكون موازياً لتلك السلطات الثلاث، أي عبر سلطة رابعة، ولنا بحث في المستقبل حول ضرورة قوى أخرى موازية، إذ ينبغي أن تكون السلطات في تصورنا، سبعة وليست ثلاثة أو أربعة، وسنبحث في ذلك لاحقاً، بإذن الله تعالى، فهذه ضمانة للنزاهة والاستقامة، بأن يكون تولّي منصب قائد الجيش، بالانتخاب لا بالتعيين.
الضمانة الثانية: أن لا يكون رئيس الجمهورية أو تابعاً له
أن يكون المنتخب قائداً للجيش، هو غير رئيس الجمهورية.
والحاصل: إن هنالك قيدين:
القيد الأول: أن يكون تنصيب هذا الشخص، بالانتخاب لا بالتعيين، لا بتعيين من رئيس الجمهورية، ولا من رئيس البرلمان، ولا من رئيس السلطة القضائية، وإنما يكون بالانتخاب.
القيد الثاني: وهو يشكل ضمانة إضافية، أن لا يتولاه رئيس الجمهورية بنفسه، فلا يصح أن يرشح رئيس الجمهورية، نفسه لمنصب قائد الجيش أيضاً، لكي ينتخبه الناس فرضاً من جديد فإن هذا مرفوض.
إذ ينبغي توفير مزيد من الضمانات، لكي لا يتحول التمركز في القدرة إلى استبداد، فإن دمج هذين المنصبين، في شخص واحد يؤدي إلى تمركز هائل للقدرة، وهو ينطوي على خطر شديد.
وقد يقول قائل: وما المانع من ذلك؟ لأن الناس قد انتخبته كقائد أعلى للجيش، بعد أن انتخبته كرئيس للجمهورية؟.
لكن نقول: إذن أ فهل للناس أن ينتخبونه رئيساً للجمهورية، وينتخبونه أيضاً رئيساً للبرلمان! ثم ينتخبونه أيضاً في نفس الوقت رئيساً للسلطة القضائية!.
فالسبب والعامل المفصلي الذي دعا إلى رفض ذلك، وهو ضرورة فصل السلطات للحيلولة دون تمركز القدرة، يستدعي وبشكل أقوى فصل قيادة الجيش عن السلطة التنفيذية. فعليه يجب من البداية، توفير هذه الضمانة وهي أن يكون هذا المنصب، مفروزاً ومعزولاً ومنفصلاً عن ذلك المنصب والمنصب الآخر، ولا يكفي تحويل الأمر إلى الانتخاب، وإنما ينبغي أن تكون هنالك ضوابط وضمانات متعددة.
الضمانة الثالثة: أن يكون سجله الحقوقي نظيفاً بل متميزاً
ـ وهي ضمانة مهمة جداً ترتبط بالقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ـ وهي: أن يكون سجله الحقوقي والإنساني نظيفاً من كل الجهات بل ومتميزاً أيضاً، ولا يكفي أن يكون ملفه الجنائي نزيهاً.
إذ أننا نلاحظ الآن في قائد الجيش، أو في أي شخص آخر متسنّم لمنصب هام جداً، في البلاد التي تتمتع بنوع من الديمقراطية، إنهم يدققون إلى أبعد الحدود في أن يكون ملفه الجنائي نظيفاً، أي أن لا يكون قاتلاً لشخص ولو قبل عقود، ولا يكون سارقاً، ولا يكون خائناً، ولا يكون قد ارتكب جريمة أخرى، وهذا صحيح وضروري.
فإن الذي يريد أن يتسنّم منصباً رفيعاً جداً، يجب أن يكون ملفه الجنائي نظيفاً إلى أبعد الحدود، والحساسية على ذلك مهما ازدادت فهي في محلها، لكن هذا لا يكفي.
ومن هنا ذهبنا إلى ضرورة توفير الضمانة الثالثة؛ ليكون الجيش حقيقة ضامناً للعدل في البلاد، بأن تكون هنالك حساسية مفرطة تجاه (الشاكلة النفسية) لقائد الجيش، وملفه الحقوقي والإنساني، بأن تجري مراجعة ملفه، حتى في عائلته ومدرسته وشركته، وكيف كان تعامله مع أهله أو تلامذته أو موظفيه؟.
فإن هذا الإنسان الذي سيصبح قائداً للجيش وللقوات المسلحة، (أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان)، إن كان يظلم أهله أو طلابه أو موظفيه، فكيف نتوقع منه أن يعدل في البلاد؟.
ومن يظلم حين يتسلط على خمسة أشخاص فقط، فكيف يصنع لو أعطي سلطة على خمسة ملايين أو خمسين أو خمسمائة مليون أو أكثر أو أقل؟.
ومن الصحيح أن سجلّه هذا وتصرفاته هذه قد لا تكون نهائية لكنها مؤشرات وهي إنذارات، إذ يمكن أن يكون قد ظلم لفترة من الزمن، ولكنه اهتدى لاحقاً واستقام، لكن هذا إنذار يشكل علامة خطر، إذ لعل هذا الإنسان (شاكلته النفسية) هي تلك.
بحث عن (لا ينال عهدي الظالمين)
ولذا نقول في بحث استطرادي ـ لكنه بحث مهم جداً، والبحث محله في العقائد ـ إن قوله تعالى: [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ][1]، يعني: أن عهد الله سبحانه وتعالى لا ينال الظالمَ حتى لو ظلم في ثانية واحدة من عمره فقط. فمثل هذا لا يصلح أن يناله عهد الله سبحانه، وقد تكون شاكلته النفسية الواقعية هي تلك، فهذا الإنسان الذي ظلم حتى لحظة واحدة في حياته، هو من تشمله الآية الشريفة: [قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ][2].
وجه الاستدلال:
إن الصور المحتملة في طلب إبراهيم (عليه وعلى نبينا وآله السلام) هي أربعة:
1-أن يكون قد طلب الإمامة والعهد لذريته الذين كانوا ظلمة طوال حياتهم، وهذا الطلب مما لا يعقل صدوره عن نبي عظيم مثل إبراهيم (عليه السلام) كما لا يخفى.
2-أن يكون قد طلب الإمامة لذريته الذين كانوا ظلمة في خصوص الفترة التي يراد إعطاء الإمامة لهم ـ وكانوا قبلها عدولاً ـ وهذا الطلب كسابقه أيضاً مما لا يعقل صدوره عن نبي عظيم مثل إبراهيم (عليه السلام).
3-أن يطلبها لذريته الذين كانوا عدولاً طوال فترة حياتهم فقط (في مقابل الشمول للصورة الرابعة أيضاً)، وهذا الطلب وإن كان معقولاً وصحيحاً، إلا أن جواب الله تعالى [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] يُظهر أن إبراهيم (عليه السلام) لم يطلب خصوص هذه الصورة، وإلا لما كان هناك أي ربط لجواب الله تعالى بالطلب، ولكان قوله تعالى: [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] لغواً.
4-فلم يبق إلا أن يكون طلب إبراهيم (عليه السلام) لنيل ذريته بالإمامة والعهد هو في حق من كانوا عدولاً في الفترة التي يراد إعطاء الإمامة لهم، لكنهم كانوا ظلمة ولو في ثانية قبل ذلك، والمبرر للطلب أنهم في وقت الطلب عدول، وأما الماضي فقد تابوا عنه، لكن الله أجابه [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]، مما يعني أن الظالم ولو للحظة واحدة في عمره لا يصلح للإمامة حتى وإن تاب.
وقد فصل العلامة المجلسي e في "البحار"[3] وغيره في كتب الكلام، أن هذا غير مبني على أن المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدأ، فليراجع.
ومثاله العرفي ما نجده في بعض دول العالم, حيث يشترطون في رئيس الجمهورية مثلاً أو رئيس القضاء، أن لا تكون له سابقة، وإن كانت قديمة وكان قد تاب عنها.
الحساسية تجاه (الشاكلة النفسية) لقائد الجيش
وفيما يرتبط بالموضوع نقول: إن [قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ][4] هي ضابطة عامة، ولذا فإننا ندعو المفكرين والمقننين والناس للدقة أشد الدقة في (الملف الحقوقي) ـ إضافة للملف الجنائي ـ لقائد الجيش، ورئيس أركان الجيش وكبار الضباط الأمراء، وكذلك النواب في البرلمان، وأنه طوال حياته الماضية, هل كان حقيقة مدافعاً عن الضعفاء والمستضعفين والأبرياء؟.
وهل كان مع المظلوم ضد الظالم أم لا؟.
سواء بالمدرسة أم بالشركة أم بالوزارة، وسواء أكان موظفا أم مديراً عادياً، وهل كانت تبدو منه بوادر للميل إلى الظالم ومع ذوي القوة ومع ذوي المكنة أم لا؟.
وإن كل ذلك يشكل علامة إنذار ويدق ناقوس الخطر؛ وذلك لان أي حادث حقوقي في الماضي، وإن كان بسيطاً قد يكشف عن (شاكلته النفسية)، مما يعني أنه لو تسنم عرش القوة (في قيادة الجيش في مبحثنا مثلاً) فلعله يطغى ويجر البلاد إلى الاستبداد.
ولتأكيد الفكرة وتكريسها بشكل أكثر عمقاً ودقة ـ وإن كانت الفكرة في تصوري من البديهيات ولكن لمزيد التوضيح، لأن العالم يسير بطريقة أخرى ـ أنه إذا كانت كان لأحدهم تجارة، وأراد من شخص أن ينقل بعض أمواله، مثل أن ينقل منه إلى زيد أو عمرو أمانة مالية ونقدية أو عينية، فإذا كانت المبالغ بسيطة فإنه يصح أن يعطيها لإنسان عادي أو موظف.
لكن إذا تقرر أن يستخدم شخصاً في شركته، ويكون أمين الصندوق والذي سيتكفل بمهمة استحصال النقود من البنك بالملايين، عندئذ سيبدي وسوسة أيضاً في التحقيق عن ملفه تاريخياً، وهل كان أميناً ويده نظيفة، أم أن هناك ثغرة في حياته؟.
مثال آخر: إذا أراد أحدهم أن يستخدم بستانياً في حديقته وبستانه، فالمهم حينئذٍ أن يكون إنساناً ملتزماً بالفعل، بمراعاة الحديقة والعناية بها، أما أن تكون عينه نظيفة مثلاً فما دام البستان بعيداً فليس مهماً، لكنه إذا أراد أن يستخدمه لداره حارساً، فالوضع مختلف تماماً عن حارس بستانه، فإنه سيدقق في خصوصياته أكثر وستكون أمانته البصرية وعفته شرطاً أساسياً.
وفوق ذلك إذا أراد أن يستخدم شخصاً كسائق لأهله وأولاده وبناته، فإن الضرورة ستكون أكبر ليحقق عن ملفّه الأخلاقي بأكمله في الماضي، إذا كان ذا غيرة وحمية ومعرفة، وإذا لم يحقق فهو مغبون وجاهل، وقد ظلم نفسه وأهله.
فكيف إذا كان المطلوب أن يُنتخب شخص قائداً أعلى للقوات المسلحة، والذي يتحكم بمصائر الجيش وأفراد الجيش وهم بالألوف ومئات الألوف أو بالملايين، وأيضاً يتحكم بمصير الأمة بالمآل.
النتيجة
إن الضمانة الثالثة هي دراسة الملف الشخص لهذا القائد، لا من حيث سجله الجنائي فقط، بل من حيث (سجله الحقوقي) أيضاً، مع أهله وأولاده وغيرهم، وكيف كان في المدرسة؟ وكيف كان في الشركة؟ وكيف كان مع القريب والغريب؟.
مالك الأشتر القائد ـ الأنموذج
وهذا هو ما نجده في مالك الأشتر، الذي انتخبه أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب (عليه صلوات المصلين) قائداً أعلى للجيش، حيث نلاحظ أن ملفه الحقوقي والجنائي كان نظيفاً نقياً متميزاً، بل إنه كان في قمة القمة، حقوقياً بل وأخلاقياً أيضاً، وكان عادلاً بأعلى درجات العدالة، ونزيهاً بأعلى درجات النزاهة، وإنساناً بأعلى درجات الإنسانية.
وإليكم الرواية التالية الشهيرة نقرؤها من "سفينة البحار"[5] كي نلفت إلى بعض النقاط النافعة بل الجوهرية، وإجمال القضية أن مالكاً الأشتر (رضوان الله تعالى عليه) كان يمر بسوق، فرماه واحد من عامة الناس بحجر أو ببندقة طين، لكن مالك الأشتر لم يعاقبه ولم يعاتبه، بل ذهب إلى المسجد ليصلي مستغفراً له. فلحقه الرجل بعد أن عرف أن هذا هو مالك الأشتر معتذراً منه، لكن مالكاً تلقاه بكل الخلق السامي والإنسانية.
أما تفصيل القصة وما يمكننا أن نستلهم منها فهو:
(إن مالك الأشتر كان مجتازاً بسوق)، هنا عبرة هامة: مع أنه كان القائد الأعلى للجيش لكنه كان يجتاز السوق وحده، إذ يظهر من القرائن وسياق القصة أنه كان وحده بلا حراس أو مسلحين، وبلا كبكبة وبلا دبدبة، حيث لو كان مالك مع جماعة، لما استحقره ذلك الشخص، ولما كان يتجرأ أن يضربه، بل تصور أنه من عامة الناس فأزرى به واستهان به.
والآن لنسأل: هل يوجد الآن ملك أو حاكم أو قائد أعلى للجيش يجتاز في الأسواق بمفرده؟ بل حتى مع الكبكبة؟ نجد أن ذلك نادر الوقوع وهذه القضية تكشف عن صفته الأولى وهي كونه: شعبياً متواضعاً، فهكذا شخص هو من انتخبه الإمام (عليه السلام) قائداً أعلى للجيش، وبذلك نكتشف جانباً من حكمة الإمام وعدله، وكيف يجب على الحكومة الإسلامية أن تكون.
ثم:
(وعليه قميص خام وعمامة منه)، وهنا نقطة لطيفة هامة أخرى: حيث كان يرتدي قميصا خاماً، وليس قميص حرير، ولا قميصا موشّى بالذهب أو مطرزا بالحرير، والقميص الخام من الأنواع البسيطة من الأقمشة، وهذه تكشف عن صفته الثانية، وهي كونه زاهداً ونزيهاً في حياته الشخصية، وكم قائد جيش تعرفونه في العالم، عليه قميص خام؟!.
(وعمامة منه)، وهذا هو الأغرب إذ العمامة عادة لها خصوصية، إذ ينبغي أن يكون قماش العمامة قماشاً متميزاً عن سائر الأقمشة، لكن عمامته أيضاً كانت من نفس نوع القميص الخام، أي أنه اشترى مثلاً ثلاثة أمتار من هذا القماش، فاقتطع منه متراً وصنع منها عمامة، وأي زهد هذا الذي يندر وجوده حتى في الناس العاديين، فكم شخصاً ترى عمامته من نفس قماش صايته أو ملابسه، التي هي بدورها أدنى من العادية؟.
(فرآه بعض السوقة)، بعض الناس السوقيين العاديين، (فأزرى بزيّه)، أي: استحقره، كون هذا النمط من الزي كان زي الفقراء، فمن ردة فعل السوقي يظهر أن القميص كان من النوع الداني وقيمته كانت دانية، (فأزرى) يعني: استهان به واستصغره واستحقر ملابسه وزيه.
(فرماه ببندقة) من طين أو ما أشبه ذلك رماها عليه تهاوناً به، ومن هذا المقطع من الرواية أيضاً يظهر كما سبق أن مالك الأشتر القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، كان لوحده ولم يكن معه حراس أو شرطة أو مرافقون.
بل لو فرض ـ على احتمال بعيد جداً ولا شاهد له ـ أنه كان معه اثنان أو ثلاثة من الحراس، فكم كانوا مهذبين ومؤدبين، وكم كانوا قد تربوا حقوقياً، حتى أنهم لم يتعرضوا له، بل ولم ينظروا شزراً إليه.
(فمضى ولم يلتفت)، أي أنه مرّ ومضى بدون أن يلتفت أبداً لذاك الطرف (يعنفه أو يعاتبه)، بل إنه لم يلتفت إليه حتى يعرفه، أي: إنه كان مسيطراً على نفسه إلى هذه الدرجة، ذلك أننا ربما نعفو عن شخص، إذا كنا أقوياء النفس وقد بنينا على الصفح، ولكننا مع ذلك نحب أن نعرف المعتدي أو المؤذي، إذ هذه طبيعة الإنسان إذ يمتلكه نوع من الفضول ليعرف من أساء إليه، حتى لو عفا عنه، أما مالك الأشتر (فلم يلتفت).
(فقيل له) أي بعض الناس المتواجدين في السوق، والذين كانوا يعرفون مالكاً، قالوا له (ويلك) أي الويل لك من عذاب شديد، ولعل المراد الويل الأخروي وليس الدنيوي، إذ كيف يكون دنيوياً ومالك قد مضى؟!.
لكن يحتمل إرادتهم الويل والعذاب الدنيوي، لأنهم يعرفون غضب الحكام وانتقامهم ويحتملون وجود عيون لمالك وأنه سينتقم لاحقاً، (أتعرف لمن رميت؟!. فقال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين)، يعني قائد الجيش، إذ الذي يبدو أن هذا هو المراد من صاحب أمير المؤمنين (عليه صلوات المصلين).
(فارتعد الرجل)؛ لأن في مرتكزه الذهني وفي التراكم المعرفي الذي عنده، أن القادة في الجيش وفي كل العالم عادة ينتقمون ويعذبون، فارتعد الرجل (ومضى إليه ليعتذر إليه، وقد دخل مسجداً، وهو قائم يصلي)، يعني مالك.
(فلما انفتل) من صلاته، (انكب الرجل على قدميه يقبلهما)؛ لأنه يخاف من العقوبة الشديدة التي عرف بها الحكام أو قادة الجيش السابقين.
(فقال مالك: ما هذا الأمر) من هنا، أيضاً يتضح أن مالكاً لم يعرفه إذ لم يلتفت في ذاك الوقت إليه، فاستغرب العمل الذي يقوم به.
(فقال: أعتذر إليك مما صنعت).
(فقال مالك:) بكل هدوء (لا بأس عليك، فو الله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر لك). وهذا يكشف عن غاية سمو النفس، إذ إنه لم يكتفِ فقط بالكف عنه وبالعفو عنه، بل زاد عليه الإحسان إليه بأن ترك أعماله ودخل المسجد ليستغفر له.
والحاصل: إن قائد الجيش ينبغي أن يكون كمالك الاشتر قائداً مثالياً.
ومن المحبذ أن نشير في ختام هذه القضية إلى ما ذكره في "سفينة البحار"، قال (قدس الله نفسه الزكية): قد ظهر من هذا الخبر أن الأشتر (رضي الله عنه) كان ممن يصدق عليه قوله تعالى: [وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا][6]. ولهذا كتب أمير المؤمنين (عليه سلام الله) إلى أهل مصر لما بعث الأشتر إليهم: (فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله)، وصدق عليه أيضاً معنى الشجاع في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أشجع الناس من غلب هواه)[7].
وعليه ـ وفي إطار الضمانة الثالثة ـ يجب أن يدرس الملف الحقوقي والإنساني لقائد الجيش، دراسة دقيقة جداً؛ لأن قادة الجيش وكبار الضباط، والحكام الذين ينصبونهم في البلاد الاستبدادية خاصة، تكون عقليتهم ـ عادة ـ فوقية استعلائية، تدميرية وانتقامية.
وإليكم الشاهد الآتي كمثال بارز على عقلية تريد الجيش للظلم لا للحق والعدل، تريد الجيش للفرد والشخص لا لصالح النوع والناس، يقول لينين: (لا يمكن اعتبار القوات المسلحة محايدة).
بمعنى أنه يريدها في جانب المستبد والحاكم الجائر والقائد الشيوعي المسيطر بالقوة، ويرفض أن تكون القوات المسلحة محايدة، ويدعو إلى جذبها إلى السياسية الشيوعية الاستعلائية الفوقية، وهو شعار أسوأ طغاة العصر، والذي جعل الجيش كله في خدمة الديكتاتورية الشيوعية الرهيبة.
وينقل عن أحد قادتهم، قوله: (تسعة من عشرة من الشعب لا يريدونني ويكرهونني وهذا لا يهم، المهم أن العاشر هو مسلح يقف إلى جواري).
فهو يعترف بأن تسعين بالمائة يرفضونه، لكنه يكفيه أن قوة مسلحة تقف إلى جواره.
إن هذا النمط من الناس مخيف جداً، وإن عقلية قادة الجيش هي هكذا عادة، [إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى][8].
وأكرر مؤكداً: إن الضمانة الثالثة التي ينبغي أن تتحقق بكل دقة، هي أن يدرس ملف حقوق الإنسان، لهذا الشخص المرشح لهذا المنصب، ليجري التأكد تماماً من تاريخه، بلحظات حياته، وأن ملفه كان قمة في النزاهة الحقوقية، كما كان قمة في النزاهة الجنائية، وهنالك ضمانات أخرى لابد من توفيرها، نتركها للمستقبل بعونه تعالى.
المبحث الثالث: الإجابة عن التساؤلات ذات العلاقة بموضوع البحث
السؤال: شورى المراجع في بلاد المذاهب الأخرى
ذكرتم من الخيارات: أن يقوم مجلس شورى الفقهاء بترشيح شخص أو أشخاص لمنصب قيادة الجيش, وهنا يفرض السؤال نفسه, وهو فماذا تقولون في البلاد التي أكثريتها من غير الشيعة من المذاهب الإسلامية الأخرى، أو البلاد الخليطة من الشيعة وغيرهم؟. فهل أمر الترشيح لشورى الفقهاء أيضاً؟.
الجواب:
سبق الكلام حول الخيارات المتاحة لدور المجتمع المدني في تنصيب القائد العام للقوات المسلحة، وأن مؤسسات المجتمع المدني، إما بأجمعها ـ وهي بالألوف ـ وإما بعضها تتولى هذه المهمة، وقد تم التطرق كمثال لمجلس شورى الفقهاء[9]، إذا كان الفقهاء أو أكثرهم يقبلون بالتصدي لمثل ذلك، ولم نرجح ذلك بل طرحناه كمجرد خيار[10].
والحاصل أنه إما أن تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني ـ كالنقابات والاتحادات والعشائر والأحزاب أو كلها ـ بترشيح شخص لقيادة الجيش، أو تقوم جهة أخرى بالترشيح (كالبرلمان مثلاً)، ثم تقوم مؤسسات المجتمع المدني بانتخاب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، من بين المرشحين.
وكان من المقترحات: أن يقوم مجلس شورى الفقهاء، بترشيح شخص لمنصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهذا فيما لو كانت الأكثرية من الشيعة، لكن غالب البلاد الإسلامية هي خليط من الشيعة والعامة، فينبغي أن يشكّل مجلس الشورى لبلد مكون من شيعة أو عامة من علماء الفريقين، كل حسب نسبته في ذاك البلد، وهذا المجلس هو الذي يرشح لهذا المنصب، بعض الكفاءات الجامعة للشروط.
كأن يرشح عشرة مثلاً لهذا المنصب، ثم ينتخب الناس عامة شخصاً منهم، أو أن ينتخب الجيش من بين العشرة شخصاً.
المهم أن الخيارات مختلفة في ذلك، وقد تم طرحها مبدئياً في سياق البحث، دون أن نحدد إحدى الخيارات؛ لأنها مقترحات وخيارات لمختلف المقننين في مختلف البلاد، لذا نعرض صيغاً مختلفة، سواء للمتدينين بمجموعة من المقترحات، أم لغير المتدينين بمجموعة من المقترحات الأخرى، حتى تكون فسحة الانتخاب واسعة من بين هذه الخيارات، وكي نكون قد قدمنا خيارات عديدة على مختلف المباني الفقهية أيضاً.
وهنا نشير إلى أن البحث ذو عرض عريض حول ماهية العلاقة، التي ينبغي أن تكون بين الشيعة والعامة، قانونياً وعقدياً وحقوقياً، ولكن نشير بإيجازٍ: فهنالك بحث عقدي، في العلاقة الحاكمة بين الفريقين، فإن للشيعة آراء ومعتقدات، والسنة لهم آراء ومعتقدات.
وهنا نقول: إن باب الحوار ينبغي أن يكون مفتوحاً؛ لأنه طريق الوصول إلى الحقيقة، فلا يُظلم هذا الطرف أو ذاك، بأن يكبت عن الإدلاء بحجته في ساحة الحوار، وإنما يكون المنهج قائماً على الحوار، والشيعة على مر التاريخ ساروا على هذا المنهج، ولذا نرى كتب السنة بمختلف ألوانها وأشكالها، موجودة عادة في مكتبات الشيعة، لكن قليلاً ما نرى كتب الشيعة موجودة في مكتبات السنة.
فينبغي إذن أن يكون الحوار مفتوحاً، والعلم متاحاً للجميع، وكل إنسان وما اختار، وفي الآية الشريفة: [وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ][11]، [وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ][12].
إذن في مساحة العقيدة، في أصول الدين، في فروع الدين، ينبغي أن يكون باب الحوار مفتوحاً، ويجب أن يتم ذلك كله في الإطار القانوني الحقوقي، الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين المذاهب؛ لأن المسلم في بلد الإسلام، شيعياً كان أم سنياً محقون الدم، ولا يجوز هدر دمه، ومحفوظ العرض، ومحفوظ المال أيضاً، وجميع حقوقه المشروعة محفوظة، وفي الرواية: (لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)[13]، على التفصيل الذي ذكره الوالد e في كتاب موسوعة "الفقه: ج107-108 الاقتصاد".
وأما مِن الناحية القانونية ـ في موطن البحث ـ فلو فرض أن بلداً نصفه شيعة ونصفه سنة، أو أكثره شيعة أو أكثره سنة، فما هي الصيغة؟.
وفي الجواب نقول: إن السيد الوالد (رحمة الله تعالى عليه) يرى في كتيب "كيف نجمع شمل المسلمين" أن الإطار العام لصيغة العلاقة، هي ـ ببيان مبسط أختصِرُه ـ إذا كان البلد أكثريته المطلقة شيعة، فمن الطبيعي أن الحكومة تكون للأكثرية، وعندئذ يحكم مجلس شورى الفقهاء بالأكثرية في الشؤون العامة، مع إحراز رضا الناس. وإذا كان البلد أكثريته سنة، فهنا يحكم البلد فقهاء السنة بالأكثرية في الشؤون العامة، بشرط إحراز رضا الناس، ولكن في كلتا الحالتين ينفذ حكمهم فيما يرتبط بتلك الطائفة المحددة من الشؤون العامة.
أما إذا كان هنالك شأن عام يرتبط بالفريقين، فيرى الوالد أن أكثرية كلا المجلسين ينبغي أن تراعى، يعني مجلس فقهاء الشيعة بأكثريتهم، ومجلس فقهاء السنة بأكثريتهم، فإذا توافقت الأكثريتان على أمر يرتبط بشؤون البلد بشكل عام، ويرتبط بمصائر كلتا الطائفتين، مثل شؤون الحرب التي لا تقتصر تأثيراتها السلبية على الشيعة فقط أو على السنة فقط، وكذا المعاهدات الدولية، ففي هذه الحالة ينفذ رأيهم لا غير، ولهذا الحديث تفصيل نتركه لمظانه.
السؤال: مراجع التقليد والمؤسسات الخدمية
إن الدولة التي شعبها مسلمون، وفيها مراجعها الأعلام ومواطنوهم، ولديها ثروة معدنية ونفطية، تعد من المغانم التي شرع فيها الشارع الخمس، وخص الإمام أو نائبه بالتصرف فيها لخدمة المجتمع وتنفيذ حاجاته، فلماذا لا يتولى المراجع استغلال هذا الحق، لإقامة الضمان والتكافل الاجتماعي في الدولة الإسلامية؟.
الجواب:
السؤال بمضمونه يتعلق بدور المرجعية والعلماء في حياة الأمة، وخلاصته أن المراجع تصل لأيديهم الأخماس والزكوات، فينبغي أن يهتموا أيضاً بسائر المؤسسات أو المرافق الخدمية، وليس أن يهتموا فقط ببناء المساجد والحسينيات، وإنما عليهم أيضاً أن يهتموا بالمؤسسات الإنسانية والخدمية الأخرى، كالمستشفيات والمكتبات، ودور إيواء الأيتام، ومراكز التأهيل، وصناديق الإقراض الخيري.
والجواب على هذا السؤال حول هذا الأمر طويل، لكن نكتفي بالإشارة لبعض الأجوبة عبر النقاط التالية:
النقطة الأولى: إنّ الكثير من الناس لهم تصور مبالغ فيه جداً، عن حجم الأموال التي تصل للمراجع العظام، فليس الأمر كما يتوهمون؛ لأن الأموال عادة بيد الدولة، التي بيدها المعادن والثروات والضرائب وغير ذلك، وإنما المراجع تصل بأيديهم نسبة ضئيلة جداً من الأموال، وهي الأخماس.
إذ ليس كل الناس ملتزمين بدفع الخمس، ولا كل الناس ملتزمون بالزكاة، بل لعل الأكثرية ليست ملتزمة بهما، ثم إن الذين يخمسّون ويزكّون، لا يدفع كلهم تلك الأموال للمراجع، بل إن كثيراً منهم قد يتصرف في تلك الأموال، بإجازة أو بدون إجازة، إذن الأموال التي تصل إلى أيدي المراجع، هي بالقياس إلى ما تحصل عليه الدولة، تقريبا لا شيء.
النقطة الثانية: إن المراجع الكرام لهم إنجازاتهم وإسهاماتهم الكثيرة في مجال المؤسسات الإنسانية والخدمية والمعرفية في هذه الحقول، ويكفي في هذه العجالة أن أشير إلى مثال واحد وهو أنّ الوالد (رحمة الله تعالى عليه) كان من المراجع الذين يبذلون أقصى الجهود في هذه الحقول، فقد أسس الكثير من المدارس، ومن المستوصفات الصحية، ومن مؤسسات الإقراض الخيرية، التي كانت تعنى بإقراض الناس بدون ربا وبدون أرباح، وبشروط ميسرة.
رغم أن الحكومات الجائرة شنت حروباً شعواء عليه ـ بل وعلى أي مرجع آخر يتصدى لمثل هذه الأدوار ـ لأن الحكومات خيارها البنك، والبنك مبني على الربا، وعلى سائر الأمور غير الشرعية، مثل بيع الكالي بالكالي.
لذا فإن الحكومات المستبدة عادة تحارب المراجع، خاصة إذا تصدوا لهذه الأدوار، ولكن مع ذلك فإن الوالد كنموذج، أسس الكثير من صناديق الإقراض الخيرية، وأيضا شجع صحبه والوكلاء والمقلدين، فأسسوا الكثير الكثير من المؤسسات بمختلف فعاليتها.
وكذلك أسس العديد من المياتم[14]، إضافة إلى الكثير من المكتبات التي تعنى بالفكر، وخدمات أخرى كثيرة فضلاً عن المساجد والحسينيات.
وربما يستطيع الباحث أن يجد أسماء العشرات منها في بعض الكتب، التي كتبت عن هذا الحقل، وعن السيد الوالد الشيرازي (رحمة الله تعالى عليه)، وأيضاً المؤسسات المختلفة التي أسسها الكثير من المراجع ممن لهم هذا الاهتمام.
فمع قطع النظر عن أن الأموال التي تصل بأيديهم ليست بكثيرة، ولو قطعنا النظر عن أن الحكومات تحاربهم حتى في هذه الأدوار، نجد أن مجموعة من المراجع ـ من رحل منهم ومن لا يزال حياً حفظهم الله ـ كالسيد البروجردي وغيره[15]، ومنهم مراجع لا يسع المقام لذكرهم، اهتموا بهذه الجوانب، حتى اهتموا بأشياء بعيدة عن أذهان الناس.
مثلاً اهتموا بتأسيس مؤسسات للختان المجاني، والذي قد يستغرب ذلك البعض، أن مرجعاً يتصدى للتشجيع لمثل ذلك، فتؤسس مؤسسات تراعي وضع الفقير، الذي لا يجد أجر الختان وهو واجب شرعاً كما هو واضح.
وليس فقط هذا المثال المذكور، فقد أسست بتشجيع بعض المراجع (جزاهم الله خيراً) بدعمهم دورات للمياه في المدن المقدسة؛ نظراً إلى توافد الزوار المليوني إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وفي غيرهما.
عليه نستخلص من هذا الطرح، أن المراجع قد قاموا بهذا الأمر، ولا نقول بأن الكل قد استوفى القيام بكل هذه الأدوار والمؤسسات، إذ لعل مرجعاً ليست عنده طاقة لذلك، أو ربما يشخص المرجع أن أولويته هي المدارس لا الحسينيات مثلاً، أو ذاك النمط المعين من المؤسسات وليس غيره، ولكن كان هناك الكثير من المراجع، الذين اهتموا بهذه الجوانب بأكملها.


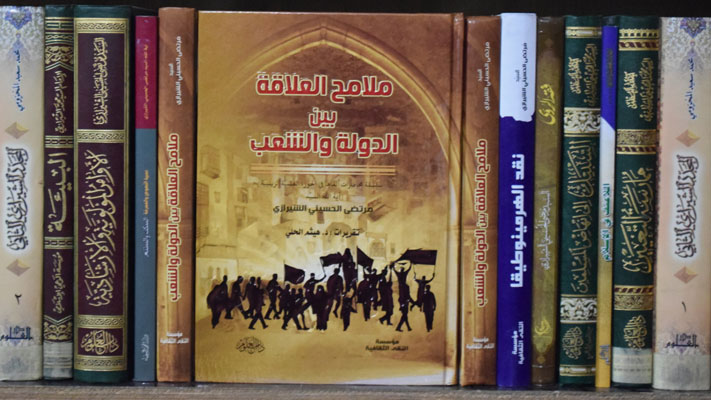

اضف تعليق