المقدمة
جرى التطرق إلى العلاقة البينية، بين الدولة والشعب، والبحث في الأطر والحدود والضوابط، التي تتحكم أو التي ينبغي أن تتحكم، في طرفي هذه العلاقة.
وتبيّن الحاجة للتعمق في البحث، لجهة ما ينبغي في تعامل الحاكم مع شعبه، وما ينبغي أن تكون عليه الرعية أو المجتمع أو الناس أو الشعب، بالنسبة للحاكم وللحكومة، والتعريف بالحقائق الاستقلالية في الأمانة، والعنوان الإرتباطي منها في عالمي التكوين والتشريع.
الغاية
إلقاء الضوء على الحقائق الاستقلالية، وإسقاطاتها في عالم التكوين، وبيان العنوان الإرتباطي في الأمانة في الحكم، واستدلالاته في عالم التشريع، وبيان المناشئ في الحقوق وشرعية الحكم.
المبحث الأول: بصائر قرآنية
ارتباطية الأمانة في عالمي التكوين والتشريع
الآية الشريفة تقول: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا]، وقد استظهرنا في البحث الماضي أن الأمانة بالقياس إلى الحكومة "أمانة الحكم" هي أمانة ارتباطية، وحيث أن البعض قد يستغرب هذا الطرح، لذا لابد من مزيد إيضاح لها، مع دفع الشبهة التي يمكن أن تتوهم في هذا الحقل.
فنقول: إن (الواجبات) في عالم التشريع، و(الحقائق) في عالم التكوين، قد تكون استقلالية، وقد تكون ارتباطية. فالحقائق الاستقلالية هي الحقائق التي لا يتوقف أحدها على الحقيقة الأخرى، ولا يتوقف بعضها على البعض الآخر.
لكن الحقائق الارتباطية، هي التي يتوقف[1] بعضها على البعض الآخر.
ففي عالم التكوين نجد مثلاً: إننا لو أسندنا كتابين أحدهما للآخر على شكل رقم 8، فإن أحد الكتابين في بقائه على هيئته هذه، متوقف على الكتاب الآخر. فلو أزلنا الكتاب الآخر فإن الكتاب الأول سيسقط أيضاً، وكذلك (البيت) فإن بعض أجزائه كالسقف بالنسبة إلى الجدران مرتبط بها ومتوقف عليها، ولا يمكن أن نزيل الجدران أو الأعمدة بأجمعها، ويبقى السقف قائماً.
فهذه أمثلة عرفية تقريبية للحقائق الارتباطية، وأما الحقائق الاستقلالية، فكهذا البيت مع ذلك البيت الآخر، فإنهما حقيقتان استقلاليتان، وكذا زيد وعمرو هما حقيقتان مستقلتان بما هما هما، عكس أعضاء بدن الإنسان، فإن بعضها مرتبط ببعض، إذ هي مرتبطة بأجمعها بسلسلة من الأعصاب، والخلايا الرمادية في المخ التي تتحكم بها، فهي متوقفة عليها، فهي إذن ارتباطية بوجهٍ.
وفي الجانب التشريعي أيضاً هنالك حقائق استقلالية، وهنالك حقائق ارتباطية.
ومن الأمثلة الواضحة للحقائق الاستقلالية: (الدَين) فلو أن أحداً كان مديوناً لشخص بمقدار عشرة دراهم، فدفع له درهماً فإن ذمته بمقدار الدرهم ستبرأ، وتبقى ذمته مشغولة بالتسعة الأخرى، فهذه حقيقة استقلالية بمعنى أن كل درهم له سهم من البراءة أو من الاشتغال (اشتغال الذمة).
لكن بعض الحقائق ارتباطية، ومن الأمثلة الواضحة لها (الصلاة). فإن الإنسان لو صلّى الصلاة بكافة أجزائها إلا الركوع، فإنها ستكون باطلة، أي يسري البطلان إلى تلك الأجزاء الأخرى من الصلاة[2].
والحاصل أن الحقائق في عالم التكوين قد تكون ارتباطية وقد تكون استقلالية، وفي عالم التشريع أيضاً قد تكون ارتباطية وقد تكون استقلالية.
وفي الآية الشريفة: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا]، قد يقول البعض: إن (الأمانة) استقلالية بمعنى لو أدى الشخص أمانة زيد له، فقد أبرأت ذمته بهذا المقدار، وإن لم يؤد أمانة عمر له، والإنسان المديون لعشرة أشخاص، لو سدد ديون ثلاثة منهم، تبرأ ذمته بنفس القدر، فإذن (الأمانات) حقائق استقلالية، فكيف نقول: إن الحكم وأمانة الحكم، هي حقيقة ارتباطية؟.
توضيح ذلك يتصور على مستويين:
المستوى الأول: هو الأخلاقي.
والمستوى الثاني: هو الشرعي والفقهي.
الارتباطية على المستوى الأخلاقي
أ- أما على المستوى الأخلاقي فالقضية تنزيلية، وبهذا المقدار لا يوجد هنالك إشكال، يعني لو أن الحاكم أدى أمانات 99ر99(عليهم السلام) من أمانات الشعب، لكنه ظلم سجيناً واحداً وصادر حقه، أو ظلم شخصاً واحداً مديراً أو مداراً من الرعية ومن الناس، من مزارع أو عامل أو سياسي أو معارض، فكأنه لم يؤد الأمانة، على المستوى الأخلاقي.
أي: إنه لو أعطى الكل حقوقهم لكنه ظلم أحدهم فقط، فإن كل عمله أخلاقياً منزّل منزلة العدم، ومما يوضحه التمثيل بابن بار بوالده طوال اليوم والليلة، لكنه في لحظة واحدة فقط نظر شزراً إلى والده وبغضب، فكيف لو رفع يده عليه مهدداً.
هنا نقول كأنه لم يفعل شيئاً، حتى لو جدّ وكدّ واجتهد في خدمة والده طوال اليوم، لكنه في لحظة واحدة طغى وشط، فكأنه لم يفعل شيئاً، أي كل عمله السابق واللاحق في نظر العرف منزل منزلة العدم، ونؤكد أنه على المستوى الأخلاقي كذلك[3].
والأمر كذلك في (الحاكم)، فإنه لو أدى حقوق كافة الناس، وجدّ واجتهد ليلاً ونهاراً، كي لا يوجد في كافة أرجاء الدولة سجين واحد مظلوم، وأن لا يكون هناك سجين سياسي في السجن، وأن لا تسحق ولو إحدى أجهزة الدولة حقوق المعارضين لأنهم معارضون، ولهم نقد موضوعي بنّاء، وقاموا بواجب النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف.
فهذا الحاكم لو ظلم ولو في قضية واحدة، فكأنه لم يفعل شيئاً، وأن كل جهاده وجهوده تعد كأنها لا شيء، وهذا أيضاً على المستوى الأخلاقي.
والصورة في العرف كذلك أيضاً، فإذا استقبل أحدهم ضيفاً في بيته، واحترمه مؤدياً فروض الضيافة له فترة طويلة، ثم في آخر لحظة أهانه بإهانة، أو بجارح من القول، فكأنه لم يفعل شيئاً من واجبات الضيافة[4].
الارتباطية على المستوى الشرعي
ب- وأما على المستوى الشرعي فالأمر كذلك؛ لأن هذه اللحظة الأخيرة قد تهدم الماضي كله، وتهدم ما فعله بأكمله. ففي المثال السابق لو خدم الإنسان أمه، لنفرض من أول الصباح إلى آخر الليل مثلاً، لكنه في آخر الليل نظر إليها شزراً، أو قال لها أفّ، فقد أبطل عمله السابق، وهذا هو ما يسمّى بالحبط.
الارتباطية بلحاظ عنوان (الأمين)
وأما في حقل (الأمانات) فنحن نقول: بأن أمانة الحكم هي واجب ارتباطي، بمعنى أن عنوان (الأمين) لا يصدق على هذا الحاكم، سواء أ كان رئيس دولة أم رئيس وزراء أم قائد شرطة أو أي جهاز آخر في الدولة، فأمانة الحكم هذه التي سلمت بيده، والقوة التي حولت له وأوكل بها، تجعله لا يصدق عليه عنوان الأمين إلا بسد أبواب العدم[5] من جميع الجهات.
ويتضح ذلك بملاحظة أن العدم لو كان له ألف باب للشيء، فلو أغلق تسعمائة وتسعة وتسعين باباً ولم يغلق الباب الأخير، فالشيء يبقى معدوماً، ولو أوجد تسعمائة وتسعة وتسعين من عوامل الوجود، لكن العامل الأخير لم يوجد، فالمعلول أيضاً لا يوجد.
هذه قاعدة واضحة وبديهية سواء أ في عالم التكوين أم في عالم التشريع، وعلى الإنسان أن يغلق أبواب عدم الشيء بأجمعها حتى يوجد الشيء، وإلا إذا بقي باب واحد للعدم مُشرَعاً غير مغلق، فالشيء يبقى معدوماً.
إذن (الارتباطية) هنا هي في (العنوان)، والأمر كذلك في مطلق الأمانة وليس خاصاً بأمانة الحكم. فلو أن شخصاً كانت بيده مائة أمانة، فأدى منها إلى أصحابها تسعة وتسعين، لكنه خان بآخر أمانة، فإنه لا يطلق عليه عنوان الأمين، بل يقولون: هذا خائن، على الرغم من أنه أرجع تسعة وتسعين أمانة منها لأصحابها.
بعبارة أخرى: هذا (العنوان الاعتباري ـ الأمين ـ) متوقف على تحقيق كل تلك العلل، 100(عليهم السلام) بأن يؤدي الأمانات كلها [إِلَى أَهْلِهَا] حتى يطلق عليه أنه (أمين)، وحتى لا يطلق عليه (خائن).
فأمانة واحدة لو خان بها فإنه يصدق عليه عنوان الخائن، وإذا مرة واحدة نظر شزراً إلى والده أو والدته فإنه يطلق عليه غير بار، إلا أن يتوب بعد ذلك، والكلام هو أن عنوان الأمين ينتفي بخيانة واحدة، فيجب أن يكون أميناً في كل الموارد، حتى يطلق عليه الأمين.
ولنضرب لكم مثالاً من عالم صناعة الكمبيوتر، فلو كان هنالك مثلاً ألف نوع من الفيروسات الفتاكة التي تدمر برامج جهاز الحاسوب، فإذا سيطر الخبير وقضى على تسعمائة وتسعة وتسعين فايروساً، فإنه لا ينفع مادام آخر فايروس لم يقضَ عليه، فإن الكمبيوتر سيتوقف إذ سيعبث هذا الفيروس به ويوقفه عن العمل ويعطله، فيجب على الخبير أن يغلق أبواب العدم كلها بالقضاء على الألف فيروس كلها، ولا يكفي أن يقضي على تسعمائة وتسعة وتسعين فيروساً.
و(أمانة الحكم) من هذا القبيل، فإن الحاكم إذا ظلم شخصاً واحداً فهو ليس بالأمين ولم يقم بأداء الأمانة، وقد نقلنا كلمة الأمير (عليه الصلاة وأزكى السلام) في مقطع سابق، ومنه (فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْـمُهِمَّ)[6].
وذلك أن هذا الشيء التافه في نظر الحاكم، هو عند الله تعالى عظيم، وحقوق الناس كلها كبيرة، غير أن الدارج عند كثير من الناس أو الحكام تجاهل الحق البسيط أو العادي، فلا يصغون إلى ظلامات المزارع، ولا يرون بداً في الالتفات إلى ظلاماته والدفاع عنها.
إن هذه الثقافة مرفوضة عند الإمام (عليه السلام) منبهاً بقوله: (فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْـمُهِمَّ).
والحاصل: إن الحاكم إذا حقق إنجازات كبيرة في هذه الدولة، فنهض بالدولة وحقق نهضة اقتصادية كبرى، ووفّر الحريات أيضاً، لكنه ظلم موظفاً أو مزارعاً أو عاملاً بسيطاً واحداً فقط، فلا يطلق عليه عندئذ أنه أدى أمانة الحكم، وأنه (أمين) بل هو خائن، ما دام مقصراً في تلك الجزئية.
والأمر في ذلك كالأمر في أجهزة الملاحة في الطائرة، التي يجب أن تكون جميعها سليمة، فإذا تعطل جهاز واحد، فقد تسقط الطائرة، أو قد يحدث فيها إرباك من نوع آخر.
أو كالأمر في (الحصن) الذي يحمي البلد من الأعداء، فإن العدو إذا نفذ من ثغرة واحدة، فإنه لا يمكن حينها القول أن آمر الحامية أو الحصن قد أحكم تحصينه؛ لأن كل هذه الأحجار والجدران قد أتقنت، ولم تبق إلا تلك الثغرة غير محكمة.
ذلك غير صحيح، فإن اللازم إغلاق أبواب العدم كلها في مواجهة العدو، وإلا لم يصنع الحامية شيئاً، بل ولاستحق العقاب.
وكذلك الأمر في (السد)، فلو كان قوي الإحكام في غير نقطة واحدة فيه كانت ضعيفة، فإن المياه ستتسرب من هذه النقطة، وقد تأتي على المزارع وعلى الناس.
الأمانة استقلالية وارتباطية
والحاصل: إنه يمكن القول أن (أمانة الحكم)، ومطلق الأمانات هي استقلالية من جهة، وارتباطية من جهة أخرى، وارتباطية من زاوية أخرى.
فإن عنوان أمين بالقياس إلى الأمانات، وهو عنوان استقلالي بلحاظ أن كل أمانة بالقياس لأمانة أخرى هي وحدة مستقلة، لها امتثال مستقل وعقاب مستقل وثواب مستقل.
فالأمانة إذن بهذا اللحاظ وبهذا المنظار استقلالية، ولكن بالقياس إلى عنوان الأمين هي حقيقة ارتباطية، أي يتوقف تحقق عنوان (الأمين) بقول مطلق على أداء الأمانات كلها بقول مطلق، وذلك نظير ما يعبر عنه في الأصول بـ (العنوان والمحصل).
الأقوال في (العدالة) وارتباطيتها
ولنستعرض الآن مثالاً آخر وهو (العدالة)، وكما هو محقق في الفقه فإن فيها أقوالاً:
منها: إنها الاستقامة على جادة الشرع دون الانحراف عنها يميناً وشمالاً، ولا يشترط على هذا القول وجود (الملكة)، وإنما تكفي الاستقامة الفعلية على جادة الشرع، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى دائماً ويتجنب المعاصي.
فإن كان المبنى الفقهي في (العدالة) هو هذا المعنى، فلو كذب كذبة واحدة، أو اغتاب غيبة واحدة صغيرة كانت أو كبيرة، لا فرق، وإن خان في درهم واحد، أو خان في أمانة إدارة التلاميذ إدارة جيدة ولو يوماً واحداً، فإنه يسقط حينها عن العدالة والاستقامة؛ إذ لا استقامة له حينها على جادة الشرع، فهو كالعنوان والمحصل.
وإن شئت قلت: هو عنوان ارتباطي بالقياس للعدالة، نعم إذا تاب المؤتمن توبة نصوحاً فترجع له العدالة.
ومنها: حسن الظاهر بعدم ظهور الفسق منه[7]، فإذا كذب كذبة، أو نظر ـ لا سمح الله ـ إلى امرأة أجنبية بريبة أو بشهوة، سينخدش حسن ظاهره، فيسقط عن العدالة.
فعند الالتزام المطلق بالطاعات كلها، والالتزام المطلق بالابتعاد عن المعاصي بأجمعها، يتحقق حسن الظاهر، فيما نعلم يعني في ظاهر الأمر، فلو أنه في ظاهر الأمر ارتكب معصية واحدة تسقط عنه العدالة[8].
الارتباطية بلحاظ عنوان (العدالة)
ومن شروط الحاكم أيضاً أن يكون (عادلاً)، وهذا وجه آخر لبيان الارتباطية. فإن الحاكم لو ظلم شخصاً واحداً من خمسين مليون إنسان أو من ألف مليون إنسان، يكون قد فقد أمانته.
ولنفرض الذي يحكم الصين، يحكم ألفاً وخمسمائة مليون إنسان، فلو التزم بالعدل منهجاً وتطبيقاً بالنسبة لهم جميعاً، إلا شخصاً واحداً ظلمه في ثانية واحدة، فإنه تسقط عنه العدالة.
وذلك فيما إذا كانت العدالة هي حسن الظاهر، فيما يخدش حسن ظاهره، أو إذا كانت هي الاستقامة على جادة الشرع، دون أن ينحرف عن الجادة يميناً أو يساراً، أو حتى إذا كانت هي (الملكة)[9].
على تفصيل في هذا الرأي الأخير، وأنه إذا فعل مثلاً الكبيرة يسقط عن العدالة بلا شك، وإذا فعل الصغيرة مصرّاً عليها أيضاً يسقط.
ولدينا بحث مفصل حول هذا الموضوع على ضوء: علم الكلام، وعلم الأصول، وعلم الفقه، نتركه لمظانه.
ويكفينا ها هنا هذا المقدار من الحديث في إطار هذه الآية الشريفة بخصوص بحثنا عن الحاكم، وأن عنوان (الأمين)، وعنوان (العادل)، لا يصدق عليه، إلا إذا التزم بالأمانة في كل الصور وفي كل الحالات.
وإلا إذا التزم بالعدالة آناء الليل وأطراف النهار، في كل شاردة وواردة، فلم يظلم صديقاً ولا عدواً، لا موافقاً ولا معارضاً، ولا حابى حزبه وجماعته، فأعطاهم فوق حقهم من أموال الناس أو من حقوق الناس، ولا عادى أولئك المنافسين له، فظلمهم بعض حقهم.
فإذا فعل الحاكم أو الرئيس أو المسئول ذلك كله، والتزم التزاماً مطلقاً بالعدل والأمانة، فإنه يصلح أن يبقى حاكماً، شرط رضا الناس به وإلا يسقط عن الصلاحية في شرع الله تعالى، أي في حكم الله سبحانه وتعالى، وفي منظار الشعب أيضاً.
والعصارة: إن [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا]، تفيد علاقة الجميع بالجميع، فلو أدى الإنسان الأمانات كلّها [إِلَى أَهْلِهَا] كلّهم، فهو أمين على أماناته.
وإذا التزم الحاكم بذلك، فإنه سيصدق عليه عندئذ عنوان الأمين، [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، فإذا حكم في كل قضاياه بالعدل، عندئذ يصدق عليه عنوان العادل، ويكون مرضياً لله سبحانه وتعالى.
المبحث الثاني: منشأ تولّد حق الحاكمية
بحثنا في بعض مباحث الفصول السابقة في المناشئ المحتملة أو المتوهمة أو المقولة لحق الحاكمية، وذكرنا أن كثيراً من الطغاة والمستبدين يجدون لأنفسهم:
1- حق (المالكية)
إذ يرى الحاكم نفسه مالكاً للعباد والبلاد، ومثّلنا بفرعون وغيره، الذي يرى أن الثروات والمعادن والنفط وما أشبه كلها ملك له، ويرى الناس عبيداً له (اتخذوا مال الله دولا وعباده خوَلا أو خوِلا)، كما يقول الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام)[10].
فهذا هو المنشأ الأول، المدعى والمتوهم والمقول والذي يستند إليه الطغاة عادة.
2- منشأ حق الحاكمية: (القهر والغلبة)
والمنشأ الثاني ـ والذي يدعيه كثيرون أيضاً وحتى بعض المتدينين، وهو من الغربة بمكان ـ هو (القهر والغلبة). وهذا المنشأ يعدّ هو الآخر مستنداً للطغاة والمستبدين والدكتاتوريين، فإن منطقهم هو: أنا الذي قهرتكم، وأنا الذي تغلبت عليكم، إذن فاسمعوا لي وأطيعوا.
وهكذا كان منطق معاوية عندما أراد أن يجعل يزيد ابنه خليفة له، فالمعروف المتواتر عند الناس الآن وفي ذاك الوقت، وكما أثبته التاريخ أيضاً، أنه كان مجاهراً بالفسق والفجور.
فأراد معاوية أن يجعله ـ وهو المجاهر بالفسق، من شرب خمر وزنا وغير ذلك ـ حاكماً وخليفة على المسلمين بالقوة، حيث كان من البديهي أن عامة المسلمين وخواصهم كانوا سيرفضون ذلك، لذلك استعمل منطق القوة والعنف اللا محدود.
فدعا بعض الخطباء وجمع الناس، فارتقى أحدهم المنبر وكان معه سيف، ولعله كان في الغمد، وأشار إلى معاوية، وقال: إن أمير المؤمنين هذا ـ وأشار إلى معاوية ـ فإن مات فهذا ـ وأشار إلى يزيد ـ ومن أبى فهذا، وجّرد السيف من غمده وشهره في وجوه الناس.
فقال له معاوية: اجلس فأنت أخطب الناس[11].
لم يكن معاوية يمتلك منطقاً بأي مقياس، بل كان منطقه الوحيد في ذلك هو (السيف والقهر والغلبة).
والحكام في ذلك على قسمين: إذ قد يصرح الحاكم بهذه الطريقة إذا كان مستهتراً، زاعماً أنه سيطر على الأمور تماماً، لذا فإنه يجهر بمنطق السيف.
كما أن معاوية في عهده مع الإمام الحسن المجتبى (عليه الصلاة وأزكى السلام) قد صرّح مستهتراً، بـ (ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به)[12].
فالحكام عندما يرون حكومتهم مستتبة، فلا يمانعون من المجاهرة بالظلم والعدوان، وقد لا يبيح الحاكم للملأ سياسته هذه، ذلك إذا رأى المستبد أن حكمه ليس بتلك القوة وبذلك الاستقرار، وعندئذٍ سيحاول عن طريق واجهات وشعارات منمقة براقة إضفاء الشرعية على حكمه.
الفطرة والعقل والشرع ضد هذا المنطق
إذن أن المنشأ الثاني المتوهم للشرعية، أو لتولد حق الحاكمية، هو (القهر والغلبة)، حدوثاً أو بقاء.
وهو منشأ واضح البطلان، وهو أمر غير مقبول بالمرّة، لا في منطق العقل، ولا في منطق الفطرة، ولا في منطق العقلاء، ولا في منطق الشرع، إذ لا أحد يقبل بمنطق القهر والغلبة.
وذلك لأنه لا يعقل القول بأنّ الحرام واللا شرعي، يكون طريقاً لتكريس النتيجة كحلال وكشرعي، وذلك كمن يقوم ـ لا سمح الله ـ بسرقة الأطفال أو اختطافهم وهم حديثو الولادة من المستشفى، ثم يقول: ما دمت قد قهرتكم وسرقت أولادكم، فهؤلاء الأولاد إذن هم أولادي، محتجاً في زعمه بالقهر والغلبة كعامل مولّد لهذا الحق.
أو كمن يختطف امرأة من بيتها أو من المدرسة أو الشارع ثم يعتبرها أمة له أو زوجة، فهل من عاقل يقبل هذا المنطق؟!!
وفي عالم اليوم نجد الكثير من نظائر ذلك، ففي بعض الإحصاءات يوجد في العالم مليونا رِقِّ ـ أي عبيد وإماء ـ لكنهم لا يطلقون عليه عنوان الرقيق ـ وإن كان واقعه ذلك ـ حيث يتعاملون معه ويستخدمونه كالرقيق، بل ويبيعونهم ويشترونهم، وإن كان بصيغ وألفاظ أخرى.
وكثير من هؤلاء (الرق العصري) هم في أمريكا وأشباهها من الدول الديمقراطية، بل إن وضع الكثير منهم أسوأ من الرقيق؛ إذ يستخدمونهم في الدعارة والفساد وفي شبكات المخدرات وغيرها، ولعل الرقم أكبر من ذلك، وهذا يعد من أعظم سيئات الحضارة الغربية، ولنسمّه (نظام الاسترقاق الحديث المقنّع).
وهكذا بالقهر والغلبة أو بالاحتيال والخدعة يصطادون شاباً أو فتاة، ثم يبيعونهما في دولة أخرى لشبكة دولية، فهل القهر والغلبة هي طريق للشرعية؟.
كلا؛ فإن ذلك حرام عقلي وشرعي، بل إنه من أبشع أنواع الظلم، ومما يستقل بحرمته العقل، ولا يمكن أن يكون طريقاً لمشروعية النتيجة.
مفردات عصرية ودينية لمنطق القهر والغلبة!
والآن لنسأل: أليس الانقلاب العسكري، وتسلم السلطة والحكم على الناس عن هذا الطريق، صورة من أبشع صور القهر والغلبة وحكومة الغابة.
وكيف يعقل أن يكون الانقلاب العسكري منشأ للشرعية؟ كيف يعقل ذلك؟.
إذا كان هذا الأمر مرفوضاً بالنسبة إلى ولد واحد أو بنت واحدة، أن يُملكا بالقهر والغلبة، فكيف نقبل أن تُتملك حكومة كاملة، في أي بلد من بلاد الشرق أو الغرب، بالقهر والغلبة؟.
ومن الواضح أن التملك والسيطرة قد تكون بالقهر والغلبة الظاهرة، كالتي نراها في الانقلابات العسكرية، أو الحروب الدولية، وقد تكون بالغلبة الخفية، عبر مثلاً (اللوبيّات الضاغطة) التي تسلك سبلاً غير شرعية للسيطرة على مقدرات الناس، فهذا أيضاً نوع من القهر والغلبة لكنه مقنّع، وما أكثر رواجه في الدول الديمقراطية، ولعلنا سنبحث لاحقاً هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً إن شاء الله تعالى.
والغريب في الأمر أن هذا المنشأ الثاني المتوهم للشرعية الذي طرحناه، والذي أصبح عند كثيرين منشأ الشرعية حتى في الحكومة الدينية.
فقد يرى البعض أن (الفقيه) إذا استولى على السلطة، كانت له (ولاية الأمر)، وكان على سائر الفقهاء وعلى الناس أيضاً أن يطيعوه، وهذا يعني أن للقهر والغلبة الكلمة الفصل في (الولاية).
ومن الواضح أن الفقهاء في زمن الغيبة قد استمدوا ولايتهم ـ بالقدر المحدد لهم ـ من الوكالة والنيابة العامة للإمام، وأدلة النيابة تشمل جميع من جمع الشرائط بوزان واحد، وعلى هذا فلهم جميعاً الولاية ـ بقدرها ـ سواء استلموا السلطة أم لا.
واستلام أحدهم للسلطة لا توجب له أرجحيته لا عقلاً ولا نقلاً، إذ لا توجد رواية واحدة تقول: إن القهر والغلبة مرجح لأحد الفقهاء لتكون له الولاية أو لتكون له فِعلية الولاية![13]
دع عنك أكثر الدول التي أصبحت ولا مستند لشرعيتها إلا القهر والغلبة!
(الجيش) السلاح الأقوى للطغاة!
وهنا نجد من الضروري أن نتوقف عند نقطة هامة جداً وحساسة ومصيرية، وهي: إن الطغاة والحكام والمستبدين يمتلكون سلاحاً، هو من أمضى الأسلحة، ومن أشد الأسلحة فتكاً ونفوذاً، في تكريس دعائم استبدادهم وسلطتهم غير شرعية، ألا وهو الجيش والقوات المسلحة.
ومن المؤسف والغريب في ذلك أن ليس هنالك تثقيف جيد للناس، حول خطورة هذا السلاح الرهيب والمحوري والمفصلي، كما أنه لا يوجد تقنين جيد لها. بمعنى أن المقننين لم يضعوا ضوابط وحدود، وضمانات قانونية متكاملة لضبط هذه القوة وتحييدها، مع أن المستبد والديكتاتور يستند إلى هذه القوة بالأساس في قمع الشعب.
كما ـ والغريب في الأمر ـ إنني راجعت الكثير من الكتب الإسلامية وغير الإسلامية، فوجدتها قليلاً ما تبحث عن ذلك، ولا أقول بالنفي إطلاقاً، إذ توجد بحوث في الجملة، لكنها بحوث مختصرة جداً عن الجيش، لجهة ماهية موقعه القانوني، من شتى جوانبه بحيث يضمن تحييد هذه القوة تماماً، وعدم إساءة استخدامها أبداً.
والملاحظ أن "مونتسكيو" قد حاول معالجة مشكلة تمركز القدرة عبر فكرة فصل السلطات، (التنفيذية والتشريعية والقضائية، فرئاسة الجمهورية والوزراء من جهة، والبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة من جهة ثانية، والجهاز القضائي من جهة ثالثة)، ولربما نتوقف في المستقبل عند هذا البحث.
ومما يدعو إلى الاستغراب أن سائر المفكرين ـ فيما وجدت ـ قد غفلوا عن وضع الحلول الفكرية وتشريع القوانين المتكاملة لما هو أخطر من ذلك بكثير، أي للبؤرة الأساسية الأقوى لتمركز القدرة، والتي لو لم تعالج لما نفع فصل السلطات شيئاً، ألا وهي الجيش والقوات المسلحة، وذلك الذي نلاحظه جميعاً.
إن أشد ما يعتمد عليه الدكتاتور لاستبداده، والدعامة الأولى له هو (الجيش والقوات المسلحة)، ومع ذلك لم أجد بحثاً قانونياً شاملاً حول موقع الجيش في الدولة، ووضعه القانوني، وكيف ينتخب قائد الجيش، وما هي الصياغة القانونية لوضعه، بحيث نضمن أن لا يتحول إلى أداة بيد السلطة التنفيذية لغرض السيطرة على كل شيء، ولإلغاء قدرات سائر القوى، ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد خطرت بالبال مجموعة من الأطر والحلول القانونية والقواعد والضوابط لهذه القضية الأساسية والمعقدة، والتي أتصور أنها لا تقل أهمية عن فكرة فصل السلطات، في أنها لو تبلورت أكثر وطبقت عملياً، لأحدثت انقلاباً جذرياً في معادلة تمركز القدرة واستبداد الحكومات.
وذلك لأن معادلة فصل السلطات لتفتيت الدكتاتورية، وتفتيت تمركز وتكرس القدرة في شخص واحد أو جهة واحدة في جانب، ومعادلة الضمانات القانونية العملية لتحييد الجيش، الذي هو أكبر عامل لتركيز القدرة بيد شخص رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع في جانب.
موقع (الجيش) في نهج البلاغة
ولنبدأ هذا البحث المفتاحي الاستراتيجي بل والمصيري، بكلام لأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب (عليه صلوات المصلين وعليه الصلاة وأزكى السلام) في "نهج البلاغة" يقول في عهده لمالك الأشتر: (فَالْـجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْوُلَاةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ)[14].
كم هو مستحكم وقوي ومتقن وحكيم هذا الكلام، ذلك أن أمير الكلام وأمير البلاغة وأمير الفصاحة وأمير الحكمة، يعطينا أطراً محورية وضوابط جوهرية لحل مشكلة مستعصية جداً في كلمات قليلة فقط: (فَالْـجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ)، وهذا يمثل بنداً جوهرياً من بنود النظام الداخلي للجيش والجنود ومنتسبي الجيش، إذ يبين ما هي مسئوليتهم، وما هو موقعهم في البلد، إنهم:
أ-(حُصُونُ الرَّعِيَّةِ) وليسوا حصوناً للحاكم.
فإن الجيوش في الدول المستبدة هي حصون للحاكم، وحصون للحكومة وليست حصوناً للرعية، إذ يستخدمها الحاكم لتكريس استبداده، فيقمع به الشعب، أو يطغى به على الدول الأخرى، وقد تكون تلك الدول مسالمة لا مشكلة لها مع هذه الدولة، بل المشكلة في الحاكم فقط.
إذ في كثير من الأحيان نجد أن علاقة الشعوب فيما بينها علاقة ودية، بل قد تكون علاقات تزاوج مكثف مثل ما نرى في كثير من الدول، التي أثيرت بينها حروب طاحنة، وإنما تنبع المشكلة من الحاكم الذي يرى الجيش حصناً له، ولأهوائه ولنزعاته السلطوية والاستبدادية، فيستغله في شن حروب والتعدي.
لكن أمير المؤمنين ومولى الموحدين (سلام الله عليه) إذ يفصح عن النظام الداخلي للجيش، يرفض أن يكون الجيش أداة بيد الحاكم الظالم، (فَالْـجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ)، للحفاظ على مكتسباتهم، وعلى حقوقهم، وعلى أموالهم وأعراضهم وكرامتهم، وليس للحفاظ على مصالح للوالي أو الحاكم أو الملك.
ب-(وَزَيْنُ الْوُلَاةِ)، وهي جمال للولاة لا أكثر، وليس لحمايتهم، أو لتكريس الشخصانية الموجودة في هؤلاء الطغاة، فالجيش حصن الرعية وليس حصن الولاة، وإذ يكون حصناً للرعية فإن الوالي يتزين بالجيش، فهو مفخرة له حيث استطاع أن يحافظ على دور الجيش ويبقيه لحماية للشعب، فالجيش "زينة الولاة" وليس سلاحاً لهم، فإن الجمال لا يستخدم في القمع، والزينة لا تستخدم في الإرهاب والسجن ومصادرة الحقوق.
ج-(وَعِزُّ الدِّينِ) أن من أدوار الجيش الأساسي في الفقه الإسلامي هو إعزاز الدين، لكنه كما نراه في كثير من البلاد الدكتاتورية استخدم لقمع المظلومين، ولسحق حقوق الناس باسم الدين، وأين هذا من عز الدين وإعزازه، إنه على العكس تماماً.
ومن الواضح أن الجيش يجب أن يستخدم كمدافع عن حقوق الناس، فإذا استخدم الجيش دفاعاً عن حقوق الرعية وتكريساً لحقوقهم، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وتكريس الحريات وللحقوق، فحينئذٍ يكون الجيش عزاً للدين.
د-(وَسُبُلُ الْأَمْنِ)، فالجنود هم سبل الأمن، بينما إذا استخدم الجيش لقمع المتظاهرين، فهو سيتحول إلى سبيل الخوف والإرهاب وإلى سبيل للدكتاتورية وتكريسها. إن الجيش يجب أن يكون سبيلاً لأمن البلاد والعباد، فلا يكون حسب المثل المتداول: (حاميها حراميها).
هـ-(وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ)، فالجيش قوام للرعية وليس قواماً للحاكم المستذئب على رعيته، والكلام حول كلام أمير المؤمنين (عليه الصلاة وأزكى السلام) طويل، وسنكمل بعضه إن شاء الله تعالى في البحث القادم.
ختاماً: بعد تفكير وتأمل وتدبر وضعت أربعة عشر بنداً أو مادة قانونية أساسية، يجب أن تراعى في بدء تكوين الجيش بنحو العلة المحدثة ثم في علته المبقية، لو تحقق ذلك فسيحدث تغييراً جوهرياً في (المذهب العسكري)[15] للدولة.
ونعني به الأسس التي تبتني عليها فلسفة العسكر، والتي تحدد ماهيته وحقيقته، ومجموعة الأسس هذه لو لم تعمل بها الدولة؛ فإن الجيش سيتحول إلى أداة إرهاب، وأداة قمع واستبداد، وسنشير إلى بعضها في فصل الضمانات، ونترك سائر النقاط إلى كتاب آخر بإذن الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، لكي نكون ممن يرفع راية العدل في البلاد، ويؤدي الأمانات [إِلَى أَهْلِهَا] إنه سميع مجيب.
المبحث الثالث: الإجابة عن التساؤلات ذات العلاقة بالموضوع
السؤال: كيف نكافح الجهل المتمكن في نفوس الناس؟.
الجواب:
إن الجهل يعد من أخطر الآفات التي تقوض إيمان الإنسان، ووعيه وحاضره ومستقبله، فما هي سبل تحجيم هذه الآفة، ومن ثم مكافحتها؟.
إن الجهل ينبغي أولاً تقسيمه إلى أقسام، إذ قد يكون الجهل جهلاً بالعلوم الطبيعية كالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات والهندسة والحساب.
وقد يكون جهلاً بالعلوم الإنسانية، وبالسياسة وبالاقتصاد مثلاً أو الجهل بالاجتماع والجهل بالحقوق.
وهذان النمطان من الجهل هما الأخطر، وإن كان النمط الأول مهماً أيضاً، ومع الأسف فإن كثيراً من المجتمعات، تهتم بالجانب الأول من العلوم فقط. إذ يتعلم الفرد فيها الحساب أو الهندسة أو الطب أو الجغرافية، ولكن لا يبذل فيها جهدا حقيقياً بالمستوى المطلوب لرفع الأمية السياسية عن المواطن، ولرفع الأمية الاقتصادية والحقوقية، في البعد النظري وفي البعد العملي، وهنا تكمن المشكلة الأساسية.
إذ قد يكون المواطن عالماً في اختصاصه، لكنه لا يعرف ما هي حقوقه، أو إذا عرفها لا يعرف سبل المحافظة عليها أو سبل تحصيلها، وذلك مثلاً كعالم طبيب أو مهندس أو خطيب أو أي شيء آخر، لكنه لا يعرف حقوقه القانونية كمواطن، ولا يعرف حقوقه الاقتصادية، أن له حرية التجارة وحرية البناء وحرية تشييد المصانع والمعامل وحرية السفر وحرية الإقامة وغير ذلك حسب القانوني الإسلامي[16]، وبدون هذه القيود المتداولة الآن في الدول المعاصرة حتى الديمقراطية منها، كما أشرنا له في بحث سابق، وسنشير له إن شاء الله في بحث مخصص لذلك لاحقاً بإذنه تعالى.
وهناك أمية سياسية، وهي أخطر من الأمية الصناعية، إن الحكومات لا تستطيع أن تتحكم في رقاب الناس، وأن تستبد بالأمور إلا لو كان هناك جهل سياسي، والذي يعني عدم معرفة الإنسان بحقوقه السياسية وبمسائل السياسة والحكم، بمسألة التعددية السياسية مثلاً، وضرورة التداول السلمي للسلطة، كل أربع سنوات مثلاً، وضرورة التغيير من القيادة إلى القاعدة، من الكبير إلى الصغير.
والأمية السياسية تعني أن لا يعرف ذلك ونظائره، أو يعرفها معرفة سطحية هامشية فقط، أو يعرفها معرفة عميقة لكنه لا يبالي بها، ولا يهتم بها، إنها كلها من (الأمية السياسية).
وهناك أمية حقوقية، والتي تعني جهل الناس بحقوقهم في مختلف الحقول، ومنه حق السجين مثلاً، فإن كثيراً من سجناء الرأي والسياسيين لا يعرف حقوقه كسجين بل وغيرهم، بل قد لا يعرف أن الدولة ليس لها الحق أن تعتقله بهذه التهمة، والتي ليست إنسانية وليست شرعية، وما أكثر أمثال هذه التهم.
وإليكم المثال التالي في هذا الحقل وهو مثال هام في الدَين، من واقع الدول الشرقية والغربية، المسيحية والإسلامية، الديمقراطية والدكتاتورية، فإنها جميعاً تسجن المدين، بينما في الإسلام لا يسجن المعسر في الدَين.
فلو كان أحد مديناً، ولا يستطيع أن يؤدي الدين، فليس من حق الدولة أن تسجنه، ومع قطع النظر عن الشرع وحكمه بعدم السجن فيما إذا كان معسراً، نقول: ذلك مخالف للعقل أيضاً، إذ أن سجن المدين فكيف يدبّر المبلغ؟.
ثم إن الدولة قد صادرت حق المدين في الحياة الكريمة وصادرت حريته، ولو ترك طليقاً فإنه سيكون أقدر على سداد المبلغ، وإن لم يقدر فيقع السداد على عاتق بيت المال في الإسلام، وعلى الدولة من وارداتها من الثروات الطبيعية أو من الضرائب.
والمؤسف أن الناس عادة لا تعرف هذا الحق، وأنه لا يجوز سجن الإنسان المدين غير القادر على أداء الدين، ولعل بالعالم الآن ملايين من الناس في الشرق والغرب، قد سجنوا لأجل هذا الأمر الباطل وأشباهه.
إذن المسألة الأولى والأساسية أن نعرف أنواع الجهل، وأن أسوأ أنواع الجهل هو الجهل السياسي والجهل الحقوقي، أي الجهل بالحقوق النظرية والعملية للإنسان، وهذا الجهل إذا ارتفع فعندئذٍ ستسير البلاد على الجادة المستقيمة، وستكون الحكومة صالحة، والاستشارية هي الحاكمة، والحريات والحقوق مصونة ومحفوظة ومكفولة، وعندئذ نجد المسلمين وهم ينطلقون اقتصادياً وصناعياً، في الفضاء وفي البحار وفي غير ذلك، ويتقدمون على الدول المتقدمة إلى ما شاء الله تعالى.
من سبل مكافحة الجهل
وبعد ذلك ننطلق للإجابة على سؤال: كيف نستطيع أن نكافح الجهل السياسي، أو الأمية السياسية، والجهل الحقوقي، وكذلك الجهل الاقتصادي؟.
وهذا الجانب ينبغي أن نبحثه ونركز عليه، وأن تعقد لأجله ألوف المؤتمرات والندوات، وعشرات الألوف من الجلسات على مختلف المستويات في شرق البلاد الإسلامية وغربها، كما يجب أن تؤسس مراكز دراسات متخصصة في دراسة سبل مكافحة الجهل، وأن تؤسس مواقع بالشبكة العنكبوتية خاصة بذلك، وأن يتداول الخطباء والكتاب هذا البحث بالدراسة والبحث والتذكير والإشارة.
وبعبارة شاملة: لابد من الاستنهاض الشامل في هذا الحقل، ولابد أن يعرف كل إنسان ـ ذكراً أم أنثى، عالماً أو مثقفاً أو طبيباً أو محامياً أو مزارعاً أو بقالاً أو غير ذلك ـ أنه مسئول شرعاً كواجب كفائي، إذ لم يقم به من فيه الكفاية، فعلى الجميع أن يتكلم وأن يربي أولاده وأقربائه على هذا الحق، وعلى هذا النوع من العلم والرشد الفكري، [وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ][17]، و[إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ][18].
فلو أن كل إنسان كتب في الشبكة العنكبوتية، أو في الجرائد وفي المجلات، أو ربّى أولاده على هذه الحقوق، فإن الوضع سيختلف كثيراً.
والمشكلة أن كثيراً من الناس يعرف الكثير من الحقائق، لكنه لا يربّي أولاده عليها، بل تراه في وادٍ وأولاده في وادٍ آخر، وترى المعلم لا يقول للتلاميذ، أو لا يكتب أو لا يخطب أو ما أشبه ذلك.
وأكرر: إن السبيل الأساسي لمكافحة الأمية، وبالذات الأمية الحقوقية والجهل السياسي الاقتصادي وما أشبه ذلك، هو (الاستنهاض العام الشمولي)، و(تأسيس المؤسسات الحاضنة) لذلك كله.
ويعني أن نعمل جميعاً بقوله (صلى الله عليه وآله): (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)[19]، وأن يكتب كل إنسان في هذا الحقل، ويخطب كل إنسان، ويربي كل إنسان غيره على هذه الحقوق الأولية البديهية العقلية والفطرية الإنسانية.
السؤال: هل للإسلام منهج في مكافحة الفقر؟ وما هو؟.
الجواب:
السؤال المطروح عن الفقر الذي يفتك بالنفس والقلب والعقل، هو سؤال مهم وحيوي، ونحن نرى أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه) كما تفرد في كلامه عن التوحيد بأبعاده الكونية والمعرفية والأخلاقية، تفرد (صلوات الله وسلامه عليه) في حديثه عن مدى خطورة الفقر ولزوم مكافحته والقضاء عليه الفقر، حتى قال: (كاد الفقر أن يكون كفراً)[20]، و(لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته)[21]، و(الفقر سواد الوجه في الدارين)[22].
والفقر داء عضال ابتليت به الأمم، في كل الدول الشرقية والغربية، وحتى في أكثر الدول تطوراً الآن وتقدماً اقتصادياً، نجد أن نسبة الفقر فيها كبيرة، إحدى هذه الدول أمريكا.
فحسب إحصاء الدولة نفسها، هنالك أربعون مليون فقيراً في أمريكا، ربما يكون العدد أكبر من ذلك، وهو رقم غريب، مع وفرة الثروات في ذلك البلد، فما بالك بالدول النامية والمتخلفة؟.
فالفقر معضلة عالمية إنسانية، وهي أزمة خانقة وكابتة ومؤلمة، والعلم الحديث لم يجد لها حلاً وافياً، لكن الحل موجود في الإسلام، وقد كتبت سابقاً دراسة[23]، حول بعض الحلول التي أشير إليها في القرآن الكريم، والتي أرسى دعائمها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وذكرها الأئمة الأطهار (عليهم السلام) لمشكلة الفقر.
كما أن العديد من علمائنا، خاصة السيد الوالد (رحمة الله عليه) قد كتب حول هذا الحقل كتباً أو ضمّن هذا البحث في بعض كتبه، مثل موسوعة "الفقه: ج107-108 الاقتصاد" حيث ذكر العديد من السبل لمكافحة الفقر في الإسلام، وإذا راجع الإنسان الأحاديث النبوية والعلوية، والأحاديث الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام)، يجد المئات من الأحاديث التي تتحدث حول هذا الحقل، وتضع وتبين السبل لمكافحة الفقر.
الحل في: الأرض لله ولمن عَمَرَها
ولنشر ها هنا إلى واحد من تلكم الأحاديث، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الأرض لله ولمن عَمَرَها)[24]، ومن قبل قال الله جل جلاله: [خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا][25]، وهذا المبدأ أو الحل يعد من أهم الوسائل والسبل وأنجحها لمكافحة الفقر في أي بلد كان من دول العالم.
وهو: إطلاق حريات الناس في امتلاك ما خلقه الله ووهبه لهم، إنها معادلة بسيطة جداً وفاعلة حقاً، إن الله سبحانه وتعالى خلق عبيده وعباده من جهة، وخلق أراض وثروات ومعادن وغير ذلك من جهة أخرى، وجعل هذه كلها لأولئك كلهم.
ولعمري إن هذا هو أسهل السبل، وأكثر الطرق فعالية ونفوذاً في مكافحة الفقر، وهو طريق سهل وواقعي جداً، وما على الدولة إلا أن تتخلى عن عنجهيتها وكبريائها، وعن استبدادها واحتكارها للثروة، وعن منع عباد الله عن امتلاك ما منحهم الله.
والغريب أن الدول التي تمارس الديمقراطية السياسية حسب ادعائها، نجدها لا تمارس الديمقراطية أبداً فيما يتعلق بالثروات، بل هي استبدادية تماماً.
إن هذه المعادن وهذه الأراضي كلها لعباد الله، ولو أطلقنا للناس حرياتهم، فإن كل واحد سيبني ما يحتاجه من الأرض أو يزرع أو يربي قطيع ماشية أو يصنع مصانع ومعامل أو غير ذلك، من دون أن يحتاج المرء إلى إجازة من الدولة أو رخصة، ولا يحتاج إلى استئذان، ولا يحتاج إلى كتابنا وكتابكم، وبدون ضريبة، وبدون ألف شرط وألف قيد، وبدون أن يتكبل وتتقيد يداه بـالبيروقراطية في هذا الحقل.
أ فليس مال الله لعباد الله؟!.
فلِمَ تحول الدولة بينهم وبين أموالهم؟!.
ومن الذي خوّلها ذلك؟!.
وبالتأكيد سيتقلص الفقر فجأة، وخلال فترة قياسية جداً بنسبة أربعين إلى سبعين بالمائة[26]، ولا يحتاج الأمر إلى تحشيد خمسمائة عالم اقتصادي، ليضعوا مناهج صعبة معقدة، لا تزيد الأمر إلا إعضالاً.
إذ أنكم تشاهدون هذه الدول الكبرى التي تمتلك من علماء الاقتصاد إلى ما شاء الله، لكن مناهجهم لم تنفع في اقتلاع الفقر أبداً، لماذا؟!.
لأنها لا تطابق الفطرة، ولا تساير الهندسة التي بنى الله سبحانه الكون عليها.
إن الله سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً بديهياً فطرياً، وهم لا يستطيعون ولو كانوا صادقين في نواياهم أن يقضوا على الفقر، من غير الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى.
دعوة الحكومات لإطلاق الحريات
وإننا ندعو ـ الآن ـ جميع الحكومات التي تحكم باسم الإسلام، وغيرها من الدول، وكذا الدول الغربية، أن يطلقوا الحريات للناس في هذا الحقل (حقل الأراضي والثروات)، لأي امرئ أراد أن يبني بيتاً أو يصنع معملاً أو متجراً أو غير ذلك.
ودرءاً للفوضى والاستغلال السيئ من قبل البعض، ستقع على الدولة مسئولية (الإشراف)، وتيسير الأمور فحسب. وبإمكان الدولة أن تفوض مسئولية الإشراف والتنظيم لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك هو الأفضل كي تشرف على حسن التخطيط، وعلى عدم ظلم البعض للبعض الآخر، وعدم إضرار بعضهم في حق البعض، وتجنب الفوضى.
ومن غريب الأمر، أن الدول عادة تتخذ (من الفوضى المزعومة) ذريعة للاستيلاء على كل شيء، وما هو إلا زعم باطل، فليتركوا الناس يبنون، ومؤسسات المجتمع المدني تشرف، ولا مجال للتخوف من حدوث الفوضى آنذاك.
أوليس الدول تقول: إن السوق يقوم بعملية تصحيح ذاتية للأسعار! كذلك هنا نقول: الناس يقومون بعملية تصحيح ذاتية للفوضى في البناء هذا أولاً.
ثانياً: إن بعض مصاديق الفوضى لا مانع منها عقلاً أو شرعاً. نعم، الفوضى الضارة بالمجتمع والخطرة، هي الممنوعة فحسب.
وثالثاً: إن (الفوضى) دليل مبائن مع المدعى، إذ كيف تحتج الدولة بالفوضى لكي تدعي أنها هي المالكة للأراضي! وكيف تحتج بها لتفرض الضريبة على تملك الأرض أو العقار أو البناء!.
ورابعاً: إن (الفوضى) دليل أخص من المدعى، إذ كيف تحتج الدولة بها لإلزام الناس حتى ببناء بيوتهم بطريقة جمالية معينة تروق للدولة لا غير!.
وخامساً: إن الفوضى يمكن السيطرة عليها عبر مؤسسات المجتمع المدني النابعة من الناس أنفسهم، أي: عبر جهات شعبية وشركات ومؤسسات أهلية من مؤسسات المجتمع المدني، أو عبر مختار المحلة أو عبر شورى المحلة أو عبر وجهائها أو عبر علمائها أو غير ذلك، وبالتعاون مع الناس، والأمر محلول عندئذٍ دون شك.
وسادساً: لو تنازلنا وتنزلنا، نقول: إن على الدولة أن تشرف لحسن التخطيط، ولكي لا يصادر أحد حق شخص آخر، كأن يأخذ التاجر مثلاً عشرين مليون متر مربع، مما يحرم عامة الناس من الحصول حتى على ألف متر أو مأتي متر مثلاً لبناء سكن عليها أو متجر أو غير ذلك، فلا حق للتاجر إذا أضاع حق الآخرين، بل له ذلك في حدود حقه وحاجته فقط.
إن الحل الإسلامي واقعي وسهل وبسيط، ولو عملت به (الهند) مثلاً، لما وجد فيها (عشرة ملايين إنسان) يولدون في الشوارع، ويتزوجون في الشوارع، ويموتون في الشوارع.
ولو عملت (مصر) بالحل الإسلامي، لما وجد فيها مليونا شخص يعيشون في المقابر، هنالك يولدون ويتزوجون ويموتون.
ولهذا البحث تفصيل نتركه لمظانه، ولوقت قادم إن شاء الله تعالى.


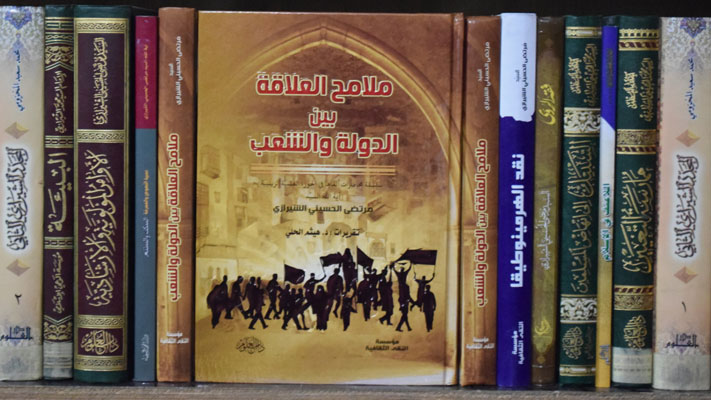

اضف تعليق