يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ][1].
المقدمة
تعد العلاقة بين الدولة والشعب، وبين الحاكم والمحكوم، من العناوين الحيوية المهمّة، ذات الأفق الإستراتيجي الخطير إلى أبعد الحدود، وقد تضمنت الآية الكريمة المذكورة، إضاءات عديدة وبصائر كثيرة، يجب البحث عنها والتدبر فيها؛ لاستكشاف الأطر القانونية الحقوقية الحاكمة على هذه العلاقة، والتي ترتكز إليها، ولاستبيان مصادر الشرعية للسلطة والحكم والدولة.
غاية الدراسة وأهدافها
إنّ الغاية من الدراسة وأهدافها، هي إلقاء الضوء على طبيعة العلاقة بين الدولة والشعب، والشكل التكاملي الذي يجب أن يحكم هذه العلاقة، وإطارها القانوني الشرعي العام، وبيان مصادر شرعية السلطة أو الحكم والحكومة، مع الدراسة الموجزة لآليات تفعيلها، استرشاداً بالآية الشريفة.
المبحث الأول: بصائر قرآنية
الإضاءة الأولى: إضاءات في الأمر الإلهي بأداء الأمانة
في قول الله سبحانه وتعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ]، ملاحظة استخدام مادة الأمر، بشكلها المؤكّد والشديد، دون صيغته؛ وذلك لأن لمادة الأمر دلالتها الآكد على المطلوبية وعلى الطلب، وذلك كقول أحدهم لابنه: "آمرك بأن تذهب إلى المدرسة"، أو "آمرك بأن تسدد ديون الناس عليك"، إلا أن هذه الدلالة تكون بشكل أضعف، فيما لو قال له: "اذهب إلى المدرسة"، وما إلى ذلك.
ولقد كان من الممكن، أن يقول الله سبحانه وتعالى: "أَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، إلا أنه قال: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ].
والحاصل أن مادة الأمر، لو استخدمت لدلّت على الأهمية القصوى، أو الأهمية البالغة أو الشديدة للمطلوب، والضرورة الحتمية أو الوجوب الأكيد، لانبعاث المأمورِ نحو المأمورَ به.
إضافة إلى ذلك نجد أن الله سبحان وتعالى، ابتدأ الآية الكريمة، بـ [إِنَّ] التوكيدية، فقال جل اسمه: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ]، وكان من الممكن أن يقول: "آْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، لكنّ [إِنَّ]، تؤكد المضمون والمدلول، والجملة والكلام أكثر فأكثر.
الإضاءة الثانية:
إن المستظهر هو أن الخطاب في [يَأْمُرُكُمْ] عام للجميع، على عكس ما توهّمه البعض، من أن الخطاب خاص بالحكام فقط، مما سيأتي توضيحه والتفصيل فيه.
إنّ هذا الخطاب موجه للحكام وللمحكومين، للتجار ولرجال الدين ولغيرهم، للجامعيين ولعامة الناس، للأستاذ وللتلميذ؛ وذلك لأنّ الضمير في [يَأْمُرُكُمْ] عام للجميع.
وعليه فالخطاب عام للجميع، فرئيس الدولة أو رئيس الوزراء، مكلف بأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، ولأنّ الحكم أمانة، والسلطة أمانة بعنقه، فعليه أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، وكذلك رئيس مجلس النواب أو مجلس الشعب أو الشورى أو البرلمان.
وكذا الحال بالنسبة إلى مدير المدرسة، فإنّ الطلبة والتلاميذ، أمانة بيديه، فالأب يقول لمدير المدرسة ـ بلسان الحال: "ائتمنتك على ابني". وكذلك الأب مؤتمن على أولاده، وشيخ العشيرة مؤتمن على عشيرته، ورئيس الحزب مؤتمن على أفراد حزبه، والخطاب أيضاً عام للوزراء، ولرؤساء النقابات، والاتحادات، وهكذا.
والجامع: إنّ كلّ إنسان عليه أن يؤدي الأمانة المؤتمن عليها، وعليه أن يفي للأمانة بحقها، فهذه الآية يستفاد منها معنى شامل للجميع، فلا هي خاصة بالحكام، ولا هي بمنأى عن الحكام أيضاً، وهما رأيان مقابلان لما نقوله.
الإضاءة الثالثة:
هي في استخدام الفعل بصيغة المضارع؛ إذ كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِأَدَاءِ الأَمَانَةِ"، بمعنى أن يستخدم المصدر، لكنّه جل وعلا استخدم فعل المضارع المصدّر بأن المصدرية، [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا].
إنّ اللفتة أو النكتة الدقيقة في هذه الكلمة، هي أن الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، ويفيد الديمومة، فتارة نقول: "زيد أبغض عمراً"، فهذا فعل ماض، والفعل الماضي لا يدل على الاستمرار.
وعليه لا يدل هذا المثال على أنّ الحالة النفسية للفعل مستمرة، ولكن لو قال أحدهم: "إن زيداً يبغض عمراً"، فيبغض بصيغة المضارع، تدل على الاستمرارية في الحالة النفسية.
كما أن الفعل الآخر في الآية الشريفة ورد أيضاً بصيغة المضارع[2]، وكان من الممكن أن يقول سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ"، وذلك وإن كان سيفيد بالمآل نفس النتيجة؛ لأنه أمر الله سبحانه، وهو أمر نافذ على امتداد الأزمنة، لكن الفعل المضارع لدلالته على التجدد والحدوث، هو أبلغ في تأكيد الدلالة على المطلوب.
الإضاءة الرابعة: العموم والاستغراق في مفهوم الأمانة
تدور حول كلمة الأمانات، وهي مما ينبغي التوقف عندها لبيان المعنى المراد من الأمانة والأمانات، ذلك أنّ [الأَمَانَاتِ] في الآية الشريفة، جمع محلى بأل "الألف واللام".
فالأمانات تفيد على هذا العموم والاستغراق، وتفيد مختلف أنواع الأمانة، وشتى أصنافها، وكافة أفراد الأمانة، فإن الأمانة قد تكون أمانة مادية، كما لو سلّم أحدهم لآخر مالاً، فعلى المؤتمن أن يؤديه له، عندما يحين حينه أو وقته.
وقد تكون الأمانة معنوية، كما لو أنّ أباً سلّم ابنه لشخص أو لصديق، فترة سفره، فعلى المؤتمن رعاية هذه الأمانة، وكذلك المدير أو المعلم، فهو يستلم التلاميذ أمانة، وعليه رعاية الأمانة، حق رعايتها.
وكذا السلطة بيد الحاكم، فإنها أمانة في عنقه، والأمانة ها هنا، هي أعم من الأمانة المادية، ومن الأمانة المعنوية الشخصية؛ لأنها أمانة أمّة أو شعب ـ بكل ما تتضمنه من أبعاد مادية ومعنوية ـ وقد سلّمت هذه الأمانة بأيدي حاكم، أو حكومة، أو هيئة حاكمة، أو برلمان، أو ما أشبه ذلك.
وعليه فإن الأمانة لها عرض عريض، ولا شك في دلالة الصدق العرفي.
أمانة الحكم والسلطة في الأدلّة النقلية
ويمكن الاستدلال بالروايات الشريفة، على أن الأمانة تطلق على (الحكم) أيضاً، وهي كثيرة وقد عبّرت عن السلطة بالأمانة.
ففي بعض الروايات يقول أمير المؤمنين (عليه صلوات المصلين) في رسالة له لأحد ولاته ـ وردت في نهج البلاغة ـ (وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ، وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ)[3].
بمعنى أن عملك وحكومتك، أو ولايتك ورئاستك، ليس لك أن تستأثر بها، فتأكل أموال المسلمين، وتعتبرها طعمة من حقك، ولقمة سائغة لك.
وكقوله (سلام الله عليه): (يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ)[4]، فليس لك أن تستطعم منه، وتخزن الذخائر والكنوز، وتبني القصور، ولكن هذا العمل ـ وهو الولاية والرئاسة والإدارة للعباد والبلاد ـ في عنقك أمانة.
وفي رواية أخرى، وردت في "الكامل في التاريخ" لابن الأثير، يقول أمير المؤمنين (عليه صلوات المصلين): (أيّها الناس إنّ أمركم هذا ليس لأحد فيه حق، إلّا من أمّرتم، وإنّه ليس لي دونكم، إلّا مفاتيح ما لكم معي)[5]. بمعنى أنّ من ينتخبه الناس، يكون له الحق[6] في الأمر والنهي، ولكنه ليس مالكاً لأموالهم، ولا له أن يتصرف فيها تصرف المالك كما يفعل سلاطين الجور؛ لأن ذلك خلاف إرادة الناس وتوليتهم.
وفي رواية أخرى، في نهج البلاغة أيضاً، يقول (عليه السلام): (فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ؛ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ)[7].
فهذه الرواية واضحة جداً، بوصفه الحكام بخزّان الرعية، والخازن (أمين)، وكذلك الوكيل (أمين)، وعلى الخازن أن لا يخون فيما خزنه، للأمة والناس، وعلى الوكيل أن لا يخون فيما وكّل فيه.
وأن العبارة الصريحة وهي (وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ)، تعني أنّ الوالي، هو وكيل الأمة، ولا يحق له أن يتأمّر فيهم بأهوائه وشهواته، وأن يستبد بالرأي، وأن ينكّل بهم، بالسجن والتعذيب، ويصادر الحقوق، ويسحق الكرامات، ويغتصب الأموال، فإنّ الوكيل لا يحق له أن يفعل مثل هذا مع موكله.
شمولية (الأمانات)
والحاصل: أن الأمانات في الآية الكريمة جمع محلّى بالألف واللام، فتفيد العموم، وتشمل أمانة الحكم والحكومة، كما تشمل أمانة أي تجمع من التجمعات، أو شركة من الشركات، أو حتى حسينية أو مسجد أو مكتبة، أؤتمن عليها الإنسان، بصفته مدير المكتبة أو المدرسة أو الحسينية أو الحوزة العلمية أو الجامعة أو غير ذلك، فهذه كلها أمانات، على المؤتمن أن يلتزم بأداء حقها.
فمن غير الصحيح إذن ما تصوره البعض من أن الأمانة لا تشمل الحكومة؛ لأن الحكومة أمانة بعنق الحاكم، بدلالة الروايات المذكورة وغيرها، وبدلالة الصدق العرفي، دون شك ودون لبس.
ولقرينة سياق الآية الشريفة أيضاً، [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ]، فالخطاب إلى نفس الجماعة، مما يستفاد منه أو يستشعر منه بقرينة السياق، بأنّ الأمانات تشمل: أمر الحكومة، والحكم، والسلطة، والسلطان، فتأمل.
ثم إن هذا الرأي المتطرف من هذا الجانب، بقوله: إن الأمانات لا تشمل الحكومة، يقابله الرأي المتطرف من الجانب الآخر، بقوله: إن الأمانات خاصة بالحكومة، وأن الأمر الوارد في الآية، هو خطاب للحكام فقط، وأن الأمانات المراد بها أمانة الحكم والحكومة والسلطة والسلطان، ودليله على ذلك بقية الآية [وَإِذَا حَكَمْتُمْ]، مما يعني أن الآية تتحدث عن الحكومة.
وهذا الاستظهار قد ذكره بعض الأصوليين والمفسرين، وإذا ارتأى هؤلاء أن الخطاب في قوله سبحانه: [يَأْمُرُكُمْ]، موجه إلى الحكام حصراً، بقرينة قوله: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ]، وهذه قرينة على أن الأمانة المذكورة هي الحكومة.
ولكن الظاهر أن هذا الاستظهار غير تام، وقد اتضحت بعض جوانبه.
أدلة على شمولية (الأمانات)
أولاً: إنّ الأمانات جمع محلى بالألف واللام، فهو يفيد العموم والاستغراق.
ثانياً: إنّ الأمانة تصدق عرفاً ولغة، على الأمانة المادية والمعنوية، وعلى الأمانة الفردية والنوعية.
ثالثاً: إنّ الروايات عندنا، تصرّح بالعموم، مع ملاحظة أن ّالسياق لا يقوى على معارضة الإطلاق أو العموم، وعلى ذلك مبنى الأصوليين؛ فإنّ السياق من أضعف الظهورات، لو كان له ظهور.
فإذا كانت هناك لفظة عامة أو مطلقة، فالسياق لا يستطيع أن يزحزحها، فكيف لو كانت هناك روايات في المقام! فهذا العطف يكون دليلاً على أن الحكومة من الأمانات، وليست الأمانات تنحصر بها، أي أن العطف هو عطف للخاص على العام.
ولنشِر الآن إلى الدليل الدال من الروايات على التعميم للحكومة وغيرها، لا على التخصيص بها، ففي تفسير الصافي الشريف، نقلاً عن مجمع البيان، عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام): (إن هذه الآية الشريفة، في كل من أؤتمن أمانة من الأمانات، وأمانات الله: أوامره ونواهيه، وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره)[8].
ويظهر من ذلك أن من الأمانات؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الإنسان أن يؤدي هذه الأمانة حقها، بمعنى أنه إذا رأى الشعب أن الحاكم قد طغى وتجبّر، فعليه أن ينهى عن المنكر، بالوسائل السلمية، عن طريق التظاهرات والإضرابات، والعصيان المدني السلمي، ومختلف الطرق المعروفة في الاحتجاج السلمي.
وهكذا نجد أن الإمام (سلام الله عليه)، يصرح بأنّ (أمانات الله) هي: أوامره ونواهيه، وأمانات عباده.
ولا ريب أن الحاكم قد أؤتمن على حقوق الناس، فإن كلّ حقوق الناس بذمته، وعليه أن يؤديها. ومن الأمانات التي بعنقه، العدل والإحسان، اللذين أمر بهما الله سبحانه وتعالى.
وأداء هذه الأمانة حقها، هو بأن يعدل في الرعية، وأن يحسن فيهم، والإمام بعد ذلك يقول: (وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره).
فعبارة الإمام نص في العموم من المال وغير المال، وعلى أي تقدير فالأمانة ليست خاصة بالمال.
نعم، ورد في الكافي الشريف عدة روايات أن الخطاب للأئمة (عليهم السلام): (أمر كل منهم أن يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه، ثم هي جارية في سائر الأمانات)[9].
ولا تنافي بين هذه الرواية وروايات التعميم، بل هذه الرواية تصرح بالتعميم أيضاً. نعم، هي تزيد على روايات التعميم بأنها تصرح بشأن النزول، وبذكر أهم الأمانات على الإطلاق.
ومن الإشارات اللطيفة في الآية الشريفة، أنّ الأمر فيها إلهي، صريح لمن يحكم بين الناس، فلا فرق فيه بين أن يكون ملكاً أو رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، وزيراً أو نائباً في البرلمان، أو رئيس حزب اتحاد أو نقابة، أو رئيس مؤسسة أو شركة، وحتى الأب والأم والمعلم، أم غير ذلك.
فكلهم مأمور إذا حكم في حقوق هؤلاء الذين استرعي أمرهم، أن يؤديها على أفضل الوجوه؛ وذلك لأن الآية الشريفة عامة شاملة.
ساوِ بين الخصمين في لحظك ولفظك
وفي رواية لطيفة، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) مخاطباً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه صلوات المصلين): (سوِ بين الخصمين في لحظك ولفظك)[10].
حيث عدَّ من آداب القضاء في الفقه الإسلامي، إذا حضر الخصمان عند القاضي، أن يراعي بينهما المساواة والعدالة حتى بنظراته، بأن تكون نظراته إلى كليهما متساوية؛ كي لا يحسّ أحدهم بالاستئساد والعظمة، لو آثره بنظراته على خصمه.
فيتبجح ويأخذه ذلك مأخذ الباطل، وكي لا يتخوف الآخر، ويحرج فيتلجلج بحجته، فالرسول (صلى الله عليه وآله) ينبّه إلى ذلك لإقامة العدل، وبهذه الدرجة من الدقة في العدل الإلهي.
غير أن الحال في بلادنا الإسلامية هو خلاف ذلك، إذ أن الحاكم لا يساوي حتى بين وزرائه، ومن جهة أخرى لا يتمكن عامة الناس من رفع ظلاماتهم إليه، إذا واجهت الفرد الواحد منهم مشكلة.
فمن الصعب بل من غير المقدور عليه عادة إيصال الظلامة إلى المسئول أو الحاكم أو الرئيس، فكيف إذا كان الخصم قوياً متنفذاً، كما هو الحال في الشركات التي يملكها الحكام أو أقربائهم ومحسوبوهم، أو تلك التي لهم فيها يد طولى ومساهمة كبرى؟!.
وقد كشفت الأحداث الأخيرة، أثناء الانتفاضات التي عمّت بعض الدول العربية[11]، جوانب من ذلك.
حيث اغتصب الحاكم المليارات من أموال الشعب، أو قد صادرها وتصرف فيها، وألقى بكل معارض في السجن أو ضيق عليه بأنواع شتى، وبحسب تعبير الإمام (سلام الله عليه): (يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ)[12].
وهكذا نجد في بلادنا لا يستطيع آحاد الناس أن يرفعوا شكوى ضد رئيس الدولة أو من هو بمقامه، أو على رئيس الهيئة القضائية. ولو رفعوا لما ساوى القاضي بين صاحب الظلامة، وبين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أمام المنصة، على عكس مما كان شاخصاً في عهد أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب (عليه صلوات المصلين).
حيث حضر أكثر من مرة مع خصمه ـ وهو الرئيس الأعلى لأكبر دولة وأقوى دولة في عالم ذاك اليوم، وهو "الإمبراطور" بمنطق العصر ـ عند القاضي[13].
وقد نقل لنا التاريخ، أنّ الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) عندما كان صبياً صغير السن، احتكم عنده صبيان، وقد كتب كل منهما ورقة، فيها جملة أو مجموعة جمل، كمسابقة في جمال الخط وحسنه.
فأوصاه الإمام أمير المؤمنين (عليه صلوات المصلين)، أن يكون عادلاً في الحكم، حتى في هذه القضية، وقال له: (يا بني، انظر كيف تحكم؛ فإن هذا حكم، والله سائلك عنه يوم القيامة)[14].
مع أنّ الأمر لم يكن بالدرجة الكبيرة من الأهمية، لتعلقه بجمال الخط لا أكثر، لكنّ الله سبحانه وتعالى يحاسب يوم القيامة، على كل حكم مهما كان.
ومن مصاديق ذلك أنه لو كان لأحدهم طفلان، وهو يحب أحدهما أكثر من الآخر، فإنه ليس له الحق في أن يميّزه على الآخر، بل إن الله سبحانه وتعالى، سيحاسبه على ذلك يوم القيامة، لو ميّز بين ابنيه بغير الحق، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، [أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، وهذا هو المقياس.
الإضاءة الخامسة: تشريع حق الرقابة على الحكام
ومن البصائر الجميلة الأخرى في الآية الشريفة، أن هذا الكلام والأمر من الله سبحانه وتعالى، يدل بالدلالة الالتزامية العرفية، على تشريع حق رقابة الناس على الحاكم، وأنّ الدقة في الكلام القرآني الكريم، تكشف لنا ذلك بمعونة الفهم العرفي للآية الشريفة.
فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن يكون حكم الإنسان حكماً بالعدل، فإن للآخرين حق الرقابة على هذا الحاكم، وهذا الحق للناس، أي للذين أمر الله سبحانه وتعالى الحاكم بأن يعدل بينهم، حتى يستبينوا إن كان يعدل في حكمه، أو لا يعدل.
وبخلاف ذلك: إن أغمض الحاكم عيونهم بالقوة عن رقابته، أو أغمضوا هم أعينهم كسلاً أو جبناً، فلن يتمكنوا أن يطالبوا بحقهم.
والحاصل: إنه قد يقال بأن هذه الآية تدل بالدلالة العرفية على ذلك، بمعنى أن تشريع هذا، يستلزم تشريع ذلك، كما في آية النفر [وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ][15].
فتشريع هذا[16] يلزم منه تشريع لزوم الحذر، وإلا لزمت اللغوية ولو في الجملة. ومنه يفهم أن الله لو أمر أحدهم بأن ينذر الآخرين، فإن مما يلزمه أنّ على المنذَرين مطاوعة الإنذار وقبوله،
والأمر كذلك في الآية الشريفة: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ]، حيث يمكن القول بأن المستفاد منه عرفاً، الدلالة على لازمه، وهو تشريع حق الرقابة للناس على الحاكم، ليروا مدى التزامه بأداء الأمانات إلى أهلها.
وبعبارة أخرى: إنّ الشارع لو لم يشرع حق الناس في الرقابة على المؤتمن كي لا يفرط بحقهم، فإن ذلك يستلزم الإيقاع في الغرر وفي الضرر، و(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ)[17].
ولو قطع النظر عن هذه الدلالة الالتزامية العرفية، يمكننا أن نستدل على حق الرقابة للناس بهذا النحو من القول: إنه بمجرد توجه أمر من الله سبحانه بأداء الأمانة، وبالعدل في الحكم بين الناس، فإن أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشمل المقام فوراً.
وبعد ذلك لا حاجة إلى هذه الواسطة المذكورة والدلالة الالتزامية، وإن كانت عرفية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب بدون شك، والعدل كما أداء الأمانة معروفان، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهما.
هذا بالإضافة إلى أن العقل قد استقل بحسنهما ووجوبهما، فيجب الأمر بالمعروف ـ العدل وأداء الأمانة ـ ويجب النهي عن المنكر.
نعم، لابد من توسيط أنه بدون الرقابة لا يمكن ذلك، إذ لا يستطيع من يغمض عينيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ بات من الواضح أنّ للحاكم طرقاً كثيرة يخفي فيها ظلمه، وفساده عن الناس.
فهو قد يعتقل مجموعة من الناس ظلماً وعدواناً ويتمكن من إخفاء ذلك، فإذا لم يكن هناك حق الرقابة للناس عليه من قبل العلماء والعقلاء وغيرهم. فلا يستطيع أحد أن يقف أمام هذا المنكر، وأن يأمر بالمعروف، و[إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ]، بمعنى إنّها موعظة حسنة بل في غاية الحسن، إذا كان الإنسان يدرك ذلك.
المبحث الثاني: مصادر شرعية الحكم وفعلية السلطة
إن البحث في هذه الآية الشريفة، هو بحث مفتاحي وأساسي لعدة مباحث في الموضوع.
ومن هذه المباحث الرئيسة: تحديد (مصدر شرعية السلطة)، وشرعية الحكومة، وهل المصدر هو الله سبحانه وتعالى، أم المصدر هو الشعب، أم أنّ المصدر هو كلاهما طولياً كما هو الظاهر[18] أو بالتشريك كما قال به البعض؟، وسيأتي في مباحث قادمة.
ومن جهة أخرى يقع البحث أيضاً حول (مصدر فعلية السلطة)، إذ قد تكون السلطة فعلية لكن بلا شرعية، حيث تستند في فعليتها وتسلطها إلى الضغط المطلق، أو الاقتناع المطلق، أو المزيج منهما، أو بالإرادة الحرة المشتركة بين الطرفين عبر عقد اجتماعي أو غيره، أو غير ذلك.
وهذا ما سيأخذ بالبحث والتمحيص لاحقاً إن شاء الله تعالى، ولنبدأ بالمبحث الأول.
الأطر القانونية الستة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم
إن البحث في الإطار القانوني الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، والصيغة القانونية لهذه العلاقة، وبيان النسبة بين الحاكم وبين المحكوم من وجهة نظر حقوقية، يتطلب مناقشة احتمالات وخيارات متعددة ممكنة أو متحققة، سواء أفي الحكومات الحالية القائمة، وما هو شكلها وإطارها القانوني ولو النظري، أم في ما ينبغي أن تكون عليها الحكومات أي (الواقع) و(المطلوب).
بمعنى أن البحث قد يقع في استعراض الواقع الخارجي تارة، وقد يكون في ما يمكن أن يكون تارة أخرى، ومن ثم بيان الأفضل في كليهما.
الاحتمال الأول في علاقة الحاكم بالمحكوم: الوكالة
(الوكالة) بمعنى أن الحاكم وكيل عن الشعب، في (تمشية أموره)، بالتعبير العرفي، أي في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل، وفي النهوض بمصالح الشعب، وفي الحفاظ على استقلال واستقرار وازدهار البلاد، وفي توفير الحريات الفطرية والشرعية له، وفي توفير فرص الحياة الكريمة لآحاد الناس، وهذا يعني أن الصيغة القانونية في العلاقة، هي صيغة الوكالة.
الاحتمال الثاني: الإذن
أن تكون العلاقة هي علاقة (الإذن)، بمعنى أن الشعب قد أذن للحاكم بهذه السلسلة من التصرفات، من إبرام عهد دولي أو معاهدة، أو إقامة صلح، أو إعلان حرب، ومن غيرها، سواء أ في السياسة الداخلية أم الخارجية.
الاحتمال الثالث: الإجارة
هو أن العلاقة هي علاقة (الإجارة)، بمعنى أنّ الحاكم يكون أجيراً للشعب، لأربع أو لخمس سنوات، أو لأقل من ذلك أو أكثر، حسب آراء الناس وباتفاقهم، والحاكم يستوفي راتباً معيناً، بإزاء خدمات معينة، يقدمها للشعب.
الاحتمال الرابع: عقد جديد
في الصيغة القانونية لعلاقة الحاكم بالشعب، أن يكون (عقداً مستأنفاً)، فلا هو إجارة ولا هو وكالة، ولا هو إذن، ولا هو جعالة، وإنما هو عقد مستأنف، وهي صيغة أخرى يمكن الالتزام بها في بعض الصور.
الاحتمال الخامس: الولاية
في نوعية وماهية العلاقة بين الطرفين هو (العلاقة بالولاية)، بمعنى أن تكون علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة تسليط اعتباري ولائي، إما من مصدر خارجي مثل الشارع الأقدس، أو من مصدر داخلي، أي من المحكومين للحاكم عليهم، فالولاية هي ولاية اعتبارية للحاكم على المحكوم.
أما الوكالة، فلا يوجد للوكيل ولاية على الموكل، فلو جعله وكيلاً له لبيع داره، فليس للوكيل ولاية على مالك الدار، بل إنّ المالك هو صاحب الأمر وهو الحاكم وهو المتفوق على الوكيل، وبيده القرار والتأثير؛ لأنه قد منح الصلاحية للوكيل في حدود معينة، وله الحق في سحبها منه.
الاحتمال السادس: التفويض
التفويض، وهو الذي يركن البعض إليه، وبخاصة الطغاة من الحكام، حيث يدّعون تفويض الناس إليهم أمر الحكومة تفويضاً مطلقاً، فيمارس الحاكم المستبد سلطته، زاعماً تفويض الأمة إليه. فإن ادعى الحاكم مع ذلك أنه (ولي) على الأمة، كان مؤداه هو الاحتمال الخامس، وإلا كان هذا الاحتمال السادس[19].
غير أن بعض المستبدين من الحكام، لا يقف عند تفويض الشعب له بل يرى (الولاية المطلقة) له ـ أي الاحتمال الخامس ـ بل وقد يدعي منحه التفويض من مصدر أعلى وأسمى في منظوره وذلك كـ: الشمس، أو القمر، حيث تعتقد بذلك بعض الأمم المتخلفة.
وأحيانا يدعي الحاكم التفويض مباشرة من الله سبحانه وتعالى، فتكون لهذا الحاكم الولاية على الشعب مثل ما للمولى على العبد.
والآن لنسأل: إذا كانت (الولاية) بالتفويض أو التولية وكانت للناس، فهل لهم نزعها عن أنفسهم وتقليدها للحاكم؟.
سنجيب لاحقاً بتفصيل ونوجز هنا:
لا يجوز للناس القيام بذلك؛ صحيح أن الناس مسلّطون على أنفسهم، لكن سلطتهم على أنفسهم هذه لا تخولهم حق إلغاء سلطتهم على أنفسهم!
أي هي حق لازم مستحق للإنسان، وغير قابل للإسقاط عنه، فهو كـ (الحكم) من هذه الجهة، وأن الشارع لا يجيز للإنسان أن يتنازل عن حريته لغيره من البشر، مدعياً أنّه صاحب الولاية على نفسه، وأن له الحق في أن يهبها لغيره، فذلك لا يجوز له شرعاً.
ولكن الغريب جداً: إن الكثير من الشعوب تتعامل مع الحاكم، وفق هذه الصورة وهذا المنطق: تعامل العبد مع المولى، وهذا هو الذي يصنع الحكام الطغاة، ويوفر لهم أرضية الاستبداد، ومصادرة حقوق شعوبهم.
ولولا تعامل الناس مع الحاكم بهذه الطريقة، لما كان بمقدور الحاكم أن يطغى، كمثل فرعون ومن على شاكلته، من النماذج المعروفة.
دقّ الأسنان في جمجمة المظلوم
وإليكم الحادثة التالية المؤلمة من عمق التاريخ:
يذكر أن شاباً قد حضر متظلماً عند أحد ملوك إيران، وقد أوصل الشاب نفسه للملك بصعوبة بالغة، إذ أنّ الناس لا يتمكنون عادة من الوصول للرئيس أو الملك؛ لأنه يعتبر نفسه فوق الجميع، في الوقت الذي يجب أن يكون الملك خادماً لشعبه لا أكثر.
وعلى أية حال، وصل ذلك الشاب إلى الملك، وسرد له حكايته وظلامته، فما كان الملك الطاغية إلا أن استشاط غضباً من الشاب، كونه قد تجرّأ، ودخل عليه لمقابلته، ثم إنّه تجرأ واشتكى من أحد المقربين للملك، ومن أصحاب النفوذ في الدولة، ما يعد في عرفه جريمة لا تغتفر.
لذلك كله، أمر الملك الجلاد بمسك الشاب، وقلع أسنانه كلها، ثم دقّها واحداً بعد آخر على رأسه، باستخدام المطرقة الثقيلة.
وبعد قلع الأسنان ودقّها على رأسه، قضى الشاب بعد دقّ السن الثالث، ولكن الملك من شدة حقده وقسوته، أمر باستمرار تعذيب الشاب حتى بعد وفاته، وقد فعلوا ذلك بالجسد الميّت.
هذا القرار الهمجي وأشباهه، إنما هو من نتائج تسليط الناس للحاكم عليهم، وتخويلهم إياه الولاية عليهم، فيكون وليّ الأمر بقول مطلق، فيصبح هو المولى والناس هم العبيد.
وهذا الشاب لم يسئ للملك، لا في حضوره ولا بغيبته، بل أتاه متظلماً فقط، فكان التنكيل به قاسياً وحشياً.
لقد كان ذلك الملك يعتبر نفسه هو المالك للناس، وليس للشاب ولا لسائر الناس أن يخرجوا عليه، بل ولا أن يشتكوا من أحد عنده بل ولا أن يحاولوا التشرف بلقائه! لأنه الحاكم والمولى وهو ولي الأمر.
هو الآمر الناهي، هو ظلّ الله في الأرض، هكذا كان الملك يفكّر، وهكذا كان يتعامل مع الناس لكن العاقبة كانت: أنّ الله مزّق مُلكه شر ممزّق.
يقول الله سبحانه وتعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا].
المبحث الثالث
إجابات على أسئلة فقهية ذات علاقة بالموضوع[20]
السؤال: هل للسجين حقوق في الإسلام؟. وإذا كانت له حقوق فما هي حقوقه؟.
الجواب: إن حقوق السجين في الدين الإسلامي كثيرة، والسيد الوالد (قدس سره)[21]، ذكر للسجين أربعين حقاً من الحقوق، وهي حقوق واسعة، ومع الأسف فإن الدول المستبدة بل حتى الديمقراطية، لا تعمل بكثير من هذه الحقوق. أما الدول المستبدة فإنها تسحق كل أو أكثر هذه الحقوق، وأما الدول الديمقراطية فتسحق العديد منها.
لقد أشار السيد الوالد (قدس سره) في كتاب موسوعة "الفقه: ج100 الحقوق"، وفي كتاب "حقوق السجين في الإسلام" وغيرها من المؤلفات إلى بعض هذه الحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- حق العمل بحرية
إنّ من حقوق السجين هو: (حق العمل)، وإن من المآخذ الكبرى على الدول المستبدة، بل حتى الديمقراطية ـ إلى حد ما ـ أنه عندما يسجن السجين، فإنهم يحرمونه عن ممارسة أعماله التجارية والوظيفية بشكل اعتيادي، بل يمنعونه عن العمل، وفي هذا ضرر مضاعف؛ إذ إنهم بذلك يحطمون اقتصاد البلد بنفس النسبة التي يمنعون بها السجناء من العمل.
فهذا السجين إن كان تاجراً، أو كان عاملاً، أو معلماً، أو في أية مهنة أخرى، فعندما يسجنوه، فإنهم يحطمون تجارته أو وظيفته، فيضرّون به أكثر مما يستحق من العقوبة، وهو سجن بدنه فقط.
كما أنهم قد يضرّون باقتصاد البلد أيضاً، بحرمانه من أيادي عاملة كثيرة، ومن عقول وأفكار فعالة[22]، فالمفروض إذن أن يكون للسجين حق مزاولة أعماله.
وهذا يعني أن التاجر السجين يجب أن يسمح له، إما بأن يخرج من السجن ليتاجر في أوقات معينة، أو يسمح له ذلك وهو في السجن، عن طريق الطرق الحديثة للتواصل كالإنترنت وغيره، أو أن يأتي العملاء لديه والمتعاملون معه، ليدير تجارته كاملاً من داخل السجن أو خارجه.
وكذلك أستاذ الجامعة أو أستاذ الحوزة أو المعلم، لو ارتكب فرضاً ما استوجب سجنه، كأن ماطل في أداء دينه مع أنه قادر على الأداء، فيجب أن توفر لهم قاعات في السجن، إذا أراد الطلبة أن يقدموا إليه ويدرسوا عنده، أو يسمح له بأن يذهب للجامعة أو الجامع ليدرّس فيها ثم يعود للسجن، أو ما أشبه ذلك.
والدولة الإسلامية ملزمة بتهيئة الدراسات وإعداد التصاميم والمخططات الهندسية لبناء السجون بحيث تستوعب هذه الحقوق، وهذه الحقوق ليست مجرد اقتراحات، بل هي من صميم حقوق الإنسان ولو كان سجيناً.
إن على الدولة أن توفر للسجين، إمكانات ممارسة ومزاولة تجارته أو زراعته أو صنعته أو إدارة شركته أو تدريسه، إما بالذهاب إلى مكان عمله، وإما وهو في سجنه.
2- حق الالتقاء بأهله يومياً
ومن حقوق السجين، حق الالتقاء بأهله، فلا وجه لأن يحرموه من ذلك، كما أن أهل السجين لهم الحق أيضاً بأن يلتقوا به.
والغريب أن في الدول الديكتاتورية قد تمضي فترة سنة أو أكثر أحياناً، ولا يتمكن السجين فيها من مقابلة أهله، فيحرمون أهله من رؤيته، كما حرموه من رؤية أهله.
ومن حقوق السجين على الدولة، بأن تبني له الدولة في السجن غرف، بحيث إذا أراد أهله المبيت عنده أمكن ذلك لهم. فهذا حق واجب على الدولة بل يستحسن، بل قد يجب أن يسمحوا له بالخروج من السجن بين فترة وأخرى، كما كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكما في الروايات بأن يسمح له أيام الجمعة في ذلك[23].
والآن وبالنظر للتطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم يمكن معالجة الإشكالات التي ترد على هذه القضية.
إذ لعله يقال: إنه إذا سمح للسجين بالخروج للعمل، أو الذهاب إلى الجامعة، فإنه سيهرب.
فيقال: بأن التطور العلمي والتكنولوجي قد عالج هذه الحالة ووضع السبل الكفيلة بالقضاء عليها، ومن هذه السبل: وضع سوار في يده، ليعطي إشارة معينة، لو تجاوز المنطقة الجغرافية المحددة له أن لا يتجاوزها، وسيبث السوار إشارات لا سلكية للشرطة لو تجاوز المنطقة، فيتمكنون من ملاحقته، وهناك سبل علمية أخرى، وإن كان في الوازع النفسي كفاية، وهذا حديث مطول نتركه في محله.
ونوجز بكلمة أنه في الحكومة الإسلامية، لو طبقت قوانين الإسلام حقيقة، فإن نسبة هروب السجناء، حتى بدون هذه الطرق العلمية، تكون ضئيلة جداً.
هذا والجميل في الأمر أن مراعاة هذه الحقوق مما ستنفع الاقتصاد الوطني، مع قطع النظر عن الجانب الديني والإنساني والعاطفي والحق الشرعي والعقلائي.
فإننا لو درسنا المسألة اقتصادياً، لوجدنا أن السجين عندما يسجن وأهله محرومون منه، فإن ذلك سيحطّم أعصابهم، وسيضر بصحتهم، وستنهار عوائل كاملة أو تنجر إلى مستنقع الفساد، وسيتشرد الأولاد، وهم بناة المستقبل.
وكم هذا سيكلف الشعب والدولة من أموال في الجانب الصحي، وفي جانب الرعاية الصحية، وفي حقل مكافحة الجريمة؟ وكم سيكلف ذلك عوائل هؤلاء المساجين، وكم سيعانون من عقد نفسية؟.
ثم إن هذا السجين ـ فيما إذا لم تحفظ حقوقه ـ عندما يطلق سراحه، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة بوجه النظام الاجتماعي.
وبإطار أوسع نجد أن هذه الحقوق تعدّ من الحقوق العقلائية أيضاً، فلسنا كمتشرعة نقول ذلك. فإن (الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم)[24]، هي قاعدة عقلية عقلائية بقدر ما هي شرعية.
إن الحاكم والقاضي له أن يسجن المجرم الحقيقي ـ وليس المعارض والناقد والأحرار والمفكرين ـ بجسده فقط، ولا يحق له أن (يسجن حقوقه) أيضاً، وذلك ما يستدعي تفصيلاً أكثر في كتاب قادم إذا شاء الله تعالى.


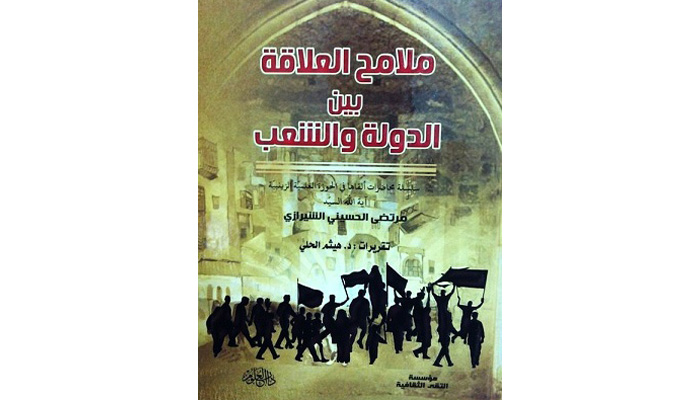

اضف تعليق