إنَّ اختزال النقد الثقافي في تتبع الأنساق من دون الانتباه إلى تعدد الطبقات النفسيّة والبلاغيّة التي يصدر عنها النص، يجعل كثيرًا من أحكامه أقرب إلى التعميمات الأيديولوجية منها إلى القراءات المتأنية. وربما آن الأوان لإعادة النظر في مثل هذه المناهج بوصفها مقاربات قابلة للنقد لا حقائق نهائيَّة...
يبدو أن منهجيَّة "النقد الثقافي" التي اتسمت بها كتابات الدكتور عبد الله الغذامي، والتي كرّست حفرياتها في الكشف عن النسق الفحولي في القصيدة العربيَّة، كانت - بإرادة أو من دون إرادة- تنطوي على نسق فحولي مضمر يسعى من خلال تلك الحفريات ليس إلى سلب أدوات القصيدة، بل إلى إبراز فحولة الناقد الذي يسعى إلى تهشيم شعريَّة الإبداع من أجل فردانيَّة وصمديَّة القارئ "الناقد".
فالغذامي لم يتوانَ عن التأويل الانتقائي أو المؤدلج لمقولات الشعراء في سبيل تثبيت فرضياته القَبْليَّة؛ فهو يفرغ الشعر العربي من كل منتج نسائي، ولأنّه لا يستطيع تجاوز الخنساء فقد أضفى عليها سمة الفحولة، مع أنَّ شعر الخنساء كُرّس في معظمه -إن لم يكن كله- في الرثاء والنواح على أخيها صخر، وهو في جوهره يخلو من النسق الفحولي الذي يبحث عنه الغذامي؛ إذ إنّ ثيمة الرثاء تستند إلى الانكسار والضعف، "كما يُسْتخلص من كلامه هو" بنقيض مقومات الفحولة التي تستعرض القوة والتسلّط. إذ نجده في سياق آخر يبرر امتناع الفرزدق عن رثاء زوجته بنسقيّة الفحولة المهيمنة على ذات الشاعر، متناسيًا السياقات الفرديّة والنفسيّة المعقدة وراء هذا الامتناع.
والواقع أنّ هذا الحصر التعسّفي للشواعر العربيّات بالخنساء ونازك، وإهمال العديد من الأسماء التي سبقت تجربة نازك على أقل تقدير، هو ليس مثيرًا للتعجب فحسب، بل هو دليل على التدعيم التعسّفي لفرضيته.
وفي ذات المسعى التأويلي المؤدلج يبني الغذامي فرضية النسق الفحولي على بيت أبي النجم العجلي: (إنّي وكلُّ شاعرٍ من البَشَرْ/ شيطانُهُ أنثى وشيطاني ذَكَرْ). مؤسِسًا استنتاجه النسقي على بيت لاحق لأحمد شوقي: (جذبت ثوبي العصي وقالت/ أنتم الناس أيها الشعراء).
وهنا كما هو واضح تأسيس بناء الفرضية على اللاحق لا السابق، في مخالفة صريحة للمنطق التأسيسي، كما أن تعميم قول أبي النجم -الذي قصد به تمييز نفسه لا وصف عموم الشعراء- فيه تعسف واضح. فبيته يتضمن، في عمقه، تأنيثًا للآخرين وتذكيرًا للذات، وهو نسق خاص لا عام.
وإذا كان لنا أن نتفق مع الغذامي في وجود نسق فحولي ضمن بنية الشعر العربي -مع التحفّظ على حصريَّة ذلك - فلا بدَّ من الوقوف عند تعريف هذه الفحولة: هل هي فحولة بيولوجية مرتبطة بالذكورة؟ أم هي تفوق فني يُقاس بالإجادة والتأثير؟
لقد أوضحت معاجم اللغة أنَّ الفحولة لا تنحصر في معناها الجنسي، بل تشمل القوة والتميّز، فـ"فحول الشعراء" هم المبرزون والمتفوقون، و"استفحل الأمر" أي استقوى. ومن ثم، فإنّ هذه الفحولة قد تكون -في السياق الأدبي- صفة غير جنسانيَّة، بل جماليَّة، تصف قدرة الشاعر على الغلبة الفنيَّة، بصرف النظر عن جنسه. وهو ما يجعل حديث الغذامي عن "الفحولة" بحاجة إلى تدقيق مفهومي: هل يعيب الشاعر أن يكون فحلًا إذا كانت الفحولة تعني الجودة؟ أم أن "النسق الفحولي" الذي يقصده هو هيمنة الخطاب الذكوري في المجتمع، لا مجرد تفوق الشاعر؟
هذا التفريق ضروري، لأن دمج الفحولة بالذكورة بيولوجيًا يعيد إنتاج التمييز الجندري الذي يفترض الغذامي أنه يقاومه، ويقود إلى إقصاء شعر النساء لا بسبب ضعف النص، بل للاختلاف الجنساني. وقد تجلّى ذلك بوضوح في موقفه من نازك الملائكة، فقد وصف الغذامي نازك بأنّها "أول صوت أنثوي يتمرّد على فحولة الشعر العربي.. من خلال كسر عمود الفحولة"، ولكن الفحولة التي يقصدها الغذامي هي ليست سوى الذكوريَّة. وهنا نلمس بوضوح مفارقة المنهج التأويلي الغذامي، فهو لا يقرأ تجربة نازك بوصفها مشروعًا شعريًا متكاملًا بحد ذاته، بل بوصفها "ردة فعل نسويّة" على مركزية الذكر، أي أنه يجعل من فعل الكتابة عند نازك تبعًا وليس تأسيسًا، وأجد من الضرورة الإشارة إلى أن الغذامي كان قبل ذلك نفى أولية كسر العمود من قبل "نازك والسياب"، في كتابه "الصوت القديم الجديد" وأرجع الأولية إلى شعراء آخرين.
بعبارة أخرى، فإنّ الغذامي -من حيث أراد تمجيد "القصيدة الأنثى" النازكيَّة- قد أسهم في تحجيمها تأويليًا، من خلال ربطها الدائم بما سبقها من "فحولة" شعريّة، لا بما أبدعته هي فعليًا من تحولات شكليّة وموضوعيّة.
إنَّ القراءة الغذامية في هذا الموضع تتعثر، لأنها تعاملت مع تجربة نازك بوصفها وظيفة ثقافية "أنثى تواجه فحولة" لا ذاتًا شعرية مستقلة، كما أنّه وفي نهجه الانتقائي عمد إلى تحويل وجهة مفردات محددة باتجاه تدعيم نسقه الثقافي، دون أن يلتفت إلى تفريغ خطاب نازك من شموليته، وتوجيهه نحو المسار الذي يرمي هو إليه. وهنا بالذات يكشف النقد الثقافي عن أحد مكامن ضعفه، حين يُغرق النصوص في أنساقها حتى تُختزل فيها، ولا يُبقي لها من تعددها الفني إلا ما يخدم فرضيته.
أما في موقفه من نزار قباني، فقد اعتبر الغذامي أن نزار -رغم مناداته بحرية المرأة- قد كرّس "أنثى المتعة" لا "أنثى الفاعلية"، وأن خطابه كان تجميلياً لا تحرريًا. غير أن هذا الطرح -وإن أصاب في بعض جوانبه- يغفل أن نزار نفسه كان في صراع دائم مع مفهوم الرجولة الشرقية، وأنه تعمّد الانقلاب على الفحولة القامعة عبر تقديم صور متعددة للأنوثة تتجاوز ثنائية التشيّؤ والتحرّر.
وأجد من المهم أن أشير إلى أن ملاحظاتنا التي دوناها هنا هي مجرد إشارات وجيزة، ولا تمثل صورة متكاملة للمآخذ التي يمكن تسجيلها على منهجية الغذامي في نقده الفحولي.
ولعل أبرز ما يحتاجه النقد الثقافي "الغذامي" هو أن يتخفف من فحولته هو، لا فحولة الشاعر أو النص الشعري، وأن يعيد ترتيب علاقته بالقصيدة بوصفها بنية معقدة، لا مجرد مرآة لأنساق السلطة (بمختلف أشكالها ومسمياتها).
إنَّ اختزال النقد الثقافي في تتبع الأنساق من دون الانتباه إلى تعدد الطبقات النفسيّة والبلاغيّة التي يصدر عنها النص، يجعل كثيرًا من أحكامه أقرب إلى التعميمات الأيديولوجية منها إلى القراءات المتأنية. وربما آن الأوان لإعادة النظر في مثل هذه المناهج بوصفها مقاربات قابلة للنقد لا حقائق نهائيَّة.


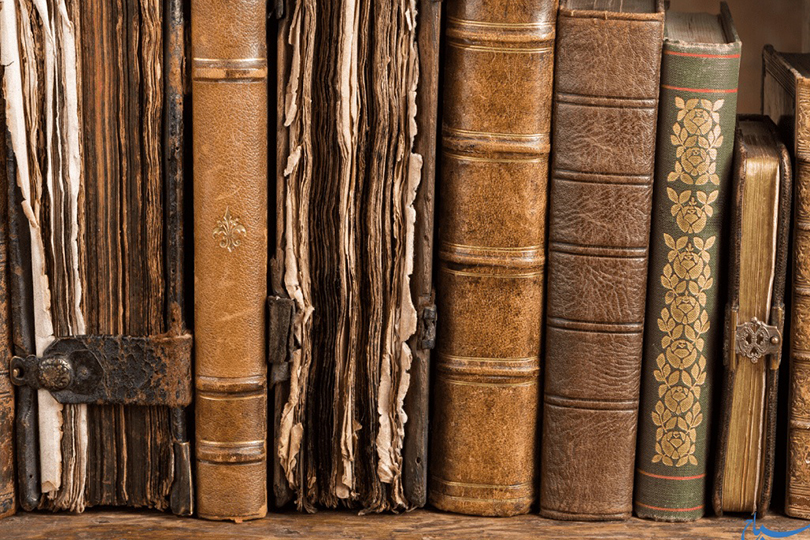

اضف تعليق