15- القرآن الكريم نص انساني نسبي
(إن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنه من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوماً، يفقد صفة الثبات، إنه يتحرك وتتعدد دلالته، إن الثبات من صفات المطلق المقدس، أما الإنساني فهو نسبي متغير، والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه، لكنه يصبح مفهوماً، بالنسبي والمتغير، أي من جهة الإنسان، ويتحول إلى نص إنساني "يتأنسن" ومن الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئاً إلا ما ذكره النص عنها؛ ونفهمه بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير والنسبي، النص منذ لحظة نزوله الأولي ـ أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي ـ تحول من كونه نصاً إلهياً وصار نصاً إنسانياً، لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل).(1)
و(إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثقافي في فهم لغة النص ومن ثم في إنتاج دلالته).(2)
المناقشة
ولابد من التوقف قليلاً عند هذه النصوص لنسجل عليها الملاحظات التالية:
أولاً: ليس كل إنساني، نسبياً
إن الكلام بمجمله مبني على (المصادرات) ـ بالمصطلح المنطقي ـ أي على سلسلة من (الدعاوى) غير البَيّنة في نفسها ولا المبيّنة، أي أنها قضايا اعتبرها الكاتب "مسلمات" ولم يقم عليها دليلاً، ومنها (أما الإنساني فهو نسبي ومتغير) و(النص منذ لحظة نزوله الأولي أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي، تحول من كونه نصاً إلهياً وصار نصاً إنسانياً).
ونقول: إن الدليل القطعي قام على إبطال كبراه الكلية (أما الإنساني فهو نسبي ومتغير)؛ إذ من البديهي أن السالبة الجزئية(3) نقيض الموجبة الكلية، ومن الواضح أن هنالك الكثير من (الإنسانيات) التي ليست هي نسبية ولا متغيرة، ويمكن مبدئياً توزيعها على مجاميع أربعة:
المجموعة الأولى: كافة مسائل الحساب والهندسة، وهي بالألوف.
المجموعة الثانية: كافة الأحكام العقلية(4) من ما كان من دائرة (البديهيات): (الأوليات) و(الفطريات)(5) مثل: إستحالة الدور والتسلسل، اجتماع النقيضين محال، وكذا ارتفاعهما، ضرورة بطلان الترجح بلا مرجح، ضرورة كون الكل أعظم من الجزء... وهكذا.
المجموعة الثالثة: كافة المستقلات العقلية، وهي بالعشرات، بل بالمئات(6) ومنها (العدل حسن، والظلم قبيح، والإحسان حسن).
المجموعة الرابعة: كافة المسائل العلمية القطعية، كحركة الأرض الوضعية والإنتقالية، والجاذبية، وغيرها.
وبعبارة أخرى: إن (الإنساني) ـ وهو الموضوع في قاعدته ـ مفهوم مبهم تتعدد الاحتمالات في المقصود منه، وعلى ضوئها يتحدد مدى صحة حمل ذلك المحمول والخبر (نسبي، متغير) عليه، فما المراد بـ(الإنساني) هل المراد به ما يخلقه الإنسان؟ أو المراد ما يلمسه ويحسه بإحدى الحواس؟ أو المراد ما يدركه ويتعقله؟
إن المراد إذا كان هو آخر الفروض ـ كما هو موطن الكلام ـ فإنه باطل، ولا توجد لدينا قاعدة تحت عنوان (كل إنساني، أي كل ما يدركه الإنسان(7)، فهو نسبي ومتغير) ويكفيك برهاناً على بطلانها مجاميع القضايا والمفاهيم الأربعة الآنفة الذكر.
ثانياً: قاعدته تنقض نفسها!
يصح أن ننقض كلامه بكلامه؛ إذ يقول (إن الثبات من صفات المطلق المقدس) أليست هذه القضية مفهوماً ومدرَكاً؟ فهي إذن إنسانية، فهي إذن متغيرة ونسبية، فقد ناقضت القاعدة نفسها إذن؟! ويجري هذا النقض في قوله (أما الإنساني فهو نسبي ومتغير) وكذلك قوله (النص.. تحول.. لأنه) وبأدنى تغيير في التعبير يظهر وجه النقض.
ثالثاً: الجسم الإنساني متغير لا الروح الإنسانية
إن الإنسان حقيقة مركبة من روح وجسد، وما يرتبط بالجسد هو المتغير، لكن ما يرتبط بالروح، لا دليل على تغيره على الأقل، لإحتمال كون الروح مجردة على الأقل(8)، فلا يصح اطلاق القول بـ(أما الإنساني فهو نسبي ومتغير)؛ إذ ما يرتبط بالروح فهو إنساني أيضاً، مثل ما يرتبط بالجسد، و(العلم) و(الإدراك) مما يرتبط بالروح، وليكن ذلك على أقل الفروض، احتمالياً(9) ومع وجود هذا الاحتمال ـ فكيف لو ذهبنا إلى أنه برهاني ـ لا مجال لتأسيس قاعدة (أما الإنساني فهو نسبي ومتغير) وقد فصلنا هذه النقطة في موطن آخر.
رابعاً: القرآن نص إلهي لا يتأنسن
كيف (يتحول القرآن إلى نص إنساني "يتأنسن") مع أن المفروض أن المسلم يعتقد أن (القرآن) نزل (كنصٍ) من السماء، أي أن الله تعالى خلق هذه النصوص بذاتها ونقلها جبرائيل (أمين الوحي) بحرفيتها للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله.
ويبدو من هذا التعبير ومن تعبير الكاتب، "مع قراءة النبي له" أن الكتاب افترض أن القرآن نزل كـ(طاقة) مثلاً على النبي ثم حوله النبي إلى مادة نصيّة، أو أنه نزل كمعاني مجردة ثم صاغها النبي في قالب الألفاظ، أو أنه نزل كروح أو محتوى ثم ألبسه النبي شكلاً لفظياً، أو كمادة هيولائية، ثم منحها الرسول (صورة متجسدة)!!
إن ما يعتقده المسلمون ـ والمفترض في الكاتب أنه مسلم ـ هو أن القرآن نزل بهذه الشكل وبهذه الصورة والهيئة وبهذه النصوص بعينها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأسيساً على ذلك فإن القرآن كنص موجود بين الدفتين هو (إلهي) مائة بالمائة، وليس نصاً إنسانياً، ويستحيل أن يتأنسن، غاية الأمر أن له أن يقول (ترجمته إلى اللغات الأخرى فقط، هي ترجمة إنسانية).
نعم، للكاتب أن يقول: إنني لا أؤمن بنزول القرآن كنص على الرسول، بل إنه نزل كمعنى مجرد أو كطاقةٍ أو كمحتوى ومفهوم دون ألفاظ، وحينئذٍ نقول له: من أين لك هذا؟ أي أنها دعوى بلا دليل، كما أنه لم يقم عليها دليلاً، بل ليس بمقدوره ذلك، إذ (الوحي) من عالم أسمى، ثم إن المقدرة على فرضها هي فرع إمكان التجربة، وهي مستحيلة في (الوحي الإلهي) لغير مَن أوحى إليه الله تعالى، كما أنها من عالم الماضي فكيف يجربه؟.
وبعبارة أخرى له أن يقول: إنني لا أعلم أن القرآن نزل كنص أو كمضمون ومحتوى مجرد، وليس له الحق في أن يحسم من دون دليل، خياراته ويقول (النص منذ لحظة نزوله الأولي...).
والغريب أننا نجده (يفتي) في المسألة، كأنها حقيقة ثابتة؛ إذ يقول (إن حالة النص الخام المقدس حاله ميتافيزيقية)، نقول: أين ثبت لك أن النص نص خام؟ أليست هذه مصادرة ودعوى بلا دليل؟ من أين لك أن النص خام؟ إن هذا هو أول الكلام، بل إنه يرد على نفسه بنفسه إذ يقول: (حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئاً) نقول: إذا كانت حالة ميتافيزيقية لا تدري عنها شيئاً، فكيف حكمت عليها بأنها (خام) وأنه (منذ لحظة نزوله الأولي أي مع قراءة النبي له لحظة نزوله، تحوّل من كونه نصاً إلهياً وصار نصاً إنسانياً)؟
نقول: ومن أين أن النص حالة ميتافيزيقية بالمعنى الذي قصده؟ وأي مسلم يقول بذلك؟ صحيح أن المسلم يقول إن جبرائيل أمر ميتافيزيقي وغيبي، وأن (نزوله) أمر غيبي، وأن القرآن الكريم يمتلك إعجازاً غيبياً وعلمياً ومادياً، لكن القرآن كنص مكتوب ومقروء، لا يقول المسلم أنه حالة معنوية أو روحية فقط أو هي هلامية غير متشكلة في قالب ألفاظ، محسوسة منطوقة ومسموعة، حتى يكون ميتافيزيقياً، ولا يقول المسلم أن هذه الآيات هي مزيج من القرآن ومن ألفاظ صنعها الرسول كقالب وكثوب لتلك المعاني!
نعم، للملحد أو المسيحي أو اليهودي أن ينكر نزول القرآن أصلاً وفصلاً، كما للمسلم الجاهل أن يستعلم، وحينئذٍ ينتقل النقاش معه إلى علم الكلام، وهنالك نجد عشرات البراهين على إعجاز القرآن محتوى وشكلاً، مضموناً وأسلوباً، لفظاً ومعنى.
خامساً: التعبير بـ(قراءة النبي للوحي) مغالطة
إن التعبير بـ(مع قراءة النبي له ـ للقرآن ـ لحظة الوحي) مصادرة ومغالطة؛ ذلك أن التعبير بـ(قراءة) يعني أن (القرآن) لم ينزل كنص على الرسول، وأن قراءة الرسول له كانت هكذا، وهذا الكلام إضافة إلى كونه مصادرة ودعوى بلا دليل، بل هو أول الكلام، يستبطن: أن لي أيضاً أن (أقرأ) القرآن، وعلى قدم المساواة مع الرسول، ولا تمتلك قراءة الرسول للقرآن (الحجية) على الآخرين! لأنها متأطرة بأفقه المعرفي وخلفياته النفسية!(10)
وبكلمة أخرى: هذا يعني أن كل مفكر يكون في (عرض) النبي لا في (طوله)، وأن قراءة النبي حجة له وعليه فقط، وليست حجة لي ولا عليّ، بل قراءتي حجة لي وعليّ فقط؟ وما الذي يبقى من الإسلام بعد ذلك؟
سادساً: خلط عالمي الثبوت والإثبات
إن قوله: (إنه ـ أي القرآن ـ يتحرك وتتعدد دلالته) تعبير غير علمي وغير دقيق، بل إنه يتضمن خلطاً بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، أي بين عالم الواقع والحقيقة، وعالم الذهن والمعنى؛ ذلك أن الذي يتحرك ويتعدد هو (فهمنا) للقرآن، وليس (القرآن نفسه) وكم فرق بين الأمرين؟
ثم (الدال) هو (النص) وليس (المفهوم) فإنه مدلول عليه، فلا يصح وصف النص في مرتبة المفهومية بـ(تتعدد دلالته).
وللتقريب للذهن نمثل بمرايا مسطحة ومقعرة ومحدبة، فإن مرآة السيارة مثلاً تعكس السيارات القادمة، لكن المحدبة والمقعرة تظهر السيارة على غير حجمها الواقعي وعلى غير المسافة الواقعية، فلو وجدت مرايا ثلاث مسطحة ومقعرة ومحدبة كلها تعكس صورة سيارة واحدة قادمة، فما الذي يتعدد؟ هل السيارة بواقعها أضحت ذات ثلاثة أحجام في نفس الوقت في عالم الواقع، أو أصبحت على بعد ثلاث مسافات مختلفة في الآن الواحد؟ أم (الصور المرآتية) هي التي تعددت؟ ثم إن من الواضح أيضاً أن (الصور المرآتية) ليست كلها صحيحة مطابقة للواقع، بل بعضها فقط.
سابعاً: لا أسوار عازلة بين حقائق الدين والعلم
إننا نرى أن من الخطأ المنهجي، تصنيف النصوص إلى دينية وعلمية(11)، ووضع أسوارٍ عازلة حولها، أي من الخطأ تماماً اعتبار القضايا بنحو المنفصلة الحقيقية، أو بنحو مانعة الجمع، أما دينية أو علمية أو غيرها، بل إن النصوص العلمية قد تكون دينية، كما أن النصوص الدينية قد تكون علمية(12)، وما أكثر ذلك، وعلى سبيل المثال نجد:
في علم الكلام: أن هذا النص: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)(13) هو نص ديني وهو نص علمي برهاني في الوقت نفسه، وكذلك: (ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)(14) و: (كما بدأنا أول خلق نعيده).(15)
كما نجد في (علم الاقتصاد والنفس) النص التالي: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)(16) و: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً)(17) أو: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).(18)
وفي (علم الأخلاق والاجتماع): (وبالوالدين إحساناً)(19)، و(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى)(20)، و(لو كنت فظاً غليظ القلب لإنفضوا من حولك).(21)
وفي (علم الطبيعة والفلك): (رب المشارق والمغارب)(22) مما يعني عدم ثبات الأرض في نقطة بالقياس إلى الشمس أو: (والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون)(23)، مما يعني توسع وامتداد الكون باستمرار، كما وصل إلى ذلك أخيراً العلم الحديث.(24)
وفي (علم التاريخ وفلسفته): ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ).(25)
وفي (علم السياسة): (أتواصوا به بل هم قوم طاغون)(26)، و(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)(27) وهكذا.
ثم إن من المرفوض تماماً اختزال القرآن الكريم في كونه (نصاً دينياً) بل إننا نراه (نصاً دينياً، علمياً، ثقافياً، اجتماعياً، تاريخياً...) الخ قال تعالى: (تبياناً لكل شيء).(28)
وتفصيل ذلك موكول إلى الدراسات القرآنية.
ثامناً: لم يتحول القرآن الكريم من التنزيل إلى التأويل
إن قوله: (لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل) يعاني هذا النص من:
أ- إنه أقامه كدليل على (أن النص منذ لحظة نزوله الأولي تحول من كونه نصاً إلهياً وصار نصاً إنسانياً) لكن اللطيف أن هذا الدليل هو بنفسه (مدَّعى) وهو أول الكلام، فقد بَرهن على المدعى بمدعى آخر، وهذا ليس بالعلمي أبداً.
ب- كما أن هذا النص يعاني من عدم الدقة (إن لم نقل: تحريف) المصطلحات، إذ (التنزيل) و(التأويل) لهما معنى خاص معروف في كتب التفسير، وقد استخدمهما الكاتب ـ عن غير خبرة، بناء على حسن الظن ـ لتفسير مدعاه.(29)
ويبدو أن السر في استخدام هذين المصطلحين كان هو تمرير فكرة (النص الخام) و(قراءة النبي) و... عبر استخدام مصطلحين مأنوسين في ذهن المسلم، ولعله، على حسن الظن، كان غفلةَ من المؤلف بمعاني المصطلحات القرآنية.
وللتوضيح نقول: إن المصطلح القرآني في (التنزيل) ـ والذي يدين به ويفهمه كذلك كل مسلم ـ لم يكن خاصاً بالمعاني والمفاهيم المجردة بل إن (التنزيل) يعني أن هذا القرآن الكريم بألفاظه نفسها نصاً وروحاً: (تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(30).
كما أن من غير الصحيح المقابلة بين التنزيل والتأويل؛ ذلك أن التفسير هو الذي يقع في مقابل التأويل، لا التنزيل، ومقصود الكاتب أن (النسبي) و(المتغير) هو التفسير والتأويل معاً؛ فإنه لا يرى ثباتاً للتفسير كما لا يرى ثباتاً لتأويله، ولو تحرى الدقة في تبيين مدعاه لكان عليه أن يقول (لأنه تحول من التنزيل إلى التفسير والتأويل).
تاسعاً: ليس كل مفهوم متغير
(لكن من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوماً، يفقد صفة الثبات)
نقول:
أ- لا دليل على أن كل مفهوم، فهو متغير.
ب- بل الدليل قام على العكس تماماً، وقد أشرنا لعدد من المفاهيم الثابتة والمطلقة في الجواب الأول.
ج- إن افتقاد (المفهوم) صفة الثبات، لا يعني بالضرورة افتقاد (النص) لصفة الثبات.
والغريب في الأمر أن الكاتب يخلط، عن جهل أو عمد، بين (النص) و(المفهوم) ثم يصل من عدم ثبات المفهوم إلى عدم ثبات النص!(31) كما سنشير له في جواب قادم.
عاشراً:(32) فارق النصوص البشرية عن النص الإلهي
أ: ولنفترض أن النص أو المفهوم الذي يخلقه البشر، عندما يتعرض له العقل الإنساني، يفتقد صفة الثبات، ولكن ماذا عن الله تعالى والنصوص أو المفاهيم التي يخلقها؟ هل تفتقد أيضاً صفة الثبات والإطلاق والقداسة؟
لكن ألا يعني ذلك نسبة (العجز) إلى الله تعالى من أن يرسل لنا قوانين ودساتير ومناهج وأحكاماً ذات مرجعية علمية مطلقة، قادرة على (تجاوز) عقبة ضعف العقل الإنساني ونسبيته؟ أي أليس الله بقادر، ثم بعد الإيمان بقدرته، ألا تقتضي حكمته البالغة أن يخلق مفاهيم ونصوصاً ذات مناعة وحصانة أمام تلوينات وتغييرات العقل البشري لهما؟ إن الوجدان والعقل يشهدان بذلك، ومن الشواهد الكبرى: (الفطريات والأوليات) و(المستقلات العقلية)(33)، ألم يقل جل اسمه: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)(34) مما يستلزم أن مَن يرى التبدل والتبديل، متوهم ومخطئ، و:(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)(35)؟ وحيث إنه من عند الله تعالى، فلا (يجدون) اختلافاً فيه، والذي يستوقفنا كلمة (لوجدوا) والمفهوم منه أنه حيث إنه من عند الله (فلا يجدون)(36) عكس كلام هذا الهِرمينوطيقي، فالنص الإلهي إذن، بتصريح القرآن الكريم، ليس نسبياً متغيراً، ولو أردنا استعارة تعبيراته قلنا (فالنص الإلهي بمجملِهِ حالة ميتافيزيقية، أي بمادته وصورته(37) ومضمونه وشكله ومحتواه وأسلوبه وصياغته، فليس قابلاً لأن (يتأنسن) أبداً).
وألم يقل سبحانه وتعالى: (يحرفون الكلم عن مواضعه)(38) مما يعني أن (التحريف) عملية مقصودة تصدر عن سابق قصد وإصرار وعناد، وذلك أعم من التحريف في مادة النص أو في هيئة النص، وأعم من التحريف في دلالته المطابقية أو التضمنية أو الإلتزامية، أو دلالة الإقتضاء أو دلالة الإيماء والإشارة، وأعم من التحريف في (النص الخام) أو (النص المتبلور).
كما يعني قوله تعالى: إن مَن فتح قلبه لكتاب الله، هداه وأرشده وأوصله للمرادات والمداليل كما هي هي أي (لـِمَواضِعِه)؟ ولو كانت المفاهيم والكلمات الإلهية متحركة ليست ذات ثبات، بل تتحرك وتتعدد بتعدد المفكرين وخلفياتهم النفسية ومسبقاتهم الفكرية، أو حسب السياقات الثقافية ـ الاجتماعية، لما كان هنالك معنى لـ (يحرفون الكلم عن مواضعه) (39) ثم لو فرض له معنى لما كان مذموماً قبيحاً بل كان عملاً إنسانياً!!
ب: لنفترض أن (النص الإلهي) فرضاً، لا يسلم من آفة التغيير والتحوير والتشويه عندما يتحول إلى (مفاهيم) في أذهان الناس، لكن أليس الله بقادر على إيجاد (مرجعيات) فكرية تصحيحية، تصحح المسار، وترشد لمكمن الخطأ، وتحدد التغيير الطارئ وإتجاهاته، كما صنع الله تعالى في عالم الطبيعة ذلك؟(40) قال الله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن)(41) وقد فصلنا في موضع آخر الحديث عن (المرجعيات): ومنها (محكمات القرآن) والكثير من قواعد (المنطق) وقواعد النحو والصرف والبلاغة، وغيرها.
ج: كما أنه تعالى قرر، إضافة للمرجعيات المنطقية والطبيعية وغيرها، مرجعيات (بشرية)، يُعَدّ كلا منها هو الحكم الفصل في أي اختلاف في معنى النص أو دلالاته، ولدى تعدد المفهوم عنه.
قال تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).(42)
و: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً).(43)
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(44).
وهذه (المرجعية) تعد من صميم مهام (رسل الله) جل وعلا، وقد فصلنا هذه النقطة في موضع آخر.
حادي عشر: برهان السبر والتقسيم
نقول ما الذي يراد استنتاجه من أن النص أو المفهوم يفقد صفة الثبات، ويتحرك وتتعدد دلالاته... الخ؟
هل يراد بذلك أن كل هذه الدلالات صحيحة؟ أو يراد أنها بأجمعها خاطئة؟ أو يراد أن أحدها صحيح والبقية على خطأ؟ أو يراد أن كلاً منها له جانب أو وجه من الصحة؟ أو يراد اننا (لا نعلم) الصحيح منها من السقيم، وليس لأحد أن يرى رأيه صحيحاً ورأي الآخرين خطأ؟
أ: فإن قيل بأن المقصود والناتج أنها بأجمعها (صحيحة)، أجبنا بإستحالة ذلك؛ إذ ما دام النص (يخبر) عن حقيقة مادية أو ميتافيزيقية، فإنه لا يعقل أن تكون كل الأفهام المتغايرة والمتعاكسة والمتناقضة، صحيحة؛ وإلا لصح التناقض في متن الواقع، أو لكان الشيء هو هو وفي نفس الوقت ليس بهو هو.
وإذا كان النص (منشِئاً) لقانون، فإنه يكون عندئذٍ هو (المحور) أي هو (الواقع الثبوتي) الذي يراد كشفه، أي هو المعلوم والمرئي والذي تعرض له العقل البشري ليفهمه، وعليه لا يعقل أن تكون كل الأفهام المتغايرة أو المتعاكسة عن حقيقته والمراد به، صحيحة، هذا.
إضافة إلى أن النص الإنشائي، يكشف(45)، على مسلك العدلية، عن وجود مصلحة كامنة في الأوامر، هي التي اقتضت الأمر، أو مفسدة هي المقتضية للنهي، وحينئذٍ لا يعقل أن تكون كل الأفهام المتناقضة عن وجه الحكم ومنشأه، صحيحة... الخ.
ب: وإن قيل: إن الحصيلة هي أنها بأجمعها (باطلة)، قلنا: إن من البديهي أن ما طابق الواقع منها، فصحيح، وإلا فباطل، ولو لم يطابق شيء منها واقع مدلول النص أو المراد به، لكانت بأجمعها خاطئة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود واقع ومدلول محدد للنص، بل أن الاعتراف بكون الأفهام أو بعضها (خاطئة) يتضمن الاعتراف بوجود (الصواب) في مرحلة الواقع ونفس الأمر؛ وإلا لما أمكن وصف ما عداه بالخطأ، إذ الخطأ مفهوم إضافي يراد به عدم مطابقة ما في عالم الذهن لما في عالم الواقع، أو نظائر ذلك.
ج: وإن قيل بأن كلاً منها له جانب صحة وجانب خطأ، أجبنا بأن ذلك إنما هو فقط فيما لو اكتشف أحدهم بعض الحقيقة، فيما أذا كانت مركبة ذات أجزاء أو أفراد، واكتشف الآخر بعضها الآخر، من دون أن يكون المفهوم من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين(46)، دون ما لو أخطأ أحدهما أو كلاهما كل الحقيقة.
وبعبارة أخرى: إن هذه الدعوى، باطلة إذا أريد بها الشمولية والتعميم، ذلك أن كثيراً من التصورات والتصديقات عن الشيء أو المفاهيم، قد تكون خاطئة تماماً أي غير مطابقة للواقع، لا أنها ناقصة فحسب، وكم فرق بين النقص وبين الخطأ واللا مطابقة؟ نعم (النقص) قد يكون من مصاديق اللا مطابقة.
بكلمة أخرى: ليس بالضرورة أن تكون الأفهام المتخالفة، متطابقة في جانب منها مع الحقيقة، إذ قد يكون المفهوم مجانباً للصواب مائة بالمائة ومن مختلف الجهات، ومن أوضح الأمثلة من يعتقد أن الله هو الشمس ومن يعتقد أنه القمر ومن يعتقد أنه بقر ومن يقول إنه بشر، فإن كل هذه التصورات والمعتقدات خاطئة تماماً، ومن الأمثلة في العلوم الرياضية: كل من يعتقد بأن مساحة المربع هي غير حاصل ضرب أحد أضلاعه في الآخر، مهما تعددت الأجوبة والآراء.
ومن الأمثلة في العلوم الإنسانية: كل من يعتقد بأن العلاقة بين العرض والطلب والقيمة هي غير هذه العلاقة (كلما زاد الطلب وقل العرض، مع ثبات سائر العوامل، زادت القيمة).
د: وإن أريد أن أحدهما المطابق للواقع صحيح، وغيره، خطأ، فذلك هو الحق، وهو ما يقول به كل مسلم، وعليه، فاللازم البحث عن تلك الحقيقية المطابقة للواقع حتى الوصول إليها.
لا يقال: (لا توجد منهجية علمية أو غير علمية للوصول إلى حقيقة النص)؟
إذ نقول: قد اسهبنا الجواب عن ذلك في موضع آخر من الكتاب، عند التطرق لمعاني النسبية، وبما ذكرناه هنالك يتضح الجواب عن الشق الخامس وهو:
هـ: وإن أريد أننا لا نعلم الصحيح من المفاهيم المتعاكسة أو المتناقضة، من السقيم، قلنا: ـ إضافة إلى ما ذكرناه هنالك ـ إن باب العلم منفتح في القضايا المفتاحية، كما أن باب العلم أو العلمي منفتح في أكثر (لو لم نقل كل) الأحكام والقوانين والسنن والقيم، وقد أسهب الحديث عن ذلك علماء الأصول في مبحث إنسداد باب العلم وإنفتاحه، فليراجع، هذا.
إضافة إلى أن من يقول بذلك له أن يحكم على نفسه بأنه لا يعلم الصحيح من المفاهيم المتعاكسة من السقيم منها، وليس له أن يعمم حكمه على الآخرين بل نقول إنه وإن قال ذلك بلسانه، إلا أنه لا يؤمن بذلك بجنانه، بل حتى وإن وثّقه بقلمه أيضاً!
لذلك نجده يعترف بسلسلة من القضايا ويعدها مطلقة، ومنها هذه القضية!(47)
والملاحظ أن الهِرمينوطيقيين، بمختلف مدارسهم، يقومون بعملية تعميم لقواعدهم وأحكامهم التي توصلوا إليها، مناقضين بذلك هرمينوطيقيتهم بنفسها!
ثاني عشر: منهجيات مرجعية
إن (الدلالات) حتى لو تعددت، لكن توجد منهجيات، منطقية، وعقلية، وعلمية، لتحديد الصحيح منها من المخطئ، كما توجد منهجية لتحديد الدلالات الأولية والثانوية، والدلالات المقصودة وغير المقصودة ـ وقد فصلنا هذه النقطة في موضع آخر.
ثالث عشر: ضبابية المصطلحات
كما أن مما يؤخذ على هذا النص، عدم وضوح المراد من مصطلحاته الأساسية والمفتاحية، وعدم تحديدها، فعندما يقول (إن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه) و(القرآن نص مقدس من ناحية منطوقه)، لم يوضح لنا المراد بالضبط من (منطوقه) فهل المراد به (المنطوق) في مقابل المفهوم؟ أم المراد به الدلالة المطابقية والتضمنية في مقابل الدلالة الإلتزامية؟ أم المراد به ما يقابل دلالة الإقتضاء ودلالة التنبيه والإشارة وشبههما؟ أو المراد به (من حيث دلالة نصوصه وألفاظه، في صقع الواقع(48) على معانيها ومداليها، الثبوتية).
فإن أراد المعاني الأولى، فإن نفي الثبوت والقداسة عن ما عدا الدلالة المطابقية(49)، مما لا وجه له، ومما لم يقم عليه دليلاً، بل إن نفس برهان قداسة المداليل المطابقية للنصوص الإلهية، هو البرهان على قداسة وثبات الدلالات الإلتزامية وغيرها؛ إذ الفرض أن خالق هذه النصوص هو الله اللا متناهي المطلق العالم المحيط القادر، فكما بمقدوره أن يخلق نصاً مقدساً أو ثابتاً من حيث منطوقه، بمقدوره أن يخلق نصاً مقدساً ثابتاً من حيث سائر دلالاته.
وإن أراد آخر المعاني، كما لعله الظاهر من سياق الكلام، نقول: إذا كان القرآن من حيث هو، وفي مرحلة الثبوت، ذا دلالة مقدسة وثابتة، على مدلولاته ومفاهيمه ومعانيه، فإنه (لا يفقد صفة الثبات) و(لا يتحرك وتتعدد دلالته) بل غاية الأمر أن (فهمنا) هو غير الثابت وهو المتعدد الدلالة، وفهمنا من البدأ لم يكن واجداً ليصبح فاقداً ولم يكن واحداً ليصبح متعدداً!
وبكلمة أخرى: إن هذا النص يتضمن مغالطة من النوع الرديء؛ إذ ما هو ثابت وواحد (وهو القرآن كنص ديني مقدس كما صرح به) هو ثابت وواجد أبداً بما هو هو، وما هو فاقد ومتحرك (وهو الإنساني، والمفهوم في تعبيره) هو كذلك ابداً بما هو هو فكيف ينسب نقص وتغير أحدهما للآخر؟
اللهم إلا أن يقال إن هذا التعبير مجازي والمقصود منه واضح؟ ونجيب:
أ: لا مسرح للمجاز في البحوث العلمية الدقيقة.
ب: وإذا كان باب المجاز مفتوحاً، فلم لا يعكس فيقول مثلاً: (إن العقل الإنساني حيث يتعرض للنصوص الدينية الثابتة والمقدسة، يتحول إلى عقل مقدس ثابت، ويفقد صفة تغيره، ونقصه وأن التغير من صفات المادي، أما الإلهي (أي العقل الذي يتعرض للنصوص الإلهية) فهو يفقد صفة التغير، وهو مطلق ومقدس حينئذٍ، يكتسب قدسيته وثباته من كون محور إدراكه هو المطلق والمقدس)!
رابع عشر: هل النص خام وغير خام؟
ويقول: (إن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئاً) ونجيب تأكيداً لما سبق وإضافة؛ من إدراك أن النص له قسمان: خام وغير خام؟ ومن إدراك أن النص عندما نزل على النبي كان نصاً خاماً؟
أن من يعترف بـ(لا ندري عنها شيئاً) و(هي حالة ميتافيزيقية) لا يجدر به ان يناقض نفسه في نفس الجملة مرتين: مرة في الصغرى والمصداق، وأخرى في الكبرى الكلية!(50)
ويقول: (إلا ما ذكره النص عنها)
ونقول: إذا كان النص ميتافيزيقياً ومقدساً وثابتاً، فإن ما يذكره النص عن نفسه، هو بالضرورة أيضاً ميتافيزيقي ومقدس وثابت.
فلنرجع إذن إلى النص نفسه لنجده يصرح بـ (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(51)، (يحرفون الكلم عن مواضعه)(52) ولو كانت الدلالات تتعدد والنص يتحرك و... لما كان معنى لتحريف الكلم عن مواضعه! بل كان سالبة بإنتفاء الموضوع؛ إذ (لا مواضع للكلم) حينئذٍ لتحرّف عنها!
ويصرح بـ (اهدنا الصراط المستقيم)(53).(54)
ويصرح بـ(مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ).(55)


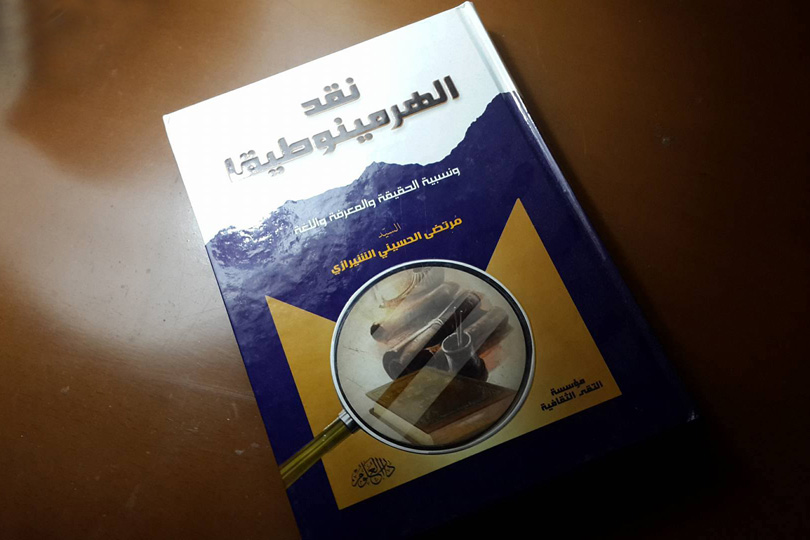

اضف تعليق