إن النسبية بهذا المعنى تواجه الإشكالات التالية:
1: بعض العلوم قطعية
إن بعض العلوم قطعية، لا ريب فيها، وذلك كعلم الحساب وعلم الهندسة، وككثير من أسس قواعدِ علومٍ كالمنطق، والفيزياء، والكيمياء، والفلك والجغرافيا، والجيولوجيا، وشبهها.
2: مسائل قطعية في علوم شتى
إن كثيراً من الحقائق والمعلومات والمعارف المبثوثة في العديد من العلوم، هي أيضاً بدورها قطعية، وهي التي يعبر عنها علماء الكلام والأصول بـ(المستقلات العقلية) ومنها:
• العدل حسن ــ علم الكلام والأخلاق.
• الظلم قبيح ــ علم الكلام والأخلاق.
• مقدمة الواجب واجبة عقلاً ولا أقل من (اللابدية) ــ علم الأصول.
• كلما طابق المأتي به المأمور به، كان صحيحاً مجزئاً ــ علم الأصول.
• التعاون على البر والتقوى والعدل والإحسان، حسن ــ علم الفقه والتفسير.
• الإعانة على الإثم والظلم والعدوان، قبيح ــ علم الفقه والتفسير.
• لا يصح من الحكيم الأمر بالنقيضين بما هما نقيضان ــ علم الكلام والأصول.
• الإتيان بالفعل بداعي امتثال أمر المولى، إطاعة، سواء قلنا بأن مطلق مطابقة المأتي به للمأمور به، إطاعة، أم خصوص ما كان عن استناد ــ علم الأصول.
• كلما كثر الطلب وقل العرض، مع ثبات سائر العوامل، ارتفعت القيمة ــ علم الاقتصاد.
• قانون (المنعكس الشرطي) ــ علم النفس.
• الحضارات، كالأفراد، لها طفولة وشباب وشيخوخة وصحة ومرض ــ علم الاجتماع.
• لكل شيء نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص ومخاطر ــ علم الإدارة.
• تمركز القدرة مقتضٍ(1) للطغيان ــ علم السياسة.
وهكذا وهلم جراً.
وقد أشرنا في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) إلى العشرات من المستقلات العقلية.
3: بطلان اللازم أو الملازمة
إن الانتقال من (ظنية) غالب العلوم، أو غالب مسائلها، والاستنتاج تبعاً لذلك (إذن فوجود الله ظني، أو أصل وجودنا ظني) واضح البطلان.
وبعبارة أخرى أدق: إن بداهة بطلان التالي، ينتج بطلان المقدم في القياس التالي (كلما كانت علومنا كلها ظنية، كان إذعاننا بوجودنا أيضاً ظنياً) نقول (لكن التالي باطل، فالمقدم مثله). وإن كان المقدم في القياس هو (حيث إن أكثر علومنا ظنية، فإن إذعاننا بوجود الله أيضاً أو بوجودنا، ظني أيضاً) منعنا الملازمة.
4: (مفاتيح العلوم) قطعية
إن (مفاتيح العلوم) بدورها قطعية ومفاتيح العلوم هي المسماة بالضروريات واليقينيات، وهي تلك التي أسهب علماء المنطق، في الحديث عنها، وهي تنقسم إلى ما يكون الحاكم(2) فيها هو العقل، أو الحس، أو المركب منهما(3)، بناء على إنحصارِ المدرِك في العقل والحس، وهي:
أ: الأوليات
(الأوليات)، وهي تلك القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها، أي لا لسبب خارج عن ذاتها، وذلك إما بأن يكون تصور الموضوع وحده تصوراً كاملاً، كافياً لتصديق العقل بثبوت المحمول لهذا الموضوع، وذلك كـ(اجتماع النقيضين) فإن تصوره بحدِّه كافٍ للحكم عليه بالاستحالة.
أو بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما، كافياً للجزم بصدق القضية وذلك كقولك (الكل أعظم من الجزء)، وكقولك (الممكن، لابد لوجوده من علة).
ب: الفطريات
(الفطريات) وهي كالأوليات، إلا أن العقل لا يصدق بها لذاتها، بل لابد لها من (وسط) سواء قلنا بأن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر، كما هو رأي البعض، أم قلنا بأنه أمر خفي غير ملحوظ للعالم، ولأنه خفي اعتبرت الفطريات غير كسبية.
وذلك كحكمك بأن مربع الثمانية ـ مثلاً ـ هو أربعة وستون، فإنه حكم بديهي، إلا أنه متوقف على وسط، وهو أن مربع كل عدد هو حاصل ضربه في نفسه. أو قولك الإثنين خمس العشرة، وهو حكم بديهي متوقف على وسط هو: العشرة عدد منقسم إلى خمسة أجزاء متساوية كل جزء منها إثنان، فالإثنان خمس العشرة، أو قولك (الترجّح بلا مرجح محال).
وهذان القسمان ينفرد العقل بالحكم بصدق القضية فيهما، من غير استعانة بالحس.
ج: المشاهدات والمحسوسات
الكثير من (المشاهدات) و(المحسوسات).
وذلك سواء المحسوس منها بالحواس الظاهرة من مبصرة وسامعة وشامة وذائقة ولامسة، أم المحسوس منها بالحواس الباطنة كـ(الحس المشترك) و(قوة الخيال) وكـ(القوة المتوهمة) و(الحافظة) وأخيراً (القوة المتصرفة).
وهذا مع قطع النظر عن بعض نقاشٍ لنا حول هذه القوى.
وهذا القسم، الحاكم فيه حسب بعض المناطقة، هو (الحس) وحده، لكن الحق إحتياجه إلى العقل أيضاً، ويظهر ذلك من جواب الإشكال الآتي.
خطأ الحواس
ولا يعترض على ذلك بـ(خطأ) القوة الباصرة مثلاً، إذ لنا أن نجيب بأن المدرَك بالحواس، بعد الاحتكام للعقل المجرد أو المصحوب بالفحص والتثبت، قطعي، وبعبارة أخرى: لا ريب في أن كثيراً من مدركات الحواس، صحيح قطعاً كـ:حرارة النار، ونور النهار، وغيرها.
كما لا ريب في خطأ بعض مدركاتها بعد الاحتكام للعقل، كإلتقاء الخطين المتوازيين على مرمى البصر، وكصغر حجم الأجسام البعيدة.
نعم تبقى أحكام قليلية مشكوكة، وليس الكلام فيها ولا تعد من مفاتيح العلوم أبداً.
د: المجربات
(المجربات) وهي التي يحكم بها العقل نتيجة تكرر الاحساس بها بإحدى الحواس لكن بقيد أن يستكشف من ذلك (العلة) فيكون من قبيل الاستقراء المعلل ـ وذلك إن لم نعلم بماهية السبب تفصيلاً، على رأي، وعلى رأي آخر: سواء علمنا بماهية السبب أم لم نعلم؛ إذ قد ذهب البعض(4) إلى أن الفارق بين المجربات وبين الحدسيات، هو العلم بماهية السبب في الحدسيات(5)، وعدم العلم به في المجربات، بل مجرد كشف أن هنالك علةً ما، وهذا الرأي هو الأقرب.
هـ: الحدسيات
(الحدسيات) وهي التي يحكم بها العقل نتيجة حدس قوي جداً بحيث لا يبقى معه للنفس مجال للتشكيك، (وذلك إثر مشاهدة أو إحساس غير متكرر على رأي يرى أن الفرق بين المجربات والحدسيات، هو تكرر المشاهدة وعدمه، أو فيما لو علمنا ماهية السبب، على رأي آخر، كما سبق).
وذلك كالحدس بكروية الأرض؛ لمشاهدة أن السفن، أول ما يبدو منها هو أعاليها، ثم كلما اقتربت لليابسة ظهرت الأجزاء السفلى شيئاً فشيئاً، وكالحدس بأن نور القمر ما هو إلا إنعكاس لنور الشمس. وكالحدس بالجاذبية من رؤية سقوط التفاحة وغيرها.
و: المتواترات
(المتواترات) وهي القضايا التي يقطع بها نتيجة أخبار جماعة كثيرة من الناس عن أمر حسي (لا حدسي)(6) بحيث يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وبحيث يمتنع عادة خطؤهم في الإخبار، وذلك كعلمنا بوجود البلدان النائية، والأمم السالفة الماضية.
و(التواتر) المنطقي هذا، يشترط فيه إفادة العلم والقطع، فلا يكون متواتراً مهما تزايد عدد الناس الشهود، إلا بهذا القيد.
وهذه الأربعة الأخيرة(7)، الحاكم فيها مجموع الحس والعقل.
ويجب أن نضيف لهذه الستة التي ذكرها علماء المنطق، ما يكون المدرك لها أو الحاكم فيها (الروح) أو (النفس) وعليه يبتني الكشف والشهود الصادق(8)، وليس هذا مجال تفصيل ذلك.
5: الظنون المعتبرة
من الصحيح أن بعض العلوم، في أغلب مسائلها، أو في العديد منها (ظنية)، وذلك كعلم (الطب) و(الفقه)، لكن هذه الظنون تعد من (الظنون المعتبرة)؛ فإن (العقلاء) قسموا الظنون إلى قسمين: ظن معتبر، وظن غير معتبر:
أما (الظن غير المعتبر) فكالظن الحاصل من أمثال الأحلام، والطَيرة والتشاؤم وطيران الغراب وجريان الميزاب، وكالاستقراء الناقص غير المعلَّل وغير المنهجي، وكظن الجاهل فيما يحتاج إلى علم أو خبروية.
وهذه الظنون لا ينبغي لعاقل أو متشرع أن يعوّل عليها أو يستند إليها. وأما مطابقتها أحياناً للواقع، فإنه لا يخرجها عن كونها، في المجموع، في دائرة (المرجوح) كما أن حصول (القطع) أحياناً، من بعضها، لبعض الناس، لا يسوّغ اعتبارها (علماً) أو (ظناً نوعياً).(9)
وأما (الظن المعتبر) فإن بناء العقلاء، والأديان كافة، قائم على (حجيتها) وضرورة الاعتماد عليها، بل يعدون من يتجنبها أو يهملها (سفيهاً)، وذلك مثل ظن الخبراء في مجال اختصاصهم، غير المعارض بمثله، بل على رأي: حتى المعارَض بمثله(10) للإلتزام بشمول أدلة الحجية للمتعارضين والرجوع عندها للمرجحات وإلا فالتخيير، كأصل أولي، وإن ذهب قوم إلى أن ذلك أصل ثانوي؛ نظراً للروايات.
ومن الواضح أن الحياة بأكملها تبتني على (الظنون المعتبرة)، ولولاها للزم الهرج والمرج، والفوضى، واختلال النظام، وللزم من تركها، الوقوع في أضدادها، وهي الأوهام والخرافات.
وذلك مثل ظواهر كلام الناس بعضهم لبعض، من أفراد وشركات ومؤسسات وحكومات، أفهل يتقبل عاقل هذا المنطق القائل بأن كافة الاتفاقات الشفوية والكتبية بين الشركات والدول أو الأفراد والناس، وكل (العقود) من بيع وشراء وصلح وشركة وغيرها، و(الإيقاعات)، وكذلك كل ما يعلن عنه أو يبلغ عنه في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ومن على منائر المساجد أو في الجامعات وغيرها؛ هذه كلها ظواهر لا تورث إلا ظناً، فلا حجية لها، ولا يلزم إتباعها، ولا يحق محاسبة أو معاتبة أو حتى عقاب المخالف لها، مدعياً أنها مجرد ظواهر لا تفيد علماً ولا تروي غليلاً؟
ولا ريب أن هذه (الظنون) النوعية العقلائية (حجة) سواء فسرنا الحجة بـ(ما يحتج به المولى على عبده، أو العكس) أو فسرناها بـ(المنجز والمعذر)(11) أو فسرناها بـ(الأوسط في القياس)(12) أو فسرناها بـ(الطرق والامارات التي تقع أوساطاً لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي)(13) أو فسرناها بـ(ما يلزم الحركة على طبقه وإتباعه، عقلاً) أو فسرناها بـ(الكاشف عن الواقع)(14) فإن الظن كاشف بقَدَرِه عن الواقع.
وبذلك كله يظهر بطلان الاستنتاجات الثلاثة الماضية التي نقلناها عن القائلين بظنية العلوم والمعارف؛ إذ مادام (الظن معتبراً) لدى العقلاء والشارع فارزة فإنه لا يجوز عقلاً الانتقال إلى دائرة معرفية أو مذهبية أخرى، مادام لم يعارضه ظن أقوى منه أو مساوٍ، كما أن الظن مادام معتبراً وغير معارض بالأقوى أو المماثل، فله حينئذٍ عقلاً وشرعاً أن يرى أنه على حق وغيره على باطل، بل عليه أن يبني على ذلك، وأما وجودنا ووجود الله تعالى وعدله وأصل تقسيم المعلومات إلى الخاطئ والصحيح، فإنها كلها قطعية لا يرقى إليه الشك فلا ربط لها بالمقام أبداً، على أنه لم تكن هنالك قضية كلية من البدأ ليستند إلى عموميتها في إدراج مثل هذه القضايا تحت رايتها، بل لو كانت الكلية موجودة لكانت مثل هذه القضايا مستثناة قطعاً، فتدبر جيداً.
6: برهان (الغاية) والاكتفاء بالظن
إن (الغاية) المتوخاة و(الهدف) المحدد والمرجو من كل علم، هو الذي يحدد مدى ضرورة أن تكون براهينه وحججه أو مؤدياته، (قطعية) أو (ظنية) وأيهما هو الوافي بالمراد والشافي للغليل والحجة للعباد وعلى العباد.
وبعبارة أخرى: إن ما هو (المتوقع) من العلوم، مختلف اختلافاً كبيراً؛ فإن المتوقع من (المنطق) أن يكون (قطعياً) لفرض أن المراد به أن يكون (ميزاناً) للفكر ومقياساً للعلوم.
أما (المتوقع) من علم (الفقه) فهو (المؤمِّن من العقاب والمعذِّر) و(الحجة) التي يحتج بها العبد على مولاه في باب الإطاعة، وذلك كله حاصل بالظنون النوعية، التي جرى بناء العقلاء عليها والتي أمضاها الشارع، من غير حاجة إلى حصول القطع.
ومع حصول هذا المؤمِّن لا يحق للعبد إهماله والانتقال إلى غيره، بل له أن يبني أنه على الحق، بل قال بعض الأصوليين: إنه (قاطع) حينئذٍ بأنه متمسك بأمر مولاه وإن كان المؤدَّى ظنياً، إذ (الطريق) قطعيّ المعذرية والحجية.
بل نقول: ما دام المولى قد اكتفى في باب الإطاعة بأمثال خبر الواحد والظواهر وأشباهها، مما تفيد الظن لا القطع عادة، فلا حاجة للسعي وراء (القطع) وإن أمكن بل لعله طلبه، لغو ومضيعة للوقت، ثم إنه لو لم يمكن (القطع) فليس نقصاً ولا عيباً.
وتدل على ذلك أيضاً روايات إرجاع الأئمة الأطهار عليهم سلام الله أصحابهم إلى بعض الرواة، رغم انفتاح باب العلم لديهم، وإمكان رجوعه للإمام مباشرة، بل رغم أنه لعله لم يكن عسراً وحرجاً أيضاً، كل ذلك توسعة من الله تعالى على العباد وإمتناناً وجوداً وكرماً.
وهذا كله، مع انفتاح باب العلم والعلمي، أما لو قلنا بالإنسداد، بمقدماته المعروفة، وهي: إن ههنا تكاليف كثيرة، وأنه لا يعقل إهمالها، وقد انسد باب العلم والعلمي بها، وأن العمل بالاحتياط عسر وحرج، والعمل بالأصول في مواردها مستلزم للخروج عن الدين، والقرعة كذلك، وترجيح المرجوح ـ وهو الوهم ـ قبيح ـ، فلا محيص ـ بناء على ذلك ـ من القول بحجية مطلق الظن، وهذا يعني أن الشارع المقدس قد اكتفى من عبيده بـ(الظن) كمؤمِّن من العقاب ومعذِّر على فرض الخطأ، واعتبره منجزاً لتكاليفه على فرض الإصابة.
وليس ذلك خاصاً بالدين والشارع، بل إن كل العقلاء يدركون أن الغاية من العلوم مختلفة، وإن (طبيعة العلوم) مختلفة.
لا يقال: ذلك وإن صح في (الفقه) إلا أنه لا يصح في علم (الكلام) و(العقائد)؛ إذ أن الشارع لا يرضى فيها إلا بالقطع.
إذ يجاب:
أولاً: أصول المعارف العقدية، قطعية، ولم ينسد إليها باب العلم، وأما المنسد إليه باب العلم فهو بعض تفاصيلها الفرعية، كخصوصيات القبر والبرزخ والقيامة والجنة والنار، وكبعض صفات الرسل والأئمة عليهم صلوات الله وسلامه، إلا أن الشارع قد اكتفى فيها بالظنون المعتبرة، كأخبار الثقات والظواهر.
ثانياً: إنه لو فرض عجز مكلف، لكونه في بقعة نائية من الأرض، أو لظروفه الخاصة، من أن يحصل على (العلم) في (العقائد) رغم جِّده وسعيه، فإنه معذور مادام لم يقصر في المقدمات، والشارع يكتفي منه بما أمكنه الوصول إليه من (الظنون النوعية) المعتبرة، وإلا فإنه سيكتفي منه بـ(الظن المطلق) وإن لم يمكنه فرضاً وبقي شاكاً متردداً، ولم يمكنه الاحتياط(15) فإنه ـ حسب المستفاد من الروايات ـ سيُعاد امتحانه يوم القيامة بعد أن تظهر له الحقائق وتتجلى أمامه المعارف.
وعلى أي تقدير، فإن (ظنه) لو أمكنه، (مؤمِّن) له من العقاب، كما أن (فحصه حتى اليأس) مؤمِّن له أيضاً حتى لو لم يفتح له حتى باب الظن المطلق.
صور فتح وغلق باب العلم
والناتج من ذلك كله، الحقائق التالية:
أ: باب (العلم) منفتح في شؤون العقائد، للكثيرين، وعدم انفتاحه فرضاً لشخص مهما بلغ من العلم، لا يسوغ له اطلاق الدعوى بأن علومنا كلها ظنية، نعم له أن يحكم على نفسه بذلك.
ب: وباب العلم وإن كان مغلقاً على البعض، إلا أن باب القطع(16) قد لا يكون منغلقاً عليه، وحجيته على المشهور ذاتية، وأما عندنا فحجية العلم فقط هي الذاتية، إلا أنه على أية حالٍ، معذور لو لم يكن مقصراً في المقدمات، وإن ارتضينا في (مباحث الأصول) أن (المعذِّر) هو (عدم الوصول) لا (القطع).
ج: باب العلم والقطع وإن كانا منغلقين، إلا أن باب الظن المعتبر، منفتح(17) وهو (المؤمِّن) في نظر المولى.
د: لو كان باب (الظن المعتبر) أيضاً مغلقاً ـ وقيل به سواء على نحو الإطلاق أو في أبواب خاصة مما يعبر عنه بالإنسداد الكبير والصغير ـ فإن باب (الظن المطلق) مفتوح، فهو الحجة ولا مناص له من إتباعه، وإلا اتبع المرجوح وهو قسيمه، وذلك قبيح عقلاً، وغير مؤمِّن ولا معذِّر.
هـ: لو أغلقت أبواب العلم والقطع والظن النوعي والظن المطلق، ولم يكن أمامنا إلا (الشك) فإن المرجع هو (الأصول)، وأصل (الاشتغال) و(الاحتياط العقلي) هو المحَّكم في باب العقيدة كلما أمكن، وعلى أية حال، لا يبقى مجال للحيرة العملية، والحيرة النظرية، غير ضارة عندئذٍ؛ إذ يكون الأمر حينئذٍ كما قال الشاعر:
على المرء أن يسعى بمقداره جهده وليس عليه أن يكون موفقاً، وعلى هذا فإنه ليس له أن ينتقل إلى خارج دائرة الاحتياط فيما لو كان مقدوراً، فمثلاً لو شك في وجود الله تعالى وفي المعاد والجزاء والعقاب والثواب فرضاً، ولم يحصل له علم ولا علمي ولا ظن مطلق فرضاً، ومع فرض أنه كان قاصراً(18)، فإن عليه أن (يحتاط نظرياً) بالاعتقاد بوجود الله وبالمعاد، وأن (يحتاط عملياً) بالإلتزام بكل أمر احتمل صدور، منه ـ خارج دائرة العسر والحرج الشديدين ـ وذلك لأن الله لو كان موجوداً والثواب والعقاب ثابتين، لكان هو الرابح، ولو لم يكن موجوداً ولا العقاب ولا الثواب ـ فرضاً إذ الفرض أنه شاك ـ لما أضره الايمان به والعمل بمحتمل أوامره شيئاً، ولو فرض ضرر فإنه أقل الضررين دون ريب، وهذا الجواب مقتبس من رواية شريفة عن الإمام الصادق عليه سلام الله إذ قال لذلك الملحد: (إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن يكن الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكتَ).(19)
7: الكمال قد يكون في الضعف
إن (كمال) كل شيء بحسبه، فقد يكون كماله في قوته، كما قد يكون كما له في ضعفه، وقد يكون كماله في كونه يقينياً وقد يكون كماله في كونه ظنياً.
توضيح ذلك:
إن الحقائق من حيث نسبتها لكل من القوة والضعف، على أربعة أقسام:
1. فقد يكون الشيء، من مصاديق (ما قوته في قوته).
2. وقد يكون من أفراد (ما قوته في ضعفه).
3. وقد يكون من مفردات (ما ضعفه في ضعفه).
4. وقد يكون من جزئيات (ما ضعفه في قوته).
القسم الأول: ما قوته في قوته
مثل (الحديد) و(الفولاذ) فإن قوته في صلابته، ومثل الرياضي والمهندس. ومن هذا القبيل (القطع والعلم) فيما من شأنه أن يقطع به ويعلم.
القسم الثاني: ما قوته في ضعفه
مثل (الماء) و(الغضروف) فإن قوته في مرونته، وكذلك (المرأة) و(الطفل)، فإن قوتها في كونها (ريحانةً وليست بقهرمانة)(20)، وقوة الطفل في رِقته وضعفه واعتماده على أبويه وبكائه.
ومن ذلك أيضاً (اللامركزية الإدارية) في التنظيمات أو الحكومات الاستشارية أو الديمقراطية؛ فإن قوة اللامركزية في ضعفها وهشاشتها. عكس (المركزية) ـ كما في الأحزاب الدكتاتورية والشيوعية ـ فإن ضعفها في قوتها.
ومن هذا القبيل (الظن) فيما من شأنه أن يُظن فيه، ومن ذلك (الظن بالنجاح في الامتحان، أو المسابقات؛ لا القطع) فإن الظن يشكل حافزاً للمثابرة والجد وأخذ الحيطة بكثرة المطالعة والإعداد والاستعداد، أما (القطع) بالنجاح فإنه من أقوى المثبطات عن الجدية في الدراسة.
القسم الثالث: ما ضعفه في ضعفه
مثل (الوسواس) المبتلى بمرض الوسوسة. و(الشكاك) في كل شيء وأمر، دون أن يتخذ من (الشك) حافزاً وباعثاً للحركة والبحث والتنقيب.
وكذلك (الطفل والمرأة والغضروف) و(الماء) من جهة أخرى؛ فإن لضعف (الطفل) مثلاً جهتين: جهة حسن وكمال، وجهة نقص وحاجة، فإن (ضعفه) من جهة هو (ضعفٌ) قد يجعله عرضة لسوء الاستغلال، والظلم، وحتى السرقة فالاستعباد، و(ضعفه) من جهة أخرى (قوة) لأن جماله ودلاله في ضعفه، ولأن ضعفه يستدعي العطف والحنوّ عليه.
وإذا أدرك المرء، كلتا جهتي الضعف والقوة، في الشيء الواحد، فإنه سيكون أكثر كمالاً ولا يغمط شيئاً، حقه، فلا يرفعه فوق مستواه ولا يخفضه عنه.
ومن هذا القبيل: (الظن) فيما من شأنه أن يقطع فيه، كالظن في المسائل الرياضية والهندسية.
القسم الرابع: ما ضعفه في قوته
مثل (قطع القطّاع) ومن هو شديد الاعتداد بنفسه حتى العجب والغرور.
ومن هذا القبيل (القطع) فيما من شأنه أن يظن فيه.
وهذه الأقسام الأربعة، تعد بمجموعها من دلائل كمال الخلق وجمال الخلقة، ومن الأدلة على عظمة الخالق، وقدرته، وحكمته، وعطائه عطاء غير مجذوذ؛ إذ أعطى كل الماهيات المتطلبة بلسان حالها للوجود ما تطلب، بل نقول: إن (تكامل الحياة) مبني على ظنية كثير من العلوم أو ظنية كثير من مسائل تلك العلوم.
وما يهمنا في هذا المبحث التوقف عنده، هو الصورة الثانية فقط (ما قوته في ضعفه) إذ مادام ذلك كذلك فإن الانتقال أو السعي للانتقال من دائرة الضعف إلى دائرة القوة، بل حتى من دائرة الضعيف إلى دائرة الأضعف مرجوح، وذلك كأن يسعى لتحويل الغضروف صلباً بصلابة العظم أو اللا مركزية إلى المركزية، أو أن ينتقل من الظن بالنجاح إلى القطع به، بالتوسل بالعلوم الغريبة مثلاً على العكس من أن ينتقل من الظن بالنجاح إلى الوهم به أي إلى أن يحتمله احتمالاً ضعيفاً ـ عبر التلقين والتشكيك والوسوسة مثلاً ـ مما يبعث في روحه اليأس والاحباط، فيترك بذل الجهد فيما تبقى من الوقت، وإن كان ذلك ينتج في البعض، عكس ذلك،إذ يزداد إصراراً وعزيمةً وجِدية.
ومن ذلك ظهر بطلان الاستنتاج الثاني(21) وعلى هذا يقبح عقلاً الانتقال من دائرة الظنون النوعية أو الظن المطلق، على الإنسداد، إلى الموهومات والأحلام وأقوال وآراء غير المجتهد المتخصص ـ وما أكثر من يفعل ذلك ـ أو حتى أن يسعى لأن ينتقل من دائرة الظنون النوعية في مثل الفقه والأصول والرجال والطب وشبههما، إلى دائرة (القطع) عبر الطرق غير العقلائية، كالرمل والاسطرلاب وقراءة الكف والفنجان والقياس وغيرها، فلو فرض أنه لو سلك هذه السبل لحصل على القطع بالحكم الشرعي، فإنه يقبح لدى العقلاء سلوكها مادامت غير عقلائية، كما يقبح لدى الشرع ذلك ولذا ألزم الشارع باتباع الطرق العقلائية، وتجنب غيرها.(22)
كما ظهر خطأ الاستنتاج الثالث، لأن وجود الله وعدله، ووجودنا، ووجود ثنائية الحق والباطل والمائز بينهما هو من مصاديق (ما قوته في قوته) فإن قوة المعرفة في أمثال تلك القضايا، بأن تكون يقينية.


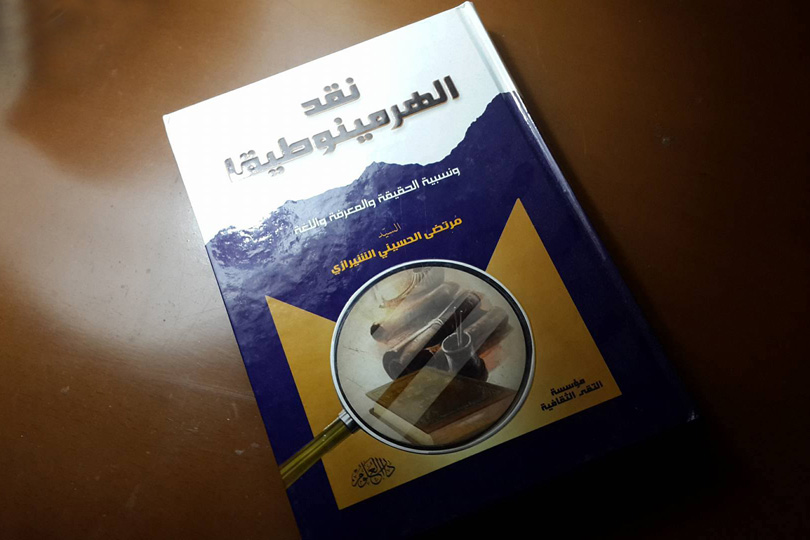

اضف تعليق