لا شك بأن حماية حقوق المؤلف جزء لا يتجزأ من الضمير الإنساني والنشاط الفكري لصاحب النتاج الذهني خاصة وللمجتمع الإنساني عامةً، فالعمل الفكري حقًا هو امتداد لشخصية المبدع وكيانه المعنوي وترجمه لما يمتلكه من قدرات إبداعية وملكّات ذهنية، كما أن فيه تشجعًا له ولغيره على مواصلة العطاء الفكري وأداء دوره الخلّاق في الإبداع والابتكار...
في زمنٍ باتت فيه النتاجات الفكرية تعبر الحدود بسرعة تفوق حركة البشر، وتنتشر عبر الوسائط الرقمية من دون قيود مكانية أو زمنية، تتصاعد الحاجة إلى منظومة قانونية رصينة تضمن للمؤلفين حقوقهم وتحفظ لمجتمعاتهم ثمار إبداعاتهم. هنا يبرز كتاب الدكتورة رشا موسى محمد الزهيري، التدريسية في كلية القانون بجامعة كربلاء، الموسوم بـ "حماية حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية"، بوصفه محاولة علمية جادة لتفكيك الإشكاليات التي يثيرها موقع المؤلف في ظل تباين التشريعات واختلاف الفلسفات القانونية بين النظم اللاتينية والأنجلوسكسونية.
الكتاب لا يكتفي بقراءة النصوص القانونية، بل يغوص في أبعادها الإنسانية والفكرية، ليؤكد أن حماية نتاج المؤلف ليست مجرد مسألة تشريعية أو اقتصادية، بل هي امتداد لصيانة الكرامة البشرية وتشجيع الإبداع بوصفه رافعة للتقدم الحضاري. ومن هنا، فإن الحوار مع الدكتورة الزهيري يفتح أبواباً مهمة لفهم دوافع اختيار المنهج المقارن، والتحديات التي صاحبت تحديد المركز القانوني للمؤلف، والفجوات القائمة بين الحماية الوطنية والالتزامات الدولية، فضلاً عن رؤيتها لمستقبل حقوق المؤلف في ظل التحول الرقمي والعولمة الثقافية.
ما الاعتبارات الفكرية والإنسانية التي جعلت من حماية نتاج المؤلف جزءًا من صيانة الكرامة البشرية عبر الحدود؟
لا شك بأن حماية حقوق المؤلف جزء لا يتجزأ من الضمير الإنساني والنشاط الفكري لصاحب النتاج الذهني خاصة وللمجتمع الإنساني عامةً.
فالعمل الفكري حقًا هو امتداد لشخصية المبدع وكيانه المعنوي وترجمه لما يمتلكه من قدرات إبداعية وملكّات ذهنية، كما أن فيه تشجعًا له ولغيره على مواصلة العطاء الفكري وأداء دوره الخلّاق في الإبداع والابتكار، أما انعكاس حماية حقوق المؤلف عبر الحدود على المجتمع الإنساني فهي تتجلى في أنها الأساس لارتقاء أي مجتمع سُلم الحضارة، فالعقل البشري حينما يتوصل الى إبداعٍ ما في صورة نتاج علمي أو أدبي أو فني، إنما يُسهِم في إثراء البشرية بمعارف وعلوم نافعة وجديدة من شأنها دفع عجلة التطور والتنمية في أي دولة تصل إليها النتاجات الذهنية.
من هنا استقطب موضوع حماية حقوق المؤلف عبر الحدود جهودًا حثيثة ومتواصلة من أجل حمايتهِ حماية فعّالة تُوازي دورهُ في خدمة الأفراد والجماعات.
ما التحديات التي صاحبت تحديد المركز القانوني للمؤلف في ظل تشابك العلاقات الخاصة الدولية؟
في الواقع، تحديات عدة تُثار عندما يُراد تحديد المركز القانوني للمؤلف في العلاقات الخاصة الدولية، فالموضوع لا يُثير إشكالًا إذا كان المؤلف شخصًا طبيعيًا واحدًا مُستقلاً غير مرتبط بعقدٍ ما مع غيره، لكن الأمر ليس كذلك في حال تعدد المؤلفين لمصنفٍ واحد –لا سيما إذا كان أحدهم شخص معنوي-أو كان المؤلِف متعاقدًا مع الغير من أجل ابتكار المؤلَف، إذ قد تطرق مشكلة من هو المؤلف في هذه الفروض، ولعل ما يزيد من المسألة تعقيدًا أنها تُثير العديد من الصعوبات في أحوال الاستغلال الدولي للمصنفات بين بلدان مختلفة في أنظمتها القانونية، فمن جهة، نجد أن الأنظمة القانونية اللاتينية كفرنسا وأغلب الدول العربية تُؤكد على مدى دور المؤلف في الابتكار الذهني للمصنف، ومن جهة أخرى نجد أن الأنظمة الأنجلوسكسونية كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والتي تُركِز على الجانب الموضوعي لحق المؤلف والمتمثل بالنتاج الذهني-المصنف- أكثر من الاهتمام بالجانب الشخصي لهذا الحق.
ولما كانت القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية المختصة بحماية حق المؤلف قد أجمعت على مدِّ نطاق حمايتها للمؤلف الأجنبي إسوةً بالمؤلف الوطني، فإنهُ لا يكون أمامنا إلا أن نُطبِق على الأول القواعد الواردة بشأن الثاني فيما يخص تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف المؤلف.
والمتتبع لنصوص القانون العراقي المتعلق بحماية حق المؤلف رقم (3) لسنة1971النافذ يجد أنه لم يُقدم تحديدًا لوصف المؤلف، بل وضع معيارًا وقرينة قانونية تقضي بثبوت صفة المؤلف لكل من نشر مصنفًا منسوبًا إليهِ، ونهج المشرع العراقي يتفق مع التشريعات العربية ومع بعض الاتفاقيات الدولية-لا سيما اتفاقيتي برن وتربس، فهو يأخذ بمعيار شكلي يُبعدهُ عن الخوض في تفاصيل من هو المؤلف الجدير بالحماية، الأمر الذي يُثير العديد من التساؤلات حول الشخص المؤهل للحماية باعتباره مؤلفًا.
فالمتأمل في القوانين المقارنة الخاصة بحق المؤلف يُدرك أنه يوجد اتجاهان تشريعيان في تحديد صفة المؤلف، أولهما، ينظر الى المؤلف على أنهُ المبتكِر الفعلي للنتاج الذهني، وهذا هو الاتجاه الشخصي، وثانيهما، يرى أن صفة المؤلف يكتسبها من يمنحهُ القانون الحقوق والامتيازات المترتبة على حق المؤلف، وهذا هو الاتجاه الموضوعي، والواقع أن الاتجاه الشخصي في تحديد صفة المؤلف إنما يكشف عن فلسفة شخصية تُسيطر على قواعد الحماية الملكية الأدبية والفنية، هذه الفلسفة التي تُركِز على شخصية المؤلف باعتباره محور اهتمام هذه القواعد يعقبه تحدٍ آخر يتجسد في تحديد القانون الواجب التطبيق على صفة المؤلف، وهنا قرر البعض بأن صفة المؤلف تثبت بتطبيق قانون دولة الحماية بغض النظر عن قانون بلد النشر الأول للمصنف، والملاحظ بأن القواعد القانونية لدولة الحماية تنطبق كونها قوانين بوليس أو قواعد ذات تطبيق ضروري( )والتي تطبق مباشرةً على المسألة المعروضة وهي هنا صفة المؤلف. أما الاتجاه الموضوعي فيرى أن الحماية التشريعية تنصب على طبع المصنفات ونشرها دون الاعتداد بالصلة الحميمة التي تربط بين النتاج الذهني وبين شخصية المؤلف، ويُؤيد هذا الأمر في الواقع المبدأ الإنكليزي القائل بأن ((جدارة الحماية ترتبط بالطبع والنشر))، فالأولوية تكون للناشر وليس للمؤلف، ولعل من أبرز القوانين الأنجلوسكسونية التي تُحدد صفة المؤلف وفقًا للاتجاه الموضوعي هو قانون حماية حق المؤلف الأمريكي الصادر عام 1976 وقانون حماية حق المؤلف البريطاني عام 1988. وعليهِ، فإنه وفقا لهذا الاتجاه فإن مسألة تحديد "من هو المؤلف" هي مسألة قانون، بمعنى أن القانون يفترض وبغض النظر عن الواقع بأن المؤلف هو من يملك الحقوق ولو لم يكن لهُ أي دور في الإبداع الذهني للمصنف، دون إعطاء أهمية تُذكر لمدى ارتباط هذا العمل بشخصية صاحبه، وهو ما يُثير إشكالية تتعلق بالمعايير أو الشروط اللازم توافرها حتى يتمكن المؤلف من اكتساب هذه الصفة(أي صفة المؤلف)، وهنا أجابت العديد من القوانين الأنجلوسكسونية عن هذه الإشكالية بقولها بالأخذ شرط الصلاحية أو شرط التأهيل للحماية، بمعنى البحث عن كونهم مكتسبين لجنسية الدولة التي يُراد حماية مصنفهم فيها أو كون محل موطنهم أو إقامتهم المعتادة فيها، وهذا الشرط يؤدي الى آثار سلبية تتمثل في إحجام المؤلفين الأجانب عن تقديم مبتكراتهم الذهنية في داخل الدولة لعدم توفير القانون الوطني الحماية اللازمة لحقوقهم.
ما دوافع اختيار المنهج المقارن كأساس لدراسة هذه الإشكالية المعقدة بين النظم القانونية المختلفة؟
لقد عرضنا لمؤلفنا((حماية حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية))بأسلوب المنهج المقارن، من أجل إبراز الخلاف التشريعي الكبير بين اتجاهين مختلفين، فمن جهة الاتجاه اللاتيني المتمثل بالتشريع العراقي وباقي التشريعات العربية والتشريع الفرنسي التي تُركز على دور المؤلف في عملية الإبداع الذهني ومدى أهمية حماية حقوقه الأدبية كونها جزء لا يتجزأ من شخصيته، وبالمقابل الاتجاه الأنجلوسكسوني الذي يتجسد بالتشريع الأمريكي الذي لا يأبه كثيرًا لشخصية المؤلف وما يتمتع به من حقوق ذات طبيعة أدبية، وإنما التركيز على العوائد الاقتصادية المترتبة على طبع ونشر المصنف.
ما أهمية دمج التطبيقات القضائية في الدراسة، وكيف أسهمت في تقوية البُعد العملي للبحث؟
لا يخفى أن بحث أي موضوع قانوني لا يكفي فيه الجانب النظري، بل لابد من ذكر السوابق القضائية كونه يساهم في تفسير وتحليل التشريعات الحالية، ويعمل على إيجاد حلول للمشكلات القانونية، فضلاً عن أنه يُعزز الفهم العميق للنص القانوني ويسمح بالتعامل مع المستجدات القانونية، وبعبارة موجزة، إن أهمية الموضوع من الناحية العملية وفي كونه محل للعديد من القرارات القضائية التي تصدر المحاكم بمختلف أنواعها، وجدنا لِزاما علينا تسليط الضوء على العديد من التطبيقات القضائية.
ما السياقات القانونية التي برز فيها قصور الفقه العراقي تجاه هذا الموضوع مقارنة بالفقه المقارن؟
هناك عدة مأخذ تم تسجيلها على التشريع والفقه العراقي سنبينها كما يلي:
-لقد لاحظنا بأن التشريع العراقي كونهُ منح صفة المؤلف للشخص الطبيعي أو المعنوي الموجه لإبداع المصنف الجماعي، ولقد عارضنا ذلك، كون أن المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي ساهم حقيقةً في إبداع المصنف، وأن الشخص المُوجِه، لا سيما إذا كان معنويًا لا يستطيع أن يكتسب هذه الصفة نظرًا لافتقاره الى القدرة على الإبداع والابتكار الذي يُعد مناط الاعتراف بصفة المؤلف.
-توصلنا بأنه في حال تعدد أفعال الاعتداء على حق المؤلف بحيث وقع كل فعل في دولة يجعل ضرورة تطبيق قانون دولة الحماية في كل دولة وقع بها فعل الاعتداء على حق هذا المؤلف، وهذا الموقف الفقهي الذي أيده القضاء الفرنسي كان محل تحفظنا، كون أن تطبيق هذه القوانين المتعددة يتطلب إلمام القاضي الوطني بقواعد الإسناد والقواعد الموضوعية الواردة في قوانين حماية حق المؤلف للدول الأخرى لكي يُحكم بتعويض شامل لكل الأضرار التي سببتها أفعال الاعتداء على حقوق المؤلف أيًا كانت جنسيته، وهو أمر عدةً يصعب تطبيقه من الناحية العملية.
-لاحظنا بأن المشرع العراقي قد تطرق لحكم مصنفات المؤلفين الأجانب المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة داخل العراق، إذ يُطبق عليها مبدأ المعاملة الوطنية-أي المساواة بالمؤلف الوطني الذي نشر مصنفه لأول مرة بالعراق-، في حين انتقدنا صمت المشرع العراقي عن إيراد نص يبين القانون الواجب التطبيق على مؤلفات الأجانب المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة خارج العراق، فذلك سيكون سبب في عزوف المبدعين والمثقفين الأجانب عن إعادة توزيع ونشر مصنفاتهم داخل العراق كون أنها غير محمية بسبب أن النشر الأول تم خارج العراق. لذا دعونا لإجراء تعديل على نص م49 من قانون حماية حق المؤلف العراقي ينص على حماية المصنفات الفكرية أينما حل أول نشر أو عرض أو تمثيل لها سواء داخل العراق أو خارجه أيًا كان القانون الشخصي الذي ينتمي إليه المؤلف، ما دام أن هذه المصنفات تحمل طابع الابتكار والأصالة وغير متعارضة مع النظام العام والآداب العامة للعراق، فضلاً عن مراعاة مصلحة المؤلفين الأجانب في نشر وعرض مصنفاتهم في العراق بدون قيود من أجل خلق حافز لديهم ولدى غيرهم على مواصلة الإبداع الفكري.
-كما برز قصور التشريع العراقي بسبب أن الإجراءات التحفظية التي قررها مشرعنا لمواجهة ضرر محتمل أو ضرر وقع بالفعل هي إجراءات اختيارية وليس وجوبية، ولذا دعونا الى زيادة فاعلية وقوة هذه الإجراءات من خلال النص على إلزاميتها.
-وجدنا قصور مشرعنا بكون الجزاء المترتب عند الاعتداء على حقوق المؤلف الوطني والأجنبي هو الغرامة، ووجدنا بأن الجزاء غير رادع، ولذا دعونا الى النص على عقوبة الحبس الى جانب عقوبة الغرامة ليحكم بكليهما أو إحداهما بحسب خطورة ودرجة الاعتداء، ليكون الجزاء أكثر فائدة بتحقيقه للردع والزجر للمعتدي ولغيره.
ما الفجوات التي تم رصدها بين الحماية التشريعية للمؤلف داخل الدولة وبين التزام الدولة باتفاقيات دولية تُعنى بالحق نفسه؟
نعم هناك عدة فجوات ما بين الحماية التشريعية وما بين الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين تم رصدها تتمثل بما يأتي:
لاحظنا بأن ذلك تحقق ما بين عموم التشريعات محل المقارنة وبين اتفاقية برن، فقد تبيّن أن هناك قصورًا يشوب نص المادة (6/ثانيًا)والتي اشترطت لتفعيل حق المؤلف الوطني والأجنبي في دفع الاعتداء الواقع على المصنف المساس بشرف واعتبار صاحب المصنف شخصيًا عند ممارسة هذا الأخير لِمكنة منع الاعتداء الواقع على مصنفه، فقد توصلنا بأن الحق في احترام تكامل المصنف لا يرتبط فقط بالشرف والاعتبار، إلا في حالة نادرة جدًا، وذلك عندما يرتبط الأمر بتشويه أو تحريف فاحش بحيث من الممكن أن يُسيء الى سمعة المؤلفين الأجانب والوطنيين واعتبارهم الفكري، أما غالبية الاعتداءات فهي تكون بعيدة عن الإضرار بشرف المؤلفين واعتبارهم. وعليهِ، طالبنا بتعديل هذا النص المعيب عن طريق النص على منع الاعتداء الواقع على المصنف عموما لطالما يمس اعتباره الشخصي أم اعتباره الفكري لتضمن الاتفاقية بذلك شمول جميع أنواع الاعتداءات بالمنع طالما كونها تمس تكامل المصنف واحترامه، وحذف الشرط الخاص (بالإضرار بشرف المؤلف واعتباره).
كما تبين اختلاف كبير بين المواقف التشريعية للدول التي تتبع النهج اللاتيني حول ضرورة حماية الحقوق الأدبية لنتاجات المؤلفين وبين اتفاقيتي جنيف وتربس الدوليتين اللتين أغفلتا الإشارة تمامًا للحقوق الأدبية، وقد انتقدنا هذا الموقف الأخير نظرًا لأهمية هذه الحقوق في صيانة الاحترام الواجب للإبداعات الفكرية وحمايتها ضد كل اعتداء يمس الاعتبار الأدبي للمؤلف الأجنبي والوطني على حد سواء. لذا طالبنا بالنص على حماية هذه الحقوق بالشكل الذي يضمن احترامها من قبل جميع الدول المنظمة الى هذه الاتفاقيات، وذلك لأجل تشجيع حركة انتقال النتاج الذهني عبر غالبية دول العالم للاستفادة من أصحاب العقول المبدعة في عملية التقدم والنهوض الفكري.
ما الرؤية التي دفعت إلى اعتبار الحقوق المعنوية امتدادًا لشخصية المؤلف، رغم هيمنة منطق السوق على بعض التشريعات؟
إن هذا المنحى في التكييف دقيق وصائب كون أن للحق الأدبي للمؤلف غايات أكثر سموًا من غايات وأهداف السوق التي تُغلِب الحقوق المادية ومنطق الربح، فالحق الأول يهدف الى حماية فِكر المؤلف من التشويه والتحريف حتى يظل النتاج الفكري صورة صادة لآراء صاحبه، على حين يهدف الحق المالي الى حماية الاستغلال الاقتصادي للمصنف من أجل الحصول على المنافع المالية المترتبة على ذلك الاستغلال.
إذ لا جدال بأن المصالح التي يحميها الحق الأدبي هي من نوع يعلو كثيرًا على الحصول على قدر من المال لقاء استغلال الملكة الذهنية لصاحبها، وبعبارة أخرى، أن النتاج الذهني هو خُلاصة مجهود فكري تم صقله وبلورته في وعاء مادي فهو بالتالي لا يُقدر بمال ولا يعبأ بحسابات السوق.
ما الأثر الذي يُحدثه اختلاف الفلسفات القانونية بين النظام اللاتيني والأنجلوسكسوني في مصير الحماية الأدبية لحقوق المؤلف؟
من المعلوم بأن مقصود الحماية للحقوق الأدبية الأول هو التعبير عن الأفكار أما الحماية للحقوق المالية لتلك الأفكار ما هو إلا نتيجة وأثر.
وفي الواقع، إن المترتب على الاتجاه التشريعي اللاتيني الذي يشتهر بحمايته للحقوق الأدبية للمؤلفين هو أنه لا يمكن إطلاق لقب مؤلف إلا على الشخص الطبيعي الذي ابتكر النتاج الذهني فعلاً، فهذه الحقوق-وفقًا للنظام اللاتيني- هي حقوق لصيقة بالشخصية، وبالتالي فإن صيانتها أمر لازم لاحترام صاحب الإبداع الذهني ومن ثم تشجيعه على مزيد من النتاجات الذهنية.
أما الاتجاه التشريعي الأنجلوسكسوني ينظر الى حق المؤلف مُستندًا على تقدير مدى التوازن المتحقق بين حاجات منتجي حقوق المؤلف في مواجهة حاجات مُستهلكي حقوق المؤلف، هذا التقدير الذي يجعل من المؤلفين على هامش حمايته.
وفي تقديرنا، بأن الاتجاه التشريعي الأول، هو الأولى بالقبول والإتباع، كونه راعى المنطق الذي يقضي باحترام صاحب المصنف الحقيقي، كما راعى جانب العدالة، وذلك من خلال ترجيح البعد الذهني للمصنف باعتباره وليد الدور الخلّاق لِمن قام بابتكاره، وهو ما ينعكس إيجابًا على عملية الإثراء الفني والأدبي والعلمي للتراث الثقافي بين الشعوب المختلفة.
ما التحديات التي واجهت فكرة ترسيخ الحق الأدبي للمؤلف في بيئات قانونية لا تعترف به كحق مستقل عن المالي؟
في الواقع، إن الاتجاه الأنجلوسكسوني قد أعطى الأهمية لمن نظم النتاج الذهني وليس لِمن أبدعه وابتكره، وهذا الإغفال القانوني الصريح للحماية الفاعلة للحقوق الأدبية قد جعل من نشر المصنف وتحمل أعباءً مالية مؤلفًا أيضًا غاضًا النظر عما بذله المؤلف الفعلي من جهود مضنية تُظهر شخصية مبدعها الحقيقية في صورة عمل أدبي أو فني أو علمي. ناهيك عن سهولة الاعتداء على الحقوق الأدبية للمؤلفين وفقًا لهذه الأنظمة بسبب إعلاء القيمة المالية للمؤلفات على حساب القيمة المعنوية لها وما يمثله من إهدار للجهد الخلّاق المبذول الذي يعتمد على الإسهام الشخصي لفكر المؤلف الحقيقي، ونضيف لكل ما تقدم، بأن الأخذ بالاتجاه الأنجلوسكسوني الذي اصطبغ بالصبغة المادية لحوق المؤلف، من شأنه أن يُقلل الحافز الذي يدفع المؤلف الوطني والأجنبي الى الانصراف في عملية الابتكار والإبداع الفكري المفيد للبشرية، لطالما أن صفتهما (كمؤلفين)غير محمية وممنوحة خلافًا لقواعد العدالة لشخص آخر أو تجعل هاجس التأليف وغايته البحث عما يحقق أرباح مالية بغض النظر عن مدى إفادة المجتمع من هذا النتاج الفكري.
ما الأسباب التي جعلت بعض التشريعات تُهمل البعد الأدبي في حماية المؤلف، مقابل تركيزها على الحق المالي فقط؟
لعلنا نُفسر ذلك بأن النظام الرأسمالي الذي تعتنقه الأنظمة القانونية الأنجلوسكسونية-وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية-قد انعكس على إغفالها للحقوق الأدبية وتركيزها على الحقوق المالية، بحيث جعلت لقب مؤلف يمكن أن يُطلق على أي شخص يستأثر بحقوق المؤلف بجانبها المالي. فالأولوية في هذه المجتمعات هو التأليف لأجل تحقيق أرباح مالية بغض النظر عن مدى إفادة المجتمع من هذا النتاج الفكري.
ما الفوارق المفصلية التي ظهرت في موقف قوانين الدول العربية من حقوق المؤلف، رغم انتمائها جميعًا لبيئة ثقافية متقاربة؟
بصورة عامة تشابهت المواقف التشريعية للدول العربية حول موقفها من حماية حقوق المؤلف والسبب الرئيسي لذلك هو انتمائها للنظام اللاتيني، عدا بعض الاختلافات من بينها:
1-فلقد لاحظنا بأن قانون حماية حق المؤلف الإماراتي وقانون حماية حق المؤلف القطري قد اعترفا بالمصنف الجماعي الذي يضعهُ شخص واحد، رغم أن العنصر الأساس لقيام المصنف الجماعي هو تعدد المؤلفين.
2-تبين لنا بأن المشرع العراقي قد أقر صراحةً بملكية حقوق المؤلف للعامل المبتكر باعتباره مؤلفًا في المصنفات المبتكرة في ظل عقد عمل، وكان هذا شأن التشريع الأردني والكويتي والبحريني والجزائري والفرنسي، في حين اتجهت تشريعات أخر إلى الاعتراف صراحةً بأن ملكية حق المؤلف إنما تثبت لرب العمل لا للعامل المبتكر ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك وهذا ما سار عليه التشريع اللبناني والمغربي.
3- بدا لنا بأن المشرع العراقي قد عدل المادة(49) من تقنين حماية حق المؤلف وفيها تطرق لحكم مصنفات المؤلفين الأجانب المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة داخل العراق، إذ يُطبق عليها مبدأ المعاملة الوطنية-أي المساواة بالمؤلف الوطني الذي نشر مصنفه لأول مرة بالعراق-، في حين انتقدنا صمت المشرع العراقي عن إيراد نص يبين القانون الواجب التطبيق على مؤلفات الأجانب المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة خارج العراق، فذلك سيكون سبب في عزوف المبدعين والمثقفين الأجانب عن إعادة توزيع ونشر مصنفاتهم داخل العراق كون أنها غير محمية بسبب أن النشر الأول تم خارج العراق.
4-انفرد المشرع الجزائري بأن أقر الحق في حساب العائدات المالية المترتبة على حق عمل نسخ او نماذج من المصنف وإتاحتها للجمهور لتوزيعها على وفق نسب معينة على مُبتكري ومُبدعي النتاجات الذهنية، وهذا الموقف يخالف باقي المواقف التشريعية التي أباحت استخدام المصنف عن طريق نسخه، فتعددت الجهات وتعددت الأغراض التي تستطيع ذلك دون إعطاء المقابل المادي للمؤلف الأجنبي أو الوطني بحجة أن التشريع الوطني قد أباح هذا النسخ.
5-إن التشريع العراقي قد انفرد بتنظيم إجراء مصادرة المصنف محل الاعتداء –أي انتقال ملكية المصنف الى الدولة بدون تعويض-ضمن الإجراءات الوقتية المنصوص عليها في قانون حماية حق المؤلف، خلافًا للتشريعات الأخرى التي لم تتطرق لإجراء المصادرة ضمن القوانين الخاصة بحوق المؤلف كونه من الجزاءات الجنائية.
ما نقاط الالتقاء والافتراق بين التشريعين الفرنسي والأمريكي في معالجة حق المؤلف ذي البُعد الدولي؟
إن أوجه الاتفاق بين التشريع الفرنسي والتشريع الأمريكي تتضح في أن:
- كليهما قد أجاز ممارسة حق نسخ المصنف المبتكر من مؤلف أجنبي من قبل الجمهور –كالاستعمال الشخصي للناسخ أو الاستخدام في الدراسات والأبحاث وإجراء أبحاث والتحليلات والاقتباسات القصيرة بقصد النقد أو الجدل أو الأخبار أو لأغراض تعليمية تتعلق بالشرح والإيضاح-دون أن يستطيع أحد الاعتراض على ذلك.
-كما اتفقا بحق الأداء العلني للمصنف بحيث يُعرض المصنف في مكان عام يستطيع الجميع ارتياده ولو في مقابل أجر.
-كلا التشريعين أجازا التنازل عن ملكية المؤلف الأجنبي والوطني في جانبها المالي جميعها أو جزء منها.
-كلا التشريعين قد قررا إمكانية الحجز على نسخ المصنف المقلد تحاشيًا لتهريب المصنفات المقلدة والتصرف فيها، ومن أجل منع المتنافسين الآخرين من التمادي في التعدي على حقوق المؤلف الأجنبي والوطني.
-كلا التشريعين قد جعلا عقوبة ارتكاب جريمة تقليد المصنفات هي عقوبة الحبس والغرامة.
أما أوجه الاختلاف بين التشريع الفرنسي والتشريع الأمريكي تتضح في أن:
-أبرز اختلاف قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي و قانون حماية حق المؤلف الأمريكي هو اهتمام المشرع الفرنسي بالحقوق الأدبية للمؤلف كونها جزء من شخصيته، بالمقابل أهمل المشرع الأمريكي هذه الحقوق مُغلبًا الحقوق المالية عليها.
-إن قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي قد أخذ بإجراء تحفظي لحماية حقوق المؤلف الأجنبي والوطني وهو إجراء وقف الاعتداء على المصنف، ولا يوجد مقابل في التشريع الأمريكي الخاص بحماية حق المؤلف.
-كما اختلف التشريع الفرنسي في تقرير جزاء المسؤولية المدنية وهو التعويض في حالة واحدة تخص الاعتداء الذي يحصل على مصنفات الفن التصويري ومصنفات الفن المعماري والغير قابلة لنقل ملكيتها لشخص آخر دون إذن صاحبها، أما قانون حماية حق المؤلف الأمريكي فقد جعل القاعدة في المسؤولية المدنية هي طلب إتلاف النسخ أو التسجيلات التي استخدمت في الاعتداء على مالك حقوق الاستغلال المالي فضلاً عن حق طلب التعويض والأرباح في أي وقت يشاء قبل تلاوة الحكم النهائي.
-لا يوجد نص في قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي يُدلل على انه يأخذ بمبدأ المعاملة الوطنية بين المؤلفين الجانب والوطنيين، خلافًا لقانون حماية حق المؤلف الأمريكي الذي أخذ بهذا المبدأ(م104) لحماية حقوق المؤلفين الأجانب طالما كانت مصنفاتهم غير منشورة، أما إذا كانت مصنفاتهم قد نُشِرت، فإنها لا تخضع لمبدأ المعاملة الوطنية إلا إذا كان مؤلفوها يُقيمون في داخل الدولة، أو كانت هذه المصنفات تتمتع بالحماية بموجب معاهدة دولية تكون الدولة طرفًا فيها.
ما ملامح القصور التي ظهرت في وسائل الحماية الداخلية، وكيف أمكن مقارنتها بفاعلية الحماية الدولية؟
من المعلوم إن النتاج الذهني يتسم بصفة الدولية التي تجعل من حمايتهِ مسألة لازمة وتنتشر بين كافة دول العالم وبغض النظر عن جنسية المؤلف أو موطنه، ناهيك عن ضرورة تشجيع هذا النتاج وحمايته لما فيه خير الإنسانية وتحقيق تقدمها المنشود.
وعليهِ، فإن حاجة المؤلفين الأجانب الى حماية لإبداعاتهم الفكرية من الناحيتين المعنوية والمادية فرضت ضرورة توفير وسائل حماية دولية لحقوقهم وفقًا لمبدأين هما، مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل.
ما مبررات تناول قواعد تنازع الاختصاصين القضائي والتشريعي، رغم ورودها كعناصر غير أساسية في خطة البحث؟
يتركز موضوع المؤَلَف في نطاق القواعد الموضوعية من بين قواعد القانون الدولي الخاص، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الأجنبي والوطني، متى ما كانوا مؤلفين، وبعبارة أكثر تحديدًا يختص موضوعنا ببحث مركز المؤلفين الأجانب والوطنيين سواء من حيث الحقوق المقررة لهم أو من حيث وسائل الحماية المحددة لهذه الحقوق، أما فيما يخص قواعد تنازع الاختصاص التشريعي وقواعد تنازع الاختصاص القضائي، فقد تمت الإشارة إليها في مواضع متفرقة من الكتاب بصورة سريعة وبعبارات موجزة حرصًا منا على الإلمام بأكبر قدر ممكن من جوانب الموضوع لأنه واقع ضمن نطاق العلاقات الخاصة الدولية، فقواعد التنازع لا تمثل عناصر أساسية في محتويات مؤلفنا.
ما الاعتبارات التي دفعت إلى تخصيص فصل كامل لوسائل الحماية الدولية في ظل هيمنة الاتفاقيات متعددة الأطراف على هذا المجال؟
تم التطرق لوسائل الحماية الدولية في مبحث كامل منبثقين من دراسة المبادئ الأساسية التي يتبناها القانون الدولي الخاص في مجال حماية المركز القانوني للأجانب وهما مبدآن، مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل، ومن خلالهما استعرضنا المواقف التشريعية والاتفاقيات الدولية، مع ملاحظة بأن كثير من التشريعات محل المقارنة قد أجرت تعديلات على فوانيها الداخلية لكي تكون منسجمة مع التزاماتها الدولية التي يفرضها عليها الانضمام لكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف.
ما أوجه الخلل التي كشفت عنها الدراسة في تعامل القضاء العربي مع قضايا حماية المؤلف ذي الصفة الدولية؟
لقد كشفت الدراسة عن هوة كبيرة بين ما موجود من حلول ومواقف قضائية تقليدية وبين التطورات التكنولوجية والتقدم في مجال حقوق المؤلف، والتي جعلت ضرورة إيجاد نظام قضائي يسبقها مراجعة النصوص تشريعية تنسجم مع حجم المعطيات الجديدة الحاصلة في مجال حقوق المؤلف، والمتمثلة بزيادة أنواع الاعتداء على حقوق المؤلف ذي الصفة الدولية ووجود تحديات جديدة في عمليات القرصنة الفكرية، بحيث تصبح هذه الحماية قادرة على استيعاب الاستخدامات الجديدة التي أحدثها التطور العلمي والأدبي والفني وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والثقافية بصورة عادلة ومشروعة.
فلا شك ضرورة توفير حماية حقيقية مع النتاجات الذهنية التي باتت تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من تطبيقات متنوعة كيوتيوب وإنستغرام وتليغرام والفيس بوك و واتساب ..الخ، والتي أصبح الاعتداء عليها أمرًا يسيرًا من خلال التقليد والتزييف والسرقة، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لأصحاب المؤلفات الحقيقيين، لذا يحتاج الأمر الى موقف تشريعي وقرارات قضائية قادرة على استيعاب كل هذه الاحتمالات، بحيث تكون هناك جزاءات رادعة وحماية رقمية للمصنفات كافة أيًَا كانت صور الاعتداء عليها.
ما الانعكاسات المتوقعة على حماية المؤلفين العرب إذا استمرت التشريعات الوطنية في تجاهل المعايير الدولية؟
أتوقع إن عدم تفعيل الحماية التشريعية لحقوق المؤلفين العرب بشكل فعال من شأنه أن ينعكس سلبًا على مدى الحفاظ وديمومة العطاء الذهني والابتكار الإبداعي لهؤلاء المؤلفين، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا يتجسد بظاهرة استنزاف عقول دول العالم الثالث أو ظاهرة هجرة المبدعين والمخترعين، وذلك من خلال استقطاب أصحاب النتاجات الذهنية من اللذين مروا بظروف صعبة في بلدانهم الأصلية الى التوطن في الدول المتقدمة ورعايتهم ماديًا ومعنويًا، بما يمثل خسارة حقيقية لأوطانهم التي لم تعرف كيف تُوفر مناخ ملائم يساعد أصحاب النتاجات الذهنية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، وخصوصًا من اللذين يحملون جنسية إحدى الدول العربية أو كانت لأحدهم إقامة معتادة أو دائمة في هذه الدول.
ما التصورات التي يمكن أن تُحدث توازناً بين الحماية الوطنية للمؤلف والحماية العابرة للحدود؟
لابد من توفير مناخ مناسب يساعد أصحاب النتاجات الأدبية والفنية والعلمية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، وخصوصًا من الذي يحملون جنسية إحدى الدول العربية أو كانت لأحدهم إقامة دائمة أو معتادة في هذه الدول، على الإبداع والابتكار، وتوفير التسهيلات المالية والمعنوية لهم لدعم وتشجيع ملكة النتاج الذهني والإبداع الفكري.
ما السُبل التي تقترحينها لتجاوز الفجوة القائمة بين النص القانوني ومقتضيات التطبيق القضائي في موضوع حماية المؤلف؟
هناك عدة سُبل يجب الأخذ بها من أجل تحقيق ذلك، وتتمثل بالآتي:
-إصدار تشريع جديد أو تعديل التشريع الحالي: يكون ذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة تخص حماية حقوق المؤلف في ظل التكنولوجيا الحديثة والإشارة الى الجوانب الفنية المستحدثة التي تخص حماية هذه الحقوق وماهية الجزاء القانوني المترتب عند الاعتداء عليها. فمن المعلوم أن المبدأ الجنائي الشهير ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)) يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص، الأمر الذي يمنع مسائلة مُرتكبي الفعل الضار بواسطة الكومبيوتر أو الانترنيت، طالما أن المشرع لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب، أو من خلال تعديل قوانين اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك من خلال السماح بتفتيش أجهزة الحاسوب وضبط البريد الإلكتروني مما يسهل في إثبات الجريمة والحصول على دليل لكشف الحقيقة.
- أقترح تدريب القضاة واعضاء الادعاء العام على قضايا حقوق المؤلف: وذلك من أجل تيسير التعامل مع الاعتداءات الوارد حصولها على حقوق المؤلف خصوصًا ما يحصل منها من خلال أجهزة الحاسوب والإنترنيت، وإدخالهم بورش تدريبية حول وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية وبالإمكان الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال.
-تفعيل دور الإعلام بكل صوره: فالإعلام سواء كان المرئي والمسموع والمقروء وحتى الإلكتروني ضروري من أجل التثقيف بسبل حماية حقوق التأليف وإعطاء إرشادات عن أخطار الاعتداء على هذه الحقوق.
- تثقيف المواطنين وزيادة وعيهم: ويمكن في هذا السياق أن ندعو الى عقد ندوات تثقيفية لتعريف عموم المواطنين بحماية حقوق المؤلف بهدف تعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال وتعريف المؤلفين أنفسهم بماهية حقوقهم وكيفية صيانتها، فضلاً عن إمكانية إصدار نشرات دورية مطبوعة أو الكرتونية من أجل التعريف بذلك. فمن الملفت في هذا الشأن بأن العديد من مستخدمين المنصات والمواقع الإلكترونية ليس لديهم المعرفة والوعي الكافي بأسس قوانين حقوق المؤلف، بالوقت الذي تظهر فيه الحاجة ملحة لفهم هذه القوانين وخاصةً مع وجود العديد من الاعتداءات على حقوق المؤلف في النطاقين التقليدي والرقمي، فهناك السرقات العلمية والقرصنة الفكرية الإلكترونية وإتلاف مصنفات الحاسب وقواعد البيانات، والاختراق أو الدخول غير المصرح به، والتجسس الإلكتروني.
-الإيداع القانوني للمصنفات: أقترح على مشرعنا العراقي إعادة العمل بالنص القانوني للمادة(48) من قانون حماية حق المؤلف الذي تم إلغاءه بموجب تعديلات جرت على القانون عام(2004) والخاص بالإيداع القانوني، فبموجب هذا النص يجب على ناشري المصنفات دون غيرهم أن يُودعوا خلال شهر من تأريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية، وندعو في هذا السياق بأن الإيداع ينبغي أن يُجريه أي مؤلف عراقي أو أجنبي يراد نشر مصنفه في العراق، وذلك من خلال جعل الإيداع هو إجراء منشئ لحماية المصنفات الفكرية وليس فقط لتيسير إثبات هذه الحماية على أن تتحمل الدولة تكاليف إجراء الإيداع.
ما رؤيتكِ لمستقبل حماية حق المؤلف في العالم العربي في ظل التحول الرقمي والعولمة الثقافية؟
تزداد يومًا بعد يوم المكانة الكبيرة للتطورات التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في إنشاء مجتمع معلوماتي جديد، ولعل حقوق المؤلف هي أحد المجالات العديدة التي تأثرت بالتكنولوجيا، مما يتطلب البحث عن آلية لحماية لحقوق الملكية الفكرية الإلكترونية في ظل التحولات الحديثة.
لذا يبدو لي بأننا نمضي قدمًا في إنشاء قواعد قانونية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بصورتيها التقليدية والإلكترونية، ولا ريب في ضرورة الإسراع بتشريع قانون شامل يستوعب كل صور الابتكار الذهني وليس فقط حقوق المؤلف، وأعني بذلك الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية، ناهيك عن تعديل النصوص القانونية الجنائية من أجل أن تتضمن حماية فاعلة لحقوق مبتكري البرامج من الاختراق والفايروسات والسرقة والتزوير والقرصنة والانتحال بهدف الاحتيال فضلا عن التجسس الإلكتروني.
وفي ختام الحوار، نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتورة رشا موسى محمد الزهيري على سعة صدرها وإضاءاتها الفكرية والقانونية القيّمة، التي ألقت الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في زمننا المعاصر. متمنين لها دوام العطاء والإبداع في خدمة الفكر القانوني وحماية حقوق المبدعين.



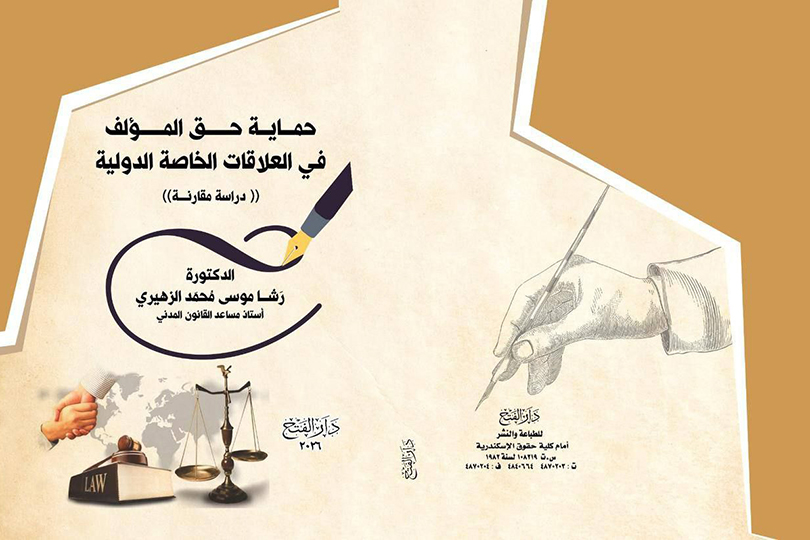

اضف تعليق