التضليل الاشتراكي هو دليل الديمقراطية غير المباشر، انهيار النظام الاجتماعي التقليدي وغياب الحضور الراقي وسوقية وفظاظة رجال الصناعة بأيديهم الحمراء السمينة، كل ذلك يُقنع الرجل العادي بأنه لا بد أن تكون لديه هو أيضًا الفرصة لإدارة الدولة. الديمقراطية، القومية، الاشتراكية كلها عند نيتشة سلسلة واحدة متصلة، وامتدادات لحداثات منحطَّة...
كانت قاطرة السكة الحديد، إحدى الصور المفضلة لدى «بوركهارت» كرمزٍ للحياة الحديثة الزاحفة. في سنة ١٨٤٤م تم افتتاح أول خط في «بازل» ليصل المدينة ببرلين وبقية ألمانيا، وفي ١٩ أبريل ١٨٦٩م جاء القطار القادم من «برلين» وعلى متنه أستاذ جديد في «الفيلولوجيا» ليعمل في جامعة «بازل» وهو «فردريك نيتشة» عبقرية في الرابعة والعشرين من العمر. عندما هبط من القطار كان «نيتشة» يبدو شخصًا غيرَ جذَّاب، حُلَّة رثَّة ونظَّارة طبية سميكة، وسلوك حيي، كان لا يُشبه أبدًا رجلًا على وشك أن يُطلق ثورةً تهزُّ أوروبا، وربما على نحوٍ أعمق مما صنعَته أحداث ١٨٤٨م، ولكنها كانت -على أية حال- ثورة في العقل وليست في الشارع.
ومثل والد «بوركهارت»، كان والد «نيتشة» قسيسًا لوثريًّا. مات و«نيتشة» في الخامسة، سنوات تكوين «نيتشة» كمفكر سوف تحتوي على سلسلة من العلاقات الواسعة مع مجموعة من الآباء المتميزين، ولكنها كانت علاقاتٍ متكافئةَ الأضداد.٢٥ كانت العائلة قد توقَّعت أن يتبع «فردريك» الانسحابي دودة الكتب، خطوات أبيه ويدخل الكهنوت، درس اليونانية واللاتينية بتوسُّع في إحدى المدارس الابتدائية المتميزة،٢٦⋆ ولكن إيمان «نيتشة» بالمسيحية لم يتخطَّ امتحان القبول في جامعة «بون» ومثل «بوركهارت» الشاب، كان عليه أن يجد منفذًا آخر لطاقاته الفكرية. كان ذلك المنفذ هو «الفيلولوجيا» الكلاسيكية، الدراسة المعمَّقة لقواعد اللاتينية واليونانية طبقًا للمبادئ العلمية الصارمة، والركيزة الأساسية للتربية والآداب الكلاسيكية في القرن التاسع عشر.
كان شديدَ الذكاء، وبدَا نضجُه العقلي كدارس للدكتوراه في جامعة «ليبزج»، وعندما عُيِّن في جامعة «بازل» كان واحدًا من أصغر الأساتذة عمرًا في عالم الناطقين بالألمانية، كانت محاضرته الافتتاحية في «بازل» يوم ۲۸ مايو دفاعًا مدويًا عن قيمة «الفيلولوجيا» كوسيلة لكشفِ وفكِّ أسرار الأدبَين اليوناني واللاتيني، وماضي أوروبا،٢٧ ولكن خطابه أعطى فكرةً خاطئة عن شكوكه بالفعل. كان في قرارة نفسه مقتنعًا بأنه لم يُصبح دارسًا كلاسيكيًّا عن اختيار وإنما عن إهمال، بالرغم من كفاءته كعالم فيلولوجيا. قبول المنصب في «بازل»، بأعبائه التدريسية الشاقَّة والصارمة، سوف يتطلب منه أن يُنحِّيَ جانبًا اهتمامه المتفتِّح بالفلسفة والأدب المقارن والموسيقى، وبالرغم من أنه قد أثبت أنه مدرس محبوب وجماهيري، إلا أنه كان قلقًا … ولم يكن سعيدًا، بعد سنوات سيقول إنه كان يشعر بأنه كان يضيِّع وقته في «بازل». لم تبدُ الحياة الجامعية بالنسبة له أكثر من نظام معوق؛ لأنه كان ينتظر يقظةً داخلية أكبر، تنتزعه من سُباته العميق.٢٨ شعاع ضئيل من الضوء، هو الذي كسر ضجرَه وقلقه في «بازل»: صداقته النامية مع «جاكوب بوركهارت»، وبالرغم من أن «نيتشة» و«بوركهارت» كانا متباعدَين بمقدار ثلاثين عامًا من العمر، إلا أنهما حقَّقَا تقاربًا وتفاهمًا وقبولًا متبادلًا. كلاهما كان يحضر محاضرات الآخر، وفكَّرَا وخطَّطَا لكتابة عمل مشترك عن ثقافة اليونان القديمة. كان «نيتشة» يواظب على حضور محاضرات «بوركهارت» عن التاريخ الحديث؛ حيث شهد هجوم الرجل الأكبر منه على «صديقنا القديم … فكرة التقدم». كان «بوركهارت» يقول لجمهوره إنَّ المبدأ المرشد لهذا العصر هو «المساواة»، «المساواة أمام القانون، المساواة في الضرائب، وأهلية متساوية للمناصب» تشترك في نفس المنطلق مع الفرصة المتساوية للملكية والثراء المادي، إلا أنه «بالرغم من كل مميزات العالم الحديث - المساواة، الثروة، الاتصال السريع، والتأثير الكبير للرأي العام على كل الأحداث عن طريق الصحافة الحديثة - فإن من المشكوك فيه أن يكون العالم قد أصبح سعيدًا.»٢٩
الرأسمالية بتقديسها «لحب التملُّك الطاغي»، خلقت تعاساتٍ جديدةً بإفساد واستغلال العمل الصناعي، الثقافة الرفيعة والإبداع أصبحَا في منزلة منحطَّة في عالم «يصبح فيه المال ويظل هو المقياس الأساسي للأشياء … (و) الفقر هو الخطيئة الكبرى»، ومن المؤكد «في لحظتنا التاريخية هذه … أنه ليس من حقِّنا أن نحكمَ على أيِّ عصر مضى».
وهذا يشمل العصور الوسطى التي كانت بالرغم من كل أخطائها «بدون … تهديد الحروب القومية، بدون صناعات كبيرة مقحمة بمنافسات قاتلة … بدون دين ورأسمالية» … ويصل «بوركهارت» إلى نتيجة مفادها أنَّ «حياتنا بيزنس … حياتهم كانت حياة». واليوم، فإن «التسرُّع والقلق يُفسدان الحياة». المنافسة العالية تجعل كلَّ شيء «في حالة اندفاع بأقصى سرعة ويُصارع على خلافات دنيا». كان «بوركهارت» يُدرك أنَّ «تحت هذا التغيُّر الشديد في نبض» القرن التاسع عشر، يوجد «التفاؤل السائد» الذي جاء به التنوير، و«إرادة عمياء للتغيير» ناتجة عن إيمان بالتقدم، إلا أنه كان يرى أن ذلك التفاؤل سيُصبح مُرًّا؛ حيث إنَّ الناس يُدركون أن آمالهم الكبرى في الثروة والسعادة لن تتحقق. «من المتصوَّر أن يتحوَّل ذلك التفاؤل إلى تشاؤم في المستقبل القريب»، ثم يُضيف «كما حدث في نهاية العصور القديمة» وسقوط روما.٣٠
كتب «نيتشة» إلى أحد أصدقائه: «مساء أمس كنت سعيدًا وأنا أستمع إلى «بوركهارت» … فأنا أواظب على محاضراته الأسبوعية عن دراسة التاريخ، وأعتقد أنني الشخص الوحيد من بين مستمعيه الستين الذي يفهم خطَّ فكره العميق … إنها المرة الأولى التي أستمتع فيها بمحاضرة في حياتي، والأهم من ذلك أنه نوع المحاضرات نفسها التي سأكون قادرًا على تقديمها عندما أكبر.»٣١
وبالرغم من أنه و«بوركهارت» كانَا ينتميان إلى جيلَين مختلفَين، إلا أن «نيتشة» كان يشارك الرجل الأكبر منه، في التحرُّر من وهْم أوروبا ما بعد ١٨٤٨م، كما كان «نيتشة» قد قرأ أيضًا الفيلسوف «إدوارد فون هارتمان» Eduard von Hartmann، الذي تنبَّأ بأن عالم المستقبل سيكون عالم «ثراء مادي وجدب روحي».٣٢ كان «نيتشة» أيضًا لا يرى فرقًا يُذكَر بين الرأسمالية الصناعية وبديلها الاجتماعي، فكلاهما يعتمد على نظرة مادية كبيرة للعالم، وكلاهما يضع الشروط نفسها على سلطة الدولة المطلقة.٣٣⋆
تنبُّؤات «بوركهارت» الكئيبة أصبحَت دليلَ «نيتشة» عن مستقبل الحضارة الأوروبية بعامة ومستقبلها السياسي بخاصة. كان «بوركهارت» يقول إنَّ انتصار القومية الديمقراطية هو الانهيار النهائي للحرية. أما عند «نيتشة»، فإن القومية هي نهاية السياسة أيضًا. وبعيدًا عن كونها تخلق إحساسًا جديدًا بالوحدة والتضامن، فإن الدولة-الأمة تُكمل الطلاق بين الفرد والمجتمع، الأمر الذي يميِّز العصر الحديث بكامله. الديمقراطية تجعل الحياة المدنية المستقرة أمرًا مستحيلًا. يقول «زرادشت» نيتشة: «لقد أدرتُ ظهري لأولئك الذين يحكمون، عندما رأيت أنَّ ما يسمونه الحكم عبارة عن مساومات مع الدهماء على السلطة.»
التضليل الاشتراكي هو دليل الديمقراطية غير المباشر، انهيار النظام الاجتماعي التقليدي و«غياب الحضور الراقي» و«سوقية وفظاظة رجال الصناعة بأيديهم الحمراء السمينة»، كل ذلك يُقنع الرجل العادي بأنه لا بد أن تكون لديه هو أيضًا الفرصة لإدارة الدولة.٣٤ الديمقراطية، القومية، الاشتراكية … كلها عند «نيتشة» سلسلة واحدة متصلة، وامتدادات لحداثات منحطَّة لا معنى لها. أعماله الناضجة كانت مرقشةً بهجوم على ألمانيا الحديثة ورموزها القيادية وبخاصة «بسمارك» والقيصر، وتلك الشخصيات التي كان المعجبون بها يحذفونها بعد ذلك عند النشر،٣٥ وفي الوقت نفسه، ظلَّ «نيتشة» متفائلًا، بينما فقد «بوركهارت» الأمل. كان «نيتشة» يعتقد أن الحضارة الأوروبية يمكن إنقاذها، وإن لم يكن بالشروط المعروفة ﻟ «بوركهارت» وليبراليِّي التنوير من الطراز القديم.
كان من رأيه أن الثقافة الأوروبية تحتاج إلى ثورة تعكس اتجاه القرن التاسع عشر، بخضوع البرجوازية والجماهير لنخبة جديدة، وقد التقى «نيتشة» بالرجل الذي يمكن أن يقود تلك الثورة. كان «نيتشة» في سن المراهقة عندما التقى بالقوة العاطفية الطاغية للموسيقِي «ريتشارد فاجنر»، إلا أنه لم يقع تمامًا تحت سحر «فاجنر» إلا في سنة ١٨٦٨م، عندما حضر عرضًا افتتاحيًّا لأوبرا: «أساتذة الغناء» Die Meistersinger، و«تريستان وايزوالده» Tristan und Isolde، «كل خليَّة، كل عصب في جسمي يهتز لهذه الموسيقى، لم أشعر أبدًا في حياتي بمثل ذلك الشعور الدائم بالخلاص، كما حدث عندما كنت أستمع إلى افتتاحية أساتذة الغناء». وفي نفس العام، حضر «نيتشة» بعد ذلك حفل عشاء مع المؤلف، وكان في حالة من التوتر لدرجة أنه مزَّق معطف العشاء الجديد من الظهر بينما كان يحاول ارتداءَه،٣٦ ولكن المؤلف الموسيقِي أُعجب بطالب الفلسفة الشاب ودعاه لمنزله في «تريبشين» بالقرب من «لوكيرن»، وبعد ذلك سوف تتعدَّد زيارات «نيتشة» له أثناء فترة عمله في «بازل». في تلك الفترة كان «فاجنر» منهمكًا في عمله الكبير: «رباعية الخاتم النيبلونج» Ring des Nibelungen، كانت حياته هي ما يُطلق عليه معاصروه «البوهيمية»، كان يعيش مع امرأة، لم تكن زوجته، وهي «كوزيما فون بالو» التي حملَت منه، والحقيقة أنها كانت زوجةَ صديقه «هانز فون بالو»، ولكن قوة شخصية «فاجنر» جعلت «بالو» يظلُّ تلميذًا مخلصًا لأستاذه (يمكن أن نقول تابعًا ذليلًا)، ويواصل قيادة أعماله لجمهور من المعجبين كان في ازدياد مستمر.٣٧
أوبرات «فاجنر» جعلَت منه البطل الثقافي لجيل كامل من الفنانين والكُتَّاب الرومانسيِّين في الفترة الأخيرة في كلٍّ من ألمانيا وفرنسا، وكان على وشك أن يُصبح رمزًا للإبداع الفني والعمق الفلسفي، على قدمٍ وساق مع «جوته» و«شكسبير». ولو قُدِّر له أن يعيش لكان في نفس عمر والد «نيتشة».
كان «نيتشة» مسحورًا بشخصية «فاجنر» الشاملة … القوية … وثقته الشديدة بنفسه، وهو ما كان نقيضَ حياء «نيتشة»، إلى جانب السخرية الشديدة والهروب من الأضواء والنزوع إلى الحزن والكآبة … وكل تلك الصفات التي كان يتَّسم بها «جاكوب بوركهارت» المعلِّم الآخر ﻟ «نيتشة». فتح «ريتشارد فاجنر» و«كوزيما» عالمًا جديدًا أمام «نيتشة»، عالمًا وجد نفسه مقبولًا فيه بالرغم من صفاته الشاذة وانطوائيته.٣٨⋆،٣٩ و«فاجنر» كان سعيدًا بهذا الاهتمام به، والذي يُشبه العبادة، من أستاذ جامعي مرموق، وهكذا، كما كان «فاجنر» يعتقد، كان هناك تلميذ لامع شديد الذكاء، يمكن أن يدافع عن أعماله ويقدِّم نظريته عن الجمال بلغةٍ أكاديمية محترمة.
في القلب من هذه النظرية، كانت توجد أفكار «آرثر شوبنهاور» Arthur Schopenhauer، الناقد الفلسفي الألماني الأشهر، عن تقدُّم القرن التاسع عشر. كان «شوبنهاور» مثالًا جيدًا عن كيفية تحويل سحر الاستشراق في بدايات القرن التاسع عشر لحياة مفكِّر. عندما كان طالب فلسفة في شبابه، وقع «شوبنهاور» على ترجمة فرنسية ﻟﻟ «أوبانیشاد» الهندية، وفتنَته الأفكار الهندوسية والبوذية عن النكران الزهدي للذات. العمل الرئيسي الوحيد لشوبنهاور وهو كتابه «العالم كإرادة وتمثل»، يميل وينحاز لهذا النمط الشرقي التصوُّفي من الحكمة، أكثر من ميله لأفكار عصر التنوير عن العقل والعلم والمدنية، وكما شرح «شوبنهاور»، فإن العالم الذي نُدركه من حولنا، أو «العالم كفكرة» ما هو إلا من صنع ذاتنا المتمركزة حول نفسها، إنه وهمٌ أو تصوُّر خادع وانعكاس لآمالنا ومخاوفنا، وكان «شوبنهاور» متفقًا مع الفلاسفة الرومانتيكيِّين الألمان في أنَّ الحقيقة الوحيدة هي الإرادة الإنسانية، إلا أنَّ المؤثرات الشرقية على «شوبنهاور» دفعَته إلى موقف أكثر راديكالية.
الإرادة الإنسانية هي مصدر كل مجاهدة من أجل المال والحب والسلطة، وهي أيضًا مصدرُ كلِّ مصائبنا وكروبنا. لا بد أن نتعلم كيف نتجنبها، وأن نشجبها؛ لكي نهربَ من «مرض حياتنا في العالم» كما يقول «شوبنهاور». الهدف النهائي للإنسان العاقل في الحياة هو ما أسماه «بوذا» ﺑ: «النرفانا»، أو «الخلاء»، وهو انعتاق نهائي من الإرادة والرغبة التي تؤدي في النهاية إلى الانطفاء والموت. كما يُنسَب إليه دائمًا القول: «ما كان يجب أبدًا أن تكون الحياة هكذا». ويعني بها الحياة حسب التقليد الأوروبي أو الغربي العلماني.
وجَّه «شوبنهاور» فلسفته عن التخلي الجذري أو النكران الزهدي للذات نحو هدفَين رئيسيَّين: الأول هو التنوير بتفاؤله الزائف وإيمانه الأجوف بالعقل، والتقدم ممثلًا بفلسفة «هيجل»،٤٠⋆ وكان هدفه الثاني هو المسيحية أو التراث اليهودي المسيحي تحديدًا. كان معظم الرومانسيِّين يفهمون التنوير والدين المنظم على أنهما عدوَّان كلٌّ منهما للآخر، ولكن «شوبنهاور» كان يراهما حليفَين، كلاهما يحثُّ الناس على خلاصهم في هذه الدنيا، سواء عن طريق العقلانية العلمية أو الدولة-الأمة، أو عن طريق الالتزام بالقانون الديني. كان «شوبنهاور» عدائيًّا، على نحوٍ خاصٍّ، تجاه اليهود بهذا الشأن، وكان يعتقد أن اليهودية قد أصابَت المسيحية بعدوى وهْم «الإرادة كفكرة»، وهي المحاولة المستميتة لتغيير أو تحويل العالم لكي يتلاءم مع مجموعة من الأفكار الدينية والأخلاقية المسبقة، والتي كان يسميها اليهود، ثم المسيحيون بعدهم بقوانين الرب.٤١
والآن، لا يبقى سوى طريق واحد للتحرر، وهو الفن والموسيقى بخاصة. الفن يصبح طريقةً جديدة لمعرفة العالم، وهو محصَّن ضد رغبات النفس المتوحشة وضد «العالم كإرادة». ومن خلال الخبرة الجمالية، مثل مشاهدة لوحة أو الاستماع إلى سيمفونية، فإننا نخبر العالمَ بطريقة جديدة ويتحقق لنا الانعتاقُ الفوري من أسر سجن الرغبة. الفن والموسيقى يمنحان لحظات التأمُّل العميق التي لم يُفسدها الاحتكاك بالمادية الفظة المحيطة بنا، ولكي يصبحا «فلسفة حقيقية» فلا بد أن يظلَّا هكذا، كما يقوله «شوبنهاور». بقيَ كتاب «شوبنهاور» غير مقروء - فعليًّا - لمدة أربعين عامًا، إلى أن جلب له التحرُّر من الوهم الرومانسي بعد ١٨٤٨م جمهورًا جديدًا لديه الاستعداد لذلك. كان «بوركهارت» أحد التلاميذ، وكان «إدوارد فون هارتمان» Eduard von Hartmann تلميذًا آخر، وهو الذي حوَّل «الإرادة المتوحشة» عند «شوبنهاور» إلى «اللاوعي» في كتابه «فلسفة اللاوعي» ١٨٦٩م، وهو المفهوم الذي تبنَّاه ونقَّحه «سيجموند فروید» Sigmund Freud فيما بعد، وفي الوقت نفسه، اكتشف «نيتشة» الشاب، نسخة من «العالم كإرادة وتمثل» في أحد محلات الكتب القديمة في «ليبزج» في عام ١٨٦٥م، وكان الإعجاب المشترك بفلسفة «شوبنهاور» هو نقطة البداية لصداقة «نيتشة» و«بوركهارت»، الذي سيصبح «شوبنهاور» يُعرف عنده ﺑ: «الفيلسوف»،٤٢ إلا أنَّ «ريتشارد فاجنر» كان تحولًا آخر. كانت أعماله الأوبرالية «الهولندي الطائر»، و«تانهاوزر»، و«تريستان وايزوالده»، تدور كلها حول فكرة «شوبنهاور» المركزية، وهي أنَّ عالم النشاط الإنساني هو عالم معاناة تصبو الروح للتحرُّر منه،٤٣⋆،٤٤ عندما زار «نيتشة» «تریبشين» لأوَّل مرة في سنة ١٨٦٩م التقطَت أُذُنُه أنغامَ بيانو معذبة قادمة من شباك مفتوح، في ذلك الصباح كان «فاجنر» يكتب «انتحار برون هيلد»، المشهد الأخير من «رباعية الخاتم»، والتي حرَّرها قبولها لمصيرها في النهاية، وحرَّر العالم من الدورة اللانهائية لإعادة الميلاد (التقمُّص) والرغبة والموت. كان المشهد يحمل ملامح «شوبنهاور»:
سأمضي إلى الأرض المختارة … الأكثر قداسة،
خلف كل الرغبات وسراب الوهم،
نهاية الرحلة الأرضية،
هل تعرفين كيف حققت
الهدف المقدس، المبارك
في كل ما هو سرمدي؟
لقد فتح ألمُ الحب الموجع عيني،
فأبصرتُ نهايةَ العالم.
لقد أكد «شوبنهاور» أن الموسيقى مكَّنَت البشر من السموِّ، ومن تجاوز قبضة الإرادة القاسية وإن كان ذلك بشكل مؤقت. «فاجنر» شرح ﻟ: «نيتشة» اعتقادَه بأن أوبراه يمكن أن تقدِّم فترةَ راحة أكثر دوامًا، «الخاتم النيبلونج» يمكن أن تحوِّل الأوبرا إلى فنٍّ ثوري - كما أعلن - فن يضم الموسيقى والدراما والشعر والفن التشكيلي في «عمل فني متكامل» Gesamtkunst Werk. أوبرات «فاجنر» في الحقيقة، سوف تُنقذ حداثةً فاسدة عن طريق مزج التطهير العاطفي بالتجربة الموسيقية السامية، بالطقس الأسطوري.
هذه الرؤية المثيرة، سارت متلازمة مع خطة متهورة بالدرجة نفسها لبناء مسرح ضخم، تُقدَّم عليه «رباعية الخاتم» كحدث سنوي، جزء منه احتفال فني والجزء الآخر طقس ديني، المسرح سوف يُبنَى على الأرض الألمانية في «بايريث» في «أبر فرانكونيا»، وبمرور الأشهر ونمو الصداقة بين «نيتشة» و«فاجنر» سوف يجد المؤلف الموسيقي في صديقه الأستاذ الشاب، حليفًا على استعداد - في خطته - أن يُدشِّن بداية جديدة للفن والإنسانية، في العامَين التاليَين ١٨٧٠م و١٨٧١م، وبينما يواصل محاضراته ومهامه الأكاديمية في «بازل»، سيُلقي «نيتشة» بنفسه في خضمِّ تلك المهمة الجديدة الأوسع: خلاص أوروبا الفعلي عن طريق موسیقی «فاجنر». في العام التالي نشر أول كتبه: «مولد التراجيديا»، الذي كان في ظاهره كتابًا عن الدراما الإغريقية والدين، بينما هو في حقيقته احتفالًا برؤية «فاجنر» للعلاقة بين الفن والمجتمع، كما قدَّم الكتاب أيضًا أول إجابة - مؤقتة - عن سؤال «نيتشة» الذي سوف يشغله طيلة حياته وهو: كيف نمنع اضمحلال الحضارة الحديثة؟
جميع كتابات «نيتشة» منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، بما في ذلك «مولد التراجيديا» وأعماله الأربعة: «تأملات في غير أوانها»، أخذت ملامحها من نظرة «شوبنهاور» عن لا جدوى الإرادة الإنسانية، ومن صورة «بوركهارت» غير الواضحة للعصر الصناعي الحديث، في كتابه «شوبنهاور كمعلم» تقرأ: «مياه الدين تنحسر مخلِّفةً وراءَها مستنقعاتٍ وبِرَكًا آسنة»، وحيث إنَّ حربًا شاملة كانت تُهدد باجتياح أوروبا، «فإن الطبقات المتعلمة والدول يجتاحها اقتصادٌ مالي جدير بالازدراء الشديد»، كما يُعلن: «لم يكن العالم أبدًا أكثرَ انغماسًا في شئون الدنيا، لم يكن أبدًا أكثرَ فقرًا في الحب والخير مما هو الآن.»٤٥ أما رجال الفكر فقد جعلوا الأمور أكثرَ سوءًا بتشجيعهم الاعتقاد في أوهام التقدم، بدل أن يكونوا «منارات، أو ملاذًا وسط هذا الاضطراب العلماني»، لقد أغرَوا الجماهير بأن تعتقد أنَّ التحسُّن النهائي للبشرية يوجد في مكان ما في المستقبل، وأنَّ السعادة موجودة هناك خلف ذلك التل الذي يتقدَّمون نحوه، وبالطريقة نفسها ينتهي «نيتشة» إلى ما انتهى إليه «بوركهارت»، وهو أنَّ «كل شيء معاصر، بما في ذلك الأدب والعلم، يخدم البربرية القادمة … نهار شتوي غائم يخيِّم علينا ونحن نعيش في جبال شاهقة … في فقر وخطر.»٤٦
ولكن «نيتشة» يرفض أيضًا حلَّ «روسو» الطبيعي أو البدائي للمدينة الحديثة، أي «عودة للطبيعة» عنده هي عودة للفقر واليأس. التاريخ لا بد أن يكون له دائمًا قوة دفع للأمام حتى وإن كانت تدفع نحو آفاق محدودة، وبالرغم من ذلك، فإن الحياة الاجتماعية وعملية التحضُّر ما هي إلا تعبيرات عن حيوانيَّتنا المنحطَّة، لا عن طبيعتنا السامية، وهي سلسلة متصلة لا تتغير من الخبرة الإنسانية المملة، لا يمكن تحسينها، وإنما يمكن التسامي عليها فقط، كما يقول «شوبنهاور»،٤٧ وهكذا نجد أنَّ «نيتشة» بينما يقبل بتشخيص «بوركهارت» وهو أنَّ الحضارة الحديثة محكوم عليها بالفناء؛ لأنها «مخرمة كالغربال» بما فيها من تحلُّل وضعف، نجده يقوم في الوقت نفسه بتعديل الافتراض الأكبر للفيلسوف، وهو أنَّ المجتمع ككل، يتبع مسارًا منتظمًا للتطوُّر العضوي؛ فكل أمة أو حضارة عند «نيتشة»، كما كانت عند «بوركهارت»، هي وحدة ديناميكية من القوى والقوى المضادة، تقوم كلٌّ منها بموازنة أو إزاحة الأخرى طول الوقت٤٨ وهو ما يعني أن الحاضر كشفٌ نهائي للماضي المطوي، وكما يقول، فإن: «أفضل ما يمكننا فعله هو أن نُواجه طبيعتنا الموروثة والقابلة لأن توَّرث، ونغرس في أنفسنا عادةً جديدة، غريزة جديدة، طبيعة ثانية لكي تذويَ طبيعتنا الأولى.» وقد اضطره إخلاصه ﻟ «شوبنهاور» والتزامه به حينذاك أن يُضيف: «كلُّ ماضٍ جديرٌ بالإدانة؛ لأن تلك هي طبيعة كل ما هو إنساني.»٤٩
هكذا كان الفرق بين «نيتشة» و«بوركهارت». أعطى الرجل الأكبر منه حقَّه، وسلَّم له بتعريفه على القوى التي أدَّت إلى انحلال وانهيار النظام القديم، ولكن «بوركهارت» فشل أن يرى أن الخطأ لم يكن في المكوِّنات الفردية، بل في ضعف النظام القديم ذاته، الحضارة الأوروبية بناء على نموذجها اليهودي المسيحي التقليدي، كان «بوركهارت» ما زال يتعبَّد في ضريح المجتمع القديم، وما زال يأمل في إنقاذ تقاليد السلوك «المهذَّب»، وأخلاقيات زملائه مواطني «بازل»، إلى جانب ثقتهم في إله خيِّر وعادل، كان عماء «بوركهارت» هو عماء القرن التاسع عشر، «إنه يعرف فقط كيف يحفظ الحياة … لا أن يولدها … شعاره: دع الموتى يدفنون الأحياء … وهذا بالتحديد هو السبب في أن ثقافتنا الحديثة ليست شيئًا حيًّا».
أوروبا الحديثة لم تفقد شرارة العظمة الحيوية، ولكن «نيتشة» أعلن بشكل حاسم أنَّ تلك الشرارة لم يكن لها وجود أبدًا، ولكي تتحرَّر من أَسْر هذا الماضي المحتضر، لا بد أن يندفع الناس نحو ثقافة جديدة، بعادات جديدة، و«غرائز جديدة». كانت «البطولة الرومانسية» هي ترياق «نيتشة» المضاد للتشاؤم التاريخي عند «بوركهارت»، فكان أن أطلق نداءه لأولئك الذين كان يسمِّيهم ﺑ «رجال الاقتداء»٥٠⋆ – الفلاسفة، الفنانون، الكُتَّاب، «أفراد مختارون … مؤهلون للمهام الكبرى الخالدة»، نخبة مثقَّفة جديدة سوف تتقدَّم، كما كان «نيتشة» يقول، وسوف يُديرون ظهورهم عمدًا للاتجاه المادي السائد للحضارة الحديثة، سيكدحون من أجل إنتاج ثقافة «شوبنهاورية» حقيقية، «سينادي كلُّ مارد فيها الآخر عبر صحاري الزمن، لن تُزعجَهم الأقزام اللاغية الزاحفة تحتهم، ولسوف يتواصل الحوار الرفيع الراقي.»٥١
كما كان «نيتشة» يُوحِي لقرَّائه بأن واحدًا من «رجال الاقتداء» أولئك، كان يعيش بينهم، وهو «ريتشارد فاجنر»، وأنَّ أوبراته سوف تجدِّد الحضارةَ وتُحرِّر غرائز الإنسان الحيوية الكبرى بتغلُّبها على التقسيم الفاجع، الكامن في أساس الثقافة الأوروبية ذاتها. في دراسته للثقافة اليونانية القديمة «مولد التراجيديا» رسم «نيتشة» ما سوف يُصبح خطًّا فاصلًا بين الروح الديونيسية،٥٢⋆ الروح غير المستأنسة للفن والإبداع، والروح «الأبوللونية»،٥٣⋆ روح العقل وضبط النفس.٥٤
كان «نيتشة» يُلمِّح بقوة إلى أنَّ قصة الحضارة اليونانية، وكل الحضارات بعامة، هي قصة الانتصار التدريجي للإنسان «الأبوللوني» - برغبته في السيطرة على الطبيعة وعلى نفسه - على الإنسان «الديونيسي» الذي يحيا فقط في الخرافة والشعر والموسيقى والدراما. كان سقراط وأفلاطون - قبل ذلك - قد هاجما أوهام الفن ووصفاها بأنها «زائفة وغير حقيقية»، وقلبَا الميزان الثقافي الدقيق بتثمينِ وعيِ الإنسان النقدي والعقلي، بينما سَفَّهَا غرائز حياته الأساسية واعتبراها منحطةً ولا عقلانية. ونتيجة هذا التقسيم هي ظهور «الإنسان الإسكندري»،٥٥⋆ المواطن اليوناني المتحضِّر، المتحقق في العصر القديم المتأخر (زمنيًّا) «المزوَّد بأعظم قوى المعرفة»، ولكن ينابيع الإبداع جفَّت بداخله، والإنسان الأوروبي الحديث هو النسل المباشر للإنسان «الإسكندري»،٥٦ هو صورة مصغَّرة من الحضارة عند «توماس باكل» Thomas Buckle، و«أوجست كونت» Auguste Comte.
اعتقاده أنَّ بإمكانه اكتشافَ الحقيقة عن طريق العقل وحده، سوف يؤدي مباشرةً إلى «روح التفاؤل السهل، التي هي جرثومة دمار مجتمعنا»، بالإضافة إلى اعتقاده الخاطئ بأن العلم والمؤسسات الاجتماعية يمكن أن تجعل الناس سعداء أحرارًا.٥٧
كان «نيتشة» يرى أوبرات «فاجنر» عودة خطيرة إلى «كُلِّيانية» الإنسان الأوروبي الأصلية، عالم «الثقافة التراجيدية» الذي يقبل كلًّا من العجز والتفوق الإنسانيَّين، الشديد البشاعة والجليل في الوقت نفسه، بواسطة مائة إنسان من هذا النوع «يمكن إسكات ثقافة عصرنا الصاخبة الكاذبة بالكامل وإلى الأبد، ليُصبح العقل والروح كيانًا واحدًا مرة أخرى».٥٨ في ۲۲ مايو ١٨٧٢م كانت الجماهير الحاشدة تصعد التلال بمشقة في «بايريث»، وسط الأمطار الغزيرة التي استمرت طول النهار، لمشاهدة الاحتفال الخاص بتدشين مسرح «فاجنر» الجديد. كانا يجلسان متجاورَين في العربة، «نيتشة» و«ريتشارد فاجنر»، الرجل الذي كان يعيش تأملات مثالية في عصر «تَحْكُم العالم فيه مضاربات البورصة»،٥٩ كان «نيتشة» ينظر نظرات سريعة إلى «فاجنر»، ولكن الرجل «كان صامتًا، يبدو أنه كان يحدِّق داخل نفسه بنظرة تعجز الكلمات عن وصفها … كل ما حدث قبل ذلك كان تحضيرًا لهذه اللحظة»، وبالنسبة للرجلين … كانت تلك اللحظة بالفعل، فجر عصر جديد.


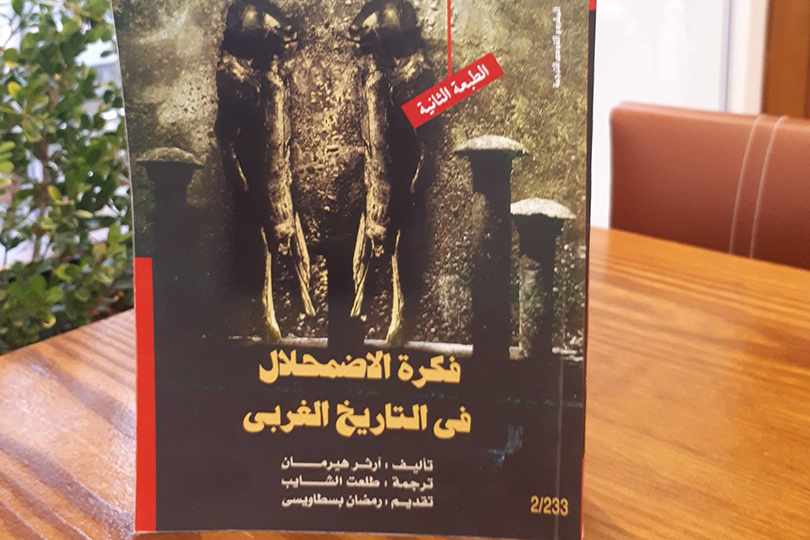

اضف تعليق