حاجة المجتمعات الدائمة إلى التطور والتقدم، تدفعنا إلى ضرورة بلورة منهجية متكاملة للنقد والمراجعة، حتى يتسنى لمختلف قوى المجتمع وتعبيراته المتعددة المساهمة الفعلية في تجاوز مواطن الخلل واليباس التي تحول دون انطلاقة فعل التغيير. فلا تقدم حقيقياً إلا بنقد عميق للسائد، ليس من أجل جلد الذات...
من أين يبدأ النقد؟
يتضمن النص القرآني العديد من الآيات والشواهد التاريخية، التي تؤكد على ضرورة أن يراجع الإنسان أفعاله، وينقد ممارساته من أجل تقويمها بما ينسجم والقيم الإسلامية العليا. فالباري عز وجل يقسم بالنفس اللوامة ويعلي من مقامها، لأنها تمارس عملية اللوم والمراجعة والمحاسبة والنقد كي تصل إلى المستوى المثالي في التعامل مع الأمور والأشياء. فقد قال تعالى [ولا أقسم بالنفس اللوّامة].
والقسم الرباني بالنفس اللوامة يوضح قيمتها في حركة الوجود الإنسانية في ارتفاعه إلى الأعلى، باعتبار بأنها تعمل على تخفيف الأثقال الروحية والأخلاقية والاجتماعية التي تشد الإنسان إلى الأسفل، لينطلق من موقع إنسانيته في حالات الصفاء الروحي الذي ينفتح به على الله عز وجل.
وبذلك كانت تمثل قمة النموذج الإنساني في أصالة التجربة الحية الواعية في حركة الحياة في داخله. فمقتضى عمق اللوم على الغفلة، وعلى التقصير، لا يترك النفس سادرة في هواها وفي غفلتها ولا يقف بها في أجواء اللامبالاة فيما يثار حولها من قضايا، لا سيما إذا كانت القضية تتصل بالمصير الأبدي، مما يجعلها في مستوى الأهمية الكبرى في مواقع الفكر والإيمان.
والقرآن الحكيم يثير فينا حس النقد الذاتي، عن طريق تذكيرنا بحقيقة وجدانية، ألا وهي بصيرة الإنسان على نفسه، فإنه قبل الآخرين شاهد عليها وعالم بواقعها، مهما توسل بالأعذار والتبريرات الواهية. يقول تبارك وتعالى [بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره].
ويؤكد القرآن الحكيم في الكثير من الآيات أيضا على مراجعة تجربة دعوات الأنبياء وتشخيص سلوك المجتمعات الغابرة ومواقفها، حتى نتمكن من الاستفادة منها وأخذ العبر والدروس من محطاتها وانعطافاتها. كما ينتقد القرآن الكريم تقليد الآباء والأجداد. قال تعالى [بل قالوا إنا وجدانا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجـــدنا آبائنا على أمة وإنا عـــلى آثارهم مقتدون].
وبهذا أسس الإسلام عقلا برهانيا ونقديا لدى الإنسان المسلم، وهذه هي البذور الأولى لمشروع النقد والمساءلة لظواهر الحياة الطبيعية والإنسانية. ولا ريب أن هناك جملة من العلوم قد تطورت وتأسست في الفضاء الحضاري الإسلامي من جراء هذه العقلية البرهانية ـ النقدية. فعلم الجرح والتعديل وعلم الحديث ونقد الرواية كلها علوم تبلورت ونضجت من جراء العقلية النقدية الإسلامية.
والنقد كعملية ثقافية ـ معرفية، هو عبارة عن فحص لكل ما هو سائد في سبيل واقع آخر مضاد له وفقا لنموذج أو تصور مستقبلي. "فالنقد يعني: الفحص والاختبار ووضع كل شيء في ميزان العقل والاحتكام إلى معاييره".
ولكن ومع هذا التأكيد القرآني والإسلامي، على ضرورة المراجعة والنقد، إلا أن واقع المسلمين يخلو من هذه القيمة، بل هناك بعض المساحات الاجتماعية التي ترذلها. ولا ريب أن لهذا الغياب أسبابه وعوامله الثقافية والاجتماعية والنفسية. فالقناعات النفسية والثقافية التي لا تراجع، ويتم التعامل معها كحقائق ثابتة، تدفع باتجاه التمتع بحق الطاعة والانقياد والاتباع، دون أن يكلف نفسه (صاحب القناعة الثابتة) عناء مراجعة أفكاره وقناعاته ومساءلتها.
وبهذا تتراكم عوامل الغفلة والاستعلاء، بحيث يتجاوز هذا الإنسان كل ممارسة نقدية، ويحجم عن ممارسة كل محاسبة إلى سلوكه وأفعاله. وهنا لا بد من بيان أن مجال النقد هو وسائل التطبيق الاجتماعي والثقافي والتعليمي، وذلك لأن الجمود عليها يعطل التقدم. وليس ثوابت الشرع وقيمه العليا. فالثوابت العقدية والتشريعية ليست موضوعا للنقد، إنها موضوع للبحث والفهم. وبطبيعة الحال فإن المحيط الثقافي التي تنمو فيه حالات ضمور الحس النقدي، هو ذلك المحيط الذي يردع عن السؤال المساءلة، ويقف موقفا سلبيا من الاختلاف الثقافي والفكري، ويحارب الإبداع خوف الابتداع. وهذا يعمق نفسية عامة تحول بين الإنسان الفرد والجماعة وممارسة النقد والمراجعة والمحاسبة لكل ما هو سائد.
فالاختلاف المرذول والمذموم، هو الناتج عن الهوى، أما الاختلاف الناتج عن البحث الحر والموضوعي طلبا للحقيقة لا إتباعا للهوى فهو اختلاف مشروع، وذلك لأنه طريق الوصول إلى الحقائق وهو الذي يثري الواقع والفكر والثقافة. والنقد وفق هذا المنظور، هو الذي يثري الساحة الثقافية بالمضامين الجادة، كما أنه يفعل الساحة الاجتماعية باتجاه الأمور والقضايا الأكثر أهمية وجدية. فالنقد هو الممارسة الضرورية في الاختلافات الثقافية والمعرفية، كما أن الحوار هو الوسيلة الفعالة الذي يمنع إصدار أحكام قيمة على الظواهر الثقافية ذات الشروط العامة والتاريخية. ولا ريب أن غياب تقاليد النقد والمساءلة، هو الذي يدفع الشعوب والأمم حين الهزائم إلى التشكيك الصارخ في كل ما هو سائد.
وهذا يقودنا إلى القول إننا بحاجة دائما أن نتعامل مع هزائمنا وانتصاراتنا بموضوعية بحيث إننا لو انتصرنا لا نصاب بداء الغرور والتعالي، فنلغي الآخرين من خريطة الوجود التاريخي.. ولو انهزمنا ندرس أسباب هزيمتنا بشكل موضوعي وهادئ، ودون أن يؤثر هذا على جوهر وجودنا وثوابت كياننا. ولا شك أن للإنجازات أسبابها وعناصرها كما أن للإخفاقات عواملها. والرؤية الموضوعية تحتم علينا دراسة المسألة من جميع أبعادها، لإزالة عوامل الإخفاق وتأكيد عناصر النجاح والإنجاز.
ولا يوجد على المستوى التاريخي أن مجتمع مكتوب عليه أو قدره الهزيمة دائما أو الانتصار دائما.. وإنما هم (الهزيمة والانتصار) ظاهرتان إنسانيتان تتحكم فيهما جملة من العوامل الذاتية والموضوعية. فالمجتمع الذي تتوفر فيه عوامل المنعة والتفوق يحقق ذلك على الصعيد العملي، والمجتمع الذي يتخلى عن تلك العوامل يصاب بالإحباط والتراجع والتقهقر. فالرؤية الموضوعية تعني، الابتعاد عن التهويل والتهوين، والبعد عن الشطط والمغالاة وعن اليأس والتيئيس الدافع إلى الاستقالة المعنوية الفردية والجماعية.
وإن فقدان الثقة بالذات من جراء نكسة أو هزيمة، يؤدي حتما إلى الاستسلام إلى المنظومات الفكرية والثقافية للغالب.. وقد أشار إلى هذه المسألة ابن خلدون بقوله: أن المغلوب مولع دائما بمحاكاة الغالب والإقتداء به لأنه يعتقد أن انتصاره راجع إلى صحة مذهبه وعوائده.
كما أن تجريح الذات وجلدها على مختلف الصعد والمستويات، ما هو في حقيقة الأمر إلا إخفاء لابتعاد المثقف أو المفكر أو الأديب والنخبة بشكل عام عن مواطن الإبداع الفكري والثقافي والأدبي وتحولهم في الكثير من الأحيان إلى إحالة للماضي وحجابا لعدم رؤية الحاضر.. فالقراءة الموضوعية إلى الظواهر الاجتماعية والإنسانية المفرحة منها والمحزنة تحتم علينا النظر إلى الأمور انطلاقا من أسبابها الحقيقية وعواملها المباشرة.
من هنا وتأسيسا على حقيقة التطورات السريعة التي تجري في العالم في كل تجاه، تتأكد ضرورة التقيد بقوانين الموضوعية في دراسة التطورات والظواهر الاجتماعية والإنسانية الأخرى.. لأن توفر هذه القوانين هو الذي يمكننا من قراءة هذه التطورات والتحولات بشكل سليم ودقيق.
والفكر النقدي يقتضي:
1- توفير أسس الفحص والمقدمات العقلية والنظرية لعملية المراجعة، إذ لا يعقل أن تتم المراجعة انطلاقا من ردود أفعال أو مماحكات سياسية. بل من الضروري أن تتوفر كل الأدوات النظرية والمفهومية والعدة التقنية التاريخية والمعاصرة لفحص الظاهرة فحصا موضوعيا متزنا.
2- التقيد بالمنهج الموضوعي دون جلد الذات أو تحميل الأخر المجهول أسباب الإخفاق وعوامل الهزيمة.
وبهذا نتشبث بما يسمى بـ (القوانين الموضوعية) للظواهر الاجتماعية والإنسانية.. ومن هنا فإن الفكر النقدي يقتضي أيضا دراسة الظاهرة والكشف عن قوانين عملها وحركتها وعن طبيعة العلاقة التي تربط بين عناصرها المختلفة.. وعن طريق هذه الدراسة نصل إلى النتائج الأخيرة بعيدا عن المسبقات الفكرية أو الاجتماعية، ونتعرف على الأسباب الموضوعية لنمو الظاهرة أو ضمورها.. إننا مع ضرورة المراجعة لمناهجنا العلمية والعملية، لكنها تلك المراجعة التي تنطلق من حس المسؤولية الذاتية وتحمل الذات مسؤولية الإصلاح.
فالمراجعة والنقد جزء من مشروع الإسلام التربوي، فلا فلاح بدون محاسبة الذات ومراجعة أفعالها وتقويم سلوكها والعدول عن الأخطاء والزلات. وبالتالي فإن النقد وفق هذا التصور مطلوبا، لأنه سبيلنا إلى التطور والتجدد والتزكية.
النقد ضرورة ثقافية
مقال الأسبوع الماضي المعنون بـ (في الممارسة السياسية) أثار الكثير من الأسئلة لدى القراء، إذ اتصل بي العديد من القراء، و طرح أسئلته و إشكالاته على أفكار المقال، و طبيعة هذه الأسئلة و الإشكالات حفزتني للإجابة عليها، حتى تكتمل عناصر الرؤية للمقال..
1ـ وأود في البداية أن أشيد بمبادرة القراء على السؤال وطرح الإشكالات و نقد بعض أفكار المقال. لأن التطور المعرفي و الثقافي في أي بيئة اجتماعية، مرهون إلى حد بعيد على وجود بيئة ثقافية ناقدة للأفكار و مسائلة للآراء.
فلا تراكم ثقافي مجتمعي، بدون حركة نقد دؤوبة و متواصلة.
والنصوص المكتوبة هي أحد فضاءات ممارسة النقد، وهذا مما ينبغي تأكيده والتشجيع عليه. أسوق هذا الكلام للحرج الذي أبداه بعض القراء، وهو يقدم ملاحظاته أو يوضح فكرته المخالفة لفكرة المقال.. فليس هناك مقالة ضد النقد، فكل المقالات والموضوعات بصرف النظر عن كاتبها هي بحاجة إلى الفحص و المساءلة والنقد، ولا حرج معرفي أو أخلاقي في إبداء وجهات نظر ثقافية أو فكرية مخالفة لمضمون هذا المقال أو غيره من المقالات.
وعلى الصعيد الشخصي يفرحني معرفيا وجود مساءلات و أفكار نقدية لما أكتب. لإيماني العميق أن تطوري المعرفي، يحتاج باستمرار إلى نقد وفحص لما أكتب. فهذا هو سبيل التطور والتراكم المعرفي.
فالخطوة التي قام بها بعض القراء في الاتصال و إبداء بعض الأسئلة أو الأفكار النقدية على ماكتبت، هي محل احترام و إشادة، ومن الضروري أن تتعزز هذه الصفة في فضائنا الثقافي والاجتماعي، لأنها جزء أصيل من أجل تطوير حياتنا الثقافية و المعرفية. فلا حياة ثقافية حقيقية بدون حركة نقد جادة وعميقة. ونحن الكتاب من الضروري أن نشيد بأية مبادرة تستهدف الإضافة في المشهد الثقافي النقدي.
والرد أو التوضيح على بعض أسئلة القراء، ليس استنكافا بأسئلة القراء، وإنما احترام و تقدير. وهذا الاحترام هو الذي يقودني إلى توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالفكرة المركزية لمقال الأسبوع الماضي.
و أدعو في هذا السياق جميع القراء، ومن مختلف مواقعهم الفكرية والثقافية إلى ممارسة حقهم و دورهم على أكمل وجه في النقد وإبداء وجهات نظر مختلفة عن ما يكتب في صفحات الرأي على المستوى الوطني والعربي..
2ـ إن الممارسة السياسية في جوهرها ومآلاتها، لا تستند إلى عالم النيات والدوافع الذاتية العميقة للإنسان، وإنما هي تستند إلى عالم المعطيات الإنسانية العميقة وطبيعة الظروف الذاتية والموضوعية الموجودة.
لأن الممارسة السياسية تستهدف تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، وفي كلا الحالتين الممارس السياسي بحاجة إلى خطوات عملية ـ تدبيريه، وطبيعة هذه الخطوات، هي التي ستحدد مدى صوابية هذه الممارسة أو جدوائيتها على الصعيد الفعلي.
فعالم القلوب والنيات ليس له مدخلية مباشرة وحقيقية في عالم الممارسة السياسية. فالإنسان الخاضع لظرف سياسي ما، يحتاج من السياسي أن يزيل عن كاهله هذا الظرف، بصرف النظر عن طبيعة دوافع هذا السياسي في القيام بهذه الخطوة. فلو خير الإنسان بين ممارس للسياسية يمتلك نية صادقة وصافية، إلا أنه لا يمتلك علاقات واسعة أو قدرة متميزة على التدبير و آخر نيته تشوبها بعض المصالح الشخصية أو الدوافع الدنيوية، إلا أن لديه الكثير من العلاقات القادرة على تفكيك بعض العقد أو مساعدته في الوصول إلى مايبتغيه. فلا ريب أن هذا الانسان سيختار وينتخب هذا الإنسان الذي يمتلك القدرة على التدبير وتسيير شؤون الناس. لذلك فإن النقطة المركزية في تقويم الممارسة السياسية ليس طبيعة الشعارات المرفوعة أو العواطف الجياشة التي يبديها، وإنما قدرته الفعلية على الانجاز، وقدرته على التدبير.
فالممارسة السياسية ليست عملا تعبديا محضا، تشترط فيه النية الخالصة، و إنما هو من الأعمال العامة و التي لا يشترط فيها النية الخالصة، و إنما يشترط فيها أهلية الإنسان النفسية و التدبيرية في القيام بهذه المهام و الوظائف المتعلقة بالممارسة السياسية..
3 ـ إن الفصل في الممارسة السياسية بين عالم النيات والقلوب وطبيعة المعطيات الواقعية القائمة، يتطلب بناء ثقافة سياسية جديدة، تتبدل فيها معايير التقويم. لأن عالم السياسة ليس هو عالم العواطف والصراخ الوجداني أو رفع الشعارات الصارخة، وإنما هو عالم القوة والمعطيات الفعلية وبناء والتوافقات وفضاء التسويات البعيد عن فكرة دحر العدو أو الخصم أو تحقيق انتصارات كاسحة عليه، وإنما هو مجال للقيام بتسويات تخرج الجميع كاسبا.
وعليه فإن النزعات الشوفينية والعدمية، هي أحد النزعات الأساسية، التي تساهم في تصحير الحياة السياسية، وتشويه الثقافة السياسية الضرورية لفضائنا العربي والإسلامي.
فالممارسة السياسية لا تستند في حركتها وفعلها إلى عالم الرغبات المجردة، وإنما تتكئ إلى عالم المعطيات القائمة.
والإنسان الذي يتحرك في الحقل السياسي برغباته الجامحة والمجردة. هو لا يمتلك على المستوى العملي إلا الشعارات البراقة واليافطات الصارخة. وهو بهذا يصنع الأوهام للناس. دون أية قدرة فعلية لإنجاز بعض جوانب هذه الشعارات واليافطات.
فالممارسة السياسية الناجحة تدير ما هو كائن، ولا تخلط بين ما هو كائن وماينبغي أن يكون. وستبقى أهداف وغايات الإنسان الكبرى حاضرة على مستوى وجدانه ومبادئه، ولكن حينما ينخرط في الممارسة السياسية فهو لايتحرك وفق رغباته وآماله البعيدة وإنما يتحرك وفق قدراته القائمة وطبيعة الظروف المحيطة به. فعالم السياسة ليس هو عالم الشعارات والرغبات، وإنما هو عالم صنع التحالفات واكتشاف التقاطعات بين جميع القوى والمكونات. وفي هذا العالم تتراكم عناصر القوة، ولا يمكن تحقيقها دفعة واحدة.
وعليه فثمة ضرورة في المجال العربي، لإعادة تأسيس لمفهوم الممارسة السياسية بوصفها القدرة على التدبير في الشأن العام، وليست مسابقة لإطلاق شعارات صارخة و تعبئة غير محسوبة للشارع تثير الغرائز وتغيب العقل. وإنه بدون تفكيك هذه الظاهرة سنبقى نحن كعرب نصرخ ونعلن ونستنكر، وكأن هذه العناوين هي التي تغير المعادلات وتبني معادلات جديدة. فكلما ازددنا صراخا، ابتعدنا عن مقتضيات الممارسة السياسية السليمة التي تفضي إلى نتائج إيجابية على قضايانا المختلفة. وأحسب أن هذه العقلية التي تمارس السياسة بوصفها إطلاق العنان للغرائز والشعارات ساهمت مع غيرها من العوامل في ضياع فلسطين وبقاء معادلة الغلبة الصهيونية. فنحن نصرخ ونرفع الشعارات و نقيم المهرجانات الخطابية، والطرف الآخر يبني المستوطنات و يمأسس حياته المدنية والإدارية والسياسية، ويصيغ التحالفات العميقة مع القوى المؤثرة في العالم، فكانت النتيجة هكذا، نزداد نحن كعرب بعدا عن فلسطين ويزداد الصهاينة عتوا وترسخا في الأرض الفلسطينية.
ودائما وفي كل المجالات، لا تتغير معادلات الميدان بالصراخ والعويل، ولا تبنى القوة النوعية لنا بكثرة الخطابات و المهرجانات الدعائية، بل تبنى بتصحيح طبيعة ممارساتنا للسياسة وإدارتنا لمعاركنا و قضايانا على أسس العقل و حساباته و معطياته و ليس وفق الرغبات المجردة.
وخلاصة القول: أن النقد بكل أبعاده و مستوياته، أضحى ضرورة ملحة و حاجة قصوى لفضائنا العربي للخروج من الأخطاء الفادحة التي كلفتنا الكثير على مستوى قضايانا الكبرى.
المجتمع والوعي النقدي:
شهدت البشرية خلال العقدين الماضيين، الكثير من التطورات والتحولات التي طالت كل شيء تقريبا بحيث دخلت الإنسانية في مرحلة تاريخية جديدة على مختلف الصعد والمستويات. صحيح أن بعض المجالات والمناطق لم تطلها حركة التحولات بشكل سريع ومباشر، إلا أن وتيرة التحولات وتصاعدها الهندسي، سيفضي في المحصلة النهائية إلى أن تطال هذه المسيرة جميع المجالات والجوانب.
فالموجات المتلاحقة من التطورات، تتطلب حيوية فكرية وسياسية عربية وإسلامية، حتى يتسنى لنا جميعا الاستفادة من هذه التطورات، وتأسيس قواعد وأطر مجتمعية، تعتني بحركة التحولات وترصد مسيرتها، وتوضح سبل وأوليات الانطلاق على ضوئها.
وحركة التقدم والتطور والتجديد في المجال الإسلامي مرهونة، إلى حد كبير بقدرة هذا المجال على توفير حقيقة الاستقرار المجتمعي وقوامه حرية الإنسان وتماسك الجماعة والاجتهاد وتطوير مؤسسات البحث والتفكير وصياغة ثقافة سياسية جديدة لا تنحبس في قوالب ماضوية ولا تلغي خصوصية أوضاعنا، ولا تقفز في المجهول وإنما تبني حياة سياسية جديدة ترتكز على إطلاق الحريات السياسية لكل القوى والمكونات، وإدارة الاختلاف والتنوع بعقلية الحوار والاستيعاب، لا بعقلية الصمت والإلغاء.
ودون ذلك سيبقى تأثير التحولات الحضارية والإنسانية التي تجتاح المعمورة وكأنه فقاعات ورغاوٍ لا تزيدنا إلا وهما وابتعادا عن المسيرة السليمة في بناء واقعنا على أسس الحرية والمعرفة.
فمواجهة تحديات العولمة، تقتضي منا جميعا، وكلٌّ من خندقه وموقعه، المشاركة الجادة في عملية البناء الداخلي وتطوير الديمقراطية وقيم الحرية وحقوق الإنسان في الفضاء العام.
وان العجز تجاه تمثّل هذه القيم والمبادئ، مهما كانت أسبابه، سيلقي بظلاله الكئيبة على العالمين العربي والإسلامي. حيث تستفحل الأزمات والمشكلات، وتتعاظم الاختناقات، ويضيق هامش الخيارات والمسارات، وتتفاقم كل أسباب الخروج من العصر.
فعصر العولمة يتطلب منا، إرادة إنسانية مستديمة، تتجه صوب طرد كل معوقات الانكفاء والانعزال والهامشية، وتبني كل حقائق الحضور والشهود. وروحية جديدة تمتص كل المكاسب، وتستوعب كل المنجزات، وتزيل من طريقها ومسارها كل الكوابح التي تحول دون توظيف مكتسبات العصر. وثقافة تعلي من شأن الإنسان وحقوقه، وتصون كرامته ومكتسباته، وتجذر وتعمق خيارات الحوار والتعددية والتسامح بدل العنف والإقصاء والأحادية. ونظاما سياسيا، يستند في إِدارته وحكمه على مبدأِ المشاركة وتداول السلطة وإرساء دعائم الديمقراطية في الحياة العامة. وإن الظفر بمكاسب التكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات، يتطلب منا كشف قوانين هذه المكاسب وسننها؛ لأن هذا الكشف، هو الذي يوفر لنا القدرة على توظيفها بما يتلاءم وقضايانا وحاجاتنا الملحة.
وإن هذه التحولات والتطورات التي تطال كل شيء، ينبغي أن تحيلنا إلى وعينا النقدي، وتطور استعداداتنا الإنسانية في المساءلة والمراقبة وإعمال العقل؛ وذلك لأن غياب الوعي النقدي مع زخم التحولات وتطوراتها المتسارعة، لا يجعلنا نوفر الأسباب والعوامل الذاتية التي تؤهلنا للانخراط النوعي في مسيرة العالم والعصر. فوعينا النقدي وتنمية استعداداتنا في المساءلة وإعمال العقل، هو القادر على توفير إمكانية إنسانية جديدة للتعامل الخلاق والمبدع مع منجزات العصر ومكاسب الإنسان.
والمجتمع الذي تضمحل فيه إمكانية ممارسة النقد والمساءلة، لا يستطيع استيعاب التحولات والإفادة القصوى من منجزات العصر والتقنية الحديثة. والوعي النقدي لا يتبلور وينمو في الفضاء الاجتماعي، إلا في إطار من الحريات السياسية والثقافية، التي تفضي إلى خلق وقائع اجتماعية تسمح بممارسة النقد وتحترم متطلباته وتؤسس لمبادرات مجتمعة على قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية.
وإن تجذر متطلبات الوعي النقدي في فضائنا الاجتماعي، هو الذي يحررنا من يباسنا وجمودنا، وهو الذي يوفر لنا الإجابات المطلوبة عن متغيرات واقعنا وراهننا، وهو الذي لا يجعل الهوية مقولة جامدة لا تحرك ساكنا، وإنما يحولها إلى وظيفة لطرد عناصر التأخر والتخلف وإمكانية إنسانية مفتوحة على الفعل والإبداع والوجود.
في النقد الذاتي:
ثمة حقيقة أساسية ينبغي أن ننطلق منها، وهي أن قوة أي مجتمع لا تقاس بمدى ما يمتلك من قدرات مادية أو سلع استهلاكية، وإنما بمستوى استقراره النفسي ونظام العلاقات الداخلية الذي يربط بين مختلف مكونات المجتمع.
فحينما يكون نظام العلاقات الداخلي يشرع للقطيعة والجفاء والتباعد، فإن قوة المجتمع تتراجع لغياب الترابط العميق بين أبنائه ومكوناته، أما إذا كانت العلاقات الداخلية قائمة على الاحترام المتبادل والفهم والتفاهم وحسن الظن، فإن هذا المجتمع يتمكن من حماية نفسه ومكتسباته من كل الأخطار والتحديات. والذكر الحكيم يحذر من جملة عناصر أن تسود في مجتمعنا، وذلك لأن هذه العناصر تنخر قوته وتشتت مكوناته وتباعد بين أبنائه. إذ يقول تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} (الحجرات 12).
فالانطباعات التي نحملها عن بعضنا البعض، ينبغي أن تكون منسجمة وتوجيهات قيم الإسلام العليا، التي تدعونا إلى اجتناب الظن. وإن انطباعاتنا ومواقفنا تجاه الآخرين ينبغي أن تكون مستندة ومنطلقة من أدلة وبراهين دامغة. والآية الكريمة تحذرنا جميعا من تشكيل قناعاتنا ومواقفنا من الآخرين من خلال الشائعات أو الحدس أو سوء الظن والتخرصات.
فالمطلوب دائما وفي كل الأحوال: إزالة كل الرواسب والعناصر التي لا تؤدي إلا إلى تضعضع البناء الاجتماعي. لذلك نجد أن التوجيهات الإسلامية تحثنا على حسن الظن والاحترام العميق للآخر شخصاً وفكراً ووجدانا.. حيث جاء في التوجيه الإسلامي (ضع أمر أخيك على أحسنه، حتى يجيء ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا)..
فالقوة الحقيقية في المجتمعات، تقاس بمستوى العلاقات والروابط بين فئات ومكونات المجتمع الواحد.. فإذا كانت العلاقة سيئة، سلبية، قائمة على سوء الظن والاتهام والكراهية والحقد، فإن هذا المجتمع حتى لو امتلك العديد من الإمكانات والثروات، فإنه لن يتمكن من بناء قوته على أسس صلبة وعميقة. أما إذا كانت العلاقة بين مكونات المجتمع الواحد، قائمة على الاحترام والتفاهم والمحبة وحسن الظن فإن هذا المجتمع سيتمكن من بناء قوته على أسس صلبة وعميقة. ولن تتمكن تحديات الواقع ومخاطره من النيل من أمن واستقرار هذا المجتمع..
من هنا فإننا ينبغي باستمرار أن نولي أهمية فائقة وقصوى الى طبيعة العلاقة بين مكونات المجتمع الواحد. ونعمل باستمرار على فحص هذه العلاقة، والسعي المتواصل لتنقيتها من كل الرواسب والشوائب التي تؤزم العلاقة وتدخلها في نفق غياب الوئام والتفاهم المتبادل.
لذلك فإن الأولوية الكبرى اليوم هي في تصليب وحدتنا الاجتماعية والوطنية، وذلك حتى نتمكن من مواجهة التحديات وتجاوز المخاطر التي تواجهنا في هذه اللحظة التاريخية العصيبة.. وهذا لا يتأتى إلا بنظام علاقات داخلية بين مكونات المجتمع والوطن على أسس أخلاقية ودينية ووطنية، نتمكن من خلالها من إزالة كل العناصر المسيئة للعلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع والوطن الواحد. وهذا يلزمنا جميعا بإطلاق مشروع حوار دائم ومتواصل بين مختلف الشرائح والمكونات، حتى نتمكن جميعا من تطوير مستوى التفاهم بين مكونات المجتمع. وإن الخلاف في القناعات والآراء والمواقف ينبغي أن لا يدفعنا إلى أن نغلق أبواب الحوار. بل على العكس من ذلك، حيث ان وجود الخلافات بمختلف مستوياته، ينبغي أن يدفعنا إلى الحوار المستديم والتواصل الإنساني الذي يساهم في تعريف بعضنا البعض بأفكارنا وقناعاتنا.
فالخلاف وتباين وجهات النظر بين أبناء المجتمع والوطن الواحد، لا يشرع للجفاء والقطيعة، وإنما يحفزنا للمبادرة للانخراط في مشروع الحوار والتواصل، حتى نحافظ على أمننا واستقرارنا السياسي والاجتماعي. فقوتنا مرهونة بوحدتنا، ووحدتنا بحاجة إلى تنظيف بيئتنا ومناخنا وفضائنا الاجتماعي والثقافي والسياسي من كل الشوائب والأوساخ المعنوية، التي تفرق بين أبناء المجتمع الواحد، وتبني حواجز نفسية وعملية تحول دون التفاهم والتلاقي.. إننا اليوم لا نتمكن من إزالة رواسب الواقع السيئة، إلا بإزالة شوائب النفوس وأحقادها وأغلالها، لأنها هي التي تنتج باستمرار حقائق البغضاء والكره والتنافر.
فليبدأ كل إنسان من نفسه، ويعرض قناعاتها ومواقفها وأوضاعها على قيم الوحدة والألفة والمحبة، ويعمل بإرادة مستديمة على طرد كل العناصر السيئة التي قد تعشعش في نفسه وتحوله إلى كائن يمارس الحرب بكل صنوفها تجاه الآخرين.. فـ (أزل الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك).. فأمننا واستقرارنا ووحدتنا، بحاجة إلى الفتنا ومحبتنا لبعضنا البعض وتجاوز حقيقي لكل أحن الماضي وسيئات الواقع.
وهذا بطبيعة الحال، لا يتأتى إلا بحوار داخلي عميق ومتواصل بين مكونات المجتمع المتعددة، حوار لا يتجه إلى المساجلة والمماحكة، وإنما الى الفهم والتفاهم. حوار لا يشرع للقطيعة والتباعد، وإنما يؤسس للتلاقي وتنمية المشترك الديني والوطني والإنساني. حوار لا يجامل ولا يداهن، ولكنه يؤسس للاحترام والاعتراف بالآخر دون التعدي على حقوق الآخرين وقناعاتهم ورموزهم وشخصياتهم.
إننا أحوج ما نكون اليوم، للخروج من أحن الماضي، والانعتاق من أسر التخلف، والتحرر من الانطباعات المسبقة والمواقف الجاهزة التي تبرر لنا جميعا الفرقة والتشتت، وتؤسس للحقد والكره.
إن الأمن الاجتماعي والوطني اليوم، بحاجة إلى كل خطوة ومبادرة، تتجه صوب الآخر وتنسج علاقات إيجابية معه، على أسس الحق والعدالة والمساواة. إننا نفهم معنى الوحدة في المجتمع الوطني، من خلال فهم معنى التلاقي والاحترام والتفاهم بين شرائح المجتمع ومكونات الوطن. فالوحدة ليست مجرد شعار ويافطة، هي رسالة ينبغي أن تتجسد في واقعنا، ولا يمكنها أن تتجسد وتبنى إلا بالحوار والتلاقي والتواصل والتفاهم والاعتراف بالآخر المختلف والمغاير...
إننا ينبغي أن نبني إنسانيتنا وأوضاعنا على أساس أن لا نعيش الظلم والانحراف في أنفسنا وعلاقاتنا بالآخرين. لأن هذه هي بوابة الوحدة والأمن والاستقرار. وحينما نمارس العسف والظلم بحق المختلفين معنا في الرأي والفكر، فإننا في حقيقة الأمر ندق اسفينا خطيرا في البناء الوطني والاجتماعي، فالاختلاف مهما كان شكله ونوعه، لا يبرر للإنسان ممارسة العسف والظلم تجاه المختلف معهم.
وعوامل الاختلاف وأسبابه، لا تنتهي وتندثر من ممارسة الظلم والعسف، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ ان هذه الممارسات تزيد الاختلافات اشتعالا، وتدخلها في دوائر جديدة تهدد أمن الجميع واستقرارهم. وقد آن الأوان بالنسبة لنا جميعا لفك الارتباط بين الاختلاف والشحناء والبغضاء.
فالاختلاف في الرأي والفكر والموقف، لا يبرر بأي شكل من الأشكال ممارسة الحقد وشحن النفوس بالبغضاء والكراهية. وقيم الدين والأخلاق الإنسانية، لا تقر هذه الممارسات والمواقف، التي تنطلق من رؤية ضيقة وموتورة للاختلافات والتنوعات المتوفرة في عالم الإنسان.. فالباري عز وجل يوجهنا إلى القول الحسن الذي ينطلق من نفس تحمل الحب والخير كله للآخر. إذ يقول تبارك وتعالى {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا} (الإسراء 53). فلنقتلع الكره والبغض من عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا، حتى نتمكن من تطهير واقعنا الاجتماعي من كل الأمراض والأوساخ، التي تضر حاضرنا وتهدد مستقبلنا.
وحتى ينجح الحوار الوطني، ويؤتي ثماره الوطنية المرجوة، بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية والمجتمعية التالية:
1) الانخراط في مشروع الإصلاح الثقافي والفكري، لأنه لا يمكن أن ينجح الحوار والتواصل بين مكونات ثقافية تحمل في داخلها وتحتضن في مفرداتها بعض العناصر السلبية في العلاقة والموقف من الآخر.. وهنا أوجه دعوتي لكل الأطراف والمواقع لممارسة نقد ثقافي صريح وشجاع لموروثاتنا الثقافية والاجتماعية وبالذات فيما يرتبط والعلاقة من ومع الآخر. حيث لا يمكن نجاح الحوار وتفعيل مفرداته في الواقع المجتمعي بدون عملية إصلاح ثقافي وفكري، تتجه الى مراجعة جادة وجريئة لمواقفنا من الآخر. حيث إننا جميعا في بعض عناصر ثقافتنا وموروثاتنا الشعبية، نحتضن موقفا سلبيا من الآخر المختلف والمغاير.. وعملية الحوار الوطني، بحاجة إلى جرأة ونقد ثقافي ذاتي على هذا الصعيد، حتى نتمكن من طرد كل مكونات السلب في رؤيتنا وموقفنا من الآخر. ولا ريب أن النظرة الاصطفائية إلى ثقافاتنا وقناعاتنا المجتمعية، هو الذي يحول دون الانخراط الجاد في مشروع النقد والإصلاح.
وبدون عملية النقد والإصلاح الثقافي والفكري، تبقى دعوات الحوار والتواصل قشرية وبعيدة عن المسار المجتمعي الحقيقي.. إن الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع والوطن الواحد، هي من الخيارات الاستراتيجية التي ينبغي أن نوفر كل الشروط المفضية الى تجسيده في فضائنا الاجتماعي. وهذا بطبيعة الحال، بحاجة إلى مشروع إصلاح ثقافي، يتجه إلى اعادة صياغة ثقافتنا الوطنية والاجتماعية على أسس أكثر عدلا ومساواة واعترافا بالآخر واحتراما لكل أشكال وحقائق التنوع المتوفرة في محيطنا الاجتماعي.
ففعالية الحوار الوطني، تتطلب عملية إصلاح ثقافي حقيقي، لطرد كل معوقات وكوابح الحوار من ثقافتنا وفضائنا الاجتماعي. فالإصلاح الثقافي الحقيقي، شرط جوهري ورئيس لنجاح مشروع الحوار الوطني.. إذ لا حوار فعال بدون نقد عميق لموروثاتنا الثقافية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في تكريس الجفاء والقطيعة بين مختلف مكونات المجتمع.
2) الموازنة بين نقد الذات ونقد الآخر، حيث ان العديد من الناس لا يحسن إلا نقد الآخرين وتحميلهم مسؤولية الفشل والإخفاق في العديد من الأمور والقضايا.. بينما حقيقة الأمر اننا جميعا وبدون استثناء نتحمل مسؤولية واقعنا وراهننا. وإذا أردنا التحرر من هذا الواقع، فعلينا أن نمارس نقداً لممارساتنا ومواقفنا وأفكارنا، كما نمارس النقد لأفكار الآخرين وممارساتهم ومواقفهم، وحيوية الحوار والتواصل دائما تنبع من عملية البحث الحقيقي الذي تبذله جميع الأطراف لمعرفة الحقيقة والوصول الى صيغ عملية وممكنة وحضارية لادارة الاختلاف والتنوع المتوفر في الفضاء الاجتماعي. والخطر كل الخطر حينما نحمل الآخر كل شيء ونزكي ذواتنا ونخرجها من دائرة المسؤولية.. بينما المطلوب دائماً وأبدا محاسبة ذواتنا ومحاكمة قناعاتنا ومجاهدة أهوائنا، وذلك من أجل أن نتحمل مسؤولياتنا على أكمل وجه، لذلك يقول تبارك وتعالى {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} (النجم 32).
والحوار الوطني اليوم يتطلب وبإلحاح شديد، من جميع الأطراف والأطياف أن يفحصوا قناعاتهم ويراجعوا أفكارهم ويمارسوا بصدق عملية نقد ذاتي، وذلك من أجل أن نتخلص جميعا من زوائدنا ومن رواسب التاريخ وأعبائه، وننطلق في بناء غدنا ومستقبلنا بعيداً عن الأحن والأحقاد والمواقف الجاهزة والمعلبة. ووجودنا الحقيقي سواء على المستوى الخاص أو العام، مرهون على قدرتنا على مساءلة واقعنا ومحاسبة أفكارها وفحص قناعاتنا باستمرار. ونحن هنا لا ندعو الى جلد الذات وتحميلها مسؤولية كل شيء، وإنما ندعو إلى الخروج من حالة النرجسية في النظر إلى ذواتنا وقناعاتنا العامة وبالخصوص فيما يرتبط بطبيعة العلاقة والموقف من الآخر.
فلنغسل قلوبنا ونطهر نفوسنا من نوازعها الشريرة والخبيثة، وندخل في رحاب الحوار برؤية وثقافة ونفسية جديدة.
في منهجية النقد والمراجعة:
عندما تصاب أمة أو جماعة بصدمة كبيرة تفقدها ثقتها بنفسها فتصبح على استعداد لرؤية كل العيوب في تاريخها ورؤية كل المحاسن في تاريخ غيرها.. وتنتقل من الدراسة الموضوعية المحددة، إلى اتهام النفس أو الواقع السيئ أو التاريخ أو التراث، ومن الواضح أن هذه المواقف لا تقدمها في شيء، بل تحرمها من ميزة الرؤية الواضحة الصحيحة، وتدفعها إلى الغرق أكثر فأكثر في الحالة التي تعيش فيها.
فتتحول هذه النكسة أو النكبة إلى معول هدم وتفتيت لكل أعمدة البناء التاريخية والعقدية والاجتماعية حيث يعدها هي السبب في هذه الهزيمة، ويفقد المجتمع من جراء ذلك كل مقومات الرؤية المتزنة والرشيدة التي ترى الأمور على حقيقتها، وتوضح الأسباب والعوامل الحقيقية لتلك الظاهرة وسبل الخروج منها أو تجاوزها وهذا يقودنا إلى القول إننا بحاجة دائماً أن نتعامل مع هزائمنا وانتصاراتنا بموضوعية بحيث إننا لو انتصرنا لأنصاب بداء الغرور والتعالي، فنلغي الآخرين من خريطة الوجود التاريخي.. ولو انهزمنا ندرس أسباب هزيمتنا بشكل موضوعي وهادئ، ودون أن يؤثر هذا على جوهر وجودنا وثوابت كياننا ولاشك أن للإنجازات أسبابها وعناصرها كما أن للإخفاقات عواملها.
والرؤية الموضوعية تحتم علينا دراسة المسألة من جميع أبعادها لإزالة عوامل الإخفاق وتأكيد عناصر النجاح والإنجاز.
وبما أن العالم بأسره يعيش زلزالاً أيدلوجياً وسياسياً فإننا أحوج ما نكون إلى فن مراجعة ظروفنا وإمكاناتنا ثغراتنا لا لكي نجلد ذواتنا ونبكي على أمجادنا وإنما لكي نستعيد عافيتنا ونسد ثغراتنا ونستوعب نقاط الإيجاب في هذا التطور الرهيب الذي يجري في العالم ونبتعد عن السيئ منه.. إذ إننا أمام هذه التطورات السريعة بحاجة إلى الاتزان النفسي والمعرفي لدراسة الأمور وتقويم القضايا والأفكار ولاشك أن فن المراجعة هو الذي يوفر هذا الاتزان، ويبعدنا عن ردود الأفعال المرتجلة القائمة على إستلاب ذاتنا ونفي إمكاناتنا وفضائلنا التاريخية والمعاصرة.
وتتأكد هذه المسألة في وقتنا الحاضر لأنه في هذه الأيام كثرت دعوات المراجعة الشاملة لأصولنا وطرائق تفكيرنا دون بيان المنهجية السليمة والواضحة لعملية المراجعة.
لاشك أن النكبات المتلاحقة والتطورات السريعة في مختلف الميادين تلزمنا جميعاً أفراداً وجماعات على الوقوف مع النفس والتأمل في هذه المتغيرات ودراستها بموضوعية واتزان، والعمل وفق النتائج المترتبة على ضوء تلك الدراسة الموضوعية.
أما أن نصرخ مع الصارخين حول ضرورة المراجعة الشاملة لوجودنا وكياننا وأفكارنا ومنظوماتنا المعرفية والمنهجية دون أن ندرك تداعيات هذه الصرخة المنهجية المقترحة لعملية المراجعة.. لاشك أن هذه الصرخة اللامنهجية ستؤدي إلى المزيد من الانهيارات ونبذ الأبنية الذاتية التي تشكل في المحصلة النهائية جزءاً من خطوط دفاعنا الحضارية.
ولا يوجد على المستوى التاريخي أن مجتمعاً مكتوباً عليه أن قدره الهزيمة دائماً أو الانتصار دائماً.. وإنما هما (الهزيمة والانتصار) ظاهرتان إنسانيتان تتحكم فيهما جملة من العوامل الذاتية والموضوعية.
فالمجتمع الذي تتوافر فيه عوامل المنعة والتفوق يحقق ذلك على الصعيد العملي، والمجتمع الذي يتخلى عن تلك العوامل يصاب بالإحباط والتراجع والتقهقر. فالرؤية الموضوعية تعني، الابتعاد عن التهويل والتهوين، والبعد عن الشطط والمغالاة وعن اليباس والتيبيس الدافع إلى الاستقامة المعنوية الفردية والجماعية.
وإن فقدان الثقة بالذات من جراء نكسة أو هزيمة يؤدي حتماً إلى الاستسلام إلى المنظومات الفكرية والثقافية للغالب..
وقد اشار إلى هذه المسألة ابن خلدون بقوله: إن المغلوب مولع دائماً بمحاكاة الغالب والاقتداء به لأنه يعتقد أن انتصاره راجع إلى صحة مذهبه وعوائده.
كما أن تجريح الذات وجلدها على مختلف الصعد والمستويات ما هو في حقيقة الأمر إلا إخفاء لابتعاد المثقف أو المفكر أو الأديب والنخبة بشكل عام عن مواطن الإبداع الفكري والثقافي والأدبي وتحولهم في الكثير من الأحيان إلى إحالة للماضي وحجاباً لعدم رؤية الحاضر.. فالقراءة الموضوعية إلى الظواهر الاجتماعية والإنسانية المفرحة منها والمحزنة تحتم علينا النظر إلى الأمور انطلاقاً من أسبابها الحقيقية وعواملها المباشرة.
والجدير بالذكر في هذا الإطار أن تاريخ الثقافة العربية الحديثة، أغلبه تاريخ مراجعة للمفاهيم الكبرى وطرائق التمدن والحضارة التي تحويها هذه الثقافة. إذ إن صدمة الحضارة الحديثة للواقع العربي المأزوم جعل أصحاب القلم والفكر من البدء بمراجعة مستمرة لصلاحية الثقافة العربية وقدرتها على مواكبة العصر وبناء الحاضر.
ويشير إلى هذه المسألة خير الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك) بقوله: إن التمدن الأوروباوي تدفق سيله في الارض، فلا يعارضه شيء إلا استعاضة قوة تياره المتتابع فيخشى على المسالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق.
من هنا وتأسيساً على حقيقة التطورات السريعة التي تجري في العالم في كل اتجاه تتأكد ضرورة التقيد بقوانين الموضوعية في دراسة التطورات والظواهر الاجتماعية والإنسانية الأخرى.. لأن توافر هذه القوانين هو الذي يمكننا من قراءة هذه التطورات والتحولات بشكل سليم ودقيق.
وفن المراجعة يقتضي:
1) توفير أسس الفحص والمقدمات العقلية والنظرية لعملية المراجعة إذ لا يعقل أن تتم المراجعة انطلاقاً من ردود أفعال أو مماحكات سياسية بل من الضروري أن تتوافر كل الادوات النظرية والمفهومية والعدة التقنية التاريخية والمعاصرة لفحص الظاهرة فحصاً موضوعياً متزناً.
2) التقيد بالمنهج الموضوعي دون جلد الذات أو تحميل الآخر المجهول أسباب الإخفاق وعوامل الهزيمة.
وبهذا نتشبث بما يسمى بـ (القوانين الموضوعية) للظواهر الاجتماعية والإنسانية.. ومن هنا فإن فن المراجعة يقتضي أيضاً دراسة الظاهرة والكشف عن قوانين عملها وحركتها وعن طبيعة العلاقة التي تربط بين عناصرها المختلفة.
وعن طريق هذه الدراسة نصل إلى النتائج الأخيرة بعيداً عن المسبقات الفكرية أو الاجتماعية ونتعرف على الأسباب الموضوعية لنمو الظاهرة أو ضمورها.. وحتى لا تكون عملية المراجعة عملية عبثية أو بدون أهداف محددة وواضحة لابد من وضوح المقصد وتحديد الغايات المرجوة من عملية المراجعة.
وبالتالي فإن فن المراجعة يعني تقبل الحقائق وعدم ألوانها بما يناسب النظام المفاهيمي الخاص.
إننا مع ضرورة المراجعة لمناهجنا العلمية والعملية، لكنها تلك المراجعة التي تنطلق من حس المسؤولية الذاتية وتحمل الذات مسؤولية الإصلاح فلا يكفينا أثناء مراجعتنا أن نعرف الداء ومكمن المشكلة أو الأزمة.. لا يكتفي بمعرفة الداء، وإنما يبدأ يكافح لصناعة الدواء الناجع لذلك الداء.
وحده العمل الجدي والمسؤول هو الذي يعطي لمشروع مراجعاتنا جدوى وفاعلية وفائدة وقد قال الشاعر:
قل لمن يبكي على رسم درس
واقفاً ما ضر لو كان جلس
وأخيراً.. فإن المراجعة تستدعي حضور الوعي الذاتي وتوافر الشجاعة الأدبية والمعرفية التي تجعل الإنسان يتجرد شيئاً فشيئاً عن مسبغاته وأهوائه السياسية والفكرية، وتخلق لديه القدرة على الصعود إلى مستوى الرؤية الموضوعية إلى الأمور والقضايا.
فحاجة المجتمعات الدائمة إلى التطور والتقدم، تدفعنا إلى ضرورة بلورة منهجية متكاملة للنقد والمراجعة، حتى يتسنى لمختلف قوى المجتمع وتعبيراته المتعددة المساهمة الفعلية في تجاوز مواطن الخلل واليباس التي تحول دون انطلاقة فعل التغيير في الواقع الاجتماعي.
فلا تقدم حقيقياً إلا بنقد عميق للسائد، ليس من أجل جلد الذات أو التباكي، وإنما من أجل توفير كل متطلبات الإصلاح وشروطه في الفضاء الاجتماعي.
النقد والوعي الاجتماعي:
يعتقد الكثير من الناس أن الوعي الاجتماعي، هو مجرد نصوص لفظية أو شعارات يلوكها لسان الإنسان، وامتلاك القدرة على توصيف الواقع الاجتماعي بجملة من الكلمات والألفاظ البراقة، يعتبر واعياً اجتماعيا ويضرب به المثال في هذا المجال،ولقد أضاع هذه الفهم ومتوالياته النفسية والاجتماعية والثقافية، الكثير من الفرص السانحة، التي كان بإمكان المجتمع العربي، لو كان يسوده وعي اجتماعي حقيقي، أن يغتنمها ويترجمها، إلى حــقائق اجتماعية وثقافيـــة تطور من واقعه، وتنهي الكثير من مشاكلــه و أزماته.
ومن جراء هذا الفهم المغلــوط للــــوعي الاجتماعي، تحولت فرص النمو والانطلاق، في المجتمع العربي، إلى مهاوي تزيد من تعقيد المشكلة وتضيف لها أبعاداً أخرى.
وتظهر أعراض هذا الفهم المغلوط لمقولة الوعي الاجتماعي، في الكثير من الأعراض والمؤشرات والمسارات التي تسير على هداها المجتمع العربي. فهي أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية، تسود قيم التلقين والتلقي والفردية القائمة على نفي حاجة الإنسان إلى التعاون والتآلف مع الآخرين، لذلك ينشأ الواحد منا وهو لا يفكر إلا في ذاته وفي حدودها الضيقة والآنية أيضاً.
وفي التنشئة الثقافية، تسود قيم الفرادة الموهومة ووهم امتلاك ناصية الحقيقة المطلقة وضرورة الاكتفاء بما عندنا من علم وثقافة، وكأن العلم والثقافة وصلا إلى حدودهما القصوى، وهي مخزنة في صندوق، وما علينا إذا أردنا العلم والثقافة إلا فتح الصندوق، ودورنا ينحصر في استهلاك ذلك العلم المكتشف من ذلك الصندوق.
لذلك ومن جراء هذا التركيب المجتمعي القائم، على فهم مغلوط أو ناقص لمفهوم الوعي الاجتماعي، نخسر فرص النمو والتطور وتنقلب علينا بشكل سلبي وتتراكم في محيطنا عناوين ويافطات تبرر لنا هذا الواقع المعاش، وبدون الاستطراد في بيان الأعراض والآثار السيئة للفهم المغلوط لمقولة الوعي الاجتماعي، نحاول أن نوضح مقصودنا من هذه المقولة.
الوعي الاجتماعي هو عبارة عن جملة المفاهيم والأفكار والثقافات التي توجه حركة أفراد هذه المسألة و متوالياتها المتعددة. لــهذا يختلف الوعي الاجتماعي من مجتمع إلى آخر، باختلاف المفاهيم المهيمنة على المسار الاجتماعي، وطبيعة الفهم الإنساني إلى تلك المفاهيم والحوافز القصوى التي تخلقها المفاهيم في حياة الناس، لذلك فإن الوعي الاجتماعي، هو وليد فهم الناس إلى تاريخهم وحاضرهم وقيمهم العليا، ونتاج التفاعل البشري مع الأطر النظرية المتاحة أو المتداولة.
وبهذا نستطيع أن نحدد مفهوم الوعي الاجتماعي بالعناصر التالية:
1) مجموع المفاهيم والقيم المتداولة في حياة الناس ونظام التفاضل الموجود بينها.
2) تفسير الناس وفق ظروفهم ومستوياتهم المختلفة، إلى تلك المفاهيم والقيم.
3) تجربة الناس اليومية في الالتزام بهذه المفاهيم، ونظام علائقهــم الســـائد في أوساطهم، وبينهم وبين الآخرين.
ووفق هذا المنظور، فإن الوعي الاجتماعي ليس مفهوما ناجزاً ومكتملاً، وإنما هو دائم التحول والتطور من جراء تحولات المجتمع المختلفة، لذلك فإن بقاء الوعي الاجتماعي ثابتاً والواقع الاجتماعي متحركاً ومتغيراً هو الذي يؤسس لفهم مغلوط ومشوه لمعنى الوعي الاجتماعي، من هنا فإن شرط الوعي الاجتماعي الفعال هو وجود فكر نقدي، يدعم هذا الوعي،ويرفده بالآفاق الجديدة، ويؤسس لحالات تحول اجتماعي متواصل بهدف الرقي والتقدم الاجتماعي، لهذا ينبغي أن لا نتشاءم أو ننظر بريبة وشك إلى كل الأفكار النقدية للعوائد والمسارات الاجتماعية وإنما من الأهمية بمكان أن نستوعب هذه الأفكار النقدية ونوفر لها الأطر الاجتماعية الطبيعية، لكي تأخذ هذه الأفكار مسارها الطبيعي في التفاعل مع الواقع الاجتماعي وبهذا التفاعل تنضج الأفكار وتتبلور المسارات وتعم الحيوية الجسم الاجتماعي كله.
وتجارب المجتمعات ذات الوعي المتميز، تؤكد لنا أهمية حركة النقد وضرورتها القصوى في خلق الوعي الاجتماعي الجديد فلولا الأفكار النقدية، التي بثها فلاسفة التنوير في أوروبا وما أحدثته من وعي اجتماعي جديد لبقي الظلام والجمود سائدا في أوروبا فشيوع مفاهيم النقد البناء في المحيط الاجتماعي يبدد الجمود وينهي الرتابة ويبث الحيوية والحياة في أرجاء المجتمع ويزيد من مستوى المسؤولية العامة ويساهم في بلورة وإنضاج قوى اجتماعية جديدة، تأخذ على عاتقها دور التجديد والتطوير في المحيط الاجتماعي.
وإن شيوع حالات الاضطراب والفوضى في بعض المجتمعات، ليس من جراء حركة النقد السائد وإنما هو في حقيقة الأمر من جراء غياب أطر الاستيعاب لأفكار النقد الجديدة أو من ردود الفعل السلبية وذات الطابع الارتجالي تجاه الأفكار الجديدة. أما المجتمع الذي يوجد لنفسه القنوات الطبيعية لاستيعاب أفكار أبنائه الجدية، فإنه سيتمكن من إضافة قوة جديدة إلى قوته وسيدخل دماء جديدة تنهي السكون وتحول دون تبلد وتكلس الحياة الاجتماعية.
لهذا فإننا نؤكد على ضرورة، توفر الأطر المناسبة لاستيعاب وامتصاص الأفكار الجديدة، والرؤى النقدية الهادفة إلى التطوير وإعادة صياغة وتشكيل الوعي الاجتماعي بما ينسجم ومتطلبات العصر وضرورات التقدم الاجتماعي.
ولا بد أن لا نستعجل في إطلاق الأحكام واتخاذ المواقف، تجاه من أجتهد في سبيل تطوير وتجديد الوعي الاجتماعي. وأن التحليل العلمي النقدي للسائد اجتماعيا وثقافياً هو الذي يوفر الأرضية العقلية والنفسية لتجاوز البائد من ذلك السائد، وإنهاء ما فيه من أنماط بالية ولقد حاول الدكتور (هشام شرابي) في كتابه " البنية البطركية.. بحث في المجتمع العربي المعاصر ". أن يوضح الصلة الضرورية بين الوعي الاجتماعي والفكر النقدي.
لهذا من الضروري أن نتعامل مع التحليلات النقدية لمسار المجتمعات العربية برؤية منفتحة - مستوعبة بعيدة كل البعد عن لغة النفي والتخوين - وإن النقد الهــادف في أحــد وجوهـــــــه الرئيسة، يشكل شرطاً ضرورياً لتحقيق التطور الاجتماعي المأمول.
فلا وعي اجتماعي متجدد، إلا بفكر نقدي، ولا فكر نقدي بنــــاء، إلا بــوجود أطر مجتمعية، تستوعب تلك الأفكار وتموجاتها. وهكذا يصبح الفكر النقدي شرطا من شروط الوعي الاجتماعي الجديد، بمعنى أن وعي المجتمع بذاته وبالآخرين وبدوره التاريخي، لا ينجز إلا على قاعدة نقدية مستديمة، تسائل السائد، وتجعله على طاولة التشريح والتقويم. وضرورة الحفاظ على الوئام الاجتماعي، لا تعني بأي شكل من الأشكال قسر الجميع وإرغامهم على نمط اجتماعي محدد. وإنما تعني حيوية التنوعات وفاعليتها في أثراء مفهوم الوئام الاجتماعي، بأفكار ورؤى وآفاق جديدة.
وبالتالي فإن الإصرار على إيجاد مسافة تفصل الوعي الاجتماعي السائد، عن الفكـــــر الـــنقدي، يؤدي فيـــــما يؤدي إليه، إلى شيوع حالة العجز التي تنتاب المجتمع تجاه مشاكله وتحدياته المصيرية.
وعليه فإنه لا مبرر للخوف من النقد وفحص المسلمات الاجتماعية، لأن هذا النقد والفحص، هو الذي يطرد العناصر السلبية والميتة من الفضاء الاجتماعي. والخوف الحقيقي ينبغي أن يكون، حينما تغيب عمليات النقد، وحينما تتضاءل فرص الفحص على وقائع المسيرة الاجتماعية. فالنقد ضرورة قصوى لسلامة المجتمع، لأنه يتجه صوب نقاط الضعف ويعمل على تعريتها وفضحها، ويشحذ الهمم لتوفير الإرادة المجتمعية القادرة على سد تلك النقاط. فلا قوة حقيقية لأي مجتمع تغيب فيه عمليات النقد والتقويم. فالقوة مرهونة بقدرة أبناء المجتمع على مساءلة سائدهم، وفحص قناعاتهم العامة، وذلك ليس من أجل إشاعة الفوضى والهدم، وإنما من أجل طرد كل الأمراض التي قد تبرز في الفضاء الاجتماعي.
لهذا كله فإننا ندعو إلى عدم الخوف من النقد الاجتماعي، بل من الضروري أن نوفر الأطر البحثية التي تقدم لنا دراسات وأبحاث جادة عن واقعنا الاجتماعي. لمعرفة عناصر قوتنا وضعفنا، ومن ثم العمل على تأكيد عناصر القوة وطرد عناصر الضعف. فلا حيوية في المجتمع بلا نقد، ولا قدرة للمجتمع للتخلص من عيوبه بدون تشجيع الباحثين والمختصين على قراءة الواقع الاجتماعي ونقده.
والنقد الاجتماعي لا يؤسس للفوضى والانفلات أو تضخيم السلبيات، وإنما هو ضرورة من ضرورات تحقيق الأمن الاجتماعي.
وجماع القول: إننا بحاجة دائمة إلى ممارسة النقد والفحص، حتى يزداد وعينا الاجتماعي وتنضج قدراتنا المجتمعية، وتتمكن من طرد كل عناصر الضعف والاهتراء من فضائنا الاجتماعي. وعليه فإن الخوف من النقد يضر بالواقع الاجتماعي حقيقة. ولا سبيل أمامنا إذا أردنا الحيوية والفعالية الدائمة، إلا مواصلة الفحص الدائم والنقد المستمر لكل وقائعنا وحقائقنا الاجتماعية. النقد الذي لا يستهدف التقويض، بل التقويم وتصحيح الاعوجاج.


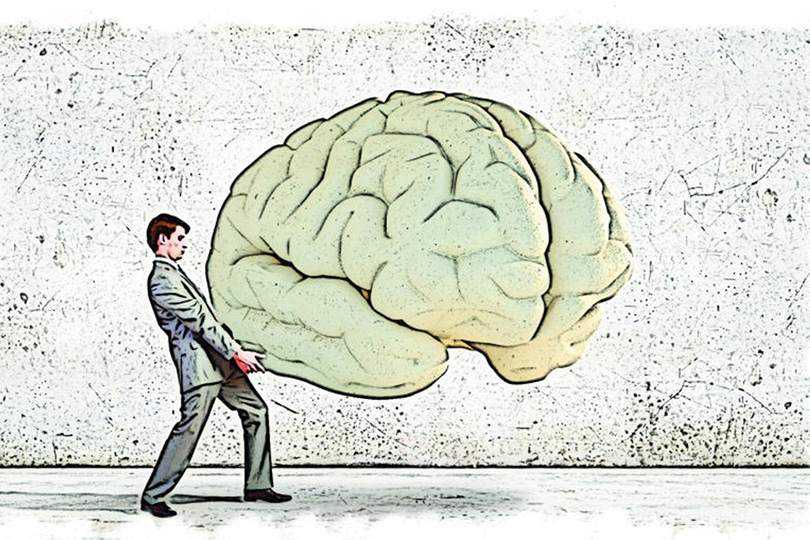

اضف تعليق