في مقابل الحرية التي ترفض الإساءة المعنوية والمادية لأي طرف من الأطراف، المقدس لا يشرع في سياق الدفاع والذود عنه ممارسة التطرف والتشدد والغلو أو هتك الحرمات والأملاك العامة والخاصة. لأن هذه الأشكال ليست دفاعا عن المقدس وثوابته، وإنما هي افتئات بحق المقدس.. لهذا فإننا في الوقت الذي...
مفتتح:
من البديهي القول: أن الحوار والتواصل بين المختلفين ليس حالة طارئة، أو تكتيكا سياسيا، وإنما هو من القواعد الثابتة التي يرسي دعائمها الدين الإسلامي للتعامل بين المختلفين والمغايرين.. فالمسلم لا يتحرك في دعوته في أجواء الإرهاب والقتل والتدمير، بل في أجواء الحوار والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن. وإن الذي يتطلع إلى إنجاز مشروعه الفكري والدعوي بالقتل والتفجيرات والاغتيالات، فإنه يناقض بذلك نصوص الشريعة الإسلامية، ويحارب قيمها ومبادئها، ويدفع الناس بوعي أو بدون وعي للانفضاض من حوله.. فالإسلام لا يدعو إلى ممارسة القسر والكراهية في الدعوة إليه، بل على العكس من ذلك تماما.. إذ يحدد مهمة وظيفة الرسل الأساسية في التذكير والموعظة إذ يقول تبارك تعالى (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).(1)
ويقول تعالى (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر)(2). ويقول عز من قائل (لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (3). فـ "القوة -مهما كانت درجتها- لن تنسجم مع طبيعة الرسالة الإسلامية، ما دامت القوة تعني محاصرة العقل وفرض الفكرة عليه تحت تأثير الألم أو الخوف، وحتى عندما يحني رأسه أمامها فإنه يتظاهر بالقبول ليخرج من الكابوس، ويبقى بينه وبين الاعتقاد مرتع غزال".
فالعنف ليس وسيلة من وسائل الدعوة، بل هو وسائل التنفير والتدمير. وأي طرف يتوسل بهذه الوسيلة، فإنه يهدد الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.. ولو تأملنا في سيرة الرسول الأكرم (ص)، سنجد أن الدعوة النبوية قامت على المحبة والأخلاق الفاضلة والتحلي بأجمل الصفات نفسا وسلوكا.
وقال رسول الله (ص) ((السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم.. قلنا يا رسول الله ومن هم؟
قال: الذين يقبلون الحق إذا سمعوه، ويبذلونه إذا سألوه، ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم هم السابقون إلى ظل العرش.. وقال (ص) الرفق رأس الحكمة، اللهم من ولي شيئا من أمور أمتي فرفق بهم فأرفق به، ومن شق عليهم فأشفق عليه)).(4)
الحوار وحماية المختلف:
فقتل الأبرياء ليس طريقا إلى سيادة الشريعة، وممارسة الإرهاب بكل صوره ليس سبيلا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل " لذلك فإن الكثير من الأعمال الإجرامية التي تحدث اليوم باسم الإسلام والجهاد، هي في ذاتها وتأثيراتها لا تخدم الإسلام والمسلمين، بل تدخلهم في الكثير من التحديات، وتهدد الكثير من المكاسب على المستويات كافة. فالعنف الديني والإرهاب الذي شاع في العديد من الدول والبلدان، بحاجة إلى مواجهة شاملة، حتى يتم إنهاء الجذور الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تقف خلف هذه الظاهرة الخطيرة وتغذيها باستمرار.
وفي إطار مواجهة آفـــة العنف والإرهاب، نحن بحاجة إلى التأكيد على النقاط التالية:
1. ضرورة الوقوف بحزم ضد كل أنواع التحريض التي تمارس ضد المختلف والمغاير. لأن استمرار حالات التحريض، هي التي تخلق البيئة الاجتماعية الحاضنة لممارسات العنف وأعمال الإرهاب. ولا يمكننا أن نواجه هذه الجرثومة، إلا بتجريم كل الممارسات والأقوال التحريضية، والتي تدق إسفينا بين مكونات المجتمع والوطن الواحد.. ولعلنا لا نجانب الصواب، حين القول: إن الكثير من الأعمال والتصرفات والتي يمكن وصفها بأنها من ممارسات وأشكال العنف الديني، هي بشكل أو بآخر من جراء ثقافة التحريض ومقولات التسفيه والتحقير التي تتوجه إلى فئة أو شريحة من المجتمع.. إن تجريم كل الممارسات الشائنة، والتي تستهدف تحقير بعض الناس سواء لقوميتهم أو مذهبهم أو دينهم، هو الخطوة الأولى في مشروع وأد وإنهاء الجذور الثقافية والاجتماعية لظاهرة العنف والإرهاب وبث الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
2. إن الاعتراف بالآخر في الدائرة الوطنية أو الإسلامية، لا يشرع إلى التحاجز وخلق الكانتونات والجزر الاجتماعية المنفصلة عن بعضها. وإنما من أجل دمج كل هذه التعبيرات والأطياف في بوتقة واحدة وهي بوتقة الوطن والمواطنة.. فنحن مع الاعتراف بكل الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل شريحة أو فئة، ولكن هذا الاعتراف لا يعني الانكفاء والانعزال أو القبول بحالة التشظي الاجتماعي. إنما الاعتراف الواعي والحضاري، والذي يقودنا إلى بناء مواطنة متساوية بين جميع الأطراف والتعبيرات. فالاعتراف بالخصوصيات، لا يلغي مفهوم المواطنة، بل يبنيها على أسس ومنظومة الحقوق والواجبات المتكافئة والمتساوية. فالرسول الأكرم (ص) في المدينة المنورة ومن خلال صحيفة المدينة، أسس إلى هوية جامعة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.
حيث تضمنت هذه الوثيقة تنسيق العلاقة بين المسلمين واليهود، وبعض من المشركين العرب. فــــقد كان الانتماء إلى دولة المدينة هو مقياس المواطنة، فالكل (بصرف النظر عن أديانهم) آمنون فيها، والكل مسئولون عن حمايتها. وبهذا خلق الرسول الأكرم (ص) في المدين المنورة تجربة قامت على مواطنة، متساوية، بين مجموعات بشرية متغايرة في أديانها ومعتقداتها.
من هنا نصل إلى حقيقة أساسية في مشروع مواجهة ظاهرة العنف والإرهاب. وهي إننا كلما تقدمنا خطوات نوعية في مشروع إنجاز المواطنة المتساوية، اقتربنا أكثر في إنهاء الجذور السياسية والفكرية لهذه الظاهرة الخطيرة. لذلك نجد أن المجتمعات التي تعيش وضعا مستقرا على هذا الصعيد، هي الأقدر على مقاومة هذه الظاهرة وضبطها.
فالمواطنون سواء بصرف النظر عن أيدلوجياتهم وقناعاتهم الفكرية والسياسية. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال لممارسة التمييز ضد بعض المواطنين لاعتبارات لا تنسجم وحقائق ومتطلبات المواطنة.. وينقل لنا التاريخ الإسلامي، الكثير من القصص، التي توضح أهمية المساواة وتكافؤ الفرص.
فالاختلاف العقدي لا يعني الحرب الاجتماعية، والتباين في القناعات والمواقف لا يعني ممارسة التهميش والإقصاء.. تبقى قاعدة (البر) هي الحاضنة لكل التنوعات والتعدديات.. إذ يقول تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين ٍ). (5) "ان النص ليس ظاهرا وحسب، بل هو بحر من الدلالات، وهو سيل من الأفكار والتصورات التي تكمن في باطنه، وتتوارى في أخاديد كلماته وحروفه والعلاقة بينهما. ونحن نعلم أن الكتاب الكريم حرم السب تحريما مطلقا، وحرم التجديف بحقوق وشرف الناس وسمعتهم، مهما كان دينهم، ومهما كانت لغتهم، والسب ظاهرة بارزة في حواء المتخلفين والطغاة والأميين، وهذا يضيف جمالاَ آخر إلى جمال الإسلام في معــالجة قضايا الخلاف".
فالمواطنة بمؤسساتها وقيمها وروحها، هي القادرة على دمج مختلف التنوعات في بوتقة واحدة بحيث تتحول التنوعات من مصدر قلق، إلى رافد من روافد الإثراء والتمكين.
فالتطرف وتبني خيار العنف، لا يخلق مواطنة متساوية، بل يفضي إلى تفكيك أسس الوحدة، ويدخل المجتمع في أتون الصراعات والنزاعات الحادة والدموية.. وإننا أحوج ما نكون اليوم، ومن أجل مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والعنف، إلى تلك الثقافة التي تولي للمواطنة حقوقا وواجبات أهمية خاصة، وتتعامل مع مختلف التعدديات بوصفها حقائق قائمة ينبغي احترامها، وتوفير كل مستلزمات مشاركتها في البناء الاجتماعي والوطني.
3- يسعى البعض وعبر وسائل مختلفة إلى التفتيش على عقائد وأفكار الآخرين. ويجعل من نفسه (فردا أو جماعة) المحاسب على الصحة والفساد. فهو الذي يوزع صكوك الغفران والمقبولية، وهو الذي يطلق أحكام الضلال والبعد عن الجادة والطريق المستقيم، أو أحكام الهدى والسير على الجادة. ولا يكتفي بذلك بل يعمل على محاسبة الناس على أفكارهم وانتماءاتهم العقدية والفكرية.
ولا شك أن هذه الممارسات، تعطي للبعض سلطة ليست له، وتجعله يمارس واجبا ليس مكلفا به. وذلك لأن الباري عز وجل هو المعني وحده جل جلاله بمحاسبة الناس على عقائدهم وأفكارهم. إذ يقول تعالى (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعلمون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون).(6) ووجود فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تخول للإنسان مهما علا شأنه أن يتدخل في خصوصيات الناس، ويفتش عن عقائدهم وأفكارهم. فإن للإنسان حرمة وقدسية، لا يجوز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال. ولعل من أهم جوانب هذه الحرمة، رفض محاولات التفتيش على العقائد والأفكار، والتدخـــل (إذا جاز التعبير) في مختصات الباري عز وجل.
فالعدل هو المطلوب في العلاقة الاجتماعية والإنسانية، أما مسائل الضمائر والقلوب والعقائد، فالباري عز وجل هو الذي يحكم فيها.. ولا يجوز لأي إنسان أن يفتش على عقائد الناس.
يقول تبارك وتعالى (وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، وإليه المصير).(7)
فالرسول الأكرم (ص) لم يجبر أحد على تغيير عقيدته، وعمل على صيانة حقوق الجميع.
وإذا كان هناك اختلاف وتباين بين المواطنين في عقائدهم وأفكارهم، فالمطلوب أن يحترم كل طرف عقائد وأفكار الطرف الآخر. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الإساءة لعقيدة أو أفكار أي مواطن. وعلى ضوء هذا الاحترام المتبادل، يتم حوار بين مختلفين، وليس حوارا بين صاحب الحق والهدى، وبين آخرين يعيشوا في ضلالهم وزيغهم. لذلك يقول تبارك وتعالى (قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين). (8) فالمساواة في الاختلاف من الضرورات العميقة التي تساهم في نجاح أي مشروع حواري وفي أي دائرة من الدوائر.
فالمطلوب هو أن نتحاور مع بعضنا البعض، على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. ولا توجد سلطة لأحد في تفتيش عقائد البشر واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء عملية التفتيش. كل المواطنين سواء، في ضرورة صيانة حرمتهم، واحترام عقائدهم وأفكارهم، والسماح لهم للتعبير عنها في ظل قانون يحمي الجميع ويصون خصوصياتهم.
فالغيرية في العقائد والأفكار، لا تنفي حقوق المواطنة، بل تؤكدها. وليس من شروط المواطنة المطابقة في الأفكار والقناعات.
ومن يبحث عن المطابقة، فإنه لن يجدها. فالمواطنة بقيمها وهياكلها ومؤسساتها، هي الإبداع الإنساني لحفظ الحقوق، وصيانة المكاسب، وإدارة التنوع بعقلية حضارية وإدارة حكيمة. ومبدأ الولاء والبراء، لا يعني ممارسة العدوان والحرب على الآخرين، وإنما وجود موقف نفسي يحول دون تأثير الآخر (المحارب والمعتدي) على أخلاقنا ونسيجنا الاجتماعي.
فـ "الأصل في العلاقات مع الآخر في القرآن هي التواصل الفكري، والاجتماعي، والعائلي، والأخلاقي بدليل جواز مؤاكلتهم، ومخالطتهم، ومشاربتهم، ومصاهرتهم، والتعامل معهم في كل مجالات النشاط الاجتماعي. وهذه المقتربات لا تنسجم مع (التولي والتبري) كما يعرضها البعض في قالب عدواني ابتدائي مسبق. فإن الموالاة المنهي عنها تأتي في نطاق إعلان الكره والحرب من قبل الطرف الآخر، أنها تبدأ من الطرف الآخر، هي جواب على موقف سلبي من الآخر يبدر منه أولا، وليس مع كل (مخالف)، كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، وإن المودة المنهي عنها في الكتاب الكريم هي مودة الذين ينصبون العداء السافر، ويعملون على التعريض بالمؤمنين، ومن ثم هي حالة قلبية أكثر مما تكون حالة عملية، بل هي موقف قلبي صرف عند كثير من الفقهاء". (9)
الاختلاف وضرورات العدالة:
على المستوى الواقعي ثمة مشكلة فكرية ـ سلوكية يتورط بها الكثيرون. ومفاد هذه المشكلة أن الاختلاف سواء كان فكريا أو اجتماعيا أو سياسيا، في غالب الأحيان يبرر ويسوغ لأحد طرفي الاختلاف والتباين أن يمارس التسقيط والاغتيال المعنوي للمختلف والتعدي على بعض حقوقه سواء كانت مادية أو معنوية.
وحين التأمل في هذا السلوك، نجده وفق المعايير الشرعية والأخلاقية، مما لا ينبغي الوقوع فيه. بمعنى لا توجد مسوغات شرعية تغطي أو تبرر لأحد طرفي الاختلاف التعدي على حقوق الطرف الآخر سواء كانت المادية أو المعنوية. وإن الاختلاف ليس مبررا كافيا للتعدي على حقوق المختلف.
ولكن على المستوى الواقعي ثمة وقائع عديدة تثبت أن الاختلاف سواء في دائرته الفكرية أو في دائرته السياسية يقود إلى انتهاك حقوق المختلف سواء كانت المادية أو المعنوية.
ولكي تتضح الرؤية لطبيعة العلاقة بين الاختلاف والعدالة نذكر النقاط التالية:
1ـ الاختلاف في كل دوائره ومستوياته، حالة طبيعية، لا يمكن أن تخلو أية ساحة اجتماعية منها. ولكن غير الطبيعي في هذا السياق، هو أن يدفعك هذا الاختلاف بأي مستوى من مستوياته، إلى التعدي المادي أو المعنوي على حقوق من اختلف معك..
ومعالجة هذا المسألة لا يمكن أن تكون بإفناء عناصر الاختلاف، لأنه من لوازم الحياة الاجتماعية، بمعنى حيث تكون هناك حياة اجتماعية، ستكون هناك اختلافات وتباينات في وجهات النظر، وإن هذه الاختلافات ستقود من يتخلى عن أخلاقه أو معاييره الشرعية إلى التعدي على حقوق من يختلف معه.
ولو تأملنا في طبيعة الإساءات التي تصدر في مجتمعنا فيما يتعلق وظاهرة الاختلاف، نجد حين التأمل العميق أن أحد أطراف الاختلاف يدفعه الاختلاف حقيقة أو إدعاء إلى تبني مواقف عدائية من الطرف الآخر المختلف معه.
وهذا يعني أن الاختلاف الفكري أو السياسي، يفضي على المستوى الواقعي إلى انتهاك الحقوق المادية أو المعنوية.
2ـ مع أن الاختلاف بمختلف دوائره ومستوياته، حالة طبيعية في حياة الإنسان فردا وجماعة، إلا أننا جميعا مقصرون في فقه الاختلاف. وهذا التقصير يساعد على أن يقودك الاختلاف إلى انتهاك حقوق من تختلف معه. لهذا فإن من الأمور المطلوبة في حياتنا الإنسانية والاجتماعية هو فقه الاختلاف بشكل جوهري وحقيقي.
لأننا نعتقد أن فقه الاختلاف سيقود إلى فك الارتباط بين الاختلاف بمختلف دوائره ومستوياته وانتهاك حقوق المختلف. بحيث يتم التعامل مع الاختلاف في سياق حدوده الطبيعية التي لا تتعداه إلى أي شيء آخر.
والمجتمع الذي يتمكن من فك الارتباط والاشتباك، هو المجتمع القادر على إدارة اختلافاته بشكل صحيح وإيجابي.
وأغلب المجتمعات التي تعاني من أزمات ومآزق في علائقها الاجتماعية سواء كانوا أفرادا أو مكونات، يعود في أحد جوانبه إلى هذه العلاقة الشائكة بين الاختلاف وانتهاك الحقوق. فمن يختلف معك ليس ساحة مكشوفة لانتهاك حقوقه أو التعدي على حقوقه.
الفصل بين الاختلاف والتعدي على الحقوق، هو الحل الأمثل لكل الأطراف.
والديمقراطية في التجربة الحضارية الغربية، هي في أحد جوانبها، محاولة مؤسسية لضبط الاختلاف وعدم استخدامه كمبرر أو مسوغ للتعدي على الحقوق.
والمجتمعات الغربية قبل لحظة التطور الحضاري، كانت تعاني من هذه الإشكالية، التي ساهمت في إدخال المجتمعات الغربية في حروب دينية وغير دينية مع بعضها البعض. وبداية اللحظة التي تمكنت فيها المجتمعات الغربية من الانتصار على واقعها المرير، هي تلك اللحظة التي فكت الارتباط فيها بين الاختلاف بمختلف دوائره ومستوياته، وأشكال انتهاك الحقوق. والديمقراطية في أبعادها الاجتماعية السياسية، هي التي جنبت المجتمعات الغربية الدخول في معارك دائمة على خلفية الاختلاف الفكري والسياسي.
ونحن في الدائرتين العربية والإسلامية، ومن أجل التخلص من الكثير من الأزمات والمآزق الداخلية، أحوج ما نكون لبناء العلاقة بين الاختلاف والعدالة. بحيث لا يتحول الاختلاف إلى مبرر للتعدي على الحقوق أو عدم الالتزام بمقتضيات العدالة.
3ـ العدالة الاجتماعية والسياسية تتجاوز في جوهرها، البعد الأخلاقي والوعظي. بمعنى أن المطلوب من الجميع سواء كنا نعيش لحظة اختلاف أو لحظة صراع، المطلوب هو الالتزام بكل مقتضيات العدالة. وإن أحد الأسباب المباشرة لتجاوز حدود ومعايير العدالة، هو حينما تبرز ظاهرة الاختلاف بين البشر سواء بعنوان سياسي أو تحت يافطة فكرية بحيث يقود الاختلاف الفكري والسياسي إلى تجاوز حدود العدالة وممارسة العدوان المعنوي أو المادي مع من يختلف معنا سواء كان فردا أو جماعة.
لذلك ثمة ضرورة قصوى لسيطرة قيم العدالة على كل أطراف الاختلاف. بحث لا يتحول هذا الاختلاف إلى مبرر إلى انتهاك الحقوق أو التعدي على مقتضيات العدالة.
فمن حقنا جميعا أن نختلف مع بعضنا البعض، ولكن ليس من حق أحد أن ينتهك حقوق من يختلف معه.
فالإنسان بطبعه نزاع إلى جعل الآخرين مثله في القناعات والسلوك، ولكن دون هذا خرط القتاد. وحينما لا ينضبط الإنسان بضوابط العدالة فإن هذه النزعة التي تتحكم في حياة الإنسان ومسيرته المتنوعة، هي التي تبرر له تدفيعه ثمن الاختلاف معي أو التباين مع وجهات نظري.
وعلى كل حال ما نود أن نقوله في هذا السياق: ان فك الارتباط والاشتباك بين الاختلاف والتعدي على حقوق المختلف المعنوية والمادية، هو أحد المداخل الأساسية لمعالجة الأزمات والمآزق التي تعاني منها مجتمعاتنا.
وإنه ليس ثمة مسوغات شرعية أو أخلاقية، للتعدي على حقوق المختلف. وإن المطلوب دائما صيانة حقوق المختلف. فمن حق الجميع أن يختلف مع الجميع، ومن حق الجميع أن يصون حقوقه ويمنع التعدي عليها، وإن التباين في الأفكار والآراء والمواقف، لا يسوغ لأي طرف التعدي على حقوق الطرف الآخر سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية.
وفي زمن التعصب المذهبي نحن أحوج ما نكون إلى ضرورة إبراز هذه القيم التي تمنع التعدي على حقوق المختلف معه. وإن الاختلاف المذهبي لا يشرع لأي طرف التعدي على حقوق الطرف الآخر.
بهذا نصون مجتمعاتنا من الكثير من المخاطر التي تهدد استقرار المجتمعات ووحدتها الداخلية.
الاستقرار والعدالة:
ثمة علاقة عميقة، وعلى أكثر من مستوى، تربط قيمة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي تجربة إنسانية، وقيمة العدالة.. بمعنى أن كل المجتمعات الإنسانية، تنشد الاستقرار، وتعمل إليه، وتطمح إلى حقائقه في واقعها، إلا أن هذه المجتمعات الإنسانية، تتباين وتختلف في الطرق التي تسلكها، والسبل التي تنتهجها للوصول إلى حقيقة الاستقرار السياسي والاجتماعية..
فالمجتمعات الإنسانية المتقدمة حضاريا، تعتمد في بناء استقرارها الداخلي السياسي الاجتماعي على وسائل الرضا والمشاركة والديمقراطية والعلاقة الايجابية والمفتوحة بين مؤسسات الدولة والسلطة والمجتمع بكل مؤسساته المدنية والأهلية وشرائحه الاجتماعية وفئاته الشعبية.. لذلك يكون الاستقرار، هو بمثابة النتاج الطبيعي لعملية الانسجام والتناغم بين خيارات الدولة وخيارات المجتمع..
بحيث يصبح الجميع في مركب واحد، ويعمل وفق أجندة مشتركة لصالح أهداف وغايات واحدة ومشتركة..
لذلك غالبا ما تغيب القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية في هذه الدول والتجارب الإنسانية.. وإن وجدت اضطرابات اجتماعية أو مشاكل سياسية وأمنية، فإن حيوية نظامها السياسي ومرونة إجراءاتها الأمنية وفعالية مؤسساتها وأطرها المدنية، هي العناصر القادرة على إيجاد معالجات حقيقية وواعية للأسباب الموجبة لتلك الاضطرابات أو المشاكل..
وإذا تحقق الاستقرار العميق والمبني على أسس صلبة في أي تجربة إنسانية، فإنه يوفر الأرضية المناسبة، لانطلاق هذا المجتمع أو تلك التجربة في مشروع البناء والعمران والتقدم.
فالتقدم لا يحصل في مجتمعات، تعيش الفوضى والاضطرابات المتنقلة، وإنما يحصل في المجتمعات المستقرة، والتي لا تعاني من مشكلات بنيوية فيه طبيعة خياراتها، أو شكل العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع والعكس..
فالمقدمة الضرورية لعمليات التقدم الاقتصادي والعلمي والصناعي، هي الاستقرار السياسي والاجتماعي.. وكل التجارب الإنسانية، تثبت هذه الحقيقة.. ومن يبحث عن التقدم بعيدا عن مقدمته الحقيقية والضرورية، فإنه لن يحصل إلا على المزيد من المشاكل والمآزق، التي تعقد العلاقة بين الدولة والمجتمع وتربكها وتدخلها في دهاليز اللاتفاهم واللاثقة..
وفي مقابل هذه المجتمعات الحضارية – المتقدمة، التي تحصل على استقرارها السياسي والاجتماعي، من خلال وسائل المشاركة والديمقراطية والتوسيع الدائم للقاعدة الاجتماعية للسلطة..
هناك مجتمعات إنسانية، تتبنى وسائل قسرية وتنتهج سبل قهرية للحصول على استقرارها السياسي والاجتماعي.
فالقوة المادية الغاشمة، هي وسيلة العديد من الأمم والشعوب، لنيل استقرارها، ومنع أي اضطراب أو فوضى اجتماعية وسياسية.. وهي وسيلة على المستوى الحضاري والتاريخي، تثبت عدم جدوائيتها وعدم قدرتها على إنجاز مفهوم الاستقرار السياسي والاجتماعي بمتطلباته الحقيقية وعناصره الجوهرية..
لأن استخدام وسائل القهر والعنف، يفضي اجتماعيا وسياسيا، إلى تأسيس عميق لكل الأسباب المفضية إلى التباعد بين الدولة والمجتمع وإلى بناء الاستقرار السياسي على أسس هشة وضعيفة، سرعان ما تزول عند أية محنة اجتماعية أو سياسية..
وتجارب الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا والعراق، كلها تثبت بشكل لا مجال فيه للشك، أن العنف لا يبني استقرارا، وإن القوة الغاشمة لا توفر الأرضية المناسبة لبناء منجزات حضارية وتقدمية لدى أي شعب أو أمة..
فلا استقرار بلا عدالة، ومن يبحث عن الاستقرار بعيدا عن قيمة العدالة ومتطلباتها الأخلاقية والمؤسسية، فإنه لن يحصد إلا المزيد من الضعف والهوان..
فتجارب الأمم والشعوب جميعها، يثبت أن العلاقة بين الاستقرار والعدالة، هي علاقة عميقة وحيوية.. بحيث أن الاستقرار العميق هو الوليد الشرعي للعدالة بكل مستوياتها.. وحين يتأسس الاستقرار السياسي والاجتماعي، على أسس صلبة وعميقة، تتوفر الإمكانية اللازمة لمواجهة أي تحد داخلي أو خطر خارجي..
فالتحديات الداخلية لا يمكن مواجهتها على نحو فعال، بدون انسجام عميق بين الدولة والمجتمع.. كما أن المخاطر الخارجية، لا يمكن إفشالها بدون التناغم العميق بين خيارات الدولة والمجتمع.. وكل هذا لن يتأتى بدون بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي على أسس العدالة الأخلاقية والمؤسسية..
وإن الإنسان أو المجتمع، حينما يشعر بالرضا عن أحواله وأوضاعه، فإنه يدافع عنها بكل ما يملك، ويضحي في سبيل ذلك حتى بنفسه.. وأي مجتمع يصل إلى هذه الحالة، فإن أكبر قوة مادية، لن تتمكن من النيل منه أو هزيمته..
فالاستقرار السياسي والاجتماعي المبني على العدالة، هو الذي يصنع القوة الحقيقية لدى أي شعب أو مجتمع..
لهذا فإن المجتمعات التي تعيش الاستقرار وفق هذه الرؤية والنمط، هي مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية..
ونحن كمجتمعات عربية وإسلامية اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة، التي تواجهنا على أكثر من صعيد ومستوى، بحاجة إلى هذه النوعية من الاستقرار، حتى نتمكن من مجابهة تحدياتنا، والتغلب على مشاكلنا والتخلص من كل الثغرات الداخلية التي لا تنسجم ومقتضيات الاستقرار العميق..
المقدس والحرية:
بين الفينة والأخرى تثار في فضائنا العربي والإسلامي، مجموعة من القضايا والممارسات، التي تستفز الناس وتقسمهم إلى قسمين: الأول مع هذه القضايا باسم الحرية، والقسم الآخر ضد هذه القضية باسم الدفاع والذود عن المقدس والثوابت.. ولعل آخر هذه القضايا المثارة، والتي أخذت أبعادا اجتماعية وسياسية وحقوقية عديدة في تونس هو بث أحد التلفزيونات الخاصة فيلم كرتوني باسم (برسي بوليس) يتعرض إلى الذات الإلهية.. مما أجج النفوس، وأنزل الآلاف إلى الشوارع منديين بالتلفزيون وأصحابه الذين سمحوا ببث فيلم مهين إلى المقدسات والثوابت الإسلامية.. وفي مقابل هذا الموقف عبر العديد من الشخصيات والمؤسسات الفكرية والمدنية والحقوقية عن رفضها لعملية استخدام الشارع، وأبدت وقوفها وتضامنها مع التلفزيون الذي مارس حريته.. وإن رفض هؤلاء إلى ممارسات الشارع، هي تعبيرهم المباشر عن حقهم في الحرية وممارساتها..
ويبدو من هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة، أن هذه المسألة تعود إلى طبيعة العلاقة المتصورة بين المقدس والحرية.. فهناك أطرافا تتصور أن الحرية بكل آفاقها وأشكال ممارساتها الخاصة والعامة، هي القيمة الكبرى التي ينبغي الدفاع عنها، ورفض أي شكل من أشكال تقييدها أو تحييدها..
لهذا فإن هذه الأطراف تقف موقفا إيجابيا ومؤيدا لكل فرد أو جهة مارست حريتها وعبرت عن قناعتها بحرية تامة.. وفي مقابل هذه الأطراف، هناك أطرافا أخرى ترى أن الحرية هي قيمة من مجموعة قيم ومثل عليا، ولا يمكن على الصعيد العملي من التعامل مع هذه القيمة بمعزل عن المنظومة القيمية الكاملة، التي تحدد بعض الحدود والضوابط على مستوى الممارسة..
وإن هذه الحدود والضوابط ليست تقييدا لقيمة الحرية، وإنما في هذا الموضوع أو القضية الأولوية لقيمة أخرى مختلفة عن قيمة الحرية.. وهكذا تتباين وجهات النظر، وستبقى العلاقة بين المقدس والحرية علاقة شائكة وقلقة، وتتطلب المزيد من أعمال العقل والفكر لبناء تصور متكامل لطبيعة العلاقة بين المقدس والحرية..
وفي سياق بلورة الرأي أو خلق مقاربة نظرية جديدة للعلاقة بينهما نود إبراز النقاط التالية:
1- مع الحرية وضد الإساءة:
الحرية الحقيقية للإنسان تبدأ حينما يثق الإنسان بذاته وعقله وقدراتهما، وذلك لأن التطلع إلى الحرية بدون الثقة بالذات والعقل، تحول هذا التطلع إلى سراب واستلاب وتقليد الآخرين بدون هدى وبصيرة.. لذلك فما لم يكتشف الإنسان ذاته ويفجر طاقاته المكنونة، لن يستطيع من اجتراح تجربته في الحرية وبناء واقعه العام على قاعدة الديمقراطية والشراكة بكل مستوياتها.. وكما يقول الدكتور (علي حرب) أن الحرية ليست هواما ليبراليا كما يتخيلها السذج من الحداثيين الحالمين بفراديس أرضية أو بديمقراطيات مثالية.. هذه أكبر عملية خداع مارسها وما يزال المثقفون العرب والغربيون فيما يخص تحديث المجتمعات العربي وتطورها.. ذلك إن الذي يمارس حريته هو الذي يجترح قدرته ويمارس سلطته وفاعليته، بما ينتجه من الحقائق أو يخلقه من الوقائع في حقل عمله أو في بيئته وعالمه..
ومن لا سلطة له لا حرية له.. ولذا فالحرية عمل نقدي متواصل على الذات، يتغير به المرء عما هو عليه، بالكد والجهد، أو المراس والخبرة، أو السبق والتجاوز أو الصرف والتحول، مما يجعل إرادة الحرية مشروعا هو دوما قيد التحقق بقدر ما يشكل صيرورة متواصلة من البناء وإعادة البناء..
من هنا ووفق هذا المنظور مع الحرية كقيمة مركزية في منظومتنا القيمية والفكرية، وضد الإساءة التي قد تمارس باسم الحرية وهي ليست من الحرية في شيء من الحرية أن تمارس قناعتك في أي موضوع، ولكن ليس من الحرية أن تسيء إلى الآخرين ومقدساتهم..
وعليه فإن فك الارتباط بين ممارسة الحرية والتصرف بإساءة إلى ثوابت الآخرين ومقدساتهم تتجلى العلاقة على نحو إيجابي بين المقدس والحرية.. بمعنى أن المقدس لا يقيد حرية الإنسان، لأن هذه الحرية من لوازم إنسانية الإنسان، ولكنه (أي المقدس) يرفض الإساءة المعنوية والمادية لأي إنسان آخر أو منظومة عقدية أخرى..
لهذا فإن فك الارتباط بين الالتزام بقيمة الحرية وأشكال الإساءات التي تمارس يساهم في تعميق مفهوم الحرية في الواقع الاجتماعي، ويزيل العديد من الهواجس والالتباسات التي يعيشها بعض الناس تجاه قيمة الحرية..
فالحرية ليست تفلتا من الأخلاق، وليس تشريعا للإساءة، وليست وسيلة لهدم الثوابت والمقدسات، وإنما هي ممارسة عقلية ونقدية، تستهدف تظهير الحقائق باستمرار ومنع قمع السؤال مهما كان موضوعه وإبراز مستديم لإنسانية الإنسان التي لا يمكن أن تتجلى بدون الحرية قولا وفعلا..
2- المقدس لا يشرع للتطرف وهتك الحرمات:
وفي مقابل الحرية التي ترفض الإساءة المعنوية والمادية لأي طرف من الأطراف، المقدس لا يشرع في سياق الدفاع والذود عنه ممارسة التطرف والتشدد والغلو أو هتك الحرمات والأملاك العامة والخاصة.. لأن كل هذه الأشكال ليست دفاعا عن المقدس وثوابته، وإنما هي افتئات بحق المقدس..
لهذا فإننا في الوقت الذي نمارس النقد تجاه أولئك النفر الذي يمارس الإساءة المعنوية والمادية بحق الآخرين باسم الحرية، في ذات الوقت نرفض ممارسة التطرف وقتل الأبرياء وهتك الحرمات والأضرار بالأملاك الخاصة والعامة باسم الدفاع عن المقدس وثوابت الأمة.. فإذا كان التلفزيون المغاربي، ارتكب خطئا في عرض الفيلم الكرتوني المسيء للذات الإلهية، فإن الرافضين لهذا العرض، ارتكبوا بدورهم خطئا شنيعا تجسد في ممارسة التطرف وقذف الناس بدون وجه حق وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة..
فالمقدس لا يتم الدفاع عنه، بوسائل وآليات يرفضها ولا تنسجم ونظام قيمه التشريعي والأخلاقي.. فالمقدس لا يتم الدفاع عنه بهدم قيم الحرية وهتك الكرامة الإنسانية، وإنما يتم الدفاع عنه، بالالتزام بهذه القيم ومقتضياتها المتنوعة.. كما أن الحرية كقيمة وممارسة، لا يتم الدفاع عنها، عبر ارتكاب الموبقات والمحرمات، ومصادمة الناس في مقدساتهم، وإنما من حقك الأصيل أن تعبر عن قناعاتك وأفكارك، دون أن تتعدى على حقوق الآخرين المعنوية والمادية.. فكما أن من حقك أن تؤمن بفكرة وتعبر عنها، من حق الآخرين أيضا الإيمان بفكرة والتعبير عنها.. وإيمانك بفكرة، لا يجعلك أنت الوحيد القابض على الحق والحقيقة، كما أن إيمان الآخرين بذلك، لا يحولهم وحدهم هم القابضون على الحقيقة..
فنحن مع الحرية وهي حق مصان للجميع، وهذا الحق لا يعني بأي حال من الأحوال، أنه يشرع لأحد حق الافتئات على مقدسات الناس وكراماتهم..
فالحرية هي بوابة الدفاع عن المقدس وثوابت الأمة.. والمقدس ليس نقيضا للحرية، بل هو أحد المدافعين عنها، والمانحين لها مضامين إنسانية وحضارية..
فالتعصب لا يحمي المقدسات، بل يشوهها، ويخيف الناس منها.. كما أن العنف لا يوقف الإساءات التي قد تمارس تجاه مقدسات الأمة وثوابتها..
لهذا فإننا نعتقد أن الإساءات المعنوية والمادية تبعد العلاقة على المستوى الإنساني بين الحرية والمقدس، كما أن التعصب والتطرف وانتهاك الكرامات والحرمات، يعمق الفجوة بين المقدس والحرية..
والصورة المثلى التي تنشدها المجتمعات العربية والإسلامية، هي أن تعيش حريتها كاملة على قاعدة احترام مقدساتها..
حدود المقدس:
كل أمة من أمم الأرض لها مقدساتها، التي تبجلها وتعلي من شأنها وتحول عبر وسائل متعددة لمنع أي إنتهاك لها..وهذه المقولة لا تختص بأمة دون أخرى أو بمجتمع دون آخر، وإنما هي مقولة تنطبق في خطها وسياقها العام مع كل الأمم والمجتمعات.. ولا يوجد على وجه البسيطة مجتمعا أو أمة بلا مقدس.. فكل الأمم لها مقدسات، وكل المجتمعات ترتب لنفسها أساليب وآليات وأعراف لتبجيل هذه المقدسات، ومنع انتهاكها أو التعدي المعنوي أو المادي عليها..
ولكن على الصعيد الواقعي، ولاعتبارات ذاتية وموضوعية، تاريخية ومعاصرة، كل الأمم والمجتمعات ولدواعي آنية أو دائمة، توسع من دائرة المقدس، وتعتبر كل قناعاتها هي من المقدسات التي ينبغي أن لا تنقد أو يوجه إليها السؤال أو علامات الاستفهام. ولعلنا لا نبالغ حين القول: إن الكثير من المشاكل والأزمات وعناصر التوتر في العلاقة بين الأمم والثقافات والحضارات، هو من جراء توسيع دائرة المقدس إما لدواعي دفاعية أو لاعتبارات فكرية-عقدية موغلة في الانغلاق والتعصب.. مما يدفع الأمور باتجاه رفض أي سؤال، والوقوف بحزم وانفعال ضد أي نقد يمارس تجاه ثقافة هذا المجتمع أو قناعات هذه الأمة..
ولكون هذا الموضوع حساسا على أكثر من صعيد، نود أن نبلور وجهه نظرنا حوله من خلال النقاط التالية:
1) نحن وانطلاقا من عقيدتنا الإسلامية وأخلاقنا الإيمانية، مع احترام مقدسات كل البشر. وهذا الاحترام بطبيعة الحال، لايعني القبول بهذه المقدسات أو تصويبها دينيا أو ثقافيا. وإنما من باب أنك لا تستطيع كأمة أن تنسج علاقات إيجابية وصحية مع بقية الأمم من دون احترام مقدساتها.
لذلك فإننا من دعاة سن القوانين الدولية، الداعمة إلى احترام مقدسات كل الأمم و المجتمعات، ورفض الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى مقدسات أمم الأرض كافة. فنحن مع إقرار كل المبادئ والقوانين في العلاقات الدولية، التي تلزم الجميع ومن مواقعهم العقدية والحضارية والجغرافية المتعددة إلى صيانة كل المقدسات، ورفض كل أشكال هتكها أو التعدي عليها..
2) من الضروري لكل أمم ومجتمعات الأرض، أن تحدد بدقة مفهوم المقدس وحدوده. لأننا في الوقت الذي ندعو إلى احترام مقدسات كل الأمم والمجتمعات، في ذات الوقت نرفض عمليات التوسع والانتشار لمفهوم المقدس..
بمعنى ووفق هذه الرؤية أن مقدسات كل الأمم، ليست كثيرة، لأنها هي العناصر الوحيدة المتعالية على الفهم والنقد في آن.. بمعنى أن عناصر المقدس في بعض جوانبها، يسلم بها الإنسان إيمانا وعقيدة، حتى لو لم يتمكن من فهمها وإدراك كنهها الأولي. لهذا فإننا نرى أن كل توسعة لمفهوم المقدس، هو يضر على الصعيد الجوهري بالمقدس الحقيقي نفسه. فكل محاولات التوسعة لمفهوم المقدس التي تقوم بها كل الأمم والمجتمعات لاعتبارات دفاعية، بمعنى خلق خطوط دفاعية عديدة، تحمي المقدس الحقيقي، وتحول دون نقده وانتهاكه..
أقول أن كل هذه العمليات، أضرت بالمقدس الحقيقي نفسه، وجرأت الناس أو نخبهم في أقل التقادير على مساءلة المقدس وإعادة خلق الفواصل والمعاير الحقيقية بين المقدس وغير المقدس في الدائرة العقدية أو الثقافية..
وهذا بطبيعة الحال، ينبغي أن لا يحول دون تشجيع عمليات البحث العلمي، التي تستهدف الاكتشاف والوصول إلى الحقيقة أو الحقائق.. فليس كل نقد ديني أو حضاري أو ثقافي، هو افتئات على المقدسات أو انتهاك لها. لذلك من الضروري في الوقت الذي ندعو إلى تحديد وبدقة عقدية وعلمية معنى المقدس وحدوده بالنسبة إلى جميع القصائد والثقافات، في ذات الوقت ينبغي أن لا نحجب أنفسنا أو نغلق عقولنا تجاه محاولات البحث والنقد العلمي.فحماية المقدسات لا تشرع لأحد ممارسة الاتهام والظن والظلم للآخرين..
وقد قال تعالى (ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )(10)
(وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)(11)..
ونحن هنا وفي ظل حروب الهوية والثقافة، نود أن تعتني كل المجتمعات ببيان مقدساتها بدون زيادة، حتى يتمكن الجميع من بلورة وصياغة رؤية أو ميثاق متكامل على صعد الأوطان والأمم والحضارات، تصون مقدسات الجميع، وتحرم كل عمليات الإساءة والانتهاك.. ووجود تباينات عقدية بين المجتمعات والأمم، لا يشرع لأحد انتهاك المقدسات أو الافتئات عليها. وقد قال الباري عز وجل (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون)(12)
وقد جاء في تفسير هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينهي المسلمين عن المبادرة إلى سب الذين يدعون من دون الله بغير علم، أو سب آلهتهم في عملية المواجهة، لأن ذلك لن يحقق أية نتيجة إيجابية لمصلحة الإيمان، لأنه لن يستطيع إقناع شخص واحد بهذا الأسلوب، بل ربما أدى إلى تعقيد الأمور بطريقة أكبر، وإقامة الحواجز النفسية ضد الإيمان والمؤمنين.
وعليه فإن المطلوب، ليس الإيمان والاعتقاد بمقدسات الآخرين، وإنما احترام مقدساتهم، بحيث يستطيع الجميع من بناء حياة إنسانية أكثر عدالة وإيمانا..
وعبر التاريخ تعددت أفهام البشر للدين، وتنوعت وسائل تعبيرهم عن هذه الأفهام.. إلا أن الأثر الدائم لهذه التعددية في الفهم البشري للدين، هو في حدود وحجم المقدس. بمعنى أن كل فهم بشري واجتهادي للدين، مهما كانت عناوينه ويافطاته، ستنعكس على طبيعة تجلي المقدس وحجمه وحدوده. فالأفهام البشرية التقليدية (الكلاسيكية) للدين، تدفع دائما نحو توسيع المقدس، وإدخال مفاهيم وعناصر جديدة إلى دائرة المقدس. إيمانا تاما من هذه الأفهام، إلى أن الوسيلة الفضلى للدفاع وحماية المقدس الثابت، هو في إضافة مقدسات وثوابت أخرى، تكون مهمتها الأساسية هي الدفاع عن المقدس الثابت والجوهري الأصلي.
كما أن الأفهام التجديدية للدين، تدفع باتجاه تحديد المقدس، ومنع إضافة مقدسات أو ثوابت أخرى إلى دائرة المقدسات والثوابت الأساسية والجوهرية.. بل إن الفعل التجديدي في الكثير من التجارب الدينية التاريخية والمعاصرة، يتجه صوب عدم توسعة المقدس وعدم تحويل المتغيرات إلى ثوابت، وإدخال ما ليس مقدسا في دائرة المقدس الذي لا يمكن مسه أو التعرض إليه.
لهذا تتجه الكثير من الجهود النظرية والمنهجية، لصياغة رؤية أو منهج موحد لفهم الدين أو محاولة إيجاد نسق توحيدي لمناهج المعرفة الدينية. وتثير هذه المحاولات الكثير من التساؤلات والاستفهامات، حول جدواها ومغزاها والنتائج المفضية إليها مباشرة وغير مباشرة.
ويشير إلى هذه المسألة الدكتور (خنجر حمية) بقوله: وما الذي يحققه توحيد المناهج المختلفة المتنوعة في فهم الدين من غايات ويقود إليه من نتائج ويتوفر عليه من حسنات وإيجابيات، على تقدير واقعية هذا التوحيد وإمكانه؟ أهو يحقق فعلا وحدة فهم الدين، أو أنه يقرب النتائج التي ينتمي إليها كل انشغال بالدين أو تدبر له بعضها إلى البعض الآخر ويجعلها أكثر انسجاما وتآلفا؟ أو أنه يحقق وحدة الأنساق النظرية التي يتشكل منها الدين في صورته العقلية، فيصبح الدين حينئذ جملة تعاليم نسقية وطقوسا شكلية وشعائر جامدة ساكنة لا حياة فيها ولا روح؟ ثم ما الذي يحركنا إلى السعي وراء هدف من هذا القبيل وما نفع ذلك وما جدواه؟ ولم يغرينا دائما وتحرضنا فكرة نشدان الواحد والوحدة والتوحد وما شاكلها في تركيبها ورادفها في دلالتها ومعناه؟ا ولم ننفر دائما وأبدا من الكثرة والتعدد، ونرفض فكرة التغاير والتمايز وننفر منها، وننبذ واقع التنوع والاختلاف ونحتقره؟ ألا يقود مثل هذا النزوع أو تلك الرغبة إلى الجمود والتحجر وإلى القضاء على روح الخلق والابتكار وقتل ملكة الإنتاج والإبداع؟ ثم ألا يؤدي في الدين، كل دين، إلى حجب الآفاق الرحبة الغنية والخصبة التي ينطوي عليها والتي تنبسط أمام العقل المتبصر فتنيره وتستنير به وتنفتح أمام خلاقية الوعي المتأمل فتثريه وتغتني به.
وعليه فإننا نعتقد وبشكل جازم، إلى أننا لن نتمكن من التعرف على دقائق الدين وبركاته ونفحاته، بدون منهجية واضحة وبصيرة متكاملة، تؤهلنا للإطلالة مع كل قيم الدين ومبادئه الأساسية، وتوفر لنا العدة الاستنباطية، لاكتشاف واستنباط أحكام الإسلام وأنظمته المتعددة. وهذا المنهج هو روح كل تفكير وحياة كل تدبر وتأمل، وهو يولد معه ويلتصق به، أي أنه وليد تجربة التفكير والتأمل لا ينفك عنها ولا يفارقها، وهو يشبهها ويغنيها ويغتني بها، ينوعها ويتنوع في أثرها، ويتبدى على صورتها وفي شكلها. إن منهج فهم الدين منهج متدفق تدفق الدين نفسه، حي ومتحرك، متحرر ومنفتح، وهو يغتني كلما انفتح أمام الوعي مجال من مجالات الدين وأفق من آفاقه، أو تبدى رمز من رموزه، أو تجسدت إشارة من إشاراته، أو تحققت دلالة من دلالاته في التجربة الروحية الوجودية أو في تجربة الوعي والفهم.
وإن الذي يشكل روح الدين (على حد تعبير الكاتب خنجر حمية) وأساس خلاقيته وجاذبيته وعصب الحياة فيه ومادة الخصوبة والغنى والتوهج هو ذلك الانفتاح الهائل للدين على آفاق متنوعة وخصبة، وجودية أو نفسية، وانطواؤه على قابليات استيعاب واستثمار لا تستنفد، بعضها يحرك الخيال وآخر يجيش العاطفة والوجدان والمشاعر وثالث يثير الوهم ويستدعيه ورابع يدفع إلى التعقل والتفكير وخامس إلى التدبر والتبصر، فكيف يتسنى لنا اختصار ذلك واختزاله؟ وكيف يمكن أن يلامس هذا الأفق من الأبعاد والدلالات عبر وحدة فهم سياقية ومنطق ثابت لا يتغير وتقنيات تأمل وتفكير جامدة وسكونية؟ إن ذلك -في ما أزعم- يقتل في الدين ما يشكل جوهره الحي المتدفق، وقابلياته الغنية الثرية التي لا تحد وآفاقه الرحبة الشاسعة الكثيفة والمتوترة.
والذكر الحكيم يحدثنا في الكثير من المواضع، عن تجليات المقدس في حياة الإنسان. إذ يسجل القرآن الحكيم ما جرى للنبي موسى عليه السلام، وكيف تم انكشاف الحقيقة له. قال تعالى (وهل أتاك حديث موسى، إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) (13).
وقال تعالى (وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين) (14).
و "إن تجلي المقدس أو ظهور علامة في مكان أو استدعاءها وتطلبها إنما يتم، كما هو واضح، لوضع حد للتوتر الذي تثيره النسبية، وللقلق الذي يغذيه عدم التوجه، وبإيجاز نقطة استناد مطلقة ومركز.
إن رغبة الإنسان المتدين في العيش في القداسة، لا تجعله وحدها قادرا على تكريس مكان بمفرده، إن ذلك يدفعه إلى تلمس ظهورات المقدس وتجلياته أو تبصر آياته وعلاماته أو استدعاء حضوره طقوسيا، وهو بذلك إنما يحاول اكتشاف الحقيقي والواقعي ليقيم ضمنهما، وينعم في ظلالهما بالشعور بالقوة والقصد، ولينفتح من خلالهما على السماء، أعني حيث يكون انقطاع المستوى بين المكان المقدس وغيره من الأمكنة أمرا متحققا رمزيا، وحيث يصبح التواصل مع العالم الآخر المتصاعد من خلال هذا المكان "(15)
فالمقدس بأمكنته ورموزه ومعطياته التاريخية والحاضرة، حاجة ضرورية للإنسان الفرد والجماعة، وذلك من أجل خلق التوازن الإنساني المطلوب بين النوازع والأهواء و الميولات الموجودة في الإنسان.. حيث أنه بدون المقدس وضوابطه، فإن الإنسان يتحول إلى كائن شرير ووحشي وأناني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى..
الحرية ومعنى الاختلاف:
لعلنا لا نضيف جديدا حين القول: أن الحـوار والتواصل الفكري الدائم، من المداخل الأساسية لتجذير مفهوم الحرية في الواقع المجتمعي. إذ من خلال هذا الحوار الجاد والمتواصل تتأسس شروط التحول الفكري والاجتماعي. وبالحوار يتم تجديد وتطوير مفهوم الحرية على المستوى النظري والعملي، ويتم اكتشاف آليات جديدة ومبدعة للنهوض بالحرية في الواقع المجتمعي.
ولا يمكن مقاربة مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر، بمعزل عن مفهوم الاختلاف، وحق الإنسان الطبيعي في هذا الاختلاف.
وجذر حق الاختلاف في المنظور الإسلامي، هو أن البشر بنسبيتهم وقصورهم لا يمكنهم أن يدركوا كل حقائق التشريع ومقاصده البعيدة، وإنما هم يجتهدوا ويستفرغوا جهدهم في سبيل الإدراك والفهم، وعلى قاعدة الاجتهاد بضوابطه الشرعية والعلمية، يتأسس الاختلاف في فهم الأحكام والحقائق الشرعية، ويبقى هذا الحق مكفولا للجميع.
فالاختلاف مظهر طبيعـي في الاجتماع الإنساني وهو الوجه الآخر والنتيجة الحتمية لواقع التعدد. أعني أن التعدد لا بد من أن يستدعي الاختلاف ويقتضيه. فالاختلاف من هذه الزاوية، قبل أن يكون حقا، هو أمر واقع ومظهر طبيعي من مظاهر الحياة البشرية والاجتماع البشري وكما تتجلى هذه الظاهرة الطبيعية بين الأفراد تتجلى بين الجماعات أيضا. لذلك فلا مجال لإنكار ظاهرة الاختلاف بما هي وجود متحقق سواء من حيث الوجود المادي للإنسان أو مــن حيث الفكر والسلوك وأنماط الاستجابة.
ووفق هذا المنظور لا يشكل الاختلاف نقصا أو عيبا بشريا يحول دون إنجاز المفاهيم والتطلعات الكبرى للإنسان عبر التاريخ. وإنما هو حق أصيل من حقوق الإنسان، ويجد منبعه الرئيسي من قيمة الحرية والقدرة على الاختيار. وإجماع الأمة تاريخيا حول قضايا فكرية أو سياسية وما شابه ذلك، ليس وليد الرأي الواحد، وإنما تحقق الإجماع عن طريق الاختلاف الفكري والثقافي، الذي أثرى الواقع، وجعل الآراء المتعددة تتفاعل مع بعضها وتتراكم حتى وصلت الأمة إلى مستوى الإجماع.
وسيادة الرأي الواحد، يؤدي إلى التخشب واليباس، وإلى توقف العقل عن التفكير في القضايا الجادة، وضمور حـالات التجديد، والاستسلام لقوالب ونماذج ثقافية وفكرية جاهزة.
والبيئة الاجتماعية التي تقمع الآراء، وتنظر إلى الاختلافات والاجتهادات الثقافية والفكرية نظرة شائنة، هي البيئة التي تزدهر فيها حالات الجمود واللامبالاة، وتعشعش فيها كل الهوامش والطفيليات.
فالعقل قرين الحرية، فلا عقل فعال بدون حرية، و لا حرية مستديمة بدون عقل يمارس التفكير والسؤال والمساءلة، ويتحرك دائما نحو تجديد أفق المعارف والتصورات، وحرية تؤسس للشروط اللازمة لممارسة العقل سلطته ووظيفته الجوهرية.
ومن خلال الصلة الوثيقة بين العقل والحرية، تتجدد أدوات المعرفة، وتتطور أنماط الإنتاج العقلي والمعرفي. ووفق هذا السياق نتمكن من القول، أن الخرافة والتقليد الأعمى للآخرين كلها مضادات للحرية.. بمعنى أن سيادة الخرافة يعني تراجع مستوى الحرية، كما أن شيوع حالات التقليد الأعمى يعني ضمور مجالات الحرية. فلا يمكن أن تلتقي الحرية مع الخرافة، كما أنه لا يمكن أن تنسجم حالات التقليد الأعمى مع متطلبات الحرية.
والإسلام الذي كفل حق الاختلاف، واعتبره من النواميس الطبيعية، وجعل التسامح والعفو سبيل التعاطي والتعامل بين المختلفين. فحق الاختلاف لا يعني التشريع للفوضى أو الفردية الضيقة، وإنما يعني أن تمارس حريتك على صعيد الفكر والرأي والتعبير، وتتعامل مع الآخرين وفق نهج التسامح والعفو. وبهذا لا يخرج الاختلاف عن إطاره المشروع، وفي نفس الوقت يمارس دوره الحضاري في حفز الهمم والبحث عن الحقيقة، والتعاطي مع جميع الآراء والتعـبيرات بعقلية حضارية تنشد استيعاب الآراء، وتستفيد منها جميعا في بناء واقعها ومسارها.
فالاختلاف لا يساوي الرذيلة والإثم والخلل، وإنما هو ناموس كوني وجبلّة إنسانية. الخلاف والتشرذم والتفرقة، هي التي تساوي الإثم والخلل. وعلى هذا ينبغي أن نجدد رؤيتنا للاختلاف، ونتعامل معه وفق عقلية جديدة، لا ترى فيه إثما ومعصية، وإنما قدرة إنسانية مفتوحة ومتواصلة لإثراء الواقع والحقيقة.
فالاختلاف هو الوجه الآخر لضرورة الاجتهاد وإعمال العقل والفكر، كما أن الخلاف والتشرذم هو الوجه الآخر للخضوع للأهواء والغرائز والنـزعات الشيطانية، التي تتمرد على القيم والأخلاق، وتؤسس لصراعات وفتن دائمة، وتدخل الجميع في أتون النـزاعات التي لا طائل من ورائها.
فالحرية لا تعني الانفلات من الضوابط الأخلاقية والإنسانية، وإنما تعني امتلاك القدرة على التعرف والاختيار وفق لقواعد عقلية أو ضوابط شرعية.
فهي تتجه إلى الكمال وليس إلى التخريب، وإلى الانسجام ونواميس الكون والمجتمع وليس للخروج عنهما.
والاختلافات المعرفية والفقهية والاجتماعية والسياسية، ينبغي أن لا تدفعنا إلى القطيعة واصطناع الحواجز التي تحول دون التواصل والتعاون والحوار. وذلك لأن الوحدة الداخلية للعرب والمسلمين، بحاجة دائما إلى منهجية حضارية في التعامل مع الاختلافات التنوعات. حتى يؤتي هذا التنوع ثماره على مستوى التعاون والتعاضد والوحدة.
والمنهجية الأخلاقية والحضارية الناظمة والضابطة للاختلافات الداخلية، قوامها الحوار والتسامح وتنمية المشتركات وحسن الظن والاعذار والاحترام المتبادل ومساواة الآخر بالذات. هذه المنهجية هي التي تطور مساحات التعاون وحقائق الوحدة في الواقع الخارجي.
فالوحدة لا تفرض فرضا، ولا تنجز برغبة مجردة، وإنما باكتشاف مساحات التلاقي والعمل على تطويرها، ودمج وتوحيد أنظمة المصالح الاقتصادية والسياسية.
من البديهي القول أن التجارب الوحدوية التي كانت تعتمد على القسر والقوة والقهر في بنائها، تحولت إلى تجارب مولدة للتمايز المقيت والإنفجارات السياسية والاجتماعية، وكأن حقبة الوحدة القسرية، هي حقبة تربية الفوارق وتنمية التناقضات وتعميق مناطق التوتر. فالمشروعات التمامية والكليانية، التي تعتمد على القوة والقهر لفرض أجندتها وتطلعاتها، وتنبذ كل أشكال الخصوصية، لا تصل إلى أهدافها، وإنما تزيد الوضع سوءا وتدمر مستويات التعايش المتوفرة. والحرية هي التي تسمح لجميع الأطياف والقوى في المجتمع، أن تمارس دورها في إغناء الوحدة الوطنية وتكريس قيم العدالة والتسامح في مسيرتها التصاعدية. ولقد علمتنا التجارب أن تأجيل مشروع الحرية لإنجاز الوحدة لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية. بل الاستبداد هو الذي يئد مشروع الوحدة، وهو الذي ينهي حلم الوحدة، ويوصل الجميع إلى نتائج كارثية. فلا وحدة بلا حرية، ومشروع الوحدة الحقيقي يبدأ بإشاعة الحرية والسماح للجميع بممارسة حقوقهم وقناعاتهم. فالكيانات التسلطية لا تصنع وحدة وإنما تصنع شمولية سياسية تلغي كل إمكانات الشعب وتحارب قواه الحية، وتحول دون انطلاقته وإنجازاته لتطلعاته وأحلامه. فالقمع لا يصنع وحدة، والقسر لا يؤدي إلى الإتحاد، وإنما يؤديان إلى تأجيج نار الصراعات والتوترات، ويخطئ من يعتقد أن طريق الوحدة هو القوة والفرض والقهر. وحدها الحرية بما تعني من مضامين ثقافية وسياسية وحضارية، هي طريق الوحدة وبوابتها الواسعة. وقوة العرب والمسلمين في حريتهم، حيث أنها القدرة المواتية لإطلاق دينامية التحولات النوعية المتجهة نحو وحدة حقيقية وصلبة في المجال العربي والإسلامي. لأنها تفكك أنظمة الاستبداد ومشروعات العنف والقهر، وتؤسس لحركة اجتماعية متواصلة، يشترك فيها الجميع (كل من موقعه وخندقه)، وذلك من أجل البناء والوحدة على قاعدة الحرية والديمقراطية. فدولة القمع والسلطة المطلقة، لا تصنع وحدة اجتماعية ووطنية مستديمة، وإنما هي تغرس وترعى بعنفها واستبدادها النزعات العائلية والعشائرية والطائفية والعنصرية والجهوية.
وبهذا نستطيع القول أن دولة القمع والاستبداد تصنع التفتت والتشظي حتى لو كان السطح الاجتماعي موحدا ومستقرا. فالوحدة هنا كاذبة والاستقرار وهم. لأنها وحدة كل عنوان فرعي ضد الآخر. واستقرار كل طرف على مواقعه التقليدية الضيقة. وبهذا تتصاعد التوترات والتناقضات بكل أشكالها وأطيافها في دولة القمع والاستبداد. فالعنف لا يصنع وحدة، وإنما يخلق انفجارا اجتماعيا بأشكال مختلفة ومستويات متعددة. وتسويد قيم الاستعلاء والتمييز والتهميش والجهوية المتطرفة، كلها تزيد من مآزق الدولة والمجتمع، وتدخل الجميع في دوامة العنف والعنف المضاد.
والأمن لا يصان بالقمع، والاستقرار لا يتأتى بتنمية المخاوف وتأجيج العواطف السلبية، والوحدة الوطنية لا تبنى بالاستعلاء والتهميش والتمييز.كل هذه الأمور (الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية) سبيلها قيم الحرية والمشاركة والتسامح واحترام حقوق الإنسان. إننا نتطلع إلى الوحدة، ولكن ليست تلك الوحدة التي تسلبنا حريتنا، وإنما نتطلع إلى تلك الوحدة التي تصون الحرية، وإلى تلك الحرية التي تثري الوحدة بمضامين حضارية جديدة. فالطريق السليم لإنجاز مفهوم الوحدة الاجتماعية والوطنية، هو التعامل السليم مع الاختلافات والتنوعات والتعدديات التقليدية والحديثة الموجودة في المجتمع، تعاملا لا يكبت ويقمع هذه التنوعات وإنما ينظمها ويحترمها، ولا يتعالى على حقائقها، وإنما يتعاطى معها وفق سياق حضاري قوامه التسامح مع حق التعدد، وتجنب أسباب وموجبات التوترات والاحتقانات ويفتح للجميع سبل العمل المشروع في مستوياته المتعددة..
وإن تنمية الحس الديمقراطي في المجتمع، لا يتأتىالا بممارسة الديمقراطية والحرية. وإن تجاوز عيوب المجتمع ومعوقات التحول الديمقراطي، لا يتأتى أيضا إلا بممارسة الديمقراطية. وحدها ممارسة الحرية والديمقراطية هي التي تتجاوز عيوب المجتمع، وتعالج معوقات الإنطلاقه الديمقراطية. "فالديمقراطية ليست ثمرة تقطف أو نظاما جاهزا يقام في لحظة يحددها حاسب إليكتروني. إنها معركة اجتماعية وسياسية طويلة ومستمرة لا تنتهي ولن تنتهي، تواكب تطور المجتمعات وتتقدم مفاهيمها ونظمها مع تقدمها. فالبر غم من أن الديمقراطية أصبحت راسخة الجذور في الدول الصناعية الغربية التي تعيش تجربتها منذ عدة قرون، لم ينته النقاش فيها والحوار حولها، ولا تزال الأحزاب تتنافس على تعميق مدلولاتها وقيمها ونظمها. ولكل مجتمع ـ حسب مستوى نضجه ونضج قواه السياسية والاجتماعية وتوازنا ته ـ مطالبه الديمقراطية ومستوى المشاركة الشعبية الضرورية لتطوير نفسه، ودرجة التمتع بالحريات الفكرية والتنظيمية الجماعية والفردية التي لم يعد هناك اليوم إمكانية بناء مجتمعات سياسية ومدنية بالمعنى الحقيقي للكلمة من دونها. إن مفهوم الديمقراطية قد ارتبط بمفهوم المواطن، وبناء المواطنية، ولا جماعة وطنية من دون مواطنيه، ولا مواطنيه من دون حرية ومسؤولية جماعية. وفي غياب هذه العوامل المترابطة معا تكمن أزمة التشكيلية الوطنية العربية جميعها، وفي كل مكان".
وإن التحول نحو الحرية والديمقراطية في أي مجتمع، بحاجة إلى وعي عميق بضرورتها وأهمية وجودها في البناء الوطني السياسي والثقافة والحضاري. وأن هذا الوعي بحاجة إلى أن يترجم إلى وقائع قائمة وحقائق مشهودة. وأن تنمية روح المسؤولية والتسامح والحقوق والكرامة، كلها عوامل تساهم في تنمية الحس الديمقراطي في المجتمع.
ودورنا في ها الإطار يتجسد في تكثيف الفعل الثقافي والاجتماعي لتحرير دينامية التحول الديمقراطي من كوابحها ومعوقاتها الذاتية والموضوعية، حتى تأخذ الديمقراطية موقعها الأساس في تنظيم الخلافات والصراعات وضبطها، وحتى تتجه كل الجهود والطاقات نحو بناء والسلم والاندماج الاجتماعي والوطني، وتعميق موجبات العدل والمساواة والحرية..
أسئلة الراهن وآفاق الخروج:
في خضم الصراعات والنزاعات الكبرى التي تعاني منها البشرية اليوم. وفي ظل الحروب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنتاب العديد من مناطق العالم البشري. من الضروري أن نتساءل: كيف لنا في هذا الجو المحموم، أن نبدع ثقافة حوارية، تساهم في تطورنا الروحي والإنساني والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة البناء والإصلاح في عالم يمور بالنزاعات والحروب.
ونحن حينما نتساءل هذه الأسئلة المحورية، لا نجنح إلى الخيال والتمني، ولا نتجاوز المعطيات الواقعية، وإنما نرى أن الخروج من نفق الحروب والنزاعات ومتوالياتهما النفسية والاجتماعية، لا يتم إلا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار والتوازن. ولا بد من إدراك أن هذه الثقافة، ليست حلاً سحرياً للمشكلات والأزمات، وإنما هي الخطوة الأولى لعلاج المشكلات بشكل صحيح وسليم.
فالعنف المستشري في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية، لا يمكن مقابلته بالعنف، لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته الخطيرة. ولكن نقابله بالمزيد من الحوار والإصلاح في أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف والقتل والتطرف بالمزيد من الأفكار والتبريرات والمسوغات.
فالاختناقات المجتمعية، تؤدي لا شك إلى بروز حالات من العنف ومظاهر الانحراف والجريمة. وعلاج هذه المظاهر، لا يتم إلا بعلاج البيئة التي أخصبت هذه المظاهر، وهي بيئة مغلقة، تصادمية، تشاؤمية، ذات نسق تعصبي.
فالتعصب يؤدي إلى العنف، والتزمت يفضي إلى الانغلاق والانطواء والانحباس. ولا علاج إلى العنف إلا بتفكيك نظام وثقافة التعصب، ولا علاج إلى التزمت إلا بالمزيد من الحوار، ونبذ الأحكام المطلقة، وتأسيس قواعد موضوعية للتعارف الفكري والمعرفي. وهذا يجعلنا نؤكد في هذه الخاتمة على النقاط التالية:
1- ثقافة سياسية جديدة:
إن التحولات الكبرى التي تجري في العالم اليوم، تؤكد على ضرورة بلورة ثقافة سياسية جديدة، ترى في الحوار جسر الوفاق الوطني، وإن السلم الأهلي والمجتمعي، هو مستقبلنا الذي ينبغي أن تسعى كل التيارات والوجودات إلى إنجازه، وإنضاج الظروف المؤدية إليه.
فالمصالحة السياسية التي ندعو إلى إرساء قواعدها الحضارية، وتوفير ظروفها الذاتية والموضوعية، بحاجة دائماً وفي كل المراحل إلى ثقافة سياسية جديدة، تمارس عملية القطيعة المعرفية والمرجعية مع ثقافة التعصب والإقصاء والنبذ والعنف، لتؤسس نمطا ثقافيا سياسيا جديدا، يأخذ من قيم الحرية والمسؤولية وحقوق الإنسان كرامته، الإطار المرجعي لهذا النمط.
ولا بد أن ندرك في هذا الإطار، أن الثقافة السياسية الجديدة، لا تبنى في لحظة زمنية واحدة، وإنما هي بحاجة إلى عملية تراكم معرفي ومجتمعي، حتى تتشكل تلك الثقافة السياسية الجديدة، التي نراها ضرورية للمصالحة السياسية المنشودة. وذلك لأن "الفكر والثقافة ليسا بنية معرفية مغلقة تتناسل معطياتها بينها كالفطر، بل هو يمثل مستوى من مستويات (أو لحظة من لحظات) التعبير عن المحيط الواقعي والتاريخي.
وبالتالي، فالأفكار لا تكتسب قيمتها من نفسها مجردة، بل من قدرتها على تمثيل اللحظة التاريخية، والتعبير عنها، والمساهمة في تغييرها ثورياً". (16)
ودواعي ومسوغات بناء ثقافة سياسية جديدة في المجالين العربي والإسلامي عديدة، ولعل من أهمها حالة الإخفاق التي لحقت بالمشروعات الفكرية والسياسية المتداولة في الفضائين العربي والإسلامي. وذلك لأن الكثير من عناصر الثقافة السياسية السائدة، مستمدة من تلك المشروعات. وإخفاق هذه المشروعات، لا شك يدفعنا إلى ضرورة مراجعة هذه الثقافة، والعمل على بناء حقائق سياسية نظرية وعملية جديدة، تتجاوز عوامل الإخفاق الذاتية والموضوعية في تلك المشروعات. كما أن استيعاب التحولات الكبرى، ومعرفة رهانات العمل الجديدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بحاجة إلى تجديد الثقافة السياسية، والوعي السياسي والحضاري، حتى يتسنى للعالمين العربي والإسلامي من تجاوز عوامل الفشل والإخفاق، وامتصاص نقاط القوة، وفهم محركات وآليات العمل الجديدة.
2- تنظيم العلاقة بين الثقافي والسياسي:
لعل من المداخل الأساسية لنهوض الأمة في هذا العصر، وللخروج من المآزق الحضارية والمجتمعية التي يعانيها راهننا وواقعنا، هو تنظيم العلاقة بين الثقافي والسياسي، وذلك من اجل الاستفادة من كل الطاقات في سبيل البناء، ولمنع توترات وحروب تهدر طاقات الأمة في سياق الهدم والقطيعة مع مكونات الأمة المختلفة. فاستبداد السياسي يدفعه إلى العمل على إخضاع الثقافي إلى كل توجهاته وخياراته، مما يلغي فعالية الثقافي على مستوى المعرفة والمجتمع. كما أن نرجسية الثقافي في بعض الأحيان، تدفعه إلى التخلي عن الساحة الاجتماعية، والانعزال عن خيارات الأمة بدعاوى وتبريرات مختلفة. مما يجعل الساحة حكراً للسياسي ومشروعاته المميتة لروح الأمة. وقد عانت الأمة خلال العقود الماضية، من الكثير من النزاعات والحروب والتوترات، جراء العلاقة السيئة بين السياسي والثقافي في المجالين العربي والإسلامي.
لذلك نرى أن أحد العوامل الرئيسة، للخروج من واقعنا المأزوم، تنظيم العلاقة بين حقلي السياسة والثقافة في تجربتنا الإسلامية المعاصرة.
وفي البدء ينبغي أن ندرك أنه ليس في مقدور أحد، إلغاء قانون التدافع الاجتماعي بين جميع القناعات والمكونات. لذلك فإن المطلوب تنظيم هذا التدافع بحيث يكون في سياق البناء والعمران الحضاري، لا في سياق النزاعات الهدامة والحروب العبثية.
إن معيار القوة هو الذي يحكم علاقة السياسي بالثقافي. بمعنى أن السياسي بما يمتلك من قوة وأدوات للفرض والقهر والتخويف، فهو يمارس دور الإخضاع لكل ما عداه. وسيبقى هذا النمط من العلاقة مسيطراً بين السياسي والثقافي، ما دام الأخير لا يمتلك عناصر قوة ووقائع مجتمعية تساند خياراته وتدافع عن انشغالاته.
لذلك نرى أن بوابة تنظيم العلاقة بين السياسي والثقافي في تجربتنا المعاصرة، هي أن يمتلك الثقافي مقومات الاستقلال ومكونات القوة ووسائل للتأثير بشكل مباشر.
فوحدها القوة (بالمعنى الحضاري) للثقافي، هي القادرة على تنظيم العلاقة مع السياسي. وذلك عبر الوصول إلى مستوى من توازن القوة بين الطرفين، يدفع هذا التوازن ومتوالياته المجتمعية، إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة السائدة، وذلك من منطلق واقعي - مصلحي، بحيث لا يمكن لأي طرف من إلغاء الطرف الآخر من الخريطة الاجتماعية.
هذا في تقديرنا هو الطريق الواقعي، لتنظيم العلاقة بين السياسي والثقافي في تجربتنا المعاصر. وبدون بناء القوة الحضارية للثقافي، ستبقى العلاقة بينه وبين السياسي، إما علاقة توتر وتأزم ونزاع، أو علاقة إخضاع وتبعية وإذلال. وكلتا العلاقتين تفضيان إلى توتر الأوضاع الاجتماعية وتأزم الحالة السياسية، والدخول في حروب جانبية، مما يعرقل مسار النهوض الحضاري في الأمة.
وأزمة المثقف والسلطة في التجربتين العربية والإسلامية المعاصرتين، مرآة لأزمة الثقافي مع السياسي في واقعنا الراهن. وستبقى هذه الأزمة، تأخذ أشكالاً مختلفة، ما دام الثقافي هامشياً وبعيداً عن مكونات القوة الحضارية.
3- عقد اجتماعي-سياسي جديد:
إن طبيعة العلاقة المأمولة بين السلطة والمجتمع في المجالين العربي والإسلامي، تتطلب العمل والسعي الجاد لتأسيس عقد اجتماعي - سياسي جديد بين الطرفين، يحافظ على حقوق كل طرف، ويبلور ويحدد واجباتهما ومسؤولياتهما أيضاً.
وهذا العقد الاجتماعي-السياسي هو الذي يحفظ مصالح الجميع، وهو المرجعية العليا لكلا الطرفين. فمفتاح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات، وجود عقد ينظم طبيعة العلاقة بين قوى الأمة ومؤسساتها المتعددة. ويحدد الأهداف المرحلية والإستراتيجية التي تسعى إليها قوى الأمة، وتبلور حقوق وواجبات كل قوة.
ولاشك أن العقد الاجتماعي-السياسي، الذي نتطلع إليه، سيساهم في ردم الفجوة بين السلطة والمجتمع، وسيقرب من خياراتهما، وسيذوب العديد من الحجب التي تحول دون التفاعل المطلوب بين الطرفين. وهذا العقد المأمول، ليس وصفة جاهزة، وإنما ينبغي أن تسعى جميع قوى الأمة ومؤسساتها في إنشائه وبلورة عناصره وبنوده، وتوفير الأرضية الاجتماعية المناسبة لاحتضانه والدفاع عنه وتطويره.
وجماع القول: إن تنظيم العلاقة بين الأمة والدولة في المجالين العربي والإسلامي، بحاجة إلى العديد من الجهود والإمكانات، وإلى ثقافة سياسية جديدة، تأخذ على عاتقها تعبئة جماهير الأمة من جديد ووفق أهداف واضحة وأساليب ممكنة وحضارية. وإلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والثقافية، بحيث نصل إلى مستوى حضاري يحكم علاقة السياسي بالثقافي والعكس.
كما أن تنظيم العلاقة بحاجة إلى عقد اجتماعي-سياسي جديد، يستوعب جميع التحولات، وينصت إلى جميع التطلعات والطموحات، ويخلق آليات عمل جديدة، تترجم جميع التطلعات الإنسانية إلى وقائع قائمة وحقائق محسوسة.
إننا نعيش في زمن الأسئلة الصعبة والحسابات الدقيقة والمعقدة، لذلك ينبغي أن لا ننجرف تجاه الأوهام، وإنما نحاول أن نبني قناعتنا ومواقفنا استناداً إلى الحقائق والوقائع القائمة، وذلك ليس من أجل الانحباس فيها أو الخضوع إلى السيئ منها، وإنما لكي تكون حركتنا ومواقفنا ووجهتنا منسجمة ومنطق التاريخ الإنساني. فالإنصات الواعي إلى تساؤلات الواقع وتحديات الراهن، يؤدي إلى نضج الخيارات وسلامة الإستراتيجيات، وذلك لأن هذا الإنصات هو الذي يؤدي إلى تحديد البداية السليمة لعملية الانطلاق في معالجة المشكلات وبلورة الحلول.
إننا جميعاً مطالبون في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة، بفتح عقولنا ونفوسنا على العصر وآفاقه، حتى تتكامل اهتماماتنا، ونزداد قدرة على اجتراح تجربتنا في البناء والتنمية والعمران الحضاري.
وبما أن هناك علاقة وطيدة بين منظومة الأفكار وطبيعة المشاعر والميول النفسية العامة. حيث أن الثقافة التي تختزن البغض والكراهية للآخرين، فإنها ستنعكس على مشاعر الأفراد والمجتمعات الملتزمة بتلك الثقافة. لذلك فإن المطلوب باستمرار تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع وأمة، والعمل على إزالة وطرد كل العوامل والأسباب التي تدعو إلى العداء الذاتي أو ممارسة أشكال الإقصاء والتهميش للآخرين. وعملية التنقية المطلوبة، ليست عملية سلبية فقط مهمتها طرد عناصر الكره والبغض في الثقافة، بل هي عملية إيجابية أيضا تستهدف تعميق أسس ثقافة الانفتاح والتسامح والمحبة والألفة، وتكريس مقتضياتهما في البناء الاجتماعي. إذ إننا نرى أن المسؤول عن العديد من ظواهر الكراهية وحالات التهميش والإقصاء، هي تلك الثقافة التي تسوغ لأبنائها هذه الممارسات والسلوكيات. ولا وقف لها إلا بتغيير الثقافة ومناهج التثقيف والتربية التي تكرس هذه العقلية، وتوفر لها التبريرات اللازمة.
إننا بحاجة إلى ثقافة تحتضن الجميع كما تعبر عنهم جميعا، وتغرس في نفوس الناس وعقولهم حب الناس وضرورة خدمتهم والتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم في التعامل معهم. هذه الثقافة هي التي تعمق خيار المحبة في المحيط الاجتماعي. أما الثقافة التي تصنف الناس، وترتب مواقفها التفاضلية بين الناس على قاعدة ذلك التصنيف، فإنها تعمق الإحن وتزرع الأحقاد وتطمس كل نوازع الخير في النفس الإنسانية. لذلك فإن المطلوب دائما، هو تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع، ورصد مظاهر الانحراف والزيغ في هذه الثقافة، ومن ثم العمل على إخراج كل ما يسئ التفاضلية بين الناس على قاعدة ذلك التصنيف. لذلك فإن المطلوب دائما، هو تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع الناس من التداول والتأثير. وهذه مسئولية كبرى، تتطلب تضافر كل الجهود والإمكانات في سبيل بلورة ثقافة اجتماعية ووطنية تعمق خيار المصالحة والوئام، وتحارب كل أشكال التمييز والتهميش بين البشر..


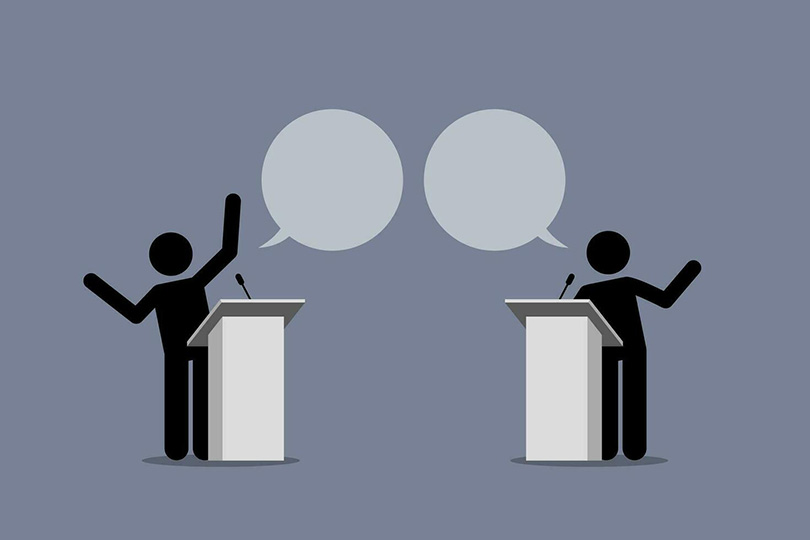

اضف تعليق