إذا كان التجديد سمة بشرية للعصور المختلفة، فإن الحداثة هي السمة الأكثر حضوراً لعصرنا الذي شهد لحظات انعطاف ثورية تاريخية هائلة وفائقة السرعة على صعيد العلم والتكنولوجيا بتوفر الشروط الداخلية والخارجية، والعوامل الموضوعية والذاتية، في إطار سلسلة من التراكمات والتحولات التي قادت إلى تغييرات نوعية...
الثقافة فضاء رحب للتعاطي مع الحقول الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والصحية والنفسية والبيئية وغيرها، ليس تعالياً على الواقع حين يُقال إن مفهوم الوطن يتأسس على الثقافة، فهي الوعاء الذي يستوعب الهوية ويجسدها على نحو حي وواعٍ بتعبيرها عن الشعور بالانتماء، فحين يولد الإنسان فإن أجواء ثقافية فطرية يتربى فيها، وهذه عصارة تطور تاريخي ولغات وأديان وتقاليد وسلوك وفنون وميثولوجيات، وبالطبع فتلك ليست معطى ساكناً أو سرمدياً؛ بل هي مفتوحة وخاضعة للتغيير، حتى لو بقيت الأصول قائمة، فإن العديد من عناصرها ستتطور وتكون عرضة هي الأخرى لتغييرات جديدة، حذفاً أو إضافة، لاسيما علاقاتها مع الثقافات الأخرى تأصيلاً أو استعارة، تأثراً وتأثيراً، حتى وإن لم تأت دفعة واحدة، لكن عملية تراكم وتطور تدرجي طويل الأمد ستطالها، خصوصاً بالتأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى كل بلد أو على المستوى العالمي.
في عام 1992 قال الروائي الإسباني انطونيو جالا وفي حفل عشاء في مدريد على شرف مائدة وزيرة الثقافة السورية حينها نجاح العطار، هناك سيدة وخادمتان، أما السيدة فهي «الثقافة» في حين أن الخادمتين هما السياسة والاقتصاد، لكن الخادمتين استطاعتا أن تسرقا مكان «السيدة» وتجلسا محلها، ومهمتنا كمثقفين هي: إعادة السيدة إلى مكانها الطبيعي والخادمتين إلى عملهما الاعتيادي.
هناك من يغالي في هذه النظرة بجعل الثقافة نقيضاً للسياسة والاقتصاد أو عدواً لهما، في حين هناك من يرى أنها بالتوازي معهما يمكن أن تسهم في إعلاء شأن الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية بين الأمم والشعوب، كما لعبت مثل هذا الدور منذ الحضارات الأولى لوادي الرافدين ووادي النيل والحضارتين الصينية والهندية وما بعدها، وإذا كان الحديث اليوم عن طريق الحرير الجديد «الحزام والطريق» فإنه تأكيد لدور العلاقات الثقافية في تعزيز العلاقات التجارية والسياسية السلمية، والتي بدونها لا يمكن أن تنتعش الثقافة أو التجارة أو السياسة، وإذا كانت ثمة حساسيات ومنافسات في الكثير من الأحيان بين السلطتين السياسية والعسكرية والسلطة الثقافية، فلأن هذه الأخيرة لها قوة معنوية نافذة، لأنها
تمثل قوة المعرفة، أو «سلطة المعرفة» على حد تعبير الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون، وإذا ما حظيت هذه السلطة باعتراف المجتمع بما فيها السلطتان السياسية والعسكرية اللتان بحاجة إليها؛ بل لا يمكنهما الاستغناء عنها، مثلما هي سلطة المال والاقتصاد، لأن هذه السلطات ستبدو عارية ودون غطاء مقنع وإنساني، وحين يتحقق مثل هذا التوافق يمكن للثقافة أن تنجز مهمتها الإبداعية مثلما للسلطات الأخرى أن تؤدي وظيفتها على أحسن وجه وبالتكامل.
ولهذه الأسباب سعى الطغاة والمتسلطون للهيمنة على الثقافة وتوظيفها لصالح سياساتهم الأنانية الضيقة، سواء باستخدام المثقفين في تزيين إجراءاتهم وتجميل سلوكهم أو «أدلجة» نهجهم، ناهيك عن حرق البخور لهم وإضفاء
نوع من «القدسية» فوق البشرية عليهم، وكان إدوارد سعيد قد أثار جدلاً كبيراً لم ينقطع بالأساس حول معنى ودور المثقف ووظيفته الإبداعية وذلك في كتابه «صور المثقف».
الثقافة بهذا المعنى مثل الحب؛ بل مثل فعل الحياة لا يمكن تجزئتها أو اقتطاع قسم منها، وهي بكل حقولها علوم وتكنولوجيا وعمران ورواية وقصة وشعر ومقالة ونقد ورسم ونحت ومسرح وسينما وموسيقى وغناء وكل أنواع الكتابة والإبداع، هي فضاء رحب للتعاطي مع الحقول الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والصحية والنفسية والبيئية وغيرها.
لقد شكلت الستينات من القرن الماضي وعياً ثقافياً جديداً وعبّرت عن روح جديدة ولغة جديدة، في المضمون أولاً، ثم في الشكل، مثلما اقترنت التسعينات بحداثة جديدة وغير مشهودة من قبل، خصوصاً بالتخلص من الكثير من الأوهام الإيديولوجية وما ارتبط بها من أنظمة ومؤسسات ويقينيات، في إطار حساسية إنسانية جديدة ورؤية إبداعية مغايرة، بالارتباط مع نتائج الثورة العلمية- التقنية والثورة الصناعية في طورها الرابع، والذكاء الاصطناعي والطفرة الرقمية «الديجيتل» وتكنولوجيا الاتصالات والمواصلات والإعلام.
إذا كان التجديد سمة بشرية للعصور المختلفة، فإن الحداثة هي السمة الأكثر حضوراً لعصرنا الذي شهد لحظات انعطاف «ثورية» تاريخية هائلة وفائقة السرعة على صعيد العلم والتكنولوجيا بتوفر الشروط الداخلية والخارجية، والعوامل الموضوعية والذاتية، في إطار سلسلة من التراكمات والتحولات التي قادت إلى تغييرات نوعية، لأن الحداثة عملية كونية تاريخية مرتبطة بنضوج شروط وعيها وليست بشكلها فحسب، وبالتالي فهي ليست فضيلة أو رذيلة بقدر ما هي استكمال لفهم جديد للعالم وفاء للعصر المتميز الذي نعيش فيه.
يمكن القول إن الثقافة تعني خير الناس، وهي صيرورة حياتنا بكل معنى الكلمة لأنها تمثل عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا وتراثنا وآدابنا وأمزجتنا وسلوكنا وطريقة مأكلنا ومشربنا وملبسنا وعمارتنا وأساطيرنا وتفسير لكل ما نحن عليه.


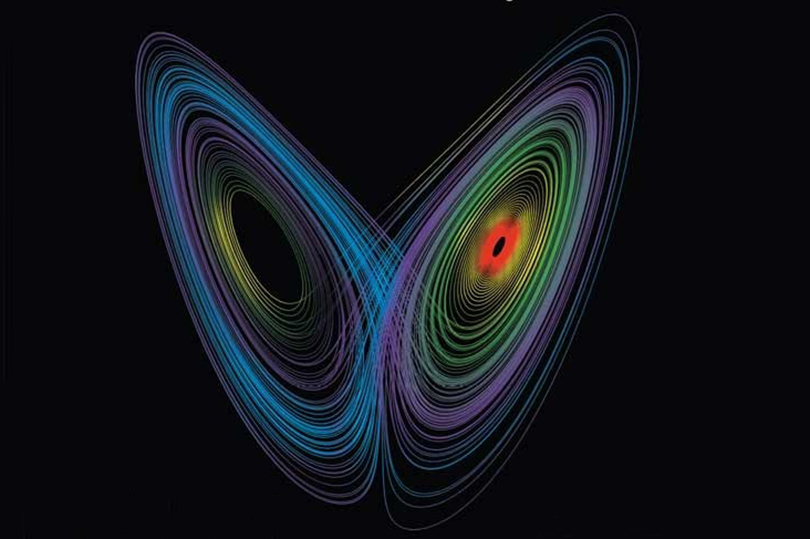

اضف تعليق