ولابد في خاتمة الفصل الرابع من ان نفصّل بعض الشيء في الحديث عن القرآن الكريم وحملته، وعن الرسل والاوصياء، معرفياً، وعن علومهم ومعارفهم، وهل هي نسبية ام مطلقة؟ وهل هي محدودة ام شاملة؟ وعن الادلة والبراهين على ذلك، وعن قضايا عديدة ذات صلة، وذلك لان العديد من الهرمينوطيقيين – ممن ذكرنا اسمائهم وممن لم نذكرهم – حاولوا تطبيق معادلات (نسبية النصوص والمعرفة) على القرآن الكريم وعلى الرسل والاوصياء، فكان لابد من تخصيص مساحة لذلك، على ان البحث عن ذلك بتفصيل واف يستدعي كتابة مجلد ضخم على اقل الفروض، ولعل الله يوفقنا لذلك في المستقبل[1].
لقد دلت الأدلة العقلية قبل النقلية على أن (القرآن الكريم) يحتضن (المعرفة المطلقة) ويتضمنها، وكذلك الرسل والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، فإنهم يمتلكون (المعرفة المطلقة) وقبل أن نستعرض عناوين الأدلة والبراهين لابد أن نشير إلى أننا نعني بـ(المطلقة):
أولاً: الشاملة لكل شيء مادي أو معنوي، ولكل حدث ولكل فكر، ولكل علم.
ثانياً: المعرفة التي تخترق أعماق الأشياء وبواطنها، أي (معرفة الشيء في حدّ نفسه).
ثالثاً: المعرفة المطابقة للواقع مائة في المائة، في الأصل وفي التفاصيل، وفي الكلي والمصاديق، وفي الكل والأجزاء، وفي مختلف الجهات والأبعاد والمراتب.
رابعاً: المعرفة العلمية القطعية لا الظنية.
خامساً: المعرفة التي لا تتغير بتغير (الخلفيات النفسية) و(المسبقات الفكرية) ولا تؤثر فيها سلبياً شخصية العارف والعالم.
سادساً: المعرفة التي لا تتغير بتغير الأزمان والأماكن والظروف.
سابعاً وثامناً وتاسعاً: تلك المعرفة ذات المعايير الموضوعية، وأيضاً التي دلت عليها الحروف والألفاظ والرموز والآيات القرآنية، بدقة لا متناهية، وأيضاً التي وضع الله تعالى لها منهجاً علمياً قرآنياً وحديثياً للوصول الصائب إليها، وإن كان المحيط بعلم المنهج هذا هو من نزل القرآن في بيوتهم.
عاشراً: إنها المعرفة التي يصح اعتقاد من طابقها، ويخطئ اعتقاد من جانبها وارتأى غيرها.
حادي عشر: إنها (المعرفة النافعة) حتماً، وتتجلى إحدى أوجه النفع، لدى معرفة أنهم (بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء) و(إنهم وسائط الفيض) و(لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها).(2)
وتفصيل ذلك ينبغي أن يطلب من علم الكلام والعقائد والتفسير والحديث، إلا أن ما ينبغي نشير إليه ههنا إشارةً هو أنه ـ إضافة إلى أنه لا يصح للمنكر أن ينكر بل غاية الأمر أن يقول: لا أعلم، فإنه نفي ما لم يحط به خُبراً.
لا ريب ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ في (الإمكان الذاتي) لوجود (كائن) يحتضن (المعرفة المطلقة) ـ وقد يكون ملكاً أو إنساناً أو مخلوقاً آخر(3) ـ كما لا ريب في ثبوت (الإمكان الوقوعي) لذلك؛ فإن وجوده ليس محالاً في حد ذاته، كما لا يستلزم محالاً آخر.
فأما (الوقوع) فتدل عليه الأدلة العقلية والنقلية المتضافرة، وأما الأدلة النقلية فهي:
منها قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها)(4) ومنها الجمع بين قوله تعالى: (تبياناً لكل شيء)(5)، و: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(6)، و: (أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(7)، و: (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)(8)و: (قال إني جاعلك للناس إماماً)(9) و: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) (10)، و: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) (11) وتفصيل الحديث عنها بحاجة إلى مقال مستقل.
إطلالة عابرة على الأدلة العقلية
وأما الأدلة العقلية، فإننا سنشير ههنا إشارة فقط لعناوين الأدلة العقلية:
البرهان الإستنباطي
فمنها: (البرهان الاستنباطي)، ويمكن الاستناد إليه بأنحاء عديدة، تطلب من علم الكلام والعقائد والفلسفة.
قاعدة إمكان الأشرف
ومنها: (قاعدة إمكان الأشرف) العقلية. لكن لا بالمعنى الذي ذكره البعض من (أن الفياض المطلق والجواد الحق لا يقتضي الأخس، حيثما يمكن الأشرف، بل يلزم من فيض وجوده ومقتضى جوده، الأشرف فالأشرف).(12)
و(العقل الأول له وجوب بالحق الأول وإمكان في ذاته، فبالجهة الأشرف يقتضي شيئاً أشرف وهو جوهر آخر عقلي).(13)
بل بمعنى (اقتضاء الحكمة: خلقه تعالى للأشرف، وكون خلقه مقتضى كرمه وجوده، لا بالقسر ولا باللا بدية) ويحتمل بمعنى (ابتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف، حتى انتهى إلى الأخس)(14)، لكن لا إلزام ولا حتمية في ذلك؛ إذ لعل المصلحة والحكمة تقتضي العكس، فلا يصح القول بـ(إن الممكن الأخس إذا وجد فيلزم أن يكون الممكن الأشرف قد وجد)(15) إذا أراد من (يلزم) الوجوب وأنّ عكسه ممتنع، بل حتى لو أراد قطعية كون ذلك كذلك، وقوعاً في كل أنواع الوجود، نعم يحتمل ذلك، وإن قلنا بمسلمية صدور أنوار الأربعة عشر عليهم سلام الله أولاً، لكن لا دليل على إطراد خلق الأشرف فالأشرف حتماً في كل شيء، ويدل عليه خلق جسد آدم قبل نفخ الروح فيه، وخلق الشيطان قبله، فتأمل.
والحاصل: إن الكلام في (الوقوع) وأن (الأشرف) قد صدر(16) منه تعالى(17)، لا في أ: استحالة صدور غير الأشرف منه، ب: ولا في استحالة تسلسلٍ غير تسلسل صدور الأشرف فالأشرف، أي أن الكلام هو في أن مقتضى جوده وكرمه إفاضة الوجود على مختلف الماهيات المتطلبة بلسان حالها، لإيجاده وخلقه لها.
واعتبر ذلك بملاحظة حال عقلاء البشر، فإن العقلاء بما هم عقلاء، يقومون بصنع الأفضل أو إنجازه، مع توفر القدرة لديهم، والحكمة، والعلم، وعدم المانع (من كسل أو مزاحم أهم أو غيرهما) ولو لم يفعلوا كانوا ملومين، واختبر ذلك أيضاً من حال الطبيب، إذا كان بمقدوره إجراء عملية ناجحة مائة بالمائة، أو المهندس لو كان بمقدوره بناء مدينة متكاملة بل مدينة مثالية، فإنه إن لم يفعل ـ مع كونه قادراً مالاً ووقتاً، وعالماً، وخالياً من المزاحمات والموانع ـ فإنه يعد ملوماً.
والأمر في الخالق جل اسمه أوضح لعموم قدرته على أن يخلق من خلفائه على الكون ـ من الأنبياء وأوصيائهم ـ من يكون بأقصى درجات الكمال، في مختلف الجهات (بأن يكون علمه شاملاً بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وهكذا قدرته وغيرها كذلك) فإن نفس علمه المحيط وقدرته الشاملة وحكمته البالغة التامة تقتضي خلق المخلوق الكامل(18)، من غير حاجة إلى التمسك ببرهان التالي الفاسد، لو لم يفعل، وهو: فعل القبيح(19)، أو إستلزامه النقص جل وعلا، عن كل ذلك.
ثم إنه بعد الفراغ عن ذلك يصح القول: (ليس يمكن في الأشرف أن يكون من أجل الأقل شرفاً)(20)، ويحتمل (للجزء الأشرف الوجه الأشرف من الفعل)(21)، و(الأصل الأشرف في الإنسان وهو الإنسان ذاته)(22)، مع إمكان العكس لو اقتضت الحكمة والمصلحة.
قاعدة اللطف
ومنها: قاعدة (اللطف) بتقريراتها المتعددة.(23)
ومن تقريراتها: أن ذلك هو مقتضى قدرة الله تعالى، وعلمه المحيط، منضمين إلى إقتضاء كرمه وجوده وفياضيته، أو إلى إقتضاء (حكمته) فلو لم يخلق الله تعالى (أشخاصاً) أو (مخلوقات) كاملة من جميع الجهات، عالمة بحقائق الأشياء، ظواهرها وبواطنها، كما هي وبشكل مطلق، وبنحو يطابق علمهم الواقع تمام المطابقة، وهم عالمون بذلك بالقطع واليقين، لا الظن والاحتمال، لكان ذلك إما لعجز أو لبخل أو لجهله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ويشهد لذلك قوله تعالى: (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)(24)، (تبياناً لكل شيء)(25).
الاستقراء المعلل
ومنها: (الاستقراء المعلل) ويمكن تصويره بأنحاء، ومن تلك الأنحاء:
ذلك المكتَشف من ملاحظة نمط هندسة الكون كله، والمبني على (العلل المعدة) و(المقتضيات) و(الأسباب والمسببات الطولية الظاهرية، والتي تكمن وراءها أسباب طولية أخرى خفية) وذلك سواء في عالم الوجود العيني أم عالم الوجود الذهني و(المخلوقات المتنوعة في درجات المعرفة والعلم والكمال) من المحدودة جداً، إلى الأوسع، فالأوسع، فالأوسع، بل يمكن بهذا اللحاظ، تحويل هذا البرهان إلى (البرهان الاستنباطي) أيضاً؛ إذ كلما تقدمنا خطوة في إكتشاف دقائق الكون وحقائق الأمور، كلما تجلى لنا عمق أكبر ومعرفة أعمق وحكمة أدق وأوسع، وأبعاد أكثر، في مخلوقات الله، كما ظهر لنا كمال أكثر في المخلوق الأفضل، كما ظهر لنا كلما درسنا حياة ومنهج وعلم وسيرة ومعاجز الأنبياء والأوصياء، إنهم هم المجلى الأعظم والتجلي الأكبر والمظهر الأسمى لعطاء الله تعالى اللا محدود.
ولعله يشير إلى جانب من ذلك قوله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)(26) و: (توفته رسلنا) (27).
البرهان الفرضي
ومنها: (البرهان الفرضي) حيث نفترض في البدء، وجود مخلوقات تمتلك المعرفة الكاملة، والعلم الشامل ونفترض أنها هي: الأنبياء والرسل، ثم نبحث عن ما يؤيد الفرضية لتتحول عندها إلى نظرية، ثم نقوم بالتجربة مرة بعد أخرى، لتتحول النظرية إلى حقيقة علمية، والنقطة الأخيرة هي التي أثبتتها حوارات ألوف العلماء مع المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم طوال مأئتين وخمسين عاماً أو أكثر، كما يتجلى ذلك لدى مراجعة كتاب (الاحتجاج)(28) وغيره، وكما يظهر من مطالعة كتاب (الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب)(29) وغيره.
ونكتفي ههنا بإشارة سريعة فنقول: إن هذا البرهان يستند إلى معطيات كثيرة ومنها أن العلم كلما تقدم وتطور، اكتشف مؤشرات جديدة، دالة على أن هنالك أرشيفاً كونياً، ومخازن جبارة للمعرفة، أودعها الله تعالى في أشياء متناهية الصغر، أو متناهية الغرابة، أو متناهية البساطة.
وتكفينا الإشارة الآن إلى:
1: (الجين الوراثي) الذي يختزن معلومات لا متناهية، وقد توصل العلماء إلى فك بعض شفراتها فاكتشفوا احتواءها على (المليارات) بل الأكثر من المعلومات، رغم تناهيها في الصغر.(30)
ولعله يشير إلى ذلك قوله تعالى: (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء)(31)، و: (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم..)(32).
2: وإلى (الأثير) والذي أثبت العلم أنه يختزن كل الأمواج والذبذبات والأصوات وغيرها.
3: وإلى (منطقة الوعي الباطن) إلى غير ذلك...
ولعل إلى ذلك ـ بل الأعمق منه ـ يشير قوله تعالى (ووجدوا ما عملوا حاضراً)(33).
العلم العنائي
ومنها(34): معادلة (العلم الإلهي العنائي بخلقه): (لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر في الخارج، وعلمه الذي هو عين ذاته، عله لما سواه، فيقع فعله على ما علم، من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصياته، والكل معلوم، فله تعالى عناية بخلقه)(35) و(العناية: هي كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل، فإن علمه التفصيلي بالأشياء ـ وهو عين ذاته ـ علة لوجودها بما لها من الخصوصيات المعلومة).(36)
وفي المنظومة:
الذات للذات والعلم للـ*****علمِ وحيث اتحـــــدا
علتاهما فاحكم بــــــــأن*****قد وحد معلولاهمـــا
وأيضاً:
وكتوهم لسقطةٍ على جذع *****عنايةً سقوطٌ حصـــــلا
ولا يخفى أن عدداً من الفلاسفة كشيخ الإشراق(37) وأتباعه أنكروا العناية، كما اختلف المثبتون لها في معناها.(38) وليس هذا موطن تحقيق ذلك، بل الاستدلال إنما هو مبنائي.
ومن الممكنات: خليفة الله الذي يمتلك كافة العلوم وكل المعارف، في شتى الحقول، بنحو مطلق، يقيني، نافذ لعمق الأشياء، فلا تناله (النسبية) في أي معنى من معانيها.
والتأمل في كلامه نظراً لما يستظهر منهم من اعتبار خلقه تعالى لما خلق، لا بالاختيار؛ (إذ مع كون علمه عين ذاته وكونه العلة، فوجب بالنظر لذاته وقوع كل ما يعلمه؛ لأن العلة تامة العلية حيث أنها هي الذات بنفسها وهي فعلية من كل جهاتها).
ونحن نقول: إن خلقه للخلق هو بإختياره، وأن (الخلق) من صفات الفعل وليس من صفات الذات، والفرق: أن صفة الذات لا يمكن ورود النفي عليهان عكس صفات الفعل (ولذا لا يصح أن تقول: قدر على هذا ولم يقدر على ذاك، أو علم الآن ولم يعلم أمس، ويصح أن تقول: خلق هذا ولم يخلق ذاك، أو أراد هذا الشيء ولم يرد ذاك الشيء الآخر) ـ حسب المستفاد من العقل ومن بعض الروايات في التفريق.
نعم نرى خلقه تعالى للكامل، نظراً لحكمته تعالى، بإختياره، وله أن لا يفعل بالنظر لذاته، وأما (العلم) فليس علة بل هو (تابع بمعنى أصالة موازِنِه في التطابق) كما ذكره المحقق الطوسي في (التجريد)، وأما كيفية العلية فمما لا سبيل لنا إليها، فلا مجال للإستدلال بإتحاد العلم والذات، وتفصيل الكلام يطلب من علم الكلام.
المعرفة العقلية المباشرة والحدس
ومنها: (برهان المعرفة العقلية المباشرة) عبر طرق عديدة، منها (العلم الحضوري) بناء على مسلك من يرى أن علم المعلول بالعلة حضوري كعلمها به، ونظيره جارٍ في المقام بأن يعلم الأدنى بالأعلى كمالاً، علماً حضورياً، لكن الظاهر بطلان المبنى والبناء.
ومنها (الحدس) نظراً لوجود وتحقق (منابع، ومعادن، ومصادر) تعدّ (مرجعية ومركزية) في شتى الأبعاد، وقد أشارت له الآية الكريمة (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) وكما يوجد في (العالم الأصغر) وهو الإنسان (جهاز مركزي) يحتوي على كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بجسم الإنسان، رغم أنه الله تعالى قادر على أن (يديره) مباشرة، كذلك في (العالم الأكبر) بكل أفلاكه ومجراته، ويوجد فوق ذلك أيضاً (والمدبرات أمراً).
ولا يخفى أن هذه البراهين أدلة على أصل وجود (مخلوقٍ) أو مخلوقات، تمتلك المعرفة الكونية الشاملة والمطلقة، بمنحة إلهية ربانية.
وإما كون تلك المخلوقات هي الرسل والأوصياء والقرآن الكريم، فدليله إضافة للآيات والروايات، (الإعجاز) في شتى الأبعاد، ومنه الإعجاز العلمي القرآني، كما أن من أدلته الوجدان الخارجي الذي تكشف عنه كلمات أمير المؤمنين والإمام الصادق والإمام الجواد، وسائر الأئمة سلام الله عليهم، وتحديهم لكافة علماء العصر.(39)
كما أنه قد يستند إلى برهان المعرفة العقلية والمباشرة والحدس وإلى البرهان الفرضي وغيرهما، لإثبات أن تلك المخلوقات هي الأنبياء وأوصيائهم.
ولعلنا نوفق للحديث عن ذلك كله على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم الحديث، في كتاب مستقل، أو يقيض الله تعالى من يضطلع بتلك المهمة.


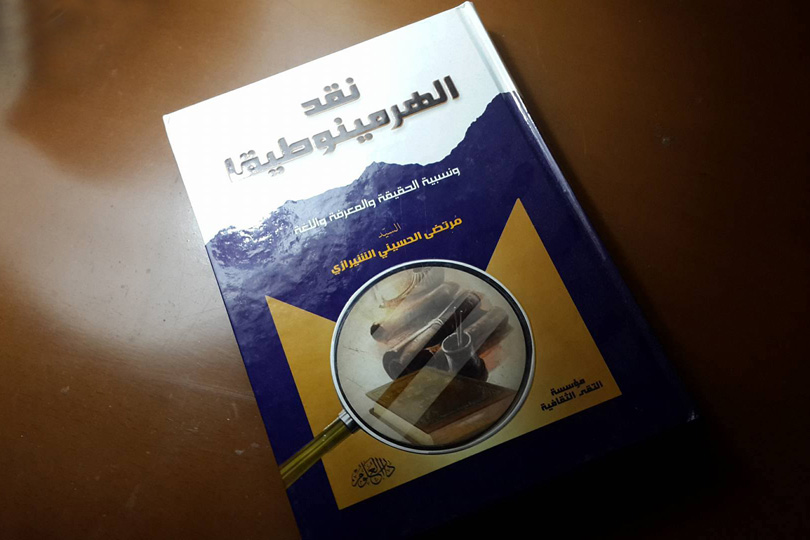

اضف تعليق