الشعبوية تضع الديموقراطية التمثيلية على مسار تصادمي مع مبادئها الدستورية. إن نجاح الشعبوية مشروط بقدرة الزعيم على تحويل سلطة الأغلبية. التحدي الذي تتركه الشعبوية أمام الديموقراطيين لا يكمن فقط في محاربة الزعماء الشعبويين، بل في إصلاح الديموقراطية التمثيلية نفسها لكي تكون قادرة على استيعاب مطالب الشعب العادي وتجديد الطبقة السياسية...
تدور هذه المقتطفات حول كتاب "أنا الشعب: كيف حوّلت الشعبوية مسار الديموقراطية"، لمؤلفته نادية أوربيناتي الذي يحمل عنوان وهي ترجمة عربية لعمل نُشر أصلاً بالإنجليزية عن مطبعة جامعة هارفارد في عام ٢٠١٩، حول تحليل ظاهرة الشعبوية وعلاقتها المعقدة بمسار الديمقراطية، مستكشفًا كيف أدت هذه الظاهرة إلى تغيير الأنماط التقليدية للحكم التمثيلي وتحدي مؤسساته. يتناول العمل قضايا رئيسية مثل تمثيل الشعب الحقيقي، دور الأحزاب السياسية في ظل صعود القيادة الكاريزمية الشعبوية، والتمييز بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة. كما يتضمن الكتاب تحليلًا عميقًا لمصادر النزعة المناهضة لمؤسسة الحكم ودور الأيديولوجيا الشعبوية وتأثيرها على الديناميكيات السياسية والاجتماعية.
1. هيكلية الكتاب وموضوعاته الأساسية
يقدم الكتاب منهجاً تحليلياً شاملاً من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول رئيسية، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، تستعرض مختلف جوانب العلاقة بين الشعبوية والديموقراطية التمثيلية:
1. المقدمة: نمط جديد من أنماط الحكم التمثيلي: تناقش ظهور الشعبوية كظاهرة حديثة ظهرت إلى جانب سيرورة الديموقراطية منذ القرن التاسع عشر، وكيف أنها تتحدى أنماط الحكومات التمثيلية.
2. الفصل الأول: من مناهضة مؤسسة الحكم إلى مناهضة السياسة: يركز على تحول الحركة الشعبوية من مجرد معارضة للمؤسسة الحاكمة (anti-establishment) إلى مهاجمة السياسة نفسها (anti-politics).
3. الفصل الثاني: الشعب الحقيقي وأغلبيته: يتناول مفهوم "الشعب الحقيقي" الذي تدعيه الحركات الشعبوية، وكيف تستغل مفهوم الأغلبية لتكريس رؤيتها الأحادية مقابل "الأقلية المنفذة" أو "الأشرار".
4. الفصل الثالث: الزعيم وراء الأحزاب: يدرس دور الزعيم الكاريزمي كعنصر أساسي في الشعبوية، وكيف يسعى إلى تجاوز الأحزاب التقليدية ليصبح هو الممثل الأوحد لإرادة "الشعب".
5. الفصل الرابع: التمثيل المباشر: يحلل طبيعة التمثيل المباشر الذي تسعى إليه الشعبوية كبديل للحكم التمثيلي، وتأثير الأدوات التكنولوجية والوسائل المباشرة في تحقيق هذا الهدف.
6. خاتمة: طريق مسدود؟: يقدم تلخيصاً للمسار الذي حولت فيه الشعبوية الديموقراطية ويطرح تساؤلات حول مستقبلها.
2. الشعبوية كنمط جديد ومناهضة لمؤسسة الحكم (Anti-Establishment)
ترى الكاتبة أن الشعبوية الحديثة، التي تجاوزت حركاتها الحدود الجغرافية، ليست مجرد أيديولوجيا، بل هي نمط تفسيري أو "رؤية" سياسية. إنها تحديث جذري لمسار الديموقراطية الدستورية.
المحور الأساسي لخطاب الشعبوية هو مناهضة مؤسسة الحكم ("الأنظمة الراسخة"، أو "نخبة السلطة" - *The Power Elite*)، والتي تصفها بالفساد. الشعبوية لا تعترض على الأغلبية كقاعدة للحكم، بل ترفض الأغلبية التي تعتقد أنها تسيطر على الحكم في اللحظة المنتخبة من الزمن.
* العداء للتمثيل والوساطة: الشعبوية تتحدى التمثيل الديموقراطي التقليدي لأنه يقوم على الوساطة (مثل الأحزاب والمؤسسات) بين الشعب وصاحب السيادة. الزعيم الشعبوي يسعى إلى إقصاء النخب و المؤسسات.
* ثنائية الصراع: يتمحور خطاب الشعبوية حول ثنائية واضحة: "الشعب الصالح" (The Good People) مقابل "الأشرار" (The Evil Others)، أو "الأغلبية العادية" مقابل "الأقلية المنفذة الفاسدة".
* تشويه الديموقراطية: إن الشعبوية في جوهرها لا تهدف إلى قلب النظام، بل إلى تغيير طبيعة الديموقراطية الدستورية من الداخل، مستخدمة أدوات الديموقراطية (مثل الانتخابات والاستفتاءات) لـ"تشويهها". هذا التحول قد يجعل الديموقراطية أقل ليبرالية دون أن يجعلها أقل ديموقراطية *جذرياً* في الظاهر.
3. الشعبوية والأغلبية: إرادة الشعب الموحدة
يرفض المنطق الشعبوي فكرة تعددية الأصوات والآراء التي هي أساس الديموقراطية الليبرالية.
* وحدة الإرادة: تدعي الشعبوية أنها تمثل إرادة الشعب الموحدة، وتستخدم مفهوم الأغلبية (majoritarianism) لتجريد بقية المجتمع (التي لا تتفق معها) من الشرعية.
* التمثيل بالاستقطاب (Pars pro toto): الشعبوية تستخدم مصطلح "الشعب" (populus) لتمثيل "الجزء" (meros) الذي يطالب بتمجيد نفسه ليمثل "الكل" (latreia). عندما تنتصر الشعبوية في الانتخابات، فإنها لا تعترف بأغلبية خاصة، بل تزعم أن الأغلبية المتحققة هي إرادة الشعب بأكمله.
* التمويل من الانتخابات: يتمثل التحدي الجذري الذي تطرحه الشعبوية على الديموقراطية في أنها تستخدم الانتخابات كأداة شرعية للوصول إلى السلطة، لكنها لا تعترف بآلية التنافس والتداول السلمي الذي ينتج عن هذه الانتخابات. بمعنى آخر، الانتخابات بالنسبة للشعبويين هي مجرد تعبير عن الأصوات ووسيلة لتجسيد "الشعب الصالح".
4. الزعيم والكاريزما والتمثيل المباشر
يعد الزعيم الكاريزمي عنصراً محورياً في النموذج الشعبوي، حيث يحل محل المؤسسات التقليدية.
* "الزعيم الكاريزمي" (Charismatic Leader): تعتمد الأنظمة الشعبوية على "الذاتية الشعبوية"، حيث يتجمع الشعب تحت راية الزعيم. لا يقتصر الأمر على مجرد الدعم، بل يتجاوز إلى تفويض شامل يجعله الممثل الوحيد لإرادة الأمة.
* التمثيل المباشر مقابل التمثيل التمثيلي:
* التمثيل التمثيلي (التقليدي): يعتمد على فصل السلطات والتوازن بين الأغلبية والأقلية.
* التمثيل المباشر (الشعبوي): لا يقتصر على الاستفتاءات، بل يهدف إلى إقامة علاقة مباشرة بين الزعيم والجمهور ("الجمهور المتلقي"). إنه يلغي دور الوسيط (الأحزاب، البرلمان).
* التوظيف السياسي للتكنولوجيا والإعلام: تستغل الحركات الشعبوية الأدوات الحديثة (مثل الإنترنت) لتجنيد الدعم الجماهيري وتجاوز البنى التنظيمية التقليدية للأحزاب.
5. جذور الشعبوية الأيديولوجية والأخلاقية
يناقش الكتاب الجذور الفكرية للشعبوية، التي غالباً ما تظهر كـ"أيديولوجيا هزيلة أخلاقية" (thin moral ideology).
* الأخلاقية ضد الفساد: الشعبوية هي حركة أخلاقية بامتياز. هي لا تقدم بالضرورة حلاً اقتصادياً أو اجتماعياً جذرياً، بقدر ما تقدم هجوماً على النخبة الفاسدة.
* انتقاد الليبرالية: الشعبوية لا تعادي الديموقراطية في جوهرها، بل تعادي الليبرالية بما تتضمنه من حريات أساسية وحقوق الأقليات، التي تعتبرها قيوداً على إرادة الشعب الموحدة.
6. التحدي المستمر الذي تمثله الشعبوية
يشير الكتاب إلى أن الشعبوية لا يمكن اعتبارها ظاهرة عابرة، بل هي تعبير عن أزمة في التمثيل الديموقراطي.
* التحدي المزدوج: تستفيد الشعبوية من إهمال المؤسسات الديموقراطية لأجزاء من الشعب، ومن ضعف النخبة وعدم قدرتها على صياغة سياسات تحظى بدعم واسع.
* الشعبوية والفاشية: يحرص الكتاب على التفريق بين الشعبوية والفاشية، حيث أن الفاشية هي نظام حكم يهدف إلى القمع المطلق وتدمير التعددية. أما الشعبوية فهي تستمد شرعيتها من الدعم الجماهيري وتحترم (ظاهرياً) آليات الديموقراطية.
يقدم الكتاب خريطة تحليلية لكيفية استخدام الشعبوية لمفاهيم الأغلبية والتمثيل المباشر لتغيير طبيعة الحكم الديموقراطي من الداخل. إنها تشكل تهديداً على التوازنات الدستورية من خلال توحيد إرادة الشعب تحت قيادة زعيم فرد ورفض دور المؤسسات الوسيطة.
لتوضيح طبيعة هذا التحول:
يمكن النظر إلى الديموقراطية الليبرالية كآلية معقدة (كساعة دقيقة) تتكون من تروس متوازنة (الأغلبية، الأقلية، الأحزاب، المؤسسات، الحقوق الفردية). تأتي الشعبوية لتبسيط هذه الآلية بشكل جذري، حيث تزيل التروس المعقدة (الوساطة والتعددية) وتجعلها تعتمد على ترس واحد كبير (الزعيم) يزعم أنه يمثل المحرك الوحيد للساعة (إرادة الشعب). هذا التبسيط يهدد التوازن والاستقرار الدائمين الذي كانت تتمتع به الآلية الأصلية.
مقدمة الكتاب: نمط جديد من أنماط الحكم التمثيلي
ظاهرة الشعبوية المعاصرة، هي ظاهرة تشكل تحدياً جوهرياً للحكومات التمثيلية. ظهرت الشعبوية منذ القرن التاسع عشر، جنباً إلى جنب مع سيرورة الديموقراطية، لكن الحركات الشعبوية الحديثة، التي تجاوزت الحدود الجغرافية، تعكس اليوم تحديات ذات حدة غير مسبوقة وتفخيماً كبيراً. وقد ظهرت هذه الحركات في كل الديموقراطيات تقريباً، من أوروبا الشرقية (كراكاس وبودابست) حتى الغرب (روما) وأمريكا اللاتينية.
تشير أوربيناتي إلى أن الشعبوية ليست مجرد أيديولوجيا شاملة، بل هي نمط تفسيري أو "رؤية" سياسية، وأنها تحديث جذري لمسار الديموقراطية الدستورية. وتقدم المؤلفة رؤية مفادها أن الشعبوية هي نوع جديد من أنواع الحكم المختلط (Mixed Government) الذي يستفيد من نظرية ثنائية الحكم في الديموقراطية التمثيلية.
المشروع الأساسي للكتاب هو تفكيك هذا التحول، حيث تفترض المؤلفة أن الشعبوية في جوهرها تشويه لطبيعة الديموقراطية. هذا التشويه لا يعني بالضرورة إسقاط النظام، بل تغيير طبيعة الديموقراطية الليبرالية الدستورية من الداخل، باستخدام أدواتها. فالشعبوية لا تخلق بالضرورة دكتاتورية، بل قد تسهم في جعل الديموقراطية "أقل ليبرالية" دون أن تجعلها بالضرورة "أقل ديموقراطية".
إن النزعة الشعبوية تستهدف بشكل أساسي "مؤسسة الحكم" (The Power Elite) وتتحدى التمثيل الديموقراطي القائم على الوساطة (مثل الأحزاب والمؤسسات). وتعتمد الشعبوية على "الذاتية الشعبوية"، حيث يتجمع "الشعب" تحت راية الزعيم. فالزعماء الشعبويون يدّعون أنهم يمثلون "الشعب الصالح" الذي تم التخلي عنه.
تُعرّف أوربيناتي الشعبوية بكونها حركة رأي واحتجاج، وفي الوقت نفسه حركة للوصول إلى السلطة. إنها لا تعتمد على أيديولوجيا شاملة، بل توصف بأنها "أيديولوجيا هزيلة أخلاقية" (thin moral ideology). فهي تركز على تمثيل "الشعب الصالح" في مواجهة "النخب الفاسدة".
الفصل الأول
يتناول الفصل الأول التحول الجذري في طبيعة النقد الذي تمارسه الحركات الشعبوية ضد الديموقراطيات التمثيلية. لا تقتصر هذه الحركات على معارضة النخب الحاكمة المؤقتة فحسب، بل إنها تتجه نحو تحدي الأساس السياسي للديموقراطية نفسها.
1. الهدف: مناهضة "مؤسسة الحكم"
ينطلق الخطاب الشعبوي من مطلب أساسي يتمثل في التخلص من "مؤسسة الحكم" (The Power Elite). هذه المؤسسة لا تشمل فقط المسؤولين المنتخبين، بل أيضاً نخبة السلطة وأجهزة صناع القرار خارج الدولة. الزعماء الشعبويون يدّعون أنهم يمثلون "الشعب الصالح" الذي تعرض للتخلي عنه، ويسعون إلى طرد "الطرف الشرير" أو "الأقلية المنفذة الفاسدة".
تكمن جاذبية هذا الخطاب في أنه يركز على العداء للنخبة الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا يعتمد على أساس أيديولوجي عميق، بل يقوم على أساس أخلاقي يفترض أن النخب الحاكمة فاسدة وغير مؤهلة للحكم، ترى الشعبوية أن النخب السياسية الفاسدة تمنع الشعب من التمتع بالسيادة.
2. التحول إلى مناهضة السياسة (Anti-Politics)
التحول الأساسي الذي يدرسه هذا الفصل هو تجاوز الشعبوية لمجرد مناهضة المؤسسة الحاكمة (Anti-establishment) لتصبح مناهضة للسياسة (Anti-politics). الشعبوية تتحدى التمثيل الديموقراطي القائم على الوساطة، وتسعى لإقصاء الأحزاب والمؤسسات كوسيط بين الشعب والزعيم.
إن هذا التحول يعني أن الشعبوية تسعى إلى تدمير النخبة القديمة باسم الديموقراطية الحقيقية أو "الأصيلة". هذه الحركات تستخدم آليات ديموقراطية (مثل الانتخابات والاستفتاءات) لـ"تشويهها"، وذلك عبر الإيحاء بأن الأغلبية المتحققة في الانتخابات تمثل إرادة الشعب بأكمله، بينما تعتبر المعارضة، والمؤسسات التي تضمن التعددية، عوائق يجب إزالتها.
يؤدي هذا الخطاب إلى تجريد أي معارضة أو أي جزء من المجتمع لا يتماشى مع رؤية الزعيم الشعبوي الموحدة من الشرعية، فإذا كان الزعيم الشعبوي يعتقد أنه يمثل "الشعب الحقيقي"، فإن من يخالفه لا يكون معارضاً سياسياً، بل يصبح جزءاً من "الأشرار"، ونتيجة لذلك، فإن النخب الشعبوية لا تقدم بالضرورة حلاً أيديولوجياً، بل تقدم هجوماً أخلاقياً.
3. إضعاف المؤسسات التمثيلية
تؤدي هذه النزعة إلى تفكيك الثنائية الديموقراطية الدستورية التي تفصل بين السلطات وتضمن التوازن. إذ أن الديموقراطية التمثيلية تتطلب التعددية. أما الشعبويون، فيرون أنفسهم حركة رأي واحتجاج قادرة على بناء الإرادة الجماعية وتوحيد الشعب تحت راية الزعيم.
الفصل الثاني
يتناول الفصل الثاني المعنون "الشعب الحقيقي وأغلبيته"، التحليل العميق للكيفية التي تستغل بها الحركات الشعبوية مفهومي "الشعب" و"الأغلبية" لتحويل أسس الديموقراطية التمثيلية. حيث الشعبوية ليست مجرد مناهضة لـ"مؤسسة الحكم" (كما في الفصل الأول)، بل هي تأويل راديكالي (أو "تشويه" في الواقع) للعلاقة بين الشعب والديموقراطية، تضرب بجذورها في تأويلات "الشعب" و"الأغلبية".
أولاً: مفهوم الشعب بين السيادة والتجريد
تدعي الشعبوية أنها تمثل "الشعب الحقيقي" (The Real People)، وهو مفهوم تجريدي. في هذا السياق، تحتفظ الشعبوية بمصطلح "الشعب" (populus)، بينما يتناغم هذا المفهوم مع فكرة "الأمة". الشعبوية تبني خطابها على أن هذا الشعب قد تُرك وتعرّض للإهمال، وتجعل منه قوة ذاتية متجانسة.
1. ثنائية الصراع الأخلاقي: الشعب الصالح مقابل الأشرار
تعتمد الرؤية الشعبوية على إطار تفسيري يقوم على الانقسام الأخلاقي للمجتمع إلى جماعتين متناحرتين: "الشعب الصالح" الذي يمثله الزعيم، و"الأقلية المنفذة الفاسدة" أو "الأشرار" الذين يحكمون. الشعبوية بذلك لا تقدم بالضرورة أيديولوجيا شاملة، بل تُصوَّر في كثير من الأحيان على أنها "أيديولوجيا هزيلة أخلاقية" (thin moral ideology)، حيث تستمد قوتها من نقد النخبة على أساس أخلاقي وليس على أساس برنامج سياسي عميق.
2. التمثيل بالجزء للكل (Pars Pro Toto)
إن الخطر الجذري يكمن في كيفية تفسير الشعبوية لمفهوم التمثيل:
* الشعبوية لا تقول بأنها تمثل الكل، بل تمثل الجزء (meros) الذي يطالب بتمجيد نفسه ليمثل الكل (latreia).
* عندما ينجح الزعيم الشعبوي في الانتخابات، فإنه لا يعترف بأنه يمثل أغلبية خاصة، بل يزعم أنه يمثل إرادة الشعب بأكمله (الشعب الحقيقي).
* هذا التحويل يعني تجريد أي مجموعة أو جزء من المجتمع لا يتفق مع رؤية الزعيم الشعبوي من الشرعية. فإذا كان الزعيم يمثل "الشعب الحقيقي"، فإن المعارضين هم بالضرورة من "الأشرار" الذين يعملون ضد مصلحة الأمة، وبالتالي لا يُنظر إليهم كمعارضة سياسية مشروعة.
ثانياً: الشعبوية وتشويه مبدأ الأغلبية الديموقراطي
في الديموقراطية التمثيلية، يجب أن يراقب حكم الأغلبية بضوابط تضمن حقوق الأقليات والتعددية. أما الشعبوية، فتستخدم مفهوم الأغلبية بطريقة مفرطة (Majoritarianism) تسعى إلى إلغاء التعددية.
1. إلغاء التعددية وتوحيد الإرادة
تؤكد أوربيناتي أن الشعبوية هي دعوة تتعلق بوحدة الأغلبية. إنها تسعى إلى توحيد إرادة الشعب وجماعة المواطنين تحت راية زعيم واحد.
* تتناقض الشعبوية مع الديموقراطية الليبرالية التي تفترض التنافس المفتوح على السلطة.
* الشعبويون يرفضون القواعد التي تفرض قيوداً على إرادة الأغلبية. هذا يعني أن الشعبوية تعادي الليبرالية الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية وتداول السلطة.
2. الانتخابات كآلية شعائرية
بالنسبة للشعبوية، تتحول الانتخابات من أداة تنافسية لتبادل الآراء وتشكيل الأغلبيات والأقليات إلى مجرد "شعيرة" يتم استخدامها لتحقيق هدف واحد: توحيد الأصوات خلف الزعيم وإثبات شرعية "الشعب الصالح".
* إنها لا تهدف إلى التعبير عن التعددية، بل إلى تجريم أو إقصاء أي صوت معارض.
* هذا الاستخدام للانتخابات يسمح بتحويل الديموقراطية التمثيلية إلى ما يُسمى "ديموقراطية غير ليبرالية" (Illiberal Democracy)، حيث يتم احترام مبدأ حكم الأغلبية شكلياً، لكن دون احترام الحقوق والحريات (المكونات الليبرالية).
3. أزمة ثنائية الحكم الديموقراطي (Duality of Rule)
تعتمد الديموقراطية التمثيلية على ثنائية الحكم التي تفصل بين السلطة السيادية للشعب (الإرادة) والسلطة التنفيذية للحكومة (الرأي والأحكام). تهدف الشعبوية إلى إلغاء هذه الثنائية، حيث يدعي الزعيم أنه يمثل الإرادة والقرار (الرأي) في آن واحد ومباشرة.
* السيادة المباشرة: الشعبوية تترجم السيادة الشعبية بطريقة مباشرة وغير ممثلة، متجاوزة المؤسسات الوسيطة (الأحزاب، البرلمان).
* هذا النمط يؤدي إلى وضع السلطة في يد شخص واحد أو أقلية منفذة (الزعيم ومساعدوه)، وتصبح القرارات المتخذة باسم الأغلبية قادرة على تجاوز القانون والدستور متى رأت ذلك ضرورياً لتحقيق إرادة "الشعب" الموحدة.
ثالثاً: المقارنة التاريخية والمنظور الأرسطي
يستعين الكتاب بمقاربات فكرية وتاريخية لتعميق فهم طبيعة هذا التحول:
* المقارنة الأرسطية: يستدعي الكتاب تحليلات أرسطو حول الأنظمة المختلطة (Mixed Regimes) والتحول بين الأغلبية والأوليغاركية (حكم القلة). يرى أرسطو أن تكوين طبقة وسطى قوية أمر ضروري للحفاظ على الديموقراطية. وفي المقابل، يظهر التحول الشعبوي عندما يحدث انهيار في التوازن الاجتماعي والسياسي.
* الحكم المختلط (Politeia): يمثل هذا المفهوم في الديموقراطية التمثيلية توازناً بين الأغنياء والفقراء، وبين النخب والمواطنين العاديين.
* في الجمهورية الرومانية القديمة، كان هناك تمييز بين (الديمنوس) و(البوبولوس). كان (البوبولوس) يشير إلى الشعب الموحد، لكن الحركات الشعبية كانت تسعى إلى تحقيق السيادة بالكامل.
يكشف الفصل الثاني عن أن الشعبوية تحول مفهوم "الشعب" من مفهوم مدني دستوري متمايز (يضم أغلبية وأقلية وحقوقاً فردية) إلى "كيان كلي متجانس" يتجسد في الزعيم. إنها تستخدم الأغلبية كقوة حاكمة (Kratos) لتوحيد المجتمع في إرادة واحدة، مما يتيح تشويه الإجراءات الديموقراطية D واستخدامها لتدمير الضوابط الداخلية، وبالتالي تحويل الديموقراطية الليبرالية إلى ديموقراطية أقل ليبرالية.
تشبيه توضيحي:
إذا كانت الديموقراطية الليبرالية (الدستورية) تشبه مجلس إدارة شركة حيث تتخذ القرارات بالأغلبية ولكن مع ضمان حقوق الأقليات والمساهمين الصغار (حقوق الأقليات)، فإن الشعبوية تحولها إلى نادي مشجعين يطيعون الزعيم، ويدّعون أن فوزهم يعني أنهم يمثلون إرادة كل المساهمين، معتبرين أن أي مخالفة لهذا الرأي ليست مجرد معارضة، بل خيانة لمصلحة النادي نفسه.
الفصل الثالث
يتناول الفصل الثالث المعنون "الزعيم وراء الأحزاب"، تحليلاً مفصلاً للدور المحوري الذي يلعبه الزعيم الكاريزمي في الحركة الشعبوية، وكيف تسعى هذه الحركات إلى تجاوز الأحزاب والمؤسسات السياسية التقليدية لتأسيس نمط حكم تمثيلي جديد يعتمد على التفويض المباشر.
أولاً: الزعيم الكاريزمي وإلغاء الوساطة الحزبية
يؤكد هذا الفصل أن ظاهرة الشعبوية الحديثة لا يمكن فصلها عن شخصية الزعيم الذي يتجاوز الإطار الحزبي التقليدي. تعتمد الشعبوية على "الذاتية الشعبوية"، حيث يتجمع الشعب تحت راية الزعيم. لا تقتصر وظيفة الزعيم على القيادة السياسية فحسب، بل على تجسيد إرادة الشعب الموحدة بالكامل.
1. العداء لـ "حكم الأحزاب" (Partitocrazia):
تتغذى الشعبوية على ضعف الأحزاب السياسية التقليدية أو تآكلها، إذ يرى الزعيم الشعبوي أن الأحزاب والمؤسسات هي مجرد "وساطة" بين الشعب وصاحب السيادة. في الديموقراطية التمثيلية التقليدية، تعتبر الأحزاب ضرورية لضمان التعددية والتحقيق العملي للإرادة السياسية، بينما في المنطق الشعبوي، تُوصف هذه الأحزاب بأنها أقلية منفذة فاسدة تعيق تحقيق إرادة "الشعب الصالح".
2. التجسيد (Incarnation) مقابل التمثيل (Representation):
الزعيم الشعبوي لا يكتفي بأن يكون ممثلاً عن الشعب، بل يسعى إلى تجسيده. ويدعم هذا الزعم تصوير الزعيم على أنه مخلص أو منقذ (المخلص)، يمتلك كاريزما تمكنه من إحياء الروح الجماعية، متجاوزاً الانقسامات الأيديولوجية أو الطبقية.
ثانياً: التفويض المباشر وتحويل التمثيل
يتمحور الخلاف الرئيسي في هذا الفصل حول نوع العلاقة بين الشعب وزعيمه. فالديموقراطية التمثيلية التقليدية تقوم على التمثيل الائتماني (Fiduciary Representation)، حيث يمارس الممثل المنتخب حكماً مستقلاً ورأياً خاصاً لخدمة المصلحة العامة، بينما يطالب الزعيم الشعبوي بـالتمثيل التفويضي (Mandated/Delegative Representation):
1. التفويض المطلق:
يسعى الزعيم الشعبوي إلى تحقيق علاقة مباشرة ومستمرة مع جماهيره. هذا التفويض لا يتقيد بالقيود التقليدية المفروضة على الممثلين، بل يهدف إلى توحيد الإرادة والصوت تحت راية الزعيم. ويعني ذلك أن الزعيم لا يكتفي بأغلبية الأصوات، بل يحتاج إلى توحيد الدعم الجماهيري الكامل لكي يظهر وكأنه لا يمثل جزءاً، بل الشعب بأسره.
2. إضعاف التنافس والتداول:
في المنظور الشعبوي، لا يتم التعامل مع الانتخابات كآلية لـ"التنافس" بين الأحزاب أو "التداول" السلمي للسلطة، بل كأداة لتأكيد شرعية الزعيم وتوحيد الأصوات. هذا يؤدي إلى إضعاف آليات المراقبة الديموقراطية، ويهدد بإفراغ القواعد الدستورية من محتواها، حيث يصبح الزعيم هو "الرغبة في الحكم" المطلقة والمباشرة.
3. استراتيجية "التخلص" والبراغماتية:
تعتبر الشعبوية هنا مشروعاً استراتيجياً. الزعماء الشعبويون يظهرون سلوكاً براغماتياً (برغماتياً) ويستخدمون خطاباً خلاصياً (خلاصياً). فبدلاً من تقديم أيديولوجيا متماسكة، يسعون إلى:
* تجنيد الجماهير عاطفياً بعيداً عن التنظيمات السياسية التقليدية.
* تقديم أنفسهم كمنقذين قادرين على تجاوز القواعد الدستورية والآليات الأساسية للحكومة (مثل البرلمان والبيروقراطية) من أجل تحقيق "إرادة الشعب" الموحدة.
ثالثاً: تحويل العلاقة بين الشعب والسياسة
يتحول مفهوم السياسة ذاته في ظل الهيمنة الشعبوية. فبدلاً من أن تكون السياسة مجالاً للتفاوض والتعددية، تصبح مسرحاً (مسرحاً) للأداء (الأداء المسرحي) والتواصل المباشر.
* الشفافية مقابل التعتيم: يزعم الزعيم الشعبوي الشفافية، لكن هذا الادعاء غالباً ما يكون مجرد دعاية شعبوية تهدف إلى إيهام الجمهور بأن الزعيم يعرف ويجسد رأيهم. في الواقع، يغيب دور المؤسسات التي تضمن التدقيق والمراقبة.
* إضعاف التنافس الحزبي: يعتمد نجاح الشعبوية على إضعاف الأحزاب الحالية المتنافسة، وإظهار أنهم جميعاً فاسدون أو عاجزون، مما يترك الساحة فارغة أمام الزعيم الذي يدعي أنه يمثل الجميع.
يؤكد الفصل الثالث أن الشعبوية تمثل تحدياً جوهرياً لآلية التمثيل الديموقراطي التقليدية عبر تقديم الزعيم كبديل للأحزاب. يسعى هذا الزعيم إلى إلغاء المسافة السياسية بين الحاكم والمحكومين (إلغاء الوساطة)، مقدماً نفسه على أنه تجسيد (تجسيد) لإرادة شعبية موحدة، مما يحوّل الديموقراطية التمثيلية من نظام يعتمد على توازن القوى المتنافسة إلى نظام يعتمد على تلبية مطالب قائد فردي كاريزمي.
الفصل الرابع
يتناول الفصل الرابع المعنون "التمثيل المباشر"، ذروة التحول الذي تحدثه الشعبوية في بنية الحكم، حيث يركز على الكيفية التي تحاول بها الحركات الشعبوية إلغاء الوسطاء التقليديين لتحقيق علاقة مباشرة وغير مقيدة بين الزعيم والجمهور.
يرى هذا الفصل أن الشعبوية، التي وصفها في المقدمة بأنها نمط جديد من أنماط الحكم التمثيلي المختلط، تقدم بديلاً جذرياً للديموقراطية التمثيلية التقليدية عبر الدعوة إلى "التمثيل المباشر".
أولاً: إلغاء الوساطة وتغيير طبيعة التمثيل
يتمحور جوهر الحجة في هذا الفصل حول رغبة الزعماء الشعبويين في تجاوز البنية الوسيطة (كالأحزاب والمؤسسات) لأنهم يرون في هذه المؤسسات عائقاً أمام تحقيق السيادة الشعبية بالكامل.
1. التحدي الجذري للتمثيل الائتماني:
في الديموقراطية التمثيلية، يمارس الممثل المنتخب حكماً يعتمد على التوازن والتفاوض والرقابة. لكن الشعبوية تتحدى هذا المبدأ، حيث يطالب الزعيم الشعبوي بعلاقة تقوم على التفويض (Delegation) بدلاً من التمثيل التقليدي. هذا التفويض يسمح للزعيم بتوحيد الإرادة والصوت، لكي يظهر وكأنه لا يمثل جزءاً، بل الشعب بأسره.
إن الهدف من التمثيل المباشر الذي تطالب به الشعبوية هو إلغاء قوة الوساطة، مما يجعل الزعيم في وضع يتيح له تجاوز المعايير والإجراءات الدستورية.
2. الزعيم كصوت أوحد:
الشعبوية تهدف إلى توحيد إرادة الشعب وجماعة المواطنين تحت راية الزعيم. عندما ينجح الزعيم المنتخب، فإنه لا يعترف بأنه مجرد ممثل للأغلبية، بل يدعي أنه يجسد الإرادة الجماعية، وأنه يتصرف "من أجل الشعب". هذا الإدعاء بتحويل التصور الإجرائي للسيادة إلى تصور تجسيدي/رمزي يُجيز للزعيم اتخاذ القرارات دون قيود مؤسسية.
ثانياً: الأدوات التكنولوجية ومفهوم "الجمهور المتلقي"
تعتمد الحركات الشعبوية المعاصرة على أدوات حديثة لتعزيز هذا النمط من الحكم المباشر.
1. تكنولوجيا تجاوز الأحزاب:
يشير الكتاب إلى أن الشعبوية تستخدم "الإنترنت" كوسيلة مبتكرة وتورية (تمويه) لإدارة الصراع. إن استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة مكّن هذه الحركات من تجنيد الدعم الجماهيري وتوجيه المعلومات إلى المواطنين العاديين، متجاوزة بذلك الهياكل التنظيمية التقليدية للأحزاب. هذا يعزز علاقة "الجمهور المتلقي" (audience democracy) بالزعيم، بدلاً من العلاقة التقليدية القائمة على التفاعل والمشاركة الحزبية.
2. رفض الانخراط في "مؤسسة الحكم":
إن الجمهور الذي يستجيب للخطاب الشعبوي يميل إلى رفض أن يتم تصنيفه ضمن أي تنظيم أو مجموعة. إنه يفضل أن يتعامل معه الزعيم مباشرة، خارج الإطار الذي تفرضه الأحزاب أو المجالس البرلمانية.
3. الانتخابات كـ"شعيرة":
في ظل التمثيل المباشر الذي تدعو إليه الشعبوية، تتغير وظيفة الانتخابات جذرياً. بدلاً من أن تكون عملية تنافسية تهدف إلى تشكيل أغلبية مؤقتة، تصبح "شعيرة" تهدف إلى تأكيد "التوحيد" خلف الزعيم. الزعماء الشعبويون يستخدمون الانتخابات كأداة لإثبات أن الأغلبية المتحققة هي إرادة "الشعب الصالح"، مما يضفي الشرعية على هجومهم على المؤسسات.
ثالثاً: تحويل الديموقراطية الليبرالية إلى ديموقراطية غير ليبرالية
يؤدي سعي الشعبوية نحو التمثيل المباشر إلى تحويل جوهري في طبيعة الديموقراطية نفسها، وهو ما يطلق عليه الكتاب مصطلح "التشويه".
1. إفراغ المؤسسات من محتواها:
الشعبوية لا تسعى بالضرورة إلى تدمير الديموقراطية، بل إلى تغيير طبيعتها من الداخل. من خلال إضعاف الضوابط المؤسسية والدستورية، يسعى الزعيم إلى تسهيل عملية تغيير القواعد القائمة أو تعديل الدستور. هذا التحول قد يجعل الديموقراطية "أقل ليبرالية" دون أن يجعلها بالضرورة "أقل ديموقراطية" في الظاهر.
2. الديموقراطية غير الليبرالية والأغلبية المطلقة:
يُفهم حكم الأغلبية في المنظور الشعبوي على أنه إرادة الشعب الموحدة وغير المقيدة. هذا الإفراط في التركيز على الأغلبية (Majoritarianism) يسمح بتهميش المعارضة والأقليات، التي تُعتبر جزءاً من "الأقلية المنفذة الفاسدة". إذاً، فالشعبوية هي دعوة إلى تغيير ماهية الحكم القائم الذي لا يرتكز على أساس طبقية أو مصالح اقتصادية، بل على أساس أخلاقي (الخير ضد الشر).
3. الانقسام الثنائي والديناميكية المتصدعة:
إن الشعبوية لا تعترف بوجود انقسام ديموقراطي صحي يضمن التنافس والتعددية. بل إنها تطمس الحكم الثنائي (Duality of Rule) الذي يفصل بين السلطة السيادية والسلطة الحاكمة. إنها تتبنى رؤية "أحادية" للسياسة، حيث يكون الزعيم هو الممثل الأوحد لإرادة "الشعب الحقيقي". هذا التحول يضع النظام السياسي برمته على "مسار تصادمي" مع المبادئ الدستورية الأساسية.
إذا كانت الديموقراطية التمثيلية التقليدية شبكة معقدة من القنوات المائية (المؤسسات والأحزاب) تضمن توزيع السلطة وتصريف المطالب عبر طرق آمنة ومدروسة، فإن التمثيل المباشر الشعبوي يشبه إلغاء هذه القنوات كلها، والسماح لـ"إرادة الشعب" (الماء) بالتدفق مباشرة عبر مسار واحد وعنيف (الزعيم)، مما يضمن وصولها بسرعة فائقة إلى مصدر القرار، ولكنه يهدد في الوقت ذاته بـإغراق البنية التحتية التي تحمي استقرار النظام (الدستور وحقوق الأقليات).
الخاتمة: طريق مسدود؟
إن الحجة الرئيسية التي قدمها الكتاب تتلخص في أن الشعبوية تستمد قوتها من تفكيك الثنائية الديموقراطية الدستورية التي تفصل بين "الإرادة" (السيادة الشعبية) و"الرأي" (الأحكام والقرارات التنظيمية). الشعبوية تسعى إلى دمج هذين المكونين في كيان واحد يتمثل في الزعيم، مدعيةً أنها تمثل الشعب بأكمله دون تجزئة أو وساطة.
أولاً: حصيلة التحدي الشعبوي: التوحيد الأخلاقي للسلطة
لقد أوضحت فصول الكتاب الأربعة الآليات التي تستخدمها الشعبوية لتغيير طبيعة الحكم الديموقراطي:
1. التحول من مناهضة المؤسسة إلى مناهضة السياسة:
بدأت الشعبوية كنزعة أخلاقية تهدف إلى محاربة "الأقلية المنفذة الفاسدة" أو "مؤسسة الحكم" (The Power Elite). ولكنها سرعان ما تطورت إلى "مناهضة للسياسة" (Anti-politics)، حيث أصبحت تستهدف البنى الوسيطة والتعددية السياسية (مثل الأحزاب والبرلمان). الخطاب الشعبوي لا يقدم أيديولوجيا متماسكة (بل هي "أيديولوجيا هزيلة أخلاقية") بقدر ما يقدم انقساماً أخلاقياً بين "الشعب الصالح" و"الأشرار".
2. إضفاء الطابع التجسيدي على الأغلبية:
تستخدم الشعبوية الأغلبية كقوة حاكمة (Kratos) لتكريس وحدة الإرادة. فالانتخابات بالنسبة للزعماء الشعبويين ليست عملية تنافسية لتداول السلطة، بل هي مجرد "شعيرة" يتم من خلالها تأكيد أن الأغلبية المتحققة تمثل "إرادة الشعب الحقيقي" بأكمله. هذا المنطق يؤدي إلى تجريد أي معارضة من الشرعية، باعتبارها جزءاً من "الأشرار" أو النخبة الفاسدة، وليس مجرد رأي سياسي مختلف.
3. هيمنة الزعيم والتمثيل المباشر:
يؤدي هذا التوحيد إلى جعل الزعيم هو التجسيد الوحيد للصوت والإرادة الشعبية، متجاوزاً بذلك الأحزاب والمنظمات. وتعمل الشعبوية على إلغاء المسافة بين الحاكم والمحكومين عبر التمثيل المباشر، مستفيدة من وسائل الإعلام الحديثة لتجنيد "الجمهور المتلقي" (audience democracy).
ثانياً: النتيجة النهائية: ديموقراطية "غير ليبرالية"
إن المحصلة النهائية لهذه الآليات هي تحويل الديموقراطية الليبرالية إلى ديموقراطية "غير ليبرالية" (Illiberal Democracy). إن الشعبوية في السلطة تحاول تحقيق هدفها المتمثل في استعادة "السيادة بالكامل"، وهو ما يتم عن طريق:
1. إفراغ المضمون الدستوري: لا تدمر الشعبوية الدستور علناً، بل تسعى إلى إضعاف الضوابط المؤسسية، مثل استقلال القضاء والرقابة البرلمانية، وتعديل القواعد القائمة متى رأت ذلك ضرورياً لتعزيز سلطة الزعيم.
2. أولوية الأغلبية المطلقة: تتبنى الشعبوية مبدأ نزعة الأغلبية المتطرفة (Majoritarianism)، التي لا ترحب بالتعددية أو بحماية حقوق الأقليات، بل ترى أن أي قيود على إرادة الأغلبية تعيق تحقيق سيادة الشعب.
بالمقارنة، يحرص الكتاب على التفريق بين الشعبوية والفاشية:
* الفاشية: هي نظام حكم قمعي يهدف إلى دمج الدولة والأمة في كيان واحد عبر تدمير التعددية السياسية بالكامل والقمع.
* الشعبوية: هي أسلوب سياسي يستخدم الانتخابات ويدعي التمسك بالديموقراطية، لكنه يمارس سلطة غير مقيدة تخفض من قيمة الليبرالية. إنها لا تسعى لتدمير الديموقراطية، بل تشويهها عبر تحويلها إلى ديموقراطية تعتمد على توحيد إرادة الشعب تحت زعيم.
ثالثاً: طريق مسدود للديموقراطية التمثيلية؟
تنتهي أوربيناتي إلى أن الشعبوية تضع الديموقراطية التمثيلية على مسار تصادمي مع مبادئها الدستورية. إن نجاح الشعبوية مشروط بقدرة الزعيم على تحويل سلطة الأغلبية على الشعب وأجزائه.
إن التحدي الذي تتركه الشعبوية أمام الديموقراطيين لا يكمن فقط في محاربة الزعماء الشعبويين، بل في إصلاح الديموقراطية التمثيلية نفسها لكي تكون قادرة على استيعاب مطالب الشعب العادي وتجديد الطبقة السياسية.
يجب على الديموقراطية الليبرالية أن تجد طريقة لإعادة بناء التوازن بين الممثلين والجمهور، وإعادة بناء ثقة المواطنين في الوساطة السياسية التي تضمن الفصل بين الإرادة (التي لا تتجزأ) والرأي (الذي يتعدد).
وخلاصة القول، فإن الشعبوية تستمر في الوجود كقوة سياسية ما دامت تستغل فجوة التمثيل الناتجة عن تآكل الأحزاب السياسية وفشل النخب التقليدية في تلبية مطالب "الشعب الصالح". إنها ليست حلاً نهائياً، ولكنها مؤشر على أزمة عميقة تتطلب من الديموقراطيات الدفاع عن قيمها الليبرالية والدستورية.
لتوضيح هذا المسار المتصدع:
يمكن تشبيه الديموقراطية الدستورية بأنها مسطرة قياس (Measure) محددة بضوابط صارمة (كالقانون والدستور). إن الشعبوية لا تحاول كسر هذه المسطرة، بل تعيد تعريف وحدات القياس الخاصة بها، بحيث يصبح "الجزء" (الزعيم والأغلبية المؤيدة) قادراً على قياس "الكل" (الشعب) وتوجيهه، متجاوزة الضوابط التي تفرضها القواعد القديمة. وهذا التحول يجعل النظام قادراً على تحقيق رغبات الزعيم بسرعة، لكنه في الوقت ذاته يفقده التوازن اللازم للبقاء مستقراً وليبرالياً.


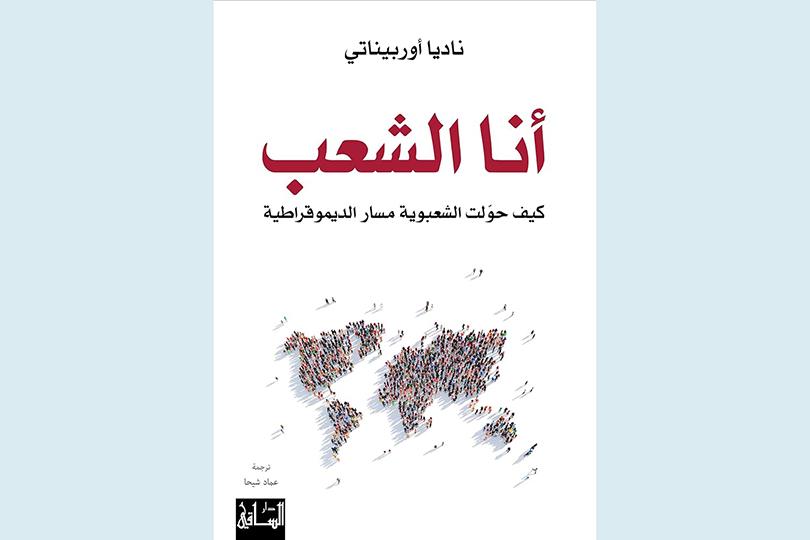

اضف تعليق