كظاهرة أنطولوجية هل التشيؤ مجرد نتاج للرأسمالية، أم أنه يعكس ميلًا إنسانيًا أعمق نحو تحويل الأفكار المجردة إلى أشياء ملموسة، والعلاقات السائلة إلى هياكل صلبة؟ قد تكون الرأسمالية هي النظام الذي أطلق العنان لهذه النزعة وعممها إلى أقصى حدودها، لكن جذورها قد تكون أعمق في بنية الوعي الإنساني نفسه...
بقلم: أ.د. إحسان علي الحيدري، أستاذ فلسفة الدين والأخلاق بكلية الآداب في جامعة بغداد
صدرَ كتابُ الدكتور علي أسعد وطفة بعنوان "من الاغتراب إلى التشيّؤ: الاغتراب في منظور كارل ماركس" في الدوحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2025. ويُعد الدكتور علي أسعد وطفة، مؤلف هذا الكتاب، أحد أبرز الأكاديميين العرب المعاصرين في مجال علم الاجتماع النقدي. ولفهم عمق هذا العمل، لا بد من وضعه في سياق مسيرته الفكرية ومشروعه النقدي الأوسع.
الخلفية الأكاديمية: انطلقت مسيرة الدكتور وطفة الأكاديمية من جامعة دمشق، حيث حصل على ليسانس في الفلسفة وعلم الاجتماع، ثم توجت بحصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي من جامعة كان (Caen) في فرنسا عام 1988. هذا التخصص في علم الاجتماع التربوي يمثل مدخلًا أساسيًا لفهم اهتمامه العميق بالقضايا النقدية المتعلقة بالسلطة، والقمع، والاغتراب داخل المؤسسات الاجتماعية، وفي مقدمتها المؤسسة التربوية.
المشروع الفكري: يتسم المشروع الفكري للدكتور وطفة بأنه مشروع نقدي متعدد الروافد، يستمد أدواته من العلوم الإنسانية، والفلسفة، والترجمة. ويظهر اهتمامه المحوري بقضايا الاغتراب، والاستلاب، والتنوير، ونقد السلطة جليًّا في عناوين مؤلفاته وأبحاثه المنشورة، ومنها: "بنية السلطة وإشكالية التسلّط التربوي في الوطن العربي"، و"الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة"، و"الدور الاستلابي للتلقين في الجامعات العربية". يتضح من هذه المسيرة الفكرية أن اهتمامه بماركس ليس مجرد اهتمام تاريخي، بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع نقدي أوسع يهدف إلى تحليل ظواهر "الاستلاب" و"الاغتراب" في السياق العربي المعاصر. فكتابه عن ماركس هو بمثابة عودة إلى الأصول النظرية لأدوات النقد التي يستخدمها في تحليلاته الأخرى، مقدمًا لقرائه الأساس النظري الذي ينطلق منه في نقد الواقع التربوي والاجتماعي العربي.
دوره كمؤسس: يتجاوز دور وطفة الجانب الأكاديمي البحت، ليمتد إلى الفعل الثقافي المنظم. فهو مدير "مركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية" ورئيس تحرير مجلته المحكّمة، مما يضعه في قلب حركة فكرية عربية معاصرة تهدف إلى "التحرّر ممّا هو ميّت أو متخشّب في كياننا العقليّ وإرثنا الثقافيّ".
الجوائز والتقدير: حظي الدكتور وطفة بتقدير أكاديمي رفيع، حيث نال عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزة الباحث المتميز من جامعة الكويت، وجائزة حميد بن راشد للعلوم الاجتماعية، مما يؤكد مكانته البارزة في الحقل الأكاديمي العربي.
تحليل مقدمة الكتاب وتحديد أهدافه المركزية
تضع مقدمة الكتاب الإطار المنهجي والنظري الذي سيحكم الدراسة بأكملها، وتكشف عن الأطروحة المركزية للمؤلف.
الأطروحة المركزية: تتمثل الحجة الأساسية للدكتور وطفة في أن مفهوم "التشيؤ" (Reification) ليس مجرد مرادف لمفهوم "الاغتراب" (Alienation)، بل هو "التجسيد السوسيولوجي الأعمق" و"الأداة المنهجية" الأكثر دقة وفعّالية لتحليل الرأسمالية ونقدها. يرى المؤلف أن مفهوم التشيؤ يتجاوز الطابع الفلسفي المجرد للاغتراب، مقدمًا أداة تحليلية أكثر قدرة على مقاربة الظواهر الاجتماعية بشكل إمبريقي. يسعى وطفة من خلال هذا التمييز إلى "سوسيولوجيا" النقد الماركسي، أي نقله من حقل الفلسفة المجردة إلى حقل علم الاجتماع القابل للتطبيق.
دور لوكاتش المحوري: يبرز وطفة الدور الحاسم للمفكر المجري جورج لوكاتش، الذي يعدّه الشخصية المحورية التي أعادت اكتشاف مفهوم التشيؤ وبلورته من داخل أعمال ماركس نفسه، ولا سيما عبر ربطه بمفهوم "صنمية السلعة" (Commodity~Fetishism). هذا التركيز على لوكاتش يوضح أن الكتاب لا يقدم ماركس فقط، بل يقدم التقليد الماركسي النقدي الذي رأى في التشيؤ مفهومًا مركزيًا.
الأهداف المعلنة: يختتم وطفة مقدمته بتحديد ستة أهداف واضحة لدراسته، تتلخص في تقديم تصور واضح عن المفهومين، وتأصيلهما فلسفيًا وسوسيولوجيًا، وتقصي تجليات التشيؤ في علاقات الإنتاج والتسليع، وتحديد صيغه الأربع، وصولًا إلى صياغة رؤية نقدية معاصرة للنظرية الماركسية في ضوء تحولات النظام الرأسمالي الجديد.
تفكيك بنية الكتاب
يقدم الكتاب تحليلًا منهجيًا متدرجًا، ينتقل من السياق التاريخي والفكري لماركس إلى تفكيك أعمق لمفاهيمه المركزية، ثم إلى نقدها وتقييم راهنيتها.
الفصل الأول: "ماركس: عرّاب النظام الرأسمالي"
في هذا الفصل التمهيدي، يؤسس وطفة لصورة ماركس ليس كفيلسوف أو اقتصادي فحسب، بل كأحد الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع. يتم التركيز بشكل خاص على أطروحته الحادية عشرة حول فويرباخ، التي تلخّص دعوته لتحويل الفلسفة من مجرد "تفسير العالم" إلى السعي من أجل "تغييره"، وهو ما يمثل جوهر الروح النقدية لعلم الاجتماع. يستعرض الفصل المصادر الفكرية الثلاثة التي شكّلت نظرية ماركس: الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (هيغل وفويرباخ)، والاقتصاد السياسي الإنكليزي (آدم سميث وديفيد ريكاردو)، والاشتراكية الطوباوية الفرنسية (سان سيمون وفورييه). ويختتم الفصل بتأكيد التأثير الهائل والزلزال الفكري الذي أحدثه ماركس، مستشهدًا بمقولة فرانسيس وين بأن "تاريخ القرن العشرين هو تراث ماركس"، مما يهيئ القارئ لأهمية الأفكار التي سيتم تناولها.
الفصل الثاني: "في مفهوم الاغتراب"
يؤصّل هذا الفصل لمفهوم الاغتراب فلسفيًا وتاريخيًا. يبدأ وطفة بتعريف الاغتراب كحالة انشطار بين "الوجود" الفعلي للإنسان و"جوهره" أو ماهيته الحقيقية ككائن حر ومبدع. ثم يتتبع المسار التاريخي للمفهوم، بدءًا من هيغل، الذي رأى الاغتراب كانفصام بين الوعي الذاتي والوعي الاجتماعي، مرورًا بتلميذه لودفيغ فويرباخ، الذي نقل المفهوم إلى حقل الدين، محللًا "الاغتراب الديني" كعملية يسقط فيها الإنسان أفضل صفاته على كائن إلهي خارجي ثم يخضع لعبادته. المحطة الحاسمة في هذا الفصل هي تحليل الكيفية التي استوعب بها ماركس هذا الإرث الفلسفي و"قلبه رأسًا على عقب". فقد أخرج ماركس مفهوم الاغتراب من عالم الأفكار المثالي (عند هيغل) ومن عالم اللاهوت (عند فويرباخ) ليرسيه في "الواقع الحي لحياة الناس وإنتاجهم". وفقًا لماركس، فإن الاغتراب الاقتصادي، الناجم عن علاقات الإنتاج الرأسمالية، هو الأساس المادي الذي تنشأ عنه كل أشكال الاغتراب الأخرى (السياسي، الديني، الاجتماعي).
الفصل الثالث: "من مفهوم الاغتراب إلى مفهوم التشيؤ"
يمثل هذا الفصل النقلة المنهجية التي بنى عليها الكتاب أطروحته. يبدأ وطفة بتقديم تعريف دقيق للتشيؤ بأنه "تحوّل العلاقات بين البشر إلى ما يشبه العلاقات بين الأشياء"، أي معاملة الناس كأدوات أو موضوعات جامدة. ولتجسيد هذا المفهوم، يستعرض المؤشرات التي وضعتها الفيلسوفة مارثا نوسباوم لتحديد الإنسان "المُشيَّأ"، مثل الأداتية (معاملة الشخص كأداة)، والملكية (معاملته كشيء يمكن امتلاكه)، والمؤشرات التي أضافتها راي لانغتون مثل الاختزال الجسدي. النقطة المحورية في الفصل هي إبراز الدور التأسيسي لجورج لوكاتش، الذي يرى وطفة أنه أول من أعطى المفهوم "صبغته السوسيولوجية" في كتابه "التاريخ والوعي الطبقي". لقد ربط لوكاتش التشيؤ بشكل مباشر بمفهوم ماركس عن "صنمية السلعة"، موضّحًا كيف أن بنية السوق الرأسمالي تؤدي حتمًا إلى تشيؤ الوعي والعلاقات الإنسانية. ويخلص الفصل إلى أن ماركس نفسه، على الرغم من عدم استخدامه للمصطلح إلا نادرًا، فإن مفهوم التشيؤ كان كامنًا في عمق تحليلاته، ولا سيما في "مخطوطات 1844" وفي تحليله للسلعة في كتاب "رأس المال"، مما يجعل عمل لوكاتش استخراجًا وتطويرًا لكنز مدفون في الفكر الماركسي.
الفصل الرابع: "رأسمالية التشيؤ"
يُعد هذا الفصل هو القلب التحليلي للكتاب، حيث يقوم وطفة بتفكيك آليات التشيؤ في مختلف مفاصل النظام الرأسمالي.
1- تشيؤ علاقات الإنتاج: يوضح المؤلف كيف أنه في ظل اقتصاد السوق، لا يتفاعل المنتجون مع بعضهم البعض بشكل مباشر كبشر، بل يتفاعلون من خلال منتجاتهم (السلع). وهكذا، فإن العلاقات الاجتماعية بين الناس تتخذ "الشكل الوهمي لعلاقة بين الأشياء". العلاقة بين الخبّاز والحدّاد لا تظهر كعلاقة إنسانية، بل كعلاقة تبادلية بين الخبز والحديد، محكومة بقوانين السوق الموضوعية والعمياء.
2- العمل والتشيؤ: هنا يتم تحليل كيف أن العمل، الذي يفترض أن يكون تعبيرًا عن جوهر الإنسان، يصبح في الرأسمالية قوة غريبة عنه. يستشهد وطفة بمقولة ماركس الشهيرة: "انخفاض قيمة الإنسان يتناسب عكسًا مع القيمة المتزايدة لعالم الأشياء". فالعامل لا ينتج السلع فحسب، بل "ينتج نفسه والعامل كسلعة"، حيث تُباع قوة عمله في السوق وتخضع لقانون العرض والطلب.
3- التسليع وصنمية السلعة: يحلل هذا القسم بعمق مفهوم "صنمية السلعة". السلعة في السوق الرأسمالي ليست مجرد شيء مادي، بل هي "شيء غامض" يخفي وراءه العلاقات الاجتماعية الاستغلالية التي أنتجته. تبدو قيمة السلعة وكأنها خاصية طبيعية فيها، بينما هي في الحقيقة نتاج للعمل الإنساني المستلب. هذا "الصنم" (السلعة) يسيطر على منتجيه ويحكم حياتهم، مما يمثل ذروة التشيؤ.
4- القيمة الاستعمالية والتبادلية: يوضح وطفة أن جوهر التشيؤ يكمن في هيمنة القيمة التبادلية (سعر السلعة في السوق) على القيمة الاستعمالية (فائدتها الفعلية لتلبية حاجة إنسانية). يصبح الهدف من الإنتاج ليس إشباع الحاجات، بل تحقيق الربح وتراكم رأس المال، أي تحقيق القيمة التبادلية، حتى لو كان ذلك على حساب الحاجات الإنسانية الحقيقية.
5- الصيغ الأربع للتشيؤ (الاغتراب): يختتم الفصل بتفصيل الأبعاد الأربعة للاغتراب التي حللها ماركس، والتي يعدّها وطفة تجليات للتشيؤ:
أ- اغتراب العامل عن منتجات عمله: المنتج الذي يصنعه العامل لا يعود ملكًا له، بل يصبح قوة غريبة عنه يملكها الرأسمالي.
ب- الاغتراب عن فعل الإنتاج: عملية العمل نفسها تصبح قسرية ومملة، وليست نشاطًا حرًا ومبدعًا.
ج- الاغتراب الاجتماعي عن الآخرين: تتحول العلاقات بين البشر في ظل المنافسة الرأسمالية إلى علاقات أداتية ومصلحية.
د- اغتراب الإنسان عن جوهره الإنساني: يفقد الإنسان جوهره ككائن مبدع وحر، ويختزل وجوده إلى مجرد أداة في عملية الإنتاج.
الفصل الخامس: "رؤية نقدية في نظرية ماركس الاغترابية"
يقدم هذا الفصل تقييمًا نقديًا لأفكار ماركس، محاولًا تحديد ما بقي صالحًا وما تجاوزه الزمن.
1- ماركس مقابل الماركسية: يبدأ وطفة بتمييز ضروري بين فكر ماركس نفسه، الذي كان مفعمًا بالقيم الإنسانية والدعوة للتحرر، وبين "الماركسية" كأيديولوجيا دولة في الأنظمة الشمولية (مثل الستالينية)، والتي ارتكبت جرائم فظيعة باسمه. يبرّئ وطفة ماركس من مسؤولية هذه الممارسات الاستبدادية.
2- سقوط التنبؤات وهيمنة الرأسمالية: يناقش الفصل النقد الشائع الموجّه لماركس، وهو عدم تحقق نبوءته بانهيار الرأسمالية في مراكزها الصناعية المتقدمة (بريطانيا، فرنسا). وبدلًا من ذلك، أثبتت الرأسمالية قدرة هائلة على التكيّف وتجاوز أزماتها المتكررة.
3- "الرأسمالية تحفر قبرها": على الرغم من النقطة السابقة، يجادل وطفة بأن نبوءة ماركس حول التناقضات الداخلية للرأسمالية لم تسقط بالكامل. فهو يرى في الأزمات المالية الدورية (مثل أزمة 2008) وفي التفاوت الهائل وتقاطب الثروة المتزايد في العالم، دليلًا على أن الرأسمالية ما زالت تنتج العوامل التي تهدد استقرارها على المدى الطويل.
4- التحولات في النظام الرأسمالي: يقر وطفة بأن الرأسمالية المعاصرة، أو "النيوليبرالية"، تختلف جذريًا عن رأسمالية القرن التاسع عشر. فالثورة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وعولمة الأسواق، وتحول طبيعة الطبقة العاملة من عمال المصانع إلى عمال المعرفة والخدمات، كلها متغيرات لم تكن في حسبان ماركس، وتتطلب تحديثًا لأدوات التحليل النقدي.
الفصل السادس والخاتمة: "راهنية ماركس" واستنتاجات المؤلف
في القسم الأخير من الكتاب، يجمع وطفة خيوط تحليله ليقدم تقييمًا نهائيًا لقيمة الفكر الماركسي اليوم.
1- راهنية ماركس: يخلص وطفة إلى أن جوهر تحليل ماركس يظل صالحًا وراهنًا. فعلى الرغم من كل التحولات، ما زالت الرأسمالية في جوهرها نظامًا "يحول الإنسان إلى مادة خام قابلة للتصنيع والتسويق". فآليات التشيؤ والتسليع والاستغلال لم تختفِ، بل تطورت واتخذت أشكالًا جديدة أكثر تعقيدًا.
2- نقد النظرية الماركسية: يقدم وطفة ملخصًا للنقود الموجهة للماركسية، ومنها: التركيز المفرط على العامل الاقتصادي وإهمال العوامل الثقافية والنفسية، والتوظيف الأيديولوجي للنظرية لخدمة مصالح سياسية، وصعوبة تطبيقها عمليًا في تحليل المجتمعات المعاصرة المعقدة.
3- الخاتمة: في الختام، يؤكد وطفة أن نظرية ماركس الاغترابية، ولا سيما من خلال مفهوم التشيؤ، ما زالت تمثل "طاقة فكرية منهجية تحليلية ليس لها بديل في دراسة النظام الرأسمالي". ويشير إلى أن التشيؤ اليوم لم يعد يقتصر على المصنع، بل امتد ليصيب "أعماق الروح والوعي والإرادة"، مما يجعل الحاجة إلى هذا النقد الماركسي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
الجزء الثاني: مراجعة نقدية ومقاربات معاصرة
القسم الثالث: تقييم نقدي للكتاب
يقدم كتاب الدكتور علي أسعد وطفة مساهمة قيّمة في المكتبة العربية، ويمكن تقييمه من خلال تحديد نقاط قوته وجوانبه التي تفتح الباب لمزيد من النقاش النقدي.
نقاط القوة
1- الوضوح المنهجي والبيداغوجي: يتميز الكتاب بقدرة فائقة على تبسيط وتقديم مادة فلسفية واجتماعية معقدة بأسلوب أكاديمي منظّم وواضح. إن تدرّجه من السياق التاريخي إلى التعريفات الفلسفية، ثم إلى التحليل السوسيولوجي، يجعله مدخلًا مثاليًا للقارئ العربي غير المتخصص لفهم جوهر النقد الماركسي.
2- مركزية مفهوم "التشيؤ": يمثل تركيز الكتاب على مفهوم "التشيؤ" وتمييزه عن "الاغتراب" إضافة نوعية. فبينما تناولت الكثير من الكتابات العربية مفهوم الاغتراب بشكل عام وفلسفي، فإن هذا الكتاب يقدم "التشيؤ" كأداة تحليلية سوسيولوجية محددة، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث الإمبريقي المستلهم من الماركسية.
3- التأصيل الفلسفي المتين: تكمن إحدى أبرز نقاط قوة الكتاب في تتبعه الدقيق للجذور الفلسفية للمفهومين في الفكر الألماني الكلاسيكي (هيغل وفويرباخ). هذا التأصيل يوفّر للقارئ سياقًا فكريًا عميقًا، ويوضّح أن فكر ماركس لم ينشأ من فراغ، بل كان حوارًا نقديًا وتجاوزًا لإرث فلسفي عظيم.
نقاط الضعف المحتملة (محاور للنقاش النقدي)
1- الأصالة مقابل التجميع: يمكن القول إن الكتاب، على الرغم من تميّزه في العرض والتحليل، لا يقدم أطروحة جديدة كليًا في حقل الدراسات الماركسية العالمية. فالكثير من أفكاره، ولا سيما التركيز على التشيؤ ودور لوكاتش، تمثل شرحًا وتجميعًا متميزًا لأدبيات موجودة بالفعل في تقليد الماركسية الغربية ومدرسة فرانكفورت. لكن قيمته تكمن في تقديمه لهذا التقليد ببراعة للقارئ العربي.
2- غياب الحوار مع ما بعد الماركسية: يركّز الكتاب بشكل شبه حصري على الماركسية الكلاسيكية والماركسية النقدية (مدرسة فرانكفورت). ويلاحظ غياب الحوار مع التيارات الفكرية اللاحقة، مثل ما بعد البنيوية وما بعد الماركسية (ميشيل فوكو، جيل دولوز، جان بودريار)، التي قدمت تحليلات مختلفة ومؤثرة للسلطة، والاستهلاك، والمجتمع المعاصر، والتي كان من شأن الحوار معها إثراء النقاش حول راهنية ماركس.
3- طبيعة الرؤية النقدية: في الفصل الخامس، وعلى الرغم من عنوانه "رؤية نقدية"، فإن النقد الذي يقدمه وطفة لماركس يبدو أقرب إلى "التحديث" و"التكييف" منه إلى النقد الجذري. فهو يدافع عن جوهر النظرية مع الإقرار بضرورة تعديلها لتناسب العصر، وهو موقف مشروع، لكنه قد لا يفي بوعد "النقد" العميق الذي قد يتوقعه بعض القرّاء.
وجهة نظر نقدية شاملة
في المحصلة، يُعد كتاب "من الاغتراب إلى التشيؤ" عملًا بيداغوجيًا وتحليليًا من الطراز الرفيع. تكمن مساهمته الكبرى في نجاحه بتقديم مدخل منهجي وعميق لفهم جوهر النقد الماركسي للرأسمالية من خلال عدسة "التشيؤ" التحليلية. إنه ينجح في تكييف هذا التقليد النقدي الأوروبي المعقّد وتقديمه بوضوح وجاذبية للقارئ العربي، مما يجعله مرجعًا أساسيًا للطلاب والباحثين المهتمين بالنظرية الاجتماعية النقدية.
القسم الرابع: مقاربة نقدية بين محتوى الكتاب والواقع المعيش
تتجلّى راهنية تحليل ماركس، كما قدّمه وطفة، عند تطبيقه على الظواهر المعاصرة التي لم يعاصرها ماركس نفسه. فالتكنولوجيا الحديثة لم تلغِ التشيؤ، بل عمّقته وغيّرت طبيعته، ناقلة إياه من حقل العمل الجسدي إلى حقل العمل الذهني والحياة الاجتماعية الرقمية.
التشيؤ في عالم العمل المعاصر: ما بعد المصنع
لقد انتقل التشيؤ من خط تجميع المصنع إلى شاشات الحواسيب وخوارزميات المنصات الرقمية.
1- اقتصاد المنصات (Gig Economy): في تطبيقات مثل "أوبر" أو "طلبات"، يتحول العامل إلى مجرد "شيء" أو نقطة بيانات ضمن خوارزمية تدير عمله وتقيمه وتحدد أجره. علاقته بالشركة مُشيّأة بالكامل، مجردة من أي بعد إنساني أو تعاقدي تقليدي. هذا يمثل تجسيدًا مثاليًا لـ"تشيؤ علاقات الإنتاج" في العصر الرقمي.
2- العمل عن بُعد والذكاء الاصطناعي: أدى انتشار العمل عن بعد، الذي تسارع بفعل الجائحة، إلى زيادة "الاغتراب الاجتماعي" عبر عزل الموظفين عن زملائهم وتحويل التفاعل الإنساني إلى اجتماعات افتراضية. كما أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل لا يهدد فقط باستبدال العمال، بل بتشييئ العمل المتبقي. فالعامل البشري الذي يشرف على نظام ذكاء اصطناعي قد يجد نفسه مغتربًا عن مهاراته وقدرته على اتخاذ القرار، متحولًا إلى مجرد مساعد للآلة.
3- تشيؤ العمل المعرفي: حتى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، يعاني العاملون "الذهنيون" مثل المبرمجين من اغتراب عميق. فهم ينتجون قيمة هائلة (أكواد برمجية، خوارزميات) تُستلب منهم فورًا لتتحول إلى رأس مال للشركات الكبرى. وعلى الرغم من أن عملهم إبداعي، إلا أنه غالبًا ما يتم تجزئته إلى مهام صغيرة ومتكررة، مما يجعل المبرمج مغتربًا عن المنتج النهائي، تمامًا كعامل خط التجميع في عصر ماركس. لقد تحول التشيؤ من "تشيؤ الجسد" إلى "تشيؤ العقل".
صنمية السلعة في العصر الرقمي وثقافة الاستهلاك
تجاوزت صنمية السلعة حدود المنتجات المادية لتشمل الهوية الرقمية والتجارب الافتراضية.
1- وسائل التواصل الاجتماعي وصنمية "الذات": لقد حوّلت منصات مثل إنستغرام وتيك توك "الذات" الإنسانية إلى سلعة قابلة للعرض والتسويق. أصبحت "اللايكات" و"المتابعون" و"المشاهدات" هي القيمة التبادلية المجردة التي يقاس بها نجاح الفرد وقيمته. هذا يؤدي إلى تشيؤ العلاقات الإنسانية (حيث يصبح الأصدقاء "جمهورًا") واغتراب الفرد عن ذاته الحقيقية في سعيه لإنتاج صورة مثالية قابلة للاستهلاك.
2- ثقافة الاستهلاك المعاصرة: بالاستناد إلى تحليلات مدرسة فرانكفورت وجان بودريار، لم يعد الاستهلاك اليوم يتعلق بتلبية الحاجات (القيمة الاستعمالية)، بل باستهلاك الرموز والعلامات التجارية التي تمنح الفرد مكانة اجتماعية (القيمة التبادلية الرمزية). هذا يعمّق "صنمية السلعة" التي تحدث عنها ماركس، حيث لا نعود نرى المنتج نفسه بقدر ما نرى "الماركة" التي تغلفه وتمنحه قيمته السحرية.
دراسة حالة - الواقع العراقي المعيش (كمثال تطبيقي)
يمكن استخدام الإطار التحليلي للكتاب لفهم بعض جوانب الواقع المعيشي في العراق المعاصر، الذي يمثل نموذجًا مركبًا للاغتراب والتشيؤ.
1- اقتصاد ريعي واغتراب هيكلي: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على صادرات النفط، وهو قطاع كثيف رأس المال وقليل العمالة. هذا يخلق اغترابًا هيكليًا واسع النطاق، حيث أن غالبية السكان، بمن فيهم موظفو القطاع العام الضخم، مغتربون عن عملية الإنتاج الحقيقية للثروة الوطنية. الوظائف الحكومية، التي غالبًا ما تفتقر إلى الإنتاجية الحقيقية، تولد شعورًا عميقًا باللامعنى وفقدان القيمة، وهو أحد أبعاد الاغتراب التي حددها ملفن سيمان.
2- بطالة الشباب والاغتراب عن المستقبل: يواجه الشباب العراقي، ولا سيما الخريجين، تحديات هائلة في سوق العمل، مع دخول مئات الآلاف سنويًا إلى سوق لا يستطيع استيعابهم. هذا الافتقار إلى فرص العمل اللائقة يخلق اغترابًا عميقًا عن المجتمع وعن المستقبل، ويجعل الشعور بالعجز وانعدام القوة سائدًا.
3- ثقافة الاستهلاك المستوردة: في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية، تحول المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي بامتياز، يعتمد على استيراد السلع وأنماط الحياة. هذا يخلق "صنمية سلعة" مضاعفة، حيث لا يتم فقط تقديس السلع، بل تقديس كل ما هو "أجنبي"، مما يؤدي إلى اغتراب ثقافي وتآكل الهوية المحلية.
4- الاغتراب الاجتماعي في الفضاء الرقمي: تشير الدراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، على الرغم من دورها في التواصل، قد فاقمت من العزلة الاجتماعية وتآكل العلاقات التقليدية، وزادت من انتشار القلق والاكتئاب. في مجتمع يعاني أصلًا من تصدعات اجتماعية وسياسية عميقة، تعمل هذه المنصات على خلق أشكال جديدة من الاغتراب، حيث يهرب الأفراد من واقعهم الصعب إلى عالم افتراضي، مما يزيد من انفصالهم عن ذواتهم ومجتمعهم.
القسم الخامس: رؤية خاصة متعددة الزوايا حول التشيؤ
إن تحليل وطفة المستند إلى ماركس يفتح الباب لتأملات أوسع حول طبيعة التشيؤ ومستقبله.
1- التشيؤ كظاهرة أنطولوجية: هل التشيؤ مجرد نتاج للرأسمالية، أم أنه يعكس ميلًا إنسانيًا أعمق نحو تحويل الأفكار المجردة إلى أشياء ملموسة، والعلاقات السائلة إلى هياكل صلبة؟ قد تكون الرأسمالية هي النظام الذي أطلق العنان لهذه النزعة وعممها إلى أقصى حدودها، لكن جذورها قد تكون أعمق في بنية الوعي الإنساني نفسه.
2- مقاومة التشيؤ في القرن الحادي والعشرين: إذا كانت الثورة البروليتارية الكلاسيكية تبدو بعيدة المنال، فإن أشكال المقاومة المعاصرة للتشيؤ تتخذ طابعًا فرديًا وجماعيًا مختلفًا. ممارسات مثل "الانفصال الرقمي" (Digital~Detox)، والتوجه نحو الاستهلاك الأخلاقي والمحلي، والحركات البيئية التي تدعو إلى إعادة النظر في علاقة الإنسان بالطبيعة (ليس كـ"شيء" للاستغلال بل كذات شريكة)، كلها تمثل محاولات لاستعادة البعد الإنساني في عالم مُشيَّأ.
3- مستقبل التشيؤ في عصر الذكاء الاصطناعي: يطرح التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي أسئلة فلسفية مقلقة. هل سنصل إلى مرحلة يصبح فيها التمييز بين الإنسان والآلة، والوعي الطبيعي والوعي المصطنع، غير ذي معنى؟ هل يمكن أن يوجد "وعي مُشيَّأ"؟ إن هذه التحديات تتطلب أدوات نقدية جديدة تتجاوز حتى الإطار الماركسي الكلاسيكي.
4- خاتمة تركيبية: يظل كتاب الدكتور علي أسعد وطفة دليلًا ثمينًا لفهم الأبعاد العميقة للأزمة الإنسانية في ظل الرأسمالية المعاصرة. إنه يسلحنا بلغة نقدية قوية ويذكرنا بأن القضايا التي طرحها ماركس قبل أكثر من قرن ونصف لم تفقد راهنيتها. ومع ذلك، فإن مهمة الجيل الحالي من المفكرين والنقّاد هي تطوير هذه الأدوات النقدية لمواجهة الأشكال غير المسبوقة من التشيؤ التي تولدها الثورة الرقمية، والتي تهدد بتحويل ليس فقط عمل الإنسان، بل جوهر وجوده ذاته، إلى مجرد شيء في عالم الأشياء.


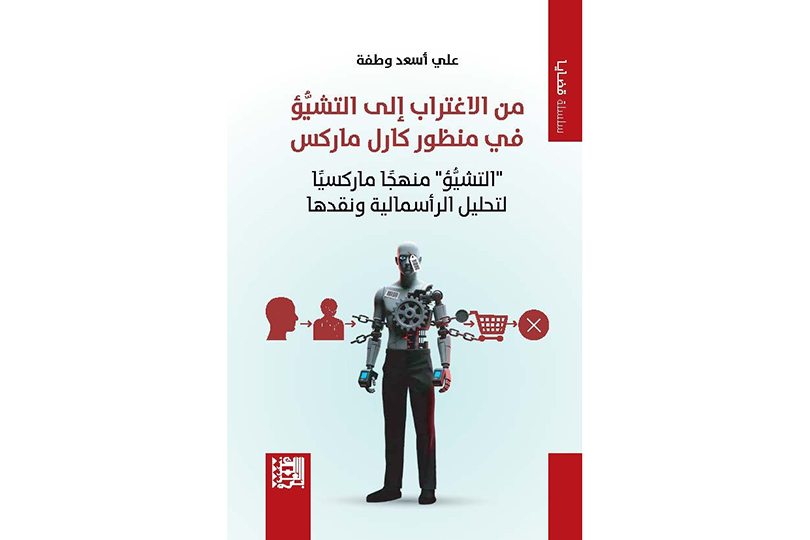

اضف تعليق