أضحت الثقافة مجموعة علامات من دون مضمون إنّه التجريد الثقافي، ذوبان مضمون الثقافة، امحاء الثقافات الإنثربولوجية، ولم يعد ثمّة فارق بين اليمين واليسار فالخطاب اليميني محافظ لكنه يجسّد في سلوكه الشخصي القيم الجديدة التي يرفضها، أما الديانات التي كان ينبغي أن تنهض فهي إما تعولمت أو تحوّلت إلى لوائح ممنوعات...
الهويات مقابل النزعة الكونية، الجندر مقابل الجنس، الجمهورية مقابل الجماعوية، العنصرية، النسوية، الهجرة... المشترك بين هذه القضايا بتداعياتها السياسية القوية هو الثقافة بكلّ ما للكلمة من معانٍ. لكنّ أوليفييه روا يرفض هنا فرضية «الحرب الثقافية» أو صراع القيم. فَما يعاني أزمةً، حسب رأيه، هو مفهوم الثقافة ذاتُه الذي اختُزل إلى نظام من رموزٍ معولمة تغزو الجامعات كما المطابخ، ومعارك الهوية والأديان كما العلاقات الحميمة، وحتى مشاعرنا المصنّفة في رموز تعبيرية.
إنها أزمة ثقافية بالأساس، ولا يتعلق الأمر بحرب ثقافات أو صراع حضارات كما نظر إليها الأميركي صمويل هنتنجتون مثلاً، أو أزمة قيم متعارف عليها، يتّضح فيها الفارق بين الخير والشر.
هو بالفعل تجريدٌ ثقافي عالمي يشخّصه روا ويتفحّص آلياته وآثاره المتناقضة: يشعر المهيمِنون كما المهيمَن عليهم بالتهديد والمعاناة، وتصير كلٌّ من الإنكليزية العالمية المبسَّطة (Globish) وقصصِ المانغا المصوّرة محاكاةً تقضي على ثراء اللغة الإنكليزية والثقافة اليابانية، وتساهم عملياتُ التواصل في صنع «مستقبل متوحِّد»...
يسعى أوليفييه روا إلى خلخلة المعطيات الفكرية الجاهزة، ويدعو إلى إعادة النظر في مسلمات سياسية واجتماعية يضعها العالم خارج دائرة الاهتمام.
يرى المفكر الفرنسي أوليفييه روا في كتابه الجديد "تسطيح العالم: أزمة الثقافة وسطوة القواعد والمعايير" (ترجمة بديعة بو ليلة، دار الساقي) أن النزاعات السياسية اليوم تخاض حول مسائل القيم والهوية بدلاً من أن تدور حول الاقتصاد أو الرهانات الاجتماعية الفعلية. فقد ترجم تمدد مجال الحرية اللافت منذ نصف قرن في السياسة والجنس والاقتصاد والفن إلى تمدد لافت أيضاً لنطاق القواعد والمعايير، حتى يمكن القول إننا في صراع نماذج ثقافية: قيم دينية مقابل قيم مادية، قيم غربية مقابل قيم إسلامية، محافظون يدينون الخروج على التقسيم الجنسي، فيما تريد النسويات وضع حد للثقافة البطريركية بأشكالها كافة. وهكذا فالثقافة هي فعلياً في مركز الاهتمامات على رغم أن معنى كلمة "ثقافة" يبقى مبهماً، ونحن لا نمر بانتقال ثقافي وإنما فعلياً بأزمة مفهوم الثقافة نفسه، ومن أعراضها أزمة اليوتوبيات، كما تمدد النظم المعيارية.
ارتأى أوليفييه روا، أن يورد في مقدمة كتابه، حادثاً يبدو "عديم الأهمية"، يتعلق بقانون سنّته شركات طيران أميركية، يسمح للركّاب بمرافقة حيواناتهم الأليفة، لأنها تدعمهم عاطفياً، وترغب في التقليل من مخاوفهم أثناء التحليق في الجو.
يستغرب روا، كيف أن ما كان سيُجابه بالرفض، أو يُعتبر إخلالاً بالنظام العام قبل عشرين أو ثلاثين عاماً، صار معياراً وقاعدة، بل أصبح قانوناً ينبغي الرضوخ له.
يرى في الأمر، أحد تجليات الأزمة الثقافية العامة، نتيجة تغيّر الرهانات داخل المجتمعات، وتغيّر ما كان بديهياً ومشتركاً داخل ثقافة متّفق عليها. عبر تبنّي ثقافة أخرى، يمارسها الناس في كل بقاع الأرض دون استثناء.
الحادث المذكور يُظهر أعراض أمرين اثنين برأيه، الأول هو المكانة التي صار يتمتّع بها الحيوان في عالمنا المعاصر (في الغرب على الأقل)، مقابل مكانة ما هو إنساني وأصبح غير مركزي.
الثاني، الحساسية الزائدة التي أصبح يتمتّع بها كثيرون، تجاه ما يعتبرونه جرحاً للمشاعر وازدراءً لخياراتهم الحياتية والسلوكية، أو "اعتداءاً نفسياً".
يتحدث الكاتب عن زوال الفروقات بين الإنسان والحيوان والآلة. إذ تبرز اتجاهات ثقافية جديدة تثير أسئلة بشأن مكانة الإنسان في العالم، وترفض هيمنته على الطبيعة، واستغلال الحيوانات، ووتطوّر الذكاء الاصطناعي الذي قد يهدّد البشر.
يقول موضحاً: "إذا تعذّر علينا تحديد مكانة الإنسان بين الحيوان والملاك، وإذا فقدنا هذا المحور العمودي لصالح محور أفقي، أي مسطّح، بحيث يتم تقليل الفروقات الدقيقة إلى ما لا نهاية، فهذا يعني أن الإنسانية في أزمة".
يلخص المؤلف التحولات بأربعة مستويات غيرت العالم منذ ستينيات القرن الماضي: أ- تحول القيم مع الثورة الفردانية في الستينيات، ب- ثورة الإنترنت، ج- العولمة المالية النيوليبرالية، د- عولمة المجال وتنقل البشر، أي زوال الأقلمة.
يحاول روا النظر في العلاقات بين هذه المستويات الأربعة من زاويتي الثقافة والمعيار، طارحاً سؤالاً أساسياً: هل إننا نعيش ببساطة انتقالاً بين نموذجين ثقافيين: الليبرالي الكوسموبوليتاني النسوي في مقابل التقليدي المحافظ السيادي البطريركي؟
تمثل الستينيات، في رأي المؤلف، نقطة تحول في تصور القيم، فهي بداية ثورة عالمية للشباب، بدأت بنزع الشرعية عن الماضي، لتشكل فئة سياسية بعينها، وهذا أمر جديد في التاريخ: كان الشباب في الحركات الثورية السابقة (الفاشية والشيوعية) طليعياً، ولكنه لم يكن فئة مستقلة تنتج قيمها الخاصة، في قطيعة مع الأجيال السابقة، إلا أن اعتراضاً عميقاً على الثقافة السائدة وعلى القيم التي تحملها، هو الذي انتصر في النهاية.
تتلخص ثقافة الستينيات الجديدة بكونها فردانية بصورة عميقة، متمركزة حول الفرد، وتتموضع في تواصل مع أيديولوجيا الأنوار التي تجعل من الفرد وحقوقه نقطة الرابط الاجتماعي. وهي بذلك تشكل حرب قيم، لأنها تجري في داخل الثقافة الغربية ذاتها، وهي عكس صدام الحضارات الذي يضع الثقافة الغربية، المتصورة كوحدة، في مواجهة الثقافات الأخرى.
في تعريفه للنيوليبرالية رأى روا أنها "التعميم المطلق لسوق حرة لم تعد مبنية على الإنتاج وإنما على التسليع النسقي لكل ما لم يكن بالضرورة سلعة، والمؤلف هنا لا يوجه اهتمامه إلى الجوانب الإقتصادية البحتة، ولا حتى السياسية، ولكن إلى أثر هذا التوسع في حقل الثقافة والقيم. لقد فكر ماركس بالفعل في تسليع الرأسمالية للعالم، ولكنه وضع له حدوداً. كان يتعين وجود قيمة استعمالية من أجل جعل خدمة ما "سلعة"، أما اليوم فلم يعد سوى قيمة تبادلية تعوض القيمة الاستعمالية، ولم يعد العمل قيمة في حين أنه كان كذلك في الرأسمالية.
أما الإنترنت فهي بالفعل عنصر من عناصر تغير النظرة الثقافية واسع الانتشار في المجتمع، وهي لا تبتدع ثقافة جديدة لكنها تدمر فكرة الثقافة نفسها، وجعل الرجوع إلى الواقع بلا فائدة من خلال خلق عوالم افتراضية مكتفية ذاتياً.
إزاء ظاهرة العولمة طرح المؤلف السؤال الإشكالي المطروح منذ عصر النهضة: هل العولمة هي تعبير عن غربنة العالم، وهل الغرب هو ثقافة ضمنت هيمنتها منذ التوسع ما وراء البحار عام 1492، أم إنه منذ عصر الأنوار بوتقة لنظام قيم يدعي الارتقاء إلى الكونية، أي أنه فوق الثقافات كافة؟ هل إن القيم المسماة غربية - حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون والعلمنة - ليست سوى طريقة لتحقيق سيطرة ثقافة الغرب أم أن هذه القيم استقلت عن الثقافة التي ولدتها وغدت تشكل نظاماً فكرياً كونياً تتبناه الحركات من أجل الديمقراطية؟
الإنسان الأفقي
يرى الكاتب: "الثقافة الجديدة لا تتّسم بالعمق ولا بالتجديد على مستوى المضامين والطروحات، فقد تمّ تسطيح المعرفة والتواصل والممارسات الحياتية المختلفة والمعتقدات والعلاقات الاجتماعية وسواها، فأعطتنا الإنسان الأفقي، الذي يستند إلى محتوى ثقافي مبتسر، متداول ومشترك بين الكل، مشاع عبر وسائل التواصل".
من علامات ذلك مثلاً، انتشار "الجلوبيش"، وهو لغة سطحية وسيطة لا يتعدى قاموسها 1500 كلمة مأخوذة من الإنجليزية، يتم التواصل بها عالمياً، الأمر الذي يقف حاجزاً من دون استعمال اللغة الإنجليزية الحقيقية الثرية بموروثها الأدبي والعلمي.
كذلك ذيوع قراءة قصص الصور المتحركة "المانجا" اليابانية الشهيرة، التي لا تمكّن من يكتفي بمطالعتها، من اكتشاف الثقافة اليابانية خصيبة الخيال والإبداع. ثم هناك استعمال "الإيموجيات" للتعبير عن العواطف.
ناهيك على أن انتشار الإنترنت، الذي لا يجعلنا نقابل إلا الأشخاص الذين نتشابه معهم، أي الذين نستعمل وإياهم العالم الافتراضي نفسه، باللغة والتقنيات التواصلية نفسها، بعكس ما يحدث في الواقع الحي، حيث نلتقي أشخاصاً مختلفين عنا.
"هذه إحدى الأوجه الرئيسة لسطوة المعايير، المرادفة لعملية إلغاء ثقافة الثقافات، أي تذويب ما تحمله الثقافة الحقيقية والعالمة، بترويج الثقافات الفرعية، جرّاء العولمة، وهي تستقلّ عن الثقافة السائدة الحاضنة لها، فيتم اختزالها في رموز تواصلية منفصلة عن الثقافات الحقيقية".
"لقد تراجعت الثقافة الحقيقية والعالمة، بمعناها الأنثروبولوجي الخاص بمجتمع أو أمّة، وبمعناها التراكمي الإبداعي، وسادت الثقافات الفرعية التي ليست سوى ثقافة مجموعات، ثقافة مسطّحة، وهي تنتظم في كل مكان حول اهتمام واحد، فتنشره حتى يصير هو المعيار والقاعدة: مثلا ثقافة مشجّعي كرة القدم، ثقافة الهيب الهوب، المنتشرة في كل مدن العالم".
التصريح بالهوية
هو تشخيص لما يطلق عليه "ثقافات بلا ثقافة". ثقافات تُنمّي الانعزال الهوياتي بمختلف تجلياته في المجتمع الغربي، وتعاني من تبعاته وتأثيراته مجتمعات أخرى، ومنها مجتمعنا العربي الإسلامي، وتقضي على المشترك الثقافي "الضمني" و"البديهي" كقاسم مشترك، لإحلال سلطة مفروضة، على مستوى التواصل.
يقول روا: "عندما تختفي الضمنية المشتركة، يجب استبدالها بالصريح الذي يمكن أن يكون أي شيء، من طاووس على متن طائرة، إلى تمساح يتم اقتياده، كما شوهد في شوارع نيويورك. الطريقة الوحيدة لضمان وجود علامات الهوية هي إظهارها".
الرغبة كمرجعية نهائية
هكذا إذاً تبدأ حكاية العالم المتحوِّل نحو الثقافة الجديدة فتتحدّد أولاً الرغبة كمرجعية نهائية: رغبة الطعام، رغبة الجنس، رغبة التملّك، رغبة الظهور... لتصبح اللذّة معياراً جديداً سرعان ما أدرجت في قوانين وعادات المجتمعات الغربية. ليضع هذا التحوّل الرغبة مقابل الثقافة. وتبرز ثورة الستينيات الجنسانية المفهوم الجديد الآتي: "الرغبة جيّدة، والثقافة قمع". أنْ تصبح الرغبة بحسب أولفيييه روا مرجعية في اختيار المرء جنسه أو عرقه أو قيمه هذا يعني أنّ الثقافة قد تسطّحتْ ودخلت في أزمة.
وفي لحظة لاحقة ومباشرة يدخل الإنترنت بأقصى سرعته ليوصل شبكة الثقافات ببعضها ويحيل العالم إلى (قرية كونية) مدعاة تقوم بتفتيت الحدود وإزالة الأقلمة ويتخذ الإنترنت من نفسه مرجعاً ذاتياً ونهائياً، لكنه يظهر بحسب روا كمدوّنة ذات معرفة أفقيّة، فمعرفة الإنترنت في نظره لا تحيل إلا إلى ذاتها والحاسوب يفتقر بشدّة للفهم الغنيّ والحدسي للعالم، والرموز الإلكترونية تعبّر عن عاطفة مسطّحة غير قابلة للتفسير وهي رموز تعبيرية لا تحيل إلا إلى ذاتها.
وقد ساهم عمالقة التكنولوجيا في الانصهار بين النيوليبرالية والقيم التحرّرية الجديدة، وبحسب الكاتب فإنّ الإنترنت لم يكن سبباً للأزمة الثقافية وإنما منحها إمكانات التحوّل، فرضها الإنترنت لا يخلق ثقافة بقدر ما يضع نظام تمثّلات وعلاقات على النقيض من الثقافة في عوالم افتراضية مكتفية ذاتياً.
وبذلك يكون الإنترنت قد خلّصنا من المحدّدات الاجتماعية وعوّض لنا العالم القديم القائم على الأقلمة وعلى الاجتماع بفضاء افتراضي وعالمي، ولم تعد الحياة الاجتماعية مرتبطة بالمكان أو بالجغرافيا التي نعيش فيها.
كلّ الأشياء تقتلع وتستخرج من بيئتها ويصبح استخدام الثقافة فولوكلورياً كونه يأخذ بعض الأجزاء المنفصلة والمستقلة ويضعها في سياق مختلف كزهور موضوعة على القبور.
الأزمتان تتلخّصان في حصول الرغبة على مقام أعلى من الثقافة وفي مواجهتها أيضاً، ودخول الإنترنت كمرجع تقني يحيل إلى ذاته ليدخل بدوره الأزمة إلى النظام التعليمي الجامعي أيضاً فيتطوّر البحث الكمّي على حساب البحث النوعي.
التحوّل الثالث الذي سبّب تسطيح الثقافة بحسب روا يكمن في العولمة النيوليبرالية التي نقلت التسليع والنشاط من الاقتصاد إلى الثقافة. فمثلاً يصوّر تلفزيون الواقع Reality TV امتداد مجال التسليع إلى الحياة الخاصة ووجوب أن يظهر كلّ شيء من الحياة اليومية إلى العلن من دون وساطة أو انتقاء حتى ما يتعلّق بالمشاعر، وهنا تكتسي الأفعال قيمة سوقيّة فتصبح موضوع تبادل من دون مضمون ومن دون ادّعاء معنى. إن الأثر الأكثر وضوحاً للنيوليبرالية هو أزمة الرابط الاجتماعي بالتوازي مع زوال الأقلمة، فالنيوليبرالية لا تهتم بالرابط الاجتماعي في النيوليبرالية لا يوجد شيء اسمه مجتمع، فقط أفراد، رجال أو نساء!
لم تحدث الأزمة عند روا فقط في الثقافي البحتّ بل انبعثت في الديني أيضاً حين تحوّل ميلاد المسيح إلى فولوكلور لا يذكر فيه صاحب المناسبة إلا عرضاً وهنا بدل التعالي البشري يحدث استنزال للمتعالي.
وأخيراً، في عولمة المجال أو زوال الأقلمة – زوال الحدود التي هي إحدى أسباب تسطيح العالم فتدّعي الثقافة الحديثة أنها كونية ذات معيار، لكنهم لم يلتفتوا إلى أن الثقافة نفسها مقاوِمة لمبدأ الكونية، والسبب واضح عند روا في كونه لا يوجد مجتمع كوني. فدعوى كونيّة الثقافة هو تجريد ثقافيّ فحسب.
فأيّ أزمة تمرّ بها الثقافة؟ يجيب روا: إذا لم نعد نعرف موضع الإنسان بين البهيمة والملائكة، وإذا فقدنا هذا المحور العمودي لصالح المحور الأفقي المسطّح الذي يتمدّد في اتجاه الاختزال يعني أن الإنسانوية في أزمة.
لا يقدم أوليفييه روا، جواباً محدداً يسهل الاعتماد عليه، بل يصل في الفصل الثامن والأخير من الكتاب إلى أن هذه الأزمة، هي أزمة تمسّ المنحى الإنساني ككل. ويسأل عن سبل توفير ثقافةٍ مقاومة أو مضادة، دون التمسك بنزعة حنينية للماضي، ثقافة لها عمق، وبإمكانها أن تتجاوز وتنتصر على إمبراطورية المعايير وسيادة الرموز.
يتم ذلك عبر توفير خيال مشترك، يتجاوز الفرد المحصّن بثقافة الأقلية، ليعانق الجماعة والثقافة الجامعة للأكثرية. وهو ما يمكن تحقيقه بالابتعاد عن آثار العالم الافتراضي، واعتناق التعدّد المجتمعي واعتماد البعد الإنساني.
يختم أوليفييه روا كتابه القيّم المبني على تتبّع دقيق لكلّ التفاصيل اليومية للمجتمعات الغربية ورموزها الجديدة بتوصيفه للإنسان الثقافي الجديد: "إنسان ليس إنساناً بالقدر الكافي". إن هذا التوصيف لدى روا يوحي لنا عمق الأزمة الثقافية، فثمّة تناغم كاذب بين الثقافة والهوية وأضحت الثقافة مجموعة علامات من دون مضمون إنّه التجريد الثقافي، ذوبان مضمون الثقافة، امحاء الثقافات الإنثربولوجية، اختزال الثقافة إلى نظم ترميزية للتواصل منفصلة عن الثقافات الحقيقية (الكيتش الجاهز)، ولم يعد ثمّة فارق بين اليمين واليسار فالخطاب اليميني محافظ لكنه يجسّد في سلوكه الشخصي القيم الجديدة التي يرفضها الخطاب، أما الديانات التي كان ينبغي أن تنهض في تجاوز الأزمة فهي إما تعولمت أو تحوّلت إلى لوائح ممنوعات.
تسطيح العالم بحسب روا هو إزالة للعمق والتعقيد والتسامي البشري المتجاوز لحدود انتمائه البيولوجي للعالم الطبيعي. ويقول في حوار صحفي أُجري معه بمناسبة صدور هذا الكتاب: “خذ (مثلاً) مكانة الإنسان في العالم. في الفكر الكلاسيكي، ومن بينه فكر عصر التنوير، كان الإنسان في أغلب الأحيان يتموضع في موقع بين الطبيعة والتسامي. هذا الموضع العموديّ (المنزلة بين المنزلتين) أضحى اليوم موضع تساؤل من خلال العلمنة ومحو الاختلاف بين الإنسان والحيوان. النزعة النباتية ومناهضة التمييز بين الأنواع البيولوجية تلغي الحدود مع الإنسان. وآخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا تطرح أسئلة عن مكانة ودور البشر”.
يشير روا إلى أحد البلدان العربية في الحوار الصحفي المشار إليه أعلاه، ويقول: ما الذي يمكن أن يكون أكثر نموذجية من حظر ذلك البلد الاحتفال بالمولد النبوي، والتصريح في الوقت نفسه بالاحتفال بعيد الهالوين؛ هذا مثال نموذجي على التسطيح واستيراد ملامح ثقافية بعد نزعها تمامًا من سياقها الأصلي. ويشير روا إلى أن حركة محو وتسطيح الثقافة في رأيه تعمل في كل مكان؛ فنحن بتنا لا نتحرك اليوم نحو ثقافة عالمية، بل نتجه نحو غياب عالمي للثقافة؛ ومع التناقضات الهائلة القائمة في عالم اليوم، فكلما اختفت الثقافة، باتت قضية الهوية أكثر مركزية.
يشكل الكتاب إضاءة في العمق على أزمة الثقافة المعاصرة وتفاعلها مع ثورة الحداثة، بكل ما تمثله من انقلاب جذري في القيم وتمدد في المعايير، وانعكاس ذلك على تحولات التفكير في عصر العولمة. كتابٌ حيوي ونقدي يثير القلق لإذعاننا بسهولة إلى توسيع نطاق المعايير.
مؤلف الكتاب أوليفيه روا هو كاتب وباحث فرنسي متخصّص في الشؤون الإسلامية، وهو أستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا، وله مقالات وكتب عدة منشورة عن الإسلام والعلمنة من بينها: عولمة الإسلام، الإسلام والعلمانية، الجهل المقدس، الجهاد والموت، تجربة الإسلام السياسي، عولمة الإسلام، البحث عن الشرق المفقود.


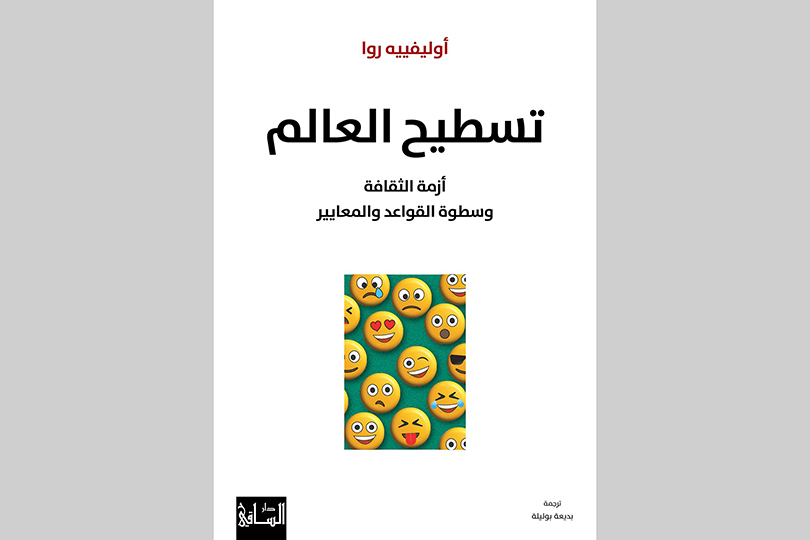

اضف تعليق