إنَّ الأوروبيِّين ما داموا أقرب إلى نموذج الجمال الجسداني الكلاسيكي، فإنَّ ذلك يعتبر دليلًا على تفوُّقهم المقدَّر لهم عن الشعوب الأخرى الأقل جمالًا. فالأوروبيون البيض هم ناس النهار بياضُ بشرتهم يعكس ضوء الشمس الذي يمنح الحياة، والزنوج هم ناس الليل، الذين تعكس بشرتُهم الأبنوسية طبيعتَهم المظلمة...
حتى سنة ١٨٥٣م كانت فكرة «الجنس» ما تزال جديدةً نسبيًّا. وفي بداية القرن التاسع عشر اقترح كلٌّ من «يوهان فردريك بلومنباخ» Johann Friedrich Blumenbach، و«جورج كوفير» Georges Cuvier تقسيمًا ثلاثيًّا للجنس البشري، وهو: الجنس الشرقي أو المغولي، والزنجي أو الحبشي، والأبيض أو القوقازي.
هذا الفرع من المعرفة العلمية الذي أسَّسه «بلومنباخ»، و«كوفير» وهو الأنثروبولوجيا كان يحاول أن يفهم أصول الاختلافات الفسيولوجية، ويقرِّر ما إذا كانت الأجناس أنواعًا متمايزة بالفعل، أو أنها مجرد تنويعات على النموذج الإنساني نفسه. إلا أن الأوروبيِّين سرعان ما بدءوا يستخدمون الفوارق الجنسية أو الفسيولوجية لتفسير الاختلافات الثقافية وفَهْمها. وكان الافتراض هو أنَّ الانحدار من جنس إلى آخر يعني إحراز السمات الذهنية والأخلاقية لأولئك الناس، والتي تظهر في أنشطتهم الثقافية، والآن، يبدو أنَّ الحضارة، أو المسيرة المتقدِّمة من البربرية إلى المجتمع المدني الحديث، قد أحرزت قاعدةَ انطلاق إمبيريقية: وهي قاعدة الجنس، وكانت هذه النظرية تبدو للمؤمنين بها في أوائل القرن التاسع عشر على أنها امتداد علمي للتاريخ العام للبشرية كما جاء عند «التنوير»؛ حيث يمكن إرجاع الغطاء الكلي للتقدُّم الإنساني إلى سبب واحد.
وقبل «دارون» بوقت طويل كانت نظرية الجنس تقول بأنَّ القوانين الموحدة للتقدُّم، لم تكن سياسيةً ولا اقتصادية (كما ستصبح مثلًا في كتاب «رأس المال» عند «مارکس») وإنما هي قوانين بيولوجية.
جميع نظريات الجنس قبل مقال «جوبينو» كانت قد صنَّفت الأجناس البشرية في ترتيب هرمي، يحتل البيضُ قمَّتَه، والسود يحتلون القاع. وكان «کارل جوستاف کاروس» Carl Gustav Carus، الذي صاغ أفكار «جوبينو» بحماس شديد، يقول إنَّ الأوروبيِّين ما داموا أقرب إلى نموذج٢٢ الجمال الجسداني الكلاسيكي عن غير الأوروبيِّين، فإنَّ ذلك يعتبر دليلًا على تفوُّقهم٢٣ المقدَّر لهم عن الشعوب الأخرى الأقل جمالًا. فالأوروبيون البيض هم «ناس النهار» كما وصفهم «کاروس»، بياضُ بشرتهم يعكس ضوء الشمس الذي يمنح الحياة، ومن الناحية الأخرى، فإن الزنوج هم «ناس الليل»، الذين تعكس بشرتُهم الأبنوسية طبيعتَهم المظلمة والبدائية.٢٤ وكان «کاروس» وغيره من أصحاب النظريات يُجمعون على أنَّ البيض يتمتعون بمزايا عقلية وجسدانية تفوق ما لدى نظرائهم من أصحاب اللونَين البُني والأصفر.
هذا الافتراض بالتفوُّق الأبيض، هو بالطبع أبرز الجوانب السيئة في نظرية الجنس بالنسبة للقرن العشرين، ولكنه كان في وقته، الجانب الأكثر إثارة بالنسبة للتفكير العِرقي. أما الذي أثار خيال القرن التاسع عشر فكان افتراض نظرية الجنس بأنَّ التاريخ الطبيعي للإنسان (كنوع بيولوجي) هو الذي أنتج أيضًا التاريخ الثقافي للبشرية (ككائنات اجتماعية أخلاقية). وبدا التقسيم طبقًا للجنس كأنه يكشف أسرارَ وغموضَ عمليةِ التحضُّر بتفسيرِ أسبابِ مُضيِّ بعض المجتمعات في مسيرة التقدم بشكل أسهل وأسرع من غيرها. نشر «جوستاف كليم» Gustav Klemm «التاريخ الثقافي العام للبشرية» - ۱۰ مجلدات - بين عامَي ١٨٤٦م، و١٨٥٢م، أي قبل ظهور مقال «جوبينو» بعام. «کلیم» يرى - وبإصرار - أنَّ كل «التطورات الثقافية في التاريخ تكوَّنت نتيجة انتشار وتطوُّر أنواع جنسية متمايزة»، ويقول إنَّ الفارق الأساسي بين الأجناس ليس لونَ البشرة وإنما السمات «النشطة» و«الكسولة»؛ فالجنس أو العرق النشط يظهر في المراحل الباكرة، (أثناء ما يسميه «كليم» ﺑ: همجية الإنسان) على شكل قوة وإرادة داخلية يستخدمها لكي يتغلب على العقبات المادية التي تقابله، ولكي يقهر أو يهزم الأجناس الأكثر كسلًا (وبالتالي الأقل قدرًا). هذا القهر، من المحتمل أن يُحدِث تمازجًا بين الأجناس، حيث المنتصرون يستقرون ويفقدون استقلالهم الحاد وإرادتهم، وتختفي المجموعة الأصلية المسيطرة ويتشكل نوع جنسي جديد يتبعه مرحلة جديدة من الحضارة.٢٥
والتاريخ - بالقطع - هو قصة امتزاج الأجناس في نظر «كليم» و«کاروس». ولكن هذا الامتزاج كان شيئًا جيدًا وليس سيئًا. كان «کلیم» يعتقد أنَّ من الممكن تتبُّع التقدم المطرد للإنسان الأوروبي من البدائية إلى الحرية وحتى مستويات أعلى متوالية من التربية الجنسية والتمازج، وهو هنا يواصل نظرة «التنوير» عن التقدم الثقافي العام، ولكن هناك مَن لا يوافق على ذلك. بيد أن هناك إجماعًا بين النظريات الجنسية على أنَّ تاريخ الجنس البشري تاريخُ تقدُّم. هو تاريخ التقدم المطرد للسيادة البيضاء وانتشار الحرية السياسية لكل البيض (أو للذكور منهم على الأقل) في شكلها الأوروبي القائم على الجنس؛ ولهذا السبب فإنَّ الإغراء الرئيسي للعِرقية في القرن التاسع عشر، كان هو رسالتها السياسية المتقدِّمة، أو بالأحرى الليبرالية. فلو أنَّ جميع البيض (أو الذكور البيض) كانوا متساوين من ناحية الجنس، فلا مبرر إذن لأي تمييز اجتماعي، أو أنَّ نظرية الجنس حطَّمت مزاعمَ الطبقة الأرستقراطية في التميُّز والسلطة. وبدلًا من ذلك، كان جميع الإنجليز أو الفرنسيِّين أو الألمان يتمتعون منذ الميلاد بالمواهب الثقافية نفسها، بصرف النظر عن الأصل الاجتماعي، وحتى أثناء تحرُّك المجتمع الأوروبي نفسه في هذا الاتجاه السعيد، كان من الطبيعي أن تمتدَّ القوة الثقافية البيضاء على العالم غير الأبيض.٢٦
وباختصار، فإنَّ مجملَ توجُّه التفكير العِرقي في أوروبا كان توجُّهًا ليبراليًّا متفائلًا، بل ويدلُّ على الرضا الذاتي. كانت كلمة «عرق» قد ظهرَت مرة واحدة قبل ذلك في كتابات «جوبینو» في سنة ١٨٤٩م٢٧ وعندما كان يضع مسودةَ أطروحته، اعتمد بشكل كبير على أسلافه الألمان، وبخاصة «كليم»، و«کاروس»، و«کریستیان لاسن» Christian lassen.٢٨⋆
قَبِل «جوبينو» التقسيمَ الهرمي العِرقي: «أبيض – أصفر – أسود»، وفكرة أن يكون التاريخ العِرقي تاريخًا ثقافيًّا، إلا أنَّه عندما وضع أفكاره الخاصة عن العِرق على الورق، استولى عليه يأسُه الرومانسي واغترابه، ناهيك عن تنفجه الأرستقراطي القديم، وبدلًا من أن تكون أوروبا الحديثة هي قمة التطوُّر البيولوجي للإنسان، كان يعتبرها بالوعةً للتفسُّخ العِرقي، وبضربة واحدة، غيَّر «جوبينو» توجُّهَ التفكير الأوروبي بشأن الجنس تغييرًا جذريًّا.
في «فصل المقال»، الأوروبيون البيض المعاصرون - طبعًا - لا يزالون أرقى من نُظَرائهم الزنوج أو الشرقيِّين، وكما يقول «جوبينو»، فإنَّ الرجل الأبيض لديه توافق أعظم بين مكوِّنات القوة الجسدانية والذكاء والأخلاق، ومن بين كلِّ الأجناس الموجودة يظلُّ هو الأكثر حيوية، تلك الحيوية التي هي قوة حياة أو جوهر تنتقل إلى ذريته، وهي أساس الحضارة والإبداع الإنساني.٢٩ حَملَةُ هذه الحيوية العضوية، هم السلف الآرومي (الأصلي) للجنس الأوروبي الأبيض الذين يسمِّيهم «جوبينو»: «الآريون»، المصطلح جاء من عالم الدراسات الاستشراقية وله في حدِّ ذاته تاريخٌ مثير. في سنة ١٧٨٨م، حدَّد السير «ولیم جونز» William Jones - وكان موظفًا مدنيًّا لدى شركة الهند الشرقية - أوجهَ التشابه اللغوي بين اللاتينية واليونانية والفارسية والسانسكريتية، بالإضافة إلى اللغات الجرمانية والسلتية. وألمح «جونز» إلى احتمال أن تكون كلُّ تلك الشعوب مشتركةً في لغة واحدة في الأصل، وربما في سمات ثقافية أخرى أيضًا.٣٠
«فردريك شليجل» دفع هذا الاحتمالَ خطوةً إلى الأمام عندما جاء إلى «باريس» ليواصل دراسةَ الفلسفة الهندية. افترض «شلیجل» أن «السانسكريتية» كانت هي اللغة الأصلية المشتركة بين كل الحضارات شرقًا وغربًا، وأن الناطقين الأصليِّين بها (الآريون الذين فتحوا الهند) كانوا هم أسلاف الإغريق والرومان والمؤسِّسين الآخرين للثقافة الغربية، والذي حدث أنَّ «شلیجل» لم يكن مُصيبًا في ذلك، بيد أن استنتاجه - أنَّ جميع الحضارات كانت في الأصل حضارةً واحدة - استولى على خيال المستشرقين والفلاسفة في أنحاء أوروبا.
فكرة وجود جنس يضمُّ كائنات كاملة منحَت العالمَ كلَّ معرفته، وأن هذا الجنس قد اختفى، فكرة ترجع إلى أيام الإغريق وخرافة «أطلانتس» Atlantis، وكانت تلك تنويعة أخرى على خرافة العصر الذهبي. كان عام وصول «شلیجل» إلى «باريس» ذروة الافتتان بمصر القديمة وﺑ «الفنية البدائية» Primitivism، والاعتقاد بأن جنسًا من الفلاسفة والفنانين والمخترعين أقدم وأكثر رقيًّا، كان يسكن هذا الكوكب، وصنع حضارة متفوقة... اختفَت الآن. هذه «البدائية» أثارَت جدلًا علميًّا في عصر «روسو»، وأيقظَت اهتمامًا واسعًا بالآثار الخاصة بالعصر الحجري الحديث.٣١
كان «شلیجل» شخصيةً مهمة، ليس في مجال الاستشراق ودراسة «الآرية» فقط، وإنما في الحركة الرومانتيكية كذلك. رأيُه العلمي الخاص ﺑ «الآرية» سرعان ما تجذَّر في تربة الخيال الخصبة. أصبح «الآريون» هم المؤسِّسون الأصليون للحضارة، والذين يسبقون الإغريق والرومان والمصريين. وبحلول عام ١٨١٣م كان العلماء والدارسون قد اخترعوا مصطلح «الهندو-أوروبيون» ليصفوا به أولئك الروَّاد الآريِّين، الشعب القلِق المغامر الذي ترك موطنه الأصلي وانطلق من أجل رسالة تاريخية. وعندما كانوا يجولون، كانوا ينشرون مواهبهم الثقافية من الشرق إلى الغرب «حيث كانت مسيرة الثقافة تتبع دائمًا مجرى الشمس»،٣٢ كما كان «أوجست فردريك بوت» August Friedrich Pott يقول. وفي رأْي «كريستيان لاسن» Christian Lassen في جامعة «برلين»، فإن أولئك الآريِّين الرُّحَّل كانوا ينشرون كلَّ فضائل ومزايا أوروبا السابقة للبرجوازية. كانوا يتمتعون بقدر كبير من الجمال الجسداني والشجاعة والإحساس بالكرامة الشخصية. (آريا: في السانسكريتية تعني الرجل الشريف)، وكانوا يعبِّرون عن نبالة الروح والحيوية في شعر الملاحم منذ «هوميروس»، و«بيولف» Beowulf إلى «المهابها راتا». كانوا رجالًا ذوي مواهبَ عقليةٍ عظيمة، قادرين على موازنة الخيال والعقل على خلاف الشعوب الدنيا التي قهروها. (مثل «الدرافيديان» في الهند القديمة، والشعوب السامية في الشرق الأوسط).
وقبل كل شيء، فإنهم كانوا رجالَ «تربة» يتمتعون بجذور عاطفية عميقة ممتدة في الأرض أكثر منها في المراكز الحضرية والتجارية. كان «الآريون» باختصار، عكس «المهذبين» بالمعنى المفهوم عند «التنوير»، وبدلًا من ذلك كانوا «فضلاء» بمفهوم «روسو»، لم يخرِّبهم الفساد ولا القيم الزائفة. كانت الفضيلة بالنسبة لهم حقًّا وامتيازًا بحكم المولد والنشأة، وكانت هي أيضًا تَرِكتَهم لذريتهم.
وعند هذه النقطة بالطبع، كان لا بد أن تندمج النظرية الآرية أو «الهندوجیرمانية» في نظرية الجنس أو العِرق. كان الآريون الرُّحَّل هم النموذج الأوَّلي لأجناس «کلیم» النشطة، وطبقًا لافتراضات الحيوية العِرقية وافق «لاسن» وغيره من علماء الآرية على أن تلك الشعوب الآرية، الأقرب إلى السلالة الأصلية، هم الذين ظلُّوا محتفظين بحيوية العِرق وصفاته البطولية. الفرس والحيثيون والإغريق الهوميرويون (نسبةً إلى هوميروس)، والهندوس الفيديون (نسبةً إلى الفيدا) في العصور القديمة، والقبائل الجرمانية، والفايكنج بعد ذلك، كلُّهم حملوا حضارةً بطوليةً بعيدًا عن وطنها الأصلي، وحسب الخرافة الآرية الرومانسية فإنَّ الماضي البطولي الفاضل يحلُّ محلَّ الحاضر كوسيلة لتحديد قيمة العِرق أو الحضارة.
امتزاج النظرية الآرية ونظرية العرق هو الذي أعطى «جوبينو» أساسًا يجعله يزعم أن الثقافةَ الأوروبيةَ كلَّها كانت نابعةً من نموذج بيولوجي واحد... وهو الأبيض، وليس في أوروبا فقط. يقول: «إنَّ التاريخ يُثبت لنا أنَّ جميع الحضارات نتجَت عن الجنس الأبيض وأنها مستمدة منه، وأنه لا توجد حضارة دون إسهامه ومساعدته.» وقدَّمت الأجزاء الثلاثة الأخيرة من «فصل المقال» عملية مسح للحضارات التي صنعها الدم الآري، والمجال هنا واسعٌ لدرجة كبيرة. قدَّم «جوبينو» وصفًا دقيقًا لعشر حضارات تاريخية كبرى تحرَّرت من عصابات الحروب الآرية... «ومن حشود الناس الذين يعيشون أو عاشوا على الأرض... كانت البقية تتحرك بفعل الجاذبية حول تلك الحضارات... سواء كانت مستقلةً أو غير مستقلة، مثلما تدور الكواكب حول شموسها.»
الأولى كانت الهند موطنَ الحضارة الآرية إن شئنا الدقة، بعد ذلك جاءت مصر وآشور بما في ذلك فارس، والمفترض أنها جميعًا قد تأسست بواسطة جنس واحد هو الذي قام بالغزو، وهو الجنس الآري الأبيض، الذي أخضع الشعوب السامية الفقيرة واحتلَّها.
بعد ذلك، جاءت اليونان وروما، والغزاة الجرمانيون الذين أسَّسوا المسيحية الغربية، وبين هذه الحضارات البيضاء المؤسسة، وضع «جوبينو» الصين، بحجة أن جماعة من المحاربين الآريِّين من الهند هم الذين أقاموها. والأكثر مدعاةً للدهشة أن الحضارات السابقة على أمريكا «كولمبس»، يتضح أنها أيضًا من نتاج الروح الآرية الغازية نفسها، ومثلما هو في حالة الحضارة الصينية، فإنَّ الإنجازات الثقافية ﻟ «الأزتيك» و«المايا» لم تكن أبدًا إنجازاتهم، بل لا بد أن تكون قوانينهم وعاداتهم ومهاراتهم الرياضية والتكنولوجية «تركة جنس أرقى اختفى منذ زمن بعيد».
كان منطق الحيوية العِرقية واضحًا بالنسبة ﻟ «جوبينو»، حيثما وجدت ثقافة، فلا بد أن نفترض وجود الرجل الأبيض؛ لأنَّ «التاريخ لا ينشأ إلا نتيجة للاحتكاك بالرجل الأبيض». وبعد أن منحوا نِعَم الحضارة، اختفت الشعوب الآرية على الفور كجماعة مائزة. تركوا خلفهم لغتَهم فقط (التنازل الوحيد من قِبل «جوبينو» لعلماء اللغات الهنود-أوروبية) وعنصرًا بيولوجيًّا راقيًّا في الشعوب التي فتحوها. هذه البقايا العِرقية أصبحت هي أرستقراطية كل حضارة: من البراهمة الهندية، إلى النبالة الزرادشتية في فارس، والبطولة «الأكيانية» في اليونان الهوميرية... إلى المحاربين الفرنجة في أوروبا «شارلمان»، وعند «جوبينو»، العِرق وليس الاقتصاد هو الذي يخلق الطبقة الحاكمة. «إنَّ المجتمع يكون عظيمًا ورائعًا بقدر ما يحافظ على الدم النبيل للجماعة التي صنعته.»٣٣
وفي النهاية، فإنَّ خرافة الجنس الآري كانت من نسج خيال النشأة الأرستقراطية التي كتب عنها. «فصل المقال في لا تساوي الأجناس»، خلق أرستقراطية فرنسية متصورة، لم تلوِّثها الثورة ولا التجارة على نطاق کوني بالفعل؛ ولهذا السبب أيضًا كان المهم بالنسبة ﻟ «جوبينو» هو أن يرجع نسبه إلى «أوتو – جارل»، الغازي الفايكنجي شبه الأسطوري الذي فتح «نورمانديا».
وكما هو الحال بالنسبة للكونتيسة «مانفريدين»، الشخصية الروائية، فإن أصله الآري قد حفظه بمعزل عن أصحاب النزعة المادية ومجتمعهم الهمجي المتفسِّخ. «جوبینو» يرى أنَّ «الجنس الأبيض اختفى من على وجه الأرض بعد أن فقد نقاءَه التام في زمن المسيح»، وأنَّ الحيوية العِرقية ذات الأساس الآري أصبحت «متفسِّخة ومنهكة»، وأن القبائل الجرمانية والفايكنج كانت الزفرةَ الأخيرة، والحضارة - منذ ذلك - تجري في زمن مسروق وحيوية مسروقة.٣٤
وحيث إنَّ الجنس الآري قد بسط سيطرته ومدَّ نفوذه بقوة عن طريق الحرب والغزو (وهما في النهاية دلائل حيوية عِرقية) فقد أصبح ضعيفًا في العدد والعُدَّة، وبسبب الغزوات البعيدة والمختلفة، أصبحت الدول الآرية (التي كانت عظيمةً ذات يوم) «غنية وتجارية ومتحضِّرة». الغزاة الفاتحون وجدوا أنفسهم في علاقات حميمة مع أصحاب البلاد المفتوحة... ويتنفَّسون معهم الهواء نفسه، كان النفور الطبيعي يؤكد نفسه بين الأجناس المختلفة، ولكنه تلاشى في النهاية إلى أن أصبحت الأجناس الدنيا الخاضعة لا تبدو قبيحةً كما كانت. «الفروق الأخلاقية والجمالية، والغزو»، كلها جزء من العملية نفسها المكوِّنة للقيمة كما يقول «نيتشة». لقد حدثت عمليةُ تهجين للسلالات، ودمُ الجنس القائم بعملية التحضير كان يُستنزَف تدريجيًّا ويجف؛ لأنه توزَّع على الأجناس الأخرى.٣٥ عملية التحضير هي عملية إفساد في رأي «جوبینو»، ويتمثَّل ذلك في اختلاط الأجناس. الغزاة يقعون فريسةً لعبقريتهم الأكيدة لكي يخلقوا نظامًا اجتماعيًّا وسياسيًّا مستقرًّا، وتلك هي «بذرة الموت الحتمي» التي كان يخشاها «جوبينو» أكثر من أي شيء آخر، وهي لعنةُ الحضارة، إنه يرى أنَّ الامتزاج الحتمي للبشر في مجتمع معقَّد مصدر للإبداع... ولكنه أيضًا مصدر لعدم الاستقرار. الحضارات تحاول أن تُطيلَ من عمرها بأن تُصبح إمبراطوريات بدمج ومزج شعوب وثقافات مختلفة في كل واحد. هذا الاندماج متعدِّد الثقافات لا يمكن أن يعيش؛ لأن الدم في النهاية «يحنُّ».
الدم هو المهم، والمثال المفضَّل عنده هو الإغريق والفرس في العصر «الهلينستي» Hellenistic Age، أولئك الذين تفرَّقت بهم السبل بعد موت «الإسكندر الأكبر»، بالرغم من كل جهوده. المصير العِرقي أيضًا يفسِّر لنا لماذا يظلُّ الهمج همجًا حتى بعد احتكاك طويل مع المتحضِّرين والأرقى منهم كما يقول: إنَّ العملية التاريخية وحدها لا يمكن أن تحوِّل البرابرة إلى بشر متحضِّرين، ولا يمكنها - لنفس السبب - أن تخفض المتحضِّرين وتُعيدهم إلى البربرية. الجنس وحده هو الذي يمكن أن يصنع ذلك.٣٦ عند «جوبينو»، الجنس أو العِرق «هو الذي يفرض على البشر أساليبَ وجودهم... وهو الذي يُملي قوانينهم، رغباتهم، ما يحبون وما يكرهون.» هو الذي يقود الشعوب والحضارات «مثل العبيد العميان» نحو انتصاراتهم الكبرى... وكوارثهم الكبرى.٣٧ وحيث إن العرق المتسيِّد، يفرِّق دمه (ويخسره) على السلالات والأجناس الأقل شأنًا، تفقد ذريته القدرةَ على السيطرة على الأحداث.
ويَصِل «جوبينو» إلى نتيجة مفادها أنَّ الحضارات تنهار لأنها لم تَعُد في نفس الأيدي تحديدًا. «والضربة لا يمكن تفاديها، هي ضربة حتمية، يراها العاقل الحصيف قادمةً، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئًا.» وأيُّ نظام للحكم لا يمكنه أن يُبطل قوانين العلم الثابتة لحظة... مهما كان براعته، هذه القوانين الثابتة هي قوانين «الحيوية العِرقية». هذا المصير المتفسِّخ كان يستولي على أوروبا القرن التاسع عشر؛ فالحضارة الأوروبية كما قال «جوبينو» لم يكن لديها متوالية خطية صاعدة من البربرية إلى المدنية، أو من العبودية إلى الحرية، وبدلًا من ذلك، فإنها كانت تتحرك في دائرة الشعوب الأكثر قربًا من المصدر الآري الأصلي، وبالتالي الأكثر حيوية، هزمت البعيدين عن المصدر... والنتيجة أنها امتزجت بمن هم أدنى منها، وفقدَت نقاءَها العِرقي. وهكذا يصبح التاريخ دورةً لا نهائية من الحروب والغزو واختلاط الأعراق، هذه هي صيغة «جوبينو» العنصرية للثورة، anakuklosis، ليس هناك منتصرون في التاريخ، بل هناك - على المدى الطويل - منهزمون دائمًا:
يمكن أن نشبِّه حضارتنا بالجزر المؤقتة، التي يُلقي بها البحر نتيجة البراكين الموجودة تحت الماء، ولأنها عرضة لعمليات التدمير التي تُحدثها التيارات؛ ولأنها تفقد القوة التي كانت تحفظها ذات يوم، فإنها كذلك سوف تتحطَّم ذات يوم، ولسوف تبتلع الأمواج العاتية بقايا الحطام...
«جوبینو» يعترف بأنها «نهاية فاجعة»، نهاية كان لا بد أن تُواجهها أجناس نبيلة كثيرة قبلنا... «ولكنه المصير الحتمي لأهل أوروبا الجدد المهجَّنين، الورثة الجهلاء لتراث عِرقي كان نبيلًا ذات يوم.»٣٨
بعد الغزوات الجرمانية الآرية، كانت أوروبا ما قبل الحداثة تنعم بطبقة حاكمة متجانسة عرقيًّا، استمرت منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى العصور الوسطى المتأخرة. كان «جوبینو» Gobineau يصفهم بأنهم «شقر»، و«عريضو المناكب»، «رُبُّوا على جوهر دين نقي وبسيط وسياسة حكيمة وتاريخ مجيد»،٣٩ أولئك المحاربون الجرمان احتفظوا بحيوية الآريِّين الأصليِّين زمنًا ما، ثم بعد ذلك جاءت الكنيسة الكاثوليكية - بغباء - لكي تعلِّم النبالة التي كانت ما تزال على بكارتها العِرقية... علَّمتها «المرونة والقابلية للتكيُّف» و«مبررات المخالطة الاجتماعية»،٤٠ تلك المخالطة (والتي هي «التهذيب» بمفهوم التنوير) كانت حتفَهم. وبدلًا من القتال، والسيطرة على شعوبهم الأقنان، تعلَّم الغزاة أن يتزوجوهم. وفي النهاية امتزج «الجرمان» و«اللاتين» و«الغال»... وغرقَت الصفوة الأوروبية الحاكمة في دورة «جوبينو» الحتمية... دورة الفساد والتفسُّخ العِرقي.
وفي نهاية العصور الوسطى بزغَت طبقةٌ جديدة من الأوروبيِّين، كانت طبقةً مدينية وسطى معيشتها من التجارة وليس من خلال الحرب والأرض، ولكنها كانت «وسطى» أيضًا بمعنى أنها كانت هجينًا من العِرقَين الغازي والمهزوم. ما تبقَّى من التاريخ الأوروبي أصبح صراعًا بين بقايا الأرستقراطية الآرية-الجرمانية الأصلية، وذلك النظام البرجوازي الناشئ، صراعًا تفوز فيه البرجوازية وتنتصر باستمرار، وذلك بفضل دهائها وأعدادها المتفوقة. ومن منظور «جوبينو» كانت الثورة الفرنسية هي الهزيمة النهائية للمقصورية الجنسية.٤١⋆ والآن أصبحت مطالبُ الطبقة الوسطى في الحرية والمساواة و«مبدأ الأخوة الإنسانية الليبرالي» لا تُقاوَم. النظام الاجتماعي الأوروبي الذي كان مقدسًا ذات يوم، نظام الأرستقراطية والتاج والمذبح، هُزِم تمامًا، وتم تدميره كما حدث لأسرة «جوبينو» نفسها. وقد يبدو غريبًا أن نعتبر الثورة الفرنسية صراعًا عرقيًّا بالضرورة، إلا أنَّ «أوجستان ثييري» Augustin Thierry قال ذلك في كتابه «تاريخ الثورة الفرنسية»، قبل عشرين عامًا. في هذا الكتاب تصل الثورة الفرنسية بصراعٍ عمرُه قرونٌ إلى ذروته، وهو الصراع بين جنسَين أو شعبَين متمايزَين: «الغال» و«الفرانك». في النهاية، تنتصر الأغلبية الغالية، ويحرِّرون أنفسهم من الفرانك الظَّلَمة في أحداث ۱۷۸۹م الدرامية، وهكذا يكون التاريخ العرقي - مرة أخرى - عند «ثييري»: هو انتصار الحرية والمساواة.٤٢ من ناحية أخرى، يستبعد «جوبينو» النهايةَ الليبرالية السعيدة ويُقصيها، بينما يكون الجانب العِرقي للصراع خفيًّا تمامًا على الخصوم. وبعبارة «ماثيو أرنولد» Mathew Arnold:
«الثورة صدام ليلي بين جيوش جبَّارة»؛ حيث يتصارع اليعاقبة والملكيون والبونابرتيون وفاسدون آخرون بين أطلال وخرائب تركَها أسلافٌ أكثر حيوية منهم.
صورة الأطلال والبقايا تتكرر على امتداد المقال، والأطلال حسب تفكير «جوبينو» هي الآثار المرئية لشعب أرقى منَّا، وهو أرقى لأنه سابق، ولكنه كان غافلًا عن مصيره الحتمي، كما نحن غافلون الآن عن مصيرنا. «كل الحضارات السابقة على حضارتنا كانت تعتقد بخلودها... «الإنكا» وأُسَرهم، كانوا مقتنعين - وبكل ثقة - بأن غزواتهم ستدوم إلى الأبد، ولكن الزمن بضربة واحدة من جناحه، ألقى بإمبراطوريتهم مثل كثير غيرها في غياهب الهاوية.»٤٣
تشاؤم «جوبينو» العِرقي ليس نظريةً في التاريخ، بقدر ما هو عمل فني رومانسي. كتب: «لم تَعُد هناك - اليوم - طبقات، لم تَعُد هناك شعوب، بل أفراد بعينهم طافين على الموج مثل حُطام سفينة غارقة.» مثل «جوبینو» نفسه. إلا أنه بالرغم من انتصار البرجوازية، تظهر جماعات جديدة من الجماهير المهجَّنة، تظهر من بين الظلام الريفي وتهبط على المدن... وكانت النتيجة الحتمية أحداث ١٨٤٨م... والأسوأ قادم! أما بالنسبة لأمريكا، التي رآها متفائلون، مثل «توكفيل»، وهي حاملة لمشعل الحضارة في النهاية، بعد أن انتقل من الأيدي الأوروبية، فهي - أمريكا - بلد يمثِّل قاعَ النزف العِرقي، حيث النفاية البشرية من الأمم والشعوب الأخرى - أفريقيا وآسيا إلى جانب أوروبا - تتجمَّع وتتراكم. أمريكا تمثِّل «الشكل الأخير الممكن للثقافة».٤٤
وحيث إن الدم الآري الأصلي يُستنزَف ويُنضَب أكثر فأكثر، فإن تلك الجماهير المهجَّنة سوف تُمتَصُّ تمامًا في النهاية ولن يكون لها وجود، ستنهض الأجناس الأخرى (الأصفر – البُني – الأحمر)، وتأخذ مكانها وتمحو ذكرى الجنس الأبيض تمامًا. وستكون الفترة الخلَّاقة بالنسبة للبشرية قد انقضَت. البشر «لن يكونوا قد اختفَوا تمامًا، وإنما تفسَّخوا وانحلُّوا وأصبحوا مجردين من القوة والجمال والذكاء.» وبأسفٍ شديد يصل «جوبينو» إلى استنتاج:
«وربما يكون هذا الخوف الذي سينتقل إلى ذريتنا، هو الذي سيتركنا في حالة من اللامبالاة، إذا لم نشعر - مرعوبين - أن أيدي القدر فوق رءوسنا بالفعل.»٤٥


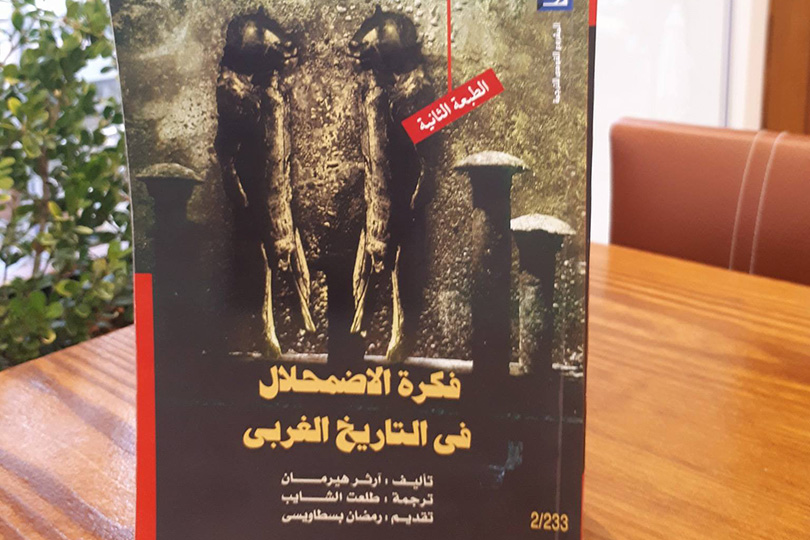

اضف تعليق