صور لنا القرآن حجم هذه المشكلة وخطورتها عندما ظل يذكر بها، ويلفت النظر إليها في مرات عديدة، وفي مناسبات مختلفة، وبالإشارة إلى أقوام وجماعات متعددة، لكي يدعونا إلى التأمل والتدبر في هذه المشكلة، التي يتوقف الإنسان فيها عن إعمال عقله، ويرتد إلى الوراء مبررا لعجزه وخموله، ومعطلا لعقله وفكره...
عندما تحدث لنا القرآن الكريم في آيات عديدة مكية ومدنية، عن مشكلة ما وجدنا عليه آباءنا، التي اعترضت طريق الأنبياء والرسل في تبليغ رسالاتهم السماوية إلى المجتمعات التي بعثوا إليها، أراد من الحديث عن هذه المشكلة، تصوير أن الرسالات السماوية إنما جاءت لتحرير العقول، وتحريض الناس على إعمال العقل، والتخلص من ذهنية القصور في الفهم، ومن منهجية التقليد والإتباع الساكن والجامد، وحتى لا يقول الناس بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.
وقد صور لنا القرآن حجم هذه المشكلة وخطورتها عندما ظل يذكر بها، ويلفت النظر إليها في مرات عديدة، وفي مناسبات مختلفة، وبالإشارة إلى أقوام وجماعات متعددة، لكي يدعونا إلى التأمل والتدبر في هذه المشكلة، التي يتوقف الإنسان فيها عن إعمال عقله، ويرتد إلى الوراء مبررا لعجزه وخموله، ومعطلا لعقله وفكره.
قال تعالى (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كانوا أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) ـ سورة البقرة، آية: 170 ـ فهذه الآية تصور أن إتباع الآباء في مثل هذا الموقف لم يكن على أساس عقلي سليم، فالبعض يتبع الآباء حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولا يهتدون. (لا يعقلون شيئا) ناظرة إلى جانب النظر، (ولا يهتدون) ناظرة إلى جانب العمل، فالذي لا يتعقل لا يهتدي.
وقد وجد الشيخ محمد عبده ضرورة أن يتوقف ناظرا إلى قوله تعالى (لا يعقلون شيئا) حتى لا يشكل هذا العموم على بعض الافهام، وبين المعنى في تفسير المنار، على ثلاثة أوجه:
الأول: أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به، بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظر ولا بحث.
الثاني: أنه جاري على طريقة البلغاء في المبالغة، بجعل الغالب أمرا كليا عاما. إذ يقولون عن الضال في عامة شؤونه إنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي إلى الصواب، ويقولون عن البليد إنه لا يفهم شيئا، وهذا لا ينافي أن يعقل الأول بعض الأشياء، ويفهم الثاني بعض المسائل.
الثالث: أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آبائهم بالفعل، وإنما المراد منها أن يتبعون اباءهم لذواتهم، كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
لهذا فأن القرآن الكريم جاء ليقول للناس أنكم لكم عقول، ولا ينبغي إتباع الآخرين بطريقة تجمد العقل، حتى لو كان هؤلاء آباؤكم، وهم اقرب الناس إليكم.
وهذا من منابع التنوير الديني في القرآن الكريم، الذي يدفع الإنسان لأن يتحرر من الركون إلى الاباء لمجرد أنهم يحملون هذه الصفة، فهذا لا يبرر له أن يعطل عقله، ويجمد فكره، في مقابل معرفة الحق وإتباعه. وإنما عليه أن يستشعر الثقة والشجاعة في إعمال عقله، وينزع عن نفسه حالة القداسة التي تعمي العقل، وحالة التقليد التي تجمد الفكر.
ويقارب هذا المعنى ما أشار إليه الفيلسوف الالماني امانويل كانت، في نص شهير له، عندما أجاب في عام 1784م، على سؤال طرحته صحيفة ألمانية على مفكري ألمانيا في ذلك العصر، وكان السؤال ما هو التنوير؟
فأجاب كانت إنه خروج الإنسان عن حالة قصوره، ذلك القصور الذي يكون الإنسان ذاته مسؤولا عنه. وأعني بالقصور عجز الإنسان عن استخدام فهمه دون توجيه الآخرين. وأن الإنسان ذاته هو المسؤول عن ذلك القصور، لأن السبب لا يعود إلى عيب في الفهم، وإنما يرجع إلى غياب القدرة على اتخاذ الموقف، والشجاعة في استخدام الفهم دون قيادة الآخرين. واعتبر كانت أن شعار الأنوار يتلخص في هذه العبارة: أجرؤ على استخدام فهمك الخاص.
وما ذهب إليه كانت يماثل ما أراد أن يقوله القرآن الكريم عند حديثه عن إتباع ما وجدنا عليه اباءنا، فقد أراد القرآن أن ينبه الإنسان إلى عقله، لكي يتحرر من العجز والضعف والإحساس بالقصور في الفهم.
منبع التنوير الديني
حينما وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بالنور في قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض) ـ سورة النور آية: 35 ـ أراد أن يخبر بأنه مصدر ومنبع النور للإنسان في هذا العالم، وليس هناك مصدر ومنبع آخر يمكن أن يلجأ إليه الإنسان، بحثاً عن النور الذي يخرجه من الظلمات، وهذا يعني أن ما دون الله هو الظلمات.
وقد توقف المفسرون كثيراً أمام هذه الآية، قديماً وحديثاً، وهكذا الفلاسفة والحكماء، بحثاً وتأملاً في الحقل الدلالي لهذه الآية، وحكمها ومقاصدها، وتذوقاً لجمالية هذه الآية، وجميع الآيات جميلة، وهذا الوصف البديع. فليس هناك ما هو أبلغ من أن يصف الله تعالى ذاته بأنه نور السماوات والأرض، وليس باستطاعة أحد أن يدعي لنفسه مثل هذا الوصف.
والمعنى العام لهذه الآية أن الله ظاهر في ذاته كظهور النور، مظهر لغيره بما يشمل كائنات السماوات وكائنات الأرض، لأن بالنور تنكشف وتظهر الأشياء للعيان. والله تعالى هو أظهر شيء في هذا الكون، لأنه نور السماوات والأرض، وليس هناك ما هو أظهر منه، وكل شيء في هذا الكون، في السماوات والأرض يدل ويرشد إلى الله تعالى، لأن نوره يظهر على كل شيء.
ويرى السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره (الميزان) أن تعريف النور بالظاهر بذاته المظهر لغيره، هو أول ما وضع عليه لفظ النور، ثم عمم كل ما ينكشف به شيء من المحسوسات على نحو الاستعارة، ثم عمم لغير المحسوس، فعد العقل نوراً تظهر به المعقولات.
وبعد أن وصف الله ذاته بالنور، شبه هذا النور بمثال بديع في تتمة الآية السالفة الذكر، بقوله تعالى (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم).
في هذه الآية يشبه الله تعالى نوره على صورة مصباح يضيء الكون برمته، ومنه ينبعث النور في السماوات والأرض.
ويرى محمد إقبال أن وصف الله بالنور كما جاء على لسان اليهودية والمسيحية والإسلام، حين يفسر قياساً إلى العلم الحديث يعطي معنى، هو الأقرب في نظر إقبال إلى ذلك الوصف، فتعاليم الطبيعيات الحديثة، كما يقول، تقرر أن سرعة انتشار الضوء لا يمكن أن يفوقها شيء، وأنها واحدة بالنسبة لجميع الذين يشاهدونها مهما اختلفت طريقة حركتهم، وعلى هذا يكون الضوء أقرب الأشياء إلى المطلق. وإطلاق النور مجازاً على الذات الإلهية، يجب أن يؤخذ في رأي إقبال على أنه إشارة إلى أن الذات الإلهية مطلقة.
وهناك من حاول الاستفادة من التحليل العلمي لظاهرة النور في إطلاق هذا الوصف على الذات الإلهية، فالنور يتميز بعدة مزايا، منها:
1ـ أنه أجمل وألطف ما في هذا العالم، وهو مصدر لكل جمال ولطف.
2ـ أنه أسرع الأشياء إذ تبلغ سرعته ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية، وبإمكانه الدوران حول الكرة الأرضية سبع مرات في أقل من ثانية واحدة.
3ـ به يمكن مشاهدة الأشياء في العالم، ومن دونه يستحيل رؤية أي شيء.
وبالتالي فإن وصف الله بالنور، هو وصف بالجمال، والهيمنة المطلقة، والتأثير على كل شيء.
أما المفسرون فقد نظروا إلى تلك الآية من جهتين، طبيعية وتشريعية. طبيعية بمعنى أن الله منور السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم، وتشريعية بمعنى أن الله هاد لأهل السماوات، وهاد لأهل الأرض، ومزين السماوات بالملائكة، ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأئمة.
وحين أراد الراغب الأصفهاني في مفرداته لغريب القرآن، أن يجمل الحديث عن كلمة النور كما وردت في القرآن الكريم، اعتبر أن النور هو: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار، وذلك ضربان دنيوي وأخروي، فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن. ومحسوس بعين البصر، وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم والنيرات. فمن النور الإلهي قوله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتب مبين) وقال: (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقال: (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقال: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) وقال: (نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء).
ومن المحسوس الذي بعين البصر نحو قوله: (هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً)، ومما هو عام فيهما قوله: (وجعل الظلمات والنور) وقوله: (ويجعل لكم نوراً تمشون به ـ وأشرقت الأرض بنور ربها) ومن النور الأخروي قوله: (ويسعى نورهم بين أيديهم ـ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فالتمسوا نوراً).
وهذا يعني أن كل ما جاء من عند الله تعالى فهو نور، ومنبع للتنوير، وإننا ينبغي أن نتعرف على نور الله في السماوات، ونور الله في الأرض بالتفكر والتأمل والتعقل، لنكتسب المعرفة بعالم الطبيعة وعالم التشريع، وهذا هو منبع التنوير الديني.


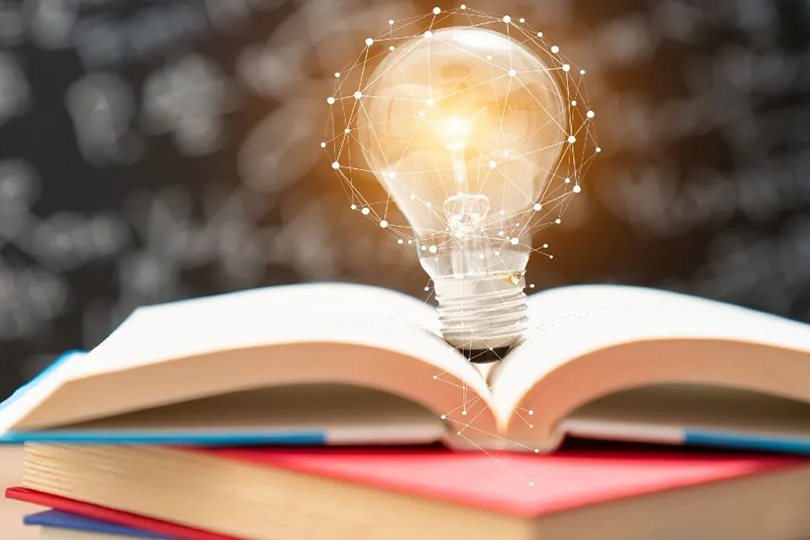

اضف تعليق