سؤال التنوير في حقيقته ليس سؤالا نظريا باردا، وليس القصد منه البحث عن المناظرة والجدل، ولا الخوض في لعبة المعاني والأفكار، وليس من غايته التعالي عن الواقع، والاندكاك في التجريد، كما أنه سؤال لا يأتي بمحض الصدفة، ولا ينبعث بصورة عفوية، ولا يظهر بلا ميعاد، وليس مكانه...
في هذا الظرف العصيب الذي تشتد فيه موجة التعصب والتطرف والتحجر التي تكاد تكتسح المنطقة العربية، وتغير من صورتها إلى صورة تغلب عليها حالة من الكآبة والإحباط والسلبية، في هذا الظرف تتهيأ الفرصة لطرح سؤال التنوير، وهذا ما يتنبه إليه عادة المفكرون في مثل هذه الوضعيات المظلمة، وذلك بفضل يقظتهم الفكرية، وحسهم التنويري، وخبرتهم النقدية، وأفقهم البعيد.
ويتصل بهذا السياق ما حصل في أوروبا القرن السابع عشر الميلادي، وتحديدا في ألمانيا التي شهدت حربا دينية عنيفة دامت ثلاثين عاما، عرفت في التاريخ الأوروبي الحديث بحرب الثلاثين عاما (1618-1648)، هذه الحرب حصلت بين أكبر مذهبين مسيحيين هناك هما الكاثوليك والبروتستانت، الحرب التي أطلقت معها موجة واسعة وشديدة من التعصب والتطرف، حولت الحياة آنذاك إلى وضع لا يطاق، لكنه الوضع الذي أطلق معه سؤال التنوير، وهذا ما يفسر بداياته في ألمانيا.
وهذا يعني أن سؤال التنوير في حقيقته ليس سؤالا نظريا باردا، وليس القصد منه البحث عن المناظرة والجدل، ولا الخوض في لعبة المعاني والأفكار، وليس من غايته التعالي عن الواقع، والاندكاك في التجريد، كما أنه سؤال لا يأتي بمحض الصدفة، ولا ينبعث بصورة عفوية، ولا يظهر بلا ميعاد، وليس مكانه الخواطر والخيال، فهذه وغيرها ليست في شيء من حقيقة سؤال التنوير.
فحقيقة سؤال التنوير أنه سؤال يظهر مع اشتداد الحاجة إليه، وفي ظل هذه الحاجة تتأكد قيمته، ويرتفع رصيده، ويتعاظم تأثيره، وتتجلى إشراقاته، ومن دون هذه الحاجة والتبصر بها، يتحول سؤال التنوير إلى سؤال باهت، لا فعل له ولا تأثير، ولا يتحرك إلا في فضاء ضيق، ولا يتصل إلا بشريحة محدودة من الناس.
ومن حقيقة سؤال التنوير أنه سؤال له فعل المواجهة، لا يركن إلى الواقع ولا يقبل الاستسلام له، لا يرضى بالسكون ولا يأنس بالجمود، ولا تنطلي عليه المهادنة ولا المخادعة.
والمواجهة في سؤال التنوير عمادها العقل والضمير والوجدان، باعتبار أن التنوير هو فعل إشراق على العقل ليقظته وإخراجه من أوهام الغفلة، وفعل إشراق على الضمير لصحوته وإخراجه من أوهام الضياع، وفعل إشراق على الوجدان لتنقيته وإخراجه من أوهام اليأس.
وأمام موجة التطرف نحن بحاجة إلى سؤال التنوير، لأننا أمام ظاهرة تعطل العقل، وتسلب من الإنسان حس التفكر، وتسد عليه منافذ الحكمة، وتشل قدرته على التبصر في عواقب الأمور، وتصيبه باليأس من المستقبل، وانسداد أبواب الأمل، وتقلب نظرته إلى الحياة وجماليتها، وتفتح عليه في المقابل الشعور بالتذمر، والإحساس بالإحباط، والاندفاع نحو المغامرات غير المحسوبة، وجميع هذه الحالات تقع على الضد من التنوير.
ونحن بحاجة إلى سؤال التنوير، لأننا أمام ظاهرة فيها من العماء الفكري، ومن القبح الأخلاقي، ومن الظلام الوجداني، ومن الجهل الديني، ومن الانحدار الجمالي، وجمع هذه الحالات لا تظهر وتتفشى بهذه الصورة المظلمة إلا في ظل غياب التنوير الذي يرفع درجة الوعي، ويعلي من قيمة العقل، ويبصر الإنسان بذاته وبعواقب أعماله، ويعمق حسه الأخلاقي، ويخرجه من دائرة من وصفهم القرآن الكريم (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) –البقرة:171-
ونعني بسؤال التنوير، السؤال الذي يقارب ظاهرة التطرف، ويلامس هذه الظاهرة على وجه الخصوص، ومن خلال هذا السؤال نضع التنوير في وجه التطرف، لنستثير جميع ممكنات التنوير في مواجهة هذه الظاهرة العبثية، والعمل على تفكيكها، وتفتيت بنيتها، وتقويض أسسها، وتحطيم أعمدتها، وتحويلها إلى ظاهرة منبوذة ينفر منها الناس ويستقبحونها، لا أن ينجذب إليها الناس ويستحسنونها، فلا بد من التغلب على هذه الظاهرة، وجعلها من الظواهر التي يصدق عليها صفة القبح في وعي عموم الناس.
ومع سؤال التنوير يتأكد دور المثقفين والمفكرين في مواجهة هذه الظاهرة، فعلى هؤلاء يقع الدور الأكبر في هذه المواجهة، فهذه هي ساحتهم، وهذه هي معركتهم، وهم الأعرف بأسلحتهم في هذه المواجهة، والانتصار فيها انتصار للتنوير، ولتعميم قيم التنوير حتى نعيد للإنسان كرامته، ونعيد للحياة جماليتها، ونعيد للمستقبل وعده وإشراقته.


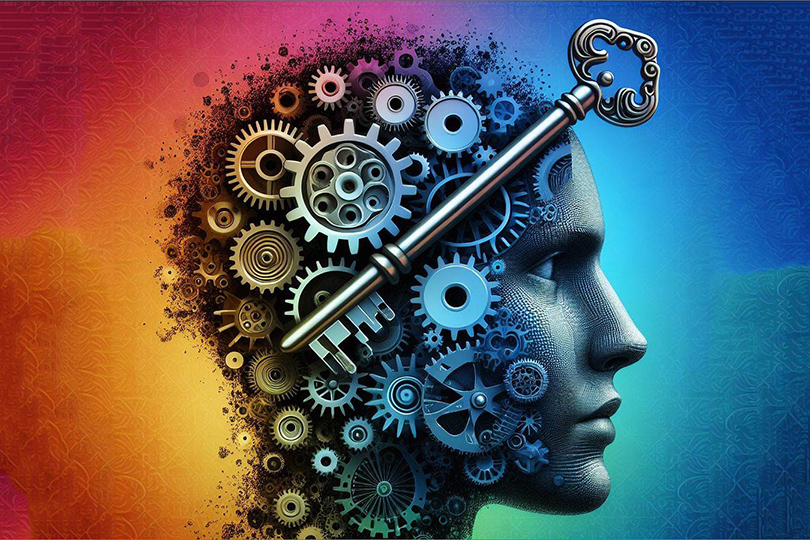

اضف تعليق