من أبرز العوامل التفكك الأسري، أو الإهمال العاطفي، أو ضعف الرقابة على سلوكيات المراهق قد يؤدي إلى نشوء مشاعر القلق والتوتر، مما يعزز من احتمالات الانحراف. كما أنَّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر، والبطالة، وتدني مستوى التعليم، تساهم بشكل كبير في خلق بيئة غير مستقرة للمراهقين، مما يزيد...
مرحلة المراهقة من أكثر المراحل التي يمر بها الفرد تعقيدًا، حيث تشهد تغيرات نفسية وجسدية وعاطفية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على سلوكه وتصرفاته؛ ومن بين هذه السلوكيات قد تظهر الانحرافات الأخلاقية التي تشكل تحديًا كبيرًا للأسر والمجتمعات على حدٍ سواء؛ إذ تمثِّل الانحرافات الأخلاقية عند المراهقين خروجًا عن المعايير الاجتماعية والأخلاقية المقبولة، مثل الكذب، والسرقة، والعنف، وعقوق الوالدين، وغيرها.
وتتنوع الأسباب التي تقف وراء هذه الانحرافات، سواء كانت نفسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، مما يجعل من الصَّعب تحديد حلول سريعة لها، وبالرغم من ذلك، فإنَّ معالجة هذه الانحرافات باتت ضرورة ملحة لحماية المراهقين من تبعاتها السلبية التي قد تؤثر على حياتهم المستقبلية وتنميتهم الشخصية.
وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على أسباب الانحرافات الأخلاقية عند المراهقين، والهدف من ذلك هو تقديم رؤية شاملة حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، ومعالجتها بعد ذلك بشكل فعَّال لتحقيق توازن صحي للمراهقين في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.
ذكر علماء اللغة لمادة الانحراف معانٍ كثيرة منها:
قال ابن منظور: «حَرفَ عن الشيء يحْرِف حرفاً وانْحَرَفَ وتَحرَّف وأحرورف: عدل. وإذا مال الإنسان عن شيءٍ؛ يقال: تَحرَّف وانحرف وأحرورف» (1). وقال الاصفهاني في مفرداته: «تحريف الشيء: إمالته» (2).
ومن هذه التعاريف اللغوية نستطيع أن نعرِّف، الانحراف بأنَّه: الخروج والعدول عن خط الاستقامة والميلان عنه؛ فإذا خرج الإنسان عن خط الاستقامة المرسوم له قيل عنه: إنَّه قد انحرف.
أما كلمة "المراهقة" في اللغة العربية فتعود إلى الفعل "راهق"، الذي يأتي بمعنى الاقتراب أو الدنو. يقال "راهق الغلام"، أي أنه اقترب من مرحلة الاحتلام، وبدأت تظهر عليه علامات التحول الجسدي والنفسي التي تميز مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الشباب. وبناءً على ذلك، فإنَّ "المراهق" هو الشخص الذي بلغ هذه المرحلة من العمر، أي الذي اقترب من مرحلة البلوغ، وبدأت تظهر عليه خصائص هذه المرحلة من تطور جسدي وعقلي وعاطفي (3).
إنَّ تشخيص الأسباب والجذور التي تقف وراء انحراف المراهقين له دور كبير في تحديد العلاج المناسب؛ فالمعالجة الحقيقية تبدأ من فهم العوامل التي تساهم في هذا الانحراف، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو ثقافية؛ إذ لا يمكن تقديم الحلول الفعَّالة ما لم يتم إزالة هذه الجذور، بل لا يمكن للتغيير أن يتحقق بشكل عميق إذا استمرت المشاكل الأساسية؛ ولهذا، من الضروري العمل على تقوية الوعي لدى المراهقين، وإرشادهم نحو مسارات إيجابية تضمن لهم حياة متوازنة وناجحة، بعد معالجة أهــم أســباب الانحراف، وهي:
أوَّلًا: تراجع دور الأسرة
تُعدُّ الأسرة هي الركيزة الأساسية في عملية التربية، وأي تقصير في هذه المرحلة يؤثِّر بشكل كبير على الأبناء؛ وقد أظهرت الدراسات التربوية أنَّ من أبرز الأسباب التي تؤدِّي إلى انحراف المراهق هو اضطراب الأسرة وعدم استقرارها؛ فعندما ينشغل الوالدان عن أبنائهم ولا يوليانهم الاهتمام الكافي، يُفتح الباب أمامهم للانحراف، وإذا نظرنا إلى حياة بعض الأشخاص الذين وقعوا في دائرة الانحراف، سنجد أنَّ الأسرة كانت هي البذرة الأولى التي نمت منها تلك التصرفات؛ ولهذا السَّبب، نجد أنَّ القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام تؤكد بشكل كبير على أهمية عدم التقصير في رعاية الأبناء؛ لأنَّ هذا الإهمال قد يؤدي إلى مشاكل جمَّة في المستقبل، ويؤثر سلبًا على المجتمع بشكل عام؛ قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(4).
وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (5).
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «...لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ اَلْعَاصِي يُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ اَلْأَدَبَ اَلسَّيِّئَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ اَلنَّارَ جَمِيعاً حَتَّى لاَ يَفْقِدَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً وَلاَ خَادِماً وَلاَ جَاراً» (6).
وينقل أنَّ طفلاً ذهب وسرق بيضة من بيت جيرانه، وجاء إلى البيت فقالت له أمه: من أين أتيت بهذه البيضة؟
قال: سرقتها من بيت الجيران، فقالت: أحسنت وأخذت تثني على ذكائه حيث استطاع أن يغافل الجيران ويسرق البيضة دون أن يُلتفت إلى ذلك.
أثَّرت هذه الكلمة في نفس الطفل فاستمر في عمليات السرقة وهكذا تطورت القضية إلى إن سرق بعد حين المجوهرات المودعة في الخزائن الخاصة للملك، ولما قبض عليه ورفع على المشنقة واجتمع الناس حوله ينظرون إليه رأى أمه واقفة تبكي فقال: أيُّها الناس اسمعوا مني هذه الكلمة: إنَّ أمي هي التي رفعتني على أعواد المشنقة وليس الملك!
فقالوا وكيف؟
قال: لأنَّ تلك الكلمة التي قالتها لي أمي في ذلك اليوم هي التي أدَّت بي إلى هذه النهاية (7).
قال الشاعر:
لَيسَ اليتيمُ مَن انتهى أبواهُ مِنْ --- هـَــمِّ الحيـاةِ وَخلَّفاه ذَليلا
أن اليَتيم هـُــوَ الــّـذي تلقى لَــــهُ --- أما تَخلَّتْ أو أباً مَشغولا (8).
ثانيًا: غياب العامل التَّربوي في المركز التعليمي
تحدث القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام عن فضل العلم؛ قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (9).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله: مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ طَرِيقاً إِلَى اَلْجَنَّةِ وَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضاً بِهِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلْحُوتُ فِي اَلْبَحْرِ وَفَضْلُ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ اَلنُّجُومِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ وَإِنَّ اَلْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ»(10).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «الْعِلْمُ أَعْظَمُ كَنْزٍ» (11).
وللمراكز التعليمية دور كبير في عملية التَّعليم، إلَّا أنَّ المشكلة التي تواجهنا اليوم تكمن في أن بعض هذه المراكز تركِّز اهتمامها بشكل أكبر على التَّعليم الأكاديمي دون أن تعطي التربية والتهذيب نفس القدر من الأهمية. وفي بعض الحالات، يتم طرح الدروس التربوية بنفس الطريقة الجامدة التي تُطرح بها الدروس العلمية مثل الفيزياء والكيمياء، مما يقلل من فاعليتها في التأثير على شخصية الطالب، أو تُعطى هذه الدروس للطلاب بهدف الامتحان فقط، وهذا أمر غير صحيح؛ فغاية العلم ليست مجرد اجتياز الاختبارات، بل تكمن في تطبيقه في الحياة اليومية وتهذيب شخصية صاحبه؛ وكذلك غاية العلم أن يكون أداة للتطوير الذاتي والتوجيه السلوكي، لا أن يُقتصر على حفظ المعلومات لتقديمها في الامتحانات؛ عن الإمــــام علي بن الحســين عليهما السلام: « مَكْتُوبٌ فِي الإِنْجِيلِ لَا تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ولَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِه لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُه إِلَّا كُفْراً، ولَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً»(12) .
إنَّ المركز التعليمي بمثابة البيت الثَّاني للطلاب بعد الأسرة، حيث يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل شخصياتهم وتوجيههم نحو المسار الصحيح؛ فالبيئة التعليمية ليست مجرد مكان للتعلم الأكاديمي، بل هي محطة تزرع فيها القيم والمبادئ التي يكتسبها الأبناء؛ وأي شيء يُغرس في نفوسهم، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، سيثمر في المستقبل، حتى وإن تأخر ذلك. فكما أن البذور الطيبة تُثمر فواكه طيبة، فإن البذور المنحرفة تُنتج آثارًا سلبية تُعكِّر مسار الفرد؛ لذلك، يجب أن تكون التربية والتعليم في هذه المراكز مليئة بالقيم البناءة والهادفة؛ لأن تأثيرها طويل الأمد في حياة الأبناء؛ عن أمـــــير المؤمنين عليه السلام: «قَلْبُ اَلْحَدَثِ كَالْأَرْضِ اَلْخَالِيَةِ مَهْمَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ» (13)، وغياب العنصر التربوي والتوجيه الصحيح يحول المؤسسة التَّعليمية إلى بيئة تساهم في الانحراف والتخبط.
ثالثًا: المجتمع وأصدقاء السوء
للمجتمع والبيئة التي ينشأ فيها المراهقون تأثير بالغ على سلوكهم، حيث تتشكل الأخلاق والعادات غالبًا نتيجة للبيئة المحيطة والأصدقاء الذين يؤثرون في قراراتهم وتصرفاتهم، وكثيراً ما يكون اكتساب هذه الصفات بشكل غير إرادي ودون وعي؛ فالمجتمع الصالح والصديق الطيب يشكلان سببًا رئيسيًا لاكتساب الفضائل والرشد، بينما يسهم المجتمع الفاسد في تبني الصفات السلبية؛ ولهذا نجد في القرآن الكريم والحديث الشريف الكثير من الآيات والروايات التي تحث على الابتعاد عن مصاحبة من يتمتعون بصفات سيئة، لما لها من تأثير سلبي على الفرد وسلوكه؛ قــال الله (سبحانه وتعالى ): (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا) (14).
وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام: إِنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ يُعْدِي وقَرِينَ السَّوْءِ يُرْدِي فَانْظُرْ مَنْ تُقَارِنُ» (15).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: «لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ ولَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِه وقَرِينِه» (16).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تَكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّتْنِ حَمَلَتْ نَتْناً» (17).
إنَّ قرين السوء من أخطر العوامل التي تؤدي إلى انحراف الشخص عن الطريق الصحيح؛ فعندما يرافق الإنسان من يُشجعه على المعصية ويُبعده عن القيم والمبادئ، يصبح من السهل على الشيطان أن يوسوس له بالأفكار السلبية ويدفعه إلى تجاوز الحدود الشرعية والأخلاقية، وفي هذه الحالة، تتحول الصداقات السيئة إلى وسيلة للانزلاق إلى السوء والابتعاد عن الاستقامة. وغالبًا ما نرى مراهقين ومراهقات كان لديهم الطموح والنية الطيبة، لكنهم وقعوا في شراك التأثيرات السلبية من قبل أصدقاء أو مجتمع سيء، مما جعلهم ينحرفون عن الطريق الصحيح؛ لذا من الضروري أن يكون الإنسان حذرًا في اختيار صحبته، وأن يسعى دائمًا إلى مصاحبة أهل الخير والصلاح، الذين يعينونه على طاعة الله تعالى وتحقيق أهدافه النبيلة في الحياة.
رابعًا: الجهل
الجهل: خلق ذميم ومعناه خلو النَّفس عن العلم، لا لنقص عقله، ولكن لعدم تعلمه وعدم محاولته في فهم الأمور بالبحث والقراءة والاستماع والمشاهدة وغيرها (18).
والجهل من العوامل الخطيرة التي تؤدِّي إلى انحراف المراهقين والمراهقات؛ فالمراهق الذي يفتقر إلى المعرفة ولا يعرف كيف يبدأ، ولا أين يذهب، ولا إلى أين سينتهي، يشبه الأعمى الذي قد يؤدي به جهله إلى الضياع والهلاك.
لاحظ كيف أن الله (تبارك وتعالى) يـأمرنا بالابتعاد عن الجهل والجاهلين لما ينتج عنهما من مفاسد كبيرة؛ قال الله تعالى: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )(19)؛ فالجهل أصل كل شر ومصدر للمفاسد، إذ يؤدي إلى غياب الوعي وقلة التجربة، ما قد يترتب عليه انحراف الشاب والفتاة عن الطريق السليم؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام: « الْجَهْلُ أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ»(20)، وعنه عليه السلام: « الجَهْلُ يَزِلُّ القَدَمَ»(21)، وعنه عليه السلام: « الْجَاهِلُ صَخْرَةٌ لَا يَنْفَجِرُ مَاؤُهَا وَشَجَرَةٌ لَا يَخْضَرُّ عُودُهَا وَأَرْضٌ لَا يَظْهَرُ عُشْبُهَا»(22).
ومما ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام:
وَفي الجَّهل قَبل المَوتِ مَوتٌ لأهلهِ --- وَأجســادَهم قبَل القبـُـورِ قبُورُ
وَانَّ امـرءاً لَـمْ يُحيى بالعـــلمِ مــيِّـت --- وَليسَ لهُ حتى النُشورَ نُشورُ (23).
خامسًا: الفراغ
وقت الفراغ: هو الوقت الذي يبتعد فيه الإنسان عن التزاماته، أو هو الوقت الذي لا يستخدمه في تحقيق منفعة دنيوية أو دينية.
وتظهر هذه الحالة؛ أي وقت الفراغ، بشكل خاص في الإجازات الصيفية والعطل الرسمية، وكذلك في الأماكن التي يزداد فيها معدل البطالة، وقد حذر المعصومون عليهم السلام من الفراغ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وكَثْرَةَ الْفَرَاغِ» (24)؛ لأنَّ الفراغ لا ينسجم مع فئة عمرية مليئة بالحيوية والنشاط والاندفاع نحو الإنتاج، بل هو عامل خطر على استقامة المراهقين.
ولذلك نجد في الروايات الشريفة الحث على الاهتمام بوقت الفراغ وعلى اغتنامه؛ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «اغتَنِمْ خَمساً قَبلَ خَمسٍ: شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قَبلَ فَقرِكَ، وفَراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، وحَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ» (25).
وعدم استغلال وقت الفراغ سيؤدي إلى سلبيات عديدة منها:
1ـ بغض الله سبحانه وتعالى للإنسان الفارغ.
2ـ تضييع الوقت الذي لا يمكن التفريط به لمن يريد التقدم والنجاح.
3ـ الفراغ قد يكون سبباً للعديد من الجرائم والانحرافات؛ لأن العبد الفارغ وخصوصاً غير المتعلم يكون صيداً سهلاً للشيطان.
4ـ الحسرة يوم الحساب لعدم استغلال هذا الوقت؛ ومما يقال: إن يوم القيامة يُقدَم للإنسان ثلاث صناديق، صندوق فيه أعماله الحسنة، وأخر فيه أعماله السيئة، والصندوق الأخير وفيه أوقات فراغه، وأكثر ما يندم الإنسان على هذا الصندوق يقول: «لو استغليت هذه اللحظات ولو بذكر الله عزَّ وجلَّ لكان خيراً لي» (26)؛ فالفراغ من الأمور المفسدة للمراهق إذا لم يستثمره بالشكل الصحيح؛ قال الشاعر:
إنَّ الشَّبابَ والفراغَ والجــدَّة --- مفسدةٌ للمرءِ أيُّ مفسدة (27).
إنَّ مرحلة المراهقة، عندما تكون مصحوبةً بالفراغ، قد تؤدي إلى الفساد والانحراف؛ فالمراهق، وبسبب حيويته وقوته، إذا لم يوجه طاقاته بشكل صحيح، قد يضيعها في أعمال غير مفيدة.
إضافة إلى ذلك، فإنَّ الفراغ يمنح المراهق وقتًا دون هدف أو مسار واضح، مما يفتح المجال للانحرافات أو الأفعال المدمرة. كما أن الجِدة، أو الحداثة، قد تكون سببًا في إغراء الشاب بأمور قد تكون ضارة له؛ وعلاج ذلك يكون بتوجيه المراهقين نحو الأنشطة المفيدة وتعليمهم قيم الاستفادة من الوقت، وتوفير الفرص التي تنمي مهاراتهم وتوجه طاقاتهم نحو الخير والإنتاج.
سادسًا: الفهم الخاطئ للحرية
الحريات التي منحها الإسلام لا مثيل لها في التاريخ؛ حيث يمنح الإسلام الحرية للمسلمين وغير المسلمين بشرط أن تكون هذه الحرية لا تضر بالآخرين؛ قال الله سبحانه وتعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (28).
وقال تعالى: (إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) (29).
وهناك تأكيد كبير على مبدأ الحرية في الإسلام لما لها من فوائد جمة تعود على الفرد والمجتمع، والحرية تكون مثمرة فقط إذا تحقق أمران:
الأمر الأوَّل: الفهم الصحيح للحرية، الذي يوازن بين حقوق الفرد وواجباته تجاه الآخرين، ويضمن أن تكون الحرية ضمن حدود لا تضر بالمجتمع أو تتعارض مع القيم الأخلاقية.
الأمر الثَّاني: التطبيق الصحيح للحرية بأن يتمتع الفرد بحقوقه كاملة، مع احترام حقوق الآخرين وضمان عدم التعدي على حرياتهم؛ وإذا حصل الفهم الصحيح للحرية، طبقت تطبيقاً صحيحاً وأثمرت، وإذا فهمت فهماً خاطئاً كانت منشأ للكثير من الآفات والانحرافات، وهذا ما نلاحظه في بعض المراهقين عندما نطرح عليهم سؤالاً عن سبب انحرافهم، فيجيبون بأنَّهم أحرار في تصرفاتهم، رغم أن هذه الحرية التي يتحدثون عنها خاطئة وتؤثر سلبًا على حياتهم ونفوسهم، وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه؛ مع أن للنفس حقوقًا معينة يجب أن تظل ضمن حدود تلك الحقوق، فإذا تجاوزتها تضررت تلك النفس، وامتد هذا الضرر ليشمل الآخرين أيضًا؛ ولاحظ حديث الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يشير إلى حقِّ النَّفس:
« وأمَّا حقُّ نفسِكَ عَلَيكَ: فَأنْ تسْتَوْفِيها في طاعَةِ اللهِ فَتُؤدِّي إلى لسانِكَ حَقَّهُ، وإلى سَمْعِكَ حَقَّهُ، وإلى بَصَرِكَ حَقَّهُ، وإلى يَدِكَ حَقَّها، وإلى رِجْلِكَ حَقَّها، وإلى بَطْنِكَ حَقَّهُ، وإلى فَرْجِكَ حَقَّهُ، وتسْتَعينُ بِاللهِ على ذلِكَ»(30)، وأما بالنسبة إلى ضرر الحرية الخـاطئة على المجتمع؛ فــيروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: « يُعَذِّبُ اللهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لَا يُعَذِّبُ بِه شَيْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ عَذَّبْتَنِي بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِه شَيْئاً. فَيُقَالُ لَه: خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الأَرْضِ ومَغَارِبَهَا فَسُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، وانْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، وانْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ. وعِزَّتِي وجَلَالِي لأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِه شَيْئاً مِنْ جَوَارِحِكَ» (31).
سابعًا: البطالة
تُعرف البطالة بأنها حالة انعدام الفرص الوظيفية للأفراد القادرين والراغبين في العمل، وهي مشكلة اقتصادية تُفضي إلى العديد من التحديات النفسية والاجتماعية. وتنتج هذه الظاهرة عن مجموعة من العوامل المتنوعة؛ أبرزها: عدم حرية الزراعة والعمارة والتجارة وما أشبه ذلك، وجعل ما يقيِّد شخص الإنسان، كالحدود الفاصلة بين البلدان، وقلة توفير فرص العمل، وغيرها من الأسباب (32).
وتوجد علاقة قوية بين البطالة والحالة النفسية للفرد؛ فعندما يعاني الشخص من البطالة، يرافق ذلك الشعور القلق والكآبة والفشل والملل، مما يؤدي في النهاية إلى انحرافه عن الطريق الصحيح؛ عن الإمام الصادق عليه السلام: « إِيَّاكَ والْكَسَلَ والضَّجَرَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ، وإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ»(33)، وعنه عليه السلام: « مَنْ كَسِلَ عَنْ طَهُورِه وصَلَاتِه فَلَيْسَ فِيه خَيْرٌ لأَمْرِ آخِرَتِه، ومَنْ كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُ بِه أَمْرَ مَعِيشَتِه فَلَيْسَ فِيه خَيْرٌ لأَمْرِ دُنْيَاه»(34).
و« كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله إذا نَظَرَ إلى الرّجُلِ فأعْجَبَهُ، قالَ: هَل لَهُ حِرْفَةٌ؟
فإنْ قالوا: لا، قالَ: سَقَطَ مِن عَيْني.
قيلَ: وكيفَ ذلكَ يا رسولَ اللَّهِ؟!
قالَ: لأنَّ المؤمنَ إذا لَم يَكُن لَهُ حِرْفَةٌ يَعيشُ بدِينهِ» (35).
وهذا تحذير من أمر خطير؛ وهو أنَّ الشخص في كثير من الأحيان إذا عجز عن تأمين معيشته، فلن يجد أمامه سوى دينه ليبيعه.
ثامنًا: الفقر الشَّديد والثَّراء الفاحش
الفقر المدقع والغنى الفاحش يشكِّلان سببينِ رئيسيينِ للانحراف؛ فالفقر يدفع إلى السرقة والحقد والغيرة، وغيرها من الأضرار، ويعدُّ من أبرز أسباب القلق الذي يدمِّر إرادة الإنسان في كثير من الأحيان، مما يجعله يعيش حالة نفسية غير مستقرة؛ عن أبي الحسن عليه السلام قال: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله: «إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ»(36)، وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ الله عَنْه إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ(37) عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْه فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ»(38).
ومن الأسباب الرئيسية للفقر:
1ـ التهاون في دفع الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة ونحو ذلك؛ قال الله تعالى:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (39).
2ـ عدم العمل والاكتساب؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْكَسَلُ والْعَجْزُ فَنُتِجَا بَيْنَهُمَا الْفَقْرَ» (40).
3ـ التوزيع غير العادل لثروات البلاد؛ قال الله تعالى:( مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (41).
وقد اهتم الإسلام أشد الاهتمام بعدم وجود فقير واحد في المجتمع، ويُذكر أنَّه: «مَرَّ شَيخٌ مَكفوفٌ كبيرٌ يَسألُ، فقالَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام: ما هذا؟
قالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، نَصرانيٌّ.
فقالَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام: استَعمَلتُمُوهُ حتّى إذا كَبِرَ وعَجَزَ مَنَعتُمُوهُ؟! أنفِقُوا علَيهِ مِن بَيتِ المالِ» (42).
وكما أن الفقر يؤدي إلى الانحراف، فإنَّ الثَّراء الفاحش يقود أيضاً إلى التَّرف والفساد والتبذير؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله: إِنَّ الدِّينَارَ والدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وهُمَا مُهْلِكَاكُمْ» (43). وعن أبي عبد الله عليه السلام: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ فَارَقَهَا رِعَاؤُهَا أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهَا والآخَرُ فِي آخِرِهَا بِأَفْسَدَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ والشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ» (44).
وعنه عليه السلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُدِيرُ ابْنَ آدَمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا أَعْيَاه جَثَمَ لَه عِنْدَ الْمَالِ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِه» (45)؛ فالحديث يُظهر كيف أنَّ الشيطان يسعى جاهدًا لإغواء الإنسان في جميع مجالات حياته، وعندما يفشل في ذلك، يركز على ما يمكن أن يكون نقطة ضعفه الأكبر: المال.
فيصبح الشيطان في هذه الحالة شديد الإغواء للإنسان، حتى يُحْكِم قبضته عليه ويشغله بالمال، فيجعله يطغى ويتعالى ويقع في المعاصي بسبب تعلقه الزائد بالثروة.
تاسعًا: ضعف الدّين لدى الإنسان
قال الراغب في مفرداته: «الدِّين يقال للطاعة والجزاء، واُستعير للشريعة، والدِّين كالملَّة لكنه يُقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة» (46).
وكلَّما كان الإنسان أكثر تمسكًا بدينه، كان أبعد عن الانحراف؛ لأنَّ الدِّين يشكِّل حصنًا قويًا يحميه من الذنوب والمعاصي، وكلَّما ابتعد عن الدِّين، كان ذلك يعني ابتعاده عن طريق الاستقامة؛ قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (47).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «الدِّينُ يَصُدُّ عَنِ المَحَارِم» (48) وضعف الدِّين لدى الفرد يعد سببًا رئيسيًا للضياع؛ فالدِّين هو أساس الشَّخصية وميزانها. وعندما يفتقد الإنسان هذا الأساس، يتخبط في حياته ويتنقل بلا استقرار. ولو أجريت دراسة، لوجدت أن أغلب المراهقين المنحرفين ينحدرون من أسر ضعيف فيها تأثير الدِّين.
ومما ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام:
لَعَمْــــــــرُكَ ما الإنسآنُ إلَّا بِدينِـــــــــــهِ --- فَلا تترُكِ التَقــــــــوى إتِكآلاً على النَسَــــــبْ
فَقَدْ رَفَعَ الإســــــلامُ سلمانَ فـــــــــارِسٍ --- وَقَدْ وَضَعَ الشِـــــــركُ الشَريف أبا لَهَـــــــبْ (49).
عاشراً: الإعلام المُضل
عُرِّف الإعلام بتعاريفٍ عديدةٍ، ومن هذه التعاريف أنَّه: «عملية نقل وقائعٍ وأحداثٍ، أو تفسير لحالةٍ معينةٍ أو إرشادٍ إلى قضيةٍ ما، أو ما أشبه ذلك ونقلها عبر رسائلٍ مكتوبةٍ أو مسموعةٍ أو مرئيةٍ وقوامه الإنسان والتقنية، والفكرة، والمجتمع، وحرية تداول الحقائق»(50) ويعد الإعلام المضل اليوم من أبرز المؤسسات التي تساهم في انحراف المراهقين أخلاقياً، ومن أبرز وسائل الإعلام في هذا السياق هو التلفاز، الذي يمكن أن يكون بمثابة معلم للمراهقين والمراهقات في تعليم العادات السيئة في بعض الأحيان؛ فقد أظهرت الدراسات أنَّ تعرض المراهقين والمراهقات للأفلام التي تحتوي على مشاهد العنف والسرقة يسهم بشكل كبير في تبني هذه السلوكيات، ومع تكرار هذه المشاهد، تصبح جزءاً من واقعهم النفسي، مما يدفعهم إلى تقليدها دون إدراك عواقبها.
وهناك وسائل إعلامية أخرى تساهم في الانحراف مثل المجلات، والإذاعة، والكتب المضللة، إلَّا أنَّ التلفاز يعد من أخطرها؛ لأنَّه يستهدف حاستي السمع والبصر معًا؛ ولهذا نجد النصوص الشريفة تؤكد على أهمية مراقبة الحواس، خاصة السمع والبصر، لما لهما من تأثير كبير على صلاح الإنسان أو انحرافه؛ قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(51).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: «النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً» (52) وعن الإمامٍ زين العابدين عليه السلام: «وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقًا إلَى قَلْبكَ إلَّا لِفُوهَة كَرِيمَة تُحْدِثُ فِي قَلبكَ خَيْرًا أَو تَكْسِبُ خُلُقًا كَرِيمًا فَإنَّهُ بَابُ الْكَلامِ إلَى الْقَلْب يُؤَدِّي إلَيْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِن خَيْر أَو شَرِّ. وَلا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» (53).
في ختام مناقشة أسباب الانحرافات النفسية والسلوكية لدى المراهقين، يتضح أن هذه الانحرافات تنشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل المتنوعة، ومن أبرز هذه العوامل، البيئة الأسرية التي تلعب دورًا محوريًا؛ فالتفكك الأسري، أو الإهمال العاطفي، أو ضعف الرقابة على سلوكيات المراهق قد يؤدي إلى نشوء مشاعر القلق والتوتر، مما يعزز من احتمالات الانحراف. كما أنَّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر، والبطالة، وتدني مستوى التعليم، تساهم بشكل كبير في خلق بيئة غير مستقرة للمراهقين، مما يزيد من تعرضهم للمشكلات النفسية والسلوكية.
علاوة على ذلك، فإن تأثير وسائل الإعلام الحديثة يعد من العوامل المؤثرة بشكل كبير في تشكيل سلوكيات المراهقين؛ فالتعرض المتكرر للمحتوى الذي يعزز من قيم سلبية مثل العنف أو التفكك الاجتماعي يساهم في تبني هذه السلوكيات من قبل المراهقين والمراهقات. بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم الضغوط الاجتماعية والعاطفية، مثل ضغط الأقران، في دفع المراهقين نحو الانحرافات السلوكية، خاصة في ظل ضعف الوعي والإرشاد من قبل الأهل والمجتمع.
وبعد ذلك لا يمكن إغفال أيضًا دور المؤسسات التعليمية في هذا السياق؛ فغياب البرامج التربوية والتوجيهية المناسبة داخل المدارس قد يؤدي إلى نقص في الوعي الذاتي لدى المراهقين، مما يسهم في انحرافهم عن المسار السليم. وفي النهاية، تتداخل هذه العوامل لتخلق بيئة محفزة على الانحراف، مما يبرز الحاجة إلى التوعية والتوجيه المبكر لتفادي هذه المشكلات.


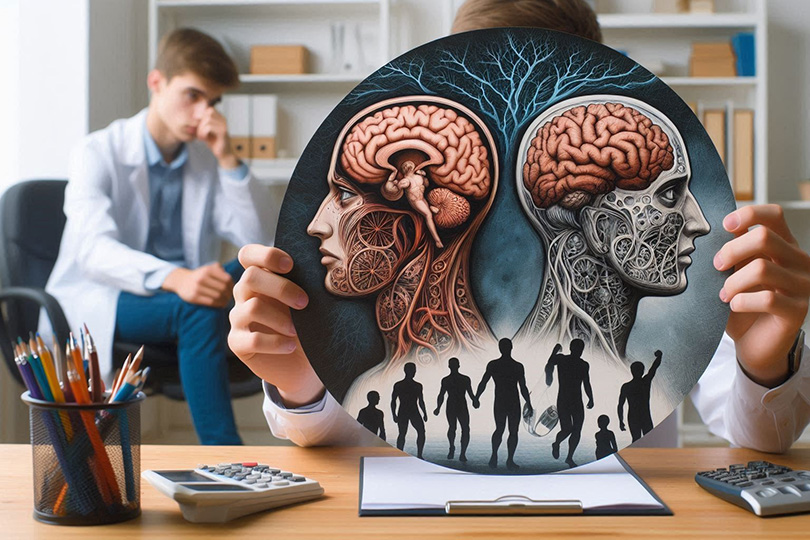

اضف تعليق