الفساد الشخصي، وهو صورة فردية لفساد الأخلاق، تسهله حالة الحضارة الحديثة، التي تتميز بظهور وسيادة الفرد المجتث، المنعزل، المستقل، ترك لمتعته الخاصة. مشهد فساد الأخلاق وإغراءات الرشوة الشخصية هي فرصة لسماع حكم الأخلاقيين مرة أخرى بل وأكثر من ذلك حكم الحكماء والأذكياء. ولكي نقاوم التأثير المفسد للمال...
الترجمة:
"من غير المرجح أن يكون أي منا واضحًا بشأن علاقتنا بالمال. وبدلا من استنكار ذلك، يجب علينا أن نعترف بأنه لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، لأن هذه العلاقات شديدة التنوع والتناقض والتشابك. إنها تراث عصور مختلفة، ولم يتم إلغاء أي منها بشكل نهائي. وليس من المؤكد حتى أن مثل هذا الموقف الذي يتميز به الماضي البعيد لن يجد شرعية جديدة، في ظروف يصعب التنبؤ بها.
سأفكر في ثلاث طبقات في مخيلتنا فيما يتعلق بالمال: طبقة أخلاقية، وطبقة اقتصادية، وطبقة سياسية. إذا لم يكن من الخطأ أن نقول إن المشاعر والمواقف المتعلقة بالثانية لم تنضج إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وإذا كان اليوم هو ما نفترضه أكثر من غيره، على الرغم من أن المشاكل تندرج تحت المستوى الثالث، فإن الارتباك الحالي لدينا وتنتج المشاعر من حقيقة أن السلوكيات المكتسبة في أوقات مختلفة تظل بطريقة ما معاصرة لبعضها البعض في عمق الحاضر.
أولا: المستوى الأخلاقي
لقد كان ذلك المال مناسبة لردود فعل أخلاقية قوية تستحق شرحاً مفصلاً. للوهلة الأولى، يبدو المال غريبًا بحكم تعريفه على المجال الأخلاقي. كوسيلة للدفع، وبعبارة أخرى، باعتبارها المال، فهي مجرد إشارة مجردة، وسيلة بسيطة للتبادل. ومن ثم فإننا نميل إلى القول إن السلع المتبادلة، وهي الأشياء الحقيقية لرغبتنا في الاستحواذ والحيازة، هي وحدها التي ينبغي أن تخضع للحكم الأخلاقي وأن يطلق عليها اسم الخير أو الشر. كوسيط محايد وعالمي، ألا يقتصر المال على التعبير عن القيمة السوقية المشتركة للسلع المتبادلة، حيث يكون السعر هو مقياس هذه القيمة؟ محايدة اقتصاديا، لماذا لا تكون محايدة أخلاقيا؟ أو بالأحرى، ألا ينبغي اعتبارها مجرد سلعة جيدة، ما دامت، على النقيض من المقايضة، تفتح مساحة مزدوجة من الحرية للمشتري والبائع؟
لكن المنطق البسيط للغاية مضلل. وينتج السعر عن منافسة الرغبات المطبقة على السلع النادرة المقدمة لشهية الجميع؛ ولذلك فإن عظمة الممتلكات المكتسبة تحمل علامة عدم تحقيق رغبات الآخرين. وهكذا يتم إخفاء لعبة صغيرة قاسية في أدنى تبادل، حيث يبدو في البداية أن حرية أحدهما في الاستسلام وحرية الآخر في الاختيار هي التي تلعب دورًا. إن استبعاد طرف ثالث غير مرئي واضح وراء لفتة البيع والشراء البسيطة. ولكن هذا ليس كل شيء، أو حتى الشيء الرئيسي؛ وبقدر ما يكون المال محايدًا فيما يتعلق بالسلع التي يسمح بتبادلها، فإنه يشكل موضوعًا متميزًا للرغبة؛ إن امتلاك الوسيط العالمي يعني امتلاك مفتاح الحكم الحر لجميع معاملات السوق. عند هذا المستوى يأتي دور الأحكام الأخلاقية، خارج أي تحليل اقتصادي.
وهذه الأحكام مهمة جدًا لدرجة أن الدفع الذي سيظهر لاحقًا لصالح الارتباط التجاري لا يمكن سماعه إلا على حساب الحجة نفسها التي يتم إجراؤها على أسس أخلاقية. وسنورد هنا تلك الحجج التي تتأرجح بين عدم الثقة والإدانة الصريحة. على عكس الرغبات المرتبطة بسلع المتعة، فإن الرغبة في الحصول على المبادل الشامل لا تتضمن في حد ذاتها أي إجراء؛ فلا معنى للحديث عن الرضا؛ لقد كررها الأخلاقيون من جميع المعتقدات والتقاليد: الجوع إلى الذهب لا يشبع؛ هناك نوع من "اللانهاية السيئة" يسكن هذا دائمًا، وهو ما لا يكفي أبدًا. لقد نقل الأخلاقيون المسيحيون، من الآباء إلى السكولاستيين الكبار، فقط الأخلاقيين اليونانيين عن فصل الاعتدال؛ إن فكرة أرسطو عن الوسيلة السعيدة بين الإفراط وعدم الكفاية تهدمها رغبة غير محدودة تحمل الآن علامة الخطيئة. وأقوى حجة تكمن في وصف هذه الشهوة بالهوى، إذا فهمنا بالهوى شيئاً آخر غير الشهوات؛ الرغبات تحد من بعضها البعض. في العاطفة يضع الفرد كل ما لديه؛ البشر وحدهم هم من يملكون القدرة على استهداف الرضا الكامل، حقًا أو خياليًا، وهو ما يسمونه أحيانًا السعادة؛ وعندما يتم تحديد سلعة واحدة بهذه الكلية، فإن الارتباط بهذا الخير يصبح كليًا؛ أما الآن، فإن المال، بسبب حياده وعالميته، المرتبط بقوة الاستحواذ غير المحددة التي يوفرها، هو موضوع الحلم، إذا جاز لنا أن نقول، لمثل هذا الاستثمار الشامل. هذه العاطفة تسمى الجشع.
ويقول لوروبر إن البخيل "يعشق الثروات ويستمتع بتكديسها على الدوام". ولكن هل "أن تكون سعيداً" يعني أن تكون سعيداً؟ يشكك الأخلاقيون في ذلك؛ إن خيال الاستثمار الكامل للرغبة في شيء واحد يجعل من العاطفة معاناة يلحقها المرء بنفسه: ألا يطلق اسم الألماني "Leidenschaft" لايدنشافت على العاطفة؟ هنا، لدى الأخلاقيين المسيحيين ما يقولونه أكثر تحديدًا من الأخلاقيين القدامى، بقدر ما أن الشغف بالذهب، من خلال احتلال المدى الكامل للرغبة، لا يترك مجالًا لمحبة الله التي وحدها يمكن أن تكون كاملة. إن خطيئة الجشع مميتة بالمعنى الحرفي للكلمة، بقدر ما تفصلنا عن الله تمامًا. قلنا الجوع الذي لا يشبع للذهب؛ شغفه يستهلك كل شيء. وعلى هذا الانتقاد للجشع يمكننا أن نطعم الإدانة الإضافية التي فرضتها ممارسة الحياة الرهبانية ونذر الفقر على جميع الممارسات الدنيوية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة والربح. من المؤكد أن الحياة العلمانية، في حد ذاتها، لا تعتبر سيئة، ولكن، مثل الزواج، يعاني العمل من المقارنة مع البحث عن الكمال المرتبط بحياة الدير. مع القديس فرنسيس، لم يعد الراهب المسيحي مجرد رجل دين ورجل ترفيه، مثل الحكيم القديم، بل "فقير". يتم الاحتفاء بالفقر باعتباره عظمة إيجابية بسبب المساحة التي يفتحها للروح المتحررة من الرغبة في الاكتساب والتملك. صحيح أن الإصلاح اللوثري والكالفيني عكس هذا الحكم السلبي على المال والتجارة، وفي الوقت نفسه أدان النذور الرهبانية وأعاد تأهيل العمل العلماني المزين بهالة الدعوة. لكن لا يزال يتعين إثارة حجة خاصة بالمهن المالية، من بين جميع المهن: الحجة القائلة بأن المال، كونه غير منتج، لا يستحق، عندما يُقرض، راتبًا خاصًا به؛ ولا شيء يفصل بين القرض بفائدة والربا.
يتذكر ج. لو جوف في كتابه "من أجل عصر وسطى آخر" أنه إذا لم يكن التاجر في العصور الوسطى مكروهًا كما قيل، وحتى لو كانت الكنيسة تحميه وتفضله في وقت مبكر جدًا، "فإنها قد سمحت منذ فترة طويلة لشكوك جدية بأن تحيط به" تخيم على نشاطها... وفي مقدمة هذه المظالم الموجهة ضد التجار، اللوم على أن أرباحهم تنطوي على رهن زمني لا يعود إلا لله" (ص 46). وهذه الحجة مثيرة للاهتمام بقدر ما تصل إلى النقطة التي تنطوي فيها الحياة الاقتصادية على رؤية كاملة للعالم، والذي يشكل الزمن بعدًا أساسيًا فيه. الآن أصبح وقت التجار فرصة للربح، إما لأن المُقرض يستغل انتظار السداد من قبل المقترض المعدم مؤقتاً، أو لأنه مستغلاً فرصة الوضع يلعب على فروق الأسعار بين الأسواق، إما لأنه فهي تخزن تحسبا للمجاعات، أو لأنها - وهذا سيكون لاحقا مصدر حجة مضادة لصالح القروض بفائدة - فإنها تفرض رسوما على المخاطر التي تتكبدها بضائعها على الطرق البرية أو البحرية. بكل هذه الطرق، "يبني التاجر نشاطه على فرضيات يكون الزمن هو نسيجها ذاته". "هذه المرة تتعارض مع الكنيسة التي تنتمي إلى الله وحده ولا يمكن أن تكون موضوعًا للربح" (المرجع نفسه).
وعلى هذا الأساس بالذات ينهار الإصلاح، من خلال تسليم جميع الأنشطة الدنيوية إلى المسؤولية الإنسانية. رسالة من كالفن إلى كلود ساشين مثيرة للاهتمام للغاية في هذا الصدد: “لأننا إذا دافعنا تمامًا عن الربا [القرض بفائدة ليس له اسم آخر] فإننا نقيد الضمائر من رباط أقوى من الله نفسه. » في الحقيقة، "ليس هناك شهادة في الكتاب المقدس تدين كل الربا بشكل كامل... شريعة موسى (تثنية 23، 19) هي شريعة سياسية، لا تربط عقل الإنسانية إلا بالإنصاف والعدالة.." ومن المؤكد أنه سيكون من المرغوب فيه أن يتم طرد الربا عن الجميع، حتى لو كان الاسم غير معروف. ولكن لكي يكون هذا مستحيلاً، يجب علينا أن نستسلم للمنفعة المشتركة” (أوبرا أمنية، المجلد العاشر، الجزء الأول، ص 245).
ثانيا. الخطة الاقتصادية
من الجدير بالملاحظة أن الرأسمالية الوليدة، لكي تحظى بالقبول، قامت بالدفاع عن نفسها على نفس الأرض التي كانت فيها الرغبة في المال والبضائع موضع إدانة من جانب الأخلاقيين المسيحيين. وفي هذا الصدد، يشكل قبول الرغبة في الإثراء تغييراً حقيقياً على المستوى الأخلاقي. وكما أظهر ألبرت هيرشمان في كتابه "عواطف واهتمامات"، فإن الانقلاب كان منهجياً في البداية. يرفض سبينوزا الموقف المعياري، ويقترح في الكتاب الثالث من الأخلاق اعتبار "أفعال الإنسان وشهواته كما لو كانت مسألة خطوط أو مستويات أو أجساد". وهو متشكك في قوة العقل على العواطف، ويؤكد أن "العاطفة لا يمكن إحباطها أو قمعها إلا من خلال عاطفة تتعارض مع العاطفة التي يجب معارضتها وأقوى منها". وهو بذلك يكرّس، بعيدًا عن أي نية أخلاقية، موقف العديد من مراقبي الطبيعة البشرية الباحثين عن العاطفة التعويضية، القادرة على هزيمة المشاعر الأكثر تدميرًا، تلك التي تحرك الأمراء بشكل رئيسي في حب المجد والشجار والحرب. وعلى خلفية هذه الأفكار المتشائمة جدًا، فيما يتعلق بكل من إمبراطورية العقل الضعيفة والتأثير المدمر للعواطف العنيفة، يرى هيرشمان أن موضوع العواطف التي يتم ترويضها بالمصلحة يبرز، وأن يتم فهم هذا بمعنى العقلانية.
حب الذات؛ إن الفائدة، بمعناها الأوسع، تشير إلى استبدال العنف بالحساب عبر مجموعة كاملة من المشاعر. هكذا توصلنا إلى أن نرى في العاطفة، التي تسمى حتى الآن الجشع أو الجشع أو الجشع، نموذج الاهتمام القادر على كبح الأهواء الأخرى مثل الطموح أو حب السلطة أو شهوة الجسد. إن الاهتمام، الذي يُفهم بالمعنى المحدود للشهوة لتحقيق الربح، يظهر الآن كعاطفة باردة، والتي، لأن ثباتها يجعلها قابلة للتنبؤ وبالتالي جديرة بالثقة، "لا يمكن أن تكذب"، كما يقول المثل السائد في هذا العصر. وإذا انتقلنا من المجال الخاص إلى المجال العام، أليس صحيحا أن التجارة هي المهنة الأنسب للحفاظ على الأخلاق السلمية، ضد جنون الأمراء القاتل؟؟ بالمقارنة مع العقل الأرستقراطي، فإن العقل التجاري هو بالتأكيد مقر المشاعر "اللطيفة". إن اقتران الكلمتين "حلو" و"تجارة"، الذي يأتي من مجال المحادثة، يمتد الآن إلى المجال التجاري بأكمله. هكذا تم رد محبة المال إلى المستوى الذي كانت فيه مُدانة سابقًا، وذلك تحت عنوان العاطفة السلمية. بعد كسب السبب الأخلاقي للمال، والتمييز بين الفائدة والعاطفة، الذي تم استخدامه للدفاع لصالحه، سيصبح عديم الفائدة، وسيكون من الممكن أن يتم تبرير البحث عن الربح على مستوى الاقتصاد الوحيد.
اكتمل هذا التغيير في الخطة بنشر كتاب ثروة الأمم لآدم سميث في عام 1776. ولم يُؤخذ في الاعتبار الآن سوى المزايا الاقتصادية التي قد تنجم عن إزالة العقبات التي تعترض البحث عن الربح (لأن آدم سميث لا يشاركه بأي حال من الأحوال التفاؤل). "من مونتسكيو فيما يتعلق بالآثار السياسية السعيدة للتنمية الاقتصادية، حيث لا تزال السياسة تبدو له وكأنها مستسلمة لـ "جنون البشر"). يقتصر النقاش على الافتراض الأساسي، “الذي بموجبه فإن أفضل طريقة لضمان التقدم (المادي) لمجتمع ما هي السماح لكل فرد من أعضائه بمتابعة مصلحته (المادية) الخاصة به على النحو الذي يراه مناسبًا” (هيرشمان، 102). فماذا عن تفكيرنا بشأن المال؟ وفي قدرة البحث دون عوائق عن الربح على إيجاد نوع جديد من الرابطة الاجتماعية، يكمن البديل الحقيقي الذي اقترحه الاقتصاد السياسي، في نهاية القرن الثامن عشر، للمقاربة الأخلاقية السابقة. تبادلات السوق، ومضاعفة العلاقات بين الأفراد، وتحررهم من قيود التبعية الشخصية.
علاوة على ذلك، فإن الارتباط التجاري يتكون من "تآلف رغبات" حقيقي، وفقًا للتعبير السعيد ل ل. بولتانسكي و ل. ثيفينو في كتابهما "عن التبرير": "إن الأفراد، الذين يتمتعون بنفس الميل إلى التبادل، يشرعون في تحديد مشترك للسلع". يتبادلون. لكن هذا التعريف المشترك الذي يعكسه السعر لن يكون ممكنا إذا لم يتمتع الأفراد بتصرفات متعاطفة يستطيع كل فرد من خلالها أن يحتضن أذواق وعواطف الآخرين؛ ومن خلال ذلك لا تؤدي المنافسة إلى تفريق الأفراد، بل تنجح في ربطهم ببعضهم البعض. يمكن للمؤلفين المذكورين بعد ذلك أن يتحدثوا عن الارتباط التجاري باعتباره تأسيسًا لـ "مدينة"، "عالم". من الواضح أن كل شيء يعتمد على قدرة العلاقة التنافسية البحتة على إحداث تأثير تنسيقي. لكن التحرر المنهجي للاقتصاد، الذي يؤدي إلى تحييد كل التقديرات السلبية المتعلقة بالنقود، لا يشكل سوى نصف الصورة، إن جاز التعبير، الوجه الآخر. ما يجب أن نفهمه هو "الغزو التدريجي لجميع مجالات الحياة الخاصة والعامة والاجتماعية والسياسية، من خلال منطق الاقتصاد والسلع... الاقتصاد هو الشكل الأساسي للعالم الحديث، والمشاكل الاقتصادية هي الحل". اهتماماتنا الرئيسية. ومع ذلك، فإن المعنى الحقيقي للحياة يكمن في مكان آخر. الجميع يعرف ذلك. الجميع ينسى ذلك. لماذا؟ ". هكذا عبر ج ب دوبوي وب دوموشيل في جحيم الأشياء. رينيه جيرار ومنطق الاقتصاد (1979).
بهذا السؤال نفسه يعود ج ب دوبوي في كتابه الأخير. التضحية والحسد. الليبرالية تتصارع مع العدالة الاجتماعية (1992). إنه يريد الرد على لويس دومون، الذي لا يعتبر السؤال الرئيسي بالنسبة له منهجيًا؛ إن تكوين الاقتصاد كعلم دقيق في مجال مستقل ومتخصص في الشؤون الإنسانية لا يكون له معنى إلا عندما تدعمه حركة روحية، وهي حركة الفردية الحديثة. الإنسان الاقتصادي هو الفرد الحديث، بلا جذور ولا روابط، مثقل بنفسه في عزلة مقفرة. إن العلم الذي يمثل هذا الفرد قضيته الحقيقية لا يمكنه إلا أن يؤسس استقلاليته وخاصة سيادته على حساب عمليات اختزالية وتبسيطية مؤسفة. الفردية المنهجية، التي تعكس الفردية كنموذج للمجتمع، تتعارض مع شمولية المجتمعات الهرمية. خارج نطاق الاندماج في مجموعة، بغض النظر عن أي موافقة رسمية، لا يمكن للفرد إلا أن يبرز نفسه، وفقًا للويس دومون، في حيلة العقد المبرم بين الذرات البشرية. في مقابل هذا التفسير المتشائم لرجل الاقتصاد، يعارض ج ب دوبوي التقليد العظيم للفردية الليبرالية، النابعة من عصر التنوير الاسكتلندي، والذي كان آدم سميث على وجه التحديد المبشر الرئيسي له. إن المسألة منهجية في المقام الأول: إنها مسألة معرفة ما إذا كانت الفردية المنهجية يمكن أن تكون غير اختزالية، وما إذا كان يمكنها أن تفكر في مجتمع السوق كنظام عفوي أو منظم ذاتيًا، وعلى أساسه ينتصر الفرد وينتصر.
عهد العدالة الاجتماعية. وللتأكيد على الاحتمال البسيط، على حافة التطور الذي سيقود من آدم سميث إلى جون راولز، وروبرت نوزيك، وفريدريك هايك، من المهم العودة، في إطار عمل آدم سميث نفسه، من ثروة الأمم إلى نظرية المشاعر الأخلاقية، كتبها قبل سبعة عشر عامًا وأعاد آدم سميث إصدارها للمرة السادسة قبل وفاته. لقد افترضنا أعلاه أن مجموعة الرغبات لا يمكن أن تولد رابطة اجتماعية دون مساعدة ودعم من التصرفات المتعاطفة. وهذا يعني أن الاقتصاد لا يمكنه أن يسمح إلا بكتابة أطروحة جديدة عن الأهواء. ومن اللافت للنظر في هذا الصدد أن نظرية آدم سميث عن المشاعر الأخلاقية لا تدين بأي شيء للاقتصاد؛ على العكس من ذلك، هي التي تسلحها ضد الانجراف الأناني. يجب علينا بعد ذلك أن نفهم بوضوح كيف أن التعاطف لا يتفق فقط مع حب الذات، أي الاهتمام بشخصنا، بل إنه متحد معه تمامًا لدرجة أنه لا يهم. يجب علينا بعد ذلك أن نفهم أن التعاطف، وهو الشعور الأخلاقي الرئيسي والوحيد، لا ينبغي الخلط بينه وبين الخير، وأنه يفترض انفصال الكائنات، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يرتكز إلا على الخيال الذي بفضله أصبح الآخر في الفكر. ومن خلال الدخول في تكوين مع حب الذات، يشهد التعاطف على النقش البدائي للنقص في العلاقة بين الذات وذاتها. هل فتحنا، مع ذلك، بديلاً متميزًا تمامًا للوحة ل. دومونت عن الإنسان الاقتصادي؟ هل يمكن إذن أن يكون هناك فردان، فردانية الذات المستقلة وفردانية الذات المستقلة، لاستخدام تمييز آلان رينو في عصر الفرد (1989)؟ سيكون هذا هو الحال إذا تم التعبير عن التعاطف بالكامل في النموذج الذي يستمده ج ب دوبوي من شخصيته المزدوجة والمتبادلة، أي تلك الحلقة المرجعية الذاتية (حب الذات) التي تربط الذات به - حتى من خلال المجتمع (التعاطف).إنها على وجه التحديد واحدة من أبرز المساهمات التي قام بها جيه بي دوبوي في إعادة قراءة أعمال سميث، حيث سلط الضوء على التناقض النفسي والأخلاقي على حد سواء، والذي يتأثر به التعاطف بشكل أساسي. يغلف نقيضه، وهو الحسد، أي الرغبة في الحصول على ما يملكه الآخر، لأنه هو من يملكه. ويخبرنا سميث، ج ب دوبوي، أنه كان حريصًا على مواجهة هذه الصعوبة الكبرى بإضافة فصل إلى الطبعة السادسة من كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" فصلًا بعنوان: "حول فساد مشاعرنا الأخلاقية، الناتج عن ميلنا إلى الإعجاب بالمشاعر الأخلاقية". الأغنياء والعظماء واحتقار أو إهمال الفقراء والبائسين." لاحظ العلاقة بين الأغنياء/العظماء والفقراء/البائسين. تُفهم حالة الغنى على أنها حالة عظمة، وحالة الفقر على أنها حالة صغر. الآن يستهدف الحسد هذه الدول. إنه “ما يمنع التعاطف من لعب دوره التنسيقي” (ج ب دوبوي، ص 96). إنه يفسد تعاطفنا مع فرحة الآخرين. وفي الوقت نفسه، يكشف الحسد عن سمة مهمة من سمات التعاطف: ما يفسده هو "الميل إلى الإعجاب بالأغنياء والأقوياء وتبجيلهم تقريبًا، واحتقار، أو على الأقل التخلي عن الناس الفقراء أو البائسين". ظروف." أليس هذا اعترافًا بأن المشاعر التي تثيرها علاقات التبادل، وبالتالي أيضًا تلك المتعلقة بجاذبية المال، لا يمكن فصلها عن تلك التي يثيرها مشهد السلطة؟ سميث يقول ذلك جيدًا: «ما هي المزايا التي نهدف إليها من خلال هذا التصميم العظيم للوجود الذي نسميه تحسين حالتنا؟ أننا نلاحظ، أن يتم الاعتناء بنا، أن يتم الاهتمام بنا بالتعاطف والرضا والموافقة؛ هذه هي كل المزايا التي يمكن أن نهدف إليها من خلال تدريبه. إن الغرور، وليس الرفاهية أو المتعة، هو ما يهمنا. لكن الغرور يعتمد دائمًا على الاقتناع بأننا موضع اهتمام الآخرين واستحسانهم” (ص. ص. 97). الاستنتاج واضح: التعاطف، الذي قلنا من قبل أنه ليس إحسانًا، “لا يختلف عن الرغبة في الاستيلاء على ما يملكونه [العظماء]. إن الرغبة في أن يكونوا مثلهم هي حتماً رغبة في الحصول على ما لديهم” (المرجع نفسه، ص 100). أليس هذا غموضًا لا يمكن تجاوزه هو ما تؤدي إليه نظرية المشاعر الأخلاقية، حيث أن “التعاطف يحتوي على حسد، ويحتوي الفعل على كلا المعنيين” (المرجع السابق، ص 100)؟ لذلك يبدو أن عنوان الفصل الذي كتبه جيه بي دوبوي عن آدم سميث مناسب: "التعاطف الحسود. » وعنوان العمل يكشف نصف سره: التضحية والحسد. وفي الوقت نفسه، فإن "اليد الخفية" الشهيرة، والتي كان من الممكن أن يظن المرء أنها مجرد إسقاط أسطوري للتعاطف نفسه، تصبح موضع شك مرة أخرى، لأنها تعيد إلى الأذهان خدعة العقل التي، وفقًا لهيجل، تستمد من المنافسة بين المصالح الخاصة قصيرة النظر هي الشكل المستقر لنظام معقول على مقياس تاريخ الإنسان بأكمله. ألا ينبغي أن تُمنح "اليد الخفية" فضيلة "احتواء" الحسد؟
من المؤكد أنه سيكون من السخافة حصر مصير ما أطلق عليه منذ فترة طويلة "الاقتصاد السياسي" في نظرية المشاعر الأخلاقية. ونرتكب حينها الخطأ المعاكس لمن رأوا «انقلاباً» بين النظرية... وثروة الأمم. سيكون الأمر أكثر سخافة أن نحكم على التطور الإضافي للاقتصاد العلمي على مثل هذه البدايات. نماذج توازن السوق العامة تعطي فكرة التنظيم الذاتي محتوى علمي دقيق. ولكن بجعل أسطورة "اليد الخفية" زائدة عن الحاجة، فهل نجحوا في إزالة كل التساؤلات المتعلقة بالفئتين الرئيسيتين من التضحية والحسد اللذين ذكرهما ج ب دوبوي في عنوانه؟ والآن، أليس فيما يتعلق بهذه المشاعر أن مسألة العدالة تنشأ في نهاية المطاف، حتى في إطار الفردية الليبرالية؟
ولكن، قبل كل شيء، يمكننا أن نتساءل عما إذا كان العلم الدقيق لنشاط مهم ولكن جزئي، ويخضع أيضًا إلى قدر كبير من التجريد - العلوم الاقتصادية - لم يعط حيوية جديدة للسؤال المذكور أعلاه حول معرفة كيفية تحديد سعر المجال الاقتصادي قادرة على مساوية مجمل الأنشطة البشرية. السؤال مهم لأغراضنا. لأنه إذا كانت مسألة النقود، في نظر العلوم الاقتصادية، مجرد فصل واحد من فصول النظرية المعممة للتبادلات، فإنها تثير مرة أخرى سؤالاً متميزاً عندما ترتبط بما ذكر أعلاه وهو "الغزو التدريجي لجميع مجالات الحياة". الخاص والعام، الاجتماعي والسياسي، بمنطق الاقتصاد والسلعة". إن مسألة "المال الملكي"، سواء أكانت صياغتها جيدة أم سيئة، لا تنشأ إلا ضمن هذه الإشكالية. والآن لم تعد المسألة تتعلق بالاقتصاد، بل أصبحت مسألة تحول نموذجي في الحضارة؛ والمشكلة التي طرحها ل. دومونت وآخرون بشأن تقييم الفردية تظهر بنفس الحدة في نهاية هذه الرحلة. هل يمكننا بعد ذلك أن نأمل في تسليط الضوء عليه، جزئيًا على الأقل، من خلال التعامل مع السؤال المطروح باعتباره سؤالًا سياسيًا، إذا كنا نسميه سؤالًا سياسيًا يؤثر على مجمل المجتمع التاريخي المنظم كدولة؟
ثالثا. الخطة السياسية
إن طرح مسألة المال على المستوى السياسي لا يعني القفز مباشرة إلى الصيغة الشهيرة: «المال مفسد. ". إنه يسأل نفسك:
1 - إذا كانت هناك مجالات للتفاعل الإنساني، ضمن الغلاف السياسي للمدينة، تفلت من قياس السلع الاجتماعية الأولية بالعملة؛
2 - في أي ظروف يتم انتهاك الحدود بين المجالات، بطريقة تتلوث القيم غير السوقية بالقيم السوقية؛
3-كيف يتم التعبير عن هذا الانتهاك على مستوى العلاقات الفردية من خلال ما يسمى عادة "الفساد". فقط في المرحلة الثالثة من التفكير، فإن السؤال، الذي تم طرحه أولاً من حيث الأمثلة، والأنظمة الفرعية، والمجالات، و"المدن" (أو أي شيء يريد المرء أن يقوله)، سوف يشير إلى مسألة المال على المستوى الأخلاقي الذي منه نحن بدأت.
تعتبر السياسة هنا متوازية مع سلطة السيادة والتوجيه والقرار التي يتماهى بها الدولة الحديثة. إن ما يميز النشاط بأنه سياسي، بالتالي، هو علاقته بالسلطة. ومع ذلك، فإننا نصل إلى السؤال الأول من أسئلتنا الثلاثة من خلال النظر في ممارسة السلطة السياسية من منظور العدالة التوزيعية. في مجتمع سياسي معين، وتحت رعاية الدولة، يتم توزيع السلع بمختلف أنواعها: سلع السوق (التراث، الدخل، الخدمات) والسلع غير السوقية (المواطنة، الأمن، الصحة، التعليم، الرسوم العامة). والتكريم والعقوبات وغيرها). تنشأ المسألة السياسية المتعلقة بالمال مباشرة من مسألة ما إذا كان من الممكن اعتبار جميع السلع الموزعة سلعا للسوق. دعونا نفهم طبيعة السؤال: ليس السلوكيات الفردية في المقام الأول، والتي من المحتمل أن تقع تحت الحكم الأخلاقي، هي التي تؤخذ في الاعتبار هنا، ولكن طبيعة الأنظمة الفرعية التي تحددها طبيعة البضائع الموزعة. ومن المؤكد أن هذه السلع لا تستحق هذا الاسم إلا لأنها مقومة ومقدرة وبهذا المعنى تعتبر جيدة؛ لكن هذا التقدير يرتكز على «فهم مشترك»، بحسب تعبير مايكل فالزر في كتابه مجالات العدالة، الذي نتابع تحليلاته هنا. هذه الرمزية المشتركة، حتى لو كانت مفتوحة للنقد والطعن، تمثل استقرارًا لإجماع دائم، ناتج عن تقاطع التقاليد التأسيسية المتجذرة في التاريخ المشترك.
إن القول بأن جميع السلع الموزعة ليست سلعًا للسوق يعني التأكيد على أن القائمة المفتوحة، على ما يبدو، للسلع الاجتماعية غير متجانسة بحكم الطابع المتعدد غير القابل للاختزال للتفاهمات المشتركة والرمزيات المشتركة. هنا، لا يختلف عالم السياسة عن عالم الأنثروبولوجيا، عندما يقتصر الأخير على توسيع خط الفهم الذي يعتقد أنه قادر على استخلاصه من الممارسات الاجتماعية نفسها، من التقديرات المدفونة فيها أو المنعكسة في رموز منفصلة. وبنفس الطريقة يعمل عالم السياسة على تحديد مختلف الرمزيات المشتركة، والتعرف على منطقها الداخلي، أي الأسباب التي تحكم مدى الصلاحية وحدود اختصاص هذا الخير الاجتماعي أو ذاك.
إن مشكلتنا اللاحقة المتمثلة في الفساد بالمال تعتمد على الموقف الذي اتخذناه في البداية، عندما نقول إنه ليس كل شيء للبيع. بمعنى آخر: السوق لا يشبع الارتباط السياسي. وكما نرى، فإن مسألة النقود تطرح على مستوى وجهتها الأساسية، وهي التبادل بين سلع السوق. يتم قياس فترة حكمه من خلال اتساع المجال التجاري. يشترى. ويكفي أن نتذكر النزاع حول صكوك الغفران في زمن حركة الإصلاح الديني، أو النزاع حول التعويض عن التجنيد العسكري في فترة أحدث، لكي نضمن أن إحساسنا بالظلم واضح للغاية وحساس للفروق الدقيقة. يوجد اتفاق بشأن عدم فساد البشر (نهاية العبودية)، وفساد المناصب العامة، والعدالة، والسلطة السياسية، وحقوق الأسرة، والحريات الأساسية، بل وأكثر من ذلك، توزيع النعمة الإلهية، والحب والصداقة، والترفيه والهواء والماء. والنقاش مفتوح بالطبع على الحدود بين المجال التجاري والمجالات الأخرى: هل أعضاء الجسم البشري للبيع؟ هل ينبغي تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر حرمانا من قبل المجتمع ككل (مشكلة دولة الرفاهية)؟ ما هي أجزاء الخدمة الصحية والخدمات التعليمية التي يمكن تقديمها لقوانين السوق، أي معاملتها كسلع سوقية؟ إن حقيقة وجود شك حول هذا التوزيع أو ذاك تثبت بوضوح أن هناك مشكلة عدالة التوزيع هناك.
إننا نتداول دائمًا على أساس توافق آراء قوي حول الفروق الأساسية حول الخطوط الفاصلة غير المؤكدة. لكن عدم اليقين ليس المشكلة الأكثر خطورة. سؤالنا الثاني ينشأ من ظاهرة أكثر إثارة للقلق، وهي ظاهرة انتهاك الأفلاك. وهو ما يضعه السيد والتزر في بداية تحقيقه ونهايته. وهو يسمي الهيمنة ميل سلع مجال معين إلى التعدي على سلع الآخرين. وإذا كان هناك وقت حيث غزت السلطة الكنسية - المالكة المفترضة للنعمة الإلهية - كافة المجالات الأخرى، فإن الخطر اليوم يأتي من ميل المجال التجاري إلى إخضاع نفسه لجميع المجالات الأخرى، مع مساواة السوق بعد ذلك لجميع المعاملات الاجتماعية. كيف هذا ممكن؟ قبل إدانة الرجال، يجب علينا أن نتساءل عن ظاهرة أكثر خفية تحدث فيما يتعلق بتقييم السلع، وبالتالي الرمزية المشتركة.
يتحدث السيد والتزر هنا عن التحويل أو قابلية التحويل. يتمثل التحول في حقيقة أن سلعة معينة، مثل المال أو الثروة، قد تم تأسيسها كعنوان للقيمة في مجال آخر من مجالات العدالة، مثل السلطة السياسية. وهذا هو السر المطلق لما يسمى بظاهرة الهيمنة، التي تُعرف بأنها "طريقة لاستخدام سلع معينة، لا يقتصر عليها معناها الجوهري أو التي تشكل هذه المعاني في صورتها الخاصة" (ص 11). سأتحدث هنا عن العنف الرمزي. يعترف والتزر بالغموض الأساسي لهذه الظاهرة: "يتم تحويل الخير السائد إلى خير آخر أو إلى عدة سلع أخرى اعتمادًا على ما يبدو غالبًا أنه عملية طبيعية، ولكنه في الواقع يشكل عملية سحرية، يمكن مقارنتها ببعض الخيمياء الاجتماعية" ( الحادي عشر). يعيد هذا النص المذهل إلى الأذهان الفصل الشهير من كتاب ماركس "رأس المال" المخصص لـ "صنم السلعة"، حيث يتم رفع السلعة إلى العظمة الغامضة بفضل الاندماج بين الاقتصادي والديني. الآن سوف يلجأ فالزر إلى التحول عدة مرات، لكنه سيتركه، دون مزيد من التفكير، إلى مكانته كمجاز. لكن هذا ليس شيئًا إذا اعترفنا، مع المؤلف، أنه “من الممكن وصف مجتمعات بأكملها وفقًا لصور التحول السائدة فيها” (المرجع نفسه). علاوة على ذلك: "إن التاريخ لا يكشف عن خير واحد سائد، ولا خير سائد بشكل طبيعي، بل يكشف فقط عن أنواع مختلفة من السحر وفرق السحرة المتنافسة" (المرجع نفسه). وفي الواقع فإن عمل السيد والتزر هو في مجمله آلة حرب موجهة ضد ظاهرة الهيمنة. إنه كتاب قتالي، في التقليد "المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام". منذ البداية، حدد النغمة: "إن هدف المساواة السياسية هو مجتمع متحرر من السيطرة" (XIII). أود أن أتعمق أكثر في الثغرة التي فتحتها فكرة التحول، والتي تعتبر ظاهرة سحرية. وأسأل نفسي سؤالاً عن كيفية مساهمة الأفراد المنخرطين في معاملات تندرج ضمن هذا المجال أو ذاك من العدالة، في هذه التجاوزات، في هذه التحويلات، باختصار في سحر التحويل هذا. يبدو لي أنه لا يمكننا التحرك في هذا الاتجاه دون النظر في حالات الأشخاص المرتبطة بتقييمات السلع الاجتماعية، وبالتالي دون النظر في عظمة أو صغر الفاعلين الاجتماعيين، لاستخدام مصطلحات بولتانسكي وثيفينو العمل المذكور بالفعل. كما أشارت تحليلات آدم سميث في نظرية المشاعر الأخلاقية إلى هذا الاتجاه؛ فالثروة والعظمة، كما رأينا، يسيران معًا. لا يمكننا عزل امتلاك السلع العظيمة عن مجموعة التأثيرات المؤثرة على مستوى الاعتراف العام. أن تكون ثريًا يعني أن تشعر فعليًا بالعظمة في كل "اقتصادات العظمة" الأخرى: في اقتصادات الشهرة، والإبداع، والعلاقات المنزلية، وبطبيعة الحال، في "المدينة" الصناعية. وهنا نجد سمة المال كخاطبة عالمية. المال هو القيمة الشاملة لجميع الأغراض، ويمر عبر الجدار. ولكن إذا كانت تميل إلى استعمار كل المجالات غير السوقية، فذلك لأن العظمة التي تمنحها للناس هي عظمة صنم، تميل العظماء الآخرون إلى الانحناء أمامها. إن كل شيء يلعب دورًا في نهاية المطاف على مستوى تقدير المقادير.
إن سحر الاهتداء، المتأصل في كل فرد، والذي يعمل أولاً على مستوى الخير والعظمة، يتحول إلى فساد شخصي. إن ما يسميه الخطاب العام بالفساد هو إذن مجرد ملخص لثلاث ظواهر: فيما يتعلق بمجالات العدالة، وسيطرة المجال التجاري على الآخرين، ولا سيما السلطة السياسية؛ على مستوى المقاييس المرتبطة بحالات الناس، تلوث جميع المقاييس بتلك التي تمنحها الثروة؛ من حيث استيعاب السلع الاجتماعية وعظمة المؤسسة، والفساد الشخصي. ألا يقول كانط الصارم: لكل إنسان ثمنه؟
إذا كان الأمر كذلك بالفعل، فإن هذه الظاهرة الأخيرة تعيدنا إلى تحليلاتنا الأولى. وبالعودة من قسمنا الثالث إلى الثاني، يمكننا القول إن الفساد الشخصي، وهو صورة فردية لفساد الأخلاق، تسهله حالة الحضارة الحديثة، التي تتميز بظهور وسيادة الفرد المجتث، المنعزل، المستقل، ترك لمتعته الخاصة. أخيرًا، بالعودة من الجزء الثاني إلى الأول، ألا يمكننا أن نقول إن مشهد فساد الأخلاق وإغراءات الرشوة الشخصية هي فرصة لسماع حكم الأخلاقيين مرة أخرى -بل وأكثر من ذلك حكم الحكماء والأذكياء. القديسون -على هذا المال "السيد الداخلي" الآخر؟ ولكي نقاوم التأثير "المفسد" للمال، أفلا ينبغي لنا أن نظل منفتحين على روح الاعتدال والإتقان التي يعلمها علماء الأخلاق اليونانيون واللاتين، وأن نظل قادرين على سماع حض الرسول بولس؟ إذ كتب إلى أهل كورنثوس: "دعونا والذين يشترون يعيشون كأنهم لا يملكون؛ أولئك الذين يستخدمون هذا العالم كما لو أنهم لا يستخدمونه حقًا. لأنه يمر، رقم هذا العالم "؟"


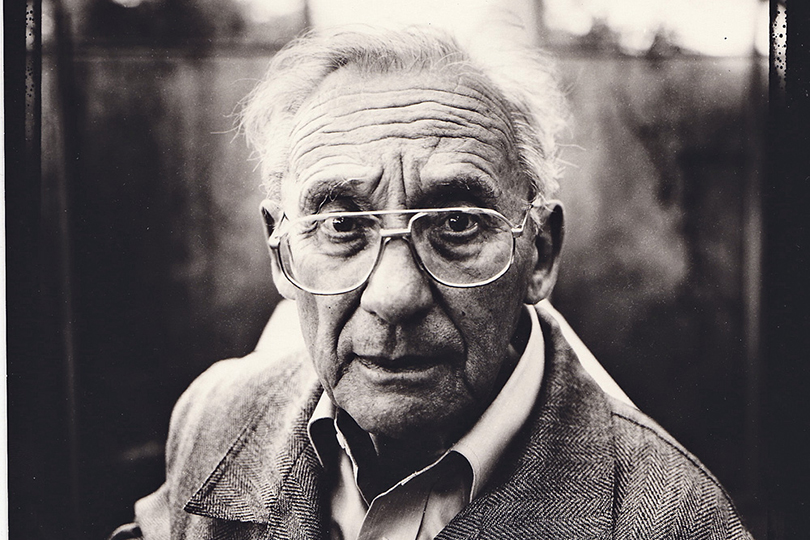

اضف تعليق