|
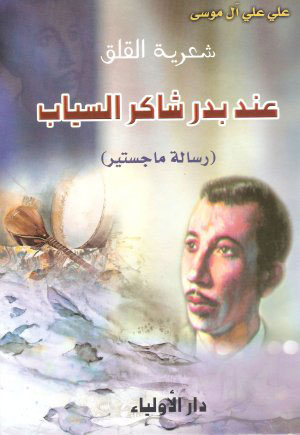
الكتاب: شعرية القلق عند بدر شاكر السياب
المؤلف: الشيخ علي علي آل موسى
الناشر: دار الأولياء- بيروت
عدد الصفحات: 760 - قطع كبير
عرض: فاضل البحراني
شبكة النبأ: بين أيدينا كتاب صدر حديثاً عن دار الأولياء في
بيروت، بعنوان: (شعرية القلق عند بدر شاكر السياب)، لمؤلفه الشيخ
علي علي آل موسى، وهو من مواليد (العوّامية) بمحافظة القطيف عام
1389هـ/1969م، درس الابتدائية والمتوسطة في العوامية، وأكمل
الثانوية في تاروت، ثم هاجر لطلب العلوم الدينية، فدرس في حوزة
الإمام القائم (عج) في إيران بين 1407ـ 1410هـ، ثمّ انتقل إلى
سورية فدرس في حوزة الإمام الصادق (ع) بين 1411ـ 1415هـ، ثم درس في
حوزة القطيف بين 1416ـ 1418هـ. من أبرز مدرسيه في الحوزة: الشيخ
محمدي البامياني، والشيخ عبد اللطيف الشبيب، والشيخ فوزي السيف،
والشيخ شاكر الناصر، والشيخ علي الناصر. وفي 1418هـ التحق بكلية
التربية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، قسم اللغة العربية، وحصل منها
في 1422هـ على شهادة البكالوريوس بتقدير (ممتاز) مع لوحة الشرف،
وفي 1429هـ/ 2008م مُنح درجة الماجستير في النقد الأدبي الحديث من
قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض، وهو يعمل في ميدان
التعليم العام منذ سنة 1422هـ.،كتب المقالة والدراسة والقصة
القصيرة والقصيدة، ونشر في العديد من الصحف والمجلات والمواقع
الإلكترونية. صدر له مسبقاً كتاب بعنوان: (ثقافة الإسلام وثقافة
المسلمين).
قبل الخوض في عباب هذا الكتاب الذي يقع في (760) صفحة من القطع
الكبير، يجب الوقوف على أهمية موضوعه، والتي تعود -حسبما يشير
المؤلف- إلى أن الدراسات النقدية التي تبحث أثر الجانب النفسي من
وجهة شعرية فنية،أي أثره في جماليات النص، قليلة في أدبنا العربي
مع أهميتها في إنتاج الدلالة،ومن ذلك الأثر الفني لظاهرة القلق،
التي لم تُدرس بشكل يتوازى مع مستوى حضورها في شعر السياب، وبروزها
في شعره منعكسة عن المكون الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي،
فضلاً عن انعكاسها على وضعه الشخصي وتجربته الشعرية،في جانبي الشكل
والمضمون.
ويعد الكتاب مشروعاً لرسالة ماجستير في اللغة العربية تسعى
لمعرفة أثر الأمور النفسية في الأدب، وتلمّس آثار القلق في شعر
السيّاب، وتقع في مقدّمة وتمهيد وثلاثة فصول:
المقدّمة:
تناولت المقدّمة خطوات البحث العلمي، من موضوع الرسالة وأهميته،
ومشكلة البحث وأهدافه، والدراسات السابقة، وفرضيات البحث وتساؤلاته،
ومنهج البحث.
فقد وجد آل موسى أنّ هناك آثاراً بارزة في شعر السيّاب خلـّفها
القلق، ومع غناها في ديوانه إلا أنّه لم يتم تناولها في دراسة
جامعية مستقلة، وهذا ما يشكل شيئاً من أهمية سبر هذا الموضوع لدى
السيّاب، كما يشكل شيئاً من مشكلات البحث التي ستجعله مع شعر
السيّاب مباشرة، وستوقفه مع صعوبة الفرز بين الظواهر النفسية
المتشابكة.
وإذا كانت ثمة دراسات سابقة للتعرّف على الأثر الفني للقلق يتكئ
عليها البحث، فإنّما هي دراسات عن شعراء آخرين غير السيّاب، كبعض
الشعراء الجاهليين، وأبي القاسم الشابي.
وتساءلت الدراسة عن دوافع القلق وآثاره في شعره، وكيف ظهر على
أساليب أدائه الشعري وموسيقاه الشعرية؟
وقد أخذ آل موسى بالمناهج التي تعينه في ذلك، فاستفاد من المنهج:
الوصفي، والتحليلي، والنفسي، والفني.
التمهيد:
وجاء التمهيد؛ ليتناول المفردات الثلاث الواردة في عنوان
الرسالة وهي: (الشعرية/ والقلق/ وبدر شاكر السيّاب)، قدّم فيها بعض
التعريفات للمصطلحين الأولين، وشيئاً من التعريف بشخصية الشاعر.
الفصل الأول:
وجاء الفصل الأول؛ ليتحدّث عن (أسباب القلق في شعر السيّاب)،
فناقش الدوافع الذاتية (الشخصية) من شكل، ويُتْم مبكر، وفقر إلى حد
الجوع، و بحث وإخفاق في الحبّ، وشعور بالنقص، وريبة وشكّ، وتمزّق
داخلي وتناقض، وبساطة وانقياد، وحدّة في الانفعال والعدوانية، ومرض
مزمن، وحضور قوي لهاجس الموت.
كما ناقش البواعث الخارجية (الموضوعية) من ثقافية كالتقلب في
المرجعية الفكرية والأدبية. واقتصادية كالطبقية والفقر. واجتماعية
كالأعراف والتقاليد الاجتماعية، وضغط المدينة، والسجن والتشرد،
والسفر وراء العلاج. وسياسية جرت في العراق، كالانتداب البريطاني،
والتحولات السياسية في حكوماته، وثورة رشيد عالي الكيلاني التي
أُعدم بعض قادتها ونفي آخرون، أو جرت في العالم العربي كاحتلال
الصهاينة لفلسطين، وويلات الاستعمار في شمال أفريقيا، أو جرت في
العالم عموماً كالحرب العالمية الثانية وسحقها للمثل.
الفصل الثاني:
الفصل الثاني يتكلّم عن (أنواع القلق عند السيّاب)، وناقش منها:
قلق الامتحان، والقلق الزماني (الوجودي)، والقلق المكاني، وقلق
الغربة، وقلق الجنس، والقلق الديني والإيديولوجي، وقلق المصير،
وقلق الموت، وقلق الدلالة، وقلق التأثير.
كما ناقش بعض الظواهر التي ارتبطت بالقلق في شعر السيّاب، ومنها:
(التشاؤم، والسوداوية، والاغتراب، والخوف، والشكّ والحيرة
والاضطراب، والكآبة، والحزن والأسى، والسأم، والوحدة، والشحوب،
والحنين، والألم، والأوهام، والحسرة، والسهر والأرق، والبؤس
والشقاء، واليأس، والتمركز حول الذات، وغيرها).
ومن قلق المكان تفرّع موضوعان ناقشهما هذا الفصل، وهما: ملامح
الصراع الدرامي بين المدينة والرّيف في شعر السياب، والمقارنة بين
جَيكور (قرية السياب التي نشأ فيها) والمدينة.
فقد بدا الرّيف لديه معلماً للجمال، والإلهام، والطهر، والبساطة،
والأم، والطفولة البريئة، والحكايات العبقة، والحبّ العفيف، بينما
عملت أسباب شخصية واجتماعية وسياسية وثقافية في إضفاء صورة قاتمة
للمدينة لديه، وقد جعلته تلك النظرة ينفر من المدينة، ويحنّ إلى
الرّيف بوصفه البديل الخارجي للمدينة، ويحنّ للماضي الذهبي الطفولي
بوصفه بديلاً نفسياً، ويحنّ للمدينة الفاضلة والمدن المسحورة،
بوصفهما بديلين سحريين أسطوريين يقاومان طغيان المدينة.
وقد دفعه ذلك -أيضاً- إلى عقد الكثير من المقارنات بين القرية
والمدينة، تتقابل فيهما القيمية والمادية، واللين والقسوة،
والوداعة والصراع، والسكينة والضوضاء، والحيوية والسكون، والعفة
والابتذال، والجمال الطبيعي والصناعي، والإلهام والعقم.
الفصل الثالث:
يدرس الفصل الثالث (شعرية القلق عند السيّاب) من ناحية فنية،
فيناول أربعة مباحث، هي:
أولاً: أثر القلق في اللغة:
وتناول أثره في مستوى (المفردة) من حيث وفرة استعمال ألفاظ معجم
القلق، وتباين المعجم اللغوي بين كلمات قاموسية ومعرّبة ودخيلة
ومستحدثة ومخالفة للقياس وعامية وأجنبية، ومن حيث العناية بالقيمة
الإيحائية للأصوات، كحروف المدّ، وياء المتكلم، والهمس والجهر،
وصيغ التكرار، ومن حيث القيمة الإيحائية للألفاظ، كالكلمات
المضعّفة (المشدّدة)، وما تحمله الأصوات من الكلمات المحكية.
كما تناول أثر القلق في مستوى (تركيب الجملة)، فوقف على بعض
ملامح صياغة الجملة لدى السيّاب، كالوصل والفصل بين التراكيب،
والتقديم والتأخير، والذكر والحذف، وظاهرة الإضافة، والتعبير
بالجملة الاسمية والفعلية، والجمل القصيرة والممتدة، والجمل
الاعتراضية، والصياغة الفنية والتقريرية للجمل، والحذف والتغيير في
كلمات القصيدة وجملها وأبياتها.
ثانياً: أثر القلق في الصورة الفنية:
ودرس معنى الصورة الشعرية، وأهميتها الشعرية، وأثر القلق في
تشكيل الصورة الشعرية لدى السيّاب، ثمّ تناول مجموعة من فنيّات
تشكيل الصورة لديه، ومنها: التمثيل، والتجسيد، والتشخيص، والتجريد،
والمعادل الموضوعي، وتكثيف الصور، والحركة، وتراسل الحواس، ومزج
المتناقضات، والمفارقة التصويرية، والارتداد (الفلاش باك)،
والمونولوج الداخلي، وتعدّد الأصوات والأشخاص، والحوار، والسيناريو،
والمونتاج السينمائي، والكورس، والوثائق التسجيلية، واللون، والضوء
والظلّ، والرمز، والتناصّ.
ثالثاً: أثر القلق في الشكل الشعري:
وتناول أثر القلق في الشكل الشعري: وكيف عمل القلق الشعوري
والعروضي لديه على تنوّع القصيدة -شكلاً- بين عمودية، وموشحة، وحرة
خالصة، وممزوجة الشكل بين العمودي والحرّ، وجعلته يؤمن بشكل شعري
ما..، ثمّ ينقلب عليه.
رابعاً: أثر القلق في الموسيقى الشعرية (الداخلية والخارجية):
ودرس الآتي:
1ـ أثر القلق في الموسيقى الخارجية: وتناول أثر القلق على
(الوزن)، من حيث علاقته باختيار الوزن، أو وحدته، أو مزج الأوزان.
كما تناول أثره على (القافية)، وأخذ السيّاب بالقافية الموحدة، أو
المتنوّعة، أو المتراوحة المتناوبة.
2ـ أثر القلق في الموسيقى الداخلية (الإيقاع): وتناول مجموعة من
سبل خلق الإيقاع الداخلي التي أسهمت في إبراز قلقه الشعوري، ومنها:
التكرار، والجناس، والتصريع، والتدوير، والتصدير، والإرصاد، وحسن
التقسيم، والكتابة بالتوزيع الموسيقي، وإشباع حركات الإعراب،
والتنوين.
وختم الكتاب بملحقين:
ملحق رقم (1): وفيه إحصاء عام لعدد قصائد السياب، وزمن كتابتها،
وبحرها، ونوع الشكل الشعري فيها.
ملحق رقم (2): وفيه الشكل الشعري في قصائد السياب (عدد قصائده
العمودية والحرة وممزوجة الشكل، وأسماؤها). |
