|
تقديم:
تعد دراسة المصطلح موضوعا جوهريا داخل الحقل اللساني، بحكم
المكانة الهامة التي يحتلها في بناء شبكة من العلائق التواصلية بين
كل المكونات التي تنشغل بتطوير الدرس اللساني الحديث، وكذلك التنوع
الذي يطبع المستويات، والطرق التي تعمل على بنائه داخل قوالب نحوية
مختلفة(تركيبية،وصرفية،وصواتية،ودلاليا).
داخل النظام الحاسوبي للغة العربية، يملك المصطلح اللساني سمات
لغوية تجعله منسجما ومعطياتها، لكن بالنظر إلى الزاوية التي تضطلع
بالطبيعة المعقدة التي تطبع إيجاد مصطلح موحد بسماته الدقيقة، فإن
طرح هذه القضية يتعلق، بموجب ذلك، بعضها بمعاينة ما يعد في المصطلح
ملازما ومنسجما للنسق اللغوي العربي، ويتعلق البعض الآخر بالدور
الذي يناط بالنحو (النظام الحاسوبي ) في تحديد السمات الكلية التي
تعمل على خلق التمايز، اعتبارا لمسألة توظيف المصطلح داخل الحقل
اللساني، والقيود التي يجب أن توفيرها لكي يتحقق التعالق اللغوي
بين المصطلح اللساني ومقتضيات النسق اللغوي العربي.
على هذا الأساس،انشغلت العديد من المجامع اللغوية والمؤسسات
المسؤولة على تعريب المصطلحات اللسانية بالنظر إلى أهمية دراسة
إشكالية المصطلح اللساني في صيغته الحديثة واستخدامه في الدرس
اللساني.مشيرين أنها نتاج علاقة تفاعلية (تواصلية)مع ما ينتجه
الآخر في نفس المجال , وخصوصا أن الدراسات اللغوية المقارنة تؤكد
أن مسايرة الركب اللغوي تتطلب ضبط دقيق للمصطلحات حتى يحسن التعامل
معها وتوظيفها بما يلزم من الحمولات الفكرية والثقافية المناسبة،
ومن جهة أخرى هي نتاج حركتي التعريب والترجمة اللذان كان لهما بعض
الآثار السلبية على فكرنا ولغتنا. من منطلق أن عملية التثاقف كان
لها بالغ الأثر في ذلك،لأنها أنتجت اتجاها جديدا في معالجة الدرس
اللساني الذي ابتعد يوما عن يوم عن أصول وقواعد اللغة العربية
ليرتبط بلغة الثقافة المهيمنة، لذلك اتسم الدرس اللساني بالغموض في
التعبير عن ذاته بمفاهيم ومصطلحات يحكمها التفرد والاضطراب , وفي
غياب مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعملية التعريب والترجمة، سادت
مجموعة من المصطلحات المتضاربة وغير المتقنة، بل لم تكلف صاحبها
سوى عملية استنساخية،
فباتت، بموجب هذا، اللغة العربية تحت رحمة المترجمين، فترجم
المصطلح الواحد بعشرات الأشكال حتى اختلفت ترجمة وتعريب المصطلح
الواحد من بلد إلى آخر، بل حتى داخل البلد الواحد نفسه إذ نجده
تباينا في المصطلحات من مؤسسة لأخرى.
1 - إشكالية العلاقة بين المفهوم ( concept ) والمصطلح (terme)
والاصطلاح (terminologie):
هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بالعامل الحاسم في كشف حدود التمايز
بين هذه المستويات على الرغم من أن البؤرة الأساسية في هذا البحث
هي المصطلح اللساني الحديث، فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك الحدود
بينه وبين باقي المكونات الأخرى،حتى يكون لدينا الاستعداد المنهجي
الواضح للدخول في المناقشات العامة حول الموضوع.
فعملية رصد حدود التمايز بينها لا تكمن فقط في الكشف عن
الاختلاف، بل النظر في مقدار تطويع اللغة العربية لها،ومدى
استخدامها في الدراسات اللسانية من أجل رسم إطار واضح لممارسة
منهجية تنبني على تحديد دقيق للبنية الداخلية، عبر مسار توليدي
يحدد الحمولة الدلالية لكل مجال على حدة , وضبط القالب الحاسوبي
الذي يعمل على تنظيم اختصاصاتها، فوجود هذه القيود يوازن بين كبس
البيانات والمؤشرات الخاصة وبين الغاية من الاستخدام الفعال لها.
لذلك كان من المنطقي استدعاء آليات اشتغال من النسق اللساني للغة
العربية من تركيب،ومعجم في بناء النسق الدلالي الذي يحدد التمايز.
وظف المفهوم (concept) في اللغة العربية باعتباره مادة تحيل
على تصور أو فكر. في حين نجد أن المصطلح(terme) هو لفظ يشتغل على
مادة الفكر. ثم إن الإطار الذي يعمل على تحديد التمايز ينبني على
أن المصطلح يختلف بحسب خصائصه من عشيرة لغوية /مجتمع لغوي إلى
أخرى، وهو أمر معكوس بالنسبة للمفهوم الذي يطبعه الاتفاق لأنه يحمل
فكرة عن شيء ويتم التعبير عنها باصطلاح محدد. من هذه الزاوية نجد
أن المفهوم والاصطلاح يتقاطعان في خاصية الاتفاق، اعتبارا أن
الإطار المرجعي الذي ينظم هذه المادة يتحدث عن الاتفاق والتوافق
واصطلح القوم: تصالحوا، بمعنى وقع بينهم صلح...فالتاء بمعنى
التشارك والاشتراك، ومعنى التفاعل مخرج من المطاوعة..والجدير
بالذكر أن ما ورد عند القدماء هو لفظ الاصطلاح ولم يرد عنهم لفظ
المصطلح([1]). بناء
على هذه الخصوصيات ندرك أن لفظ الاصطلاح يضم المفهوم باعتباره مادة
موضوعية مستقلة.
في ضوء ما سبق يتضح أن المفهوم( concept) غير مصطلح (terme)
فالأول يحيل على فكرة ما يحكمها المتغير وعدم الاستقرار ( + متغير
)، في حين أن التالي يحيل على بناء يحكمه الاتفاق بحكم موضوع
الاختصاص(- متغير ) أما الاصطلاح فيحيل على المادة (الآلة) التي
تقود إلى إيجاد المصطلح عبر تدخل الوسائط و الآليات التي تستدعيها
مقتضيات ومتطلبات النسق التركيبي للغة العربية.
إن هذا التحديد الدقيق هو الذي يجعل من الممكن لنا أن نعلو،
ليس فقط على رسم حدود اشتغال كل واحدة من المفردات، بل أيضا على
ضبط المنهج الذي يجعل مجال اشتغال الاصطلاح المصطلح والمفهوم واحد.
وهو الأمر الذي تنفيه كل الأعراف النظرية والمنهجية في أي بحث. بل
إن الأمر يتضح بجلاء حينما ننظر في مادة كل واحدة منهما في المعاجم
العربية القديمة. نورد أن لسان العرب لابن منظور عندما تطرق إلى
فعل فهم عرفه :الفهم : المعرفة بالشيء : عقله وعرفه...وأفهمه الأمر
وفهمه إياه جعله يفهمه(2). وهذا أمر لا يدهشنا خصوصا أن ابن منظور
اشترط في عملية الفهم إدراك الشيء والإحاطة والعلم به، بمعنى أكثر
تدقيقا تشكيل تصور أ و فكرة عن الشيء المراد إفهامه.
وهذا ما يفسر في نظرنا أن( concept ) باعتباره لفظا أجنبيا
يقابل المفهوم، والتصور،والفكرة. وبالتالي نجد أن المفهوم والتصور
والفكرة يؤدي بعضها إلى الآخر ,عن طريق بناء صيرورة معرفية تجمع
بينهم.
إلى جانب المفهوم، نورد الآن بعض التحديدات للمادة التي حاولت
أن تقارب بين الاصطلاح والمصطلح، فالشيخ المناوي يعرف الاصطلاح
بقوله :"اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ينقل عن موضعه الأول" (3).
أما المصطلح بمعناه الحديث "علم مشترك بين اللغة والمنطق وعلم
الوجود وعلم المعرفة أو المعلوماتية وحقوق التخصص العلمي والأدبي
والفني، وعلى تعريفه بإيجاز بأنه العلم الذي يبحث في العلاقة بين
المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها"(4).
2- وضعية المصطلح اللساني الحديث
اللغة العربية بحاجة إلى رسم مسار جديد يعمل على ضبط قواعدها و
أساليب اشتغالها.حتى تتمكن من وضع تخطيط لوجهات نظر خاصة ترتبط
بضبط سوء الفهم الرئيسي الذي يكمن في الاعتقاد أن الاصطلاح
والمصطلح واحد، وأن المصطلح والمفهوم لا تجرى بينهما مساحة واسعة
تتضاعف هوتها حينما يدخلان بوابة الاشتغال والحوسبة. ومن هنا تتأسس
العديد من الإشكالات التي نتنبأ بموجبها أننا نستطيع أن نجد وضعية
مصطلحية يشوبها الاضطراب وعدم الاستقامة.
ولكي ندرك ذلك دعنا نتساءل قليلا عما يعنيه هذا الاضطراب
والخلط. المسلمة أنه إذا أردنا أن نتحدث عن وضعية المصطلح اللساني
الحديث، فلا بد أن ننظر في وضعية اللسانيات باعتبارها العلم الذي
يعمل على تفسير الظواهر اللغوية وسبل تطويرها وجعلها مسايرة
للأبحاث الدولية، فالدرس اللساني، لكي يكون متطورا أو مسايرا، يجب
أن يكون مقارنا ومواكبا لكل القضايا المعرفية عبر ممارسة تعريبية
تتجاوز الحواجز الثقافية،والفكرية،و العلمية.و بالتالي القفز عن
ذلك الانفصام الذي يميز اللغات التي تستهلك أكتر ما تنتج. المؤسف
أن فهم هذه العلائق المقارنة لم يكن كما نتصور، فحملت اللسانيات
على عاتقها كل دوافع التشتت الاصطلاحي بين كل المؤسسات المعنية
بضبط المصطلح، وبين المجهودات الفردية التي اجتهدت في وضع بعض
المصطلحات دون تنسيق جماعي ولا تكتل مجامعي. مما انعكس سلبا على
فهم وإدراك الدرس اللساني الحديث وخلق حاجز تواصلي بين
مصطلحاته.النتيجة تقول أنه من دون تفهم المشكلات تنشأ الوضعية التي
يصعب علينا فهمها بصورة واضحة.وضعية تتلخص في مدى استلهام المعطيات
اللغوية من طرف المتعلم و الباحث الشئ الذي يكرس الموقف المشكك في
قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات الجديدة.
هذا الاضطراب في وضعية المصطلح يمكن أن يعود بالأساس إلى
الطريقة المتبعة من طرف مجموعة من المؤسسات أو المجامع التي تضطلع
بصوغ المصطلح، فندرك أن كلمة/ لفظة واحدة يمكن أن تصاغ بناء على
ترجمة المعنى أو بناء على التعريف،أو بناء على نقل اللفظة الأجنبية
إلى اللغة العربية مع إخضاعها للصوت والنطق العربي.
إلى جانب هذا، نجد من يعتمد على آليات مؤسسة مثل النحت،أو
الافتراض،أو التوليد، أوالاشتقاق،وهناك بعض الدارسين من يعود إلى
النبش في الموروث العربي القديم قصد العمل على بعثه وإحيائه،
والبحث فيه كما يمكن أن يستوعب الحديث. فالأكيد أن كل هذه الحسابات
في وضع هذا المصطلح اللساني الحديث أثر بشكل سلبي على وضعيته من
خلال النزعة الضيقة والخلفيات المعرفية التي ينطلق منها واضعوا
المصطلح.
لابد من الإشارة إلى أن اختلاف التصورات والاتجاهات اللسانية
كان عاملا وراء ظهور مصطلحات لسانية مترامية الأطراف وغير محددة
التوجه بالنسبة للمشتغل غير المتخصص، فكانت بعض الاقتراحات التي
دعت إلى وضع مصطلح لساني يستجيب لحاجات الطالب / الباحث مع التلميح
إلى الخلفية المعرفية التي تحكمه.
وعلى هذا الأساس، فلا مناص من التأكيد أنه لا يوجد أي إتفاق /
إجماع حول المصطلحات اللسانية الحديثة التي يتم تداولها الآن في
الدرس اللساني. وبالتالي فعوض أن تكون المصطلحات عاملا مساعدا على
وحدتنا، أصبحت هاجسا وعائقا أمام تطويرنا ثقافيا، ولغويا، و فكريا،
وبالتالي خلق فجوة مصطلحية داخلية كان من اليسير أن نتغلب عليها
لكن اهتمامنا انصب على تكريس وضعية التفرقة والاضطراب المصطلحي في
علاقته بما هو وارد وخارجي.
الشئ الذي انعكس على معظم اللسانيين الذين لم يسلكوا طريقا
واحدا في تعريب المصطلح، ولم يتفقوا على قاعدة واحدة تساعدهم على
مقابلة المصطلح باللفظ العربي،فليس غريبا أن تشمل أزمة المصطلح كل
الجوانب المرتبطة بالدرس اللساني. وما يزيد في غرابة الوضع هو أننا
كنا في الريادة من حيث صناعة المعاجم , فقد سبقنا العالم في مجال
صناعته بفضل جهود الخليل في " العين "( في القرن الثاني الهجري).
وكنا أيضا أول من خرج إلى الفيافي والقفار لجميع الألفاظ واللهجات
القحة من أفواه أهلها من منطلق ارتباط اللغة بواقعها. وكنا أيضا من
رواد المعاجم المختصة من خلال ابن سيده في معجمه " المخصص" و"فقه
اللغة" للتعالبي وغيرهما كثير، بالإضافة إلى كل هذا، كنا السباقين
أيضا إلى المعجمة الإصلاحية بفضل معجم "التنوير في الإصطلاحات
الطبية" لابن نوح في القرن الرابع الهجري. علاوة على ذلك كنا أول
من تربع على عرش الأسس الدقيقة والمنهجية التي اتحدت من أجل وضع
المصطلح،من خلال علم أصول الفقه الذي حدد للمصطلح غاياته ومصادره
وطرق استنباطه وموارد دلالته وكيفية إعمال الفكر والبحت العلمي
فيه(5).
لكن عندما نأخذ هذا الإرث الثقافي الكبير ونحاول أن نمعن فيه
النظر نجد أنه انبثق أساسا من جهود فردية أخذت على عاتقها بناء
معاجم عربية تحفظ اللغة العربية من الشتات، وتنوع من الملكة
المعجمية عند مستعمليه، دون أن يكون هناك تجاوزا لما هو خارج
اللغة، فأين نحن من السلف، الظروف متاحة والموارد موجودة،و المعاني
ملقاة،وسبل استلقاط المعرفة في متناول الجميع، لنجد أنفسنا أمام
مجامع لغوية بالاسم، قد انفصلت عن جماعتها وتوزعت جهودها على القيل
والقال. لنختم على ذلك بوعد اتحاد المجامع العربية الذي مازال
سرابا على الطريق، في الوقت الذي أصبحت الضرورة الملحة إلى
التكتل،وتوحيد جهود المؤسسات والمجامع من أجل القبض على المصطلح
الواحد وتقويته وتوحيد المنهجية التي بموجبها نستطيع أن نبتكر
مصطلحات تواكب تطور الدرس اللساني الحديث، ففي المصطلح،عوض أن
نتصالح نجد أنفسنا نتصارع، فأصبحنا نعيش عصبية مصطلحية شبيهة
بالعصبية القبلية، فهذا مصطلح مغربي، والأخر شامي، والآخر
قاهري...فأصابنا الارتباك في توحيد المصطلح وتوليده، وعجزت أدواتنا
تماما عن مواجهة ظاهرة " الانفجار المصطلحي "(6).
أن هذه الوضعية التي يعيشها المصطلح اللساني الحديث تعكس بجلاء
الارتباك الكبير فيما يخص عملية إحيائه وبوتقته، ولعل التشتت
الحاصل في مواقف بعض اللغويين المختصين،وبعض المؤسسات والمجامع
تساهم بشكل كبير في تأخير الاستفادة من الفضاء اللغوي
الأجنبي،وتعطيل الممارسة اللسانية بمصطلحات وظيفية ومحلية نابعة من
صميم لغتنا. فالأكيد أن هذا التشتت والعجز لا يمكن أن نرده إلى
اللغة وإلى نسقها بل أصبح كل واحد منا يدرك أن العربية قادرة أن
تولد ما لا يعد ولا يحصى من المصطلحات لو نحن أحسنا التعامل
معها،وأحسنا مغازلتها بما يجب من الدقة والاجتهاد،ولا حاجة في
القول إن اللغة تبقى قوية و كبيرة بأهلها، وتصغر بصغرهم
ومن ثم فإن أحادية التصور وأحادية الدلالة شيئان مختلفان تمام
الاختلاف والحال أن المناداة بضرورة تخصيص مقابل واحد لكل مصطلح
الشئ الذي قد يعني المناداة بتعطيل مبدأ تعدد المصطلحات في اللغة
مثلما يذهب إلى ذلك عبد القادر الفاسي الفهري عندما يقول،معترضا
على مبدأ من مبادئ توحيد المصطلح مفاده ضرورة وضع مصطلح واحد
للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد.
3 - إشكالات المصطلح اللساني الحديث
تتأسس قوة أي لغة بالحوسبة الدقيقة، والاستيعاب الشامل لمختلف
التغيرات المستمرة في المعطيات اللسانية الحديثة، والصمود أمام كل
تلك التحديات التي يفرضها الواقع الثقافي والحضاري المتقهقر
لمجتمعنا اللغوي، أو المنافسة التي تفرض وجودها مع اللغات الأخرى
خصوصا في مجال التعليم إذ ينظر إلى اللغة العربية من موقع الضعف في
غالب الأحيان،في مقابل ذلك،ينظر إلى اللغات الأجنبية على أساس أنها
لغة الفكر و التقدم و الرقي الفكري.الشئ الذي ينعكس سلبا على
التعليم و على جهود حركات التعريب و الترجمة. حيت ينقاد المغلبون
إلى تقبل الغالب، أو أن الغالب يفرض لغته وثقافته على المغلوبين.
والحقيقة أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي أتبتت قدرتها على
الصمود بسبب جملة كبيرة من المعطيات والخصوصيات الموضوعية.
لكن، ما يشغل كل مهتم بالمصطلحات اللسانية الحديثة، ونحن نتحدث
عن القدرات والإمكانات التي تتيحها اللغة العربية لمستعمليها، أن
نتخلص من كل هذه الغنائيات والنرجسيات التنظيرية والزعامات
الواهية،و نقف عند حدود الواقع والمعطى، وننظر من الثقب الضيق الذي
أصبحت عليه حال اللغة العربية، ولنهتم بالقضايا الحقيقية التي
تتعلق أساسا بإشكال المصطلح اللساني، حيت نواجه بموجب ذلك المطالب
اللغوية والتربوية والحضارية الملحة التي يحتاج إليها كل باحت،
فأصبح من الضروري البحت في المصطلح و الكشف عن المعيقات لتي تحول
دون تطويره وتنويعه.
وعلى هذا الأساس، نشير إلى أن أهم الإشكالات التي يعاني منها
المصطلح اللساني الحديث تبدأ أولا من البرنامج الاصطلاحي الذي يشرف
على تمكين المصطلح وإبداعه. لنقف مع الفاسي الفهري في اعتباره أن
أي برنامج اصطلاحي يواجه اليوم إشكالان أساسيان يتمثل الأول في
توفير العدد الهائل من المصطلحات لمواكبة الحاجة الملحة إلى
التعبير عن مفاهيم وتصورات جديدة بعبارات اصطلاحية يوازي عددها
العبارات التي توفر في لغات الحضارات الأخرى(7). أما الثاني فيرتبط
بإشكال التقريب والشفافية بين اللغة العامة المتداولة (المعجم
العام) واللغة المختصة (المعجم المختص، أو الإقطاعي،أو الاصطلاحي)
حتى لا يبتعد التواضع في الاصطلاح ويستغلق، وحتى يظل الذهاب
والإياب بين المعجم العام والمعجم المختص قائما وفاعلا.
إن النظر إلى هذين الإشكالان يمكنان من فهم درجة التباين
الحاصل اليوم في معالجة المصطلح. فكلما اتسعت الهوة بين المعجم
العام، باعتباره يشكل القاعدة العامة المتداولة، والمعجم المختص
الذي يعتبر أحد الخصائص الذاتية التي تنشغل بإعطاء وفحص المادة
المعجمية في مجال اشتغالها، كلما كان هناك خلط وارتباك وابتعاد عن
الفحص الدقيق للمادة المعجمية.هذا التباعد يزكي العجز عن الإحاطة
الشاملة بالمصطلح قبل تحوله إلى اللغة العامة،لذلك نعتقد أن آلة
الاصطلاح يجب أن تبقى معطلة إلى أن يختمر المصطلح في لغته الأم
وينمو ثم نعمل على نقله بكل أمانة إلى اللغة العربية تفاديا إلى
بعض الانزلاقات المعرفية من قبيل استعمال "صوتيم" عوض "صوتية "
للدلالة على فونيم (PHONEME). واستعمال DISTRIBUTONNOLISME للإحالة
على النظرية الاستغراقية، بدل الإحالة على التوزيعية، بالإضافة إلى
مجموعة كبيرة من المصطلحات اللسانية الحديثة التي خرجت بشكل كبير
عن المألوف.ومن أجل ضبط ذلك نعقد مقارنة بين بعض المصطلحات كما
وردت في المعجم الموحد،ومقابلاتها كما وردت عند الفاسي الفهري من
قبيل :

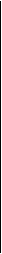 المصطلحات المقابل في المعجم الموحد
المقابل عند الفاسي المصطلحات المقابل في المعجم الموحد
المقابل عند الفاسي
Agromamaticalite (عدم الاستقامة ) لا نحوية
Complementizer ( المعمول به) مصدري
Distribution complémentaire ) التعاقب بالتنافي التوزيع
التكامل
Morphème /meneme دالة نحوية صرفية
Signe linguistique علامة الدليل اللغوي العلامة اللغوية
Analyse morphologique تحليل إلى دوال التحليل الصرفي
Acceptabilité استحسان القابلية أو المقبولية
Competence الملكة اللغوية القدرة
Crammaticalite السلامة النحوية اللغوية
Topicalisation التحديث أو الابتداء التبئير

وهذا النوع من المصطلحات يطرح جديًّا عدة قضايا، على
رأسها:طبيعة الترابط بين المعجم والمصطلح من جهة، وبين المصطلح وما
يحيل إليه من مفاهيم من جهة أخرى. خصوصًا عندما يتعلق الأمر
بالحمولة الفكرية والثقافية التي يتحرك فيها هذا المصطلح. فالسياق
الفكري والثقافي يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على
مستوى الحياة التي يعيشها المستعملون له أفرادًا وجماعات، كما يعكس
أيضًا نوعية العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الثقافي. لنأخذ آخر
مصطلح موظف هنا topicalisation، ونفترض أن أي متعلم أو باحت أراد
أن يطلع عليه داخل درس لساني معين، فكيف له أن يجمع في الوقت نفسه،
بين التحديث و الابتداء في النحو العربي، وبين التبئير في
اللسانيات الحديثة، تم ما الغاية من هذا التعدد؟ وما مدى القرابة
المعرفية التي تحدد عملية التحديد ؟ وبذلك نضيف متاعب جديدة
للمتعلم والباحث العربي. ولا شك أن تعدد المتدخلين في المعجم
واختلاف وجهات نظرهم ومستويات تكوينهم اللساني ساهم بشكل كبير في
وجود نوع من عدم الوضوح في التعامل مع المقابل العربي
إن مثل هذه الصياغة المصطلحية تتنافى والدقة المتوخاة من
التحديد الدقيق للمصطلح اللساني الحديث، ونعتقد أن هذه المقابلات
المقترحة تعكس عدم التنسيق بين اللساني اللغوي والمختص حتى يتم
التحديد الدقيق لها، اعتبارا منا أنه لا يمكن أن نلتمس الموقف
الموسوعي للمصطلح إلا من خلال شخصان اثنان، لغوي عارف بدقائق اللغة
العربية ومختص يستطيع أن يحدد المضامين،لتكتمل المعطيات الصرفية،
والاشتقاقية، والدلالية للمصطلح.
كما يكشف هذا التضارب في المصطلحات الطابع الانفرادي الذي يبرز
أن هناك زيغ للمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، إذ يرجع ذلك أساسا
إلى عدم النسقية في نقل المصطلح، فبعض المصطلحات سيارة التي تنتقل
من مجال إلى مجال آخر دون أن تبدل من مدلولها، مثل "marque " التي
تقابلها "السمة" تنتقل داخل الصواتة، والصرافة، والتركيب بنفس
النسق، فنقول " marqué" بمعنى "الموسوم" و " marquage " " وسم "(8)
وبالتالي فكلما زادت الهوة بين اللغة العامة والاصطلاح كلما كانت
عملية التطور والتوليد مؤثرة في النسق الدقيق والأمثل الذي يحكم
عملية التحديد.
إلى جانب هاته الإشكالية التي يعاني منها البرنامج الاصطلاحي،
لم تسلك قاعدة توليد المصطلح طريقاً واحداً لمقابلة المصطلح
اللساني باللفظ العربي. إذ لا يكفي أن تكون لدينا قائمة
بالمصطلحات، لكن الأهم أن تكون لنا ضوابط نسقية في صوغ هذه
المصطلحات بشكل يضمن نوعاً من الانسجام والدقة والمرونة في استخراج
المقابل المناسب. إعتبارا أيضا إلى الجمود ظل يطبع آليات تكوين
المصطلح،فعلي الرغم من القاسم المشترك الذي تجتمع عليه كل المؤسسات
و المجامع اللغوية العربية والمتجسد في أهمية التعريب، إلا أن هناك
من ينتصر للترجمة على حساب التعريب، إذ لم نستغل هذه الرخصة كما
يجب، علاوة إلى أن بعض المصطلحات يجب التعامل معها بحرص شديد نظرا
للحساسية الثقافية والوجدانية من قبيل " الخطاب، والنص، والتأويل "
نعتقد أنه من الأفيد أن نقوم بعملية اختزال الإشكالات بطرحها
المصطلح اللساني الحديث في مجموعة من النقط حتى يسهل على القارئ
مناقشتها والوقوف عندها بما يلزم من الدقة،اعتبارا منا أنه لا سبيل
للاختباء وراء النرجسيات والعنتريات التي تعمل على تسويق الكلام
المعسول حول لغتنا. الكلام شئ والواقع شيء آخر، اللغة العربية تعيش
أزمة حقيقة في إيجاد المصطلح الأمثل، الأكيد أننا عندما نضع الأصبع
على الداء يسهل الحصول على الدواء وبالتالي فإن الحكمة تقتضي
التعامل مع الواقع المصطلحي من منطق الواقع والموجود، وعليه نؤكد
أن أزمة وإشكال المصطلح اللساني الحديث ترجع، إلى جانب الأسباب
المذكورة أعلاه، إلى :
1 التنوع في مصادر التكوين العلمي للسانيين يؤثر على شكل
سلبي في مسالة توحيد المصطلح.
2 توزيع اللسانيين عبر مشارب معرفية
مختلفة،فرنسية،وانجليزية، وألمانية، مما يعكس النزعة الإديولوجية
التي تطبع أبحاثهم.
3 تضارب المصطلحات بين كل الاتجاهات يجعل وضع المصطلح في
حاجة إلى إعادة ترتيب البيت حفاظا على وحدة المصطلح ومحاولة في
الدفاع عن أحاديته.
4 اختلاف الآليات التي تولد المصطلح من مجمع /معهد لغوي
إلى آخر، بل من لساني إلى آخر مما يعكس أن عملية التنسيق غائبة
وغير حاضرة بأي شكل من الأشكال.
5 اتساع الهوة بين الجانب النظري والجانب المنهجي بين
أقطاب الدرس اللساني العربي.
6 معالجة المصطلح من زاوية فكرية تصورية مما يسقط معالجته
في اختصاص آخر يقترب من المفهوم.
4-نحو مصطلح لساني موحد
سأل ملك الفيلسوف كونفيشيوس في الصين عن كيفية إصلاح البلاد
فأجابه:"عليك أن تبدأ بإصلاح اللغة"(9)
إذن،اللغة العربية الفصحى في حاجة إلى تلاحم جميع اللسانيين و
المختصين من أجل العمل على تيسير استعمالها في الحياة العامة،وتجنب
كل التعقيدات الممكنة،وتدليل الصعوبات الكائنة،وتبسيط القواعد
النحوية، والصرفية، مع العمل على تزكيتها بقوالب صيغية و مصطلحات
جديدة في حدود اللغة القابلة للاستعمال.
هنا يمكن أن نبتدئ بوضع منهجية واضحة و موحدة في توليد المصطلح
اللساني الحديث.
إن استخدام المصطلح اللساني الحديث داخل الترجمة و التعريب هي
أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى خلخلة التوازن المعرفي الذي نضبطه،
لذا كانت الضرورة ملحة من أجل ضبط دقيق للحالات التي ينبغي فيها
ترجمة المصطلح و الحالات التي يجب فيها تعريبه،على الرغم ممن يوازي
بين الترجمة والتعريب ويعتبرهما شيئا واحدا. وهو أمر خاطئ بالنظر
إلى مسألة التخصص ومجال الاشتغال.
إن الآلة التي بموجبها اشتغل جل الباحثين في المجال الاصطلاحي
هي: الاشتقاق، والاقتراض، والنحت، و التوليد.إذ يصر بعض المصطلحيين
على إيجاد المقابل العربي و تجنب الوافد الأجنبي،هذا التجنب الذي
يؤدي في غالب الأحيان إلى خلق مقابلات متعددة، وعلى ضوء هذا،يتأكد
أن النقاش و الخلاف بين اللسانيين الساهرين على تنظيم المصطلح داخل
المعجم، فمنهم من ينتصر للنحت فيضع كمقابل
ل électromagnétique 'كهرمغناطسي' وهناك من يعمل على تحليل الكلمة
ويقسمها إلى أجزائها الأصلية قبل تعريبها مثلا. walky-talky،في
مقابل ذلك هناك من يبحث في الإرث اللغوي ليستعمل بدل
التلفون،الهاتف.
وهو الأمر الذي انعكس، بالتأكيد،على عملية عدم الضبط الدقيق
للمصطلح اللساني الحديث،إذ نجد كمقابل ل مصطلح phonology علم
الأصوات التنظيمي،علم التشكيل الصوتي،علم وظائف
الأصوات،النطقيات،علم الأصوات،علم الأصوات التشكيلي أو التنظيمي،
علم النظم الصوتية،دراسة اللفظ الوظيفي،علم الأصوات اللغوية
الوظيفي. وبالتعريب يمكن أن ننقل الكلمة عبر الاشتقاق phonological
كمقابل ل : فونولوجي،و phonology كمقابل ل: فونولوجيا.(10)
إذا كان جميع المختصين،و كل المجامع اللغوية لا تخرج عن ذلك
الإطار الذي يحدد بشكل قوي القواعد الأساسية التي بموجبها يحوسب
المصطلح،فلما لا توجد خطاطة عامة نعمل بموجبها على توحيد المصطلح
اللساني،كما أنها ستوفر مجموعة من إمكانات التوليد الدقيقة و
المضبوطة،من منطلق تطبيق آلية الاشتقاق، والنحت،و الاقتراض،
والتوليد. وفي هذا الإطار أورد الفاسي الفهري خطاطة عامة نعتقد
أنها كفيلة بأن تحل مشكل المصطلح اللساني و هي:
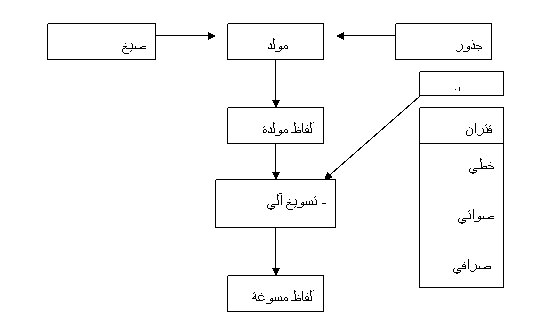 خطاطة
عامة لقاعدة الإصلاح المولد (11) خطاطة
عامة لقاعدة الإصلاح المولد (11)
الجذور المولدة يتم قرنها بالصيغ، التي بموجب ذلك تعمل على
توليد عدد من الألفاظ التي تخضع لعملية الإلصاق،لتحط الرحال داخل
المصافي الآلية إذ يتم استبعاد الجذور التي يتكرر فيها الحرف
الواحد مثلا(ب ب ب) جذر غير ممكن آليا.وتصفى كذلك الجذور التي
تبتدئ بصامتين مثلا: (قق) (ظظ).وإذا كانت بعض الحالات الشاذة يتم
إدراجها ضمن معجم خاص، ولكن لا يتم توليدها بطريقة آلية. ليتم
الانتقال إلى عملية التسويغ بنوعيه الآلي و بالتمثيل الذي نعود فيه
إلى المعاجم والنصوص في علاقتها بحدود مستوى النسق اللغوي. إذ يجب
هنا أن نفصل بين ما يمكن أن يقبله النسق،ولا تقبله المعاجم و
العكس.ومن تم لا يمكن أن نحكم على عدم جوازه،بل هي فكرة أساسية
تجعلنا نفرق بين الأشياء التي يقبلها كل مستوى بعد ذلك ننتقل إلى
إعطائها صورة خطية عربية محوسبة بدقة.
بناء على هذا،نقول إذا كانت المصطلحات اللسانية تتوق لأن تصبح
دراسية علمية للمفاهيم والمفردات الموجودة في اللغات الأجنبية،فإن
التوليد الاصطلاحي باعتباره آلية معيارية،يمكن عدها قاعدة تتجه نحو
التمثل والتحقق.هذا شئ سينعكس على ضبط العوالم التي من خلالها يمكن
أن نصنع ثقافة لسانية جديدة تمنح الدرس اللساني حيوية جديدة تواكب
التطور الذي ما فتئت هوته تتسع يوما عن يوم، و تبديد
هذه الهوة لن يتأتى إلا عبر المرور على سكة توحيد المصطلح
اللساني وتزكية حضوره.
* معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب
كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط-
........................................................
المراجع
1- د. عباس الصوري(1995): الرصيد المعجمي في اللغة العربية،
الرباط
2-ابن منظور،لسان العرب،ج12،دار الصادر،بيروت،لبنان
3- قيس خزعل جواد(1989):حول المفهوم و المصطلح في الفكر
العربي،رسالة الجهاد،ع81،ليبيا
4- الخياط،محمد هيثم(1995):نحو منهجية لوضع المصطلح العربي،
لحديت،الموسم الثقافي 12 لمجمع اللغة العربي
5-نبيل علي و نادية حجازي(2005):فجوة اللغة،رؤية معلوماتية،ضمن
عالم المعرفة.الكويت.
6- المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات(1989): المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم، تونس
7-محمد حلمي هليل(2003):التقييس المصطلحي في البلاد
العربية،مجلة اللسان العربي،المجلد7،ع145
8- محمد بنخلف(1987):التعريب و المعاصرة،الوحدة،ع34،33،المغرب.
9-ع الفاسي الفهري(2005):أزمة اللغة العربية في المغرب نين
اختلالات التعددية و ثغرات "الترجمة"،منشورات الزاوية،المغرب.
10- ع الفاسي الفهري (1998):المقارنة و التخطيط،دار
توبقال،ط1،المغرب
11- ع.الفاسي الفهري(1985): اللسانيات واللغة العربية، دار
توبقال الدار البيضاء.
|
