|
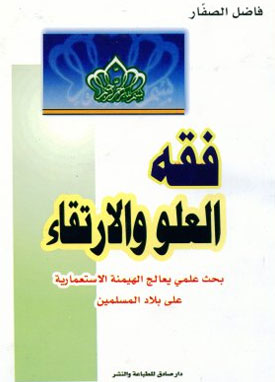 الكتاب: فقه العلو والارتقاء. الكتاب: فقه العلو والارتقاء.
الكاتب: فاضل الصفّار.
الناشر: دار صادق للطباعة والنشر، كربلاء
المقدسة.
سنة النشر: ط1، 1426.
الصفحات: 208 صفحة، قطع كبير.
قراءة: حسن آل حمادة
تمهيد
أصبح الفقه بفضل نخبة من الفقهاء والعلماء المعاصرين،
حاضراً في جميع المجالات الحيوية في الفكر الإسلامي المعاصر، ولم يعُد
قاصراً على الموضوعات التقليدية التي أشبعت بحثاً ودراسةً!
ولعلّ الفقيه الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي [1347-1422هـ]،
يأتي على رأس هذه الطليعة التي كتبت فقهاً معاصراً، دلّل من خلاله على
أن الإسلام بإمكانه أن يُسهم في صياغة الحياة الكريمة لهذه الإنسانية
التائهة، وفقاً لضوابط تقعيدية مبنية على الأسس الفقهية، وفي الوقت
نفسه، يُحلِّق بمعتنقيه بأجنحة الحداثة والمعاصرة.
فالإمام الشيرازي (رحمه الله) كتب في فقه السياسة، وفقه الدولة
الإسلامية، وفقه الاقتصاد، وفقه الاجتماع، وفقه الإدارة، وفقه المرور،
وفقه البيئة، وفقه العولمة، وفقه المستقبل، وفقه السلم والسلام...إلخ؛
ضمن موسوعته الفقهية الشهيرة التي ناهزت المائة والخمسين مجلداً، وأسس
بذلك مدرسة فقهية معاصرة، ارتقت بالفقه لخوض غمار الموضوعات الحديثة؛
التي قد لا تغري نخبة من العلماء على طرقها عبر بوابة الفقه!
وضمن هذا السياق صنَّف أحد تلامذة الإمام الشيرازي، وهو
العلامة الفقيه الشيخ فاضل الصفّار، كتابه الماثل بين أيدينا؛ لبلورة
جملة من المباحث المتعلقة بالقاعدة الفقهية المعروفة بـ(قاعدة العلّو
ونفي السبيل)، ويلحظ القارئ لهذا البحث العلمي الرزين؛ أن الشيخ قد
توسع في شرح القاعدة؛ ليعمد على تطبيقها فيما يخص كثير من المستجدات
التي نعيشها في هذه المرحل الزمنية، مما سنعرض له في طيّات هذه
المراجعة.
مفاد القاعدة:
قد اشتهر اسمها بين الفقهاء بقاعدة نفي السبيل؛ لاستنادهم
فيها إلى الآية الشريفة: {ولن يجعل اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا}[النساء:141]،
ومفادها -حسب المؤلف- نفي سلطة الكافر على المسلم بأي نحو من أنحاء
السلطة، ومن هنا ذهبوا إلى أن كل معاملة من المعاملات أو علاقة من
العلاقات الاجتماعية والعقديّة -وربّما تعمّم لتشمل السياسيّة
والاقتصاديّة والعسكريّة وغيرها بين المسلمين والكفّار- إذا كانت موجبة
لتسلط الكفّار على المسلمين فإنّها لا تجوز تكليفاً، كما أنّ المعاملات
ونحوها قد يقال ببطلانها وضعاً، كما تمسك الفقيه المراغي بها، وعنونها
بأنّها من جملة مبطلات العقود استناداً إلى القاعدة، سواء كان ذلك في
البعد الفردي أو الجمعي(ص7).
فهذه القاعدة مطبقة في موارد كثيرة في مختلف أبواب الفقه
من العبادات والمعاملات والأحكام، كما أنها لا تنحصر في إبطال العقود،
وهي اليوم محلّ ابتلاء الكثير لتداخل المجتمعات وارتفاع الحواجز
الجغرافيّة في الجملة وتداخل الثقافات وكثرة حالات اللجوء والهجرة إلى
بلاد الغرب، أو مجيئهم إلى بلادنا للسياحة والعمل ونحوها. ولعلّ إحدى
جهات البطلان والحرمة فيها ما صرّح به مؤلف (جواهر الكلام في شرح شرائع
الإسلام)، الشيخ محمد حسن النجفي، من قيام الأدلّة على وجوب إعزاز
المسلم وتعظيمه وعدم إهانته، واستدلّ له بأنّ: "الإسلام يعلو ولا يُعلى
عليه"(ص8).
ويذهب المؤلف في بحثه قائلاً: لم نعثر على موارد كثيرة تعرّض لها
الفقهاء لعلّو الإسلام فيها بالمقدار الذي يمكن أن يستظهر من الحديث "الإسلام
يعلو"، فهم قد اكتفوا ببعض العقود والمعاملات المعهودة، كبيع العبد
المسلم إلى الكافر، أو المصحف الشريف، أو حكمهم بعدم علوّ بيوت الكفّار
على بيوت المسلمين، أو عدم جواز نكاح الكافر للمسلمة، وغير ذلك. مع
أنّا -والكلام للمؤلف- لو أخذناها بالتأمل والتحليل فربّما يمكن أن
نستفيد منها جملة من الأحكام المهّمة التي تخصّ شؤون الحياة العامّة
للمسلمين في أبعاد السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم والتربية
والإعلام وغير ذلك من الشؤون(ص8).
وهذا الطرح هو المنحى الذي سار عليه المؤلف وبه تميّز كتابه؛ ليجعله
-بحق- بحث علمي يعالج الهيمنة الاستعمارية على بلاد المسلمين، وهو
بأطروحته هذه تجاوز البحث التقليدي حول القاعدة، لينطلق بها في رحاب
واسعة، جمعت بين البعد الفقهي والفكري في آن، وهو الأسلوب الذي نرتئي
كقرَّاء ومتابعين أن يُتَّبع كمنهجية حديثة في البحوث والدراسات
الفقهية المعاصرة.
وقبل الاسترسال في الحديث عن القاعدة، ننوه إلى؛ أن الفقهاء جمعوا
الرواية النبوية التي جعلوها عنواناً للقاعدة: "الإسلام يعلو"، والآية
الشريفة: {ولن يجعل اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا}[النساء:141]،
في قاعدة واحدة وساقوها مساقاً واحداً، إلاّ أن الظاهر أنّ "الإسلام
يعلو"، -كما يوضح الصفّار- يصلح أن تكون قاعدة مستقلة أيضاً، لما يترتب
عليها من فروع مهمّة قد لا تستظهر من الآية... فإن الآية تشير إلى
العقد السلبي من القاعدة إذ تنفي سيطرة الكفّار على المؤمنين، والرواية
تشير إلى العقد الإيجابي، وهي تدعو إلى العلوّ وسيطرة المؤمنين على
الكافرين، وبذلك أيضاً يظهر وجه الجمع بينهما وسبب سوقهما مساقاً واحداً؛
لأنّ أحدهما يكمّل الآخر، ويشير إلى جهة ربّما لم يتعرض لها الآخر بشكل
صريح(ص8-9).
القاعدة في دلالة الكتاب
وتظهر القاعدة في آيات لعّل من أهمّها آيتين، هما:
الأولى: قوله سبحانه: {ولن يجعل اللهُ للكافرين على
المؤمنين سبيلا}[النساء:141].
الثانية: قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن
المنافقين لا يعلمون}[المنافقون:8].
وفيما يرتبط بدلالة الآية الأولى، فقد استفاد منها بعض
الفقهاء نفي السبيل مطلقاً؛ الأعم من التكويني والتشريعي، كما يذهب
لذلك المراغي (رحمه الله)، أما السيِّدان البجنوردي، والشيرازي (رحمهما
الله)، فنفيا السبيل التشريعي فقط، بمعنى رفع الحكم الشرعي الذي يوجب
تسلّط الكفّار على المسلمين، وكأنّ وزانه عندهم "لا ضرر"، و"لا حرج"،
ونحو ذلك(ص18-19).
فتحصّل من ذلك أن المراد عند الأخيرين، نفي الحجّة في الدنيا أو في
الآخرة، وإلاّ فمن جهة غير الحجّة فالكفّار لهم سبيل على المؤمنين بلا
ريب(ص26). وبتعبير الإمام الشيرازي، "بأنّ الآية في مقام التشريع لا
التكوين؛ لوضوح أنّ الكفّار أحياناً يغلبون المسلمين، ويعلون عليهم
علوّاً ماديّاً، كما علا فرعون في الأرض"(ص17-18).
ويظهر أن المؤلف -الشيخ الصفّار- يذهب إلى "أن ظاهر الآية نفي
السبيل بنحو عامّ وكلّي"(ص27)؛ إذ يصل لنتيجة أخرى بعد تعمقه في سرد
الآراء، حيث يقول: إن الظاهر إمكان القول بشمول إطلاق الآية للسلطنة
التكوينيّة أيضاً بسلوك سبلها وأسبابها... ولعلّ هذا ما يظهر من (الجواهر)،
حيث ذكر جملة من المحتملات، ومنها نفي النصر والظهور لليهود على
المؤمنين، وهو ظاهر في التكويني كما لا يخفى، مضافاً إلى الحجّة في
الآخرة(ص42-43).
ويشكل الشيخ الصفّار على أستاذه الإمام الشيرازي بقوله: وبذلك يظهر
أيضاً أنّ ما ذهب إليه سماحته (رحمه الله) في الفقه: (القواعد الفقهية)،
من أنّه لو أريد التكوين منها خصّ المراد بزمان مولانا سلطان العصر
والزمان (عجل الله فرجه)، حيث الظهور المبارك وقّوة المؤمنين على
الكافرين، محل تأمّل، إذ إنّ إطلاق الآية إذاً لا يمنع منه مانع فهو
يشمل الزمانين معاً. نعم -يقول الصفّار- زمان ظهوره (عجل الله فرجه)،
أجلى مصداقاً وأظهر شمولية، إلاّ أنّه لا ينفي ما عداه. وإن لم يكن
هناك إطلاق يشمل التكوين فلا يشمل الاثنين معاً، فتخصيص سماحته [الشيرازي]
التكوين بزمان دون زمان ممّا لم نفهم له وجهاً، فتأمّل!(ص44-45).
ويمكننا أن نُعَّقِب على رؤية المؤلف الكريم، بأننا
-وبنظرة قاصرة- لا نميل لما ذهب إليه، من كون الآية تشمل المجالين:
التشريعي والتكويني؛ وإلا فليفسر لنا واقع الحال الذي نعيشه الآن
كمسلمين! اللهم إلاَّ أن يقال: إن الآية تشمل المجالين، ولكن؛ لأن
المسلمين لم يعملوا وفق التعاليم الإلهية، ولم يطبقوا وصايا الرسول
(صلى الله عليه وآله وسلم) التي جاهد من أجل تبليغها؛ بـ(انقلابهم)
عليها منذ أن أغمض عينيه، بل قبل ذلك! فهم في عيشتهم يعمهون!! وبتعبير
الشيخ فاضل الصفّار "إن الظاهر إمكان القول بشمول إطلاق الآية للسلطنة
التكوينيّة أيضاً بسلوك سبلها وأسبابها".. فالظاهر الذي يستنتجه الشيخ
الصفّار ينسفه الواقع المرّ الذي نعيشه، بل نتجرعه، يومياً!! وحتى لو
قيل إن العمومية في الآية الشريفة تفيد الغلبة المؤقتة للكافرين، فيما
الغلبة النهائية للمؤمنين، فهذا القول يُرّجِح كفة القائلين بالسلطنة
التشريعية، لا التكوينية! وإلاّ كيف نقرأ حياة أئمة أهل البيت (عليهم
السلام) العملية، فبيدِ من كانت السلطنة التكوينية في حياة أكثرهم؟
استرسالاً، أقول: أجل، لن يجعل اللهُ للكافرين على
المؤمنين سبيلا؛ إنهم أحرزوا حقيقة الإيمان، فهل هي مُحرزة في حياة
الفرد المسلم؟ وماذا قدمّ المؤمنون، وماذا عملوا، لكيلا يكون للكافرين
الغلبة والهيمنة؟
ولعلّه من المناسب أن نوجز هنا القصة التي نقلها المؤلف
عن كتاب الإمام الشيرازي "السبيل إلى إنهاض المسلمين"، فقد ذكر سماحته
أن الخليفة العثماني عبد الحميد، الذي سقطت تركيا على يده كان قد كتب
لافتة ونصبها فوق رأسه في قصره، وكان مكتوباً عليها رواية: "الإسلام
يعلو ولا يعلى عليه"! فإذا قيل له إن الغرب تقدم في النظام والسلاح
والصنائع، وما أشبه، مما يخشى عليه أن يتغلب على بلاد الإسلام كان
يكتفي بالإشارة للافتة.. وبسبب فهمه الخاطئ للدين، وبسبب دكتاتوريته،
سقطت دولة آل عثمان سقوطها الشنيع(ص250-251).
ذكرت هذه القصة، والنقاط السابقة، لأقول: إننا بحاجة لمزيد من
التأمل والدراسة، عندما نتمسك بشمول الآية للسلطنة التكوينية، إلى جنب
السلطنة التشريعية، والله العالم.
وفيما يرتبط بدلالة الآية الثانية وهي قوله تعالى: {ولله
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون}[المنافقون:8].
فإنها -حسب المؤلف- "ظاهرة في حصر العزّة بالله وبرسوله وبالمؤمنين،
ووجهه واضح، حيث إنّ عزّة المؤمنين هي عزّة لرسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) ولله سبحانه؛ لأنّهم منسوبون إليهما، وعاملون لأجلهما كما
هو واضح، والسلطنة تنافي ذلك من جهة منافاتها للعزّة؛ إذ مقتضى العزّة
الاستقلال بالتصرّف وحرّيّة الاختيار والسيادة على النفس والمال والعرض،
بل والفكر، فجعل السلطنة تنافيها. ومن جهة أنّ السبيل سلب الحريّة
والسيادة وهو مساوق للإذلال والمهانة عرفاً كما لا يخفى، ويكفي أحد
الملاكين في نفي السبيل فضلاً عن اجتماعهما"(ص71-72).
القاعدة في الأدلة الأخرى
ويُقصد بها هنا: دليل السنّة الشريفة، ودليل الإجماع، ودليل العقل.
وسبق أن أشرنا في السطور السابقة لدليل السنّة الشريفة، وعمدته
الخبر المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "الإسلام يعلو، ولا
يُعلى عليه"، وقد ألمع إليه المؤلف من حيث: السند والدلالة والأقوال،
بين قائل: بالتضييق، أو الإجمال، أو الإطلاق.
فالحديث بقول المؤلف، مرسل إلاّ أنّه معروف بين الفقهاء، بل
استدلّوا به في أكثر الموارد التي ينفون فيها سلطنة الكفّار على
المؤمنين، ويجرونه مجرى القاعدة(ص91). ويصرِّح الشيخ الصفّار إلى أنه
يميل إلى حجيّة الحديث "من باب بناء العقلاء أو تراكم الظنون
العقلائيّة المورثة للاطمئنان"(ص119).
"وأمّا الدلالة: فهي ظاهرة في علوّ الإسلام ذاتاً كدين ومبادئ
وأحكام، وصفة كسيادة وقوّة وحجّة، وعدم علوّ غيره عليه في الجهتين، فهو
يثبت من جهة وينفي من جهة أُخرى"(ص93).
وفيما يتعلق بدليل العقل، سنقتطع بعض العبارات من قول
المؤلف ليتضح المطلب، إذ نجده يقول: "إن مقتضى طبع العقلاء وفطرتهم
الأولى هو تحسين اعتدادهم بأنفسهم وحفظ سيادتهم وسلطتهم على أنفسهم
ومنع غيرهم من أن يكون له سبيل عليهم حتّى إذا كان من أهلهم وذويهم
فضلاً عن أبناء ملّتهم ودينهم... هذا في البعد الشخصي. وكذلك في البعد
الجماعي والأُممي فإنّهم يذمّون من يسلّم زمام الوطن والناس إلى
الكفّار، ويقبّحون فعلته، بل ويهبّون لمحاربة هذه السيادة والعلوّ،
بالأرواح الغالية والأموال من أجل رفعها عنهم... ومن المعلوم أنّ العقل
إذا حكم بحسن نفي السبيل وقبح جعله يتبعه حكم الشرع أيضاً، لأنّ هذا من
المستقلاّت العقليّة التي يتلازم فيها حكم الشرع والعقل، وعلى أقلّ
التقادير يصلح أن يكون مؤيّداً لدلالة الآيات والروايات"(ص121-122).
بعض التطبيقات العملية للقاعدة
أشار المؤلف لعدد من هذه
التطبيقات، ونورد هنا بعضاً منها:
- عدم ثبوت ولاية الكافر على المسلم، لأنّ الولاية سلطنة
وسبيل، فلا يجوز جعله قيّماً على صغار المسلمين أو سفهائهم، بل
ومجانينهم، وكلّ ما جعل الإسلام عليه ولاية وكذلك لو كان لميّت مسلم
أولاد كفّار فليس لهم الولاية في تجهيزه وتكفينه ودفنه، كما لا تتوقّف
على إذنهم؛ لأنّه نوع سبيل، بل الأمر يرجع إلى الورثة المسلمين، أو من
له الأولويّة العرفيّة به منهم، لقوله سبحانه: {وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75]، وإلاّ كان اللازم على المؤمنين
والحاكم الشرعي حسبة.
- عدم جواز جعله متولياً على الأوقاف الإسلاميّة، كالمدارس الدينيّة
والمستشفيات ودور الأيتام والمساجد والحسينيّات وقبور الأولياء
والصالحين فضلاً عن المعصومين (عليهم السلام) وغير ذلك؛ لأنّ التصرّف
في مثل هذه، أو التولّي عليها عرفاً من السبيل.
- عدم توقّف صحّة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر بناء على
توقّفها على إذن الولد؛ لأنّه من مصاديق السبيل.
- بطلان نكاح الكافر من المرأة إذا أسلمت؛ لأنّ الرجال قوّامون على
النساء، والزوج له نوع من تسلّط وسبيل على الزوجة فيما قرّر الشارع له
من الحقوق.
- عدم جواز تولّي الكفّار للحكومة أو الإمارة أو منصب الملوكيّة على
المسلمين؛ لأنّه من أجلى مصاديق العلوّ والسبيل، كما لا تنعقد له بيعة
ولا رأي أو تمثيل أو نيابة بناء على الانتخابات، فإنّ البلد إن كان فيه
إجماع مسلم فواضح، وإن كانت الأكثريّة مسلمة فالحكم للأكثريّة حسب
ضوابط العقلاء فضلاً عن السبيل، وكذا الكلام في الوزارات بدءاً من
الوزير إلى المديرين الكبار الذين يمنعون ويأخذون ويقرّرون على
المسلمين؛ لأنّه من المصاديق الظاهرة للسبيل(ص265-267).
إثارات وملاحظات من وحي القاعدة
تحت هذه السطور سنورد بعض المسائل والتنبيهات التي تطرق
لها المؤلف حول القاعدة؛ لنثيرها في هذه المراجعة، ولنضفي عليها بعض
الملاحظات التي نرتئي أهمية الحديث حولها، وهي على النحو الآتي:
ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إحداث الكنائس والصوامع
والبِيَع وغيرها من بيوت العبادة في بلاد الإسلام، وإذا استجدّت وجبت
إزالتها، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز إجازة الحاكم نشاط الكنائس
ونحوها... لأنه خلاف نظر الإسلام في تقليص الأديان والمذاهب... ومثل
هذا إجازتهم في نشر كتبهم ونشراتهم، وكذلك إلى سائر المؤسّسات ولو
الخيريّة منها إذا كانت سبباً لإظهار قوّة الكفر وسلطنته على
المسلمين(ص79).
هذه الأمور المذكورة أعلاها، إذا كانت تسبب سلطنة
الكافرين، فهي غير جائزة حسب المشهور.. لكن، ماذا لو لم تكن كذلك؟ هل
سنجيز حينئذ لهم بناء دور العبادة التي تخصهم؟ وهل سنسمح لهم بممارسة
حريتهم في التبشير بعقائدهم ومبادئهم؟
وماذا عنّا نحن -كمسلمين- هل، سنطالب بحرية بناء المساجد
ودور العبادة والتثقيف، إذا كنّا في بلادهم؟ أم إننا سنلتزم، بما
منعنهم من ممارسته؟
مثلاً، إذا أبقينا الكنائس القديمة، ولم نسمح بالجديدة؛
انطلاقاً من القواعد الفقهية، فبأي حق، سنطالب ببناء مساجد جديدة في
بعض بلدانهم التي لا توجد بها مساجد؟
من خلال ما سبق وددت القول: قد يتساءل البعض، إذن أين
الحرية التي كفلها الإسلام للآخر؟
وماذا عما ذهب إليه المشهور من عدم جواز أن يعلو دار
الكافر دار المسلم، خاصةً في بلاد المسلمين؟ وكذلك عدم حقهم في اللباس
الحسن والمركوب كذلك؟
أجل، قد نتفق مع المؤلف فيما يخص المسائل الثلاث الأخيرة،
عندما قال: "الأقوى اختصاص ذلك بصورة الهتك وانتهاك حرمات الإسلام
وإذلال المسلمين لا مطلقاً"(ص189).
وهنا نقتبس مسألة أثارها المؤلف على النحو الأتي:
قد يقال: إن العمل بمقتضى نفي السبيل وعلوّ الإسلام والمسلمين
يستلزم التفريق بين الناس ومنع التقدّم وإيجاد الأزمات بين الكفّار
والمسلمين؟ وهنا إجاباته مختصرة:
أولاً: أنّ ما يفعله الكفّار بالمسلمين من الإضرار والهتك
في أساليب السيطرة شنيع جدّاً.. فهم يمارسون قتل وإبادة الحرث والنسل..
ثمّ نحن لا نعمل ذلك إلاّ دفاعاً وحمايةً من علوّهم وتجبرهم؛ لأنّ
الإسلام رحيم والمعتقدين به رحماء، خصوصاً وأنّ الحاكم الشرعي يمنع من
ظلمهم أو التعدّي عليهم، فشتّان بين نفي السبيل في الإسلام وغيره؛ ولذا
لم تحدث أيّ مشاكل وأزمات مع أهل الكتاب أثناء حكم الإسلام مع أنّ
القوانين كانت مطبّقة على الجميع.
ثانياً: أنّهم بإقدامهم على الكفر ورفضهم الهداية يكونون
قد عرّضوا أنفسهم لذلك.
ثالثاً: أنّ مقتضى الالتزام بكلّ دين وشريعة شرائط
وقوانين ينبغي مراعاتها؛ لأنّ من التزم بشيء التزم بشرائطه، فكما نحن
نلتزم بشرائط الإسلام وهم يلتزمون بأديانهم فعليهم الالتزام بآثارها
السلبيّة أيضاً، كما يفعل اليوم القانون الوضعي، فإنّ من يلتزم بقانون
بلد يدفع الضرائب له، ويخضع لأزماته وحروبه، ونحو ذلك، كما أنّ من
يلتزم بالاستبداد أو بالديمقراطيّة يلتزم بشرائطهما، وهكذا(للمزيد،
ص189-192).
في تعيين بعض المقدّمات الوجوديّة للعلوّ ونفي السبيل
إيماناً من المؤلف بوجوب العمل لتهيئة المقدّمات الوجودية والأخذ
بها للدفاع عن حقوق المسلمين كيلا يصبح سبيل للكفّار عليهم، وكذا
للإقدام البنائي من أجل علوّ الإسلام وإعزاز المسلمين ورفع كلمة لا إله
إلاّ الله منصورة قوية على المعمورة، ونظراً لأهمية هذا المبحث وقلّة
من تعرض له من الأعلام -بعبارة المؤلف- فقد أفرد ذلك في بحث مستقل
ومطول، أضفى على الكتاب جنبة فكرية هامة، إضافة لأطروحته الفقهية
المتماسكة.
وفي أساليب رفع السبيل وأحكامه تعرض المؤلف لمسائل بعضها يرتبط بوصف
المرض والآخر بالعلاج، وسنكتفي بالإشارة إلى بعض منها، كعناوين:
فقد تطرّق الكاتب لوجوب: رفع هيمنة الكفّار على المسلمين، وإلغاء
قوانين الهيمنة على المسلمين، وإلغاء القوانين المحاربة للدين وكرامة
الإنسان، ومكافحة الاستعمار بالعمل الإيجابي.
ومن البدائل المشروعة التي يؤكد عليها المؤلف: إحياء المفاهيم
الإسلامية، التنظيم في حياة المسلمين، الاكتفاء الذاتي، تأسيس منظمات
الحماية التي تهتم بشؤون المسلمين.
ملاحظتان فنيتان حول منهجية المؤلف
- عندما تطرق المؤلف لدلالة الكتاب [القرآن]، حول
القاعدة، في مبحث المقصد الأول الذي يبدأ من الصفحة (17)، قال بأنها
تظهر في آيات لعلّ أهمّها آيتين، واستشهد بالأولى: "ولن يجعل
اللهُ...إلخ"، وراح يبحث في دلالتها لغاية الصفحة (69) من الكتاب، ثم
وفي نفس الصفحة أشار للآية الثانية: "ولله العزة ولرسوله...إلخ"، وهذا
الأسلوب يربك القارئ، الذي سيجهد نفسه في تقليب الصفحات لمعرفة الآية
الثانية، وكان من المستحسن أن يشير إليهما معاً -كما فعلنا تحت عنوان
القاعدة في دلالة الكتاب- ثم يفصِّل في استدلاله حول كل آية على حدة.
-كان بودي أن يعمد المؤلف لتلخيص آرائه في نهاية كل مقصد
فقهي تطرق إليه في الكتاب، حتى يسهل على القارئ استيعاب مادته العلمية،
ومعرفة خلاصة رأيه بوضوح، بدلاً من البحث عنها بين ثنايا السطور، وربما
لم ينهج الباحث ما ذهبنا إليه؛ كون الكتاب في الأصل مجموعة من الدروس
الملقاة على طلبة الحوزة العلمية في جوار السيدة زينب (عليها السلام)
في الشام عام 1421هـ، وطريقة الدرس والبيان تتطلب التدرّج في عرض
الأدلة الموافقة والمغايرة. |
