|
هذا الحصر يعني نفي احتمال قيام الصراع على أساس آخر أكثر خطورة من قبيل (هل نستمر على الإسلام أم نعود إلى الجاهلية؟!)، وبنجاح الحصر السابق تم إلغاء هذا الاحتمال، وهو يعادل النجاح في ترسيخ الإسلام في الفاصلة الواقعة بين عهد الرسول(ص) وعهد الإمام علي(ع)، وتحويل الصراع إلى صراع داخلي (بين إسلام ولائي وإسلام غير ولائي). ويلاحظ أن البعد الذي سعى الإمام علي(ع) لإبرازه كمميز رئيسي لعهده تجلى في تأسيس واعتماد آليات تساهم في جعل النخب والجماهير في وضع القدرة على الفرز بين الخطوط التي تدّعي الانتماء إلى الإسلام؛ ولهذا فإنه ركّز على تعميق الثقافة المميزة، أو عدسات الوعي، من قبيل (إعرفْ الحق تعرف أهله) أو(لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق) أو (لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قيل) وبذلك وضع عقبة كؤود أمام (الحالة الأموية) التي مارست سياسة غريبة وبعيدة عن روح الإسلام، وبفضل جهد الإمام برز النظام الأموي كنقلة حادة وعدول تام عن الإسلام، وبمجرد مقارنته بعهد الإمام علي(ع) فإنه بدى كعملية إحياء واسعة للجاهلية من خلال بناء إمبراطورية عربية تحت شعارات إسلامية، وبذلك تم ضرب الأساس الإنساني الذي يقوم عليه الإسلام، ومن ثم ايقاظ العصبية القبلية، كرابطة بديلة عن رابطة العقيدة، ومع العصبية استيقظ الحس القومي لدى العرب فايقظ بدوره الحس القومي لدى الشعوب الأخرى وهي ما تزال آنذاك حديثة العهد بالإسلام، ثم إقامة نظام ملكي وراثي، وهو مما لا أساس له في الإسلام، وإنما استوحي من الأنظمة الرومية التي كانت له روابط بها. كما يكتسب وبالتبع دور الإمام الحسين(ع) أهمية خاصة؛ إذ إنه قام أيضاً على مبادئ مناقضة تماماً للمبادئ الأموية التي كانت تريد تكريس مبدأ (الخضوع للقوة) و(القدرية) و(الرضى بحكم السلطان) مهما كان؛ فجاءت ثورته (ع) وهو ابن رسول الله(ص) لنزع الإسلامية عن هذه المبادئ؛ لما كان يمثله الإمام الحسين(ع) من إرث النبوة، ولما كان يحظى به من إقناع لدى النخب وعموم الأمة، وبذلك أسس الإمام(ع) خط المقاومة، وعدم الخضوع للقوة مهما كانت عظيمة، ورفض أي نوع من التبرير لهذا الخضوع. ومن هناك انطلقت موجة المعارضة المتعددة الاتجاهات فحجّمت من حالة التكلس التي سعى الأمويون لإرسائها باستخدام سلاح الترغيب والترهيب، والذي كاد أن يشمل بآثاره النخب المثقفة في الأمة، ويدل على هذا التكلس مطالبة عدد كبير من أبناء الصحابة الإمام(ع) بعدم الخروج، لكنه(ع) وهو الذي يعرف ماذا يفعل، أصّر على الخروج وترك صرخته العظيمة التي تدوّي في عمق التاريخ حتى اليوم الموعود يوم ظهور الغائب المنتظر(عج) الذي يكون شعاره (يا لثارات الحسين(ع)). ولقد كانت مهام بقية الأئمة (ع) بدءاً من السجاد(ع) متعددة؛ وكان منها ترسيخ مبادئ الثورة الحسينية، بل كان أهمها تقوية الحس الثوري والاندفاع نحو الاستشهاد؛ وبذلك ترسخ في التاريخ الإسلامي التيار المعارض الذي سجله لنا التأريخ بالصورة المعروفة. والمهمة الرئيسية الأخرى التي أداها الإمام السجاد(ع) هي مهمة التثقيف وتعميق الوعي الذي كان عليه أن يكشف زيف ادعاء السلطة بأنها ممثلة للإسلام، وأن الإسلام الذي تمثله هو الإسلام الوحيد؛ وبذلك سلب من السلطان إمكانية تبرير انحرافه بالإدعاء أنه أمر من السماء، تلك الطامة التي دمرت أغلب الديانات السابقة حيث يقفز الطغاة بعد النبوة مدعين بأنهم ممثلو السماء، ثم يغالون فيقولون أنهم أبناء الله أو أبناء الآلهة، لتضيع معالم الحقيقة، ثم يعملون لإهلاك الحرث والنسل وتكون وحشيتهم منسوبة إلى الله لأنهم أبناؤه، ولهذا يجب الالتفات إلى أهمية الدور المستقبلي الذي أصبح اليوم ماضياً بالنسبة لعصرنا، والذي مارسه الأئمة(ع) بصمت دون أن تدرك الأمة أو النخب أو السلطات المرامي العميقة لتصرفاتهم، وتقبلها البعض على شكل شعارات ومحفوظات لا أكثر أو تعبداً في الغالب؛ حتى بدت في بعض الأحيان غريبة، تلك الثقة العالية التي كانوا يتحدثون بها عن نهاية هذه السلطات، وعن المستقبل وعن سيادتهم الآتية، مع أن ذلك أمر يستند إلى العقل وإلى قراءة المعطيات الواقعية وإخبارات الرسول (ص) بالإضافة إلى ما كان يُلقى في روعهم من قبل الله سبحانه وتعالى. فيزيد حينما (بُشر) بقتل الحسين(ع) فرح، ولكنه بعد أيام قليلة صار يبكي؛ لأنه رأى نتائج فعلته الشنيعة، وأحسّ المأزق الذي فرضه عليه الإمام(ع). أما الإمام الباقر(ع) فقد أطلق موجة ثقافة (وعي الدين) حيث انتعشت مدرسة نقد الحديث وفرز الرجال، ونقد المتون ومناقشة أبعادها كبديل عن محاولات السلطات فرض التسليم الأعمى للحديث، ولم تلتفت السلطات في البداية إلى خطورة عمل الإمام(ع) لكنها التفتت إلى ذلك بعد فوات الآوان، فحاولت اصطناع الفقهاء الذين حاولوا نشر وإذاعة مقولات السلطة، لكنها لم تنجح إلا في الحفاظ على الذات، بينما استطاع الإمام(ع) عن طريق هذه الخطوة: 1- نشر ثقافة القراءة النقدية للنصوص وهو مبدأ يؤكد الوعي. 2- فرز خط الإمامة - كحالة فقهية أصيلة - عن خط فقه السلطة. 3- إنهاء فرصة وضع أكاذيب جديدة ونسبتها إلى الرسول(ص). أما الإمام الصادق(ع) فقد قام بتوسيع ما قام به والده(ع) مضيفاً إليه نشر (العلوم المحضة) وهي من الأدوات المهمة في تحقيق التكامل الاعتقادي الذي يشكل أحد أهم أغراض وأهداف الإسلام؛ حيث يريد الإسلام الوصول إلى أدق صور الإدراك الموضوعي للكون، فإنه من حيث ذيوعه كمبدأ ومنهج ساهم في تطوير أساليب اليقين التي تقلص من فرص عشعشة الدجالين أو نشر الخرافات التي تقف وراء الانحرافات. وهنا أيضاً كما في المرات السابقة استمرت السلطات في ايلاء اهتمامها للعلوم الدينية فقط، ولم تلتفت إلى خطورة انتشار العلوم الدنيوية، لأنها كانت تعتقد أنها محايدة، مع أنها ليست كذلك، لأنها من أهم الأدوات التغييرية التي ستعتمد عليها عودة سيطرة خط الإمامة ولكن بعد حين. فالعلم في البداية يكون سلاحاً يتصرف في توجيهه الإنسان، لكنه بعد رسوخه فانه هو الذي سيقود الإنسان (أما ويبر فقد ترك باب التأريخ مفتوحاً بشكل واسع للتوجيه البشري، فهو يرى أن المرء أوقع نفسه في شرك مؤسساتي أقامه بنفسه لكن يمكنه قطع خيوط هذا الشرك في لحظات الانتفاضات، وإعادة صياغة البنية المؤسساتية بشكل يجعلها أقرب إلى رغباته، أما على المستوى الثقافي فإنه يرى أن عملية العقلنة المتزايدة تشير إلى إخضاع الكون للعقل البشري بشكل متزايد أيضاً، لكن في الوقت نفسه ليس هنالك ما يدل على أن الإنسان قادر على أن يعكس اتجاه هذه العملية حتى لو غير رأيه فيها) (1). |
|
الانتلجنتسيا- أداة تغيير.. |
|
وهنا أيضاً التفتت السلطة متأخرة لهذا السلاح عندما رأت نشوء طبقة من العلماء (التكنوقراط) ينتشرون في المجتمع مرتبطين بخط الإمامة ويجتذبون الناس من خلال المكانة الاجتماعية التي يتمتعون بها، وبذلك تم تأسيس أول طبقة (انتلجنتسيا في التأريخ الإسلامي)، وفي تأريخ العالم، فإن هذه الطبقة هي التي ستلعب دوراً تأريخياً على صعيد العالم مستندة إلى قوة العلم. فالأئمة(ع) ونتيجة لإدراكهم لحقائق سنن التأريخ وادراكهم أن التغيرات في أي بقعة من العالم سرعان ما تنتشر في أرجاء واسعة منه إثر الاحتكاك الحضاري، وبالتالي فان وجود هذه الطبقة سيكون هو السلاح القوي الذي سيؤدي إلى تفجير واقع الإنسان، ويساهم في تحقيق التكامل الإنساني منطلقا من نسف رواسب العهود السابقة، ومهيئاً الأرضية للطور الواسع والأخير من التكامل، ولهذا فإن الإمام علياً(ع) حذّر من وقوع هذا السلاح بأيد غير أمينة، وطلب أن لا يعمل بالقرآن غير المسلمين، وطبيعي أن عمل هؤلاء بالقرآن لا يعني العمل بالجانب العبادي، لأن غير المسلمين أصلاً لا يهتمون له؛ ولذلك فإن التحذير يخص الجانب العلمي والتنظيمي. ومهما يكن فإن انتشار العلوم أصبح قادراً على إيجاد أرضية مشتركة يلتقي عليها جميع أبناء البشر، ولا يستطيع أحد أن يقف منها موقفاً سلبياً بسبب مصدرها أو انتمائها الجغرافي. وعندما التفتت السلطة إلى خطورة هذه الطبقة عمدت أيضاً إلى اصطناع طبقة مرتبطة بها (مثقفي السلطة) تمتهن الترويج لمقولاتها وراحت تشجع الترجمة ونقل تراث الانسانية وإشاعة الجدل والحوارات العقيمة، لكنها مع ذلك لم تستطع إيقاف هذا التيار رغم تمكنها من التضييق عليه. (فالطبقة الحاكمة، باستغلالها الدولة ووسائل العنف، يمكنها أن تؤخر السيرورة التأريخية إلى حد ما، لكن عجلات التأريخ تدور في النهاية، ولا يستطيع أحدٌ أن يوقفها أو يغير اتجاهها) (2). وهذا الذي حصل فعلاً فقد انتقل العلم إلى أوربا، وهناك دك معاقل الكنيسة أمام أنظمة علمانية، ولتعود هذه القوة فتهشم الإمبراطوريات في العالم الإسلامي وتفسح المجال لإعادة التأسيس مؤذنة بانطلاق حركة نقد واسعة للتأريخ وللواقع، فالطبقة (العلم) التي ولدت في العالم الإسلامي وانتشرت بعد عدة قرون في جميع أصقاع الأرض، وصارت تلعب دوراً خطيراً على الصعيد الاجتماعي والسياسي؛ إذ صارت من أقوى الطبقات التي نافست طبقة القادة العسكريين ففي (المجتمعات البدائية التي لا تزال في المراحل الأولى من التنظيم تكون الجرأة العسكرية هي الطبقة التي تفتح الطريق للوصول إلى الطبقة الحاكمة أو الطبقة السياسية) (3). أما بعد النهضة العلمية التي أسسها الإسلام بفضل الائمة(ع) ولحد اللحظة الحاضرة، وبعد مخاضات طويلة وبطيئة فقد احتلت الطبقة المثقفة مكان الصدارة وصارت تلعب دوراً رئيسياً في توجيه التحولات وفي قيادة المجتمع في جميع أصقاع الأرض بما في ذلك العالم الإسلامي. فلأول مرة في التاريخ تتأسس طبقة باسم العلم وتأخذ دور القيادة في المجتمع فتفرض نفسها على السلطة والدين (المسيحية) في وقت واحد بل إنها وقفت وراء أقوى الموجات الإصلاحية الدينية التي خلصت الدين المسيحي من الكثير من الأوهام التي لحقت به. وعلى هذا فإن الثورة العلمية التي فجرها الأئمة(ع) في العالم الإسلامي، انتقلت إلى الغرب، وقضت على الأوهام التي كانت تروج باسم الدين، وهو بالضبط ما أشرنا إليه وسميناه بالتكامل الاعتقادي، وهذه الثورة قضت على القدرية، واستعباد الأكثرية من قبل الأقلية، ونشوب الثورات الكبرى كالثورة الفرنسية والانكليزية، وماحصل في عموم أوربا، وحررت الإنسان من الأغلال التي كانت سائدة قبل (عصر النهضة). لقد كان دور (الانتلجنتسيا) في الغرب دوراً تحررياً للفكر وللمجتمع؛ إذ فرضت عليه التحرك واللقاء بالعلم، الأمر الذي فرض تغيرات هامة على بنية المجتمع، ولكنها فيما بعد عادت، بفعل الاحتكاك بين الشرق والغرب، لتلعب دوراً مماثلاً في الشرق أيضاً إذ (بنظر كثير من الباحثين، أن الطبقة المثقفة كركيزة اجتماعية، بالغة الأهمية في عملية (التحديث) الرأسمالي العقلاني للمجتمع) (4). وهذا يساوق ما ذهب إليه (قسم من علماء الاجتماع في الغرب من خلال تطوير فكرة الوظائف الجامعة والثقافة الخلاقة للنخبة المثقفة - أيّاً كانت - في المجتمع المعاصر، إلى إرساء أسس الموضوعية التي تعتبر الانتلجنتسيا - طائفة مختارة - تشيع في العالم العدالة والنبوءة مؤهلة لأن تكون معلمة المجتمع أيا كان نظامه الاجتماعي والاقتصادي) (5). وعندما انتقلت إلى الشرق فإنها عملت على أداء نفس الدور وخاضت صراعاً مماثلاً مع الدين عموماً، إلا أنها في النهاية سوف لن تستطيع أن تحدث أثراً إلا في بعض المقولات الهشة التي روجت لها السلطات على أنها من الدين، أما الدين والوحي فإنها ستلتقي معه، وليتحد دورهما معاً في إكمال عملية التحرر من قوى التسلط الغربية التي تحاول أن تجعل من العلم والتفوق أداة استعباد جديدة، وفي نفس الوقت في توفير الظروف الملائمة لعبور عقبة التخلف الكؤود وهي عقبة ناشئة عن الاستجابة الناقصة للوحي. وهنا يأتي دور الخط الذي أعده الأئمة(ع) وتركوه يعمل في أوصال الأمة؛ ليحقق الاتصال التأريخي بين البعثة النبوية الشريفة والبعثة الثانية التي تأتي مع ظهور الإمام المنتظر(عج) الذي سينقل دور الانتلجنتسيا في دورها المعاصر، من الانتماء الغربي ويعيد تأسيس انتمائها من جديد إلى منبعها الشرقي فتعود للالتحام بالوحي، وصولاً إلى أهم حلقات الالتحام بين قطبي الحضارة المعاصرة (الشرق والغرب) فإذا توفرت هذه الحلقات صارت الظروف معدة لتقبل الحلقة القادمة وهي الحلقة الأكثر تطوراً (علمية - أخلاقية) وهذا الالتحام لا يمكن أن يحدث إلا عند من يملك الخطين، بينما لا يملك الغرب إلا العلم، ولا يملك الإرث الأخلاقي إلا الشرق، ولا يملك الاثنين إلاّ خط الأئمة(ع) لأنه خط الوحي الخالص وهو يأتي من وراثة الوحي، وهي وراثة فعلية، وليست مجرد وراثة ثقافية؛ فالإمام الحجة المنتظر(عج) ، عندما يظهر، ومعه مصحف فاطمة(ع) وعمامة رسول الله(ص)، وذو الفقار، ومعه أيضاً تابوت السكينة ومواريث الانبياء، جميعاً وهذا كله يدل على نقاء المشرب وصفاء المنبع. |
|
الآثار العملية للاستجابة الناقصة.. |
|
فهذه البذرة التي بذرها الإمام الصادق(ع) كان لها آثار بعيدة ظهرت فيما بعد، وهذا يعكس مستوى التفوق الذي يخطط لأجيال بعيدة، ولا يقيم حساباته على أساس الخطة الحاضرة، وهو الخطأ الذي مارسته السلطات آنذاك؛ فالأمويون وبسبب قصر النظر ونزعة التجبر عمدوا إلى تفضيل العرب، كانعكاس لتفضيل أنفسهم على الآخرين، وبذلك أثاروا نقمة (الموالي) كما أن احتكارهم للسلطة أدى إلى إثارة نقمة (أبناء الصحابة) وتحولهم إلى المعارضة، أما استشهاد أهل البيت(ع) فقد أدى إلى نقمة الأمة عموماً. أما بنو العباس الذين اعتمدوا على الموالي، فإنهم أضحوا أسرى لهم بعد حين؛ فصاروا يخوضون صراعات ضد بعضهم البعض من جهة، وضد خط الأئمة(ع) وضد الموالي من جهة أخرى في حرب أنهكتهم في النهاية ومهدت لزوالهم. وهذا يعكس خطأ رأي من يقول بوجود مؤامرة ضدهم لأنهم هم أنفسهم قد تآمروا ضد أنفسهم؛ بابتعادهم عن جادة النجاة، ألا وهي اتباع الوحي وأخذه من منابعه، بدلاً من محاربة خط الأئمة، والتضييق عليهم بالقتل والتشريد والتكفير والخروج على الإسلام!!، ومع ذلك فإن هذه التهم لم تحدّ من تنامي المعارضة، وخصوصاً بالنسبة للتيار الذي يقوده الأئمة(ع)، فهذه التيارات جميعاً كانت تساهم في منع السلطة من التجبر، ولأنها تيارات متعددة فإن الحكام لم يستطيعوا أن يركزوا جهودهم على تيار الأئمة؛ مما أتاح لهم متنفساً لإدامة عمليات التثقيف، وجمع الأنصار، ومواصلة مد التيار بعناصر البقاء، والامتداد التاريخي، حتى أن ضغط تيار الإمامة كان يتصاعد أحيانا إلى الدرجة التي تدفع بأركان النظام إلى التظاهر بعزمهم على التخلي عن السلطة وإعادتها لأهل البيت(ع) إرضاءً للمطالب الجماهيرية وهو ما وقع في زمن الإمام الرضا(ع). وقد مارس الأئمة(ع) في صراعهم نوعين من التربية؛الأول هو التربية العامة التي تشمل توعية الناس عموماً بالإسلام ودون التطرق إلى جوانب الاختلاف، وتمثل الثاني بالتربية الخاصة لبعض كوادر خط الأئمة(ع) والاستفادة منهم كأذرع حركة في أوساط الأمة؛ ولهذا فإن نتاج حركة الإمامة كان عبارة عن ما يلي: 1- تحقيق التكامل التام (الاعتقادي والسلوكي) الذي يتأسس على مبدأ القبول بخط الولاية، ثم يصار إلى تربية الفرد وإعداده بمقدار استعداده، ليتقدم على طريق التحول إلى كادر علمي، ومن ذوي الانضباط الأخلاقي العالي، وبالطبع لا يفصل الأئمة(ع) بين الجانبين؛ إذ (الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل). 2- وهناك الحالة الناقصة حيث يقبل البعض بخط ولاية الأئمة(ع) لكنهم يعجزون عن مجاراتهم في الانضباط الأخلاقي وهؤلاء طبعاً على درجات، بعضها مقبولة وبعضها الآخر ذمها الأئمة(ع)، وذموا أصحابها الذين يدعون الاتباع في القول إما في السلوك فإنه غير منضبط حتى بالأخلاقيات الإسلامية العامة، وهؤلاء كانوا وبالاً على خط الإمامة. ولعل عهد الإمام علي(ع) قد شهد هذا النمط من الأتباع؛ فكان الخوارج من (الموالين) الذين جرّوا البلاء على خط الإمامة، أما بالنسبة للإمام الحسن(ع) فقد هاجمه بعض هؤلاء وطعنوه في فخذه. 3- وخارج هذا الخط نلاحظ وجود التزام سلوكي لكنه لن يبلغ حالة التكامل ما لم يتأسس على القبول بخط الإمامة(ع) ونرى أيضاً حالة أخرى هي عبارة عن عدم الالتزام لا بإمامة ولا بغيرها، وهؤلاء هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. وعلى هذا الأساس يمكن فرز ما يلي: 1- حالة من التكامل في إطار الاعتقاد، وتترجم إلى القبول بخط الإمامة باعتبارها الأساس في هذا التكامل ومنها نصل إلى التكامل السلوكي، وتترجم بالانضباط الاخلاقي العالي باعتباره الأساس والمقدمة للوصول إلى الأشكال العالية من هذا التكامل وهذا الإطار هو إطار (خاص الخاص- وعام الخاص). 2- وهناك تكامل في إطار السلوك، لامتلاك بعض الأفراد الاستعداد التام لالتزام أخلاقي عالٍ، لكنه لن يتكامل ما لم يصل الإنسان إلى عبور عتبة التكامل بقبول الوحي والخضوع لولاته وهذا إطار (خاص العام). 3- دائرة الانفلات وهو إيمان اللسان دون القلب، وهو إيمان كعدمه؛ لأن الإسلام رفضه وهنا إطار(العام). 4- دائرة الإنفلات من إيمان اللسان والقلب معاً، وهي تشمل عموم الناس من غير المسلمين. وهكذا فإن دائرة الصراع كانت تجري بين التيار الأول المؤلف من (حالة التكامل التام والناقص) والتيار الثاني المؤلف من (حالة التكامل السلوكي وحالة الانفلات) وإلى جانب هذا الصراع هناك صراعات داخل كل تيار على حدة. غير أن الصراع داخل خط الإمام(ع) كان صراعاً فكرياً بدرجة رئيسية بينما كان الصراع داخل التيار الثاني صراعاً عنيفاً وله جانبان: 1- صراع المصالح المجردة من أي غطاء. 2- صراع النخب والمثقفين الداعين إلى الإصلاح والالتزام بثوابت التيار الآخر. |
|
نشوء الأرضية المشتركة (داخلياً).. |
|
وهذا التيار الذي بدأ ينشطر بهذه الطريقة كان مؤشراً على حالة من الانفصال بين السلطة التي صارت تتجه إلى دائرة عدم الالتزام (الانفلات)، ودائرة النخب التي صارت تشترك مع خط الأئمة(ع) في معارضة السلطة؛ مما يؤذن بنشوء معالم اشتراك، وهذا بحد ذاته انتصار كبير، لأن السلطة إنما احتلت هذا المكان باعتبارها تمثل الإسلام، فحين تفقد هذا التمثيل فإنها تفقد مبررات بقائها وتستعد في أي ظرف للانهيار. ومن الواضح أن انهيار السلطة سيوسع فرص التقدم أمام تيار الإمامة، لكننا نعلم بأن السلطة لم تكن هدفاً لهذا التيار في هذه المرحلة، وأن هدفه هو إنضاج ظروف استيعاب التكامل التام؛ ذلك لأنه بدون هذه الظروف فإن العودة للآمال بالسلطة لا معنى لها لأنها في أحسن ظروفها لن تصل إلى حالة الإمام الحسن(ع). انهيار السلطة سيخلق فرص تقدم الوعي، وهو ما حصل بعد انهيار السلطة العباسية؛ إذ تحولت إيران بعد هذا الانهيار إلى تيار الأئمة(ع) كما أن انهيار الدولة العثمانية أدى إلى تصاعد دور كربلاء والنجف كحواضر علمية وثقافية، وأن الدراسات المتواصلة للتأريخ والواقع صارت تقترب بدقة من تشخيص نقاط الخلل في المسيرة التأريخية؛ وهذا يعني أنه حتى لو لم يتم بصورة مباشرة فانها عبارة عن اكتشاف لصحة الموقف الذي وقفه الأئمة(ع) الذين عارضوا السلطات خلال كل تلك الفترات، وهي أيضاً صارت تشير إلى بعض المعالم الصائبة على طريق التصحيح. |
|
نشوء الأرضية المشتركة (خارجياً). |
|
وإذا أضفنا إلى ما سبق وجود إطار عالمي بات ينضج سريعاً باتجاه اكتشاف المسارات الصحيحة، فإننا نتبين أن العالم بات يقف على مشارف النقلة القادمة التي وعد بها. فالغرب حين نهض نهضته الحديثة انطلق لإنشاء حضارة مؤسسة على (العنصرية).. (العقلنة)، وبعد قفزات استطاع السيطرة على العالم وسخر موارده البشرية والاقتصادية، واستطاع من خلال هذه السيطرة أن يتقدم تقنياً؛ وبعد أن تواصلت الحركة العلمية توضح أمام الجميع زيف أحلام النهضة ونهاية الإنسان المغامر الذي أنجز الكشوفات الجغرافية، وأسس للاستعمار الاستيطاني، ووجد الإنسان الغربي أنه حوّل العالم إلى عالم واحد مزدحم، ومهدد بالأخطار، لا مكان فيه لاستمرار الاستعمار، فاضطر إلى استبدال سيطرته المباشرة إلى سيطرة اقتصادية وثقافية. وما كان لهذا التحول أن يحدث لولا الثورة العلمية التي مكنت الإنسان في الغرب من معرفة نفسه، ومعرفة الآخرين، وتكوين رؤية موضوعية للكون، وبذلك لفظت العنصرية أنفاسها، وماتت أسطورة الجنس الراقي، وكل الأفكار المشتقة منها، والتي تدور في فلكها؛ وهذا بحد ذاته يشكل مقدمة أخرى للقاء بني البشر! |
|
المشتركات الموروثة.. |
|
إلى جانب هذا التقدم الذي حدث في أرض الواقع وفي الظروف الموضوعية على صعيد عالمي، هناك آلية الموروثات الاعتقادية التي يمكن متابعتها أيضاً في دائرتين: الأولى – الدائرة الاسلامية الداخلية: يجمع المسلمون كلهم على النبوة، ولا يختلف إثنان حول صدقية الرسول الأكرم(ص) كمرسل من قبل السماء، وأنه آخر الانبياء، كما تجمع الأمة على الاعتقاد بظهور المصلح آخر الزمان، وهو الامام المهدي المنتظر(عج) مع اختلاف حول كونه الامام الثاني عشر الحجة بن الحسن(عج) الذي ولد وغاب، أو هو محمد بن عبد الله الذي يولد آخر الزمان، فقد روى أبو نعيم في حديث أبي هريرة أن رسول الله(ص) قال: (لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي يملأها قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً ) (6). لكن هذا الخلاف رغم أهميته في هذه الفترة، سينتهي يوم الظهور؛ لأن الأمة ستجتمع عليه لما يقدمه من أدلة ومعجزات يعرفها الخاص والعام، فالأمة اختلفت حول كل الأئمة(ع) لكنها متفقة حول ولاية الامام المهدي(عج) فهذا الأمر إذا أضيف إلى عوامل الاشتراك الموضوعية، فإنه لا شك سيهيىء عامل التحام داخلي قوي سيفعل فعله في اللحظة المناسبة. الثانية – الدائرة الخارجية: بالإضافة إلى ما مر هناك جوانب اشتراك اعتقادية بين أتباع أغلب الديانات، وخصوصاً بين أكبر كتلتين دينيتين هما كتلتا المسلمون والمسيحيون؛ إذ (يشكل المسيحيون والمسلمون في العالم أكبر كتلتين بشريتين تعتنقان أوسع ديانتين سماويتين) (7). وقد وردت صفات المخلّص بصورة متقاربة جداً في الديانتين، كما أجمعت الديانتان على ظهور المسيح(ع) في آخر الزمان، مع اختلاف متمثل في أن المسلمين يعتقدون بظهور المسيح(ع) بمعية الإمام المهدي(عج)، والمسيحيون لا يشيرون الى الامام المهدي(عج) في معتقداتهم. الا أن ظروف الظهور تكون مشتركة؛ فالمسلمون يعتقدون بأن الأمر هو كما قال الرسول(ص):(والذي بعثني بالحق نبياً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه، وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب) (8). وقد وردت مثل هذه الأوصاف في الاناجيل حيث جاء (يكون ذلك إذا كثر الجور والفساد وظهر المنكر) (9). أو (يخلّصون كما يخلّص الذهب) (10). وعند المسلمين جاء (وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئاً)(11). كما يجمع المسلمون والمسيحيون على أن عصر الظهور هو عصر رخاء، وسيادة العدالة وإنصاف الضعفاء؛ ولهذا فإنهم ينتظرون ظهور المسيح(ع) بنفس الظاهرة والحماس التي ينتظر بهما المسلمون، وأما اليهود فإنهم يشتركون في هذا الاعتقاد، وكذلك عدد آخر من الديانات، فهذا المخزون الاعتقادي سيشكل أرضية التحول الكبير الذي ستكون نواته أهم بقعتين في الأرض، وأهم ديانتين عالميتين، وهما الاسلام والمسيحية؛ ليتم بعد ذلك تأسيس عصر النور، وعصر سيادة الوحي، في عودة الإمامة إلى قيادة التحولات في إطار قبول داخلي وخارجي. ومن الملفت للنظر أن الرسول(ص) وخليفته الإمام المهدي(عج) يشتركان في الاسم والكنية؛ الأمر الذي يُشعر بنوع من الامتداد في كل شيء؛ ذلك أن الإمام الحجة(عج) لا يأتي إلا بإحياء السنّة وإماتة البدعة؛ ليبدأ الزمن طوراً جديداً ولا يقف التطلع المستقبلي الإسلامي عند هذه النقطة، بل إنه يتابع حركة التيار وصولاً إلى فترة الظهور أو ما بعد الظهور. أما لحظات تأسيس التكامل العالمي فهي كما يلي: 1- تساهم العناية الإلهية في دعم التحول دعماً مباشراً عن طريق: أ) إشراك الملائكة في توطيد خلافة الإمام الحجة وفي عملية الصراع، أي حفظ الإمام، ومنع اغتياله وضمان أنتصاره في المعارك. ب) دعم الإمام (عج) بقوة قيادية هي حصيلة الامتحانات الطويلة، حيث يتم استخلاص (313) نقيباً مع قوى جماهيرية تنتمي إلى تيار الإمامة، ذلك التيار الأكثر قرباً من الإمام والذي بلغ الوضوح الاعتقادي لديه أعلى الدرجات وكذلك تطور نضجه السلوكي، ثم تأييد إسلامي عام، وأخيراً تأييد عالمي؛ ولهذا فإن الإمام (عج) يبني خططه الكونية على الأسس التالية: أ) تأسيس السلم العالمي. ب) إزالة الفقر عالمياً. ج) تحقيق الانفجار العلمي (بالمعنى الحيادي للعلم). فهذه العوامل جميعاً هي من أهم عوامل التقدم، وتحقيق حلم الانسانية العظيم، وهكذا يكون الاسلام قد رسم لنا صورة واضحة المعالم عن المستقبل، بخلاف غيره من الرؤى التي تتسم إما بالتشاؤم أو التي تصنع من خيالها نهاية مأساوية للتأريخ، أو توقفه عند الأوضاع الحالية المفعمة بالبؤس والمشاكل، وهناك من يقول بامتداد التأريخ بلا نهاية... وينفرد الاسلام بين جميع هذه التيارات بأنه أقام البداية والنهاية على أسس موضوعية نلمسها من خلال الإنجازات المتحققة بالفعل، منذ زمن البعثة الشريفة وحتى اللحظة الراهنة، ومن خلال المشترك الاعتقادي عند المسلمين وسواهم. |
|
الهـــوامـــش: |
|
(1) التغيير الاجتماعي: أميتا انزيوني وإيفا انزيوني، ترجمة: محمد أحمد حسونة، مراجعة: عبد الله ناصيف ح1 ص14. (2) المصدر نفسه: ص14. (3) المصدر نفسه: ص366. (4) المثقفون والتقدم الاجتماعي: عدد من المؤلفين، ترجمة شوكت يوسف، منشورات وزارة الثقافة والاعلام في دمشق (1984) ص14. (5) نفس المصدر: ص14. (6) الإمام المهدي عند أهل السنة: مهدي إيماني، ح2 مكتبة الامام أمير المؤمنين العامة اصبهان ص9. (7) المخلّص بين المسيحية والإسلام: دار المحجة البيضاء - دار الرسول الأكرم (ص)/ ط1/ 1996 ص79. (8) المصدر نفسه: ص155 نقلاً عن بحار الأنوار. (9) المصدر نفسه: ص151. (10) المصدر نفسه: ص151. (11) المصدر نفسه: ص151. (*) انتليجنتسيا: طبقة المثقفين المصلحين في روسيا القيصرية خلال القرن التاسع عشر. أو هي (مجموعة المثقفين في كل بلد خلال مرحلة معينة) المعجم الأدبي / جورج جبور/ ص37. |
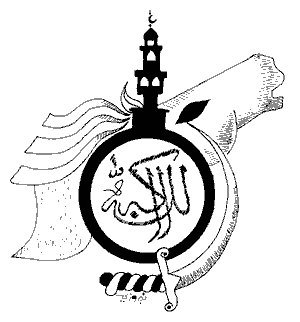 ولذلك فإن جهد الإمام أعاد حالة التطابق بين
عهده وعهد رسول الله(ص) وهذا ينطوي على(أهمية كبيرة) لأن العهود الثلاثة
أوجدت بعض الفروق عن عهد رسول الله (ص) وكان أخطرها ترك الولاية، بالإضافة
إلى فروق أخرى كانت أقل خطراً ولذلك لم يلتفت إليها أحد من عامة الناس، ولذا
انحصر الصراع الرئيسي في دائرة (من هو الخليفة؟).
ولذلك فإن جهد الإمام أعاد حالة التطابق بين
عهده وعهد رسول الله(ص) وهذا ينطوي على(أهمية كبيرة) لأن العهود الثلاثة
أوجدت بعض الفروق عن عهد رسول الله (ص) وكان أخطرها ترك الولاية، بالإضافة
إلى فروق أخرى كانت أقل خطراً ولذلك لم يلتفت إليها أحد من عامة الناس، ولذا
انحصر الصراع الرئيسي في دائرة (من هو الخليفة؟).