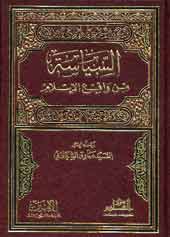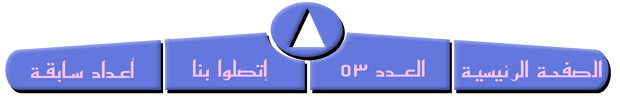|
السياسة الإسلامية أو الإسلاموية |
|||
|
|
|
||
|
على ضوء الفكر السياسي لآية الله الفقيه السيد صادق الشيرازي |
|||
|
ياسر الحبيب |
|||
|
لا تزال الأيديولوجيات والثقافات واقعة في حيرة من أمرها تجاه وضع تعريف محدد واضح للسياسة بشقيها النظري والعملي، ذلك لأنها – أي السياسة – محل بحث وتنظير دائمين يتصلان بالواقع وظروفه المتغيرة من جيل إلى جيل، وهو الأمر الذي يغير كثيرا من المفاهيم والرؤى التي لا تقع – طبيعيا - على هامش الثابت، بل على هامش المتغير. و(السياسة) من وجهة أخرى هي نقطة تقييم أساسية لمختلف المناهج الفكرية التي يتوقف أمر المفاضلة فيما بينها على أيّها أقدر على ملامسة الواقع السياسي وتصويبه ودفعه باتجاه إنماء الاجتماع الإنساني. وبعبارة أخرى يمكن اعتبار أن السياسة باتت معضلة حقيقية أمام المفكرين الذين عليهم أن يقدموا حيالها تصورا يقترب من المثالية، وتعاطيا مبنيا على القيم والمعايير الفاضلة. ويمكن القول أيضا أن تقييم أي اتجاه فكري يمكن أن يتم عبر نافذة عمله السياسي، فكلما كان هذا العمل نزيها ومنضبطا وهادفا إلى التنمية والرفاه، كلما فرض هذا الاتجاه احترامه على المراقبين والمقيّمين والمهتمين، وساعد بضرورة الاقتضاء على تمدده واتساع نطاقه جماهيريا. وللتقريب؛ نشير إلى أن كثيرا من الأيديولوجيات نجحت في ترسيخ هويتها – ولو لبرهة – لأنها اتقنت العمل في الميدان السياسي وقدمت صورة مشرقة لنفسها في هذا المضمار، بينما سقطت أيديولوجيات أخرى لأنها أعطت صورة سوداوية لنفسها عندما بدأت في الخوض السياسي، ولعل تجربة (الشيوعية) أوضح مثال على هذه الحقيقة، فرغم أنها سرت في العالم سريان النار في الهشيم وتوسعت دائرتها لتشمل أنظمة وجماعات ومجتمعات بظن أنها تمثل الصورة المثلى للمساواة، إلا أنها ما إن خرجت من محيط التنظير الفلسفي إلى دائرة التطبيق العملي عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا، حتى تبين عقم فرضياتها ونظرياتها الماركسية اللينينية، وهو ما تسبب في تلك الإخفاقات المتكررة التي أفضت إلى سقوط الاتحاد السوفياتي وتلاشي المد الشيوعي في العالم. وبعبارة مختصرة؛ إن فشل أي اتجاه فكري في تجربته السياسية يؤدي لا محالة إلى موته وانتهائه، هذا في حال كون التطبيق غير مجانب لما في النظرية، وإلا فإن الخلل قد يكون في التطبيق وحده. ويقوم الباحثون – عادة – قبل الولوج في تقييم التجارب السياسية للتيارات المنهجية، بمقايسة التعريف الاصطلاحي الذي تقدمه تلك التيارات للسياسة والعمل السياسي، من خلال أدبياتها وتعابيرها. ذلك لأن التعريف يرسم ملامح رؤية فكرية سياسية معينة تمهد الطريق نحو مقارنة موضوعية في ما بين تلك التيارات والمناهج. لذا فإن وضع تعريف محدد للسياسة يعد أمرا ليس هينا بالنسبة إلى المفكرين وأرباب الأيديولوجيات، وهو ما عبرنا عنه بالحيرة التي تنتابهم أثناء تعرضهم للمفهوم السياسي العام. |
|||
|
مناهج متعاكسة |
|||
|
ثمة مناهج قدمت مفاهيم متباينة تكشف النقاب عن طبيعة رؤيتها للعمل السياسي وأهدافه وغاياته، فبعض منها قال بأنه – أي العمل السياسي – مجرد (عمل يهدف إلى السيطرة على الحكم)، فيما اعتبر آخر أنه (نتاج نزعة التسلط) ! وتتباين التعاريف وتختلف، لكنها في تطورها من البدائية الفكرية إلى ثقافة العولمة تتدرج. ومن تلك التعاريف أن العمل السياسي (علاقة في ما بين موازين القوى)، (وسيلة استقطاب لتشكيل القيادة)، (جهد جماعي منظم لتحقيق غاية وحدوية تتمثل بالحكم غالبا)، وهكذا تصل التعاريف أخيرا إلى مصطلح من كلمتين فقط، وبات هذا المصطلح معتمدا لدى معظم الموسوعات السياسية والمناهج الدراسية الأكاديمية في الجامعات، وهو أن العمل السياسي ليس سوى (فن الممكن)! ببساطة جاء تعبير (فن الممكن) ليقدم صورة واضحة للذهنية التي ترى في العمل السياسي مجرد وسيلة لتحقيق أية غاية مهما كانت، فليس مهماً أن يكون العمل السياسي هادفا إلى صالح عام، وليس مهما أن يتسم بالنزاهة. فـ (فن الممكن) يعني أن تجعل ما تريده ممكنا.. مهما كلّف الأمر وتطلّب! وذلك ارتكازا على الأرضية الميكافيلية (الغاية تبرر الوسيلة). وهذا المفهوم هو وليد الحضارة الغربية، ولعله يضع نقاطا على الحروف مفادها أن كل هذا البريق السياسي الغربي ليس نابعا من معايير وقيم سامية رغم ما يحمله من شعارات الحرية والعدالة والديموقراطية والمساواة وما إلى ذلك، فالتجاذب في ما بين أقطاب القوى التي يهدف كلٌ منها إلى جعل ما يريده ممكنا هو جوهر التفاعل السياسي الذي قد يؤدي أحياناً إلى تحقيق نتائج إيجابية وقتية من المؤكد أنها لن تستمر ما دامت لعبة المصالح هي الحاكمة. والثقافة الإسلامية باعتبار أنها نابعة من شريعة تجعل الإنسان – لا المادة – هو المحور والهدف، فإنها بلا شك ترفض هذا المعنى للعمل السياسي الذي اختزلته الثقافة الغربية في تعريف (فن الممكن). فثمة ضوابط كثيرة اشتُرِطت لأجل ضمان هدفية ونزاهة الممارسة السياسية، وهي ضوابط تحول دون تولّد نزعات الاستئثار والتسلط والفردية والمصلحية، التي يتعرض لها الناشط السياسي أكثر من غيره خاصة إذا ما حقق لنفسه مواقع متقدمة في صنع القرار. ولئن كان هذا هو الإطار الكلي الذي ترسمه الثقافة الإسلامية للعمل السياسي، فإن التباين لا يزال ماثلا في مسألة تحديد مفهوم ذلك العمل، من اتجاه إسلامي لآخر، إذ إن اختلاف الاجتهادات والمدارس الفكرية الإسلامية أثر بطبيعة الحال على هذا المبحث الدقيق الذي ظل – إلى جوار هذا الاختلاف – متواريا لحقب طوال عن بساط البحث، وهو ما ساعد على نشوء هذا الاختلاف واتساع نطاقه. ولعل هذا التأخر في تناول هذا المطلب من قبل العلماء والمفكرين الإسلاميين مردّه إلى عاملين أساسيين، أولهما مرتبط بالثقافة الشيعية، والآخر متعلق بالثقافة السنية. |
|||
|
تأخر البحث السياسي |
|||
وأما تأخر البحث السياسي لدى السنة فنتيجة لطبيعة الثقافة السنية التي اتسمت بالاستكانة لولاة الأمر من الخلفاء والسلاطين وتحريم الخروج عليهم مهما كان من أمر، وذلك تأسيسا على قواعد فقهية اكتظت بها كتب علماء هذا الفريق الذي كان طوال عهده مسالما مع السلطات. وإذا عُلِم أن العمل السياسي يقضي – مبدئيا – بالسعي لتغيير الواقع، فإن فكرة الانتظار السلبي لدى الشيعة، وفكرة الخضوع للسلطة لدى السنة، يعنيان انتفاء مثل هذا السعي بقبول الواقع، مما جعل السياسة غير مطروحة – بجدية – لا علميا ولا فقهيا. وإن كان هناك من طرح فإنه لم يتعدّ السهل الممتنع، إلا نادرا. هذه المباعدة بين الفقهاء والسياسة تركت ثغرة استطاعت الأيديولوجيات الشرقية والغربية النفاذ منها إلى المجتمع الإسلامي، حتى تمكنت من تغيير كثير من القيم والمعايير والتقاليد والأعراف التي كانت في ما مضى تشكل الهوية الإسلامية. وكرد فعل عكسي نمت في المقابل أفكار تطرفت، وأخرى تعصبّت، فنشأت جماعات (إسلامية) اعتبرت العنف – مثلا – وسيلة مشروعة لتحقيق الغاية، وهو الأمر الذي ألصق ظلما تهمة (الإرهاب) بالإسلام في عين المراقب، وعلى هذا فقس. حيث أدى الاختلال في فهم الإسلام لدى بعض الجماعات إلى رسم صورة مشوهة عنه للغاية، وعندما سنحت الفرصة لتلك الجماعات لإقامة أنظمة حكم تطبق فرضياتها السياسية، تزايدت في المقابل عملية التشويه، ففقد كثير من الناس الثقة في المشروع الإسلامي الذي لم يروه محققا لآمالهم وتطلعاتهم، وقد أدى ذلك لاحقا إلى تكوين موجة من الرفض للدين من دون تفريق بينه وبين من يحكمون باسمه. ومثّلت هذه الوضعية غير السوية؛ تحدِّيّين للعلماء والفقهاء المفكرين، فهم من جهة ملزمون بمواجهة أفكار الاستغراب والاستشراق التي زرعتها المخططات الاستعمارية، كما انهم من جهة أخرى واقعون في مأزق التعامل مع الجماعات والأنظمة المتلبّسة بالرداء الديني. فوجد أولئك العلماء – وهم قلة – أنفسهم في مواجهة فكرية – سياسية مع جبهتين لا تقل إحداهما خطورة عن الأخرى، فيما كان همّهم الأول استعادة ثقة الجماهير في الطرح الإسلامي وضمان عودتهم إلى حضارتهم المشرقة. |
|||
|
السياسة من واقع الإسلام |
|||
|
كتاب سماحة آية الله الفقيه السيد صادق الحسيني الشيرازي يزيل كثيرا من ترسبات الغبار التي تجمعت، وهو أيضا نافذة جيدة للإطلالة الأولى على عالم السياسة في الإسلام. وأهمية هذا الكتاب (السياسة من واقع الإسلام) تنبع من كونه نتاجا غنيا لفقيه أصولي كبير اشتهر في الحوزات العلمية بسعة الأفق والعمق العلمي والمعرفي، فهو أحد أبرز أعمدة المدرسة الحوزوية الكربلائية الوارثة لتاريخ جهادي جعلها رافدا محوريا من روافد الفكر النهضوي الرافض للانغلاق داخل دائرة فقهية ضيقة، وهو – إلى جانب ذلك – يعد الساعد الأيمن للمرجعية العليا المتمثلة في أخيه الأكبر الإمام الشيرازي الذي فجّر – بفكره الموسوعي – نهضة ثقافية إسلامية عالمية لا تزال آثارها ماثلة في شتى البقاع. |
|||
|
السياسة الإسلامية والإسلام السياسي |
|||
|
يضع السيد الصادق في كتابه خطوطا عريضة للسياسة الإسلامية، لا الإسلام السياسي. وشتان ما بين المعنيين أو المصطلحين، إذ الأول يدل على توظيف السياسة في خدمة الدين، في حين يعكس الآخر المعادلة بتكييف الدين على حسب المرامي السياسية. ولنا أن نضع هذين التعبيرين، السياسة الإسلامية والإسلام السياسي، على طرفي نقيض، بين المثالية والواقعية. وانطلاقا من ذلك يتحدث سماحة السيد عمّا أسماه (الفرق الشاسع) بين السياسة الإسلامية والسياسات المعاصرة والمتبعة في يومنا الحاضر. سواء كانت تلك السياسات شرقية أم غربية.. أم إسلاموية. وهنا نستعير نحن هذا التعبير الأخير من تجربة التاريخ للتفريق بين السياستين والمنهجين، إذ لا يصح أن نصف تلك السياسات المتلبسة بالدين بأنها (إسلامية). وقد لجأنا إلى تكوين لفظة (إسلاموية) من منظور أن أول اتجاه منظم للإسلام السياسي برز في تاريخ هذه الأمة، كان اتجاه بني أمية. وعند الجمع بين كلمتي إسلام – أموي، يمكن اختزال التعبير إلى (إسلاموي). في البدء يقارن السيد الصادق في أطروحته، بين (السياسة المادية البحتة التي يمارسها ساسة دنيا اليوم في الغرب والشرق الأوسط) وبين (سياسة الإسلام المبتنية على إدارة الناس في شؤونهم المادية كافة بالإضافة إلى الالتزام الكامل، بالعدل والإحسان، والإنسانية والعواطف الخيرة، والفضيلة والأخلاق الكريمة، واستقامة الفكر والعقيدة). وهو يؤكد أن (هذا المزيج من المادة والروح في كل الأبعاد لكل منهما، هو رابع المستحيلات في منطق المادية. لكن الإسلام هو الذي جعل من هذا المستحيل ممكنا. لا ممكنا فحسب.. بل مطبقا من قبل رسول الله(ص)، وكذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام) (1). ولذا نرى السيد يضع كمدخل بحثي، أنموذجين للسياسة الرشيدة للرسول الأعظم وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام، آتيا على تحليل المواقف والأقوال، هادفا إلى بلورة نتائج علمية لعلها تبدو – في منطق اليوم – ضربا من الغرابة وباعثا على الدهشة في عالم السياسة المادية المظلم. فمن يا ترى يمكن له أن يتصور – كمثال - أن أعظم زعيم كان يحكم في زمانه أعظم إمبراطورية، تُوُفّي وهو مدين؟! نعم.. هكذا كان رسول الله(ص)، وكذلك كان أمير المؤمنين(ع)، فكلاهما استشهدا وهما مدينان للناس، كما أثبته السيد في كتابه استنادا إلى الموثّق من الأخبار، هذا على الرغم من أن بيت مال المسلمين كان تحت تصرفهما، وكذلك ثروات ومقدّرات الأمة من أقصاها إلى أقصاها. إلا أنهما صلوات الله عليهما كانا يقترضان من هذا وذاك لا لأجل منافع شخصية، بل لأجل صالح الأمة ومستضعفيها. ويخبرنا التاريخ في قصص كثيرة كيف أن الرسول والأئمة(ع) كانوا لا يعيرون اهتماما لماء الوجه عندما يستدينون لأجل الفقراء والضعفاء والمساكين. وكان كل إمام يقضي دين الذي سبقه. وعندما نحلل هذه المواقف نراها لم تتكرر ولن تتكرر، فمن مِن كل هؤلاء الرؤساء والأباطرة والزعماء، مات وهو مدين؟ بل ألا يبدو شاذا أن نرى أحدا منهم يموت دون أن يخلّف لأنجاله تركة ضخمة من المال والأملاك؟! ومن له أن يتصوّر قائدا عظيما يتمكن من السيطرة بعد سنين طوال على عاصمة مناوئيه ومحاربيه، فيقعون في قبضته، ثم بدلا من أن يفتك بهم، نراه يصدر قرارا بالعفو العام عنهم رغم ما فعلوه من قتل وظلم وحروب واعتداءات؟! فكانت (إذهبوا فأنتم الطلقاء) عنوانا ساميا لسياسة رحيمة عظيمة، وكذلك كان موقف الأمير(ع) عندما وقعت صاحبة الجمل بين يديه فلم يعاقبها بل ردّها إلى حيث يُفترض أن يكون خدرها معززة مكرمة. وتلك سياسة العفو العام التي لا نظير لها في عالمنا، هذا العالم الذي يتعطش فيه الزعماء السياسيون إلى الفتك بخصومهم. ألسنا نسمع عن مذابح يرتكبها (القادة) بحق معارضين بعد (مسوغات إعلامية) من قبيل الاتهام بالعمالة والتآمر والعصيان؟! بل لقد بلغت روح الاستئثار والانتقام درجة أن يقتل الابن أباه والأخ أخاه ليجلس أحدهما مكان الآخر على كرسي الرئاسة! ومن منّا يتصّور – في منطق سياسة اليوم وساسته – أن يقيم أكبر زعيم لأكبر دولة في بيت متواضع رثّ بالٍ صغير، بلا حاجب ولا حراس، بل نحن نتكلم عمّن كانا يقطنان في أوهن البيوت، كالرسول والأمير(ع)، مع ما لهما من الشأن عند الله وعند الناس. وليس ذلك إلا تواضعا وزهدا في هذه الدنيا الفانية. ثم فلننظر إلى زعماء هذه الأيام وقد شيدوا القصور واكتنزوا الأموال، ولا تكاد ترى أحدهم يتنقل شبرا إلا أحاطت به جوقة من الحرّاس الشخصيين. أما أن تصل إليه لتكلمه أو تعرض عليه شكواك.. فإنك قد تتمكن من الوصول إلى المجرات والكواكب والنجوم، قبل أن تصل إليه! |
|||
|
الإمام علي(ع) والمعارضة |
|||
|
وهذا أبو الحسن عليه الصلاة والسلام، يسمح لمعارضيه ومناوئيه من الخوارج أن ينصبوا أمام باب منزله منبرا يعتلونه كل يوم للطعن فيه وسبّه، ولا يمنعهم - رغم محاربتهم إياه في النهروان– فيء الله من بيت المال، ولا يحرّم عليهم ارتياد المساجد، مع ما هم فيه من الكفر والمروق والقسوة والغلظة. فيضرب علي(ع) بذلك مثالا للحرية ومبادئها التي تجسدت فيه. وهل لنا أن نجد رئيسا من رؤساء عصرنا لا يكمم أفواه الرأي الآخر، ولا يصادر الحريات، ولا يسلب الحقوق؟! ومثل هذه الأمثلة والنماذج كثير، مما أسهب آية الله السيد الصادق في تحليلها حتى وصل إلى ملامح عامة للسياسة الإسلامية من واقع تلك السير العطرة. يقول السيد: (كان رسول الله سيد الأنبياء محمد(ص)، سيدا لساسة العالم، وأكبر سياسي محنك، فهو تلميذ الله تعالى، وأستاذ جبرائيل، وسيد الأنبياء ومعلم البشرية كلها. وسياسته هي التي حيرت العقول، وأشخصت أبصار العالمين. وبهذه السياسة الحكيمة استطاع رسول الله(ص) أن يجمع حول الإسلام أكبر عدد ممكن من البشر، في مدة قصيرة أدهشت التاريخ، وأنست الأولين والآخرين، وأركعت حكماء العالم لها إجلالا وتقديرا، مما لا يجد التاريخ الطويل للعالم لها مثيلا ولا نظيرا) (2) وكان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو المثل الآخر الصحيح الذي عكس سياسة الإسلام بكل دقة وروعة واستيعاب، بعد رسول الله(ص). لذلك كانت سياسة أمير المؤمنين(ع) العملية خير درس للقادة والمسلمين في تطبيق حياتهم العملية السياسية عليها. |
|||
|
أساس الحكم الإسلامي المعاصر |
|||
|
وحيث أن هذه السيَر – طبيعيا – تشكل المنهل الأساسي الذي ينبغي أن يستقي منه الساسة الإسلاميون الدروس، فإن من اللازم أيضا أن تكون هذه الدروس والمبادئ أساس لبنات الحكم الإسلامي المعاصر. والسيد الصادق يرى أن هذا الأمر بحاجة إلى ألوف الأنواع من الكتب المختلفة في هذا المجال. ومن أسهل وأعمق الطرق إلى ذلك؛ التلاحم الفكري المعمق بين الحوزة العلمية والجامعة، لوضع صيغة صالحة وغنية بالصحة وإمكان التطبيق العملي في العصر الحاضر، للحكومة الإسلامية الإلهية الحقة. ويستمر سماحته في رسم مسار السياسة الإسلامية بدقة، رغم طبيعة كتابه من حيث كونه يحمل خطوطا عريضة. بيد أن المتتبع لثنايا الكتاب يلحظ أن كل نتيجة وصل إليها مؤلفه كانت بمثابة تعرية للسياسة الإسلاموية أو الإسلام السياسي، وذلك من خلال أسلوب نقض إيجابي يبدو موجها لأولئك الذين أهملوا كثيرا من المبادئ والمعايير الإسلامية الصحيحة في الحكم. فالحاكم الإسلامي ينبغي أن تتوافر فيه ملكات العدالة والفقاهة والتقوى والعلم، إلى جوار أن توليه الحكم يفرض عليه التنازل عن كثير من الراحة واستبدالها بكثير من العناء. فهو موظف لخدمة المجتمع، منصبه منصب تكليف لا تشريف، ومسؤوليته مضاعفة أمام الله تعالى والأمة. ويعتقد السيد الصادق أن الحاكم أو الرئيس (يجب أن يلاحظ جميع حاجات المسلمين، فيسدها ويغيث الضعفاء والمضطهدين، ويستمع إلى الفقراء والمساكين) (3). ونتوقف عند قوله (يلاحظ جميع حاجات المسلمين) إذ إن الحاكم الإسلامي حسب أطروحة سماحة السيد، وإن كان حاكما لقطر من الأقطار، فإن عليه ألا ينظر إلى أهل قطره فقط، بل تشمل اهتماماته جميع المسلمين، فالإسلام ليس قطريا، ولا يعترف بالحدود والجنسيات، وإنما هو دين عالمي. هكذا جرت سيرة قادته، كأمير المؤمنين(ع) حيث كان ينعم حتى على أهل الشام ويشملهم برعايته، وإن لم يكونوا خاضعين لامرته إثر تمرد معاوية وانشقاقه واستفراده بالحكم. وهذه النقطة، أي ضرورة أن يساوي الحاكم بين المسلمين على اختلاف بلدانهم وتباين أعراقهم، تبدو مهملة اليوم في أدبيات الحكّام والزعماء، حتى أولئك الذين يختبئون خلف ستار الحكم الديني ويطرحون أنفسهم كقادة عالميين وولاة للأمر في وقت يأطرون فيه أنفسهم -عمليا- بإطار إقليمي محدد لا يسع المسلمين ولا يحتويهم. |
|||
|
عوامل تحطيم الأمة |
|||
|
ومن جانب آخر؛ يسجل سماحة السيد ثلاثة عوامل زرعها الاستعمار لتحطيم الأمة الإسلامية، وبدلا من أن يُنتبه إليها وتُقتَلَع، فإنها انطلت على هؤلاء وأولئك فأمست واقعا معترفا به. وهذه العوامل التي يرفضها السيد في أطروحته رفضا باتا هي: الحدود، الجنسيات، والجمارك. ناعتاً إياها بـ(الثالوث البغيض) قائلا: (لا للثالوث البغيض المركب من الحدود الأرضية المصطنعة داخل الوطن الإسلامي الشامل، والجنسيات والجوازات وقوانين الإقامة، والمكوس والجمارك. فهي عوامل لتحطيم المسلمين، وهي أسس رصينة للاستعمار الكافر، فالله تعالى، والرسول(ص)، والقرآن، كلهم ضد هذا الثالوث البغيض. والفقهاء، وتاريخ الإسلام، وفقه الإسلام، كلها ضد هذا الثالوث الممقوت) (4). |
|||
|
الضمان الاجتماعي في الإسلام |
|||
|
وفي سياق تناوله للسياسة الإسلامية في الضمان الاجتماعي، نجده دام ظله يقول: (الضمان الاجتماعي في الإسلام صبابة الإنسانية في قمتها، ولذا فإن الإسلام حيث ينطلق من زاوية الإنسانية، يصب هذا الضمان بما يوافق الإنسانية في أعمق أبعادها الفضيلة، وبالتأكيد لم ير التاريخ قبل الإسلام، ولم تسجل الحضارات بعد الإسلام، حتى اليوم ضمانا اجتماعيا بعمق الضمان الاجتماعي في الإسلام. إنه يقول: إن كل من يموت وعليه ديون، فعلى إمام المسلمين أداء ديونه، وكل من يموت وله مال، فالمال كله لورثته، ليس لإمام المسلمين منه شيء.. فهل رأيت ضمانا اجتماعيا كهذا، حتى في أعمق الحضارات؟) (5). ولم يَفُت سماحة السيد التأكيد على عنصر العدالة الذي يميز السياسة الإسلامية، ذلك العنصر الذي يعد أملا لجموع البشر ومحكا لمختلف السياسات. فلا طبقية ولا فئوية في الإسلام، ولا تفرقة بين أبيض وأسود، عربي أو أعجمي، إلا بالتقوى. ويسترشد السيد بكلمة لأمير المؤمنين(ع) يقول فيها: (خير السياسات العدل). وكذلك قوله صلوات الله عليه: (اعدلوا ولا تفضلوا أحدا على أحد). معتبرا أن (العدل هو أساس سياسة أمير المؤمنين(ع) في كل أمر، ومن ذلك ما أوصى به ولاته في أهل الكتاب ومنهم اليهود الذين وصفهم القرآن الحكيم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فقد أخرج الكليني بسنده عن رجل من ثقيف وكان من عمال أمير المؤمنين(ع) أنه قال: استعملني علي بن أبي طالب على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي: إذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي. قال: فأتيته. فقال لي: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو) (6). وهذا النص الذي يورده السيد في كتابه، يمثل منهجا تسامحيا ليس واردا في قواميس ساسة اليوم، فعلى رغم أن اليهود هم ألد أعداء المسلمين، ولا تزال مكائدهم مستمرة إلى يومنا، إلا أن السياسة الإسلامية تضمن لهم ما ضمنته للمسلمين أنفسهم. ولو أن هذا المنطق عُرِض على ساسة اليوم لقالوا متعجبين: أ نساوي بينهم وهم أعداؤنا!، وربما يكون جواب أكثرهم شفقة وعطفا: مالنا ولهم! لهم ما لهم ولنا ما لنا!، إلا أن هؤلاء لم يستوعبوا بعدُ هذا المنطق، منطق العدل. وهو ذات المنطق الذي جعل جماعات من اليهود يدخلون الإسلام سجّدا منذ بزوغ فجره لمّا عرفوا منه هذا التعامل وهذه المنطقية. |
|||
|
السياسة الإسلامية والمعارضة |
|||
|
وأما عن تعامل السياسة الإسلامية مع المعارضة، فينبئك عنه ما نقله السيد الصادق، إذ قال: (لما عزم أمير المؤمنين(ع) على صد معاوية ورده والمسير إلى صفين، خطب خطبة حرّض فيها الناس على الجهاد، فقال صلوات الله عليه: سيروا إلى أعداء الله، سيروا إلى أعداء القرآن والسنن، سيروا إلى بقية الأحزاب وقتلة المهاجرين والأنصار. فعارضه رجل من بني فزارة، ووطأه الناس بأرجلهم، وضربوه بنعالهم حتى مات. فودّاه أمير المؤمنين(ع) من بيت المال. ويظهر من هذا الحديث أن الرجل كان قد خاشن الكلام مع أمير المؤمنين(ع)، ومع ذلك اعتبره الإمام قتيل بيت المال، فدفع ديته من بيت المال! أين توجد مثل هذه الحرية في الكلام والرأي والتعبير إلا في الإسلام؟ أمير المؤمنين يدعو الناس إلى حرب عدو الله وعدو رسوله معاوية بن أبي سفيان، فيعارضه الرجل ويقتله الناس، ومع ذلك يدفع أمير المؤمنين(ع) ديته إلى ورثته! أين في أنظمة الأرض مثيل لذلك حتى في أكثر بلاد العالم حرية هذا اليوم؟!) (7). |
|||
|
الإسلام والحرية |
|||
|
أما عن سياسة الإسلام في الحريات، فينبئك عنها قول السيد: (الحريات التي ضمنها الإسلام للمسلمين ولعامة الناس لم ير التاريخ الطويل للعالم لها نظيرا ولا مثيلا، وحتى هذا اليوم الذي يحب الغربيون أن يسموه بعصر الحرية. فإن الإسلام يعطي لكل فرد من المسلمين، بل وحتى غير المسلمين من سائر البشر كامل الحرية في جميع المجالات المشروعة ما دام لا يضر ذلك بحرية الغير. وأول ما يبدأ الإسلام بتحرير الناس فيه؛ الفكر، واختيار الدين، فإن الإسلام لا يجبر الناس على دين معين أبدا ولو كانوا في بلاد الإسلام وتحت رعايته وحمايته. وقد أعلن القرآن الحكيم هذه الحرية الفكرية بقوله: لا إكراه في الدين. وقد نفّذ ذلك رسول الله(ص) في كل حروبه الدفاعية وغزواته، فكانت الانتصارات تلو الانتصارات التي يحققها الله تعالى لرسوله الكريم لا تحمله على إجبار الناس باعتناق الإسلام، بل يعرض عليهم الإسلام، فمن قبله فهو، ومن لم يقبله فلا جبر عليه بالقبول) (8). وعلى صعيد التنمية العمرانية، يؤكد السيد الصادق أن السياسة الإسلامية وفرت حرية تساعد على استثمار الأراضي وتنميتها عبر إباحتها لمن يعمرها بناء أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك. وذلك استنادا إلى قوانين نبوية منها: (الأرض لله ولمن عمرها قضاء من الله ورسوله)، (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)، (من أحاط حائطا على أرض فهي له)، (من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحق به) (9). ولو أن السياسات الحديثة اتخذت هذا القانون الإسلامي وطبقته، لانتفت مشاكل الإسكان مثلا، ولساعد ذلك على تطور المجتمع زراعيا وعمرانيا وصناعيا. لكن الساسة المعاصرين ممن يحكمون هذه البلاد أفرطوا في سن تلك القوانين الوضعية الكثيرة التي تحد من استثمار الأراضي، وتكبل النشاط العمراني والتنموي، الأمر الذي ساهم في عزلة حضارية لا يزال المسلمون يئنون منها. وإذا طعّمنا هذه الدراسة بهذه المقتطفات من الأطروحة السياسية لآية الله الفقيه السيد صادق الشيرازي، والتي تشكل في مجموعها ملامح سياسة واقعية إسلامية حقيقية. لأمكن لنا أن نستقرأ التباين بين مفردات هذه السياسة والسياسات المعاصرة، لا سيما الإسلاموية منها، عبر مقارنة كفانا مؤونتها السيد في كتابه. يقول حفظه الله: (غير أن السياسة الإسلامية تباين السياسة العالمية اليوم في أصولها وفروعها، فالسياسة الإسلامية هي غير السياسة المعاصرة التي تمارسها معظم الدول تماما. ذلك لأن الإسلام يسير في سياسته مزيجا من الإدارة والعدل، والحب الشامل، وحفظ كرامة الإنسان، وتقييم دم الإنسان، فهو يحاول ألا تراق قطرة دم دون حق، أو تهان كرامة شخص واحد جورا، أو يظلم إنسان واحد.. بل وحتى حيوان واحد. أما السياسة – بمفهومها المعاصر – فهي القدرة على إدارة دفة الحكم وتسيير الناس والأخذ بالزمام مهما كلفت هذه الأمور من تهدير كرامات، وإراقة دماء، وكبت حريات، وابتزاز أموال، وظلم وإجحاف.. ونحو ذلك. فما دام الحكم له والسلطة خاضعة لأمره ونهيه فهي الغاية المطلوبة وإنها لتبرر الواسطة، وإن كانت الواسطة إراقة دماء الألوف والملايين جورا وظلما، هذا منطق السياسة الممارسة في أغلب بلاد العالم اليوم! ولكي يظهر لنا مفهوم السياسة في الإسلام، ومفهوم السياسة المعاصرة في أغلب بلاد العالم، ولكي ينجلي لنا البون الشاسع بين السياستين، نضع أمامنا أمثلة وممارسات واقعية لكل واحدة من السياستين) (10). |
|||
|
نماذج من واقع السياسة الإسلامية |
|||
|
وبعدما يورد سماحته أمثلة من واقع السياسة الإسلامية، في حفظ الدماء وضمان العدل، ينتقل إلى المقارنة الموضوعية مع ما هو جارٍ في الغرب. فينقل أن البريطانيين قتلوا في الهند في قصة حرب الأفيون حوالي عشرين مليون إنسان! كما قتلوا فيها أيام المطالبة بالحرية والخروج من نير الاستعمار ثمانمئة ألف إنسان في صورة مجاعة اصطناعية! وأن لينين ونتيجة لسياسته الشيوعية العقيمة في تطبيق اشتراكية المزارع قتل - باعترافه - مئة ألف قتيل ناهيك عمن امتلأت بهم السجون لأنهم رفضوا التخلي عن مزارعهم وقوت يومهم! وأن الحرب العالمية الثانية راح ضحيتها سبعون مليون إنسان بين قتيل وجريح ومعلول ومعدوم! وأن الاستعمار الفرنسي قتل في الجزائر وحدها في حرب التحرير أكثر من مليون من البشر! وأن الأميركيين قتلوا في الحرب الفيتنامية قرابة نصف مليون أيضا! فهذه هي نماذج من سياسة معاصرة مظلمة سوداوية!! أما السياسة الإسلامية، فتقضي حسب ما أثبته السيد الصادق، بعدم شن حرب إلا في حال الدفاع، وصون دماء الناس بقدر المستطاع، حتى أنه أشار إلى أن في القاموس السياسي الإسلامي أربعة عشر صنفا من الكفار المحاربين الموجودين في ساحة الحرب، يحرم على المسلمين قتلهم! وهؤلاء هم: 1) الشيخ الفاني الذي لا يقدر على حمل السلاح. 2) المرأة التي لا تشترك في الحرب وإن كانت تسعف الجرحى والمحاربين وتساعدهم في المأكل والملبس ونحو ذلك. 3) الطفل قبل بلوغه السن الشرعية الذي هو في الأنثى عشر سنوات، وفي الذكر إكمال خمس عشرة سنة غالبا. 4) من به الشلل أو الزمن وكل مقعد لا يقوم على رجليه. 5) الأعمى. 6) كل مريض أقعده المرض. 7) الرسول الذي يأتي برسالة من الكفار المحاربين إلى المسلمين. 8) الراهب المنشغل بعبادته، وإن كان مع المحاربين، ويدعو لهم بالنصر ولكنه لا يشترك في الحرب عمليا. 9) المجنون. 10) كل من لا مصلحة إنتصارية في قتله. 11) الفلاح والزارع اللذان يعمران الأرض. 12) أصحاب الصناعات كالمهندسين والمخترعين ونحوهم. 13) أصحاب الحرف كالنجار والصائغ ونحوهم. 14) الخنثى. وليست هذه القائمة الطويلة إلا دليلا ساطعا على احترام السياسة الإسلامية للإنسان وصونه كرامته وحرمته، وهو اهتمام يعد صفحا من الخيال لدى أية سياسات أخرى، فعندما يشتد النزال ويحمى الوطيس، لا يبقي أولئك ولا يذرون أحدا في ساحة المعركة. يقول السيد: (الإسلام ينهى عن أن يبتدأ المسلمون القتال مع الكفار الذين لم يستلوا سيفا على المسلمين، ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم) (11). ويعني هذا أن السياسة الإسلامية تحاول دوما أن تحول بقدر المستطاع دون اندلاع الحرب التي هي دمار أولا وأخيرا وإن كانت انتصارا وفوزا. في حين أن بقية السياسات تميل دوما إلى شن الحرب كلما سنحت لها الفرصة لإشباع نهمها التسلطي وشهوتها التوسعية، أو لتصدير مشاكل الداخل إلى الخارج، وهاهي الحروب في عالمنا لا تنتهي.. ولن تنتهي! |
|||
|
ما هي السياسة ؟ |
|||
|
وعوداً على بدء؛ يبرز سؤال مهم في ختام هذه الدراسة حول التعريف الذي ينتهي إليه السيد الصادق للسياسة، تلك الدعامة الأساسية من دعامات العمل الإسلامي الهادف – استراتيجيا – إلى قيام الدولة الإسلامية العالمية. وتلك النقطة المحورية التي يتوقف عندها المفكرون وأرباب الأيديولوجيات لأنها غدت مقياسا تقييميا مفصليا. يعرف السيد السياسة بقوله: (إنها تنظيم أمور دنيا الناس على أحسن وأرفه وجه) (12). ويعتبر السيد هذا التعريف (من صميم الإسلام ومن أسس الدين، التي يجب على كل فرد من المسلمين العمل لتطبيقها على العالم كله، والجهاد بمختلف الوسائل والسبل من أجل تثبيتها) (13). وبناء على ذلك يمكن استخلاص أن السياسة – وفق منظور سماحته – هي وسيلة تنظيمية لتحقيق الرفاه الكلي، ولعلها – من جهة أخرى – عبارة عن (صياغة جديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام). وهذا المعنى يقارع بلا أدنى شك معاني سائر الأيديولوجيات، التي لم يربط أكثرها اهتماما بالإنسان وأقلها اكتراثا بالمادة؛ العمل السياسي بتحقيق الرفاه، بل جعله دوما محصورا في دائرة الحكم وتشعباته، معتبرا إياه الغاية والمنتهى، وإن كان حاول تلطيف الصورة بادعاء أن الوصول إلى الحكم هو أيضا وسيلة لتحقيق المتطلبات المجتمعية، لكنه وقع في المقابل في مأزق الضمانات التي تحكم هذا الحكم وهذه المتطلبات، فأيهما مقدم على الآخر؟! والتجربة – يا ترى – ما الذي أثبتته؟! ثم لماذا تدخل كلمة (الحكم) دوما على الخط؟ أليس ذلك يعني انحصار العمل السياسي في دائرته بغض النظر عن موقعيته؟! السياسة الإسلامية بدورها لا ترى في الحكم عنصرا سياسيا أساسيا، بل تجعله وليد توافق طبيعي، ديني وشعبي، عندما وضع المنصّبون من قبل الله تعالى وهم الأئمة(ع)، شرائط وضوابط تجعل من كل فقيه عادل، متأهلا – ضمن إطار تعددي شوروي – تأهلا تلقائيا للقيادة والحكم، مع فسحة واسعة يوفرها الإسلام لتداول السلطة الشعبية المنتخبة برلمانيا وتنفيذيا عبر أحزاب حرة متنافسة. وهذه الموافقة بين الفقهاء والشعب، هي ضمانة أساسية لاستقامة العمل السياسي وتحقق الرفاه. أما أن تنحصر القيادة في ولاية احتكارية إسلاموية، فأمر ينشئ التطرف والعصيان، لأنه يسلب تلك الضمانة التوافقية. |
|||
|
واجب الجميع |
|||
|
وتحت عنوان (واجب الجميع) نترك الحديث للسيد الصادق الذي ختم بهذا الباب كتابه (السياسة من واقع الإسلام) إذ يقول: (لم يكن التدخل في الأمور السياسية، وتعديل الأمة، وتقويمها واجب العلماء فحسب، بل هو واجب الجميع، والجميع مسؤولون عنه غدا يوم القيامة. فكل زيغ أو انحراف يحدث في الأمة الإسلامية، يجب على جميع المسلمين مكافحته وإصلاحه. وقد قال الرسول الأعظم(ص): كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (14). ولكن المسلمين حينما تكاسلوا عن العمل، وفقدوا المسؤولية، وقعد كلٌ في داره، صبت عليهم مصائب الدنيا بأجمعها، ووقعوا فرائس صهيون والغرب والشرق وغيرهم. ولكنهم اليوم بدأوا اليقظة، ومعرفة ما يدور حولهم، فيرجى لمستقبلهم الخير الوافر، والعزة الشاملة بإذن الله تعالى. فأساس التقدم والخير والعزة هو الوعي الصحيح والإيمان الصادق، وقد ورد في الحديث الشريف: العالم بزمانه لا تهجم عليه النوائب) (15). |
|||
|
الهوامش: |
|||
|
1 - السياسة من واقع الإسلام، صادق الشيرازي، ص10. 2 - نفس المصدر، ص39. 3 - نفس المصدر، ص319. 4 - نفس المصدر، ص314. 5 - نفس المصدر، ص239. 6 - نفس المصدر، ص188. 7 - نفس المصدر، ص159. 8 - نفس المصدر، ص223-224. 9 - الأحاديث الأربعة عن كتاب (مستدرك الوسائل). 10 - نفس المصدر، ص19. 11 - نفس المصدر، ص301. 12 - نفس المصدر، ص15. 13 - نفس المصدر، ص15. 14 - نفس المصدر، ص391. 15 - نفس المصدر، ص392. |
|||