الوحدات الوطنية في المجتمعات المتنوعة، لا يمكن أن تبنى وتصان من خلال تجاهل حقائق التنوع والتعدد فيها. لأن عملية التجاهل المنهجية تحرض أهل كل هذه الحقائق للتمسك الصلب بحقائقها وثقافتها لأنها بدأت تشعر أنها مستهدفة في بعض خصوصياتها أو ثقافتها. كيف نحافظ ونحمي وحدتنا الاجتماعية والوطنية...
في طبيعة مفهوم الدولة
لعلنا لا نأت بجديد حين القول: أن قيم الإسلام السياسية، لا تؤسس لنظام حكم ثيوقراطي، وإنما هي تدعو وتحث على تأسيس حكم منبثق من جسم الأمة، ويكون تعبيرا عن حاجاتها وتطلعاتها، ويمارس دوره ووظائفه بوصفها جهازا مدنيا، لا يمتلك إلا السلطة المخولة لهم من الأمة، وهي التي تراقب أداءهم، وهي التي تقرر استمرارهم أو إعفاءهم من هذه المسؤولية الكبرى.. فالحكم وممارسته ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لإنفاذ تشريعات السماء، وتوفير حاجت ومتطلبات الناس.. إذ يقول تبارك وتعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون)..
وقال عز من قائل (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون). لهذا نجد أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخرج عن نطاق البلاغ والتعليم والتزكية.. وإن نظام السياسة والتدبير، لا يدار بالقهر والاستئثار والاستفراد والإكراه، بل بالحرية والشورى ومشاركة الجميع في صناعة حاضرهم وصياغة مستقبلهم..
فشرعية الحكم الحقيقية في أنه يحكم بالعدل والقسط بين الناس، وحين يخرج الحكم عن مقتضيات العدل والقسط في ممارسة الإدارة والحكم، تنتهي شرعيته، ويتحول إلى حكم مستبد وظالم.. يقول تبارك وتعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)..
"فمن هدي الإسلام أن يؤسس الحكم على عقد مواطنة ونظام سلطان، وأن تسود للأفراد حرمات وحريات ومساواة أساسية كيفما اختلفوا أفذاذا وجماعات، وألا يتولى أحد السلطة العليا عنوة بل بخيار الرعية انتخابا حرا عدلا، وأن تكون قرارات الأمر العام الكبرى عن شورى بإجماع أورأي غالب، وأن تتفاصل تناظيم السلطة وتتكامل وتتوازن وتتضابط تقاسما للسلطة لا احتكارا، وأن يكون الأصل في العلاقات الدولية السلام أو الدفاع عن العدوان.. تلك أحكام إسلامية، كلها معروف مقبول في ميزان الإنسانية كافة مبادئ عليا لازمة لا سبيل في دولة للشذوذ عن بعضها من بعض الرعية، لاسيما أنها تؤسس على الحرية والشورى والعدالة وفيها بوح رأي للملل والطوائف، فإن تجمع أهل ملة في إقليم تباح لهم قسمة من السلطات كلها في سلطان الدولة. "(راجع كتاب السياسة والحكم.. النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع)
وإن التأمل في طبيعة الوظائف تقوم بها الدولة في الرؤية الإسلامية، يجعلنا نعتقد بشكل لا لبس فيه، أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية وليست ثيوقراطية.. وأن المهام والوظائف الملقاة عليها وظائف مدنية.. ولعل من الأخطاء الشائعة في الكثير من الدراسات والأبحاث السياسية التي تتعلق بفقه الدولة في المنظور الإسلامي، هو عملية الخلط التاريخي بين وظائف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ووظائف الدولة كمؤسسة جامعة وحاضنة لكل التعبيرات والمكونات..
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو على رأس الدولة في التجربة التاريخية، كان يقوم بوظائف وأدوار بوصفه رسولا ونبيا، وليس بوصفه رئيس الدولة.. عملية الخلط على هذين الصعيدين، هو الذي أربك الرؤية تجاه مفهوم الدولة في التجربة التاريخية الإسلامية.. وحتى تتضح رؤيتنا في هذا السياق، من الضروري أن نحدد وظائف الدولة كمؤسسة وهياكل إدارية بعيدا عن المهام والوظائف الدعوية والدينية والأخلاقية التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه رسولا ونبيا.. " والقرآن لا يصف دولة، بل وصف مجتمعا وإذا ما كان القرآن أفقه الفقه والفقيه، فلا يجوز للأخير أن يتخطاه، أي أنه ليس من شأنه أن يصف شكل الدولة ولا طريقة تشكلها، بل يصف عدلها وجورها فيحث على العدل ويحرض ضد الجور، حتى إذا ما بلغ الجور مستوى نوعيا، إندك الفقيه في الاجتماع وفي الطبقة السياسية المعترضة، ليعملوا معا على التغيير، على موجب العدل والعدالة والتقدم، والحرية شرط الشروط.. وهنا يمارس الفقيه دوره في الصف الأول كفرد مواطن مدني.. وفي الأساس الفلسفي للمسألة أن الاجتماع، بما هومتحدات ثقافية يدخل الدين في أساسها ثابت، بينما الدولة متغير، والمتغير محفوظ في الثابت منهجيا، كما أن الثابت محفوظ في المتغير، ولكن من دون مشروع محدد سلفا، لأن الدولة كضرورة اجتماع مفهوم متحرك تقدر بظروفها "..
إننا نعتقد أن وظائف الدولة (أية دولة) بعيدا عن مضمونها الأيدلوجي ورسالتها العقدية هي:
1-حفظ الثغور والحدود ومنع أية محاولة للتعدي والعدوان.. وإن أي خلل على هذا الصعيد يعد تهاونا من مؤسسة الدولة..
فالأهداف الحقيقية والمطلوبة من مؤسسة الدولة، بصرف النظر عن أيدلوجيتها ومتبنياتها العقدية والفكرية، هي حفظ الأمن وتوفير الاستقرار والسلام وإقامة العدل وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم وضمان التقدم الاقتصادي، وتوفير الفرص للجميع بلا تمييز ومحاباة وحماية المستقبل للأجيال المقبلة..
فصد العدوان بكل أشكاله، هومن المهام والوظائف الأساسية للدولة، وأي تقصير لها في هذا السياق تحاسب عليه..
2- حفظ المصالح العامة: فمؤسسة الدولة لا يمكنها تعميق شرعيتها في الفضاء الاجتماعي، بدون سعيها المتواصل لحفظ مصالح شعبها العامة.. والدولة التي تفرط بمصالح شعبها تفقد شرعيتها الاجتماعية ولا تلتزم بوظائفها الرئيسية.. فكل التصرفات والممارسات الداخلية والخارجية، التي تقوم بها الدولة ينبغي أن تكون في نطاق حفظ مصالح المجتمع المتعددة..
3- تحقيق العدالة: في المجتمع الإنساني حيث تتضارب الإرادات وتتعدد الميولات وتتراكم نزعات السيطرة والهيمنة، تكون من وظائف الدولة الكبرى تحقيق العدالة في المجتمع، سواء في الفرص التي تتيحها لشعبها، أو في توزيع الثروات والإمكانات، أو في مشروعات البناء والتنمية.. فالدولة كمؤسسة معنية بانجاز مفهوم العدالة في حياة مجتمعها.. " فبيان الأحكام الشرعية من شؤون الإفتاء وهي وظيفة الفقهاء، وليس للحكومة أن تمنع من توفرت فيه شرائط الإفتاء من بيان الأحكام الشرعية وتعليمها، وليس لها – أيضا – المنع من أن يرجع المواطنون إلى الفقهاء لأخذ الفتيا، وإن اختلفت الآراء الفقهية، ما لم تكن ثمة مصلحة تقتضي أن يكون الاجتهاد موحدا.. كما في مجالات السياسة والاقتصاد والجهاد، فيكون الاجتهاد المتبع إما اجتهاد الحاكم إن كان مجتهدا، أو يختار اجتهاد من بين الاجتهادات، فيكون هو الملزم.. ولكن مع ذلك لا يمنع ذلك الفقهاء الآخرين من إبداء رأيهم المخالف، لأن توحيد الاجتهاد يقتصر على مجال العمل والتنفيذ..
وربما يختزن هذا الرأي – ضمنا – قدرا كبيرا من إعطاء حرية التعليم في الدولة الإسلامية، إذ في الوقت الذي لم يكن فيه الحق للدولة الإسلامية أن تحتكر التعليم الديني، فربما من الأولى عدم إعطاء الحق لها في احتكار التعليم غير الديني، ما لم يكن يتعارض مع النظام العام في الدولة الإسلامية.
ويتضح من خلال الوظائف المذكورة أعلاه، أن وظيفة الدولة الأساسية وظيفة مدنية، تستهدف المساهمة في تأمين حاجات المجتمع الضرورية، والعمل على خلق فرص التقدم وأسباب التطور في المجتمع..
(في الفلسفة السياسية الحديثة إن الدولة كيان اصطناعي ابتدعته الجماعات الإنسانية لتنظيم اجتماعية، وضبط صراعاته بوضع قواعد لها تكون محط مواضعة واتفاق، وموطن احترام وتوقير.. ويقترن بهذه الفكرة التسليم بأن ماهية الدولة ذاتية، تكون منها هي: كتمثيل للمجتمع والأمة، لا من خارجها، وأن وظيفتها اجتماعية وليست أخلاقية أو دينية، أي إنها تنصرف إلى إشباع حاجات مادية في المجتمع (الأمن، حماية الكيان، تدبير شؤون العامة...... الخ)، لا إلى خدمة مبدأ أعلى: أخلاقي أوديني أو ما في هذا المعنى، ذلك أن المبدأ الذي أسس الدولة في التاريخ هو المصلحة العامة والمشتركة للناس في مجتمع ما).. "1"
تعدد الانتماءات والوحدة السياسية
دائما المجتمعات المتعددة والمتنوعة سواء كان أفقيا أو عموديا، تولي لموضوع وحدتها الاجتماعية والوطنية أولوية خاصة. وذلك لأن طبيعة الاختلاف في الانتماءات والميولات والخصوصيات الثقافية، يملي على مؤسسة الدولة أهمية الحفاظ على وحدة هذا المجتمع والوطن، بحيث لا تتحول الانتماءات المتعددة في الإطار الوطني والاجتماعي الواحد، إلى مبرر لتضعيف البناء الوحدوي للمجتمع والوطن.
ولو تأملنا في الخريطة الأيدلوجية والمذهبية والقومية للمجتمعات الإنسانية اليوم، لرأينا أن كل المجتمعات الإنسانية تعيش حقيقة أو أكثر من حقائق التنوع والتعدد. وأنه على وجه البسيطة لا يوجد مجتمع متجانس في كل دوائر الانتماء التي تعيشها المجتمعات الإنسانية المعاصرة.
فإذا كان المجتمع موحدا في دينه فهو يعيش حالة التعدد والتنوع على مستوى المذهب والمدارس الفقهية الإسلامية. وإذا كان موحدا في الدين والمذهب نجد أن تعدده وتنوعه يأتي من البعد القومي أو العرقي للمواطنين.
وعليه فإن المجتمعات الإنسانية قاطبة تعيش حالة التعدد والتنوع.
وإن وحدة هذه المجتمعات لم تنجز على أنقاض حقائق تنوعها وتعددها. وإنما أنجزت من خلال احترام هذه الحقائق وإفساح المجال لها لإثراء الواقع الاجتماعي والثقافي من خلال خصوصياتها وعناصر القوة الذاتية.
وعليه فإننا نرى أن الوحدات الوطنية في المجتمعات المتنوعة، لا يمكن أن تبنى وتصان من خلال تجاهل حقائق التنوع والتعدد فيها. لأن عملية التجاهل المنهجية تحرض أهل كل هذه الحقائق للتمسك الصلب بحقائقها وثقافتها لأنها بدأت تشعر أنها مستهدفة في بعض خصوصياتها أو ثقافتها.
وبالتالي فإن المطلوب في المجتمعات المتنوعة هو كيف نحافظ ونحمي وحدتنا الاجتماعية والوطنية في ظل واقع اجتماعي متعدد ومتنوع.
حين الاقتراب الموضوعي من هاتين الحقيقتين، حقيقة الوحدة الوطنية التي هي من ضرورات الوجود والمنعة.
وحقيقة التنوع الذي يعيشه المجتمع على أكثر من مستوى. نجد أن المطلوب أمام هذه الحقائق الالتزام بالنقاط التالية:
1ـ الالتزام بسياسات الاحترام والاعتراف بالحقائق الموجودة في المجتمع. لأن تجاهل هذه الحقائق سيقود إلى تمسك أصحابها بشكل صلب، مما يقلل من إمكانية بناء الوحدة الوطنية على أسس صلبة وصريحة.
كما أن العمل على إفناء أو مخاصمة هذه الحقائق، سيقود المجتمع على المستوى العملي إلى التحول إلى مجتمعات متعددة ولكنها تعيش تحت سقف وطني واحد.
ولكن مع انفجار الهويات الفرعية لأغلب الانتماءات الموجودة في مجتمعاتنا، فإن وجود مجتمعات متخاصمة أو متباعدة في إطار وطني واحد، فإنه سيفضي باستمرار إلى دخول الوطن في تحديات ومشاكل لا يمكن معالجتها، لأن هذه التحديات تتغذى باستمرار من حالة الشعور العميق لجميع هذه الانتماءات للتعبير عن ذاتها بشكل صريح وفاقع.
وهذا بطبيعة الحال في ظل غياب العلاقة السوية والايجابية بين مختلف المكونات، سيؤدي إلى توتر العلاقة ويفاقم من حالات غياب الثقة ببين جميع الأطياف والتعبيرات.
لذلك فإننا نعتقد أن أسلم الخيارات وأصوبها هو التعاطي الإيجابي مع حقائق التنوع والتعدد وضبطها جميعا بقيم الوحدة الوطنية ولوازمها الأخلاقية والقانونية.
ولو نظرنا إلى المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمتطورة، والتي تعيش حقائق التنوع على أكثر من صعيد ومستوى، لوجدنا أن هذه المجتمعات، لم تتجاهل حقائق التنوع في مجتمعها، كما أنها لم تتعامل معها بقسوة، وإنما احترمت هذه الحقائق ووفرت لها قانونيا واجتماعيا التعبير السلمي والموضوعي عن ذاتها وضبطت كل هذه الخصوصيات والتعبيرات بمنظومة أخلاقية وقانونية، بحيث يحترم الجميع مقتضيات الوحدة الوطنية ومتطلباتها الوطنية والاجتماعية.
وعليه فإننا نرى أن أسلم الخيارات المتاحة للتعامل مع المجتمع المتعدد والمتنوع هو الاعتراف بهذه الحقائق والتعامل معها بوصفها هي من عوامل تعزيز الوحدة الوطنية وليس من مخاطرها أو نقاط ضعفها.
2ـ في الوقت الذي ندعو الجميع للالتزام بسياسات الاعتراف والاحترام لحقائق التنوع الموجودة في المجتمع والوطن، ندعو في ذات الوقت إلى بناء مجتمع سياسي موحدا وبعيدا عن كل نزعات التمترس الطائفي أو القومي أو العرقي.
نحن مع احترام التنوع في الدائرة الاجتماعية، ولكننا ضد نقل هذا التعدد إلى مؤسسة الدولة أو ما يمكن أن نطلق عليه المجتمع السياسي.
نعترف بالتعددية في الدائرة الاجتماعية، ولكن في المجتمع السياسي ينبغي أن نحافظ على الوحدة بكل مستوياتها وتجلياتها، بحيث تكون المواطنة بكل حمولتها الحقوقية والدستورية، هي معيار من يحق له الالتحاق بالمجتمع السياسي.
وبهذه الطريقة نحن نحافظ على وحدة المجتمع والوطن من خلال بناء الوحدة الوطنية والاجتماعية على قاعدة القبول التام بكل حقائق التعدد والتنوع.
وفي هذا السياق من الضروري بيان إننا ضد أية مخاصمة طائفية أو عرقية أو قومية في المجتمع السياسي ومؤسسات الدولة.
فالكفاءة الوطنية وحدها هي مقياس من يحق له المشاركة في عضوية المجتمع السياسي.
وان اعترافنا بحقائق التنوع والتعدد، ينبغي أن لا يتعدى الميدان الاجتماعي والثقافي بكل مستوياتها.
(الدولة الحديثة دولة لمواطنيها كافة بمعزل عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية.. وهي، بهذا الاعتبار، لا يمكنها أن تنحاز إلى فريق آخر أو فرقاء آخرين..
خاصة وأن الأعم أغلب من مجتمعات العالم متعدد التكوين الديني والمذهبي.. أما الذهاب إلى القول إن الدولة تتبنى دين أغلبية مواطنيها ففيه نقض لمفهوم المواطنة من جهة، وفيه – من جهة ثانية – خلط فاضح بين معنى الأغلبية والأقلية وهومعنى سياسي بامتياز، وبين معنى الجماعات، وهو معنى ثقافي وأنتربولوجي وديني لا يتأسس سياسيا في الدولة).."2"
فالدولة بكل مؤسساتها موحدة، ومعيار الشراكة فيها هو الكفاءة الوطنية. أما المجتمع فهو يعيش حالة التنوع بكل مستوياتها، ويتنافس الجميع في الدائرة الاجتماعية بدون أي ضغط سلبي على أي مستوى من مستويات الانتماء الموجودة في المجتمع.
3ـ في الوقت الذي ندعو إلى احترام كل حقائق التنوع الموجودة في المجتمع، ندعو في ذات الوقت إلى وطن واحد موحد يحتضن الجميع ويعمل على توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة للجميع بدون تحيز لأحد أو افتئات على أحد. ووحدة الوطن ليس من القضايا القابلة للمقايضة. بل هي من الثوابت التي تصل إلى حد ما يطلق عليه المقدس السياسي، الذي ينبغي لكل أبناء الوطن الحفاظ عليه وحمايته من كل المخاطر والتحديات.
وبهذه الآليات نصل إلى معادلة قائمة على العناصر التالية: احترام كامل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية ومجتمع سياسي موحد معيار الالتحاق به هو الكفاءة الوطنية بصرف النظر عن انتماءات هذه الكفاءات الوطنية، ووحدة وطنية لا مساومة عليها، وتصان وتحمى من الجميع، ويتم الدفاع عنها بالغالي والنفيس.
وفق هذه المعادلة تتمكن المجتمعات المتنوعة والمتعددة أن تبني وحدة وطنية صلبة، لا يخشى عليها مهما كانت التحديات أو المكائد التي يكيدها أعداء الوطن.
فالانتماءات بكل مستوياتها، هي حقائق اجتماعية وثقافية عنيدة، وقادرة على الدفاع عن نفسها مهما كانت القوة التي تريد اجتثاثها أو استئصالها. وإن هذه الحقائق بحاجة إلى احترام قانوني ومؤسسي لوجودها وخصوصياتها، وإن هذا الاحترام القانوني والمؤسسي، سيحولها إلى طاقة خلاقة لإثراء حقائق الوحدة الوطنية، وستدافع بكل ما تملك عن وطنها ووحدته.
بين الديمقراطية والشعبية
على مستوى المفاهيم والمصطلحات المتداولة، هناك حاجة إلى تحديد معاني هذه المفاهيم وتوضيح المقصود من المصطلحات المتداولة. وإن عملية التحديد والتوضيح ليس عملا ترفيا، وإنما له مدخلية أساسية في فكر الناس وثقافتهم ومعايير التقويم لديهم للظواهر الفكرية والسياسية والاجتماعية. لأن في بعض الأحيان هناك من يتقصد خلق الالتباسات والتشويه سواء على مستوى المفاهيم أو المصاديق الخارجية لهذه المفاهيم.
ومن هذه المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح دقيق هو مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشعبية. لأن هناك وسائل إعلامية عديدة تعمل على الخلط بين الديمقراطية والشعبية وجعل المفهوم الثاني هو معيار المفهوم الأول. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تجمد الفكر السياسي وتشويه المسارات السياسية والاجتماعية وخلق حالة من تزييف الوعي.
لذلك ثمة ضرورة معرفية واجتماعية لبيان الفروقات بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشعبية وأوجه التشابه بينهما.
فهناك أنظمة سياسية في كل مناطق العالم لها شعبية، أي لها حاضنة اجتماعية واسعة، ولديها منجزات اقتصادية ومعيشية وسياسية عززت سمعتها وموقعها لدى شرائح محددة من شعبها. إلا أن هذه الأنظمة السياسية لم تصل إلى الحكم بوسائل ديمقراطية كما أنها لم تستمر في الحكم عبر آليات انتخابية ـ ديمقراطية.
هذا النوع من الحكومات والأنظمة السياسية، لا يمكن أن ننفي عنها صفة الشعبية، ولكننا نستطيع وعبر مفهوم وجوهر العملية الديمقراطية أن ننفي صفة الديمقراطية. فكل نظام سياسي يتوسل آليات الانتخاب والتداول هو نظام ديمقراطي وتارة تكون عملية الديمقراطية لديه شكلية وتارة أخرى تكون حقيقية. أما الأنظمة السياسية التي تتكئ على منجزها التاريخي أو الاقتصادي أو الخدمي، إلا أنها لا تتوسل آليات الانتخاب هي أنظمة سياسية لها قاعدة اجتماعية وشعبية، ولديها تأييد واسع أو محدود من شرائح وفئات مجتمعها، إلا أنها ليست ديمقراطية وفق المعايير المتبعة ديمقراطيا ودستوريا.
وحينما نتحدث عن شعبية النظام السياسي، لا نتحدث عن إجماع الشعب أو المجتمع في تأييده للنظام السياسي. لأن إجماع أي شعب على تأييد نظامه السياسية دونه صعوبات حقيقية وغير متاح تحقيقه في الواقع الخارجي. بمعنى أن المقصود من الشعبية، هو وجود فئات وشرائح اجتماعية وازنة مؤيدة للنظام السياسي ومدافعه عن خياراته، وتعتبر نفسها هذه الشرائح هي القاعدة الاجتماعية للسلطة.
في مقابل شرائح اجتماعية أقل وزنا وتأثيرا ليست مؤيدة بالمطلق لنظامها السياسي أولا تعتبر نفسها من قاعدة السلطة الاجتماعية.
ونحن هنا لا نود المفاضلة بين ديمقراطية النظام السياسي وشعبيته، لأن المفاضلة تحتاج إلى مداخل أخرى، وإنما ما أردنا إثارته في هذا المقال هو عدم الخلط بين ديمقراطية النظام السياسي كمفهوم وحقائق دستورية وقانونية، وبين شعبية النظام السياسي حيث وجود تأييد صريح من قبل فئات المجتمع لخيارات النظام السياسي ومشروعاته المختلفة سواء كانت داخلية أم خارجية.
ولو أردنا على ضوء هذه المفارقة بين الديمقراطي والشعبي أن نقترب من الواقع السياسي العربي. سنجد أن هناك أنظمة سياسية كالنظام السياسي المصري في عهد جمال عبد الناصر، فهو نظام سياسي له شعبيته الوازنة ولزعيم هذا النظام شخصية كاريزمية واضحة حيث الملايين من الشعب المصري كان يهتف باسمه ويدافع عن مشروعاته وخياراته.
ويبدو لي أنه لا أحد يشك في أن النظام الناصري في مصر كان يمتلك شعبية وقاعدته الاجتماعية واسعة في كل المدن والأرياف المصرية، إلا أن هذا النظام، لا يمكن اعتباره نظاما ديمقراطيا. لأنه لم يأت إلى السلطة بآليات انتخابية، تداولية، كما أنه لم يستمر في السلطة بوسائل ديمقراطية.
والخطير في الأمر على المستوى السياسي، حينما يكون المزاج العربي سواء في هذه الدولة أو تلك رافضا إلى النظام الديمقراطي ومؤيدا للنظام الشعبي. مع العلم أن كل نظام ديمقراطي هو بالضرورة له شعبية وازنة وهي القاعدة الاجتماعية التي دعمته وأوصلته إلى الحكم. ولكننا لا نستطيع أن نساوق بين النظام الشعبي والنظام الديمقراطي بدون استخدام آليات الانتخاب والتداول.
لأن وجود هذا المزاج العربي الشعبي، لا يساعد على تطوير الأنظمة السياسية في العالم العربي، ولا يعتني بتطوير مفهوم الشراكة والتوسيع الدائم للقاعدة الاجتماعية للسلطة.
وفي مقابل هذا نعتبر أن فرصة الأنظمة السياسية الشعبية للالتزام بالآليات الديمقراطية مؤاتية،
لأن هذه الأنظمة ستوظف شعبيتها لتعزيز سلطتها عبر آليات ديمقراطية ودستورية.
أما الفصل بين الشعبي والديمقراطي، سيحول دون بناء أنظمة سياسية متطورة وعميقة في الوجدان الشعبي والاجتماعي في وقت واحد. والمطلوب عربيا هو استمرار السعي والكفاح من اجل توظيف البعد الشعبي للأنظمة السياسية في بناء ديمقراطية ممكنة ومتاحة.
أما الخطير في الأمر حينما تسود في المنطقة العربية أنظمة سياسية ليست ديمقراطية وفي ذات الوقت ليس لديها شعبية وازنة، فإن هذه الأنظمة تعيش الانفصال والاغتراب عن شعبها ومحيطها الاجتماعي، كما أن قاعدتها الاجتماعية ضيقة ومحدودة، وستجبر كل هذه النواقص باستخدام القهر والقمع لإدامة سلطتها وهيمنتها على المجتمع. ولو تأملنا في تجربة الأنظمة السياسية العسكرية التي جاءت إلى الحكم عبر الدبابة والانقلاب العسكري وحكمت العديد من البلدان العربية في عقود الخمسينيات والستينيات سنجد هذه الحقيقة جلية وواضحة وصريحة.
فهذه الأنظمة السياسية ذات قاعدة اجتماعية محدودة، واحتكرت كل مواقع الدولة والسلطة لأبناء المؤسسة العسكرية، وتعاملت مع فئات وشرائح المجتمع الأخرى بفوقية واستعلاء، وأماتت الحياة المدنية والأهلية، وألغت كل فعاليات المجتمع المدني، فاتسعت الفجوة بينها وبين شعبها، ولا خيار أمامها للاستمرار في السلطة إلا سياسة تكميم الأفواه والاستمرار بقوة الحديد والنار، لجبر نقصها وإخماد الأصوات الرافضة إلى خياراتها ونهجها في الحكم. فتحولت السلطة في زمنهم في العديد من البلدان العربية إلى مصدر للإفقار المتعاظم لفئات المجتمع المختلفة، وطاردة للعقول المفكرة والمبدعة ومفككة لنسيج المجتمع. فكانت تجربة قاسية ومريرة على الواقع العربي، وأحسب أن المنطقة العربية لا زالت تدفع فاتورة الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها النخب السياسية ـ العسكرية آنذاك.
لذلك ثمة ضرورة دائمة في كل البلدان العربية في الاستمرار في تطوير أنظمتها السياسية وتجاوز الأخطاء السابقة سواء على مستوى الخيارات أو مستوى الأولويات لأنه لا تقدم حقيقي ولا قوة فعلية وازنة إلا في ظل أنظمة سياسية متطورة وتنشد التطور الدائم. لأن يباس الأنظمة السياسية سينعكس سلبا على مختلف جوانب الحياة.
ولو تأملنا في لحظات التقدم والانجاز لدى مختلف الشعوب والأمم، لوجدنا أن هذه اللحظات تشكلت من لحظة تطوير وتحديث أنظمتها السياسية.
(لا سبيل إلى أن يعيش مجتمع من دون دولة مهما كانت درجة التنظيم الذاتي لذلك المجتمع.. بل إن بلوغ ذلك التنظيم الذاتي نفسه درجة من التطور والمتانة والتماسك لا يعني شيئا آخر أكثر من أنه يقود إلى نشوء دولة..
إن الترابط بين الجماعة والدولة – هنا – ليس مصادفة تاريخية ولا هو من مواريثها المتكرسة بقوة أحكام الزمن والعادة، وإنما مأتاه معنى الدولة ذاته..
فالدولة ليست مضافا في تاريخ مجتمع، بل هي ماهيته التي من دونها لا يكون كذلك، أي مجتمعا.. وهي ماهيته لأنها مبدأ التنظيم الجمعي فيه: المبدأ المؤسس للمجتمع بالضرورة، أي الذي من دونه لا يكون المجتمع مجتمعا بل هو فضاء فسيح لجماعات منفصلة عن بعضها ثم إنها ماهيته لأنها عقله الذي يحقق به وعيه بنفسه كمجتمع ملتحم، أي – بالتالي – مختلف عن غيره ومتمايز).. "3"
جدل الدين والدولة في التجربة الغربية
على المستوى الغربي ثمة بلدان وتجارب، حاربت الكنيسة الحداثة السياسية والثقافية، فنتج عن ذلك تقلص وتراجع حضور الدين في الحياة العامة. كما هو الشأن في اسبانيا. وفي بلدان أخرى اضطلعت الكنيسة بدور محوري في مواجهة الأنظمة الشمولية، فكانت طليعة تنويرية للمجتمع، فشهدت يقظة دينية جلية للعيان وبارزة في الحياة العامة كما هو شأن بولندا. فالتجربة الغربية ليست على نسق واحد، وهناك تفاوت بين البلدان الغربية في طبيعة الجدل المعرفي والسياسي بين الدين والدولة في فضاء هذه الدول والمجتمعات. إلا إننا نستطيع القول إن أسس وأصول هذا الجدل واحدة في الدول الغربية مع تمايز في طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر بها هذه الدول. فاغلب هذه الدول لم تقص الدين تماما من الحياة العامة، وإنما حددت له مكان وموقع ينشط ويتحرك فيه، دون الإضرار أو التدخل المباشر والفج في أداء الدولة ومواقفها المختلفة. كما إن التكوين المعرفي والفلسفي للكثير من أطراف النخب السياسية في الغرب، هي متأثرة ومستلهمة للقيم الدينية – المسيحية.
فالغرب لم يطرد الدين من فضاء الدولة، وإنما جعل مؤسسة الدولة هي المهيمنة والمسيطرة على الفضاء الديني في الكثير من الجوانب والأبعاد.
والسلطة ومؤسساتها المختلفة في ظل الأنظمة الغربية الديمقراطية، ليست منفصلة عن مجتمعها، وشرعيتها (أي سلطة) ليست نابعة من خارج المجتمع وخياراته السياسية، بل هي على مستوى الشرعية والمشروعية نتاج مباشر لخيارات المجتمع وانتخاب هذه السلطة من أجل تحقيق هذه الخيارات في الواقع الوطني العام. فلا شرعية للسلطة وفق الرؤية الديمقراطية ـ المدنية إلا شرعية الجمهور التي منحها صوته وأختارها لإدارة شؤون الدولة والمجال العام. [إن السلطة الديمقراطية تنتشر تحت طالع المثولية. فهي ليست سوى تعبير عن المجتمع، والمجتمع يمثل نفسه بنفسه من خلالها، ومن داخل ذاتها. باستثناء أن هذه العملية تفترض ابتعاد السلطة، أي تمايزها البين عن المجتمع. هذا هوالشرط الذي يجعل من الممكن التحقق من نسبة التماثل بين هذين القطبين.
فالديمقراطيات المعاصرة لم تجد سبيلا إلى الاستقرار إلا بدءا من اليوم الذي اكتشفت فيه أنه من الضروري القبول بالفارق من أجل تقدير الوفاق، بدلا من البحث بلا جدوى عن التطابق. فالارتباط الميتافيزيقي بين السلطة والمجتمع أبعد من أن يقرب بينهما، بل هو عمليا يفصل بينهما.. وكلما توفرت المطابقة بينهما في الجوهر، كلما أزداد الفارق الوظيفي بينهما. هذا يعني أن الغيرية المستبعدة لصالح تفوق معياري عادت لتنبثق من جديد داخل الآلية السياسية نفسها، بصورة غير مرئية، وغير معروفة بالنسبة للمعنيين بها، ولكن بفاعلية شديدة. إن ما كان يتخذ مظهرا دينيا بحتا نراه مجددا وبشكل عملاني في قلب الرابط الجماعي].. [مارسيل وشيه ـ الدين في الديمقراطية، ص 29ـ 30، ترجمة شفيق محسن، المنظمة العربية للترجمة ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت 2007 م].
والذي يؤكد أهمية التمييز بين الدولة والدين في الفضاء الغربي، وجود تفسيرات كنسية شمولية ـ سلطوية للدين بحيث إذا سادت هذه التفاسير ووصل أصحابها إلى السلطة، فهم سيمارسون كل ألوان العنف والقسر من أجل تعميم قناعاتهم وأفكارهم. والذي يمارس اليوم العنف والتكفير والتفجير ضد المختلفين معه في السياسة أو الدين أو المذهب، فإنه إذا أمتلك مقدرات الدولة فهو سيوظفها لصالح مشروعه الأيدلوجي فسيعمل من موقع السلطة والقدرة على ممارسة القسر، لإقناع الشعب خياراته وأفكاره وسياساته.
وهذا يعني على المستوى العملي تأبيد الاستبداد السياسي بتغطية دينية.
بحيث يتكامل الاستبدادان الديني والسياسي. وعلى المستوى التاريخي في التجربة الغربية فإن أسوء اللحظات من الناحيتين السياسية والدينية هي تلك اللحظات التي يتكاتف الديني بالمعنى الكنسي مع السياسي لبناء سلطة سياسية ـ دنيوية، تمارس الاستبداد بكل صنوفه فالتمييز بين الدين والدولة لا يعني إلغاء موقع الدين من حياة الناس، وإنما ضمان هذا الموقع حتى لا تتعدى الدولة لمؤسساتها المختلفة على مجال الدين. والمنظرون الغربيون يتحدثون عن مجموعة من الاعتبارات تؤكد ضرورة التمييز بين الدين والدولة ويمكن بيان هذه الضرورات في النقاط التالية:
1ـ توزيع عناصر القوة والسلطة، وعدم اجتماعها في مساحة اجتماعية ضيقة. لأن احتكار عناصر القوة والسلطة في يد فئة محدودة، يفضي بالضرورة إلى الاستبداد والديكتاتورية في أبشع صورها.
2ـ حتى لا تتحول التفسيرات البشرية للدين إلى أيقونة مقدسة، لا يمكن نقدها وإبراز عيوبها، بحيث سيتم التعامل معها بوصفها متعالية على زمانها ومكانها، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك. مما يؤدي إلى قيام السياسي بتوظيف التفسير الديني المدعوم من قبله لتأبيد سلطته، ومنع أي شكل من أشكال الاعتراض عليه. فلكي يتحرر الديني من سطوة السياسي، ثمة ضرورة قصوى للتمييز بين مجال الدين ومجال الدولة.
3ـ لكون المجتمع متعدد ومتنوع أفقيا وعموديا، وحتى لا تتحول الدولة بكل مؤسساتها إلى حاضنة للبعض وطاردة للبعض الآخر لاعتبارات أيدلوجية بحيث تتحول إلى دولة مع البعض من مكونات شعبها وضد مكونات أخرى من شعبها. وهذا بطبيعة الحال يفضي إلى تفشي الظلم والتمييز بين المواطنين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. لذلك وحتى تكون الدولة دولة للجميع بدون الافتئات على أحد أو الانحياز لأحد على حساب أحد آخر، ثمة ضرورة للتميز، حتى تصبح الدولة بكل هياكلها متعالية على انقسامات شعبها ورافعة لهم جميعا نحو مواطنة جامعة بدون تمييز بين المواطنين. لذلك على مستوى التجربة الغربية ارتبط تاريخ العلمانية بتاريخ الدولة. بمعنى أن النخب الغربية لم تتمكن من بناء دولة عادلة وديمقراطية وحاضنة لجميع مواطنيها إلا بالخيار العلماني.
لذلك تراكمت الممارسة العلمانية في أروقة مؤسسات الدولة، وترافق بماء الدولة مع صعود الخيار العلماني، بوصفه الخيار الذي يحترم الدين دون معاداة ويفسح له المجال لممارسة دوره على صعيد الإيمان الشخصي ومؤسسات المجتمع المدني. مع إدراكنا التام أن ثمة تجارب علمانوية ـ غربية، حاربت الدين وعملت على إقصاءه من الوجود والتأثير فحين تفقد المؤسسات الدينية قدرها الجامع والحاضن للجميع، لامناص من التمييز بين مجال الدين ومجال الدولة. لذلك فإن الدولة التي تدار بعقلية مذهبية ـ مغلقة، بصرف النظر عن صوابية هذا المذهب أو حقانيته في الاعتقاد والإيمان، فإن هذه الدولة ستعبر حين الالتزام بمقتضيات العدالة النسبية عن آمال وحساسيات بعض شعبها وليس كل الحساسيات الموجودة في شعبها. لذلك فإننا نعتقد أن كل دولة في الفضاء الإسلامي، تحول الدين الإسلامي إلى أيدلوجيا من خلال تفسير محدد ومعين لقيم الدين ومبادئه الأساسية، ستساهم في تنمية الفوارق بين المواطنين ولن تتمكن من الوفاء بكل حاجات ومتطلبات كل مكونات شعبها.
ونحن هنا نفرق بين الدين كمنظومة قيمية وتشريعية متكاملة، وبين الأيدلوجيا الدينية وهي أحد تفاسير هذا الدين. وليس من الطبيعي هنا أن نساوي بين الدين المنزل من الخالق عزوجل وبين الاجتهادات البشرية التي قد تصيب وقد تخطأ. وحين المفاضلة والاختيار بين دولة تستند إلى رؤية دينية خاصة ليست محل إجماع وتوافق، وبين دولة تستهدي بقيم الدين العليا، وتتعامل مع المواطنين على حد سواء بصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم الأيدلوجية. فنحن نختار الدولة المدنية التي تعتبر قيم الإسلام مرجعيتها العليا وتتعامل مع أبناء شعبها على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. فنحن لسنا مع قسر الناس وإخضاعهم لرؤية دينية واحدة، كما إننا لسنا مع دولة تتدخل بشكل غير قانوني في المجال الخاص للأفراد والمواطنين.
فالمطلوب حياد الدولة كمؤسسة تجاه عقائد المواطنين. حتى لوالتزم أفراد هذه المؤسسة برأي دين أوعقيدة دينية خاصة. فمن حقه ذلك، ولكن ليس من حقه أن يوظف موقعه الرسمي لتعميم عقيدته أو الترويج لأرائه، فالدولة كمؤسسة على مسافة واحدة بين جميع المواطنين، حتى لوتعددت انتماءات المواطنين وقناعاتهم الفكرية والسياسية. والدولة هنا معنية بتطبيق القانون المنبثق من إرادة الشعب، وليس التفتيش في ضمائر الناس وقلوبهم بمعنى أنها دولة تحترم الحريات الفردية في إطارها الحقيقي وفي كل مالا يتعلق بالمواد الإجبارية في القوانين العامة. إنها تسمح بشكل خاص للمعتقدات الدينية وللعبادات بأن تنموبحرية خارجها، على أن لا يمتد مطلب حق ممارسة حريات المعتقد المحق إلى أفعال وتدخلات تخالف الحق العام، وعلى أن لا تسعى أي ديانة (أو مذهب) إلى منح مؤسساتها سلطة تنافس السلطة المدنية، وتناوئها في مجالها وتسعى إلى القضاء عليها، هناك تسامح كامل إذا، طالما أن السلطة المدنية ليس لها أي منافس في مجالها، في ما يتعلق بالقيم الجوهرية التي باسمها تسود الجماعة، وهي قيم ليست في هذه الحالة سوى تلك التي ينص عليها العقد الاجتماعي].. [كتاب الدين في الديمقراطية ـ ص 68 ـ مصدر سابق].. فهي دولة لها سلطة تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وتسيير شؤون الناس الداخلية والخارجية. وتمارس كل هذه الأدوار والوظائف على قاعدة الدستور ومبادئه الأخلاقية والقانونية.
العرب بين السلطة والدولة
تتفق جميع التحليلات الاستراتيجية والسياسية أن ما جرى من تحولات سياسية في بعض البلدان العربية، هي تحولات طالت السلطة السياسية، بوصفها هي الجهاز المؤسسي والبيروقراطي المعني بتسيير شؤون الدولة وسياساتها الداخلية والخارجية. وإن تفاقم إخفاق هذه السلطة في تلبية طموحات شعبها وتجاوز محنه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو الذي يوفر المناخ لتحرك الشعب بقواه المختلفة لإخراج السلطة من دائرة إدارة الشأن العام.
إلا أن هذه التحليلات تختلف مع بعضها البعض حول مسألة: هل القضاء على السلطة السياسية، يقود إلى القضاء على الدولة. أم أن الدولة بوصفها المؤسسة الثابتة والضاربة بجذورها في عمق المجتمع، هي مؤسسة لا يمكن القضاء عليها بهذه السهولة أو بالطريقة التي جرت في دول الربيع العربي. ومن الضروري في هذا السياق ومن منظور علم الاجتماع السياسي، أن يتم التفريق بين مفهوم وحقيقة السلطة السياسية ومفهوم وحقيقة الدولة.
وإن من الأخطاء الشائعة على الصعيد العربي، التعامل مع هذين المفهومين بوصفهما حقيقة واحد، بينما في المنظور العلمي والواقعي يتم التفريق والتمييز بين السلطة والدولة.
صحيح أن السلطة هي بعض الدولة، بمعنى أنها (أي سلطة) هي الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة إلا أن هذه المساحة الواسعة التي تحتلها السلطة إلا أنها لا تملأ كامل مفهوم الدولة. فالسلطات السياسية هي سلطات متحولة ومتغيرة، إلا أن الدولة بوصفها مؤسسة متكاملة هي مستقرة وثابتة وقادرة على التكيف مع سلطات سياسية مختلفة ومتنوعة في خياراتها وأولوياتها.
السلطة مهمتها إدارة وتسيير الشأن اليومي للمواطنين، إلا أن الدولة هي المعنية بالسياسات الاستراتيجية والخيارات الكبرى وقضايا الأمن القومي وصياغة اتجاهات السلطة سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي.
ولعل من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها النخب السياسية الجديدة في بعض بلدان الربيع العربي أنها اعتبرت حالها حين وصولها إلى السلطة إلى أنها قادرة على التحكم في مسار الدولة. إلا أنها في حقيقة الأمر اصطدمت مبكرا مع القوى الحقيقية التي تعبر عن الدولة، ولم تتمكن هذه النخب السياسية الجديدة من إنهاء تأثير قوى الدولة وتعبيراتها المركزية.
ولعل الكثير من صور الصراع السياسي والشعبي والمؤسسي التي جرت في دول الربيع العربي بعد سقوط النظام السياسي، تعود في جذورها الأساسية وأسبابها البعيدة والحيوية إلى السعي المتبادل من قبل قوى السلطة الجديدة وقوى الدولة الثابتة والمستقرة إلى التحكم في المسار السياسي العام.
ولكل طرف من هذه الأطراف حيثياته ومبرراته في سياق السعي للتحكم وضبط المعادلات المستجدة وفق رؤية هذه القوى أوتلك. فالنخب السياسية الجديدة استندت في مشروع استحواذها على إنها صانعة التغيير السياسي الأخير، وهذا الإنجاز يؤهلها إلى التحكم في مسار السلطة والدولة معا. أما القوى والمؤسسات الفعلية فكانت تعتقد أنه لولاها لما تمكنت هذه النخب من السيطرة على مقدرات السلطة السياسية. لأنها هي القوى التي حيدت المؤسسة العسكرية بكل أجهزتها، وهي التي منعت من الاستمرار في استخدام العنف العاري ضد الناس المتظاهرين، وإنها هي بحكم علاقاتها وتحالفاتها التي وفرت الغطاء الإقليمي والدولي للحظة التغيير السياسي.
لذلك فإن هذه القوى تعتبر نفسها هي الشريك الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وإن أية محاولة جديدة للاستغناء ستفضي إلى الفوضى وانهيار مؤسسات السلطة ومؤسسات الدولة معا..
ومن منظور سياسي واقعي فإن جوهر الارتباط وبعض أشكال الفوضى والانفلاش التي تعيشها بلدان الربيع العربي. تعود إلى الاختلاف العميق الذي طرأ على المشهد السياسي والاستراتيجي بين نخب السلطة السياسية الجديدة ونخب الدولة العميقة والثابتة والمتحكمة في الكثير من مفاصل الحياة.
وإنه أذا تمكنت قوى السلطة الجديدة من التحكم في مسار الأحداث والتطورات، فهذا يعني على المستوى الواقعي سيادة الفوضى وبروز التناقضات السياسية والعميقة على المشهد السياسي والاجتماعي.
أما إذا تمكنت قوى الدولة العميقة من إخراج النخب الجديدة من السلطة والتحكم مجددا بمفردها في مسار الأمور والتحولات، فهذا يعني على المستوى الواقعي إعادة إنتاج الاستبداد السياسي بقفازات جديدة وبخطاب سياسي جديد مقبول من قبل بعض فئات وشرائع الشعب. ولدى هذه الشرائع الاستعداد التام للانخراط المباشر في الوقوف دفاعا عن قوى الدولة العميقة وبالضد من نخب السلطة السياسية الجديدة.
ويبدو من طبيعة تحولات ما يسمى بالربيع العربي، أنه لا يمكن لأي قوة أن تحقق الانتصار الكاسح على القوة الأخرى.
لأن التحولات السياسية التي جرت في هذه البلدان، ليست تحولات نهائية، وإنما هي في بعض جوانبها شكل من أشكال التسوية، بحيث ترفع قوى الدولة يدها عن السلطة السياسية القديمة مما يوفر الأرضية بشكل سريع إلى انهياراها وهذا ما حدث في مصر وتونس واليمن. وفي المقابل فإن النخب السياسية الجديدة تلتزم بالحفاظ على المؤسسات الاستراتيجية للدولة، وكذلك خيارات الدولة السياسية والاستراتيجية. لذلك فإن ما جرى ليس انتصارا كاسحا لأحد الأطراف، وإنما هي تسوية سياسية بين بعض قوى الشعب التي تحركت ضد السلطة السياسية القديمة وطالبت بسقوطها وبين مؤسسات الدولة العميقة التي لم تقف ضد مشروع خروج النخبة السياسية القديمة من السلطة.
وبالتالي فإنه ثمة شراكة في مشروع التحول السياسي، هذه الشراكة هي التي تحول دون تفرد أي طرف من الأطراف بالمعادلة الجديدة. والنفق الجديد الذي دخلته بعض هذه البلدان هو الصدام المباشر وفض الشراكة أو تبديل بعض أطرافها، مما أدخل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في امتحان جديد، قد يكلف هذه الدولة أمنها واستقرارها السياسي والاجتماعي خلال المرحلة الراهنة.
وعلى ضوء هذه الثنائية العربية العميقة بين السلطة والدولة، لا يمكن أن ينجز مشروع الديمقراطية في العالم العربي دفعة واحدة، وإنما هوبحاجة إلى جهد مكثف ومؤسسي وعلى مدى زمني حتى تتمكن دول العالم العربي من إنجاز مشروع الدمقرطة والمشاركة الشعبية المؤسسية في إدارة الشأن العام.
ومن يبحث عن إنجاز مشروع الديمقراطية دفعة واحدة وفي ظل هذه الظروف، فإنه على المستوى العملي سيحصد وقائع مناقضة للديمقراطية وستدخل تعبيرات المجتمعات العربية في أتون الصراعات والصدمات التي تزيد من تعويق مشروع الديمقراطية في المنطقة العربية.
وعليه فإن التحولات الإصلاحية السياسية في المنطقة العربية، هي من أسلم الخيارات للمنطقة العربية، التي تعيد صياغة شرعية السلطة السياسية على أسس جديدة، وفي ذات الوقت تنفس حالة الاحتقان الأمني السياسي التي تشهدها بعض بلدان المنطقة العربية. فالإصلاح السياسي المؤسسي والتدريجي والحيوي هوالذي يجنب دول العالم العربي الكثير من المآزق والتحديات.
(ربما كانت الدولة أعظم اختراع إنساني في التاريخ لأنها مكنت المجتمعات من أن تقوم، ومن أن تحسن تنظيم نفسها وتحصيل شروط حياتها وتأمين أمنها في الداخل والخارج.. كذلك نهضت الدولة بدور الآخرين.. ولولا الدولة، لكانت الحياة الاجتماعية جحيما لا يطاق، بل لكان فناء النوع الإنساني.. هذا ليس غزلا في الدولة، إنه تقرير حقيقة موضوعية وتاريخية.. وقد لا يعرف قيمة الدولة إلا من عاش تجربة غياب الدولة وانقلاب الفوضى من كل عقال كما في حالة المجتمعات المنغمسة في حرب أهلية).. "4"
العرب ومفهوم الدولة القوية
علم الاجتماع السياسي المعاصر، يفرق اليوم بين الدولة القوية والدولة القمعية، ويرى أن الدولة التي تلتحم في خياراتها ومشروعاتها مع مجتمعها وشعبها هي الدولة القوية، حتى لو لم تمتلك موارد طبيعية هائلة.. فالدولة القوية حقا، هي التي تكون مؤسسة للإجماع الوطني وأداة تنفيذه.. وتنبثق خياراتها وإرادتها السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا..
ولا ريب أن الدولة القمعية بتداعياتها ومتوالياتها النفسية والسياسية والاجتماعية، هي من الأسباب الرئيسة في إخفاق المجتمعات العربية والإسلامية في مشروعات نهضتها وتقدمها.. لأنها تحولت إلى وعاء كبير لاستهلاك مقدرات الأمة وإمكاناتها في قضايا الإستزلام والمجد الفارغ والأبهة الخادعة، ومارست كل ألوان العسف لمنع بناء ذاتية وطنية مستقلة..
ومؤسسات الأمة في التجربة التاريخية الإسلامية، كانت تمارس دورا أساسيا في تنظيم حياة الناس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. ويتكثف دورها ويتعاظم في زمن انحطاط الدول أو غيابها أو هروبها من مسؤولياتها تجاه الأمة..
وفعالية الأمة السياسية والثقافية والحضارية، من الأمور الهامة على مستوى الغايات التي تتوخاها المنطقة العربية والإسلامية، وعلى مستوى العمران الحضاري.. إذ أن الأهداف الكبرى التي تحتضنها الأمة وتتطلع إلى إنجازها وتنفيذها، لا تتحقق على مستوى الواقع إلا بفعالية الأمة وحركتها التاريخية وتجسيدها لقيم الشهادة..
والمجتمع المدني – الأهلي، هو أحد جسور الأمة لإنجاز تطلعاتها وتنفيذ طموحاتها. لذلك من الأهمية بمكان العمل على تطوير ثقافة مدنية – أهلية، تبلور مسؤوليات المجتمع، وتحمله دورا ووظائف منسجمة واللحظة التاريخية..
وإن تجذير هذه النوعية من الثقافة في المحيط الاجتماعي، سيضيء سبلا هامة لمبادرات المجتمع وريادته في العمران الحضاري.. وذلك لأن هذه الثقافة ستنشط من حركية المجتمع وتزيده تماسكا في طريق البناء والتنمية، وتعزز بعضه بعضا، وتعمق في نفوس أبناء المجتمع الثقة والفعالية والانفتاح على الأفكار والتجارب الجديدة، والمرونة التي لا تعكس ضعفا وهزيمة، وإنما مرونة قوامها الثقة بقدرة الآخرين على المشاركة في البناء، والتسامح حيال الاختلافات والمواقف القلقة والملتبسة..
وإن الوصول إلى مجتمع عربي – إسلامي جديد، يأخذ على عاتقه مسؤولية التاريخ والشهادة على العصر، بحاجة إلى تنشئة ثقافية وسياسية جديدة، تغرس في عقول ونفوس أبناء المجتمع قيما جديدة تنشط الحركية الأهلية، وترفده بآفاق جديدة، وإمكانات متاحة، وتطلعات حضارية.. والتنشئة الثقافية والسياسية، من الوسائل الهامة التي تساهم في تطوير الحقل المدني – الأهلي في الأمة.. وإن شبكة العلاقات الاجتماعية، كلما كانت متحررة من رواسب الانحطاط والتخلف، وبعيدة عن آثارهما النفسية والعامة، كلما كانت هذه الشبكة قوية وفعالة.. وإن التنشئة الثقافية والسياسية السليمة، تساهم مساهمة كبيرة في حركية هذه الشبكة وقدرتها على تجاوز المحن والابتلاءات، وتوفر لها الإمكانية المناسبة للتعاطي مع اللحظة التاريخية بما يناسبها وينسجم مع متطلباتها.. وهي " وسيلة فعالة لتغيير الإنسان، وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه، وكيف يكون معهم مجموعة القوى التي تغير شرائط الوجود نحو الأحسن دائما، وكيف يكون معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ " (راجع مالك بن نبي، ميلاد مجتمع – شبكة العلاقات الاجتماعية ص 100)..
وفي إطار البناء العلمي والثقافي الذي يؤسس ركائز الحركية المدنية – الأهلية، ينبغي العناية بالمفاهيم والقيم التي تشكل مداخل ضرورية ومفاتيح فعالة لدفع قوى المجتمع نحوالبناء المؤسسي. وكذلك قراءة الأحداث والتطورات، واستيعاب منطقها وتجاه حركتها والمفاهيم المتحكمة في مسارها. و"إن ما ينبغي الحديث عنه، وما يشكل أداة مفهومية أوضح وأسهل للبحث هومجموعتان من العوامل الداخلية، لا تتماهى مع التراث، وإنما تغطي البنى المحلية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، كما نشأت في إطار التحرر من الماضي من جهة، وفي إطار التأثر بالخارج في العقود الماضية من جهة ثانية، أي من حيث هي ثمرة للتفاعل السابق بين التراث المجروح والمهتز، وأحيانا المدمر، وبين الحداثة بما هي مجموعة الأنماط الجديدة التي فرضت نفسها على وسائل وطرق إنتاج المجتمعات، لوجودها من الناحية الفكرية والخيالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية معا.. أما المجوعة الثانية فهي العوامل التاريخية التي ترتبط ببنى النظام العالمي، من حيث هو ترتيب لعلاقات القوة على الصعيد الدولي، وبسياسات الدول المختلفة الكبيرة والصغيرة الوطنية، وما ينجم عنها من تعارض في المصالح، ومن نزعات متعددة للهيمنة والسيطرة والتحكم بمصير المجتمعات الضعيفة، للاستفادة من مواردها، واحتواء ثمار عملها وجهودها " (راجع جورج جقمان وآخرون، حول الخيار الديمقراطي – دراسات نقدية، ص 121)..
ومن خلال هذه القراءة الواعية والدقيقة تتضح الظروف الموضوعية والمؤشرات العامة، التي تؤسس لشبكة التضامن الاجتماعي والتآلف الداخلي بصورة حيوية وفعالة..
وهذا لا شك هوشرط تحويل الظروف الموضوعية والمؤشرات العامة التي تدفع باتجاه الخيار الديمقراطي والمدني إلى واقع ملموس وحركة اجتماعية متواصلة.. وبالتالي تتصاعد قدرة المجتمع على إجهاض كل مشروع ارتدادي، وترتفع وتيرة الحركية الاجتماعية باتجاه البناء المدني والمؤسسي..
فالوعي الذاتي بالظروف الموضوعية وقوانين حركتها، هو شرط الاستفادة منها، وتوظيفها بما يخدم أهداف الوطن والأمة.. وبهذه العناصر والقيم، يكون المجتمع بكل شرائحه وفئاته مسئولا عن تطوير ذاته، وتجديد رؤيته لنفسه ولدوره التاريخي..
ومن المؤكد أن تطوير هذا التوجه في المحيط الاجتماعي، سوف يؤدي إلى إحداث شكل أو أشكال من المشاركة الشعبية في الحياة العامة.. والمجتمع الذي يفتقد الوعي والإرادة، فإنه ينزوي عن راهنه، ويعيش الهامشية، ولا يتحكم في مصيره ومستقبله..
لذلك فإن بداية تطور الحقل المدني – الأهلي في الفضاء العربي والإسلامي، هي في عودة الوعي بضرورة هذا الحقل في البناء والعمران، وامتلاك إرادة مستديمة لتحويل هذا الوعي إلى فعل مجتمعي متواصل، يتجه إلى تطوير وترقية وتنمية الحقل المدني – الأهلي في الأمة...
وفي المجال نفسه يمارس هذا الحقل دور إنتاج وسائل التطوير في المجتمع..
وبهذا يكون الحقل الأهلي في الأمة، هو حجر الأساس ونقطة البداية، في مشروع العمران الحضاري الجديد..
من الطائفة إلى الدولة
حين التعمق في مجرى الأحداث والتطورات والتحولات السياسية والاجتماعية في المنطقة، يجدها تتجه نحو مسارين وخيارين..
المسار الأول: هو تفكيك الدول القائمة وبناء كانتونات ودويلات دينية ومذهبية في المنطقة. وهذا بطبيعة الحال سيفتح الأفق العربي صوب صراعات ونزاعات مذهبية ودينية أهلية، تدمر ما تبقى من النسيج الاجتماعي، وتؤسس لمشروعات بناء مجتمعات مغلقة وذات هوية خالصة، مما يفضي إلى التهجير والتهجير المضاد، ويدمر أسس التعايش بين الناس. ويحول الانتماء الديني والمذهبي والعرقي والقومي، من مصدر للطمأنينة الاجتماعية، إلى رافد لتغذية النزاعات المفتوحة على تدمير الدول والأوطان.
وفي هذا المسار تنهار الدولة كما ينهار المجتمع، وتتحول الفضاءات الاجتماعية إلى مسرح للاحتراب وتصفية الحسابات وممارسة العنف بكل صنوفه وأشكاله.
ولا شك أن هذا الخيار أو المسار هومن المسارات الكارثية على المنطقة العربية، لأنه يدمر كل شيء ولا يصل إلى شيء.. لأن الانقسام والتشظي والمتلازم دائما مع الحروب واستخدام العنف، سيتولد وسيسري على جوانب الحياة المختلفة.
لذلك يعد ووفق المقاييس المختلفة، أن هذا المسار من المسارات الكارثية على الانسان العربي والاستقرار العربي والنسيج الاجتماعي العربي. لأنه يحول الجميع ضد الجميع دون أفق سياسي واجتماعي واضح ونبيل.
لذلك نجد أن الدول التي بدأ بالبروز فيها هذا المسار، أو هناك قوى تعمل من أجل انخراط الجميع في هذا المسار، تعيش كل صنوف العذاب والعنف والقتل.
فالجميع يمارس القتل والاختطاف والتطهير الديني أو المذهبي أو العرقي، والكل يشعر أنه بهذا العمل المشين يدافع عن مقدساته وتاريخه وثوابته، وهو في حقيقة الأمر يدمر مقدساته وتاريخه وثوابته.
وفي مقابل هذا المسار الكارثي الذي يحول العرب بكل دولهم وشعوبهم، إلى ساحة للحرب والاقتتال العبثي. ثمة مسار آخر لا زال يراهن على الدولة، ويسعى بكل إمكاناته للدفاع عن مبدأ الدولة الجامعة والحاضنة للجميع. وهذا الخيار والمسار يشجع ويدعو الجميع للخروج من أناهم القبلية والقومية والمذهبية إلى رحاب الاجتماع الوطني الذي يثرى بالجميع، وإلى الدولة التي تتسع للجميع.
وأمام هذه المسارات ومتوالياتها، لا شك إننا مع المسار الثاني وندعو إلى تجنيب كل الدول العربية كوارث المسار الأول الذي يدمر الدولة والمجتمع معا..
وفي هذا السياق يجدر بنا أن نذكر الجميع بالحقائق التالية:
1ـ إن القبائل والمذاهب والأديان، ليست بديلا أو نقيضا لمفهوم الدولة وضروراتها السياسية والاجتماعية والإنسانية. وحينما ندعو إلى التشبث بخيار الدولة والعمل على حماية فكرة الدولة في الاجتماع العربي المعاصر، لا ندعو إلى تدمير القبائل أو المذاهب أو الأديان. وإنما ندعو إلى احترام هذا التنوع الذي تعيشه كل المجتمعات العربية. ولكنه الاحترام الذي يعزز خيار الاندماج والوحدة.
لأنه حينما يتشبث كل طرف بعنوانه الخاص ويتم التضحية بحاضن وجامع الجميع، فإنه يفتح الطريق لفتن وحروب لا تنتهي بين جميع هذه المكونات.
وحينما تقصر الدولة أمام هذه الحقائق، من الضروري أن تطالب برفع هذا التقصير. ولكن من المهم أن لا يقودنا تقصير الدولة أو عدم إيفائها بمتطلبات الحياة إلى التضحية بها.. لأنه ضرورة لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنها. والمطلوب دائما إصلاح أوضاع الدولة وليس التضحية بها كمؤسسة جامعة وحاضنة للجميع.
وهي ليست بديلا عن حقائق المجتمع القبلية والمذهبية والدينية، كما أن هذه الحقائق أيضا ليست بديلا عن الدولة ودورها ووظيفتها. والمطلوب عربيا احترام التنوع الديني والمذهبي والقومي في المنطقة العربية، وحماية الدولة بوصفها المؤسسة التي لا غنى عنها..
2ـ إن حماية الدولة ودورها الحاضن لجميع التعبيرات، يتطلب من جميع هذه التعبيرات الانعتاق من ربقة الأنانية والانكفاء والانطواء وتنمية المساحات المشتركة، التي تحول جميع هذه التعبيرات إلى رافد لإثراء الحياة العامة والمشتركة.
وهذا بطبيعة الحال يتطلب الإعلاء من قيمة المواطنة، بوصفها هي العنوان والحقيقة القانونية والدستورية التي تنظم منظومة الحقوق والواجبات.. فالأوطان لا تبنى بانغلاق كل مجموعة على ذاتها، وإنما بانفتاح وتواصل الجميع مع الجميع ضمن رافعة ومحدد المواطنة الجامعة.
كما أن الأوطان لا تحمى بتنمية النزاعات الطائفية أو أنظمة المحاصصة المذهبية. فالأوطان تحمى بالمساواة والعدالة ووحدة مؤسسة الدولة التي تتعامل مع المواطنين بوصفهم مواطنين وليسوا أفرادا ينتمون إلى مذاهب وقوميات وقبائل.
وإن انحدار العرب صوب التعامل مع بعضهم البعض بوصفهم طوائف وقبائل، سيدخلهم في أتون أزمات متواصلة، وسيخدم هذا الانحدار الكيان الصهيوني الذي يتطلع إلى لحظة تآكل وتشظي العرب الداخلي، بحيث يصبح هو الكيان الأقوى والقادر على فرض شروطه على الحياة العربية بأسرها.
لذلك فإن وقف هذا الانحدار ضرورة عربية رسمية وأهلية للحفاظ على فكرة ومؤسسة الدولة ووحدة العرب وللوقوف بوجه المشروع الصهيوني.
3ـ إن اللحظة السياسية والاجتماعية الحالية التي يعيشها العرب بكل بلدانهم وأقطارهم، تتطلب صياغة مشروعات وطنية للمصالحة بين مؤسسة الدولة والمجتمع بكل شرائحه وفعالياته.
لأن هذه المصالحة هي التي ستنقذ العديد من الشعوب العربية من التآكل الداخلي والتشظي الطائفي.
وإن استمرار الفجوة بين الدولة والمجتمع أو بعض فئاته أو شرائحه سيقود إلى وجود مناخ من اللاثقة التي لا تخدم أمن واستقرار الدولة العربية والشعوب العربية.
لذلك فإن تجديد وتفعيل العلاقة وبناء أواصر الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع بكل فعالياته في الواقع العربي المعاصر يعد من الضرورات القصوى التي تجنب الواقع العربي الكثير من السلبيات والسيئات. وأنه آن الأوان بالنسبة إلى المجتمعات العربية المتنوعة للخروج من عناوينهم الخاصة إلى رحاب الوحدة الوطنية والمواطنة الجامعة.
فوحدة الأوطان العربية اليوم مرهونة، بوجود مبادرات فعالة وشجاعة، تستهدف معالجة بعض مشاكل الحياة العربية وتعزيز أواصر العلاقة بين الدولة والشعب، حتى يتمكن الجميع من إفشال مخططات الأعداء التي تعمل بوسائل عديدة لتقسيم العالم العربي وإدخاله في أتون معارك عبثية، تدمر كل مكاسب العرب، وتنهي أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي في كل الدول العربية.
وخلاصة القول: إننا ندعو جميع العرب بكل انتماءاتهم وأيدلوجياتهم، للتمسك بفكرة الدولة لديهم، لأنه بدونها سنبقى كانتونات متحاربة ومتنازعة ومكشوفة لإرادات الأعداء ومخططاتهم الشيطانية.
الدولة وأمن المجتمعات
في الحياة الإنسانية ثمة منجزات نوعية، لا زالت قادرة على تقديم مكاسبها للإنسان الفرد والجماعة ولولاها لدخلت الكثير من المجتمعات الإنسانية في دائرة ضياع المصالح والفوضى التي تدمر كل شيء.
وأحسب أن من أهم المنجزات التي صنعها الإنسان في هذه الحياة الطويلة، هي فكرة الدولة، بوصفها مؤسسة كبرى لتنظيم شؤون المجتمعات وإدارة مصالحها والحفاظ على مكاسبها.
وإذا أردنا أن ندرك قيمة الدولة ودورها في تسيير شؤون الناس وتنظيم مصالحهم، ننظر حينما تغيب هذه الفكرة ـ المؤسسة، عن حياة أي مجتمع، حيث تنتشر الفوضى، ويدب الخصام والصراع بين مكونات وتعبيرات المجتمع، ويضحى الإنسان مهددا في كل شؤونه.
لهذا فإننا نعتقد أن وجود مؤسسة الدولة في أي بيئة إنسانية، هومن ضرورات الحياة، وأنه لولا وجود هذه المؤسسة، لضاعت الحقوق، وتلاشت المكاسب، وأضحت حياة الإنسان بدون ناظم لتنظيم مصالحهم المختلفة.
من هنا فإن الدولة كفكرة ومؤسسة عامة. هي ضرورة من ضرورات الوجود الإنساني، وأنه لا يمكن أن تنظم مصالح الناس المختلفة بدون وجود مؤسسة الدولة. فهي ضرورة وحاجة في آن. لأن المجتمعات الإنسانية التي تفتقد الدولة ـ المؤسسة، ترى أن ضمن أولوياتها وأهدافها الملحة بناء مؤسسة الدولة لتنظيم شؤونهم المختلفة، والحفاظ على مصالح الأفراد والمجموعات البشرية في آن.
ولكون العديد من المجتمعات العربية اليوم مهددة بانهيار الدولة ودخولها في نفق الفوضى الرهيبة، من الضروري في هذا السياق بيان وذكر النقاط التالية:
1ـ إن الدول بصرف النظر عن أيدولوجياتها ومستوى قدرتها على إدارة شؤون الناس فيها، ومدى التزامها بمقتضيات العدالة والتداول، لا زالت ضرورة من ضرورات الوجود الإنساني. وإنه لا يمكن لأي مجتمع اليوم من الاستغناء عن فكرة ومؤسسة الدولة. فكل المجتمعات الإنسانية اليوم بصرف النظر عن درجة تقدمها أو تخلفها وبمدى التقدم الذي أحرزه الناس في حياتهم المختلفة، لا زالت كل المجتمعات الإنسانية بحاجة إلى الدولة، بوصفها هي المعادل الموضوعي للنظام القادر على تنظيم شؤون الناس وتصريف مصالح الناس بدون التعدي عليها أو الاستخفاف بها أو الافتئات عليها.
لذلك فإن كل المشروعات الأيدلوجية والسياسية التي تفكر في الاستغناء المباشر أوغير المباشر عن فكرة ومؤسسة الدولة، هي مشروعات تساهم بشكل مباشر في ضياع مصالح الناس ومكاسبهم المختلفة. فالدولة في كل المجتمعات الإنسانية لا زالت ضرورة وجود وحياة. وإن هذه المؤسسة الكبرى مهما كانت عيوبها أو أخطائها فإن كل هذه العيوب والأخطاء، لا يمكن أن تعالج بالتخلص من فكرة الدولة أو الغاءها من الوجود الإنساني. فلا زالت هي حاجة ملحة وضرورية لكل الناس.
2ـ لكون المجتمعات العربية والإسلامية اليوم، تعاني من خطر الإرهاب والعنف الذي بدأ بالبروز في الحياة العامة. فإن هذه المجتمعات لا يمكن أن تواجه تحديات الإرهاب والعنف بتضعيف مؤسسة الدولة أو التشجيع على إلغاءها عن الحياة العامة. لأن هذه الخطوة ستفضي من الناحية الواقعية بالمزيد من فرص انفجار العنف واستخدامه بدون مرجعية قانونية أو إدارية، مما يحول غياب أو ضعف الدولة في أي مجتمع، إلى فرصة لتدهور الأوضاع على كل المستويات وبروز أمراض الانتقام والقتل العشوائي وما أشبه ذلك.
لذلك إننا نعتقد أن كل التحديات التي تطلقها آفتي العنف والإرهاب، لا يمكن مواجهتها إلا بمؤسسة الدولة وأجهزتها المختلفة.
صحيح قد تصاب بعض أجهزة الدولة ببعض العيوب، ولكن مهما كانت عيوب الدول، لا غنى عنها كمؤسسة ناظمة لمصالح الجميع ومحافظة على آليات الانتظام العام.
من هنا وفي ظل هذه الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة بأسرها على كل المستويات، بحاجة أن نعيد الاعتبار لفكرة ومؤسسة الدولة، وإن المجتمع بكل مكوناته وتعبيراته، ليس بديلا عن الدولة ومؤسساتها.
لذلك مهما كانت المشاكل والصعوبات، نحن أحوج ما نكون إلى حماية فكرة الدولة في فضائنا السياسي والاجتماعي في كل بيئاتنا العربية.
وإن العيوب والمشاكل التي نواجهها في العالم العربي، لا يمكن أن تواجه بتغييب فكرة ومؤسسة الدولة.
ولا نريد لوطننا العربي أن ينخرط في فتنة تغييب أو تضعيف مؤسسة الدولة.
لأن كل محاولة لتضعيف فكرة ومؤسسة الدولة، ستفضي إلى نتائج كارثية على مستوى الحياة العامة. وإنه لا يمكن لأي فئة اجتماعية أن تقبض على مصالحها بدون وجود إطار ومؤسسة الدولة.
3ـ لو تأملنا في حياة المجتمعات العربية التي احتربت داخليا مع بعضها البعض، وعاشت مرحلة الحرب الأهلية بكل مكوناتها وتعبيراتها. سنجد أن هذه المجتمعات وبعد تجربتها المرة في الحرب الأهلية، ترى أنه لا حل ولا علاج لوضعها إلا بالدولة. فالدولة حينما تغيب والمجتمع بكل تعبيراته ومكوناته، يعيش الصراع والتنافس الصريح بين كل أطرافه، فإن الصراع المفتوح بين جميع الأطياف، سيقود إلى انهيار المجتمع بكل فئاته في أتون الحرب والقتل المتبادل.
وإن وقف الانهيار الاجتماعي، لا يمكن أن يتحقق عمليا بدون إعادة الاعتبار إلى الدولة كفكرة ومؤسسة، فهي القادرة على إخراج المجتمع من صراعاته الداخلية، وهي المؤسسة الوحيدة القادرة على تنظيم مصالح كل الفئات والأطياف بعيدا عن احتمالات الحرب أو الصراع المفتوح.
لذلك فإن المطلوب في هذا السياق رفض كل نزعة تستهدف إسقاط الدولة كمؤسسة ناظمة لشؤون المجتمع من التجربة العربية المعاصرة.
فمهما كانت عيوب الدولة في التجربة العربية المعاصرة، فإن غيابها أكثر عيبا وخطرا على الجميع.
والناس بكل مكوناتهم وتعبيراتهم، مهما كانت قوتهم الفعلية أو الافتراضية، ليسوا بديلا عن مؤسسة الدولة. ولا نريد لمجتمعاتنا الوقوع في براثن الفوضى أو الضياع في متاهات مشروعات سياسية وأيدلوجية تستسهل فكرة تغييب مؤسسة الدولة.
وعليه فإن مؤسسة الدولة بكل أجهزتها، هي المعنية بأمن الناس والمجتمعات التي تديرهم.
وإن كل الجهود الاجتماعية المبذولة في هذا السياق، ينبغي أن تكون داعمة لأجهزة الدولة وليست بديلا عن أجهزة الدولة.
أسوق كل هذا الكلام، لتفنيد كل أوهام الاستغناء عن فكرة ومؤسسة الدولة.
فهي أي مؤسسة الدولة، هي ضامن وحدة الوطن وهي القادرة وحدها على حماية أمن المواطنين، وهي الضرورة التي لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنها.
في معنى الدول الفاشلة
ثمة حقيقة سياسية ومجتمعية تكشفها الكثير من الأحداث السياسية الكبرى التي تجري في المنطقة، إلا أن القلة من المهتمين من يلتفت إلى هذه الحقيقة، ويرصد آثارها ومتوالياتها على المواطنين وعلى الاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
وهذه الحقيقة هي أن أخطر مرحلة تبلغها الأحداث والتطورات في أي بلد، هوحينما يصبح هذا البلد بلا راعي، وبلا حكومة تضمن الحدود الدنيا للنظام وتسيير شؤون الناس.
لأن الدولة التي تصبح بلا راعي ينظم مصالح الناس ولوفي الحدود الدنيا، ويمنع التعديات على أملاك الناس وأعراضهم، تصبح هذه الدولة فضاء مفتوح ومتاح لجميع الجماعات السياسية والإجرامية لتنفيذ مخططاتهم وأجندتهم بعيدا عن الرقابة والمحاسبة من قبل الأجهزة الرسمية. وفي ظل صعود الجماعات العنفية العابرة للحدود، تتحول هذه الدولة الفاشلة إلى بيئة حاضنة لهذه الجماعات، تدرب فيها عناصرها على الأعمال الإرهابية والعنفية وتطوير تعبئتها الأيدلوجية، مما يسرع في عملية أتساع دائرة هذه الجماعات التي تهدد أمن الأوطان والمنطقة بأسرها.. وأمام هذه الحقيقة المركبة والمتداخلة، تتعقد أزمة الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في هذه الدول، وتصبح هذه الدول الفاشلة ساحة مكشوفة لكل الإرادات والمشروعات الأمنية والسياسية، مما يزيد الأعباء على أبناء هذا الوطن وتلك الدولة الفاشلة. فالجميع يتنافس ويتصارع بمختلف الأسلحة الأمنية والسياسية والعسكرية على أرض ليست أرضهم وبدماء هذا الشعب المسكين الذي انهارت دولته وتحولت إلى دولة فاشلة غير قادرة على ضبط أمنها الداخلي وأمن حدودها. ولكونها أضحت ساحة مكشوفة وغير مسيطر عليها بقانون وأجهزة تنفيذية قادرة على ضبط الأمن والاستقرار، فإن جميع القوى الإقليمية والدولية والقوى الخارجة على قوانين بلدها، ستتجمع في فضاء هذه الدولة الفاشلة وستتصارع هناك وستدمر بقية البنية التحتية غير المدمرة، وستفتك بالنسيج الاجتماعي والوطني، مما يفاقم من أزمات هذه المجتمعات، ويدخلها في أتون الفوضى المدمرة والكارثية على كل الصعد والمستويات.
وأمام هذه الحالة التي تؤثر سلبا وبشكل عميق على الأمن الوطني والإقليمي والدولي نود التأكيد على النقاط التالية:
1 – لو تأملنا في البدايات الأولى والتي أنتجت في المحصلة النهائية ما نسميه (الدولة الفاشلة) سنجد أن أحد الأسباب الأساسية هوانسداد أفق الحل والمعالجة الداخلية لمشاكلها السياسية والأمنية والاقتصادية وتصلب جميع الأطراف وعدم تنازلها وسعيها إلى خلق تسوية ترضي الإطراف المتصارعة وتخرج الوطن والشعب من احتمالات الصدام والصراع الدائم.
فحينما ينسد أفق الحل السياسي الداخلي وتتعاظم تأثيرات الأزمة، وتستدعي جميع الأطراف المتصارعة الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن النتيجة الفعلية المترتبة على ذلك هو تأكل الدولة ومؤسساتها من الداخل وتعزيز الانقسام الأفقي والعمودي في المجتمع.
وتوقف عجلة البناء والتنمية، وكل هذه العناصر مجتمعة تفضي إلى دخول هذه الدولة في مرحلة الفشل والعجز عن معالجة مشاكلها وأزماتها المستفحلة. وحينما تصل الدولة إلى مرحلة الفشل والتآكل الداخلي، فإن عودتها إلى عافيتها يتطلب الكثير من الجهود والإمكانات والصبر، وقد تتعافى وفي كثير من الأحيان لا تتعافى، وإنما يستمر التدمير والدمار والقضاء على المؤسسات المتبقية للدولة. وأمامنا جمهورية الصومال كمثال على ذلك، فهي ومنذ سنين طويلة تعاني الصعوبات الجمة للعودة إلى دولة مركزية قادرة على ضبط الأمن وتسيير شؤون مواطنيها. فلم يعرف الشعب الصومالي خلال العقود الثلاثة الماضية إلا القتل والدمار والحروب الداخلية والكانتونات المغلقة على بعضها البعض والتدمير المتواصل للنسيج الاجتماعي والقبلي.
من هنا ولكي لا تصل بعض الدول العربية الأخرى إلى مرحلة الفشل بحاجة إلى الإسراع في وقف الانحدار والتآكل الداخلي، عبر الإصلاحات الإدارية والدستورية والسياسية، التي تعيد الحياة إلى مشروع الدولة، وتعيد ثقة شعبها بقدرة الدولة على الخروج من مأزق الانهيار والتآكل الداخلي.
2- دائما في لحظات انهيار الدول المركزية، تبرز وتتعاظم الانقسامات الاجتماعية تحت يافطات دينية أو مذهبية أو عرقية أو قبلية أو جهوية، مما يجعل الانهيار خطيرا لأنه يصيب الدولة والمجتمع في فترة زمنية واحدة، مما يفاقم من حالة العنف والاحتراب الداخلي. وهذا التشظي المجتمعي يكشف غياب مشروع وطني لهذه الدول لانجاز مفهوم الاندماج الوطني لذلك وفي اللحظة الأولى لغياب الدولة أو تآكلها تبرز كل التناقضات المجتمعية، ودائما يكون البروز بوسائل قهرية - عنيفة تساهم في تدمير النسيج الاجتماعي والوطني. وهذا بطبيعة الحال يعود إلى غياب مشروع للانتماء الوطني، بحيث يكون هذا الانتماء هو الانتماء المشترك الذي يضمن حقوق الجميع بدون افتئات على أحد.
وتتحمل كل الدول العربية في هذا السياق مسؤولية العمل على بناء مشروع وطني متكامل للاندماج الوطني، بحيث لا تتحول مجتمعاتنا العربية إلى مجتمعات منقسمة أفقيا وعموديا تحت يافطة الانتماءات التاريخية والتقليدية.
وتتوسل هذه الدول في بناء مشروع الاندماج الوطني على وسائل التنشئة والتثقيف والإعلام والتعليم والتعامل مع الجميع بمساواة على قاعدة المواطنة الجامعة.
وهذا بطبيعة الحال سيخفف من مخاطر التآكل الداخلي للدولة، لأنه يبقي المجتمع موحدا ولديه القدرة على بناء كتلة تاريخية وطنية قادرة على وقف الانحدار وإعادة بناء الوطن على أسس جديدة تخرج الجميع من أتون المآزق السابقة.
3- من الضروري أن تدرك جميع دول المنطقة أن تجذر الجماعات التكفيرية والعنفية في المناطق التي انهارت فيه الدولة أو تآكلت، يعد خطرا حقيقيا على الجميع. لأنه لا يمكن للأمن الوطني والقومي العربي أن يهنأ بالاستقرار السياسي في ظل وجود جماعات عنقية - تكفيرية تمتلك القدرة على التدريب العسكري وحيازة الأسلحة والمعدات العسكرية بكل أنواعها.
لذلك ثمة ضرورة وطنية وقومية لكل الدولة العربية لبناء مشروع عربي متكامل يستهدف مواجهة جماعات العنف والتكفير التي بدأت بالانتشار والتوسع في دول عربية مختلفة مستفيدة من وجود ثغرات أمنية وسياسية عديدة في جسم بعض هذه الدول. لأن هذه الجماعات وكما أثبتت التجربة في أكثر من مكان، لا تعرف إلا القتل والتفجير وتدمير البنى التحتية، ولا شك أن هذه الجماعات وبما تشكل من فكر عنفي وممارسات إرهابية تشكل خطرا محدقا على العالم العربي. ولا خيار أمام العرب إلا الوقوف في وجه الثقافة التكفيرية والجماعات العنفية والإرهابية التي قد تلتقي مع إرادات دولية أو إقليمية بشكل موضوعي لإدخال العالم العربي في أتون العنف والعنف المضاد. ولو تأملنا في ظاهرة الإرهاب، لرأينا أن الدول الفاشلة من أخصب البيئات الاجتماعية والسياسية لتمدد حركات وتنظيمات الإرهاب.فتنظيم داعش لو لم يجد دولا فاشلة أو في طريقها للفشل، لما تمكن هذا التنظيم من التوسع والامتداد. لذلك لايمكن محاربة الإرهاب إلا بإصلاح وضع الدول العربية، وإخراج الدول الفاشلة منها من مربع الفشل، عبر دعم مشروعات المصالحة من مآزق انسداد أفق الحل والمعالجة السياسية.
وجماع القول: إن العالم العربي يواجه تحديا جديدا، يتجسد في انهيار وتآكل بعض دوله، مما أدخل مجتمع هذه الدولة في مضمار الصراعات المعقدة والمركبة بعضها متعلق بملفات وصدامات داخلية، وبعضها الآخر متعلق بصراع الآخرين على أرض هذه الدولة المتآكلة مما جعل في الوسط العربي مجموعة من القنابل الحارقة والخطيرة في آن.
وأمام هذا التحدي النوعي الجديد، بحاجة أن تبادر دول العالم العربي لإيقاف هذا الانحدار وإيجاد خطط حقيقية وممكنة لإخراج هذه الدول من سقوطها السريع وتآكلها الداخلي المستغرب.
وهذا لا يتم على نحو فعلي إلا بأدوات إصلاحية، تنهي بعض مآزق العلاقة بين الدولة والشعب، حتى يتمكن الجميع من الخروج من مخاطر انهيار دولة عربية في ظل أوضاع عربية على أكثر من صعيد حساسة ودقيقة وتتطلب إرادة عربية جديدة تتجه صوب بناء أنظمة سياسية دستورية وقانونية وديمقراطية.
العرب وخطر تفجير المجتمعات من الداخل
حين التأمل في طبيعة الأحداث والتحولات التي تجري في المنطقة اليوم، ندرك أن المنطقة بأوضاعها الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، دخلت في مرحلة جديدة. حيث اجتازت دول المنطقة اليوم مرحلة سعي القوى السياسية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، من مرحلة العمل على تفكيك الأنظمة السياسية، وإحلال قوى سياسية جديدة محلها، إلى مرحلة العمل على تفجير المجتمعات العربية من الداخل، مستفيدة من طبيعة التناقضات والتباينات الموجودة في المجتمعات العربية.
بمعنى أن اللحظة الراهنة التي تعيشها المنطقة، هي لحظة انفجار الهويات الفرعية سواء كانت دينية أو مذهبية أو قبلية أو مناطقية، وسعي أطراف كل هذه الهويات الفرعية على التعريف بذاتها انطلاقا من انتماءها الفرعي.
فأضحى الإنسان المسلم السني، يعرف نفسه بوصفه سنيا، وذات العمل يقوم به المسلم الشيعي، وهذا ما يجري في مختلف دوائر الانتماء الفرعي المتوفرة في المجتمعات العربية.
ولا ريب أن هذه العملية المشحونة بأدبيات الهويات الفرعية، لها تأثيرات حقيقية على كل النسيج الاجتماعي العربي. فالدول التي كانت تعيش الوحدة والاستقرار وتتعامل مع مواطنيها بوصفهم مواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم ومناطقهم، أضحى الجميع يفكر بدائرته القريبة، ويرى أن هذه الدائرة القريبة لها كامل الحق في التعبير عن ذاتها كما تشاء، وأنها تستحق موقعا في الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ليس على قاعدة إثراء الحياة الوطنية والاجتماعية، وإنما على قاعدة زحزحة بعض الدوائر الاجتماعية المنافسة، لصالح انتمائي الخاص.
ونحن هنا لا نقول أن هذه المسألة، أصابت دائرة انتماء محددة، دون بقية الدوائر، وإنما هي أصابت الجميع، وكل الدوائر وفق عناصر قوتها الذاتية عبرت عن أهدافها وغاياتها، فالجميع أضحى يبحث عن خلاص فردي لجماعته الخاصة، وضاعت في معمعة هذا الجدل الصاخب كل عوامل الاستقرار وأسباب حماية النسيج الاجتماعي من كل عمليات التآكل الطارئة والتي زحفت على كل الدوائر.
ولا ريب أن أول ضحية لهذا التفكير والممارسة العملية، هو وحدة المجتمعات والأوطان. فبدل أن تفكر هذه المجتمعات في وحدتها الداخلية، أضحت مهددة بانفجار هوياتها الفرعية وتهديد وجودها واستقرارها الاجتماعي والسياسي.
ولعل بروز الصراعات الطائفية التي تجتاح المنطقة اليوم،هو أهم تجليات المشروع الجديد الذي يستهدف تفجير المجتمعات العربية من الداخل، وتحويل كل الهويات الفرعية فيها، إلى عامل لهدم استقرارها ووحدتها الداخلية.
ولو تأملنا في حال بعض المجتمعات العربية التي تعيش الفوضى وحالة الاحتراب الداخلي أو الأهلي الذي يسفك الدماء فيها، ويتم تفجير وتدمير بنيتها التحتية والأساسية هومن جراء تحريك ملف الانتماءات الفرعية، وتحويلها من انتماءات طبيعية ينبغي أن تحترم وتقدر، إلى انتماءات تعبر عن ذاتها وفق النسق السياسي والعسكري الذي يبحث عن مصالح هذه الدوائر دون الدائرة الأوسع، وبدل نسج علاقات الشراكة والتضامن الداخلي بين مختلف المكونات والتعبيرات، تم تفجير هذه الخلافات والتناقضات، وأضحت غالبية دول المنطقة تعاني في وحدتها واستمرارها كدولة واحدة ومجتمع واحد يحتضن كل هذه التعدديات والتنوعات.
وأزاء هذا المشروع الخطير، والذي بدأ من الناحية العملية بتهديد كل دول العالم العربي عبر تفجيرها من الداخل، بحيث يكون لكل هوية فرعية دولة وكيان مستقل، يعيش حالة من العداوة والخصومة مع الكيانات الاجتماعية الأخرى التي تشكلت وفق هذا المنوال.
نقول أن أزاء هذا المشروع، ثمة ضرورة عربية للتفكير في مخاطر هذا المشروع، والسعي لبناء رؤية ومشروع عربي قادر على معالجة المشاكل الطائفية والمذهبية والعنصرية والجهوية على قاعدة استمرار الوحدة وصيانة المنجز التاريخي.
وهذا بطبيعة الحال يتأتى من خلال النقاط التالية:
1ـ لعل غالبية الدول العربية ارتكبت خطئا تاريخيا بحق نفسها وبحق الواقع العربي المتنوع والمتعدد. وذلك بسبب تعاملها مع حقائق التنوع الديني والمذهبي المتوفرة في الوقع العربي بعقلية النبذ والاستئصال والطرد من مساحة الوطن الذي يحتضن الجميع. لذلك فإننا نعتقد أن غالبية الدول العربية المعاصرة لأسباب عديدة في أغلبها ذاتية، لم تتمكن من التعامل مع حقائق تنوعها الاجتماعي، بعقلية حضارية، قادرة على استيعاب كل هذه التعدديات ودمجها في متحد وطني جديد.
وبفعل هذه النزعة الاستئصالية التي تحكمت في العديد من أجهزة الدولة في التعامل مع تعددياتها، برزت المشكلة الطائفية بمستويات متفاوتة في أغلب الدول العربية، وما نعيشه اليوم هونتاج طبيعي لكل عمليات الطرد والاستئصال الذي مارسته أجهزة الدول العربية مع حقائق تنوعها بكل مستوياته.
لذلك فإن الخطوة الأولى لإصلاح هذه الأوضاع، هوبناء رؤية عربية جديدة في طريقة التعامل مع حقائق التعدد والتنوع الموجودة في العالم العربي.
وهذه الرؤية الجديدة ينبغي أن تبنى على استبدال سياسات الطرد والاستئصال بسياسات الاستيعاب والمساواة والمشاركة.
وإن حقائق التنوع ليست عيبا يجب إخفاؤه من النسيج الاجتماعي والسياسي. كما أن هذه الرؤية الجديدة ينبغي أن تعمل على تظهير البعد الوطني الذي يجمع الجميع ويحتضنهم ويدافع عن مصالحهم ومكاسبهم.
أحسب أن هذه العناصر الأساسية، هي القادرة على تحويل حقائق التنوع والتعدد من مصدر للقلق السياسي إلى مصدر للاستقرار الاجتماعي والسياسي. فسياسات الاستيعاب والشراكة والمواطنة الواحدة والمتساوية في آن، هي القادرة على حماية الوحدة وتعزيز أسباب الاستقرار وإفشال مشروع تفجير المجتمعات العربية من الداخل.
2ـ حينما تتحول بعض الدول العربية إلى طرف في الصراعات المحلية، فإن هذه الدولة ستتحول من مصدر للوحدة وضمان مصالح الجميع، إلى مؤسسة كبيرة ترعى انقسام المجتمع الواحد ودخوله في حالة من الفوضى الاجتماعية والسياسية.
لذلك فإننا نعتقد أن تطوير بنية الدولة العربية المعاصرة، بحيث تكون دولة لجميع المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، هو الحل الأمثل الذي يخرج العالم العربي من وقائع التشظي الذي بدأت بالبروز في أكثر من دولة ومجتمع.
3ـ حينما يغيب المشروع الوطني الجامع والمحتضن لكل حقائق التنوع والتعدد، تبرز الانتماءات الفرعية بنزعتها الاستقلالية والانفصالية.
لذلك في كل دولنا العربية، تحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل وشامل، وقادر على استيعاب كل حقائق التنوع وإشراكها في الإطار الوطني بدون أية نزعة تعمل على استخدام الغطاء الوطني للانتصار لانتماء على حساب بقية الانتماءات.
فليس جديدا حينما نقول أن مجتمعاتنا متنوعة ومتعددة وفي ذات الوقت نحن نطمح إلى الوحدة وبناء أوطان قوية وصلبة.
أمام هذه الغاية النبيلة ثمة ضرورة لاحترام كل هذه التنوعات عبر مشروع وطني يستوعب الجميع ويحترمهم وتصان خصوصياتهم بالقانون. والأوطان الصلبة لا تبنى إلا بالوحدة المبنية عل احترام التنوع، وبإشراك جميع أبناء الوطن في الحياة العامة.
وخلاصة القول: إننا نتمكن كدول عربية من إفشال مشروع تفجير المجتمعات العربية من الداخل، وذلك عبر تغيير إستراتيجية التعامل مع حقائق التنوع الديني والمذهبي الموجودة في الفضاء العربي. بحيث يتم التعامل على قاعدة الاحترام والشراكة الوطنية، التي لا تميز أو تفرق بين انتماء وآخر في الدائرة الوطنية.
عبر هذه الاستراتيجية نحافظ على مكاسبنا التاريخية، ونتمكن من هزيمة مشروعات كسرنا من الداخل عبر تفجير تناقضاتنا الداخلية.
الإرهاب وتخريب الدول
أود في هذه المقالة أن أنطلق من سؤال مركزي، ألا وهو هل تستطيع الجماعات المتطرفة والإرهابية أن تبني دولة وتؤسس لنظام سياسي مستقر.
لو تأملنا في تجارب جميع الجماعات المتطرفة والإرهابية، سواء في دولنا العربية والإسلامية أو في دول العالم المختلفة، سنجد أن طبيعة هذه الجماعات وآليات عملها وعقليتها العامة، غير قادرة على بناء دولة وتأسيس نظام سياسي مستقر.
صحيح أن هذه الجماعات قادرة على بيع الأوهام المثالية والأيدلوجية على الناس، مستفيدة من طبيعة الخطاب الأيدلوجي الذي تتبناه، والذي يصور أمر بناء الدول، وكأنه من الأمور البسيطة والسهلة، وإن تمكنهم السياسي سيفتح للجميع خير الأرض والسماء. ولكن حين تفحص تجاربهم، ستجدهم أنهم قادرين على هدم الدول وتفتيت عناصر قوتها، وتخريب النسيج الاجتماعي للمجتمعات. إلا أنهم غير قادرين البتة على بناء أنظمة سياسية مستقرة وتتمكن من إدارة دولة وضمان مصالح العباد فيها..
وعدم قدرة الجماعات المتطرفة والإرهابية على بناء أنظمة سياسية مستقرة وقادرة على حفظ وحماية مصالح جميع المواطنين، يعود في تقديرنا إلى الأسباب التالية:
1ـ إن بناء الدول وأنظمة سياسية مستقرة، يحتاج باستمرار إلى عقلية تلحظ معطيات الواقع وحقائقه، وتتحرك بخطوات مدروسة لبناء لبنات النظام السياسي المأمول. وهذا بطبيعة الحال يتطلب نسج علاقات تعاون أوتحالف مع بقية القوى السياسية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، وتتطلع أيضا إلى بناء نظام سياسي جديد.
وهذا لا يمكن أن تقوم به الجماعات المتطرفة والإرهابية، لأنها جماعات تستند في النظر إلى الواقع وأحواله، إلى معادلة صفرية إما هذا أو هذا، يعني إما أن يتمكنون بوحدهم ويبنوا واقعا على مقاسهم الأيدلوجي، أو يستمروا في القتل والتدمير وإشاعة كل أشكال التطرف والإرهاب.
ففكر هذه الجماعات المتطرف وبنيتها الإرهابية، يحول دون أن تتوفر لدى هذه الجماعات قدرة فعلية على بناء دول وأنظمة سياسية مستقرة.
ولم يحدثنا التاريخ أن هناك جماعة متطرفة بصرف النظر عن أيدلوجيتها وطبيعة خطابها، أنها تمكنت من بناء دولة.
صحيح أن هذه الجماعات قادرة عبر عنفها وإرهابها وتدمير بنى الحياة في المجتمع، من إسقاط حكومات وأنظمة سياسية.
ولكنها دائما غير قادرة على بناء دولة. وعدم القدرة هذه تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعتها الإرهابية وبنيتها المتطرفة، التي يجعلها قادرة على الهدم والتدمير دون البناء والعمران.
2ـ دائما بناء الأنظمة السياسية القادرة على حفظ وحماية مصالح جميع العباد في كل مناطق البلد، تحتاج إلى ذهنية سياسية وإدارية تعلي من شأن التوافق وتعمل على توسيع المساحات المشتركة مع مجموع الفعاليات والقوى السياسية الحية. لأنه لا يمكن لجهة سياسية أو أيدلوجية واحدة، أن تتحمل بوحدها عبء توفير مستلزمات بناء دولة مستقرة وقادرة على الاستمرار.
لأن هذه المهمة بطبيعتها، بحاجة إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، حتى تتمكن من بناء واقع سياسي جديد بقاعدة اجتماعية واسعة.
وهذا لا يتأتى إلا للجماعات المعتدلة، التي تتمكن من بناء تسويات وتوافقات من أجل المصلحة العامة.
وجماعات التطرف والإرهاب غير قادرة ذاتيا وموضوعيا من تدوير زوايا الاختلاف مع غيرها. لأنها جماعات على المستوى الفعلي تلتزم بمقولة الشاعر [لنا الصدر دون العالمين أو القبر].. فالنزعة الأيدلوجية لجماعات العنف والإرهاب، لا تعرف خيار تدوير الزوايا، ولا تفقه مسار التسويات والتوافقات السياسية والمؤسسية، القادرة على بناء كتلة واسعة من السياسيين والفعاليات الاجتماعية المختلفة لبلورة إدارة سياسية جامعة، لبناء واقع سياسي جديد بمقاس مصلحة الوطن كله ومتطلبات الحياة السياسية التي تحتضن جميع القوى السياسية بمختلف مرجعياتها الأيدلوجية والفكرية والسياسية.
فجماعات العنف والإرهاب، تعرف المغالبة والصراع المباشر بكل أدواته مع من يختلف معهم أيدلوجيا أوسياسيا. ولا تفقه هذه الجماعات أي شيء في فنون بناء التوافقات والتسويات الاجتماعية والسياسية، لذلك هي جماعات غير قادرة على بناء أنظمة سياسية مستقرة بمقاس كل المواطنين وفعالياتهم السياسية والاجتماعية المتعددة.
3ـ من المؤكد إننا اليوم نعيش في عصر تتداخل فيه الإرادات والمصالح وتتشابك بين مختلف الأمم والشعوب.
ولا يمكن لأية قوة سياسية أو أيدلوجية أن تحارب العالم كله. لأن أية جماعة تفكر بهذه الطريقة هي جماعة تبيع الوهم على الناس وتتجه بخياراتها نحو الانتحار الجماعي.
ويبدو أن طبيعة تفكير وعقلية جماعات التطرف والإرهاب تنسجم وهذه الطريقة في التعامل مع العالم بقواه المختلفة.
لأنها جماعات لا تحسن بناء صداقات سياسية وفكرية لها، وإنما هي تستعمل عملية تصنيف جميع الأطراف والقوى في خانة الخصوم والأعداء. لذلك هي بمثابة قنبلة جاهزة للانفجار في كل وقت ومع أي طرف. لأنها ببساطة شديدة لا تمتلك قراءة موضوعية لأحداث العالم وقواه الفاعلة.
وهكذا سلوك سياسي وأيدلوجي غير قادر على بناء العناصر الذاتية والشروط الموضوعية لبناء دولة أو نظام سياسي حاضن لجميع تعبيرات المجتمع.
وعليه نتمكن من القول: أن جماعات العنف والإرهاب، غير قادرة ذاتيا وموضوعيا من بناء دولة وأنظمة سياسية جديدة قادرة على إنجاز الأمن والاستقرار العميق في المجتمعات.
لأن البنية الأيدلوجية والفكرية لهذه الجماعات، ترذل فكرة الاستقرار وتوفير الخدمات الضرورية ومشروعات التنمية. لأنها تتعامل مع ذاتها ودورها، بوصفها كتلة بشرية وأيدلوجية مهمتها الأساسية هداية البشر وإخراجهم من كفرهم أوشركهم أوغيهم الديني.
وهكذا جماعات لا تفقه أصول وقواعد بناء الدول، وامتلاكها لخطابات أيدلوجية تبشيرية، لا يعني أنها قادرة على بناء دولة بشروطها القانونية والدستورية والسياسية ومنسجمة وروح العصر ومكاسب الحضارة الحديثة.
من هنا فإن من يريد أن يدمر دنياه، ويقضي على كل فرص الحياة الكريمة، فعليه بإتباع هذه الجماعات. وعليه فإننا نعتقد وبشكل عميق أن جماعات العنف والإرهاب، قادرة على التخريب والتفجير وإدخال الدول والمجتمعات في مربع الدول والمجتمعات الفاشلة، وغير قادرة ذاتيا وموضوعيا من بناء دول مستقرة وتتحرك باتجاه التطور والتقدم. هذا ماتثبته التجارب، وهذا مانفهمه من عقلية أهل التطرف والإرهاب. فالكلام الجاهز والبسيط والمعادلات الصفرية، لاتبني دولا، ولا تؤسس لاستقرار عميق للأمم والمجتمعات.
العالم العربي ودولة المواطنة
لعلنا لا نأت بجديد حين القول: أن أغلب المجال العربي بكل دوله وشعوبه، يعاني من تحديات خطية وأزمات بنيوية، ترهق كاهل الجميع، وتدخلهم في أتون مآزق كارثية..
فبعض دول هذا المجال العربي، دخلت في نطاق الدول الفاشلة، التي لا تتمكن من تسيير شؤون مجتمعها، مما أفضى إلى استفحال أزماتها ومآزقها على كل الصعد سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية.. والبعض الآخر من الدول والمجتمعات، مهدد في وحدته الاجتماعية والسياسية، حيث قاب قوسين أو أدنى من اندلاع بعض أشكال وصور الحرب الأهلية..
ودول أخرى تعاني من غياب النظام السياسي المستقر، ولا زالت أطرافه ومكوناته السياسية والمذهبية، تتصارع على شكل النظام السياسي، وطبيعة التمثيل لمكونات وتعبيرات مجتمعها..
إضافة إلى هذه الصور، هناك انفجار للهويات الفرعية في المجال العربي بشكل عمودي وأفقي، مما يجعل النسيج الاجتماعي مهددا بحروب وصراعات مذهبية وطائفية وقومية وجهوية.. ونحن نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة، مليئة بتحديات خطيرة، تهدد استقرار الكثير من الدول والمجتمعات العربية، وتدخل الجميع في أتون نزاعات عبثية، تستنزف الجميع وتضعفهم، وتعمق الفجوة بين جميع الأطراف والمكونات..
وفي تقديرنا أن المشكلة الجوهرية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في بروز هذه المآزق والتوترات في المجال العربي، هي غياب علاقة المواطنة بين مكونات وتعبيرات المجتمع العربي الواحد..
فالمجتمعات العربية تعيش التنوع الديني والمذهبي والقومي، وغياب نظام المواطنة كنظام متجاوز للتعبيرات التقليدية، جعل بعض هذه المكونات تعيش التوتر في علاقتها، وبرزت في الأفق توترات طائفية ومذهبية وقومية.. فالعلاقات الإسلامية – المسيحية في المجال العربي، شابها بعض التوتر، وحدثت بعض الصدامات والتوترات في بعض البلدان العربية التي يتواجد فيها مسيحيون عرب..
وفي دول عربية أخرى، ساءت العلاقة بين مكوناتها القومية، بحيث برزت توترات وأزمات قومية في المجال العربي.. وليس بعيدا عنا المشكلة الأمازيغية والكردية والأفريقية.
وإضافة إلى هذه التوترات الدينية والقومية، هناك توترات مذهبية بين السنة والشيعة، وعاشت بعض الدول والمجتمعات العربية توترات مذهبية خطيرة تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي..
فحينما تتراجع قيم المواطنة في العلاقات بين مكونات المجتمعات العربية، تزداد فرص التوترات الداخلية في هذه المجتمعات.. لهذا فإننا نعتقد أن العالم العربي يعيش مآزق خطيرة على أكثر من صعيد، وهي بالدرجة الأولى تعود إلى خياراته السياسية والثقافية.. فحينما يغيب المشروع الوطني والعربي، والذي يستهدف استيعاب أطياف المجتمع العربي، وإخراجه من دائرة انحباسه في الأطر والتعبيرات التقليدية إلى رحاب المواطنة..
فإن هذا الغياب سيدخل المجتمعات العربية في تناقضات أفقية وعمودية، تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي..
وإن نزعات الاستئصال أو تعميم النماذج، لا تفضي إلى معالجة هذه الفتنة والمحنة، بل توفر لها المزيد من المبررات والمسوغات..
فدول المجال العربي معنية اليوم وبالدرجة الأولى بإنهاء مشاكلها الداخلية الخطيرة، التي أدخلت بعض هذه الدول في خانة الدول الفاشلة والبعض الآخر على حافة الحرب الداخلية التي تنذر بالمزيد من التشظي والانقسام..
فما تعانيه بعض دول المجال العربي على هذا الصعيد خطير، وإذا استمرت الأحوال على حالها فإن المجال العربي سيخرج من حركة التاريخ، وسيخضع لظروف وتحديات قاسية على كل الصعد والمستويات..
وإن حالة التداعي والتآكل في الأوضاع الداخلية العربية، لا يمكن إيقافها أو الحد من تأثيراتها الكارثية، إلا بصياغة العلاقة بين أطياف المجتمع على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات..
وإن غياب مقتضيات وحقائق المواطنة في الاجتماع السياسي العربي، سيقوي من اندفاع المواطنين العرب نحوانتماءاتهم التقليدية، وعودة الصراعات المذهبية والقومية والدينية بينهم، وسيوفر لخصوم المجال العربي الخارجين إمكانية التدخل والتأثير في راهن هذا المجال ومستقبله..
فالمجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات الإنسانية، التي تحتضن تعدديات وتنوعات مختلفة، لا يمكن إدارة هذه التعدديات على نحو إيجابي إلا بالقاعدة الدستورية الحديثة [المواطنة] كما فعلت تلك المجتمعات الإنسانية التي حافظت على أمنها واستقرارها..
فالاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمعات العربية، هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية..
وأي مجتمع عربي لا يفي بمقتضيات هذه المواطنة، فإن تباينات واقعه ستنفجر وسيعمل كل طرف للاحتماء بانتمائه التقليدي والتاريخي.. مما يصنع الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين مكونات المجتمع الواحد..
وفي غالب الأحيان فإن هذه الحواجز، لا تصنع إلا بمبررات ومسوغات صراعية وعنفية بين جميع الأطراف.. فتنتهي موجبات الاستقرار، ويدخل الجميع في نفق التوترات والمآزق المفتوحة على كل الاحتمالات..
لهذا فإن دولة المواطنة هي الحل الناجح لخروج العالم العربي من مآزقه وتوتراته الراهنة..
فدولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه، وهي التي تستوعب جميع التعدديات وتجعلها شريكة فعلية في الشأن العام، وهي التي تجعل خيارات المجتمع العليا منسجمة مع خيارات الدولة العليا والعكس، وهي التي تشعر الجميع بأهمية العمل على بناء تجربة جديدة على كل المستويات،وهي التي تصنع الأمن الحقيقي لكل المواطنين في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة..
والمجتمعات لا تحيا حق الحياة، إلا بشعور الجميع بالأمن والاستقرار.. لهذا فإن الأمن والاستقرار لا يبنى بإبعاد طرف أو تهميشه، وإنما بإشراكه والعمل على دمجه وفق رؤية ومشروع متكامل في الحياة العامة..
وهذا لا تقوم به إلا دولة المواطنة، التي تعلي من شأن هذه القيمة،ولا تفرق بين مواطنيها لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية..
فهي دولة الجميع، وهي التمثيل الأمين لكل تعبيرات وحراك المجتمع..
فالمجال العربي اليوم من أقصاه إلى أقصاه، أمام مفترق طرق..
فإما المزيد ن التداعي والتآكل، أو وقف الانحدار عبر إصلاح أوضاعه وتطوير أحواله، والانخراط في مشروع استيعاب جميع أطرافه ومكوناته في الحياة السياسية العامة.. فالخطوة الأولى المطلوبة للخروج من كل مآزق الراهن وتوتراته، في المجال العربي، هي أن تتحول الدولة في المجال العربي إلى دولة استيعابية للجميع، بحيث لا يشعر أحد بالبعد والاستبعاد.. دولة المواطن بصرف النظر عن دينه أو مذهبيه أو قومه، بحيث تكون المواطنة هي العقد الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف.. فالمواطنة هي الجامع المشترك، وهي حصن الجميع الذي يحول دون افتئات أحد على أحد..
وجماع القول: أن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، هي خشبة الخلاص من الكثير من المآزق والأزمات..
العالم العربي والحكم الرشيد
يعيش العالم العربي بكل دوله وشعوبه اليوم، الكثير من التحولات والتطورات المتسارعة.. حيث دشنت لحظة سقوط نظام بن علي في تونس عملية التغييرات والتحولات التي لا زال تأثيرها ممتدا ومتواصلا في كل أرجاء العالم العربي بمستويات وأشكال متفاوتة ومختلفة. ولا ريب أن ما يجري من أحداث وتطورات في بعض البلدان العربية، هو مذهل وغير متوقع وكل المعطيات السابقة، لا تؤشر أن ما حدث سيكون قريبا..
لهذا فإن كل هذه التطورات والتحولات هي بمستوى من المستويات مفاجئة للجميع..
فالفكر السياسي العربي وخلال العقود الثلاثة الماضية، كان يبشر بأن الثورات والانتفاضات الشعبية لم تعد هي وسيلة التغيير السياسي في المنطقة.. وإن ثورة 1979 م في إيران هي آخر الثورات الشعبية في المنطقة..
لذلك فإن النخب السياسية في العالم العربي بكل أيدلوجياتها وخلفياتها الفكرية، كانت تعيش حالة من اليأس تجاه قدرة الشعب أو الشعوب العربية من إحداث تحولات دراماتيكية في واقعها السياسي وواقع المنطقة بشكل عام.. ولكن جاءت أحداث وتطورات وتحولات تونس ومن بعدها مصر، لكي تثبت عكس ما كانت تروجه بعض الأيدلوجيات والنخب تجاه الجماهير وقدرتها على إحداث تغيير سياسي في واقعها العام.. والملفت للنظر والذي يحتاج إلى الكثير من التأمل العميق هو أن جيل الشباب، أي جيل الإعلام الجديد من الفيسبوك وتوتير ويوتيوب هو الذي قاد عملية التغيير، وهو الذي تمكن من تحريك الشارع العام في تونس ومصر.. فالجيل الجديد الذي كانت تصفه بعض النخب والجماعات، بأنه جيل ترعرع بدون قضية عامة يسعى من أجلها ويناضل في الدفاع عنها عكس أجيال الخمسينيات والستينيات، هو الذي قاد عملية التغيير، وبوسائله السلمية استطاع أن يحرك كل النخب وكل شرائح وفئات المجتمع الأخرى..
لهذا فإن ما حدث ويحدث في العالم العربي اليوم هو مذهل، وقد أنهى حقبة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث كان الغرب بنظر إلى شرائح المجتمعات العربية المختلفة بوصفها مشروع قائم أو محتمل للإنسان الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقوم بأعمال عنفية لا تنسجم وقيم الدين وأعراف العالم العربي وتقاليده الراسخة..
فما جرى في تونس ومصر، حيث حضر الشباب، ومارسوا حقهم بالتعبير عن الرأي، أنهى على المستوى الاستراتيجي حقبة بقاء الشباب العربي تحت تهمة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر..
فالنموذج الجديد الذي قدمه الشباب العربي في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا ومطلبيا هوأنه جيل يستحق أن يعيش حياة كريمة وأن تعاطيه الشأن العام عبر عنه خارج الأطر والأحزاب الأيدلوجية، وإنما مارسه بطريقته الخاصة، والمذهل في الأمر أن هذه الطريقة غير المتوقعة هي التي أتت أكلها، ونجحت في إحداث تغييرات وتحولات سياسية واجتماعية كبرى في أكثر من بلد عربي.. لهذا فإننا نعتقد أن المنطقة العربي بأسرها، تعيش مرحلة جديدة على أكثر من صعيد.. وما نود أن نؤكد عليه في هذا السياق هي النقاط التالية:
1 – إن المجتمعات والشعوب العربية تستحق حكومات وأنظمة سياسية متطورة ومدنية، وتفسح المجال للكفاءات الوطنية المختلفة للمشاركة في تنمية الأوطان العربية وتطويرها على مختلف الصعد والمستويات..
والذي يلاحظ أن الدول العربية التي كانت أولا زالت في منأى من موجة المطالبة بالإصلاحات والتغييرات، هي تلك الدول التي تعيش في ظل أنظمة وحكومات فيها بعض اللمسات أو الحقائق الديمقراطية، أو تمكنت من حل بعض مشاكل شعبها الاقتصادية والاجتماعية.. ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذه الموجة ستطال بشكل أو بآخر كل الدول والشعوب العربية..
ونحن نعتقد أن مسارعة الدول العربية في القيام بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، سيقلل من فرص خروج الناس إلى الشارع إلى المطالبة بحقوقهم.. وما جرى في تونس ومصر، يوضح بشكل لا لبس فيه أن المجتمعات العربية تستحق أوضاعا سياسية واقتصادية وقانونية أفضل مما تعيشه الآن..
2 - إن التحولات السياسية الكبرى التي تحققت في تونس ومصر، وموجاتهما الارتدادية في أكثر من بلد عربي، تجعلنا نعتقد وبعمق أن المشاكل الكبرى وبالذات على الصعيد السياسي متشابهة في أغلب الدول العربية.. فالحكومات والأنظمة السياسية في هذه الدول، هي أنظمة ذات قاعدة اجتماعية ضيقة، مع تضخم في أجهزتها الأمنية التي تمارس الإرهاب والقمع بكل صوره وأشكاله، مما زاد من الاحتقانات، وراكم من المشكلات البنيوية التي يعيشها المجتمع والدولة في هذا البلد العربي أو ذاك..
وبفعل هذه الحقيقة تمكنت هذه الدول التسلطية من إفراغ كل الأشكال والحقائق الديمقراطية الموجودة في أكثر من بلد عربي من مضمونها الحقيقي، حتى أضحت نموذجا صارخا للمقولة التي أطلقها المفكر المصري (عصمت سيف الدولة) بالاستبداد الديمقراطي.. فالأشكال الديمقراطية أصبحت عبئا حقيقيا على المجتمعات العربية ونخبها السياسية والاجتماعية والثقافية، لأنه باسم الديمقراطية يتم تأبيد السلطة واحتكار عناصر القوة وتستفحل من جراء هذا كل أمراض الاستبداد والديكتاتورية..
3 – إن الإصلاح السياسي الذي نراه أنه جسر عبور لكل الدول العربية إلى مرحلة جديدة، تؤهلها لتجاوز بعض مشكلاتها، ومعالجة أزماتها الداخلية، ويحصنها من خلال تطوير علاقة الدولة بمجتمعها تجاه كل التحديات والمخاطر.. أقول أن هذا الإصلاح السياسي هو ضرورة حكومية – رسمية، كما هو حاجة وضرورة مجتمعية..
فهو(الإصلاح) ضرورة للحكومات العربية لتجديد شرعيتها الوطنية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية ولكي تتمكن من مواجهة التحديات المختلفة.. كما هو(أي الإصلاح) ضرورة وحاجة للمجتمعات العربية، لأنه هو الذي يخرج الجميع من أتون التناقضات الأفقية والعمودية الكامنة في قاع المجتمعات العربية، وهو الذي يصيغ العلاقة بين مختلف المكونات على أسس الاحترام المتبادل والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات..
ومن المعلوم أن الانغلاق في السلطة سمة من سمات الدولة التسلطية (على حد تعبير خلدون النقيب في كتابه: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر – دراسة بنائية مقارنة)..
وهو يعبر عن حالة غير طبيعية في مسيرة الدولة الحديثة، هي حالة التماهي بين السلطة والدولة.. لهذا فإن العالم العربي بحاجة إلى أنظمة سياسية حديثة تستجيب لشروط العصر ويتناسب والدينامية الاجتماعية المتدفقة..
4 – إن التجارب والتحولات السياسية الكبرى، تجعلنا نعتقد أن الشيء الأساسي الذي يجعل عمر الدول طويلا وممتدا عبر التاريخ، ليس هوترسانتها العسكرية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وإنما هوقبول ورضا الناس بها.. إذ أن كل تجارب الدول عبر التاريخ الطويل تثبت بشكل لا لبس فيه أن حكم الناس بالإكراه، قد يطول، إلا أنه لا يدوم.. وإن عمر الدول واستمرارها مرهون بقدرة هذه الدول على تحقيق رضا وقبول الناس بها.. بمعنى أن الدول حتى ولو كانت إمكاناتها البشرية محدودة وثرواتها الطبيعية والاقتصادية ومتواضعة، إلا أن رضا الناس بها، وقبول الشعب بأدائها وخياراتها، فإن هذا الرضا والقبول يجبر الكثير من نواقص الدولة الذاتية أو الموضوعية، ويمدها بأسباب الاستمرار والديمومة..
فالذي يديم الدول ويوفر لها إمكانية الاستمرار، هومشاركة الناس في شؤونها المختلفة، واحتضانهم إلى مشروعها، وشعورهم بأنها (أي الدولة) هي التعبير الأمثل لآمالهم وطموحاتهم المختلفة..
وما جرى في تونس ومصر من أحداث وتحولات سياسية سريعة، يؤكد هذه الحقيقة.. فكل المؤسسات والأجهزة العسكرية، لم تستطع أن تدافع عن مؤسسة السلطة التي يرفضها الناس ويعتبرونها معادية لهم في حياتهم اليومية وتصوراتهم لذاتهم الجمعية والمستقبلية.. لهذا فإننا نعتقد إن إسراع الدول في إصلاح أوضاعها وتطوير أنظمتها القانونية والدستورية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية وتجديد شرعيتها السياسية، كل هذه العناصر تساهم في إعطاء عمر جديد لهذه الدول..
فتحريك عجلة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولنا العربية، أضحى اليوم من الضرورات والأولويات، التي تحول دون دخول دولنا العربية في أتون المشكلات والأزمات التي تعوق من مسيرتها ودورها في الحياة الوطنية والقومية والدولية..
ومن المؤكد أن اقتراب الدول العربية من قيم ومعايير الحكم الرشيد، هو الذي سيعيد الاعتبار إلى المنطقة العربية، وهو السبيل المتاح والممكن اليوم للخروج من العديد من الأزمات والمآزق على الصعيدين الداخلي والخارجي..
وحده الحكم الرشيد بكل قيمه ومضامينه ومقتضياته، هو الذي سيعيد العالم العربي إلى حركة التاريخ، ودون ذلك ستبقى المنطقة بكل ثرواتها البشرية والاقتصادية بعيدا عن القبض على أسباب التقدم والاستمرار الحضاري..
أيها العرب... حافظوا على دولكم
لو تأملنا في مآل الأحداث والتطورات التي تجري في المنطقة العربية على أكثر من صعيد، لوصلنا إلى قناعة عميقة مفادها: أن هذه الأحداث تتجه صوب إسقاط مفهوم وواقع الدولة في المنطقة العربية، لصالح إمارات أو ولايات لا تتعدى إدارة للأوضاع المحلية، بحيث تتحول كل مدينة في المنطقة العربية إلى ولاية قائمة بذاتها، لها علمها الخاص وجيشها وحكومتها.
مما يعني الترحم على مرحلة سايكس بيكو، والدخول في مرحلة تجزئة المجزء وتأسيس حكومات وأنظمة سياسية على مقاس الانتماءات الدينية والمذهبية والقبلية المنتشرة في ربوع العالم العربي.
وتباشير هذه المرحلة بدأت في الرقة ودير الزور والموصل والعمل المتواصل لتعميم هذه النماذج الكارثية على المنطقة العربية.
من هنا فإن المعطيات السياسية القائمة اليوم في المنطقة العربية، تتجه صوب [اللادولة] وهي حالة إذا تعممت في العالم العربي، فإن هذا يعني دخول العرب جميعا في متاهة طويلة، ستمارس فيها كل أشكال الفوضى والقتل على الهوية وضياع الحقوق بكل مستوياتها.
وعليه فإننا ندرك أخطاء وخطايا الكثير من الدول في المنطقة العربية، ونعتبر أن بعض خيارات وسياسات هذه الدول هي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.
ولكن البديل الذي تتجه إليه الأحداث والتطورات أكثر خطرا وكارثية على الواقع العربي من وجود دول تحافظ في المجمل على النظام العام وتحول دون الاقتتال الأهلي.
فالدول مهما كانت إرتكاباتها وأخطاؤها وسيئاتها، إلا أنها أفضل بكثير من مرحلة [اللادولة] حيث تعم الفوضى وتسري كل أشكال النهب والتعدي على الحقوق.
من هنا فإننا نرى أن الراهن العربي في أغلب دوله ومناطقه يتجه صوب: إما مرحلة بقاء الدولة القائمة بكل أخطاءها وسيئاتها أومرحلة [اللادولة] حيث تتشكل ولايات وإدارات محلية على مقاس الانتماءات المذهبية والقبلية والدينية.
ومن المؤكد أن تعميم نموذج [اللادولة] يساوي تغييب دائم للعرب على كل المستويات الإقليمية والدولية، وانتصار تاريخي للمشروع الصهيوني في المنطقة ودخول العرب في مرحلة من المطالبة بإصلاح دولهم وخياراتها السياسية والاقتصادية إلى مرحلة بقاء الدول ووظائفها الأولية.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها العديد من الدول، حيث تحولت من دولة واحدة إلى مجموعة دويلات متحاربة مع بعضها البعض بدون أي أفق للحل والمصالحة من الضروري التأكيد على النقاط التالية:
1ـ إننا ندرك أهمية وجود مؤسسة الدولة كناظم أساسي لكل الأمم والشعوب ونعتبر أن غياب مؤسسة الدولة، يعني على المستوى العملي الوقوع في براثن الفوضى والاقتتال الداخلي.
ولكن صمود هذه الدولة أمام تطورات المرحلة وتداعياتها الخطيرة، يتطلب من القائمين على أمر الدول في كل المنطقة العربية إلى إصلاح وتطوير بعض أمورها، حتى لا يكون الطريق الوحيد أمام بعض العرب [وهو طريق غير مبرر على كل حال] هو إسقاط الدولة وبناء أوضاع سياسية واجتماعية على مقاس المذهب والقبائل والعشائر.
ومن الضروري في هذا السياق أن تدرك جميع النخب والفعاليات، أنه مهما كان سوء الدولة وخياراتها، إلا أنها أفضل من مرحلة تشظي الدولة وإنهاء وجودها كناظم ومحافظ على المصالح العامة.
ولو تأملنا في أحوال الناس والشعوب الذين عاشوا مرحلة غياب الدولة وانخرطوا في مرحلة الفوضى وتعدد الرايات والمجاميع المسلحة التي تدير مدنا وأحياءا لاتضحت بعمق حقيقة ما نصبو إليه.. فلوكان الخيار دولة جائرة وبها عيوب الدنيا إلا أنها تحافظ على الحدود الدنيا للنظام العام ومصالح الناس، وبين تغييب الدولة وكل مكون أو تعبير يدير نفسه بنفسه، فإننا لا شك نفضل الخيار الأول، لأنه في الحدود الدنيا يحول دون الفوضى وانتشارها.
من هنا فإننا ندعو كل القوى الأهلية التي تحارب حكوماتها وأنظمتها السياسية إلى ضرورة الالتفات إلى طبيعة المخطط الذي يستهدف المنطقة، حيث تدمير الجيوش العربية وتخريب البنية التحتية للدول والمجتمعات وتغذية مستمرة للإحن المذهبية والقبلية والجهوية،
مما يفضي على المستوى العملي إلى انهيار الدولة في المنطقة العربية.
فنحن مع إصلاح الأوضاع السياسية في كل دول المنطقة العربية، ولكننا لسنا مع تدمير الدول وتخريب عناصر القوة والاستقرار فيها وفي مجتمعاتنا. لذلك ثمة ضرورة للحفاظ على الدولة لوقف الانحدار وللحؤول دون التشظي الدائم في المنطقة العربية.
2ـ بعيدا عن أحن التاريخ وصعوبات الراهن ومأزقه والتباساته، ثمة حاجة تاريخية في المنطقة العربية والإسلامية لصياغة تفاهم جديد بين السنة والشيعة في المنطقة العربية، يستهدف هذا التفاهم إنهاء حالة الاحتراب القائمة في أكثر من بلد عربي، وإرساء قواعد وأسس ومبادئ لعلاقة تفاهم جديدة تجنب المنطقة بأسرها احتمالات الحروب المذهبية المتنقلة والتي لا رابح منها سوى أعداء الأمة المتربصين براهنها ومستقبلها.
لأن بقاء حالة الانقسام الحاد والاحتراب المستمر، سيجعل المنطقة بأسرها مكشوفة أمنيا وسياسيا، وهذا الانكشاف لن يخدم إلا أعداء الأمة.
وندرك سلفا أن كل طرف يحمل الطرف الآخر أخطاء وخطايا الراهن، ولكن من الضروري أن يدرك الجميع: أن السنة والشيعة في المنطقة العربية محكومون بالتفاهم مهما كانت الصعوبات والمشاكل. لأن الخيار الآخر المتاح إذا غابت حقائق التفاهم هوانقسام المنطقة أفقيا وعموديا ودخولها في مرحلة انعدام الوزن من جراء حالة التوترات المذهبية المفتوحة على كل الاحتمالات.
فكما تمكن الأوروبيون من تجنيب منطقتهم ويلات الحروب باتفاق وتفاهم [وستفاليا] نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تفاهم سني ـ شيعي يجنب المنطقة بأسرها ويلات الحروب المذهبية.
3ـ ويبقى الخيار الأسلم للجميع، هو خيار المصالحة بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية، بحيث تنصت الدولة إلى حاجات ومتطلبات المجتمع وتعمل على تلبيتها وفق إمكاناتها وقدراتها.
وهذا الخيار بمتوالياته السياسية والاجتماعية، سيجنب المنطقة الكثير من المخاطر، كما أنه سيجدد في شرعية النظام السياسي ويوسع من قاعدته الاجتماعية وسيفك وينفس حالة الاحتقان التي قد تكون سائدة في بعض دوائر المجتمع..
ومادمنا نتحدث عن مصالحة، فإننا نتحدث عن ضرورة التسوية السياسية بين الطرفين، بحيث يتم التنازل المتبادل، من أجل إخراج المنطقة من احتمالات السقوط في مهاوي العنف الأعمى.. وخلاصة القول: أن المنطقة العربية لعوامل ذاتية وأخرى دولية، تتعرض إلى مشروع خطير يستهدف تفجير المجتمعات العربية من الداخل، وإسقاط دولها وتأسيس أمارات ودويلات غير قابلة للحياة إلا بتعميم لغة القتل وحقائق العنف العبثي. وإن ملامح هذا المشروع بدأت بالبروز في العراق وسوريا، لذلك ثمة حاجة عربية عميقة لليقظة والوقوف في وجه هذا المخطط والمشروع الذي لو تحقق سيجعل الجميع يترحم على لحظة سايكس بيكو. لذلك فإن دعوتنا الصريحة للعرب جميعا أن حافظوا على دولكم الوطنية، وامنعوا إسقاطها وانهيارها.. فمهما كانت سيئات هذه الدول، إلا أنها أفضل من لحظات اللادولة حيث يتم تعميم الفوضى والقتل.


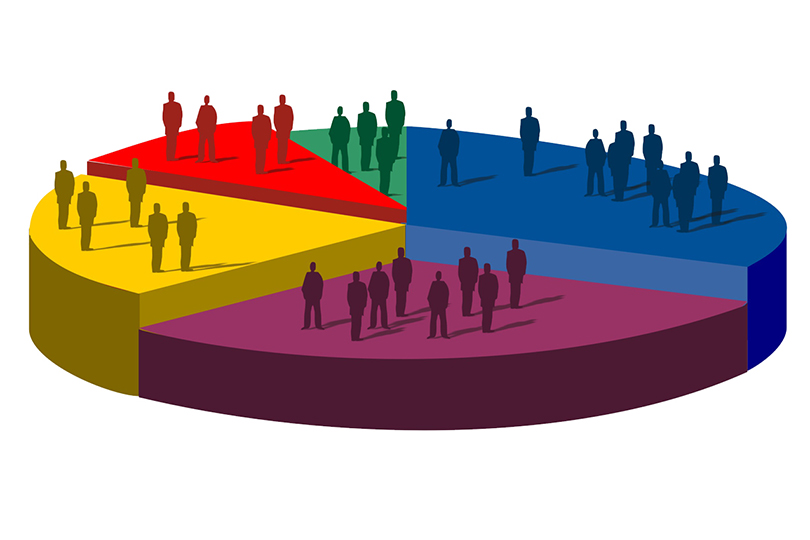

اضف تعليق