|
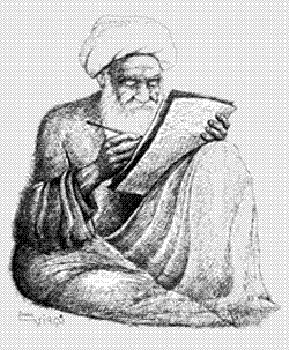
من أهمية الثورة الى ضرورة قراءتها:
ثورة العشرين في العراق، تعد من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ
العراق الحديث، فهي منعطف تاريخي وسياسي واجتماعي بالنسبة للشعب
العراقي، وبداية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، بل لعلنا لا نبالغ إذ
قلنا إنها أهم حدث تاريخي منذ سقوط بغداد على يد المغول، وما تبعه من
موجات غزو واحتلال متلاحقة امتدت عبر قرون طويلة.
هذه الأهمية لثورة العشرين في العراق تنبع من الظروف التي كانت
محيطة بالثورة والتي رافقت اندلاعها ومن النتائج التي انعكست على
مستقبل العراق دولة وشعبا، ويمكن نقرأ أهميتها كما يأتي:
· إنها أول ثورة وطنية وحدت الشعب العراقي منذ الغزو المغولي بريفه
ومدنه وقبائله ومكوناته الاجتماعية.
· إنها أول ثورة أطاحت بالاستعمار البريطاني ويصفها الإمام السيد
محمد الشيرازي بأنها الثورة التي هزت العرش البريطاني[2] (وكان القوة
رقم واحد بعد الحرب العالمية الأولى) وأجبرته على الاعتراف بالعراق
كدولة بعد 4 سنوات من الاستعمار البريطاني و400 سنة من السيطرة
العثمانية البغيضة التي أعادت العراق من شعب متحضر الى مجتمع بدائي في
كل مجالات الحياة، فقد رأت الحكومة البريطانية، ان سياسة القمع والشدة،
التي سار عليها (السير اي. تي. ولسن)، (نائب الحاكم الملكي العام في
العراق) لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة حاسمة في قطر كالعراق، برهنت الأيام
على ان أبنائه لن يرضخوا لأي استعباد أو استرقاق، فقررت إبدال الحاكم
المشار اليه بالسر برسي كوكس، الذي رافق الحملة البريطانية في فتحها
للعراق.
· إنها أطاحت بالمخطط الاستعماري البريطاني الذي كان مرسوم للعراق
وهو استعمار العراق وتحويله الى مستعمرات اصغر كإمارات الخليج
ومشيخاتها، أي حكم العراق حكماً استعمارياً استيطانياً، وفصل البصرة عن
العراق وربطها بالهند، وجلب عدة ملايين من الهنود إلى العراق لتهنيده،
وتغيير ديموغرافيته، وعزله عن محيطه، وتسمية خليج البصرة بالخليج
الإنكليزي- الهندي. وقد سجل التاريخ اعترافات وشهادات من قبل الحكام
الإنكليز وعراقيين في العراق على أهمية ثورة العشرين، ودورها في تأسيس
الدولة العراقية، إذ تقول المس بيل في أوراقها بهذا الخصوص: "لم يكن
يدور بخلد أحد ولا حكومة صاحبة الجلالة، أن يمنح العرب مثل الحرية التي
سنمنحهم إياها الآن كنتيجة للثورة". [3]
· إنها وحدت الشعب العراقي تحت قيادة شعبية موحدة من كافة فئات
الشعب العراقي تحت إشراف المرجعية الدينية بقيادة المرجع الحائري
الشيرازي[4] الذي أعلن الإذن الشرعي للبدء بالثورة في فتواه التاريخية
وأشار فيها:
" بسم الله الرحمن الرحيم، مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين.
ويجب عليهم، في ضمن مطالبهم، رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل
بالقوة الدفاعية إذ امتنع الإنكليز عن قبول مطاليبهم. محمد تقي الحائري
الشيرازي" [5].
إن هذه الفتوى كانت بمثابة الركيزة الأساسية في انطلاق العمل
الثوري ضد الاحتلال، إذ أُيدت من قبل خطباء وعلماء كربلاء ومنهم محمد
حسين المازندراني ومحمد صادق الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي، ومحمد
علي الحسين وغلام حسين المرندي ومحمد رضا القزويني ومحمد إبراهيم
القزويني ومحمد الموسوي الحائري وعلي الشهرستاني وهادي الخرساني وجعفر
الهر وكاظم البهبهاني وفضل الله وعلي الهادي الحسين [6].
كما وتداعى على ضوء هذه الفتوى العديد من علماء النجف الذين اجتمعوا
وقرروا توجيه رسائل إلى رؤساء عشائر الفرات وخصوصاً عشائر الرميثة
والسماوة يحثوهم فيها إلى الثورة وكان أبرز الذين حضروا هذا الاجتماع
المهم الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ الجواهري والشيخ حسين كاشف
الغطاء والشيخ رضا راضي والشيخ جواد الشبيبي ونجل شيخ الشريعة([7]).
وكما عقد اجتماع آخر في منطقة المشخاب القريبة من النجف يوم 29 حزيران
1920 حضره عدد كبير من سادات ورؤساء الفرات الأوسط وقرروا فيه إعلان
الثورة وأرسلوا عنهم مندوبين لإطلاع العلماء ورجال الدين في النجف على
قراراتهم.
ومن هنا نعرف أن الثورة كانت بدفع، وتخطيط، وتحريض، وفتاوى المرجعية
الدينية الشيعية بالتحالف مع العشائر الشيعية وشيوخها في الوسط والجنوب
التي قدمت من الضحايا حسب ما قدَّرها الجنرال هالدين، أحد القادة
العسكريين البريطانيين آنذاك، بـ 8450 بين قتيل وجريح، مستنداً في
تقديره هذا على عدد القتلى الذين عُثرَ على جثثهم، وعلى التقارير
الواردة من مختلف المصادر، وعلى سجلات الدفن في كربلاء والنجف. ومعظم
الخسائر كانت من عشائر منطقة الفرات الأوسط، وهذا عدد كبير في تلك
الفترة التي كان عدد نفوس العراق نحو مليونين ونصف المليون نسمة [8].
مر وقت طويل على اندلاع الثورة العراقية الكبرى، ما يقارب من قرن من
الزمن، ومرت بالعراق الكثير من الثورات، ومؤكدا إنها انطلقت من ظروف
اجتماعية واقتصادية مغايرة لواقعنا الراهن، لذا فالسؤال الذي يبدو
ملحا: ما هي الضرورة في قراءة ثورة العشرين؟
إن انعكاسات ثورة العشرين قد أثرت بشكل كبير في طبيعة الحكم في
العراق وشكل الدولة. ومن أهم هذه الانعكاسات:
أولا: تقرير شكل الحكم وطبيعة تشكيل الدولة: بعد أن تسنى للمحتلين
البريطانيين إعادة تثبيت سيطرتهم على العراق، وقمع ثورة العشرين، دعا
تشرشل وزير المستعمرات البريطاني الحكومة العراقية الى حضور مؤتمر في
القاهرة في 12 آذار 1921، لبحث المستقبل السياسي للعراق. وقد حضر وفد
عن الحكومة العراقية التي شكلها المندوب السامي، ووفد عن الحكومة
البريطانية، يضم المسؤولين الكبار في الإدارة البريطانية في العراق،
والممثلون البريطانيون في بلدان الشرق الأوسط، لبحث مستقبل العراق، وقد
جرى في هذا المؤتمر بحث مستقبل العراق السياسي، تحت ظل الانتداب
البريطاني وكانت أهم المسائل التي جرى بحثها:
1 ـ اختيار شكل نظام الحكم في العراق، وقد تم خلال البحث الاتفاق
على جعل العراق دولة ملكية دستورية، وترشيح الأمير فيصل ابن الحسين
ليكون ملكاً على العراق.
2 ـ جرى بحث كيفية تخفيض النفقات البريطانية اللازمة لإدامة السيطرة
البريطانية على العراق، حيث سببت ثورة العشرين خسائر مادية جسيمة
لبريطانيا، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح والتي جاوزت 20
آلفاً من الجنود والضباط البريطانيين.
3 ـ جرى بحث موضوع تشكيل جيش عراقي قوامه 15 ألف جندي، وإناطة الأمن
الداخلي به.
4 ـ جرى بحث وضع قوات الليفي البريطانية في العراق، وتقرر زيادة
عددها من 4000 الى 7500 فرداً، على أن تقوم الحكومة البريطانية
بنفقاتها، وجرى الاتفاق على مرابطة 6 أسراب من الطائرات الحربية في
القواعد البريطانية بالعراق، ثم تبادر الحكومة البريطانية بسحب قواتها
تدريجياً من العراق، وعلى اثر انفضاض المؤتمر، تمت دعوة الأمير فيصل
لتولي الملك في العراق.
ثانيا: إضعاف ومحاصرة المرجعية الدينية في كربلاء ثم النجف وتهميش
الأغلبية: ويشير الإمام الشيرازي الى إن: (الثورة قد جرّت الويلات
والمآسي على الشعب العراقي إلى يومها هذا)[9] ولمعاقبة قادة الثورة،
ومكافأة الذين وقفوا ضدها من العراقيين، يقول الميجر ديكسون وهو بمثابة
الحاكم العام للفرات الأوسط: "إن النية يجب ان تتجه لتعيين الرجال ذوي
الآراء المعتدلة دون غيرهم في المناصب السياسية، وضرب واضطهاد عناصر
الثورة في حالة وجودها". كما وأوضحت المس بل وبانفعال شديد موقفها من
الشيعة بالذات قائلة: "أما أنا شخصياً فأبتهج وأفرح أن أرى الشيعة
الأغراب يقعون في مأزق حرج. فإنهم من أصعب الناس مراساً وعناداً في
البلاد"[10].
ومن هنا نعرف أن الثورة أثارت مشاعر العداء والضغينة عند الإنكليز
ضد الشيعة ولم يحاولون إخفاءها. كما ولاحظ استخدام المس بيل لكلمة
(الأغراب) في وصف الشيعة إذ منذ ذلك الوقت بدأت حملة اعتبار الشيعة
أجانب في العراق لتبرير حرمانهم من حق المشاركة في الدولة.
ولم يكتف الإنكليز بزرع لغم الطائفية في الدولة الحديثة عند تأسيسهم
لها، بل عملوا على تكريس تهمة الطائفية ضد كل من يشكو منها، إذ يقول
الدكتور سعيد السامرائي في عقدة الاتهام بالطائفية في كتابه القيم
(الطائفية في العراق) ما نصه: "من ضمن الخطة التي وضعها الإنكليز
لتدمير نفسية الشيعة العراقيين عندما أسسوا الدولة العراقية مجبرين،
نتيجة للثورة العراقية التي فجرها وقادها وتحمل معظم تضحياتها الشيعة
عام 1920، هي محاصرتهم بتهمة الطائفية، وذلك كي يردوا بمحاولة نفيها.
ومحاولة النفي هذه ستكون:
أولاً: بتقديم آيات الولاء للدولة المضادة للأغلبية الشيعية بمختلف
الوسائل التي في أبرزها التحيّز ضد الشيعي في التعيينات والترقيات
والترشيحات والإيفادات والبعثات وصولاً إلى مشاركة الدولة وطاعتها بما
تقوم به من اضطهاد طائفي ضد الشيعة أنفسهم، كما ونجد ذلك واضحاً
وجليّاً وبطريقة عملية عند تشكيل أوَّل حكومة عراقيّة على أثر إنتصار
الثورة، فقد تشكلت أول حكومة عراقية برئاسة عبد الرحمن النقيب وضمت
تسعة وزراء؛ سبعة منهم من أبناء العامّة، وواحد من الشيعة، وآخر من
الأقلِّيّات وهو يهودي يدعى (ساسون حسقيل)، وقد أعطي وزارة الماليّة،
وبذا تفوَّق على الوزير الشيعي[11].
وثانياً: بالوقوف ضد كل شيعي يرفع صوته صارخاً بالمظلومية الواضحة
للشيعة خشية أن تثبت تهمة الطائفية لأنهم قد أدخلوا في روعهم أن طلب
الإنصاف هو تحيّز مذهبي". [12]. علماء الشيعة ومراجعها وقاداتها لم
يكونوا ببعيدين عن هذه السياسة الطّائفيّة، بل ان الأمر بدا جليّاً
أمامهم، فجاهدوا مُحاولين كشف ذلك للأمّة من جهة، ومُخاطبة الحكومة،
ومطالبتها بوضع حَدّ لهذه الإستراتيجيّة الاستعمارية من جهة أخرى، فعلى
سَبيل المثال بعث الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء عام (1354هـ) بمذكرة
إلى الملك غازي؛ أبدى إستياءه من تقييد حريّة الصحافة والتمييز الطائفي
الذي لحق بالأكثريّة الشيعيّة، وتجريدها من هويتها الوطنيّة، ودعا إلى
إلغاء الضرائب، وتقليل عدد المُوظّفين في الدوائر الحكوميّة، وتهذيب
مناهج وزارة المعارف، وجعل الدروس الدينيّة كسائر الدروس الأخرى،
ومُراعاة العدالة في تقسيم المراكز الصحّيّة والعمرانيّة بين أبناء
الشعب، وخاصّة في مدن الجنوب والعتبات المُقدّسة[13].
على أي حال، قرر الإنكليز تشكيل حكم أهلي في العراق وإعطاء المناصب
لأولئك الذين ناصبوا الثورة العداء. فقد تأسس الحكم الوطني أو الأهلي
في العراق عام 1921 بتخطيط من الحكومة البريطانية، واختير السيد عبد
الرحمن النقيب رئيساً للحكومة الأهلية الأولى، مكافئة لإخلاصه
للمحتلين، إذ ينقل المؤرخ مير بصري عن النقيب قوله: "إن الإنكليز فتحوا
هذه البلاد وأراقوا دماءهم في تربتها، وبذلوا أموالهم من أجلها، فلا بد
لهم من التمتع بما فازوا به".[14]
وهذا هو ديدن العملاء في بيع الوطن مقابل امتيازات السلطة والتي
عادة ما تكون خدمة للأجنبي المستعمر وقهر الشعب وسلبه حقوقه وثرواته.
ثالثا: موقف الدولة العراقية الوليدة (1920-2003) من الأغلبية
ومرجعيتها: إن حرب الجهاد وثورة العشرين قد بينتا بوضوح ما للمرجعية
الدينية الشيعية من نفوذ قوي في البلاد وتأثيرها الروحي على الجماهير.
فكلمتهم مسموعة وبذلك كانوا يشكلون خطراً على سلطة الاحتلال، ومن بعدها
على سلطة الحكم المرتبط بالدوائر الاستعمارية، إذ ان وجود مؤسسة دينية
(شيعية) على هذا القدر من الاستقلال والنشاط السياسي، يشكل خطراً على
السلطة العراقية الوليدة التابعة للهيمنة البريطانية الاستعمارية
ولتأثيرات الدول الأجنبية في ادوار أخرى.
ومن تلك الإجراءات التي اتخذت بعد تنصيب الملك فيصل تهجير علماء
الشيعة ونفيهم، ويذكر الإمام الشيرازي إن: (وبعد فترة أخذ الحكم
الطائفي بمحاربة الشيعة وحوزاتها وعلمائها، فأمر فيصل (صالح حمام)[15]
بنفي مراجع التقليد ورجال الدين من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة إلى
إيران، وفي اليوم المحدد لرحيلهم ذهب الناس لوداعهم من منطقة المخيم في
كربلاء المقدسة إلى باب بغداد (وهي نهاية كربلاء على طريق بغداد) وكانت
حالة الحزن والبكاء والتضرع بادية عليهم وهم يودعون العلماء) [16].
لذا سعت حكومات الأقلية المتعاقبة إلى اجتثاث سلطة المجتهدين الشيعة
والمؤسسات الشيعية في البلاد. بالطبع ليس من منطلقات عقائدية بل لان
تلك الحكومات بأشكالها العسكرية والقومية والحزبية كانت تابعة لهيمنة
الدول الأجنبية لتحقيق مصالحها الانوية والحزبية ضد مصالح الشعب
العراقي، وهي في نوبات قلقها المستمر من المرجعية الشيعية نراها لا
تفتا تحاربها بشتى الوسائل الوحشية والدموية ليس لاختلاف فقهي أو
تشريعي بل لأنها أدركت ومنذ ولادة الوعي الوطني المعاصر للشعب العراقي
إن المرجعية لسان الشعب العراقي حينما يظلم وتصادر حريته، وهي منطلق
لثوراته ومرتكز لضمان كرامته وسيادته.
من أهمية الخبرة الى إدارة الثورة:
يعيد الإمام السيد محمد الشيرازي الخبرة الى عدة مستويات معرفية
منها النقلي والعقلي، ليؤكد على سمة الاكتساب والتحصيل كسمة معرفية
مميزة للخبرة، مع إشراك التجربة كنسغ متجذر في تحصيل الخبرة[17].
ويدفع الإمام الشيرازي الخبرة في عنوان العلم [18]، ليفاجئ القارئ
بوجود علم الخبرة في امة ما تزل لا تكترث للخبرة في جميع المجالات فكيف
بالخبرة السياسية.
هنا يدخل الشيرازي الخبرة كسياق يحتوي الخطاب السياسي ويوجهه..
ليعيد فاعلية الخطاب السياسي ليس من حيث انتماءاته أو هويته أو
اتجاهاته، بل من حيث ما يكتسبه من خبرة تزيد من قدراته على التفاعل
والتعامل مع الموقف السياسي.
ثم يقدم لنا نصوصا من السنة للنبي والأئمة المعصومين درجنا على
قراءتها ضمن سياقاتها ضمن التاريخ السياسي للإسلام من منظور المواجهة
أو الانتصار أو تأصيل الحق لكن السيد الشيرازي يقدمها ضمن منظور فاعلية
الخبرة (السياسية) في العمل السياسي.
ومنها: عند ما طرح سلمان الفارسي (رضوان الله عليه) على النبي (صل
الله عليه واله وسلم) فكرة حفر الخندق في واقعة الأحزاب[19]، فهذه
الفكرة والخبرة الحربية كانت عبارة عن تجربة عاشها سلمان (رضوان الله
عليه) في الزمن الماضي في بلاد الفرس، فأقرها الرسول (صل الله عليه
واله وسلم) وطبّقها حيث أمر بحفر الخندق [20].
ويؤكد الشيرازي على ان: (أبرز مصداق في هذا المجال ـ أي مجال الخبرة
الصحيحة للتأسي بهم ـ هو رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) وأهل
البيت الطاهرون (عليهم السلام) حيث جعلهم الله تعالى أسوة لنا، فيلزم
علينا أن نتعلم من علومهم وخبراتهم، فإن تعدد أدوارهم واختلاف أزمانهم،
لم يؤثر على وحدة الهدف، بل كان كل إمام يكمّل خطوات الإمام الذي سبقه،
ويشيد أركاناً وأسساً إسلامية ناصعة، ثم يأتي الإمام الذي يليه ليكمل
الدور، وهكذا كان عمل أئمتنا الأطهار (عليهم السلام)، بل هكذا كانت
مسيرة الرسل والأنبياء (عليهم السلام) والأديان السماوية مع البشرية،
فكل نبي كان يكمل ما قام به النبي الذي قبله، إلى أن تكامل الدين في
آخر صورة وطُرح للعالمين على يد خاتم النبيين محمد (صل الله عليه واله
وسلم)، ونحن من الضروري أن نعمل طبق هذا الأسلوب وهذا المنهاج
الصحيح)[21].
ويستعرض لنا السيد الشيرازي قبس من الأحاديث النبوية وأقوال الأئمة
عليهم السلام لتدهش القارئ بمجالات من الحكمة ظلت قرون طويلة لا تلتفت
اليها الأمة، دون ان تعي ان امتلاك الحق لا يحقق وحده الانتصار للامة
لا على انحدارها الداخلي ولا على تقهقرها الخارجي، ومن تلك الحكم:
قال رسول الله: (العاقل من وعظته التجارب)[22].
قال أمير المؤمنين: (عند الخبرة تنكشف عقول الرجال) [23].
وقال: (إنما البصير من سمع ففكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر) [24].
وقال: (واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، ومعرفة
العبرة، وسنة الأولين، فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة، ومن تأول الحكمة
عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة، فكأنما كان مع
الأولين واهتدى إلى التي هي أقوم، ونظر إلى من نجا بما نجا، ومن هلك
بما هلك، وإنما أهلك الله من أهلك بمعصيته، وأنجى من أنجى بطاعته)
[25].
ويعد الامام الشيرازي ان امتنا بالرغم من وجود المنهج الإسلامي الذي
يحث على اكتساب الخبرة في شتى المجالات، ويفرض على أهل العلم تنمية
قدراتهم بالخبرة، ويقدم آلاف الوقائع والمواقف التي تؤلف منهاجا
متكاملا للتدريب والتنمية لتطوير أداء الفرد والجماعة والأمة، وبالرغم
من وجود آلاف الحكم التي تؤلف نهجا تربويا في بناء الإنسان الخبير إلا
إن السيد الشيرازي يرى إن امتنا ما تزل متخلفة اليوم في عالم الخبرة
وتفتقد الى علم الخبرة بصورة عامة في الحياة وفي المجال السياسي على
وجه الخصوص.
ويلتفت الإمام الشيرازي الى إن حاجة الأمة الى الخبرة الخارجية
والاتكاء على الخارج في ما نحتاجه من الخبرات يجر الأمة الى هيمنة
خارجية او تلاعب بحقيقة صلاحية الخبرات التي نستهلكها من الخارج،
فيقول: (وواحدة من أبرز مشاكل بلادنا الإسلامية هي هذه، أي عدم وجود
خبراء محليين في مستوى عال من الخبرة، فهي فقيرة في هذا الجانب؛ ولذلك
فهي تستعين بالخبراء الأجانب، وجرت عادة الاستعمار أن يجنّد هؤلاء
الخبراء للعمل معه ولغير الغاية المنشودة منهم، فيجعل من بعض هؤلاء
الخبراء جواسيس، يتجسسون على البلاد التي يعملون فيها، ويرفعون
المعلومات الخطيرة عن ذلك البلد)[26].
ويرى الإمام الشيرازي إن غياب الخبرة يؤدي الى الانتكاسة وضرب مثلا
بذلك نتائج ثورة العشرين لضعف الخبرة السياسية، فالانتكاسة تحدث: (تأتي
الانتكاسة عادة من قلة الخبرة، وبسبب أخطاء في العمل، أو أخطاء في
التطبيق أو النظرية، وما لم يتشخص الخطأ، فإن الأمور سوف تجري حتى تصل
إلى الانتكاسة، فإذن علينا أن ندخل الميدان العملي، ونأخذ بالأسباب
الصحيحة التي تعطينا النتائج الصحيحة، ونحاول أن نتعامل مع الخطأ
والسلبيات بروح عالية، وأمل كبير، وجدية متواصلة، وعزم ثابت، حتى نصل
إلى المراد)[27].
لكن الإمام الشيرازي يؤكد على انه: (لابد أن يعرف الجميع أن
الانتكاسة في أي طريق ليست نهاية له، وليست مدعاة للتنازل، ولا
الابتعاد الكلي أو الانسحاب التام عن العمل وإلغاء الأهداف، ونثر
الأتعاب والجهود مع الريح؛ بل إن الانتكاسة هي عبارة عن عثرة وسط
الطريق، يمكن عبورها وتجاوزها بصمود الإرادة وقوتها؛ مضافا إلى التوكل
على الله وطلب العون منه، لذا لابد لنا أن نأخذ من مجموع الانتكاسات
التي نمر بها، أو التي مر ويمر بها الآخرون، دروساً في عملنا وسيرنا
نحو تحقيق الأهداف..) [28].
ويحول الإمام الشيرازي الانتكاسات التي تمر بها الأمة الى مصدر
للخبرات من خلال دراستها والاستفادة من دروسها، فيقول: (والذين يتصورون
أن الانتكاسة بمثابة الأغلال والقيود المعيقة عن العمل والتواصل، أولئك
أخطأوا في فهمها، ولم يعوا معناها، بل إن هناك بعض الانتكاسات تعكس من
ورائها فوائد للعامل، لكي يكشف أخطاءه ونقاط ضعفه، ويميزها ويشخّصها،
ثم يسعى نحو وضع العلاج المناسب لها وتصحيحها) [29].
ومن هذه العبر.. دروس من ثورة العشرين.
دروس من ثورة العشرين:
ينظر السيد الشيرازي الى ثورة العشرين بمستويين من الاعتبار،
المستوى الأول: وفيه يدلل لنا على أهمية الخبرة والدور الذي يمكن أن
تلعبه في تقرير مصير شعب أو امة، وليس في موقف واحد أو حدث معين بل إن
الخبرة السياسية قد تكون عنصرا حاسما لمستقبل ذلك الشعب وتلك الأمة.
هذه المسؤولية التي من الضروري ان تضاف على الفاعلين في المشهد
السياسي، فأخطاء صغيرة هنا وهناك يمكن أن تدمر مصير شعب أو مكون،
والعكس صحيح في الجانب الايجابي، فالسياسي عليه أن لا يحجز رؤيته على
الآن بل أن يجعل حاضره متصل بمستقبله، وهذا هو إحدى تجليات التفكير
الاستراتيجي.
امتلاك الخبرة السياسي لا يأتي بالأمنيات ولا بالنوايا الطيبة فقط
بل يجب أن تكون هناك مؤسسات لصنع هذه الخبرات وإنتاجها، وقد أشار
الإمام الشيرازي الى بعضها في كتابه الخبرة وتطوير الحياة وبعضها مبثوث
في فلسفته المؤسساتية والإدارية مما لا مجال للتفصيل فيه.
المستوى الثاني: هو كيف نحول تجاربنا وتاريخنا الى مصدر للخبرة،
فليس الغرض من دروس في ثورة العشرين في العراق هو محاكمتها، أو
تقييمها، أو تحويلها الى مجد أو ثورة حولت انتصارها القوى الاستعمارية
الى انتكاسة على المدى البعيد، دروس من ثورة العشرين أرادها الإمام
الشيرازي أن تكون مصنعا لإنتاج الخبرة السياسة، ومع بون المسافة
الزمنية فمن المؤكد إن الشيرازي أرادها أن تكون منجما لدراسة دور
الخبرة في توجيه الأحداث والوعي السياسي في صناعة المواقف، مع التأكيد
على أن وجود النخب السياسية الصالحة لا يعني انتصار الإرادة الشعبية
إذا لم تكن تلك الجماهير بمستوى الوعي السياسي الذي يمكنها من مجاراة
ترسمه لها قياداتها السياسية، وبالطبع واحد من أعظم شواهد ذلك معركة
صفين الشهيرة ولعبة رفع التحكيم، وعلى نفس الجرح يضع الإمام الشيرازي
إصبع التأمل، فنقتبس منه:
الفوز في العمل السياسي يمكن أن يضيع إذا لم يوظف بالشكل الصحيح:
فبالرغم من نجاح ثورة العشرين إلا إن عدم توظيف نتائجها بالشكل الذي
يحقق مصالح الجماهير الثائرة أدى الى نتائج عكسية ظلت تلقي بظلالها الى
الوقت الحالي، فيقول الامام الشيرازي: (وتدخلت القوى الكبرى
الاستعمارية، وجاءت بحكومة شكلها عراقي، ولكن حقيقتها ليست كذلك، فجرّت
الويلات والمآسي على الشعب العراقي إلى يومها هذا، إن تلك الانتكاسة
يلزم أن تكون عبرة لنا، لنصحح الأخطاء التي وقعنا فيها في ذلك الوقت،
حتى لا تتكرر ثانية) [30].
قلة الخبرة عند الكوادر السياسية الوسطية وضعف الوعي السياسي يؤدي
الى ضياع الجهد السياسي وتوظيفه: لان المخططات السياسية متحركة وهي قد
تواجه أزمات وإشكاليات فعليها أن تناور وتغير من تقنيات العمل واليات
التنسيق وبالتالي فان نجاح المسيرة السياسية لا يتوقف عند تخطيط القائد
بل على قدرة الكوادر الوسطية (قادة الميدان) في تنفيذ تلك المخططات،
فالمرجعية خططت بما تمتلكه من رؤية إستراتيجية لكن التنفيذ مرة جاء ليس
كما هو مطلوب وأخرى كان خارج السياق خصوصا في توظيف مرحلة ما بعد
الثورة. وفي هذا السياق يقول السيد محمد الشيرازي: (واستطاع الإنجليز
أن يلتفوا على العراق مرة أخرى وبصيغة جديدة؛ إذ نصبوا فيصل ملكاً على
العراق، وقد انطلت المؤامرة على بعض الثائرين نتيجة قلة الوعي وعدم
الخبرة، نعم وقف البعض الآخر وهم الواعون ضد هذه المؤامرة من أمثال:
السيد أبو الحسن الأصفهاني[31].. والشيخ محمد حسين النائيني[32]..
وغيرهم من العلماء فلم يقبلوا بهذه المؤامرة الاستعمارية، حيث عارضوا
ترشيح (فيصل) وأي مرشح آخر في ظل الانتداب، وشددوا على تشكيل الحكومة
الإسلامية المستقلة عن الأجنبي استقلالا تاماً وأكدوا على ضرورة أن
يكون الحكم بيد الأكثرية الشيعية..) [33].
فهم الجماهير للحدث السياسي عنصر حاسم في العمل السياسي: فلا يكفي
أن تكون القيادة السياسية تفهم ما يجري، أو ما يراد بما يجري، بل أن
يترسخ هذا الفهم عند الجماهير، لكي نحصل على موقف شعبي واضح عام، أما
طريقة إملاء المواقف على الجماهير فهي لا تؤدي غرضها، أو تؤدي الى
نتائج ضعيفة، وإذا كانت وسائل الاتصال والتواصل ضعيفة قبل قرن في
العراق فان اليوم أصبح بإمكان القائد السياسي أن يتواصل يوميا مع
جماهيره، وحتى بشكل تفاعلي. والى هذا يشير الإمام الشيرازي الى موقف
الناس بعد إعلان الملكية ونفي وترحيل العلماء الى إيران الذي كان لهم
دور فاعل بثورة العشرين بقوله: (وفي اليوم المحدد لرحيلهم ذهب الناس
لوداعهم من منطقة المخيم في كربلاء المقدسة إلى باب بغداد (وهي نهاية
كربلاء على طريق بغداد) وكانت حالة الحزن والبكاء والتضرع بادية عليهم
وهم يودعون العلماء، ويقولون: لهم لا تنسونا من الدعاء عند مرقد الإمام
الرضا (ع)!! هذا كل ما قام به الناس تجاه هذا العدوان السافر، ولم
يقوموا بأي تحرك سياسي أو ضغط اجتماعي أو ما أشبه. نعم، هكذا كانت ردة
فعل الناس بسيطة تجاه هذا الحدث المؤلم، فالناس أخذوا ينصرون العلماء
بالدموع والحزن فقط من دون أن يتخذوا موقفاً عملياً في هذا السبيل،
وكان بإمكانهم تغيير مسار الحدث في حينه لو أنهم تصرفوا بوعي وأدركوا
خطورة تصرف الحكومة تجاه مراجعهم وعلمائهم، وما لذلك من أثر في
المستقبل وكونه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخر أشد خطورة وأكثر تأثيراً،
وللأسف الشديد لم يبد أحد من الناس اعتراضه المؤثر واستنكاره الشديد
على الحكومة لاتخاذها هذا الإجراء الظالم ضد العلماء والمراجع؛ لذا فإن
الحكومة واصلت تنفيذ القرار وأبعدتهم إلى إيران) [34].
يخلص الإمام الشيرازي في مروره السريع بثورة العشرين، وبعد قراءتها
بعد عشرات السنين الى نتيجة مهمة، وهي ان الخبرة السياسية والوعي
السياسي يلعبان دورا حاسما في أكثر الثورات نجاحا وتألقا مثل ثورة
العشرين والتي ما تزل للان تسمى الثورة العراقية، دورا في توظيف نتائج
الثورة، غير إن السياسة البريطانية المتمرسة وعقليتها الاستعمارية في
ذلك الزمن أدت الى قلب نتائج الثورة ضد الأغلبية وتأسيس الدولة
العراقية الحديثة بشكل يؤدي الى تهميشهم وسلب حقوقهم، ويختم الإمام
الشيرازي هذه الوريقات من دروس من ثورة العشرين بقوله: (وكان كل ذلك
لقلة وعي الناس وعدم خبرتهم بالقضايا السياسية. وهكذا تتبين أيضا خطورة
الدور المهم للسان والقلم في تعميق الوعي وتعبئة الرأي العام لتحقيق
الأهداف اللازمة) [35].
* مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث
http://shrsc.com
....................................................
[1] عنوان هذه القراءة مأخوذ من عنوان فرعي من كتاب
الخبرة ودورها في الحياة للإمام السيد محمد الشيرازي.
[2] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. بيروت ـ مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، الطبعة
الأولى 1428هـ / 2007م. ص21.
[3] وميض عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية
والاجتماعية للحركة القومية العربية، ص399.
[4] الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي، زعيم روحي
كبير، صادق العزيمة، نافذ الكلمة، واسع النفوذ ولد في شيراز سنة 1256
هـ وهاجر الى كربلاء سنة 1271هـ لارتشاف مناهل العلم والعرفان، وبعد أن
درس على أشهر رجالاتها مدة قصيرة من الزمن، انتقل الى سامراء وتتلمذ
على وحيد زمانه وكبير مجتهديه، الميرزا حسن الشيرازي الكبير، فضرب بسهم
وافر في الفضل والكمال حتى خلفه في منصب الرئاسة الدينية. فلما كان
الاحتلال البريطاني للعراق، واشتدت الحاجة اليه، طلبه علماء النجف،
ورؤساء القبائل، للسفر اليهم، فوافق على إجابة طلبهم، ولكن لما رأت
الأوساط الوطنية ان حاجة كربلاء الى وجوده اعم وأفضل، انتقل اليها فوضع
عصا ترحاله فيها يوم 18 صفر المبارك من سنة 1336 هـ فعمل الوطنيون على
الاستفادة من نفوذه الواسع، فكان عاملا كبيرا من عوامل بعث الروح
الوطنية، وتنشيطها، كما كان قائدا روحيا للثورة. فقد تمكن من رفع أسباب
النفور والعداء الكامن في نفوس رؤساء القبائل، فالق بين الشيوخ، واحل
الصفاء محل العداء، وبذل بسخاء عظيم في سبيل جلب الرجال وتأمين حاجاتهم
بما وهبه الله من مال ونعم. (ينظر: الحسيني، الثورة العراقية الكبرى،
ص96). وترجمته في كتاب الخبرة ودورها في الحياة ص22: (هو الشيخ محمد
تقي بن الميرزا محب علي بن أبي الحسن الميرزا محمد علي الحائري
الشيرازي زعيم الثورة العراقية، ولد بشيراز عام (1256هـ) ونشأ في
الحائر الشريف، فقرأ فيه الأوليات ومقدمات العلوم، وحضر على أفاضلها
حتى برع وكمل، فهاجر إلى سامراء في أوائل المهاجرين، فحضر على المجدد
الشيرازي حتى صار من أجلاء تلاميذه وأركان بحثه، وبعد أن توفى أستاذه
الجليل تعين للخلافة بالاستحقاق والأولوية والانتخاب، فقام بالوظائف من
الإفتاء والتدريس وتربية العلماء. ولم تشغله مرجعيته العظمى وأشغاله
الكثيرة عن النظر في أمور الناس خاصهم وعامهم، وحسبك من أعماله الجبارة
موقفه الجليل في الثورة العراقية، وإصداره تلك الفتوى الخطيرة التي كان
لها الوقع العظيم في النفوس. فهو فدى استقلال العراق بنفسه وأولاده.
وأشعل شرارة ثورة العشرين ضد الاحتلال الانجليزي للعراق، فقد جاء في
فتواه: مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم
رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع
الانجليز عن قبول مطالبهم. وأفتى بحرمة انتخاب غير المسلم. وكان
العراقيون طوع إرادته لا يصدرون إلا عن رأيه وكانت اجتماعاتهم تعقد في
بيته في كربلاء. قال عنه السيد حسن الصدر في التكملة: (عاشرته عشرين
عاماُ فما رأيت منه زلة ولا أنكرت عليه خلة). من مؤلفاته: حاشية على
المكاسب، ورسالة في صلاة الجمعة، ورسالة في أحكام الخلل.. توفي في
الثالث عشر من ذي الحجة عام (1338هـ) مسموماً ودفن في الصحن الحسيني
الشريف ومقبرته فيه مشهورة).
[5] فريق المزهر الفرعون، الحقائق الناصحة في الثورة
العراقية سنة 1920 ونتائجها، ط2. (بغداد:1995)، ص، 195.
[6] فريق المزهر الفرعون، الحقائق الناصحة في الثورة
العراقية، ص196.
[7] عبد الشهيد الياسري، البطولة في الثورة
العشرينية، (النجف:1966)، ص162-164.
[8] علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق
الحديث، مطبعة امير-قم، ط1، 1413، ج5، ص 349.
[9] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص21.
[10] حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق،
مطبوعات CEDI فرنسا عام 1989.، ص134.
[11]. عبدالرزّاق الحسني: الثورة العراقية الكبرى.
صيدا، لبنان، الطبعة الثانية -1965. ص30.
[12] سعيد السامرائي، الطائفية في العراق، ط1، 1993،
مؤسسة الفجر، لندن، ص 123-124.
[13]. تاريخ الوزارات العراقيّة، للكاتب عبدالرزّاق
الحسني: ص111.
[14] مير بصري، أعلام السياسة في العراق، ص 137.
([15]) كان مدير شرطة كربلاء المقدسة في ذلك الزمن.
[16] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة، ص24-25.
[17] الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة، ص7.
[18] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص5.
[19] فقد قال سلمان: يا رسول الله، إن القليل لا
يقاوم الكثير في المطاولة، قال: فما نصنع؟. قال: نحفر خندقا يكون بيننا
وبينهم حجابا فيمكنك منعهم في المطاولة، ولا يمكنهم أن يأتونا من كل
وجه، فإنا كنا معاشر العجم في بلاد فارس، إذا دهمنا دهم من عدونا نحفر
الخنادق، فيكون الحرب من مواضع معروفة.(انظر: الشيرازي، الخبرة ودورها
في الحياة. هامش ص 30).
[20] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص28.
[21] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص17.
[22] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص18.
[23] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص15.
[24] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص16.
[25] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص19.
[26] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص26.
[27] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص20.
[28] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص19.
[29] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص19-20.
[30] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص21.
[31] هو السيد أبو الحسن بن السيد محمد بن السيد عبد
الحميد الموسوي الأصفهاني، شخصية فذة، ذو عبقرية نادرة، فريد دهره،
ووحيد عصره، حامل لواء الشيعة، من فحول علماء عصره. كان محققاً مدققاً
فقيهاً أصولياً خبيراً بتراجم الرجال وسير التأريخ، جليل القدر عظيم
المنزلة، حوى صفات الكمال وخصال الخير. ولد سنة 1284هـ في أصفهان، ورد
إلى النجف الأشرف أواخر القرن الثالث عشر، وأقام في كربلاء المقدسة مدة
ينهل من معين علمائها، وبعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي رشح للزعامة
الدينية، وبعد وفاة الشيخ أحمد كاشف الغطاء والميرزا حسين النائيني
أصبحت لـه الزعامة الدينية والرئاسة الروحية بلا منازع، وسار حديثه في
الأوساط، طبقت شهرته الآفاق، حتى انيطت به القيادة الفكرية والمرجعية
العامة في التقليد، فقام بأعبائها، واستقل بإدارتها، وتكفل بتسيير شؤون
المعاهد العلمية وحوزات التدريس في إيران والعراق والهند وباكستان
والافغان وغيرها. شارك في الحركة الدستورية في إيران كما شارك في ثورة
العشرين، وعارض تنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق. كان مجلس درسه
ملتقى البارزين من رجال العلم والفضلاء أينما حل، من مؤلفاته: الرسالة
العملية (وسيلة النجاة)، شـرح كفاية الأصول، حاشية علـى العروة الوثقى،
حاشية على تبصرة المتعلمين، منتخب الرسائل، ورسالة ترجمة المقلدين،
وحاشية ذخيرة العباد ليوم المعاد، وحاشية المناسك، وحاشية منتخب
الرسائل، وحاشية نجاة الصياد، وغيرها من الكتب الأخرى. توفي في ذي
الحجة عام (1365هـ) في الكاظمية، وشيع جثمانه الطاهر تشييعاً مهيباً
إلى النجف، ودفن في الصحن الغروي الشريف.
[32] هو الشيخ الميرزا محمد حسين ابن شيخ الإسلام
عبد الرحيم النائيني (1277 ـ 1355هـ) مجتهد خالد الذكر من أعاظم علماء
الشيعة وأكابر المحققين. أكمل المقدمات في أصفهان، هاجر إلى العراق
فتشرف إلى سامراء فحضر بحث المجدد الشيرازي ثم صار كاتباً ومحرراً لـه،
ثم هاجر إلى كربلاء المقدسة ومنها إلى النجف الأشرف وأصبحت بينه وبين
الشيخ محمد كاظم الخراساني رابطة قوية واختصاص وثيق وصار من أعوانه
وأنصاره في مهماته الدينية والسياسية، كما صار من أعضاء مجلس الفتيا.
وعند حدوث أمر النهضة وتبديل حكومة إيران الاستبدادية إلى الدستورية
التي تزعمها الشيخ الخراساني وذلك عام (1324هـ) وقف معه المترجم وكان
يرى رأيه فألف كتابه الموسوم (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) وبعد وفاة شيخ
الشريعة ارتفع ذكره ورجع إليه كثير من أهل البلاد البعيدة. توفي عام
(1355هـ) في النجف الأشرف ودفن في الحجرة الخامسة على يسار الداخل إلى
الصحن الشريف من باب السوق.
[33] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص22-23.
[34] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص24-25.
[35] الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. الخبرة
ودورها في الحياة. ص26. |
