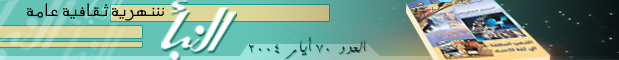
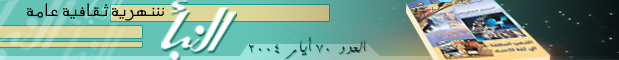 |
|
نحو ثقافة التطابق مع الاسلام التنشئة الثقافية |
|
سيد أمين حسين الرجا |
|
إن السلوكيات تمثل انعكاساً أميناً للثقافة، وحين تنفصل النظرية عن الواقع فإنها تعبر عن ازدواجية التفكير؛ ولهذا تنشأ خيارات جديدة مثل إقصاء الإطار النظري بصورة نهائية أو السعي للتطابق معه، وبما أن الثقافة الإسلامية ابتليت بهذه البلوى، فكيف يمكن لنا خلق نقاط الالتقاء بالثقافة الإسلامية المقصاة، وإعادتها لترسم أبعاد الحياة بصورة دقيقة؟ هذه النقاط بالطبع نقاط اتكاء عملية؛ لأن الثقافة حاضرة كأطر نظرية، وباعتبار المرجعية الدينية هي المؤسسة الفعلية التي تمثل قيادة الأمة، فكيف يمكن لها أن توجه الواقع رغم عوامل الإعاقة المعروفة؟ قبـل الإجابـة على هذا لا بــد من عدة توضيحـــات لكيفيـة الســلوك وأســبابه التي هي ذات ارتباط وثيق بعلم النفس وأبحاثه، وهذه التوضيحات هي جزء من الإجابة ندرجها فيا يلي: 1-خلق الإنسان وأودع الدنيا للاختبار، وأعطيت حقيقته جسداً تتصرف من خلاله وبناءً على نوعية السلوك تكون نتائج الاختبار الإلهي؛ قال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)(الملك:2). لقد تم تزويد الإنسان بالعقل الذي ليس له علاقة بالأفعال والسلوكيات، بل العمل الرئيسي له هو التمييز بين الخطأ والصواب، من خلال طاقة الفكر العملاقة المودعة فيه، والدليل على أن محتويات العقل مودعة مسبقاً، ما يسوقه الإمام علي (ع): (أرسل الله الأنبياء ليثيروا لهم دفائن العقول)، والمدفون يحتاج إلى دافن وهو الله جل وعلا، وأن العقل لا يخلق الأفكار خلقاً بل يتقلب بينها بحثاً وتنقيباً؛ أما القرار في الأفعال والسلوكيات فمن اختصاص النفس البشرية المجهولة، فهي التي تقرر الإقدام على فعل ما أو عدم الإقدام، وهذه النفس ذات صفات عديدة منها أنها (ترغب ولا ترغب - تلتذ ولا تلتذ - تتأثر بالبيئة ولاتتأثر- قابلة للتطبع والترويض وغير قابلة - مصدر المحبة والكراهية أم لا- على اتصال بالعقل أو لا)، فتصبح ثنائية الإنسان (العقل - النفس)؛ كأن العقل فيه للتمييز بين القوانين و النفس فيه سلطة تنفيذية (مشرّعاً لها) قد تلتزم وقد لا تلتزم. 2- قوانين الإسلام هي (ما يجب أن يكون عليه السلوك نظرياً) أما ما تصرفه المسلمون سابقاً وما يتصرفونه حاضراً ولاحقاً فهو (ما كان عليه السلوك واقعاً)، مما يدل على أن هناك فرقاً بين (ما يحدث) و(ما يجب أن يحدث)، وهذا ما يدور حوله موضوعنا في إجراء تطابق ما بين (ما يجب أن يحدث) و(ما يحدث واقعاً)، أما الاختلاف فيما بينهما فيجرنا إلى تساؤل آخر وهو (لماذا يحدث؟)، أي ما هو السبب في كون السلوك بهذه الصيغة؟، ومهما يكن السلوك، فإنه لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية بالحصر المنطقي من خلال قسمة منطقية مجراة بلحاظ الانطباق بالسلوك على الفقرة القانونية وصحتها وموافقتها لرغبة النفس أو عدم ذلك كله: 1-سلوك منطبق على تشريع وهذا التشريع صحيح ومتوافق مع رغبة النفس مثل ممارسة الزواج وإفطار العيدين. 2- سلوك غير منطبق على تشريع وهذا التشريع صحيح ومتوافق مع رغبة النفس مثل ترك ممارسة الزواج وصيام العيدين. 3- سلوك منطبق على تشريع وهذا التشريع صحيح وغير متوافق مع رغبة النفس مثل ممارسة دفع الزكاة والحقوق الشرعية. 4- سلوك غير منطبق على تشريع وهذا التشريع صحيح وغير متوافق مع رغبة النفس مثل ترك ممارسة دفع الزكاة والحقوق الشرعية. 5- سلوك منطبق على تشريع وهذا التشريع غير صحيح لكنه متوافق مع رغبة النفس مثل ممارسة الاختلاط في الغرب. 6-سلوك غير منطبق على تشريع وهذا التشريع غير صحيح لكنه متوافق مع رغبة النفس مثل ترك ممارسة الاختلاط. 7- سلوك منطبق على تشريع وهذا التشريع غير صحيح وغير متوافق مع رغبة النفس مثل ممارسة دفع بعض أنواع الضرائب. 8-سلوك غير منطبق على تشريع وهذا التشريع غير صحيح وغير متوافق مع رغبة النفس مثل ترك ممارسة دفع بعض أنواع الضرائب. مع العلم أنه إذا كان التشريع إلهياً فإن الاحتمالات الأربعة الأخيرة تزول وتبقى الأربعة الأولى، أما الأول والثالث فهما الصيغة المطلوبة وهما اللذان يمثلان الأفعال الخيرة والحسنة أما الثاني والرابع فهما اللذان يمثلان الأفعال القبيحة والشريرة وبتقسيم آخر يعتمد أساساً آخر في القسمة يقسم الأفعال والسلوكيات إلى أربعة أقسام؛ هي: 1- سلوك ذو فائدة حاضراً وفائدة لاحقا. 2-سلوك ذو فائدة حاضراً وضرر لاحقا. 3-سلوك ذو ضرر حاضراً وفائدة لاحقا. 4-سلوك ذو ضرر حاضراً و لاحقا. وبلحاظ رغبة النفس وعدمها تصبح الاحتمالات أيضاً ثمانية، مع العلم أن الفائدة اللاحقة أو الضرر اللاحق يمكن أن يكون معلوماً ويمكن أن يكون غير معلوم، وبهذا اللحاظ وأيضاً النظر لإجراء تقاطعات بين احتمالات هذا التقسيم واحتمالات التقسيم السابق وغيرها من التقسيمات الأخرى نحصل على أبجدية احتمالات السلوك، وهي متاهة يصعب حصرها، ولكن من المتفق عليه أن التشريع الذي يأخذ بعين الاعتبار مستقبل نتائج سلوك ما، أدق من غيره وأفضل، وإذا علمنا أن عقل الإنسان إذا ما شرع لسلوك ما فإن تشريعه هذا يفتقر إلى المقدرة على التنبؤ بالنتائج المستقبلية مثل (تشريع الفجور والاختلاط في الغرب؛ إذ لم يكن في يوم من الأيام معلوماً أنه سيؤدي إلى الأيدز مثلاً)، إلا أن التشريع الإلهي يلم بكامل جوانب القضية حاضرها ولاحقها، أما التشريع الوضعي فيأخذ بعين الاعتبار المدى المنظور فقط متأثراً كذلك بالنفس وميولها، أما الإجابة على التساؤل الذي يقول: (لماذا يحدث؟) فيجب أن نعلم أن المحرك الأساسي للسلوك هو الحاجة بنوعيها المادي والمعنوي، ولا يكون هناك دور للحاجة المعنوية إلا بعد إشباع الحاجة المادية، وفي تقديم الإمام علي (ع) للفقر على الفخر في قوله: (أهلك الناس اثنان مخافة الفقر وطلب الفخر)، إشارة إلى ذلك؛ ومن المعلوم علمياً أن حاجات الإنسان لا تقف عند حد معين إذ لا عد لها ولا حصر، بل تتقدم للأمام بشكل مذهل، ولا ينتقل الإنسان إلى إرواء حاجة إلا بعد إرواء ما قبلها في سلم الأولويات؛ فلا تشبع حاجة إلا ويسود مخاض لولادة حاجة جديدة، إلا أنه مهما تعددت الحاجات المادية، ومهما اتسعت أفقياً وعمودياً، فإنه يمكن إرجاعها وحصرها في سبع حاجات رئيسية أساسية أفقياً، وتتدرج كل واحدة منها عمودياً، وهذه الحاجات هي أفقيا:1-التنفس - 2- الشرب - 3- الأكل - 4- النكاح - 5- اللبس - 6 -السكن - 7 -الانتقال. فلا يطلب الإنسان الشراب إذا منع التنفس، ولا يطلب الطعام إذا منع الشراب وهكذا، مع العلم أنه إذا تم تجاوز مرحلة التنفس والشراب والطعام تترافق بقية الحاجات، مع أمور أخرى من لهو ولذائذ مما سوى ما ذكر على نحو العموم والخصوص من وجه، ولا يخفى أن التفاوت العمودي في الحاجة الأفقية الواحدة قد يكون واسعاً جداً، فمثلاً الحاجة إلى المأكول قد يسدها البعض بقرص من الشعير وهو مأكول، بينما يسدها بعض آخر بطعام الملوك والأثرياء الفاخر والمتعدد وهي من المأكول أيضاً، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الحاجات الأفقية في تدرجها العمودي، ولكن هذه الحاجات تمثل حلاً مؤقتاً لإبقاء الإنسان في الحياة مهما تطورت رفاهيتها، والاستمرار بتلبية تلك الحاجات لا يضمن الاستمرار في الحياة، فعندما تنتهي حياة الإنسان فإن التلبية السابقة المتطورة للحاجات لا تغني عن الإنسان شيئاً؛ لذا يجب استبدالها بما يضمن النتيجة، ولا بديل إلا المضيف أو الملاذ أو المنقذ؛ فلنسميه الحاجة الثامنة وهي تاج الحاجات إن جاز التعبير وهو الله جل وعلا، ويشتد الشعور بتلك الحاجة عند اقتراب الموت فتصبح حاجة مؤثرة على السلوك أكثر من السابق بعد أن كانت شبه ثانوية في تأثيرها على السلوك، وباللحظة التي ثبت أن إرواء الحاجات السبع والمبالغة في إسعاد الإنسان في الدنيا لا يغني عنه شيئاً، فلا بد لنا من التعرف إلى دساتير وقوانين تضمن للإنسان نتيجة نهائية ودائمة لا نتيجة مؤقتة وبمراعاة العقل فإن طريقة الحصول على النتيجة النهائية يحددها المضيف الذي إليه المآل والمصير؛ قال تعالى في سورة البقرة الآية 28 (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) فيجب أن تؤخذ منه؛ لذا فقد أرسل الأنبياء وزودهم (بكاتلوكات) الاستعمال للكون وفي الكون على اعتبار أن مجال عمل الإنسان يشمل الكون بأسره بدليل قوله تعالى في سورة لقمان الآية رقم 20 (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض)، وبما أن الكون أكبر جهاز في الوجود فقد كان أفضل كاتالوك لاستعمال هذا الجهاز هو القرآن الكريم، فالكون جهاز كاتالوكه القرآن الكريم، وإذا ما رأى الإنسان أن صيغاً من الحياة الوضعية أفضل من صيغة القرآن الكريم فالعيب فيه وليس في القرآن، كما لو أن الأعمى لم ير الشمس فالعيب فيه وليس فيها. إذاً تحديد نوعية الحركة هو نسبي؛ فهذا الكون الذي نعيش بداخله لا يمكن إلا أن تكون نظرتنا إليه معكوسة أو مخطئة؛ إذ كيف يمكن لمن هو بداخله أن يفسره بدون الإطلاع على خارجه ولا يمكن أن يطلع على خارجه إلا صانعه وهو الله؛ فالنظرة الصحيحة هي (كاتالوك) الصانع وهو القرآن الكريم، والفائدة أن القرآن الكريم هو القاعدة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها السلوك لنتجنب الخطأ والتي يجب أن نسعى لإجراء انطباق بينها وبين سلوك المسلمين ويلحق بالقرآن الكريم شريعة الله التي تجلت بأقوال وأفعال وتقريرات النبي(ص) والأئمة عليهم السلام باعتبارهم ترجمان القرآن ودليل الاستعمال الكوني، وعندما نؤمن كمسلمين بأن قانون الإسلام هو القانون الصحيح فقط الذي يجب أن تكون السلوكيات متطابقة معه فما هو السبب في الانحراف عن هذا القانون بالرغم من وجود هذا الإيمان علماً أن هذا الانحراف هو واقع ملاحظ لا مفر منه وليس بالسهل ولا باليسير القضاء عليه بل ولعل النبي (ص)والإئمة المعصومين(ع) لم يستطيعوا - إن جاز التعبير - إلزام البشرية بقانون السماء وقاموا بالحروب من أجل ذلك ومع هذا فقد فضلت البشرية الحل المؤقت الأرضي لمشكلاتها على الحل الدائم السماوي وأفلتت من القوة الجاذبة إلى الشرع الإسلامي وأصبحت تسير بقانون القوة النابذة عن الالتزام بالشرع، وبالتحديد حدث ذلك بعدما يسمى بعام الجماعة، وتسلم زمام الأمور من قبل قائد من قواد القوة النابذة عن الشرع وهو معاوية بن أبي سفيان، وتعمق الشرخ بين الإسلام وحقائقه ونصوصه وما بين المسلمين؛ فأصبح الإسلام في واد والمسلمون في واد آخر والسبب في ذلك أن الإنسان بطبعه ميال إلى ما يسمى (ببراق الرداء وحاضر النتيجة) وبرأيي فإن عدم الاستمرار، بعد النبي والإمام(ع) على حقيقة الشرع هو تفوق الحاجة الآنية التي تمثلها الحاجات السبع سابقة الذكر على قانون الحاجة الثامنة والنهائية اللاآنية وكيف لا تتفوق سبع حاجات على حاجة واحدة غير ملموسة لدى الإنسان العادي حسياً معرفة مدى أهميتها؟ وليس فقط السبب هو وجود شخصيات منحرفة ومندسة مثل معاوية بن أبي سفيان وغيره؛ فما هؤلاء إلا تعبير عن واقع يدعمهم ويريد ما يريدون وهم يتربّعون على رأس الهرم الذي يمثلونه ولو لم يوجدوا لوجد غيرهم، والخلاصة أن: 1-سلوك الإنسان ناتج عن الحاجات السبع عندما لا يراعي الناحية الدينية. 2-تتأثر سلوكيات الإنسان بالحاجة الثامنة عندما يراعي الناحية الدينية فيصبح سلوكه مزيجاً من أجل ثماني حاجات بدلا ًمن سبع فتظهر سلوكيات العبادة والالتزام بقانون السماء بشكل متفاوت عمودياً. 3-الثقافة الإسلامية وقوانينها الصحيحة وضعت بمراعاة الحاجات الثماني للإنسان. 4-القوانين الوضعية وضعت بمراعاة الحاجات السبع للإنسان. 5-تجاوب البشر مع القوانين الوضعية لأنها تعطي حلاً لحاجة حاضرة (إن هؤلاء يحبون العاجلة) (الإنسان::27). 6-تأخر الناس عن القوانين الإسلامية لأنها تلبي حاجة مؤجلة. والآن وبعد أن أصبحت الثقافة الإسلامية مقصاة عن واقع التطبيق يطرح هذا التساؤل: كيف لنا أن نخلق نقاط الالتقاء بالثقافة الإسلامية المقصاة وإعادتها لترسم أبعاد الحياة بصورة دقيقة؟ ولا يريد السائل أطراً نظرية لأن الأطر النظرية موجودة وحاضرة بل يريد صيغة نظرية للمرحلة العملية تتكئ عليها نقاط الالتقاء المنشود الذي يتم على يد المؤسسة المرجعية التي تواجه العوائق والمصاعب في هذا السبيل. وقبل الإجابة نذكر الحقائق التالية: 1-الحلول لا يمكن أن تفرض بالقوة وقد تنجح القوة ولكنها تحمل بذور الهدم بداخلها. 2-لإنسان ميال بطبيعته إلى الحرية، والكبت الخارجي لا يمكن أن يكون بديلاً عن القناعة العقلية المدعومة بميل النفس لها من خلال ترويض النفس أخلاقياً بالاستناد إلى بيئة تؤيد هذا الأمر لتعتاد عليه النفس، وهذا تأييد للرواقية وللفيلسوف الفرنسي كانت الذي يقول إن العقل هو مصدر الإلزام الخلقي وأن الالتزام الأخلاقي مصدره داخلي، وردٌّ على الحدسيين ومنهم (توماس هوبس) الذي بنى نظريته على مبدأ الأناة ويرى أن الدولة هي مصدر الإلزام الأخلاقي الذي يجب أن يفرض من الخارج. 3-الميول النفسية رغبةً وعدم رغبة هي الموجه المهم لكثير من التصرفات والسلوكيات وتتكون هذه المشاعر في البيئة فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار منذ البداية البيئة وما تسجله الحواس الخمس منها منذ الصغر؛ فهو سيصبح لاحقاً جزءاً لا يتجزأ من الإنسان. 4-الحلول الآنية تأتي في الأولوية عند السواد الأعظم من الناس. وبناءً عليه يجب على المؤسسة المرجعية القيام بخطوات عملية، نذكر منها ما يلي: 1-يجب أن تبني المؤسسة المرجعية نظريتها في توجيه السلوك استناداً على أبحاث علم النفس المتطورة. 2-إشاعة القناعة التامة بتفوق القوانين الإسلامية من حيث صوابيتها على غيرها مئة بالمئة. 3-إحاطة العالم الإسلامي بموجة إعلامية عارمة صادقة وبراقة تعتمد على كل وسائل الإعلام وبالخصوص أكثرها تأثيراً وانتشاراً فمن الإذاعة إلى التلفزيون والانترنت والمحطات الفضائية وكذلك لا يخفى دور الصحف والمجلات وطباعة ملايين البوسترات والمؤلفات المختلفة المواضيع وبالخصوص أكثرها اختصاراً، فالله قد جعل الكون كله في مجلد واحد وهو القرآن الكريم وكان بإمكانه أن يكتب لنا عن الكون مليار مجلد أو أكثر، وترك المطولات لخاصة العلماء كما ويجب أن تكون هذه الحملة الإعلامية بصورة معاصرة ومنافسة تركز على السواد الأعظم وهذا ما يترافق مع الجماهيرية في التوعية التي هي جزء من نظرية المرجع الديني الأعلى السيد محمد مهدي الشيرازي (قدس سره) في الإصلاح الشامل، التي بناها على ستة عوامل إحداها التوعية. 4-الصيغ والطروحات التي تقدمها الثقافة الإسلامية لإرواء الحاجات السبع للإنسان. يجب تشجيع المسلمين على ممارسة جميع جماليات الاقتصاد الإسلامي بما لا يتعارض مع الشرع وإنزال كل الصيغ الممكنة في القانون الإسلامي إلى حيّز التطبيق وذلك ضمن نطاق الحاجات السبع بمختلف درجاتها العمودية والأفقية، وذلك لردم الهوة الواسعة ما بين تناول الحاجات السبع في المجتمع اللامسلم والمجتمع المسلم مما يخرج المسلم من حالة الكبت الذي تعشعش بظله فكرة الانفجار المعاكس إلى إرواء الحاجات على طريقة اللامسلم مع بقائه مسلماً وهذا هو عين الازدواجية في التفكير المذكورة سابقاً، فإلى الآن ربما يتصرف المسلم تصرفاً شرعياً ومع هذا فهو ينظر لنفسه أنه يفعل المذموم والممنوع على عكس نظرة الباري جل وعلا؛ لذلك ولهذه النقطة بالذات علاقة وطيدة مع العادات والتقاليد لشعوب متعددة الأشكال والألوان ضمن دائرة الإسلام. 5-الاعتناء بطبقة علماء الدين وإحاطتهم بما لا يمكن معه أن يتسرب إليهم بذور أي انحراف - ولو بسيط - عن التطابق مع الثقافة الإسلامية؛ لأنهم القدوة التي إن لم تعمل بما تعلم، استنكف الجاهل أن يتعلم؛ قال أمير المؤمنين (ع): (قامت الدنيا بأربعة، عالم عامل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بفضل ماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه فإن لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإن بخل الغني بفضل ما له باع الفقير آخرته بدنياه). 6-الاعتناء بالأثرياء المسلمين الذين تقوم على أكتافهم عمليات الإنفاق الهائل في سبيل تحقيق الالتقاء بين المسلمين وثقافتهم. 7-اعتماد الحوار والسلام مبدءاً رئيسياً في العمل من أجل الإسلام وبالخصوص في دائرة المسلمين وهذا ما يتوافق مع الآية الكريمة التي تقول: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256)، وما يتوافق أيضاً مع نظرة السيد الشيرازي (قدس سره) للسلم إذ يقول: (السلم أحمد عاقبة وأهنأ مذاقاً)، على عكس نظرة النازية المتمثلة بقول هتلر في كتابه (كفاحي): (السلم سراب خادع). 8-العمل على خلق بيئة يكون التطبيق الإسلامي فيها حالة أخلاقية وهي مرحلة تأتي بعد مرحلة القناعة العقلية، فالعقل يحسب حساباً ويقتنع بما فائدته أكبر من ضرره ولعل في الآية الكريمة التي تقول: (وإثمهما أكبر من نفعهما) دليلاً على جواز الطرح والمفاضلة والحساب في عواقب الأفعال ومكاسبها فما كانت فائدته أكبر فلا بأس به، وما كان ضرره أكبر فيجب أن يرفض ومع علم العقل بهذا، فإن النفس تنفذ ما ضرره أكبر أحياناً لأن القناعة الحسابية وحدها لا تكفي للالتزام بل يجب أن ننقل هذه القناعة الحسابية إلى طور أكثر سيطرة على الإنسان وهو طور الالتزام الأخلاقي بما يحتمه الحساب فمثلاً تنظيف الأسنان بالفرشاة عندما يحسب حساب تفاضل نفعي قد يلتزم به وقد لا يلتزم ولكنه عندما يتحول إلى عيب يحتمل المدح والذم اجتماعياً أو أسرياً يلتزم به، وكأن الحساب النفعي والتفاضل هو دليل عقلي والمدح والذم دليل نفسي عاطفي مؤثر أكثر وكأنه خدعة هادفة يمرر من تحتها ما يحتمه الحساب الذي هو نتيجة العقل فالحالة النفسية وسيلة أخلاقية تبعد الإنسان عن الدليل، بل تجعله يفعل ما يحتمه الدليل العقلي ولكن بأسلوب التقزز من المذموم، والفخر بتناول الممدوح، وذلك لضمانة التنفيذ، وكأن الحالة النفسية الأخلاقية تعني افعل أو لا تفعل ولا تسأل عن المبرر والدليل، فإن عرف الدليل يكون باب التهاون مفتوحاً، وهذا يجري في كثير من التعاليم الدينية فربما بسيطها ينطوي على أمر جلل وربما جللها ينطوي على أجل، فيجب نقل المجتمع إلى تطبيق ثقافة الإسلام بعد اقتناعه بها عقلاً وإلزامه بتنفيذها أخلاقاً إلزاماً نابعاً من بيئة تؤيد الإسلام، فالعقل مرحلة تسبق النفس ويجب عدم الاعتماد عليه فقط؛ لأن العقل لا يسيطر على الفعل والسلوك بل يصحح ويخطئ، أما موطن السلوك فهو النفس الإنسانية وأعماقها السحيقة. 9-إعداد الدعاة المجهزين بالخبرة الواسعة بالثقافة الإسلامية واعتمادهم أحدث الأساليب العلمية والنفسية في توجيه السلوك فبعلمهم يقنعون الآخرين بأفكارهم وبتطبيقهم لأفكارهم على أنفسهم يهيئون الجو النفسي لتقليدهم وهذا هو المطلوب فمثلاً: عندما يريد الداعي إقناع أحد ما بفكرة جديدة، يجب أن يراعي المراحل التالية: 1-طرح الفكرة على زيد من الناس. 2- القناعة بالفكرة. 3- تطبيق الفكرة بعد القناعة. علماً أنه بعد طرح الفكرة هناك حالتان: الحالة الأولى: عدم قناعة زيد بالفكرة (عندها يجب البحث عن السبب هل هو جهل في زيد فيجب رفعه أو ضعف في الأسلوب الداعي فيجب تغييره). أما الحالة الثانية: فهي قناعة زيد بالفكرة (عندها تأتي بعدها مرحلتان): قناعة زيد بالفكرة - انتقل زيد إلى تطبيق الفكرة (عندها تمام الصواب). -لم ينتقل زيد إلى تطبيق الفكرة (يجب البحث في سبب عدم التطبيق بعد القناعة ولا تخلو أسباب عدم التطبيق بعد القناعة من أحد الأسباب التالية: أ-مانع نفسي؛ وهذا يعود لكراهية زيد لهذه الفكرة نفسياً مع قناعته بها عقلاً فيجب عندها متابعة ترويض نفس زيد على هذه الفكرة بالإكثار من ممارستها أمامه أو بأي شيء يحببها إليه نفسياً فليس كل ما اقتنع به تم تطبيقه. ب-مانع اجتماعي؛ يعود لتجاوب الناس مع المجتمع مع قناعتهم بصحة الفكرة المخالفة لقناعة المجتمع وذلك خوفاً من النبذ وفقدان القيمة وعندها يتعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع حالة المانع النفسي لإشاعة الأمر حتى يصبح اعتيادياً مألوفا. ج-مانع سياسي؛ فقد لا يتناسب تطبيق فكرة ما مع واقع سياسي ما فعندها يجب العمل بأسلوب الحوار، ولا يجوز العنف والهمجية فهي لغة الصراع والتفاهم بين الحيوانات التي لا تمتلك أبجدية للحوار والتفاهم، أما أبجدية الإنسان وأبجدية الحاضر والمستقبل فهي الحوار والإقناع الذي يعطي تجاوباً أكبر حتى من قبل المانع السياسي ذاته، أما العنف فلا يسبب إلا ردة الفعل التي تسبب التذمر والتقزز والنفور من الإسلام ودعاته، كما لا يجوز اللعب بدماء الناس علماً أنه لا يحق إلا للمعصوم من نبي أو وصي التصرف بها، أما المغامرون بدماء البشر فهم الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا). 10-مراعاة سلم الأولويات أفقياً وعمودياً عند المدعو إلى التطبيق فعند تقديم المرجعية الإسلامية للإنفاق الشرعي فيجب أن تقدم الحاجة ذات المخاض على غيرها وهي مختلفة من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر. 11-تقوم المؤسسة المرجعية بإيجاد كوادر كفوءة ومتسلحة بالخبرة العلمية والتقنية في توظيف الأموال ويسمح لهذه الكوادر بالنظر إلى المشروع الإسلامي على أنه مشروع اقتصادي ضخم وتكون عوائد التوظيف رصيداً داعماً متزايداً أبداً لرفد الصوت الثقافي الذي يزداد علواً بالتبعية ولن تجدي النوايا الحسنة للثقافة الإسلامية بدون تسلحها بالرافد الاقتصادي... إلخ من العديد من الأمور المهمة التي يجب على المؤسسة المرجعية تنفيذها حتى يبلغ التطابق بين الإسلام والمسلمين إلى الذروة المنشودة وما ذلك على الله بعزيز، وما لا يدرك كله لا يترك جلّه، وكما قال أمير المؤمنين (ع): (من رام شيئاً ناله أو اقترب منه)، ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. |