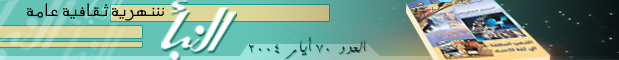
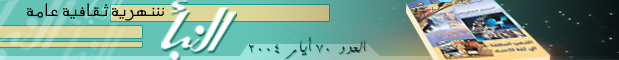 |
|
تاريخنا كيف كتب وكيف يقرأ |
|
مهدي عبد الحسين النجم |
|
بعيداً عن أي تحديد لمفهوم التاريخ أو البحث في منهجياته، أو ما يلتزمه المؤرخ من فلسفة أو دستور أخلاقي، فإننا يجب أن نؤكد حقيقة مفادها: (إن حقائق التاريخ لاتصل إلينا مطلقاً بصورة (بحتة)، إنها دائماً تنعكس من خلال ذهن المدون، يترتب على ذلك أننا إذا ما تناولنا عملاً تاريخياً فينبغي أن لا يكون اهتمامنا الأول منصباً على الحقائق التي يتضمنها، وإنما على المؤرخ الذي كتبها)(1)، ولكي يكون المتلقي مؤهلاً لتجاوز الحقائق المدونة إلى استقراء ذهن المدون ومعرفة توجهاته ومواطن التأثير عليها، فإن على المؤرخ مهمة صعبة لا تقف عند إيصال الحقيقة التاريخية موثقةً بالشاهد والدليل. بل تتجاوز المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المهتمين بتدوين الحدث (أي المؤرخين) إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي عند المتلقين أيضاً. إن المؤرخ لا يعدو كونه ابن بيئةٍ تلقي عليه ضلالها من وعي أو انحراف، ومن سذاجةٍ في التفكير أو التلقي، ومن استنامةٍ لقبول ما هو شائع أو متقبل دون النظر إلى حركة التاريخ ومعرفة كنه المنعطفات التي تنتاب الأمم بين جيلٍ وآخر. وعلى ذلك فإن رفع مستوى المؤرخ لا يتأتى إلا بعد رفع مستوى المتلقين. يقول ابن خلدون: إن التاريخ نظر لا مجرد رواية. وعلى ذلك وضع منهجياته في مقدمته المشهورة، ولكن هل غيرت منهجياته منحى التفكير لدى المؤرخين على الأقل؟ أقول جازماً: إنها لم تفعل ذلك حتى مع ابن خلدون نفسه حين كتب تاريخه(العبر وديوان المبتدأ والخبر). يقول الأستاذ العروي:(ما هو مؤلم ومزعج أن المقدمة لم تغيّر وجهة نظر المؤرخين، وذلك متوقع لكونها لم تغيّر الذهنية العمومية، وعند التوفيق ما كان يمكن أن تؤثر والمجتمع في حالة تفكك وانحطاط، والوعي التاريخي لا يحصل إلا في عهود التقدم والازدهار)(2). ومما لاشك فيه فإن أحداث التاريخ فرغت في المدونات على شكلين، الأول: في صورة خرافة تناقلتها الأجيال حتى صارت حقيقة تقترب من اليقين بقدر ما تبتعد عن الشك، والثانية: بشكل قولٍ مثبت بوثيقة (والحق إن قسماً ضئيلاً جداً من معلوماتنا حول الماضي خاضع إلى التوثيق، أما القسم الأكبر فهو دائماً وباستمرار مفرغ في تصور عام وعامي يمثل جانباً من ثقافتنا الموروثة)(3). على أننا حين ننظر إلى التاريخ كصناعة، وليس كمجموعة من حوادث منتقاة من الماضي، وفي مجتمع يعتبر التاريخ كنزاً يقف أمامه بخشوع وإجلال يقربه من العبادة والتقديس، يجب أن لا ننظر إلى الوثيقة بقدسيةٍ لا تدع مجالاً للشك فيها، (إن الحقائق سواء وجدت في الوثائق أم لم توجد، فإنها لابد أن تخضع لصنع المؤرخ قبل أن تعم فائدتها)(4). ومن التاريخ ما كتب بقصد إضفاء العاطفة، دفعت إليه الأزمات كالحروب القومية أو الدينية، فتنسى الحقيقة بعض الشيء كأنما دعت الضرورة إلى ذلك، وإن الطغاة من رجال السياسة يدعون إلى ذلك، يريدون أن ينظروا إلى التاريخ لا على أنه نوع من المعرفة التي لها منهجها الخاص بها للوصول إلى الحقيقة، بل على أنه وسيلة للوصول من نوع إلى المعرفة يثير المشاعر ويوجهها إلى حيث يريدون مما يؤدي في الأخير إلى تركيز سلطاتهم ودعم مراكزهم. وتاريخنا الإسلامي قد بدأ بتدوين سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الشريفة، وتسجيل جهاده وانتصاراته، غير أن ذلك المنحى أقحم فيه فصيلان، هما فصيل أهل الكتاب الذين أسلموا، فاهتموا بتاريخ ما قبل الإسلام فكانوا مصدر الإسرائيليات في التاريخ، وفصيل القصاصين والوضاعين الذين دفعتهم مشارب شتى إلى الوضع والدس، أو لتزيين الأخبار أو لتشويش الحقائق. وقد تحولت رواية أحداث السيرة النبوية الشريفة إلى رواية سيرة الخلفاء وولاتهم، وما حدث من فتوحات، وربما ما استحدثوا من نظم، وحيث أن النبوة في عدنان وكذلك الخلافة، فقد دفع ذلك من أسلم من أهل الكتاب وممن رويت عنهم الإسرائيليات ومن غيرهم إلى وضع سيرة القحطانيين الذين سبقوا إلى بناء الحضارة وتأسيس الممالك، فكان عبيد بن شريّة وكعب الأحبار ووهب بن منبّه، ولكن الذين دونوا الأحداث في بلاط الخلفاء والملوك شعروا بخطر تزايد الروايات عن أمجاد القحطانيين فعملوا هم أيضاً في إعلاء شأن العدنانيين، والحط من أندادهم القحطانيين فكانت روايات سيف بن عمر التميمي مثلاً في تأكيد سيادة العدنانيين وتبعيّة القحطانيين لهم في مجالات الإدارة والفتوحات، حتى قيل إن الجن تغنت بأمجادهم ونطقت الملائكة بألسنتهم وانقادت نواميس الطبيعة لمشيئتهم. على أن التدوين في بدايته لم يعتمد سوى بضعة عشر رجلاً(5) رووا أحداث السيرة، ثم أخذ عنهم الرواة الذين تتابعوا في النقل جيلاً بعد جيل حتى حلّ عصر التدوين، ثم ظهرت كتب الجرح والتعديل التي صنفت رواة الحديث خاصةً، فجرحت بعضاً وعدلت آخرين، ووضعت اصطلاحات شتى لتمييز الثقات عن غيرهم، ومن يقع بينهما من مدسين وغيرهم. على أن المعدلين إذا استطاعوا أن يحددوا الثقات وفق ضوابط معروفة فإن تلك الضوابط ستكون قاصرة حين نعلم أنها لم تنظر إلى ما رواه أولئك. ولم تحاول أن تتوغل في أذهانهم فتكشف عما تعمدوا التغافل عنه من أحداث لغايةٍ تدفعهم إليها نوازع شتى، وتحدوهم إليه سلطة الحاكمين الذين اعتمدوا دعوى الكفاءة الأسرية في دعم سلطانهم حيناً والحق الإلهي حيناً آخر، وكان لهؤلاء الحاكمين أندادٌ وخصوم ومنافسون لهم في تأسيس الدولة الإسلامية يد وفي ماضيها قدم فشاءت هذه الأسر ألا تذكر لهم سابقة ولا تسجل لهم فضيلة، واعتاد المتلقون ذلك ودرجوا عليه، حتى لم يعد هؤلاء يعرفون من ماضي الأمة غير ما شاءت لهم السلطة معرفته، وحين جاء عصر المدونين لم يجدوا إلا رأياً عاماً رأوا في الخروج عليه خطراً يتهددهم بالرفض، فآثروا الإذعان للرأي العام، فاستبعدوا عن مدوناتهم ما اختلف مع الخط العام الذي اعتمده الرواة أو اعتمده لهم أولو الأمر، فكانت روايات سيف بن عمر دون غيرها المصدر الرئيس لتاريخ الطبري في أحداث الردة والفتوحات والفتن التي اضطربت بها الدولة الإسلامية منذ العام 11هـ حتى العام 37هـ. وقد أشار الطبري نفسه كما أشار غيره إلى اعتمادهم ما ينسجم مع الرأي العام أو مع مالا يختلف مع الخط(الرسمي)، قال في أخبار أبي ذر الغفاري مع معاوية: كرهت ذكر أكثرها. فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنهم ذكروا في ذلك قصة عن سيف. وقال ابن الأثير: (من سب معاوية إياه وتهديده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصاع النقل به) ثم أورد ما فصّله سيف في ذلك. وقال ابن خلدون فيما روي عن سيف: إنه أوثق ما رأيناه في ذلك وأبعد عن المطاعن والشبهة في كبار الأمة. وقال الطبري وقد ذكر مكاتبات محمد بن أبي بكر إلى معاوية: كرهت ذكرها لما فيها مما لا يحتمل سماعه العامة. لقد اكتسبت روايات سيف بن عمر قبول المؤرخين لما اشتملت عليه من تنزيه لسادات قريش -وهم كبار الأمة- ولا شأن للذين حط من أقدارهم من الرموز القحطانية على ما كان لها من التزام شديد بمبادئ الإسلام. لقد كتب تاريخنا بحذر شديد، ليس حذراً من الوقوع في الخطأ، بل حذرٌ من تدوين الصحيح الذي (لا تحتمله العامة) التي هيأت السلطات أذهانها في اتجاه محدد، ولربما حاول بعض رواة السيرة تجاوز ذلك بخطى قصيرة كالزهري الذي سجل له التاريخ مواقف لم يرضها أولو الطول والسلطان، وابن إسحاق الذي سجل روايات الزهري في الإمام علي بن أبي طالب(ع) والأنصار، على أنها مبادرة لم تفت القائمين على رسم مناهج التاريخ لمعالجتها، فعمد ابن هشام إلى تهذيبها(مما يسوء بعض الناس ذكره) ولعلّ هذا الذي يسوء بعض الناس ذكره من أخطر ما حذف من سيرة بن إسحاق. لقد أغفل مؤرخونا على عمد- أشياء- خطيرة جداً في مسيرة التاريخ ولكن ثمة نقاط ضوء تركت بين السطور تشير إلى ما وراءها، ولو وقف عندها أحد الباحثين لأضاءت له كثيراً من الظلمات، ولقادته إلى حقائق مذهلة حرص القائمون على كتابة التاريخ قديماً وحديثاً على طمسها. يقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه(الإسلام وأصول الحكم): كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه كلما حاولنا أن نبحث جيداً فيما رواه لنا التاريخ عن أولئك الذين خرجوا على أبي بكر فسمّوا بالمرتدين، وعن حروبهم تلك التي لقبوها حروب الردة، ولكن قبساً من نور الحقيقة لا يزال ينبعث من بين ظلمات التاريخ)(6). لقد أقصرت الحديث على تدوين التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى نظراً لأهميته القصوى في تفسير كثير من الأحكام، ولئن طالت يد السياسة الروايات الأولى فوضعتها في المنحى الذي تريد، فقد طالت أيضاً أحكاماً كثيرة بنيت على أساسٍ من تلك الروايات، يجدها المتتبع واضحة في مباحث الإمامة والإرث والقضاء والقدر، وفي أحكام الخمس وكثير من العبادات. وحين أدعو إلى إعادة قراءة التاريخ إنما أريد وصف ما يجري في ذهن رجلٍ يتكلم عن وقائع الماضي من منظور خاص به، كما ادعي أن واجب المؤرخين يجب أن يتركز في رفع مستوى المتلقين قبل رفع مستوى المؤرخ. فقد رأينا أن بعض مؤرخينا كابن خلدون وضعوا منهجيات وقواعد وأصولا، وحددوا مجموعة من العلوم يجب أن يتعرف عليها صاحب هذا الفن. ولكن ابن خلدون حين كتب التاريخ لم يستطع أن يخرج عن الطوق الذي وضعه المفهوم العام للأحداث فلم (يعرضها على أصولها ولا قاسها بأشباهها، ولا سيرها بمعيار الحاكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار) وحين ندعو إلى المنهجية في فهم الأحداث فإننا لا نريدها(مثل توجيهات الاستعمال التي تباع مع الآلات والأدوية) وأن يتوخى محللو الأحداث الصدق والوفاء لما يروونه. ولو أردنا مَعلماً في تاريخنا نهتدي به ونعيش على ضوئه لما أعدمنا أمثلة سبقت عصرها ولم تقتصر على وضع المنهجيات، بل مثلتها بصدق منقطع النظير.
(1)عبد الله العروي، مفهوم التاريخ23/1. (2)المصدر السابق29/1. (3)المصدر السابق23/1. (4)المصدر السابق17/1. (5)صائب عبد الحسين: تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي صفحة35. (6)الإسلام وأصول الحكم صفحة193. |