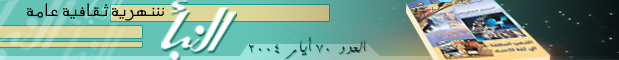
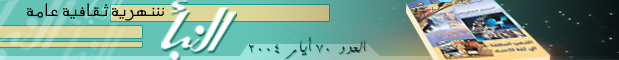 |
|
خطوة أولية نحو فهم الدستور |
|
محمد عبد المهدي |
|
مع طي صفحة النظام العراقي السابق، على جميع الأصعدة، والتسليم بالإجماع على زوال تلك الحقبة وبزوغ ضوء جديد في تأريخ العراق الحديث، فقد صار لزاماً مواكبة الملامح العديدة، والمشكّّلة لصورة المستقبل القادم للعراق. الزوايا التي يمكن النظر إليها تجاه الواقع العراقي الراهن عديدة، ومن العسير تقديم أحدها على الأخريات دون إمعان في الأسباب والمبررات، بيد أن الجميع يتفقون على أهمية الجانب الفكري والثقافي في بناء الفرد والمجتمع العراقي، بعد أن علاهما التآكل والتصدّع من جرّاء العقود الظلامية السابقة. النظرة الواقعية و(العملية) إن جاز التعبير، نحو الوضع العام للداخل العراقي يدعو إلى تكثيف الجهود واجتماعها حول مائدة العمل المشترك، للخروج من هذه المساحة المتقهقرة، بالقياس حتى مع الدول الصغيرة النامية، والاتجاه نحو مسار التنمية والتطور الثقافي والتقني... وإذا كان المفكرون والمثقفون وغيرهم يسلمون بصعوبة حصر وتعداد المشاكل والعراقيل التي يعاني منها الجانب الثقافي مثلاً في العراق اليوم، فإن من غير المنطقي تسليط الضوء عليها ولو بإيجاز في بضعة صفحات ليس إلا... غير أنه من المفيد القول بأن خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، هي أكثر معقولية من انتظار عصا سحرية تعيننا على تغيير سلبيات هذا الواقع وذاك. المشاهدات الأولية بهذا الخصوص تحيلنا إلى مسألة في غاية الأهمية من جهة استباقها لأغلب القضايا الفكرية والثقافية، ألا وهي (المصطلحات المتداولة)، تعريفها ومفهومها ودلالتها الحقيقية، بعيداً عن التشويش أو اللبس أو أي تراكمات آلت من تأثيرات المرحلة الفائتة. وهنا لابد من الوقوف عند ملاحظتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى- إن الجدل ليس في معرفة المصطلح أو حتى دراسته، بل في عمق تلك المعرفة أو الدراسة، والمنطلق المنهجي الذي اتبع لفهم واستيعاب مصطلح ما. خصوصاً وأننا نرى بما لا يقبل الشك تفاوتاً واضحاً في تقويم وعرض العديد من المفاهيم الفكرية والسياسية والاقتصادية السائدة في دائرة الأحداث على الساحة الدولية، ومردّ ذلك التفاوت إلى الاختلاف الإيديولوجي والعقائدي والتلون في التيارات الفكرية الموجِّهة للمجتمعات والأمم. الثانية- هناك ضرورة مُلحّة في تقديم مصطلح على آخر، لأهميته على الساحة المحلية أو الدولية أكثر من سواه. فالدستور والانتخابات والديمقراطية أشد أولوية اليوم في المشهد العراقي، من العولمة أو اتفاقية (الغات) على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن الأولوية الآنفة لا تلغي، بلا شك، استعراض المصطلحات والمفاهيم المتداولة في عالمنا اليوم، مادامت تلامس قضايانا الفكرية والثقافية.
الدستور.. كان من المتوقع تصدّر قضية وضع الدستور وسن القوانين والتشريعات، في بلد خرج للتو من منطقة فراغ دستوري استمرت لعقود، حيث يومئ المشهد السياسي العراقي اليوم، إلى حقيقة ما جرى بالأمس، والحال قريب من نقطة الصفر لأي مراقب يختزل تاريخ العراق ببضعة عقود أو حتى قرون سابقة، إلا أنّ مكمن الغرابة هو أن الجدال والنقاش يدور في بلد المسلّة التشريعية، الأشهر من أن تُعرَّف عالميا... وفي خضم التناوشات الأولية والتجاذب القانوني وحتى السياسي والديني حول قضية الدستور العراقي، لابد أولاً من معرفة الجوانب المتعلقة بالقضية، قبل التمادي في تحليل وتقويم ما يجري من سجالات داخلية.
زوايا التعريف.. لا غرابة في الاختلاف على تفاصيل وضع الدستور وتطبيقه، حين رؤية التقابل في تفسيره وفهمه أساسا. ففي الوقت الذي تتفق الأطراف على أهمية تلك القواعد القانونية في كل مجتمع إنساني، والتي تمثل الدستور المتضمن قواعد الدولة الأساسية، فقد اختلفت في مصادر سن القوانين الدستورية، تلازماً مع الاختلاف في منهج التفكير المتّبع، فمن معتبر أن الدستور هو مجموعة القواعد التي تحدد سلطات الطبقة الحاكمة وتقيد من امتيازاتها أثناء ممارستها لهذه السلطات، وبالدرجة التي تقرّ بها للأفراد بحقوقهم وحرياتهم(1)؛ لغاية مَن نفى وجود أي دستور غير الأدلة الأربعة المذكورة فقهياً (الكتاب والسنة والإجماع والعقل)، وذلك عندما يكون الحديث عن أسس الدولة الإسلامية(2)، مروراً بعديد التعاريف الأخرى، ومنها التعريف المعجمي القائل بأن الدستور هو أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة. وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة(3). وهكذا فإن لكل دولة دستور، مكتوباً كان أو غير مكتوب، كما هو الحال في بريطانيا. ومثلما تمتاز بعض الدساتير بجواز تعديلها بقانون تصدره الهيئة التشريعية أو الهيئات التنفيذية في الدولة، دون حاجة إلى إجراءات معقدة وخاصة، فهناك في الوقت نفسه دساتير تتصف بالجمود، وتعديلها يتطلب إجراءات معقدة، مثل استفتاء الشعب أو إجماع مجلس النواب أو أغلبية الثلثين ونحو ذلك من إجراءات. والدستور يبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغييرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها، ثم علاقاتها مع المواطنين وتبيان حقوقهم وواجباتهم، وهو ضمانة لحريات الأفراد وحقوق الجماعات. ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى، ومن هنا كان استقلال القضاء في الدولة أمراً حيوياً(4). ونفهم من ذلك أن الدستور يفترض أن يمثل الشرعية في الأمة، ويعكس الرأي العام أو الاتجاه العام السائد. وفي الوقت الذي يضمن وحدة الدولة أرضاً وشعباً، فإنه لا يكتفي بتناول الحاضر، بل يتجاوز إلى النظر للمستقبل أيضا.
الدستور معدّلاً ومؤقتاً.. في الأمم التي يكون الشعب هو مصدر السلطات الثلاث، فإن إدخال تغييرات على نصوص المواد التي يتألف منها القانون الأساسي للدولة، لا يتعارض مع قدسية الدستور وتحريم المساس بها، مادام أن الشعب نفسه له الحق في إجراء تعديلات تبيحها نصوص الدستور ذاته، وتتيح له مسايرة التقدم والتطور. ومع ذلك، فإن الدساتير الموضوعة تختلف من جهة درجة الصعوبة في الإجراءات المتبعة في تعديلها. فهناك الدساتير التي يمكن القول عنها بأنها (مرنة)، حيث يمكن تعديل نصوصها اللازمة لتعديل تلك القوانين، والسلطة التشريعية تملك صلاحيات واسعة لتعديل فقراتها وتفرعاتها. أما الدساتير التي يمكن القول بأنها (جامدة)، فهي كما تبدو ظاهراً، عكس الأولى، من حيث الصعوبة في التعديل، كاشتراط أن يتم ذلك بأغلبية عددية خاصة في البرلمان، أو اجتماع أعضاء مجلس البرلمان جميعاً، أو بإجراء انتخابات جديدة وتكوين برلمان جديد لتعديل الدستور، أو بإجراء استفتاء شعبي. وعلى هذا يمكن ملاحظة أن مفردة (الجمود) الآنفة إنما عُني بها صعوبة التعديل من حيث إجراءاته، لا مسألة التحجر في القوانين نفسها وعدم القدرة على المساس بها مطلقاً، أي أن المسألة نسبية، رغم أنه قد يكون هناك استثناء في حالات معينة، كأن ينص الدستور على عدم إمكانية تعديله خلال فترة معينة من تاريخ صدوره، أو تقييده بالجمهورية أو الملكية، كشكل دائم للحكم في الدولة، من دون تناسي أن (القطعية) في القوانين، إن وجدت، هي قطعية وحَدّية من الزاوية النظريّة وحسب. حيث أثبت الواقع أن ضغط الأحداث في الأمم والشعوب قد يكون أحياناً كثيرة أقوى من هذه النصوص التي يفترض أنها محرِّمة التعديل أو التغيير. وفي الجانب الآخر هناك الدستور الذي تعمل في ظله الدولة لفترة محددة على سبيل التجربة والاختيار، أو الذي يوضع لمرحلة معينة من تاريخ الأمة، على أمل إيجاد دستور دائم يعمل به يسمى بـ (الدستور المؤقت). وغالباً ما صدرت الدساتير المؤقتة على أثر الانقلابات السياسية أو العسكرية، أو التحولات الخطيرة في أنظمة الدول. وذلك حتى يتسنى للسلطة الحاكمة وضع دستور دائم تقرّه المؤسسات المختصة (الصالحة)، ويكون متناسباً مع آمال الأمة وأمانيها القومية والوطنية(5). لا حاجة بنا إلى الإسهاب في خصوص هذه الفقرة الأخيرة، حيث أثبتت الوقائع أيضاً أن العديد من تلك الانقلابات والتحولات الخطيرة آلت إلى نتائج دراماتيكية، حالت بدورها دون الوصول إلى دستور دائم يسيّر شؤون الدولة، بل وحتى دون تطبيق أبسط مفردات قوانين الدستور المؤقت نفسه!
الدستور والإسلام.. وقد يكون التأطير الإسلامي للقوانين في بعض بلداننا الإسلامية هو الحكمة المقابلة للامعقولية المتمثلة في حلم فرض الدستور الإسلامي بضربة سيف واحدة. نعم، لا خلاف في أن الدستور الإسلامي محدد في دائرة الحجية الشرعية التي حددتها الشريعة بالأدلة الأربعة، وهذا غير اصطلاح الدستور الذي وضعته الدول والأنظمة السياسية في العصر الحاضر، وبالخصوص الدول الديمقراطية، حيث وسّعت من دائرة التقنين ومنحت للحاكم، بالإضافة إلى دور التنفيذ والإجراء، حق تشريع القانون وجعل القواعد الملزمة حسبما تقتضيه الحاجة أولاً، والمصلحة ثانيا(6). إسلامياً، هناك من يصر على التساؤل أنه مادامت الأدلة الأربعة آنفة الذكر قد بينت رأي الشرع في جميع مناحي الحياة، فما هي الحاجة إذن إلى وضع دستور يسيّر البلاد والعباد؟.وعلى هذا لا ينحى القول بأن الإسلام لا يحتاج إلى دستور، منحى الاستفزاز، مادام الدين الإسلامي ليس نظرية تحتاج إلى دستور مكتوب ينزلها إلى حيّز الواقع والتطبيق. أما التساؤل المعاكس الذي قد يتبادر لدى بعضهم، بخصوص المستجدات الآيلة من تقدم وتطور الحياة، فجوابه مطروح منذ قرون، وتحديداً مع بزوغ الفقه الإسلامي وفروعه، حيث رسمت الشريعة الإسلامية لنا الخطوط العريضة لكيفية التعامل مع تلك المستجدات والمستحدثات، بالرجوع إلى الفقهاء القادرين على استنباط الأحكام التكليفية. وهنا لا ينبغي تناسي رأي بعضهم القائل أنه في ظرف مّا،مع التشديد على هذه الأخير، قد يكون السير وفق دستور وضعي مكتوب أكثر واقعية من قرينه العرفي، حيث التقاليد والأعراف المجتمعية الراسمة لتفاصيل الدستور. فالدستور العرفي هو مجموعة الأعراف والتقاليد والاجتهادات القضائية (التي تتم في المحاكم)، بالإضافة إلى المواثيق التي يضطر لها الحكام بضغط من الطبقات الاجتماعية المختلفة إلى إصدارها. وهي غير مقننة في نص قانوني ورسمي(7). ومن الجدير هنا أن نشير الى بضع ملاحظات رديفة بما ذكر: 1-إن التدرج والتتابع في تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية، ومن ضمنها تدرج التأطير الإسلامي للدستور، بما يتلاءم ومستجدات العصر، قد يكون الأقرب للواقعية العملية، خصوصاً عندما يكون المقابل الضياع في غياهب التخلف العقائدي والإيماني. 2-تطبيق الدستور، أياً كان، يجب يمرر شيئاً فشيئاً إلى الأفراد والمؤسسات، خصوصاً تلك الفقرات التي تحمل في طياتها الكثير من اللغط والنقاش. والشواهد أكثر من أن تحصى على ردود فعل عكسية تجاه الإكراه على تطبيق الأحكام والقوانين بالوسائل الصارمة. 3-الدساتير لا تلقّن من الخارج، كما هي لا تفرض من الداخل، سواء بقوة السلاح او الإعلام على سبيل المثال، فالدستور هو خلاصة لقناعة الأمة بالأسلوب والمنهج والقوانين المراد السير وفقها. 4-تبقى الكلمة الفيصل في شكل الدستور وما يتضمنه من قوانين تمتلكها الشعوب وحدها. وتلك مسألة ثانية تتعلق بقضايا الانتخابات والإستفتاءات الشعبية. فالشعوب هي التي تستطيع البتّ في شأن إعطاء زمام الأمور بيد المرجعية الدينية أو السياسية أو حتى العسكرية إن شاءت ذلك.
(1)القانون الدستوري، د. إسماعيل غزال. (2)الحكومة الديمقراطية، الشيخ فاضل الصفار. (3)معجم المصطلحات السياسية. (4)المصدر السابق. (5)المصدر السابق. (6)الحكومة الديمقراطية، الشيخ فاضل الصفار. (7)المصدر السابق. |