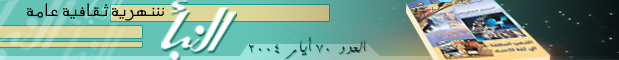
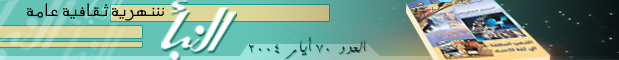 |
|
الاسلام واسئلة العصر |
|
أحمد حسن |
|
يستطيع المراقب لأحوال المسلمين أن يلاحظ بشكل جلي واضح أن هنالك مفارقة كبيرة تميزهم عن غيرهم من أتباع الديانات المعروفة سماوية كانت أم وضعية. فمن جهة يبدو الإسلام وبعد مرور خمسة عشر قرناً على انطلاق الدعوة الإسلامية من شبه الجزيرة العربية، قد انتشر في معظم أرجاء الكرة الأرضية من مشارقها إلى مغاربها ويصنف اليوم على أنه الدين الأسرع انتشاراً بين البشر في دول العالم، إلا أنه ومن جهة أخرى يبدو ديناً محاصراً مطارداً تلاحقه تهمة الإرهاب ووصمة التخلف، وترسم له وسائل الإعلام الغربية منها بشكل خاص صورة الشبح المخيف الذي يهدد الحضارة الغربية بالدمار، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول التي جعلت الإسلام والمسلمين في موقع المتهم، دون أن ننسى حقيقة أن الدول التي ترفع لواء الإسلام لا تجد لها مكاناً ضمن قائمة الدول المتحضرة أو حتى قائمة الدول الصناعية الكبرى. منذ خمسة عشر قرناً كان الإسلام ولفترة طويلة هو الحاضنة الرئيسية لحضارة العالم وكانت مدنه المزدهرة مثل بغداد ودمشق وقرطبة هي مدن العالم الرئيسية، وكان المسلمون هم الجسر الذي يربط بين حضارات العالم القديم وحضارة العالم الحديث، عبر علماء ورجال فقه، ورجال دين ودنيا استوعبوا ما سلف ثم أضافوا إليه من لدنهم الكثير وقدموا عصارة ذلك للعالم. اليوم لا يستطيع أي مراقب منصف أن يمنع نفسه من السؤال ماذا حدث حتى وصل الإسلام إلى هذه الحالة؟. أين يكمن السبب الحقيقي لهذه المفارقة الغريبة؟ هل هي قصة الحضارة التي يشبهها بالإنسان يولد ويموت؟. هل هنالك تفسير علمي شاف لما حدث؟ ثم ما هو موقفنا نحن المسلمين؟ هل يكفي أن نتهم أعداء الإسلام بأنهم يقدمون عنه صورة خادعة وكاذبة، أم أن علينا أن نعترف بالحقيقة مهما كانت جارحة؟ باعتبار ذلك يشكل خطوة أولى نحو إيجاد الحلول التي تسمح لنا بأن نعود إلى المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، وأن نلعب دورنا الذي نستحق عليه - عندها فقط - أن يباهي بنا رسولنا الكريم (ص) الأمم يوم القيامة. نحن في أزمة واضحة للعيان، أزمة لم تعد تحتمل الإنكار، أو الأجوبة المراوغة الكاذبة. وأزعم أن بداية الإجابة على أسئلة الأزمة تكون بالاعتراف بها أولاً، ثم البدء بعملية البحث العلمي الجاد و الدؤوب والحر بنفس الوقت للوصول إلى إجابة واضحة لسؤال يبدو بسيطاً للوهلة الأولى ولكني أزعم أنه أكثر إلحاحا من جميع الأسئلة الأخرى، متى بدأ هذا الانحدار؟. وأحسب أن أزمة أي حضارة، دينية كانت أم دنيوية تبدأ عندما يتراجع العقل أمام النقل، ويتراجع التفكير الحر الواعي أمام التفكير الظلامي المغلق، الذي يهدف إلى تجميد وتثبيت النص - مطلق نص - في دائرة مقدسة، بحيث يصبح مجرد التفكير كفراً يستأهل الموت أو على الأقل الطرد خارج جنة الجماعة. وبالتالي يصبح النص غير المفكر فيه و به، نصاً لا يقدر على الإجابة على أسئلة جديدة تطرح نفسها مع كل شروق جديد للشمس. علماً بأنه يجب ألا نغفل بالتأكيد دور الصراعات السياسية والحركات الاجتماعية في جدلية العقل والنقل سلباً أم إيجاباً، أي في انتصارها أو استخدامها لأحد الطرفين في مواجهة الآخر، وأزعم أن هذا أو ما يشابهه قد حدث في حضارات بلاد ما بين النهرين، ووادي النيل والحضارة الإغريقية، والفارسية، حيث أن الصراع داخل مكونات كل من هذه الحضارات على حدة، وانتصار النقل فيها على العقل أوصلها إلى مرحلة لا تستطيع فيه الإجابة على الأسئلة الجديدة فكان مصيرها السقوط والاندثار. في الإسلام نستطيع أن نرى ملامح الصراع تتشكل منذ اللحظة الأولى بعد وفاة الرسول الكريم (ص) (منا أمير ومنكم أمير)، لا يفيدنا في شيء أن نخفي رؤوسنا كالنعامة فمنذ تلك اللحظة المبكرة من عمر الإسلام، بدأت بذور الصراع بالتكون، صراع غامض غير واضح المعالم إذا حاولنا التستر عليه، فإننا لن نستطيع التستر أبداً على أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة، وضع الاحتكام للسلاح حداً لحياتهم، مع ما يحمله ذلك من معان وبعضهم يضيف عمر بن عبد العزيز كخليفة راشدي خامس، وهم بذلك يضيفون قتيلاً آخر للسابقين، وإن لم يكن السيف هو من فعلها، إلا أن أدوات القتل الأخرى لا يمكن الاستهانة بها أبداً. تلك الفترة كان الإسلام الصاعد، المنطلق يستطيع بشكل أو بآخر تجاوز هذا الأمر، أو حتى مجرد تأجيل الأزمة، فقد كان أغلب المسلمين هم ممن عايش الرسول (ص) وعاش معه تجربة الإسلام الأول الطاهر، النقي، الذي لم يكن له من هم سوى إعلاء كلمة الله، بل بعضهم كان قد عايش تجربة العذاب في مكة المكرمة والهجرة إلى المدينة المنورة. لذلك بقيت الأزمة جمرا تحت الرماد لا ينطفئ ولكنه لا يشتعل أيضاً، بحيث يحرق التجربة الغضة التي نقلت العرب من قبائل متفرقة متصارعة، إلى أصحاب إمبراطورية مترامية الأطراف، دون أن تفوتنا الإشارة إلى الأحداث التي ترتبت على الفتنة الكبرى وظهور الخوارج إلى ساحة الفعل في الإسلام. وبما أنني لست في سياق تقديم بحث مفصل حول سيرورة الأزمة بعد ذلك سواء أكانت ظاهرة أم مخفية - ولذلك بحث آخر - نظراً لضيق المقام فإنني سأعمد مباشرة إلى الولوج إلى اللحظة التي يعتبرها الكثيرون - وأنا منهم - لحظة الأزمة كما تسمى، وهي اللحظة التي انتصر فيها النقل على العقل بشكل نهائي في الحضارة الإسلامية، وتمثلت بانتصار الغزالي وتياره، على ابن رشد وتياره حتى ليمكننا القول أننا بشكل أو بآخر لا نزال نعيش تبعات ذلك الصراع الذي قذف بفيلسوف عقلاني مثل ابن رشد إلى منظومة حضارية أخرى تلقفته تلقف الأرض العطشى للماء، بعد أن اختار أصحابه ماء آخر وسبلا أخرى. بدأت مقدمات لحظة الغزالي تتشكل بشكل جلي، منذ أن اختار الخليفة العباسي المأمون ولأسباب محض سياسية أن يعلن القول بخلق القرآن، وأن يرفع من مقام القائلين به وهم في ذلك الوقت المعتزلة، الذين دفع بهم إلى واجهة الأحداث طالباً امتحان الناس بمسألة خلق القرآن فمن أجاب فله الأمان، ومن رفض يضرب عنقه، بما يعنيه ذلك من احتكام للسيف في خلاف فكري أو هكذا أريد له أن يبدو، وعلى ذلك سار خليفته (المعتصم). أما في زمن الخليفة المتوكل فقد انقلب الأمر لأن التهديد الذي يواجهه المتوكل كان يأتي من جانب قادة جنده الأتراك، الذين كانوا أصحاب السلطة الفعليين واللاعبين الرئيسيين في بغداد حاضرة الخلافة يومذاك، وهكذا نظر المتوكل حوله فوجد أن القوة التي تستطيع مساعدته هي المعارضة السنية الحنبلية، التي كانت تهيمن على الشارع حينذاك، وكان الانقلاب السريع، فمن يقول إن القرآن مخلوق يضرب عنقه، ومن يقول إنه غير مخلوق يقرب وترفع درجته، وهكذا نرى أن الدين يستخدم للمرة الألف في الصراع على السلطة ومرة أخرى كان السيف هو الحكم الذي لا مجال لمراجعة أحكامه. المهم في الأمر أن المعتزلة ممثلو التيار العقلاني وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مطاردين، منبوذين، مهددين بالقتل من قبل سلطة متحالفة مع تيار ثقافي، ينادي بأولوية النص وأسبقيته على العقل، بل وباستبعاد الأخير من حيث هو عقل فعال مفكر، من ساحة الفكر، وتوج ذلك إعلان أحد أهم تلاميذ المعتزلة (أبو الحسن الأشعري) انضمامه إلى التيار الآخر. وبكلمة بسيطة وعلى المستوى الفكري، فإن قول المعتزلة إن القرآن مخلوق كان يعني التركيز على الإنسان، ودوره في اختيار حياته وتصرفاته، وما ينتج عن ذلك من نتائج بينما كان قول الأشاعرة إن القرآن غير مخلوق، يعني التركيز على الخالق وإهمال دور الإنسان، وأيضاً ما ينتج عن ذلك. و على هذا فإن انتصار الأشاعرة وفق ما أسلفنا كان المقدمة المطلوبة لبروز ظاهرة الغزالي (تولد 450 هـ) الذي اعتنق الفكر الصوفي والأشعري معاً ليصل إلى نتيجة تقول: إن الزهد في الدنيا والانقطاع للآخرة هما الفوز الأكبر للإنسان، علماً أن الآخرة والدنيا عند الغزالي هما (كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر) لتحل هذه المقولة وأمثالها أمام مقولة (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) والتي كان يرددها المسلمون في فترة صعودهم الحضاري. وبذلك تكونت تلك اللحظة الفارقة التي ندعوها بلحظة الغزالي، استناداً إلى ما كان يمثله هذا الفيلسوف المتصوف من سطوة دينية ودنيوية، باعتباره من مثقفي السلطة العضويين - بكلامنا هذه الأيام - فقد التقت رغبته (بطلب الجاه وانتشار الصيت) مع رغبة السلطة وسياستها في محاربة الحركات المقاومة لها كالباطنية مثلاً، هذا الالتقاء في المصالح هو الذي دفعه لتأليف كتابه (فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) الذي يخبرنا في مقدمته أنه ألفه (بناء على الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية) وكتابه الآخر (تهافت الفلاسفة) الذي الفه ليحط من شأن الفلسفة والفلاسفة، وبذلك يكون قد أتم هجومه على مناوئي السلطة من باطنيين وفلاسفة، وأكمل إغلاق الدائرة حولهم، فالسلطة تحاربهم بالسيف وبالفكر المضاد، وهكذا قدم لنا الغزالي مثالاً لمثقف السلطة، نجده في كل الثقافات، ويعبر عن التقاء المصالح بين المثقف والسلطة، فيستخدم أحدهما الآخر للإيقاع بخصومه، لكن التاريخ يخبرنا أن هذه الشراكة تنتهي دائماً لصالح الطرف الأقوى وهو السلطة في كل الأحوال. ماذا كانت نتيجة هذا الصراع الطويل الذي تحدثنا بشكل مقتضب عن بعض فصوله؟ النتيجة كانت أن الثقافة الإسلامية وبالتالي العربية قد تراجعت واقتصرت على النص استجابة لعوامل مختلفة يبدو أنها لازالت هي الفاعل الأكبر منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. تلك هي المشكلة فما هو الحل، إننا وإن كنا لا نستطيع الادعاء بأننا نمتلك الحل إلا أننا نزعم أننا اليوم نبدو أحوج من أي وقت مضى لاستعادة سلطة العقل ودفعه إلى لعب دوره الحقيقي والفعال في بناء المجتمع والإنسان، علماً أننا لا نستطيع أن ننكر أن اللاعب الحقيقي في ساحة الثقافة الإسلامية العربية اليوم هو النص سواءً أكان نصاً دينياً أم غير ديني وما نقوله عن أزمة الإسلام، ينطبق من حيث سيطرة قدسية النص على دعاة القومية والماركسية والليبرالية الحديثة، فهؤلاء جميعاً قد وضعوا نصوصهم الخاصة بهم، وأحاطوها وتفسيراتها بهالة من القدسية حتى أصبحت عصية على المراجعة والنقد، وانتقلت من دائرة الدنيوي المفكر به إلى دائرة المقدس غير المسموح بتناوله، هذه الأزمة التي نعيشها تحتاج إلى خطوات جريئة وشجاعة، تحتاج إلى أجوبة سريعة حول أسئلة راهنة مثل: ألم يحن الوقت للعمل على تفكيك التركيبات المعرفية للعقل الذي يسيطر علينا ونفكر به وفيه بنفس الوقت؟ والذي علينا أن نعترف بشجاعة أنه يعيش بأزمة نتيجة تقييده بالنص السنا بحاجة إلى توصيف الداء وتسمية الأشياء بأسمائها؟ لنتمكن من تحضير العلاج الشافي لها. قديماً قال السيوطي المتوفى سنة (910هـ) إنه (يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب). فكيف سمحنا لنص المتقدمين أن يغلق باب الاجتهاد أمام اللاحقين وأنا اقصد بالنص هنا مجموعات المدونات التي رفعت بحدود القرن الثالث عشر الميلادي إلى مرتبة النصوص المقدسة). ثم هل يعقل أن يبقى فهمنا للنص مرتبطا بالإطار الثقافي والأفق العقلي لمسلمين عاشوا قبلنا بقرون تربو على العشر، كيف نقبل أن تحكمنا آراؤهم وتحليلاتهم، التي كانت صحيحة في حينها، ونحن نعيش في عالم آخر، عالم يستطيع فيه المرء أن يحصل على معلومات هائلة حول أي شيء بكبسة زر واحدة بحيث تبدو معلومات القدماء أمامها شيء لا يذكر؟ ألا يتعارض ذلك مع مفهومنا القائل أن دلالة النص المقدس - القرآن الكريم - تتجاوز حدود الزمان والمكان؟ إن الغرب لم يبني حضارته الحديثة بغض النظر عن رأينا بها، إلا بعد أن أشبع لاهوته دراسة وبحثاً، وبالتأكيد ليس هنا مجال المماحكة حول تدين الغرب أو إلحاده، فيكفي أن نقوم بدراسة موضوعية حول المجتمع الأمريكي مثلاً لنعرف ما هو حجم انتشار الدين والمعتقدات الدينية بين صفوفه. نستطيع القول أن مثقفينا ينقسمون إلى تيارين رئيسون، العلمانيون والإسلاميون، وضمن هذين التيارين توجد تفرعات مختلفة. ولكن بمراجعة دقيقة لخطاب هؤلاء المثقفين من الطرفين ومن ينوس بينهما نجد - مع استثناءات قليلة - أنهم ينقسمون بشكل واضح إلى علمانويين وإسلاموين. فالعلمانويون يحاولون إحداث قطيعة كاملة مع الزمن الإسلامي بحجة أن الحضارة هناك في الغرب، ويجب التماهي معها إلى الحد الأقصى، ونحن وإن كنا نوافق على ذلك، إلا أننا نرى أن هذا النوع من التفكير والرفض العلمانوي لدراسة الدين وتفكيك بنيته الداخلية باعتباره لازال الفاعل الأكبر في حيز الثقافة العربية والإسلامية، لم ينتج عنه سوى المزيد من الغربة لهذه الفئة، ولم تستطع تجربتهم أن تتأصل في مجتمعاتنا لسبب واضح، وهو أنهم حاولوا تطبيق علمانية شعوب أخرى تمتلك تجربتها السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة عن تجربتنا، وأرجو ألا يفهم هذا القول على أنه دعوة للخصوصية كما يدافع عنها بعضهم والتي أصبحت بفضلهم كلمة حق يراد بها باطل. وعلى الجانب الآخر من المشهد الثقافي والاجتماعي نجد أن الإسلاميين لا ينفكون يبشروننا بالفردوس المفقود، والماضي الذهبي للحضارة الإسلامية، وأن طريق استعادة كل ذلك يبدأ باستعادة تلك المرحلة بقضها وقضيضها أي الحل خلفنا وليس أمامنا. وهكذا وجدنا أنفسنا بين إسلاموية تريد إعادتنا للماضي وعلمانيون حقيقيون وإسلاميون حقيقيون أيضاً، إلا أنهم - ويا للأسف لم يزالوا صوت صارخ في البرية. والحق أننا لا نريد سوى نظام يكون التقدم الإنساني، والاجتماعي والسياسي والأخلاقي والثقافي فيه هو البوصلة التي يسير هذا النظام المأمول على هديها. ويحضرني هنا سؤال مهم جداً للمفكر محمد أركون: (ألسنا بحاجة إلى ماكس فيبر جديد يدرس لنا العلاقة بين التنمية من جهة، وبين الظاهرة الدينية من جهة أخرى)؟ لتكون نقطة إنطلاق لحداثتنا المأمولة، ولتضعنا مرة أخرى على سكة الحضارة الإنسانية كفاعلين إيجابيين، وليس كمتفرجين سلبيين على أحداث لا يد لنا في صنعها، مما قد يعرضنا للطرد خارج المسرح في أي لحظة يقررها الآخرون. يستطيع المراقب لأحوال المسلمين أن يلاحظ بشكل جلي واضح أن هنالك مفارقة كبيرة تميزهم عن غيرهم من أتباع الديانات المعروفة سماوية كانت أم وضعية. فمن جهة يبدو الإسلام وبعد مرور خمسة عشر قرناً على انطلاق الدعوة الإسلامية من شبه الجزيرة العربية، قد انتشر في معظم أرجاء الكرة الأرضية من مشارقها إلى مغاربها ويصنف اليوم على أنه الدين الأسرع انتشاراً بين البشر في دول العالم، إلا أنه ومن جهة أخرى يبدو ديناً محاصراً مطارداً تلاحقه تهمة الإرهاب ووصمة التخلف، وترسم له وسائل الإعلام الغربية منها بشكل خاص صورة الشبح المخيف الذي يهدد الحضارة الغربية بالدمار، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول التي جعلت الإسلام والمسلمين في موقع المتهم، دون أن ننسى حقيقة أن الدول التي ترفع لواء الإسلام لا تجد لها مكاناً ضمن قائمة الدول المتحضرة أو حتى قائمة الدول الصناعية الكبرى. منذ خمسة عشر قرناً كان الإسلام ولفترة طويلة هو الحاضنة الرئيسية لحضارة العالم وكانت مدنه المزدهرة مثل بغداد ودمشق وقرطبة هي مدن العالم الرئيسية، وكان المسلمون هم الجسر الذي يربط بين حضارات العالم القديم وحضارة العالم الحديث، عبر علماء ورجال فقه، ورجال دين ودنيا استوعبوا ما سلف ثم أضافوا إليه من لدنهم الكثير وقدموا عصارة ذلك للعالم. اليوم لا يستطيع أي مراقب منصف أن يمنع نفسه من السؤال ماذا حدث حتى وصل الإسلام إلى هذه الحالة؟. أين يكمن السبب الحقيقي لهذه المفارقة الغريبة؟ هل هي قصة الحضارة التي يشبهها بالإنسان يولد ويموت؟. هل هنالك تفسير علمي شاف لما حدث؟ ثم ما هو موقفنا نحن المسلمين؟ هل يكفي أن نتهم أعداء الإسلام بأنهم يقدمون عنه صورة خادعة وكاذبة، أم أن علينا أن نعترف بالحقيقة مهما كانت جارحة؟ باعتبار ذلك يشكل خطوة أولى نحو إيجاد الحلول التي تسمح لنا بأن نعود إلى المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، وأن نلعب دورنا الذي نستحق عليه - عندها فقط - أن يباهي بنا رسولنا الكريم (ص) الأمم يوم القيامة. نحن في أزمة واضحة للعيان، أزمة لم تعد تحتمل الإنكار، أو الأجوبة المراوغة الكاذبة. وأزعم أن بداية الإجابة على أسئلة الأزمة تكون بالاعتراف بها أولاً، ثم البدء بعملية البحث العلمي الجاد و الدؤوب والحر بنفس الوقت للوصول إلى إجابة واضحة لسؤال يبدو بسيطاً للوهلة الأولى ولكني أزعم أنه أكثر إلحاحا من جميع الأسئلة الأخرى، متى بدأ هذا الانحدار؟. وأحسب أن أزمة أي حضارة، دينية كانت أم دنيوية تبدأ عندما يتراجع العقل أمام النقل، ويتراجع التفكير الحر الواعي أمام التفكير الظلامي المغلق، الذي يهدف إلى تجميد وتثبيت النص - مطلق نص - في دائرة مقدسة، بحيث يصبح مجرد التفكير كفراً يستأهل الموت أو على الأقل الطرد خارج جنة الجماعة. وبالتالي يصبح النص غير المفكر فيه و به، نصاً لا يقدر على الإجابة على أسئلة جديدة تطرح نفسها مع كل شروق جديد للشمس. علماً بأنه يجب ألا نغفل بالتأكيد دور الصراعات السياسية والحركات الاجتماعية في جدلية العقل والنقل سلباً أم إيجاباً، أي في انتصارها أو استخدامها لأحد الطرفين في مواجهة الآخر، وأزعم أن هذا أو ما يشابهه قد حدث في حضارات بلاد ما بين النهرين، ووادي النيل والحضارة الإغريقية، والفارسية، حيث أن الصراع داخل مكونات كل من هذه الحضارات على حدة، وانتصار النقل فيها على العقل أوصلها إلى مرحلة لا تستطيع فيه الإجابة على الأسئلة الجديدة فكان مصيرها السقوط والاندثار. في الإسلام نستطيع أن نرى ملامح الصراع تتشكل منذ اللحظة الأولى بعد وفاة الرسول الكريم (ص) (منا أمير ومنكم أمير)، لا يفيدنا في شيء أن نخفي رؤوسنا كالنعامة فمنذ تلك اللحظة المبكرة من عمر الإسلام، بدأت بذور الصراع بالتكون، صراع غامض غير واضح المعالم إذا حاولنا التستر عليه، فإننا لن نستطيع التستر أبداً على أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة، وضع الاحتكام للسلاح حداً لحياتهم، مع ما يحمله ذلك من معان وبعضهم يضيف عمر بن عبد العزيز كخليفة راشدي خامس، وهم بذلك يضيفون قتيلاً آخر للسابقين، وإن لم يكن السيف هو من فعلها، إلا أن أدوات القتل الأخرى لا يمكن الاستهانة بها أبداً. تلك الفترة كان الإسلام الصاعد، المنطلق يستطيع بشكل أو بآخر تجاوز هذا الأمر، أو حتى مجرد تأجيل الأزمة، فقد كان أغلب المسلمين هم ممن عايش الرسول (ص) وعاش معه تجربة الإسلام الأول الطاهر، النقي، الذي لم يكن له من هم سوى إعلاء كلمة الله، بل بعضهم كان قد عايش تجربة العذاب في مكة المكرمة والهجرة إلى المدينة المنورة. لذلك بقيت الأزمة جمرا تحت الرماد لا ينطفئ ولكنه لا يشتعل أيضاً، بحيث يحرق التجربة الغضة التي نقلت العرب من قبائل متفرقة متصارعة، إلى أصحاب إمبراطورية مترامية الأطراف، دون أن تفوتنا الإشارة إلى الأحداث التي ترتبت على الفتنة الكبرى وظهور الخوارج إلى ساحة الفعل في الإسلام. وبما أنني لست في سياق تقديم بحث مفصل حول سيرورة الأزمة بعد ذلك سواء أكانت ظاهرة أم مخفية - ولذلك بحث آخر - نظراً لضيق المقام فإنني سأعمد مباشرة إلى الولوج إلى اللحظة التي يعتبرها الكثيرون - وأنا منهم - لحظة الأزمة كما تسمى، وهي اللحظة التي انتصر فيها النقل على العقل بشكل نهائي في الحضارة الإسلامية، وتمثلت بانتصار الغزالي وتياره، على ابن رشد وتياره حتى ليمكننا القول أننا بشكل أو بآخر لا نزال نعيش تبعات ذلك الصراع الذي قذف بفيلسوف عقلاني مثل ابن رشد إلى منظومة حضارية أخرى تلقفته تلقف الأرض العطشى للماء، بعد أن اختار أصحابه ماء آخر وسبلا أخرى. بدأت مقدمات لحظة الغزالي تتشكل بشكل جلي، منذ أن اختار الخليفة العباسي المأمون ولأسباب محض سياسية أن يعلن القول بخلق القرآن، وأن يرفع من مقام القائلين به وهم في ذلك الوقت المعتزلة، الذين دفع بهم إلى واجهة الأحداث طالباً امتحان الناس بمسألة خلق القرآن فمن أجاب فله الأمان، ومن رفض يضرب عنقه، بما يعنيه ذلك من احتكام للسيف في خلاف فكري أو هكذا أريد له أن يبدو، وعلى ذلك سار خليفته (المعتصم). أما في زمن الخليفة المتوكل فقد انقلب الأمر لأن التهديد الذي يواجهه المتوكل كان يأتي من جانب قادة جنده الأتراك، الذين كانوا أصحاب السلطة الفعليين واللاعبين الرئيسيين في بغداد حاضرة الخلافة يومذاك، وهكذا نظر المتوكل حوله فوجد أن القوة التي تستطيع مساعدته هي المعارضة السنية الحنبلية، التي كانت تهيمن على الشارع حينذاك، وكان الانقلاب السريع، فمن يقول إن القرآن مخلوق يضرب عنقه، ومن يقول إنه غير مخلوق يقرب وترفع درجته، وهكذا نرى أن الدين يستخدم للمرة الألف في الصراع على السلطة ومرة أخرى كان السيف هو الحكم الذي لا مجال لمراجعة أحكامه. المهم في الأمر أن المعتزلة ممثلو التيار العقلاني وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مطاردين، منبوذين، مهددين بالقتل من قبل سلطة متحالفة مع تيار ثقافي، ينادي بأولوية النص وأسبقيته على العقل، بل وباستبعاد الأخير من حيث هو عقل فعال مفكر، من ساحة الفكر، وتوج ذلك إعلان أحد أهم تلاميذ المعتزلة (أبو الحسن الأشعري) انضمامه إلى التيار الآخر. وبكلمة بسيطة وعلى المستوى الفكري، فإن قول المعتزلة إن القرآن مخلوق كان يعني التركيز على الإنسان، ودوره في اختيار حياته وتصرفاته، وما ينتج عن ذلك من نتائج بينما كان قول الأشاعرة إن القرآن غير مخلوق، يعني التركيز على الخالق وإهمال دور الإنسان، وأيضاً ما ينتج عن ذلك. و على هذا فإن انتصار الأشاعرة وفق ما أسلفنا كان المقدمة المطلوبة لبروز ظاهرة الغزالي (تولد 450 هـ) الذي اعتنق الفكر الصوفي والأشعري معاً ليصل إلى نتيجة تقول: إن الزهد في الدنيا والانقطاع للآخرة هما الفوز الأكبر للإنسان، علماً أن الآخرة والدنيا عند الغزالي هما (كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر) لتحل هذه المقولة وأمثالها أمام مقولة (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) والتي كان يرددها المسلمون في فترة صعودهم الحضاري. وبذلك تكونت تلك اللحظة الفارقة التي ندعوها بلحظة الغزالي، استناداً إلى ما كان يمثله هذا الفيلسوف المتصوف من سطوة دينية ودنيوية، باعتباره من مثقفي السلطة العضويين - بكلامنا هذه الأيام - فقد التقت رغبته (بطلب الجاه وانتشار الصيت) مع رغبة السلطة وسياستها في محاربة الحركات المقاومة لها كالباطنية مثلاً، هذا الالتقاء في المصالح هو الذي دفعه لتأليف كتابه (فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) الذي يخبرنا في مقدمته أنه ألفه (بناء على الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية) وكتابه الآخر (تهافت الفلاسفة) الذي الفه ليحط من شأن الفلسفة والفلاسفة، وبذلك يكون قد أتم هجومه على مناوئي السلطة من باطنيين وفلاسفة، وأكمل إغلاق الدائرة حولهم، فالسلطة تحاربهم بالسيف وبالفكر المضاد، وهكذا قدم لنا الغزالي مثالاً لمثقف السلطة، نجده في كل الثقافات، ويعبر عن التقاء المصالح بين المثقف والسلطة، فيستخدم أحدهما الآخر للإيقاع بخصومه، لكن التاريخ يخبرنا أن هذه الشراكة تنتهي دائماً لصالح الطرف الأقوى وهو السلطة في كل الأحوال. ماذا كانت نتيجة هذا الصراع الطويل الذي تحدثنا بشكل مقتضب عن بعض فصوله؟ النتيجة كانت أن الثقافة الإسلامية وبالتالي العربية قد تراجعت واقتصرت على النص استجابة لعوامل مختلفة يبدو أنها لازالت هي الفاعل الأكبر منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. تلك هي المشكلة فما هو الحل، إننا وإن كنا لا نستطيع الادعاء بأننا نمتلك الحل إلا أننا نزعم أننا اليوم نبدو أحوج من أي وقت مضى لاستعادة سلطة العقل ودفعه إلى لعب دوره الحقيقي والفعال في بناء المجتمع والإنسان، علماً أننا لا نستطيع أن ننكر أن اللاعب الحقيقي في ساحة الثقافة الإسلامية العربية اليوم هو النص سواءً أكان نصاً دينياً أم غير ديني وما نقوله عن أزمة الإسلام، ينطبق من حيث سيطرة قدسية النص على دعاة القومية والماركسية والليبرالية الحديثة، فهؤلاء جميعاً قد وضعوا نصوصهم الخاصة بهم، وأحاطوها وتفسيراتها بهالة من القدسية حتى أصبحت عصية على المراجعة والنقد، وانتقلت من دائرة الدنيوي المفكر به إلى دائرة المقدس غير المسموح بتناوله، هذه الأزمة التي نعيشها تحتاج إلى خطوات جريئة وشجاعة، تحتاج إلى أجوبة سريعة حول أسئلة راهنة مثل: ألم يحن الوقت للعمل على تفكيك التركيبات المعرفية للعقل الذي يسيطر علينا ونفكر به وفيه بنفس الوقت؟ والذي علينا أن نعترف بشجاعة أنه يعيش بأزمة نتيجة تقييده بالنص السنا بحاجة إلى توصيف الداء وتسمية الأشياء بأسمائها؟ لنتمكن من تحضير العلاج الشافي لها. قديماً قال السيوطي المتوفى سنة (910هـ) إنه (يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب). فكيف سمحنا لنص المتقدمين أن يغلق باب الاجتهاد أمام اللاحقين وأنا اقصد بالنص هنا مجموعات المدونات التي رفعت بحدود القرن الثالث عشر الميلادي إلى مرتبة النصوص المقدسة). ثم هل يعقل أن يبقى فهمنا للنص مرتبطا بالإطار الثقافي والأفق العقلي لمسلمين عاشوا قبلنا بقرون تربو على العشر، كيف نقبل أن تحكمنا آراؤهم وتحليلاتهم، التي كانت صحيحة في حينها، ونحن نعيش في عالم آخر، عالم يستطيع فيه المرء أن يحصل على معلومات هائلة حول أي شيء بكبسة زر واحدة بحيث تبدو معلومات القدماء أمامها شيء لا يذكر؟ ألا يتعارض ذلك مع مفهومنا القائل أن دلالة النص المقدس - القرآن الكريم - تتجاوز حدود الزمان والمكان؟ إن الغرب لم يبني حضارته الحديثة بغض النظر عن رأينا بها، إلا بعد أن أشبع لاهوته دراسة وبحثاً، وبالتأكيد ليس هنا مجال المماحكة حول تدين الغرب أو إلحاده، فيكفي أن نقوم بدراسة موضوعية حول المجتمع الأمريكي مثلاً لنعرف ما هو حجم انتشار الدين والمعتقدات الدينية بين صفوفه. نستطيع القول أن مثقفينا ينقسمون إلى تيارين رئيسون، العلمانيون والإسلاميون، وضمن هذين التيارين توجد تفرعات مختلفة. ولكن بمراجعة دقيقة لخطاب هؤلاء المثقفين من الطرفين ومن ينوس بينهما نجد - مع استثناءات قليلة - أنهم ينقسمون بشكل واضح إلى علمانويين وإسلاموين. فالعلمانويون يحاولون إحداث قطيعة كاملة مع الزمن الإسلامي بحجة أن الحضارة هناك في الغرب، ويجب التماهي معها إلى الحد الأقصى، ونحن وإن كنا نوافق على ذلك، إلا أننا نرى أن هذا النوع من التفكير والرفض العلمانوي لدراسة الدين وتفكيك بنيته الداخلية باعتباره لازال الفاعل الأكبر في حيز الثقافة العربية والإسلامية، لم ينتج عنه سوى المزيد من الغربة لهذه الفئة، ولم تستطع تجربتهم أن تتأصل في مجتمعاتنا لسبب واضح، وهو أنهم حاولوا تطبيق علمانية شعوب أخرى تمتلك تجربتها السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة عن تجربتنا، وأرجو ألا يفهم هذا القول على أنه دعوة للخصوصية كما يدافع عنها بعضهم والتي أصبحت بفضلهم كلمة حق يراد بها باطل. وعلى الجانب الآخر من المشهد الثقافي والاجتماعي نجد أن الإسلاميين لا ينفكون يبشروننا بالفردوس المفقود، والماضي الذهبي للحضارة الإسلامية، وأن طريق استعادة كل ذلك يبدأ باستعادة تلك المرحلة بقضها وقضيضها أي الحل خلفنا وليس أمامنا. وهكذا وجدنا أنفسنا بين إسلاموية تريد إعادتنا للماضي وعلمانيون حقيقيون وإسلاميون حقيقيون أيضاً، إلا أنهم - ويا للأسف لم يزالوا صوت صارخ في البرية. والحق أننا لا نريد سوى نظام يكون التقدم الإنساني، والاجتماعي والسياسي والأخلاقي والثقافي فيه هو البوصلة التي يسير هذا النظام المأمول على هديها. ويحضرني هنا سؤال مهم جداً للمفكر محمد أركون: (ألسنا بحاجة إلى ماكس فيبر جديد يدرس لنا العلاقة بين التنمية من جهة، وبين الظاهرة الدينية من جهة أخرى)؟ لتكون نقطة إنطلاق لحداثتنا المأمولة، ولتضعنا مرة أخرى على سكة الحضارة الإنسانية كفاعلين إيجابيين، وليس كمتفرجين سلبيين على أحداث لا يد لنا في صنعها، مما قد يعرضنا للطرد خارج المسرح في أي لحظة يقررها الآخرون. |