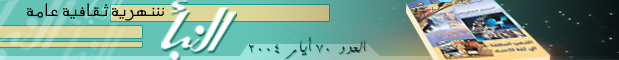
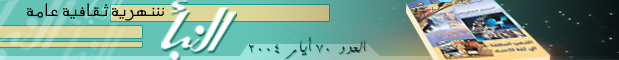 |
|
الاقتصاد السياسي وازمة الديمقراطية في العالم العربي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
د. مدين علي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تطورات مذهلة وضعت المنطقة العربية على مفترق طرق، وهي في حالة من الضعف والتفكك بصورة تنذر بنهاية تاريخية، الأمر الذي يطرح على المثقفين والنخب الفكرية تقديم استراتيجيات عمل مبنية على التحليل المعمق والاستقراء علّها تفوّت الفرصة على القوى التي تتربص بالمنطقة العربية شراً وتهدد بالإتيان على ما تبقى. على أي حال إن البحث في الوضع العربي الراهن وما يمكن أن تتجه إليه الأمور يفرض بالضرورة التركيز بصورة أساسية على طبيعة الدولة/ السلطة في المنطقة العربية وأدائيتها وفلسفتها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وبالتالي إنجازاتها، وذلك انطلاقاً من ضلوعها عملياً في تكوين ما هو كائن. ومن المفيد هنا التذكير بأبرز الاتجاهات الفكرية التي تناولت مسألة الدولة الوطنية في المنطقة العربية، فقد اتجه فريق من الباحثين للتركيز على عملية النشأة التاريخية للدولة القطرية، وهنا يمكن أن نميز بين تيارين اثنين، الأول: اعتبر الدول القطرية وليدا مسخا وتركة استعمارية ثقيلة وهي ليست أكثر من نتاج لثقافة وإرادة أوربية، وهذا ما يتلخص في خطاب القوميين العرب والماركسيين والإسلاميين، فيما اتجه التيار الآخر ليرى في الدولة الوطنية/ القطرية كيانا يتمتع بكامل الشرعية يمتد في جذوره إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية. هذا في الوقت الذي اتجه فيه فريق آخر ليتجاوز منطق السجال حول هذه المسألة ويركز التحليل على تقويم فعالية الدولة الوطنية/ القطرية، ومدى إنجازاتها والتزامها بمصالح مجتمعاتها، وتحقيق غاياتها في التنمية والتحرر، ولعله يجسد في الواقع التيار الأكثر عقلانية وواقعية في التعاطي مع قضية الدولة القطرية، لأن شرعية الوجود من عدمه لم تعد موضع نقاش، فالدولة القطرية هي فاعل أساسي مهما كانت درجة فاعليته، قائم بقوة القانون الدولي وإرادات الدول الكبرى المرتبطة عضوياً بمصالحها، التي تحدد في نهاية المطاف شكل ومضمون الثوابت في علاقاتها الخارجية وتحالفاتها الدولية، وليس فيه بعد عن الحقيقة القول بأن الدول القطرية هي مطلب شعبي للمجتمعات العربية. على أية حال لن ندخل في تفاصيل ما تقدم، بل سنتجه إلى التركيز لى النظرية السياسية والفلسفية للأنظمة السياسية العربية التي شكلت إطاراً مرجعياً للممارسة العملية، والتي اعتمدت عليها في التأسيس لشرعيتها السياسية ولمشروعية استخدام السياسات والوسائل التي ارتأتها ضرورية في تصريف شؤون الدولة والمجتمع. ولعل السؤال المطروح: كيف اتجهت الدولة/ السلطة للعمل على اكتساب شرعيتها خلال العقود الأربعة المنصرمة؟ هل كان ذلك بوسائل دستورية وقانونية ومن خلال الاقتراع والتصويت النظيف والاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد وللإمكانات الاقتصادية؟ في الواقع، إن جميع مؤسسات الدولة الحديثة من تنظيمات ونقابات عملت الدولة/ السلطة على إنشائها في العالم العربي، إلا أنها أصرّت عملياً على أن تكون في الغالب مؤسسات صورية ومخترقة لا معنى لها تستخدمها السلطة بالاتجاه الذي تريد، واتجهت عوضاً عنها لاكتساب شرعيتها من خلال سياسات وممارسات اجتماعية واقتصادية كانت لها تداعيات سلبية مهمة على مستقبل الديمقراطية والعمل السياسي في العالم العربي منها: 1-التماهي مع الموروث التاريخي العربي بما يتضمن من عصبيات وانتماءات جزئية، فالدولة رغم أنها رفعت شعارات التحديث وإعادة إنتاج المجتمعات العربية بخصائص معاصرة قوامها المواطنة السياسية، والانتماء إلى الأنا الكلية/ الجمعية، فإنها اتجهت إلى التماهي مع الموحدات الصغرى، واستقطاب مفاصلها الحقيقية من خلال إشراكها في الممارسة السياسية وذلك كآلية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وضمان الاستمرار، ولذا فقد توسعت في عملية إنشاء المؤسسات البيروقراطية الحكومية وقامت بتوزيعها على القبائل والطوائف، وبذلك فإن الموارد والإمكانات التي كان من الواجب أن تخصص للتنمية قد ذهبت لتمويل الإنفاق على هذه المؤسسات التي لا تتعدى في جدواها أكثر من كونها جوائز ترضية وليست مؤسسات إنتاجية فعلية. 2-تجهت الدولة على اكتساب الشرعية من معايير حديثة كالتي تحدث عنها ماكس فيبر كالقانونية والعقلانية والقيادة الملهمة والكاريزمية، بل وأكثر من ذلك الإنجاز فقد اتجهت لبناء المشاريع والمصانع، إلا أنها بجانب كبير منها لم تكن خاضعة لدراسات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، ولم تأت في سياق إستراتيجية تنموية استشرافية مما أدى إلى ضياع موارد وإمكانات كثيرة في إنفاقات لا جدوى منها إذ أن المهم هو الإنجاز كمياً. 3-المصدر الثالث وهو الأبرز والأهم، إذ أنها اتجهت، أي النخب السلطوية، إلى مقايضة السياسة بالاقتصاد حيث استخدمت ثروات الأمة ومواردها لشراء الولاء السياسي، وهذا ما تم فعلاً من خلال التحكم في شكل الملكية وإدارة الاقتصاد وحقوق المواطن الاقتصادية وسياسات توزيع الدخل القومي وسياسات الإنفاق والاستثمار وغير ذلك، وفي إطار المقايضة المذكورة يمكن أن نميز بين أسلوبين اثنين هما: - الأسلوب الأول: انطلق في طروحاته من شعارات اشتراكية وتنموية ربما كانت في بعضها صحيحة في السياق التاريخي لحركة التطور في المنطقة العربية، طروحات دفعت بالدولة إلى الانغماس على نطاق واسع في الحياة الاقتصادية، واحتكارها للسوق احتكاراً شبه مطلق بواسطة قطاع حكومي تقليدي لا تحكمه الإدارة الاقتصادية المعاصرة ولا يستطيع الاستمرار إلا بقوة وظروف احتكار الدولة للسوق ومن خلال تحكمها في عمليات الإنفاق والاستخدام والتشغيل من خلال التوسع الدائم في مؤسسات القطاع العام كي تصبح الدولة هي سوق العمل الوحيد، وهذا ما أعطى للدولة قدرة كبيرة على التحكم في الأرزاق والأعناق، إذ أصبحت الوظيفة العامة جائزة الولاء والانتماء وليست القدرة على الأداء، ونتيجة لذلك تكثفت المفاعيل السلبية لقانون الحاجة الذي سيطر بصورة مؤلمة على مختلف جوانب حياة الإنسان العربي. - الأسلوب الثاني: فقد اتجهت فيه الدولة/ السلطة إلى إدارة الاقتصاد وتوزيع الدخل القومي في مستوى معين من الليبرالية الاقتصادية فقط دون السياسية وذلك بما ينسجم أساساً مع توجهات الأنظمة السياسية إذ وزعت الموارد والعوائد وعقود الأشغال والتوريد على الأصدقاء والأعداء ومراكز القوى الاجتماعية ذات القدرة على الحركة والتأثير. وفي كلا الأسلوبين لم تتجه الدولة جدياً إلى تغيير خصائص النظام الاقتصادي وطبيعته الريعية، فلم يكن إنجاح القطاع العام هدفاً فعلياً، ولم تدفع الدولة بالقطاع الخاص ليكون منتجاً وفاعلاً، بل اتجهت لتعميق اتكاليته على الدولة ممثلة بالقطاع العام. وهكذا تم خلق نوع من التشاركية بين القطاع الخاص والنخب السلطوية التي تتولى إدارة القطاع العام، وعليه بقيت الأنظار مشدودة للدولة من الفئات الراغبة في العمل ومن الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج التي تثري عن طريق الدولة، وفي كل الحالات بقي الهدف الأساس هو ضمان الشرعية السياسية من خلال الولاء أو الانتماء أو كلاهما معاً، وأصبح المال والثروة جائزتهما. وهنا تحول الإنفاق من كونه إنفاقاً بهدف النمو والتنمية إلى إنفاق بقصد الضبط السياسي بعيداً عن شروط وقوانين اللعبة الديمقراطية، وفي الواقع إن شل العملية الديمقراطية وازدياد قدرة الدولة / السلطة على التسلط لا يرتبط فقط بطبيعة وخصائص الإنفاق الذي أشرنا إليه، بمقدار ما يرتبط بطبيعة الإيرادات العامة للدولة في المنطقة العربية، فالموارد بمعظمها لا تتولد من عمليات خلق للقيمة، بل من مصادر ريعية كحيازة آبار النفط أو احتكار سوق داخلية من خلال سياسات حمائية وتدخلية متشددة، أو الإشراف على موقع جغرافي أو بحري معين، أو أنها موارد تتولد من سيطرة كاملة لقطاع عام تقوم الدولة / السلطة بالتصرف بفوائضه وأرباحه وأملاكه وإنفاقها بالطريقة التي تشاء ومتى تشاء. وهي بالمجمل موارد وإيرادات تجعل الدولة / السلطة على مسافة بعيدة من المجتمعات ومتحررة من قبضتها داخل المؤسسات الدستورية أو صناديق الاقتراع، مما يجعلها أقل استجابة لشروط العمل الديمقراطي التي كانت ستفرض عليها فيما لو أن حدود القطاع العام كانت محدودة بنشاطات معينة ولو كان الاقتصاد إنتاجياً بمعنى أن موارده الأساسية هي من القيم التي يخلقها المجتمع فعلاً، فعندئذ ستكون الضرائب والرسوم هي المورد الأساس لإيرادات الدولة/ السلطة، وهي بمجملها لا يمكن للدولة أن تجبيها إلا بعد موافقة المؤسسات الدستورية والتشريعية عملاً بمبدأ لا ضريبة إلا بقانون، وبذلك يستطيع الشعب من خلال البرلمان أو صناديق الاقتراع الضغط على الحكومة من بوابة الاقتصاد مما يدفعها للعودة إلى حدودها الطبيعية في حقل السياسة (هذا من جهة) ويدفعها لأن تمارس سياسات إنفاقية تنموية واقعية وعقلانية وحقيقية لا يمكن لها أن تمولها إلا بموافقة شعبية. وما نلحظه في العالم العربي هو أن الدولة / السلطة كي لا تقع في مصيدة الديمقراطية تصرّ على المحافظة على القطاع العام كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً وحتى خط الدفاع الأخير، وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى أن انتشار القطاع العام بكثافة لم يقتصر على الدول التي تبنت خطاً اشتراكياً بل وحتى تلك التي نهجت خطاً ليبرالياً، فالنفط ملكية حكومية وهو يشكل عماد الاقتصادات لدول عربية كثيرة وأكثر من ذلك تتجه الدولة / السلطة على خط آخر باتجاه المحافظة على الطبيعة غير الإنتاجية للاقتصاد إذ أنها لا ترغب كما أشرنا سابقاً بقطاع عام اقتصادي فعلاً ولا حتى بقطاع خاص يعتمد على ذاته كما هو الحال في الغرب فعلاً إذ أن البديل لذلك هي الموارد الريعية التي تستطيع أن تنفقها كما تشاء وترضي بها من تشاء بغض النظر عن دوره في العملية الإنتاجية، وهذا ما يضمن لها الولاء والانتماء والدعم والموازرة، والمفيد هنا الإشارة إلى أن القطاع الخاص الحديث في الوطن العربي كان معظمه قد تشكل أو تكوّن من خلال استغلال الدولة وتجيير القوانين والفوائض العامة والعقود لمصلحة الخواص، مما يعني أن جانبا من(القطاع الخاص) مرتبط عضوياً بالسلطة وبالتالي أن مصلحته تكمن في استمرار السلطة وفي نهجها الذي شكل القاعدة لمحدثي النعمة في المنطقة العربية للإثراء، ولذا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الفئة هي ضد الانفتاح قبل الدولة/ السلطة، نظراً لما يكرسه الانفتاح من شفافية وحرية اقتصادية ومنافسة خارجية ستعصف بمواردها ومصادر إثرائها. على أي حال فإن الإخفاق الذي منيت به التنمية في المنطقة العربية دفع شعوب المنطقة والمجتمعات العربية التي ارتضت تاريخياً بحقوق سياسية منقوصة مقابل الوعد بالتنمية والقضاء على التخلف، دفعها للمطالبة بكشف حساب مع السلطة حول طبيعة ومستوى الأداء والإنجاز وقد يكون من المفيد الإشارة هنا إلى التراجع الكبير في مواقع الدول العربية في دليل التنمية البشرية خلال السنوات 1992 - 1996 - 1999:
من خلال هذا الجدول يتبين لنا التراجع الكبير في الوضع التنموي للإنسان العربي وذلك طبقاً لمقاييس ومؤشرات التنمية الحديثة، وهو مؤشر يتجه انحداراً كلما تم تضمينه أبعاداً وعناصر أخرى تدخل بوتقة رفاه الإنسان وتوسيع خياراته. وإذا ما انطلقنا من تقرير التنمية الإنسانية العربية رغم تحفظاتنا الشديدة عليه، فإنه يبقى مؤشراً مهما يبين وضع الحريات والحقوق، فمثلا نجد أن الفلبين وبنما والدومينيكان وسريلانكا وغانا وزيمبابوي وموزمبيق تتقدم بمجملها على جميع الدول العربية، وهذا يبرز من خلال الجدول التالي:
لقد وجدت الدولة / السلطة نفسها مؤخراً في مواجهة أعدائها التاريخيين من قوميين وماركسيين وغيرهم، كما وجدت نفسها في مواجهة مجتمعاتها المسحوقة والمهمشة، هذا في الوقت الذي وجدت فيه نفسها أيضاً أمام متغيرات خارجية وخطاب دولي سياسي واقتصادي ليبرالي مكثف يدفع باتجاه ضغط حدود مساحة سيادتها إلى الحدود الدنيا، مما يعني أنها أصبحت في مواجهة الداخل والخارج معاً، مواجهة دخلت معها في أزمة حقيقية شاملة تتلخص بأنها أزمة شرعية الوجود والقدرة على الاندماج والتكيف مع المتغيرات الدولية ومدى القدرة على صهر الانتماءات الجزئية (الوحدات الصغرى) المهددة بالتذرّر ودمجها في إطار الوحدات الكبرى. وفي إطار العمل للمستقبل لا بد من العمل المكثف باتجاه ترسيخ أسس الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي إضافة إلى ضرورة التخلص من أولوية السياسي والاجتماعي والعسكري على الاقتصادي في قرار عقد النفقة والتخطيط الاقتصادي وتشجيع المنافسة. ويبقى الأساس للحريات السياسية والديمقراطية هو تحرير الأسواق المحلية والنزوع نحو ليبرالية اقتصادية، وهو الشرط الأساس الذي سيؤدي إلى تغيير مصادر الشرعية السياسية للأنظمة العربية لجهة تفعيل المؤسسات الدستورية وتوسيع حق الاقتراع والتصويت واستجواب الحكومة والمساءلة وتقويم الأداء والإنجاز، كما أنه سيؤدي إلى إسقاط منطق الكهنوت السياسي والمفاهيم التقليدية لجهة إحلال مفاهيم وثقافة معاصرة يطلبها أصدقاء السلطة قبل أعدائها، ترقى بالعمل السياسي العربي من المستوى الدوني الهابط ومن مستوى كونه أداة لممارسة القهر والإذلال إلى مستوى حداثي راقٍ وعصري ينطوي على منهج عقلاني يخلق الظروف الموضوعية لإطلاق قوى الابتكار الخلاقة التي تساعد على النهوض والتحرر، كما ترقى بالعمل السياسي إلى نسق متقدم يساعد على رفع مستوى التفاوض للدخول في شراكات عربية عربية، وعربية دولية متكافئة. كلمة أخيرة، إن وظيفة الدولة ليست الإنتاج وإنما الرعاية والتنظيم ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وحماية الأطفال وتمكين المرأة والضمان الاجتماعي وتحريك معدلات النمو الاقتصادي من خلال استخدام سياسات مالية ونقدية إضافة إلى الدور الأهم الذي يتلخص بتحقيق الاستقرار وصيانة الأمن، تلك هي وظائف الدولة في المناخ الاقتصادي الدولي الجديد. إن مقتل الدولة/ السلطة لم يكن في ساحة السياسة كما يحلو لبعضهم، بل في ساحة الاقتصاد حيث أخفقت في تحقيق التنمية وتحسين أوضاع الناس المادية، وهو إخفاق انتقل بها من ساحة الاقتصاد إلى بورصة السياسة حيث بدأت التنازلات والمساومات والهرولة وراء المساعدات وتنفيذ الإملاءات..الخ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||