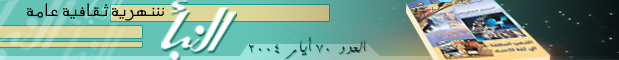
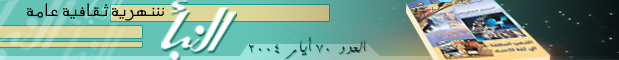 |
|
الشرق في عيون غربية |
|
عبدالله الفريجي |
|
إذا كان من المسلم به أن الله تعالى حين خلق الإنسان ومنحه القابلية على تكرار ذاته وإنتاج الأشباه عبر عملية التكاثر فإنه بذلك منحه المزيد من فرص البقاء والاستمرار لأن كل إنسان هو عبارة عن فرصة إضافية لاستمرار الجنس البشري ولهذا فإن إفناء أي فرد يعادل إفناء الجنس البشري برمته. غير أن هذا ينطوي على محذور نشوء الاختلاف والتباين بين أبناء البشر، رغم أن الاختلاف في أصله لا ينطوي على أي محذور لأنه بالأساس والجوهر لا يدل إلا على إغناء النوع من خلال تعدد الأفراد إذ لو كان الأفراد نسخا مكررة لنسخة واحدة لكان ذلك يعادل فرصة واحدة للبقاء لأن تفاوت الصفات يعني تفاوت القدرات والمواهب والملكات، وعليه فإن كل فرد مختلف يعني فرصة مختلفة بما سوف يمنحه الفرد لأعقابه من مواهب البقاء وبالتالي فإن التفاوت يعني التفاوت في الفرص إذ قد تكون فرصة ما أغنى من سواها في تحقيق هدف التكاثر ألا وهو البقاء والاستمرار. وإذا ضربنا مثلاً لهذه القضية بالوعي العربي الإسلامي والوعي الغربي باعتبارهما نموذجين قائمين لعلاقة الأنا بالآخر فإننا نجد أن هذه العلاقة تميزت في بعض أطوارها باتجاهها نحو الرغبة الجامحة لإفناء الآخر، ثم الاستحالة قهراً إلى نمط من أنماط التفاعل، وإن كان في الأصل غير مقصود وغير مخطط له إذ أن التفاعل يأتي من خلال الأمر الواقع الذي تفرضه قوة الآخر التي تمنع الفناء وتفرض البقاء وتبعاً له تفرض التفاعل بين طرفي العلاقة. وفي هذا المقطع تبدأ الذاكرة الجماعية بإبعاد العوامل البناءة في العلاقة وتحصن الوعي بأنواع الذكريات الدامية والتصورات الأسطورية المفعمة باللاواقعية والخيال. وهكذا نلاحظ أن الرغبة في إخفاء الآخر كيف تجر إلى التفاعل القسري وحتى لو كانت تسوق معها التصورات غير الموضوعية عن الآخر إلا أنها أيضاً تثبت بعض العلاقات ذات اللمعان الشديد وهي ترسم صورة الآخر بريشة المخيال والتجني لأن هذه العلاقات هي الجوانب الواضحة من الآخر والتي لا يمكن معها الجنوح نحو الخيال والأسطورة.
دور الرحالة في التصورات وإذا شئنا أن نضرب مثلاً على كيفية بناء الصورة التي كونها الغرب عن الشرق فإنها نجد أنها لم تقترب أبداً من الطريقة العلمية في ذلك بسبب اعتمادها أشخاصاً معدودين لم يدرسوا الشرق ولم يمسوا أي جزء منه إلا مساً عابراً ومن هؤلاء مثلاً المغامرون والرحالة الذين كانوا أحد أهم أقنية المعلومات مع (أن مفهوم الرحلة باعتبارها وسيلة لجمع المعلومات وتسجيلها أمر شائع في المجتمعات التي تمارس درجة عالية من القوة السياسية، فالرحالة يبدأ رحلته وتكون وراءه أمة ذات سلطات تدعمه بنفوذها العسكري والاقتصادي والفكري والروحي، ولذا نجده عندما يكتب يضع في حسابه جمهوراً خاصاً من القراء ألا وهم أبناء وطنه وأقران مهنته وملكه أو راعي رحلته ولا شك بأن وجود هؤلاء نصب عينه يؤثر على رؤيته ويجعله انتقائياً يختار من المعلومات أنواعاً معينة أو يركز على سمات دون غيرها لمجرد أن لها رنينها في ثقافة أمته، كما أن مركزه الاجتماعي يساهم في تلوين رؤيته تلك، إذ غالباً ما يكون منحدراً من طبقة مرفهة تتيح له أن يقوم برحلات عالية المستوى والتكاليف فيغدو بطبيعة الحال ممثلاً لمصالح وأنماط من التفكير أنشئ عليها. فقد كانت صورة الإسلام التي صنعتها القرون الوسطى طافحة بالأخطاء المتعمدة كما كانت تحتوي في ثناياها مقداراً كبيراً من الإمعان في الأسطورة، وعززت نظرية (نحن وهم) الأوروبية شهادات جاء بها رحالة خياليون أو واقعيون من أمثال الإسكندر ماندفيل وماركو بولو أو دوريك. على أننا يجب أن لا ننسى الدوافع المغرضة وراء تكون صور سلبية عن الآخرين لتبرير ممارسة العنف ضد هؤلاء وقد بدأ إيقاع الأذى عندما شاع (وروجية جماعات متسلطة وقادرة تلفق صورة عن (الآخرين) من البشر وتصنفهم في نماذج نهائية ترسمها هي ولا تمت إلى النماذج الطبيعية بشيء ويقدم المؤلف بليني في كتابه (التاريخ الطبيعي) نموذجاً مبكراً للنصوص ذات النزعة المعرفية، فهو يزخر بالحديث عن عادات (أكلة لحوم البشر) وجماعة الاستومي التي تعتمد حياتها على شم التفاح وجماعات السيوبود وأهل الأمازون والبراهمة، ولذلك كان أساس شعبية كتاب (بليني) في أوروبا (العصور الوسطى) أنه رتب وركز كتابه على المعتقدات السائدة حينئذ عن أجناس غامضة (من الناس) وقد تكرر الأسلوب نفسه في عصر النهضة حين وصفت روايات الرحلات أسفاراً تتسم بالغرابة المعتمدة.
الأطوار التاريخية والوعي وفي النهاية فإن هذه الصورة أقيمت على أنواع من العواطف، لكن هذه العواطف ليست واحدة فإنها في البداية كانت عبارة عن نوع من الانبهار بالشرق لأن الشرق فيه الكثير مما يفتقده العالم الغربي في تلك العصور، ثم تطور هذا الأمر تبعاً للعلاقة المتطورة بين الشرق والغرب والمتغيرة، ففي المرحلة التي كان فيها الشرق قوياً فقد كانت هناك حالة من الانبهار بعد وقوى مترف، ثم صار عدواً يمكن التفكير بالمساومة معه ثم صار هذا العدو مادة للأطماع لأنه بات قابلاً للاستعمار، وأخيرا كان هو العدو المتخلف المقهور غير المتحضر المهاجر من بلده ومن وطنه هرباً من القهر، أو هو الرجل الذي خضع للعبودية والتخلف ونماها معه في ذلك الوطن المظلم. بل يذهب بعضهم إلى أن العربي كان ماثلاً في المخيلة الغربية حتى قبل السيد المسيح (ع) بخمسة قرون، وها هو (أخيل) في (بروميثوس قتيلاً) يصف العرب هكذا: (القبائل المحبة للحرب، تكفي قشعريرة لتهيج رماحهم القاطعة). وفي نفس الحقبة وصف (هيرودوت) الجزيرة العربية بأنها أرض تسكنها ثعابين ذات جناحين وأغنام لا تتحرك إلا ووراءها عربات تحمل ذيولها الضخمة، وكرس فيما بعد كل من (دودور دوسيسيل) و(تبيوك ناسيت) و(آمين مارسيلين) بعض المقاطع العجيبة من كتاباتهم العجيبة للعرب ولا يفوتنا أن نشير إلى ما كتبه فلافيوس جوزيف في بداية القرن (1) من مؤلفه (حرب اليهود) والذي يحكي عن الحرب التي دارت بين اليهود والعرب والتي انتهت بانتصار الأوائل في نهاية اليوم السادس. وإذا كانت هذه الحقبة غير مهمة من التاريخ لقدمها فإن الاحتكاك الحقيقي يبدأ مع ظهور الإسلام وتحول العرب إلى أمة قوية صارت تحتك بالغرب وخصوصاً في معركة (بواتيه) سنة 732 التي قاتل فيها المسلمون جنود شارل مارتيل، هذه المعركة التي لم يهتم بها المؤرخون المسلمين صارت إحدى أسس الميثولوجيا الوطنية. ورغم الصورة التي رسمتها الأساطير الغربية للعربي السارق أو المهاجم، فإنها جعلت منه أنموذجاً يرغب جميع الناس لتكراره ،ففي أغاني القرون الوسطى الملحة، لا يمكن لساكن فرنسا القديم أن يتصور حباً كبيراً أو إحدى الملاحم الخالدة دون أن يقيس نفسه (بالسادازان) وهي صورة العرب كما رسمتها الأساطير.
الصورة القاتمة للشرق غير أن الصورة العفوية الأسطورية للعدو تغيريت منذ الحروب الصليبية إذ اقترنت بحالة من نقد الذات وخصوصاً بعد فشل الحروب الصليبية في أخذ بيت المقدس من أيدي المسلمين فهذه المرة لم يكن الوضع (الصراع) الذي أوضح قدرة وقوة العرب والمسلمين منبثقا عن جهل، فبالعكس من ذلك حين فوجئت أوروبا في غمرة الحروب الصليبية بقدرة الجنود العرب المسلمين على المقاومة وسرعة غزوهم للعالم انكبت على دراسة أسباب هذه الظاهرة، فكلف الرهبان بالبحث عن الذي تعود إليه مسؤولية هزيمة المسيحية فاهتدوا إليه بسرعة؛ إنه محمد(ص) فبدونه لم يكن للعرب أن يفلحوا في الخروج من صحرائهم وشرحت حينها حياة الرسول (ص) ونقبت في أعماق حياته الخاصة لتعرية كل تفاصيلها فأحصيت زوجاته وحاشيته ثم سيرته وأضيفت أشياء أخرى على ما عثر عليه.
الاستشراق علم الاستعمار غير أنه خلال هذه الفترة تحولت النظرة إلى الشرق من عدو قوي مرهوب إلى موضوع للاستغلال والاستعمار، وبذلك صار بالإمكان أن نسمي علم الاستشراق بأنه علم الاستعمار. وهكذا ولد هذا العلم كتعبير عن انقلاب العلاقة بين الشرق والغرب فالمراد هنا من الخطاب الاستشراقي العام أداء وظيفة تعبوية وسياسية وتخيلية خدمت السياسات الاستعمارية ونقلت جزءا لا يتجزأ من مناخات صعود الإمبريالية). وإن (الخطاب الاستشراقي وعلى الرغم من النقلات المهمة التي شهدتها استراتيجياته على مدى القرنين المنصرمين ظل في الجوهر عاجزاً عن التطور بسبب تمسكه بخرافة كبرى حول الشرق: إن الثقافة الشرقية هي في حد ذاتها ثقافة التطور الموقوف بصفة دائمة، كما عبر جون كوسيك، هذا الارتداد الأيديولوجي والمنهجي كان من رأي سعيد أحد أدوات إنتاج الهوية الغربية (مثل الهوية الشرقية) وتوطيد رغبة الغرب في فرض إرادته على الشرق. وهنا يمكن الالتفات إلى أحد أهم أبعاد الاستشراق وخلال جميع أطواره أنه ليس مجرد معرفة مشوهة ومغرضة وغير موضوعية للآخر الشرقي، بل هو عملية إيقاد لرغبة عميقة لصياغة الذات بهدف استعباد الآخر والتخلص من خطره فهو عملية ذات بعدين: بعد معرفي وبعد عملي ذاتي يراد به رسم صياغة للذات، كنقيض أو مخالف للآخر الموسوم بكل الأوصاف السلبية.
النقد وتصحيح الصورة ولهذا فإننا نحتاج بصورة دائمة لتعطيل هذه العملية وخصوصاً على صعيد المخيلة الشعبية في الذات وفي الآخر وتحويلها إلى عملية نقدية لهذه الصورة التي تنتج في دوائر نخبوية هادفة وغير عفوية على الإطلاق. ولكي نتمكن من الاحتفاظ بطاقة معرفية - نقدية عالية أمام العماء المنظم الذي يقترحه نموذج المستشرق الأكاديمي المحلف عصبوياً ضد الحقيقة الثقافية أو المؤرخ المتمركز حول ذاته الفردية شبه العنصرية، والموضوع في خدمة دوائر رسم السياسات الكولونيالية الجديدة أو المفكر والفيلسوف ما بعد الحداثي المتحلل من أعباء التاريخ فنحن بحاجة دائمة إلى كتب نقدية معمقة وشجاعة. والمهم في كل هذه السيرورة إذن هو الصورة الفعلية التي ترسمه الاستشراقيات المعاصرة للإنسان الشرقي والمسلم على وجه الخصوص، من خلال الخوض في التاريخ والعقائد والسياسة لأنها الهدف في العملية هوالازدواج وبالتالي هذا هو المطلوبة.
الإشكالية ومغالطة الطرح ماذا أتاح لنا إدراك الطبيعة الخاصة التي تتزامن مع رسم الصورة السلبية عن الآخر الشرقي في الغرب؟ ألا وهي الرغبة في تحصين الذات والسعي لبنائها بصورة مضادة أو مغايرة لسلبيات ونقائص الآخر الشرقي المستبد والغني الكسول والمتخلف، فإننا حينئذ سنرى بعمق الحالة الخاصة من التحيز للذات الواعية والمنظمة والتي تقوم على عدم الاعتراف بعناصر الإيجاب والقوة وسائر الفضائل الأخرى أو إذا ما تم الاعتراف بها فإنها تستجيب لدوافع نفس الحالة، بحيث أنها تصب في الأغراض الخاصة التي ذكرناها. ولهذا، فإن الحديث عن هذه الإشكالية بالأصل يصب في هذا المصب لأنه يرمي إلى تكريس هذه التصورات ولأنه يوحي بأنها مقامة بالأصل على التحيز للذات على حساب الآخر، وإن هذه الحالة لدى طرفي العلاقة (الشرق والغرب) هي واحدة وبالتالي فإنها مبررة حتى لو اختلفت درجتها بين الشرق والغرب. فهذه المشكلة مقامة على أساس وجود نزوع طبيعي لدى كل إنسان للتحيز لذاته ضد الآخر وفي هذا الأمر مغالطة كبرى ذلك أن الفرق بين الإسلام وبين سواه هو في أن التحيز يأتي بعد استكمال الهوية ولصالح تركيزها، بينما ينطلق التحيز الغربي كجزء من الهوية وهذا الفارق مهم جداً لقراءة الواقع والخروج بنتائج ذلك أن الذات الغربية تأسست على أساس استيعاب النموذج الحضاري الإسلامي في زمن كانت قوة الحضارة منهارة، وبالتالي فهو يتضمن إنكار الاستيعاب من خلال دعوة الالتحام بالنموذج الإغريقي قفزاً على المأخوذ من الحضارة الإسلامية فتكون أصل عملية الإستشراق الغربية المقامة تحيزا للذات بينما تكون الحالة لدى الشرقيين مغايرة لأنها ليست سوى تعبير عن حالة من نقد الذات الحاضرة قياساً على ذات مغايرة وآخر ى معاصرة، وبالتالي فإن التحيز ليس دخيلاً في بناء الهوية. فلكي يتسنى للآخر وضع أسطورته في إطار المركزية الغربية قام في البدء باستعدادات جيوسياسية واقتصادية وثقافية عامة لتمكنه من بلورة صورة عن ذاته، وخلق شكل مواز لصورة ممسوخة عن (الآخر)، ليؤكد ذاتيته ثم راح يرسم لنفسه مصيراً لاهوتياً وميتافيزيقياً ليجعل من ذاته محوراً، بل مرجعاً تاريخيا أحادياً في معالجة مجتمعات ما وراء أسواره وقد تم ذلك عبر إرساء قواعد منظوماتية فكرية يرمي من ورائها إلى انتزاع إجماع من مواطني مجتمعاته على رسالته التبشيرية كي يتسنى له تصديرها باسم الفردوس الموعود من المستعمرات. عند تجاوز هذه المعضلة فإن الدعوة يجب أن تتركز على التعايش والتفاعل الحضاري البناء وكما قلنا أن ذلك لا يمكن أن يتأسس إلا على أساس النظرة العلمية لأنه أقرب السبل لتكوين تصورات وصور موضوعية عن الإنسان والطبيعة والعلاقات وأن العلمية لا تعني النقد المستمر للطرق والمناهج والسبل المعروفة لتكوين الحقائق فضلاً عن عدم البقاء في أطر الصور الجاهزة والأحكام المسبقة. |