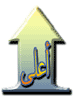|
أحمــد البغــدادي |
||
|
|
||
|
بمجرّد أن يلقي المرء نظرة متأملة إلى ما حوله من الطبيعة والكون المادي اللانهائي، وإلى محيطه القريب والبعيد، ويلتفت إلى نواحي السماء وآفاقها وعوالمها العجيبة، من نجوم وأجرام ومجرّات تدهش العقول، وتأخذ بالألباب، تتبدّى له من فور وبوضوح تام إحدى أكبر الحقائق الموضوعية الكبرى التي تطبع جميع العوالم والأكوان - من غير استثناء - وهي ذلك التنوع الكبير والمدهش الذي ميّز عوالم المادة الجامدة وغير الجامدة، بما فيها عالم المجرات والنجوم والأقمار، وأفلاك عجيبة لا يعلم غاية سرها وأقصى مكنونها إلا بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وكذلك عالم النباتات بكل ألوانها وصنوفها البحرية والبرية، وتنوعاتها الرائعة والمعجبة، ابتداءً من البذرة المتناهية في الصغر إلى الأشجار العملاقة، وغير ذلك مما ينبئك بعالم هو غاية في التنوع واختلاف الألوان والأسماء والأصناف والأجناس.. هذا التنوع الشامل والمستوعب لجميع الأشياء قد لازمه ملازمة تامة كاملة تنوعٌ في المهام والوظائف والتراكيب الداخلية والأشكال الخارجية، وهكذا فكلما أبعد المرء في تفكيره، وأمعن النظر دلته حقائق الكون الكبرى على أن هذا التنوع هو ظاهرة كونية شملت أدق دقائق عالم الطبيعة وجميع عناصرها بشتى تجلياتها، كما إن هذا التنوع لم يحدث صدفة قط، وإنما هو - في الحق - من تخطيط وإبداع مبدع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الذي علمه فوق كل ذي علم والذي أتقن كل شيء خلقه، وأحسن صنعه وأتمّه؛ وإلى ذلك فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة بأن هذا التلوّن والتنوع في كل شيء إنما هو من مظاهر الخلق الكبرى، ومن مظاهر الإعجاز والإبداع في الخلق، مما يعني - من جملة ما يعنيه - أن عظمة الله سبحانه وتعالى لا تتجلى في مجرد إيجاد الأشياء من العدم، بل بخلقها وإيجادها على هذه الشاكلة العجيبة الغريبة في صنعها وتنوّعها واختلافها.. هذا التنوع والاختلاف الذي أضفى صورة جميلة وفاتنة على العالم.. كما قد شاءت الإرادة الإلهية المقدسة أن يسم هذا التنوع والاختلاف - فضلاً عن عالم الدنيا - عالم الآخرة أيضاً، حيث حدّثت الآيات المباركات عن أن الوجود الأخروي وجود متنوع الدرجات، وربما أكثر من الدنيا تفاوتا وتنوعاً.. وهذا التنوع المادي ينقل الفكر إلى تنوع آخر، هو ذلك التنوع في ميول البشر واعتقاداتهم وآرائهم ونزعاتهم؛ وهذا غير خصوص تنوعهم في أشكالهم وألوانهم وأعراقهم ولغاتهم، فها هنا نلاحظ مستويين من التنوع؛ تنوع لا علاقة له بالعقائد الدينية، أي تنوع في الأذواق والعادات وأنماط العيش، وطرز البناء، والزيّ، وغير ذلك مما يتصل بالثقافة بمفهومها العام، وهو تنوع هائل يضفي - في الغالب - روعة وبهجة على الحياة الإنسانية، من حيث أنه ينسجم مع التنوع التكويني للأكوان والمخلوقات.. وهناك تنوّع آخر يتعلق بمجال الاعتقادات الدينية، وما إليها من قناعات وتوجهات سياسية تشمل الصيغ التي ينبغي أن تكون عليها حياة الإنسان في مجتمعه من حيث النظام السياسي والاجتماعي وما شاكل، مما يعد مظهراً عادياً، من مظاهر الحياة البشرية، منذ أن وجدت وإلى يومنا هذا، حيث لم يأت وقت على بني آدم، لم يكونوا فيه مختلفين، بل هم على الدوام يحيون حياةً ميزتها الثابتة التعددية والتنوع.. إذن تاريخ الوجود الإنساني هو تاريخ التنوع في الاعتقادات والمذاهب والآراء، وكذلك التعدد الشامل في مظاهر الحياة المادية لجميع الأكوان، وهو ما يتماشى مع أهداف الخلق والوجود؛ ذلك أنه لم يأت - قطعاً - خلافاً للمشيئة الإلهية، أو رغماً عنها، وإنما هي سنة الله في خلقه، وهي ماضية إلى ما شاء الله.. فحيال هذا التنوع الشامل في المجال العقائدي، والذي يتجاوزه إلى جميع الأكوان والعوالم المادية، هل يوجد وضع تشريعي ملائم على مستوى العقيدة الإسلامية، مستوعب للعقيدة المخالفة حقاً كانت أم باطلاً؟! أو بعبارة أخرى هل ينفي الإسلام العقائد المخالفة ويسلب منها حق الوجود والفعالية في المحيط الذي يحتكم في شؤونه - على الأعم الأغلب - إلى أحكام ومبادئ الشريعة السمحاء، أي هل يعطي الفكر الإسلامي صفة المشروعية للفكر المخالف، أم يسلبها منه بحيث لا يعترف، أو قل يعاضل وينابذ كل ما يخالفه في عقيدته وشريعته؟!. في الحق أن التصورات والمفاهيم التي ازدحمت بها أذهان غير قليل من المشتغلين أو المهتمين في الأوساط والمحافل الثقافية والعلمية، وطائفة من ذوي الاهتمامات المعرفية المختلفة، تدور حول نظرة محتكمة تماماً إلى منطقٍ شبه ثابت ومستعد للجدل الطويل حول مدعى فرضته مسيرة طويلة من حوادث العنف ووقائع الصراع والحروب التي غالباً ما كان منشؤها سعي أصحاب العقيدة الأقوى إلى تطويع المجتمع كله جميعاً لها، دون أدنى فسحة أو متنفس للغير، بدعوى أو بعذر أن وجود هؤلاء الأغيار مخالف للعقيدة المقدسة متنافر مع الإرادة الإلهية، وعليه فإن هذا الوجود ممنوع وباطل ولا يتمتع بأية حرمة، وقياساً على هذه النظرة فإن المجتمع المتدين تنعدم فيه الألوان والمذاهب الفكرية المخالفة، ولا سبيل فيه البتة إلى التنوع والاختلاف في العقائد.. نعم حصل مثل ذلك في بعض الأديان التوحيدية السماوية، كالمسيحية واليهودية، وفي الطرق الأخرى كالمجوسية والبوذية والكونفوشيوسية والهندوسية، التي عرف عنها في مراحل تاريخية بعيدة وقريبة، ومن خلال وقائع معلومة، أنها كانت تحاول - على الدوام - نفي الآخر، وإثبات الذات، وصهر المجتمعات - كلاً وجميعاً - في بوتقتها، وتوحيدها في ساحتها وحسب. |
||
|
لعلّ بعض الوقائع والأحداث التي جرت في دنيا الإسلام قد تسببت في جانب من عناد المعاندين بأن النظرة الفقهية والجانب التشريعي في الفكر الإسلامي لا يعترف بأدنى شرعية لكل ما يخالف هذا الفكر في عقيدته، بل يفترض أن كل التنوعات وأي غير من الأغيار يجب أن تذوب فيه، ويتوحد عليه الناس - جملةً - بل قد تعدى الأمر مسألة التوحد الديني إلى محاولات محمومة إلى التوحد المذهبي وفق نظرة تزعم بأن لا وجه للتنوع والتعدد المذهبي داخل المعتقد، ولا يفوتنا أن أشدّ من ذلك حصل داخل الأديان الكبرى، من قبل مذهب غالب ضد مذهب غلبه على أمره ضعف الإمكانات المادية من نحو السلطة الزمنية والمال والسلاح.. وغير ذلك، والتجارب القريبة والبعيدة في التاريخ تدلنا على أنه قد حصلت عمليات اضطهاد وقمع قاسية جداً من قبل سلطات تدين لمذهب بعينه ضد كيانات مذهبية أخرى، وهو ما يعبر عن حالة انكماش وانغلاق على الذات فرضته عوامل مشخصة تماماً، وهي بعيدة عن روح الدين الحنيف وسعة عطنه ورحمته التي تعمّ الموافق والمخالف دونما استثناء؛ فهذا صريح القرآن الكريم يقول: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ)(البقرة/256). بالإضافة إلى العشرات من النصوص القرآنية المتضمنة بشكل أو بآخر لهذا المعنى عينه.
وغاية القول هنا أن الرؤية الإسلامية تسمح لوجود الأغيار وتعطي العذر لمن لم يعتنق الإسلام بسبب عدم توفر القناعة الكافية لديه باقتضاء (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، ولكنها لا تسمح - في حال - بالدعوة إلى العمل ضد الدين. |
||
|
ثم لابد أن نشير إلى حقيقة دينية عظيمة جديرة بالتأمل، وهي أن الله سبحانه وتعالى كرّم بني آدم، على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومذاهبهم الدينية والفكرية، بالعقل والإرادة الحرة (الاختيار) والقدرة على التكلم باللغات المختلفة باختلاف البيئات، حيث قال عز من قائل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء/ 70)، وأحسن إليهم بأن كرمهم بالعلم: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (البقرة/ 31)، (خُلِقَ الإِنسَانُ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) (الرحمن/ 4-5). فخلق الإنسان حراً مختاراً يرشد إلى أن الاختلاف بين البشر مسألة طبيعية وتتماشى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بل وأكثر من ذلك قد يحدث أن يختلف الإنسان مع نفسه بأن يرى اليوم رأياً ويرجع عنه غداً، وهكذا. بيد أن هذا الاختلاف قد يؤدي بالإنسان إلى مهاوي الجهالة والتعصب، والجنوح نحو التعدي والاقتتال، وإهدار حرية الآخرين، وعلى نحو الإجمال تجاوز الحدود المقبولة والمعقولة للخلاف، ما لم يكن هناك ضابط أخلاقي ووازع ديني يحيل التنوع والاختلاف رحمةً تنعم فيها العقول وتستريح النفوس بالتلاقح الفكري وتبادل التجارب والاستزادة من العلوم والفنون والصناعات المختلفة، ولعل هذا جزء مما أراده النص القرآني (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) (الحجرات/13)، وحمل الله الإنسان في البر والبحر، ليمشي في فجاج الأرض ويسير بطاقته العقلية وإرادته الحرة في مدارج الحضارة وأطوارها، ليكشف ببصيرته آيات ربه في الآفاق، وسننه الكونية، فقال سبحانه: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). وهكذا فالرؤية الإسلامية الحقة تسد الطريق تماماً بوجه احتمالات نشوب الفتن، واضطرام الصراعات، التي غالباً ما تأتي من باب اختلاف الآراء والمذاهب الفكرية والعقيدية، والاعتداد باللون والعرق والأنساب، بأن توجه الإنسان إلى أهداف شريفة من قبيل عمارة الأرض، واستغلال موارد الرزق التي خلقها الله تعالى من ثروات نباتية وحيوانية وبحرية وأرضية، لتحقيق تكافؤ الفرص، وبسط العدل، وغير ذلك مما يحول التنوع والتغاير والاختلاف إلى رحمة للعالمين. |
||
|
من الطبيعي أن يسعى من رأى الحق والصواب في دينه أن ينشط في دعوة الناس إليه، وأن يرى كل انتصار وتقدم لعقيدته انتصاراً وتقدماً لنفسه وهذا أمر قابل للإدراك بسهولة، لأنه معهود في جميع المجتمعات الإنسانية، من أي لون أو جنس كانت، وأمثلته واضحة ومتحركة في الواقع المعاش، مما يغني عن الشرح والبيان، هذا فضلاً عن أن بعض الأديان تحضُّ معتنقيها للعمل على نشرها وإقناع الآخرين بها، كما هو شأن الإسلام الذي يقول نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم): (وأيم الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه شمس وغربت) (1). ولكن دعوة الإسلام ترتكز - كما يتضح من الآيات والروايات الكثيرة - على الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن، وتجنب أية محاولة لفرض الدين من طريق السطوة أو السلطة. وبالطبع فإن هناك بعض الديانات تحصر نفسها في عرق معين وتغلق أبواب دعوتها على من لم ينحدر من تلك العروق، كما ينقل عن المجوسيين الزرادشتيين الذين يحرّمون على أي إنسان لم يولد زرادشتياً أن يعتنق دينهم رغم اعتقادهم بأفضلية دينهم على سائر الأديان ولذلك أشرف دينهم على الانقراض حيث لا يزيد عدد أتباعه حالياً على (120ألف) مجوسي في العالم. هذا ومن الصحيح والمشروع محاولة إقناع الآخرين والتأثير على نفوسهم باتجاه الدين - كما أسلفنا - ولكن البعض قد يستخدم القوة والعنف لفرض الدين أو المذهب الذي يؤمنون به على الآخرين، وهذا مردّه الجهل أو روح التسلط والظلم، فمن يفرض دينه على الناس بالقوة والقهر إنما يعترف بفشل عقيدته وعجزها عن استقطاب الناس وإقناعهم، أو أنه يستغل الدين كستار وغطاء لعدوانه وتسلطه على الناس، وكم عانت البشرية وتحملت من المصائب والمآسي في حروب وصراعات دامية تحت شعارات دينية وفكرية(2). ففي العصور الوسطى - مثلاً - رزحت الشعوب الأوربية في ظل القمع والإرهاب باسم الكنيسة والدين المسيحي حيث سن الملك الفرنسي (شارلمان) قانوناً يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنصّر، ولما قاد حملته القاسية على السكسونيين والجرمان أعلن أن غايته إنما هي تنصيرهم(3). ولمحاكم التفتيش التي أنشأتها الكنيسة في تلك العصور سمعة سيئة وسجل قاتم، فقد اجتهدت في فرض آراء الكنيسة على الناس باسم الدين، والتنكيل بكل من يرفض أو يعارض شيئاً من تلك الآراء، فنصبت المشانق وأشعلت النيران لإحراق المخالفين، ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم (300000) أحرق منهم (32000) أحياء، كان منهم العالم الطبيعي المعروف (برونو)، نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم، وحكمت عليه بالقتل، واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه، وذلك يعني أن يحرق حياً، وكذلك كان. وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير غاليليو بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس(4). وحينما جاء الإسلام أعلن موقفه الواضح والصريح من حرية الاعتقاد واختيار الدين، وأرسى القرآن الحكيم مبدأ الحرية الدينية الفكرية في قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ) (البقرة/ 256). يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره (الميزان): (وفي قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) نفي الدين الإجباري، لما أن الدين وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى، عملية يجمعها أنها اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه والإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية، وأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والإدراك، ومن المحال أن ينتج علماً أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقاً علمياً، فقوله: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين، أنتج حكماً دينياً ينفي الإكراه على الدين والاعتقاد، وإن كان حكماً إنشائياً تشريعياً كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله: (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ)، كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرهاً، وهو نهي مستند على حقيقة تكوينية، وهي التي مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية) (5). وإذا كان هناك من لا عمل له سوى التقاط مواد مندرسة في التأريخ، ليتخذها قاعدة أو منطلقاً لتوجيه سهام النقد إلى مراحل تاريخية معينة في مسيرة الرسالة المحمدية (صلى الله عليه وآله وسلم) الأصيلة، ويقصر النظر على حلقات بعينها، متحاملاً ومبغضاً، فهو معذور بقصر نظره، وأفون عقله؛ من حيث أن مطالب الدين القويم سهلة يسيرة، ورسالته سمحاء تخاطب كل الأفهام وبجميع مستوياتها، فهو بالجملة آيات بينات، ويهدي للتي هي أقوم، وفيه صلاح المجتمعات على كافة الصعد، وطرقه إلى ذلك واضحة تماماً ومشروعة لكل من له بصر وبصيرة.. وهكذا فإن الدين الإسلامي رغم كونه خاتم الأديان، وهو دين الله تعالى، يخاطب العقل المفكر، والفطرة السليمة، والوجدان المتفتح، والنفوس غير المعاندة، والاجتماع البشري برمته، إلا أنه يشدد على قضية الاقتناع بعد إلقاء البينة، والإدراك، وليس فيه أدنى توجه نحو الإكراه والغصب، أما ما تتعلق به بعض القلوب المريضة من أن الإسلام قام وعاش في ظلال السيوف، فإنما تعبر عن نظرة مجتزأة ومواقف مرتجلة تنقصها الحجة والمعرفة، ويمكن قطع وجهتها من قريب، مؤكدين بحق أن الإسلام يدعو إلى السلام ويعتبر السلم هو الأصل والحرب هي الاستثناء، قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) (البقرة/208)، وقال أيضاً: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) (الأنفال/ 61)، فنرى أن الإسلام يأمر بمحاربة من لا يزال يقاتل المسلمين ويريد الاعتداء، وينهى عن موادة أمثال هؤلاء، أما الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم، فالله سبحانه يأمر ببرهم والإقساط إليهم وإن كانوا كفاراً.. إلى غيرها من الآيات القرآنية الكثيرة التي إذا جمعت إلى الجهاد تكون النتيجة: إن الجهاد والحرب حكم ثانوي اضطراري، وأن السلم هو الحكم الأولي، وفي حديث قال الإمام علي (عليه السلام) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين: (لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم) (6). |
||
|
لابد من التأكيد بأن الفوضى وغياب الحدود والضوابط التي يقول بها العقل السليم - وما يقوله العقل فتصديقه ضروري - مثل ذلك لا يصلح الإنسان والمجتمعات أبداً، فالحكمة تقضي والعقل يأمر، وكذلك المسيرة الطبيعية لبني البشر، بأن لكل شيء حدود وقواعد إذا غابت تساوى وجود ذلك الشيء مع عدمه، أي يضحى وجوده بلا غاية، ويصبح عبثاً ليس غير، وهكذا الأمر بالنسبة للحرية؛ فهي إن تركت سائبة بلا حدود عقلانية، فغايتها الضلال، والسقوط في كل هاوية، وتجارب الأمم القريبة بمثابة أدلة حية على هذا المدعى. هذا على حين أن الإسلام قد أطبق المفصل وأحكم قواعد الحرية للإنسان - أفراداً ومجتمعات - بأن جعل إطاراً معقولاً وصحيحاً لحرية الفكر وحرية القول، وحرية العمل، هو (عدم الإضرار بالآخرين وعدم الإضرار البالغ بالنفس)، حتى إن الأكل والشرب المضرين ضرراً بالغاً لا يجوزان، لأنهما إضرار بالنفس، والسباب بالقول، والضرب، ونحوهما لا يجوزان لأنهما إضرار بالآخرين، كما إن الاستفادة من مواهب الحياة أكثر من القدر الصحيح لا تجوز لأنها إضرار بالأجيال القادمة.. وقد حدد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل فكر وعمل بعدم الضرر، حيث قال: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (7). ولا ندري كيف يسوغ لأصحاب بعض المذاهب الفكرية والفلسفات الكلامية، القول بالحرية المطلقة التي من أولى سقطاتها قضية تزاحم حريات الأفراد في المجتمع الواحد، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى الإضرار والتضييق على حريات البعض دون البعض الآخر، فتصبح والحال كذلك، أشنع من القيد، هذا بالإضافة إلى ما نلحظه من آفات وعيوب اجتماعية فيما يدعى ببلاد الحرية، التي من السهل إدراك أن مصدرها هو الحرية المطلقة التي لا تعرف حدوداً ولا قيوداً ضرورية لحياة المجتمعات الإنسانية، حتى البدائية منها. ففي الحق؛ نرى أن آثار ومساوئ الحريات المطلقة تفوق آثار وأخطار مرض الإيدز، ذلك لأن مثل هذا النوع من الحريات قد دمّر حياة المجتمعات، وأفقدها الهدوء والطمأنينة، وجعلها تعيش قلقاً ووساوس في لحظات حياتها المليئة بالصخب والفوضى.. |
||
|
لعلّ من نافلة القول أن الدين الإسلامي واسع سهل، يحمل في طياته خطاباً شاملاً للكيان البشري، وهو مستوعب لجميع الأزمنة، لا يتوقف نشاطه، ولا ينطفئ مصباحه، مهما تقادم الزمن به؛ إذ هو هو في خطابه للعقل والوجدان والفطرة السليمة، وهو أيضاً لا يعاضل أهل الأديان الأخرى ما داموا مسالمين معه، غير معاضلين، ففي روايات متواترة نرى إلزام الإسلام أهل دين بما يلتزمون به، حيث يقرّ لهم الحرية في دينهم، مثل ما ورد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: سألته عن الأحكام؟ قال: (تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون)، وفي رواية أخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: (ألزموهم بما التزموا به)، وعن الصادق (عليه السلام) قال: (كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمهم)، ولذا نرى أن الإسلام لا يتعرض للمجوسي ونحوه إن نكح أمه وأخته حيث أن ذلك جائز في دينه.. وإن كان دينه في الواقع مزيفاً، لأن الإسلام لا يريد الإكراه، للقاعدة المعروفة: (القسر لا يدوم)، وإنما يريد إعطاء الحرية لكل إنسان فيما يعمل بحسب معتقده، وإنما يناقشه بالمنطق، ولذا قال سبحانه وتعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل/ 125)، وفي روايات متعددة: (إن المجوس يورثون على ما يعتقدون وإن لكل قوم نكاحاً) (8). وحينما يقبل الإسلام بوجود سائر الأديان والاتجاهات ضمن مجتمعه وفي ظل دولته، فإنه يمنحهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائر أديانهم والقيام بطقوس عباداتهم، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها دون أن يفرض عليهم شعائره وأحكامه أو يتدخل في شؤون أديانهم.. ويشيد أحد الكتاب الأجانب (آدم متز) بمستوى الحرية الدينية في ظل الدولة الإسلامية فيقول: لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر الدينية لأهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم، وإن الحكومة في حالات انحباس المطر، كانت تأمر بتنظيم مواكب يسير فيها النصارى وعلى رأسهم الأسقف، واليهود وعلى رأسهم النافخون بالأبواق.. ويقول (جولد تسيهر): (سار الإسلام لكي يصبح قوة عالمية على سياسة بارعة، ففي العصور الأولى لم يكن اعتناقه أمراً محتوماً فإن المؤمنين بمذاهب التوحيد أو الذين يستمدون شرائعهم من كتب منزلة كاليهود والنصارى والزرادشتية كان في وسعهم متى دفعوا ضريبة الرأس (الجزية) أن يتمتعوا بحرية الشعائر وحماية الدولة الإسلامية.. بل لقد ذهب الإسلام في هذه السياسة إلى حدود بعيدة، ففي الهند - مثلاً - كانت الشعائر القديمة تقام في الهياكل والمعابد في ظل الحكم الإسلامي) (9). وهكذا فإن مبادئ الإسلام وتعاليمه في الوقت الذي تربي الإنسان المسلم على التزام دين الله وتوحيده، فإنها توجهه بأن يحترم الإنسان بما هو إنسان مهما كان دينه أو مذهبه، حيث أن (الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق). |
||
|
الهــوامــــش : |
||
|
(1) الصياغة الجديدة: الإمام الشيرازي ص372. (2) التعددية والحرية في الإسلام: حسن الصفار ص85. (3) بين علي والثورة الفرنسية: جورج جرداق ص43. (4) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي ص192. (5) التعددية والحرية في الإسلام: حسن الصفار ص60. (6) الصياغة الجديدة: الإمام الشيرازي ص365. (7) المصدر السباق: ص309. (8) المصدر السابق: ص311. (9) التعددية والحرية في الإسلام: حسن الصفار ص80. |
||
 إذن المبدأ الأساسي في الإسلام
والذي لا مراء فيه هو هذا المبدأ التشريعي
الذي ينفي أية مشروعية للإكراه في الدين
ويشدد على أن الناس جميعاً ليسوا موضوعاً
للإكراه على اعتناق الإسلام، والإسلام فضلاً
عن أنه يسلب مشروعية الإكراه، فإن النصوص
التشريعية، وواقع التاريخ يثبت أن دار
الإسلام تتسع لغير المسلمين وتوفيهم حقوقهم
السياسية والإنسانية بصورة كاملة، مما يعني
بجلاء أن الإسلام دينٌ يستوعب مبدأ التنوع في
العقائد دون أن يكون لهذا التنوع أي مساس
بالحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية
لأصحابها، بل جميع هذه الحقوق مكفولة بمقتضى
روح الدين وجوهره الثابت، وهذا ليس مدعى أو
جزاف في القول، بل هو حقيقة أكدها سيد الوصيين
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بقوله: (الناس
صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).
إذن المبدأ الأساسي في الإسلام
والذي لا مراء فيه هو هذا المبدأ التشريعي
الذي ينفي أية مشروعية للإكراه في الدين
ويشدد على أن الناس جميعاً ليسوا موضوعاً
للإكراه على اعتناق الإسلام، والإسلام فضلاً
عن أنه يسلب مشروعية الإكراه، فإن النصوص
التشريعية، وواقع التاريخ يثبت أن دار
الإسلام تتسع لغير المسلمين وتوفيهم حقوقهم
السياسية والإنسانية بصورة كاملة، مما يعني
بجلاء أن الإسلام دينٌ يستوعب مبدأ التنوع في
العقائد دون أن يكون لهذا التنوع أي مساس
بالحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية
لأصحابها، بل جميع هذه الحقوق مكفولة بمقتضى
روح الدين وجوهره الثابت، وهذا ليس مدعى أو
جزاف في القول، بل هو حقيقة أكدها سيد الوصيين
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بقوله: (الناس
صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).