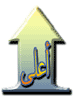|
(تاريخية الظاهرة.. وسبل نفيها) |
|
وقد تركزت (المركزة الغربية) في موقف ثقافي مواز لموقفها الاقتصادي والسياسي تمثل بالنظر لنفسها على إنها ومرجعياتها هي الحَكَم الوحيد في الحُكم على تراث الشعوب وثقافاتها. وكان هذا الموقف هو الأكثر خطورة إذ إنها هاجمت الوعي وربطته إلى عجلاتها الخاصة وأسقطت من الحساب كل ما عدى ذلك من معتقدات وأفكار وقيم. ولقد كان لب هذه القضية هو الاعتقاد بإطلاقية العلم والأفكار المنتجة وفق الطرائق والنظم والمرجعيات الفكرية الغربية فكل ما هو غربي هو حقيقة مطلقة لا يشوبها شك وما عداها مجرد أوهام لا تستحق سوى الإلغاء والزوال سواء بالنسبة للحضارة الغربية نفسها أو الحضارات التي خضعت لأحكامها التعسفية آنفة الذكر!!. وإن من أهم الظواهر الخطرة التي أفرزتها الحضارة الغريبة هي ظاهرة التحاث في الوعي وهي تشبه ظاهرة التحاث الفيزيائية من خلال مظاهر هي: أولاً: إنها تحدث لوجود قابلية في الطرف المستجيب بفعل الفراغ في القوى المقابلة. ثانياً: إنها تحدث لوجود القوتين في حالة تماس واتصال. ثالثاً: إن النتائج في كل الأحوال لا توازي الأصل وتزول بزواله أو تحوله. فالتحاث إذن ظاهرة ثقافية تولد في أجواء الهيمنة التي نشأت إثر تفوق الحضارة الغربية وبروز مركزيتها بالنسبة للحضارات الأخرى، وإن أبرز مظاهر (التحاث) الانفعال المباشر المقصود أو العفوي بالتطورات الواقعة داخل الحضارة الغربية وتحول الحضارات إلى حالة الإلحاق رغم أنها غير ملحقة فعلاً وأن ما يلوح من التماثل المظهري يعبر عن واقع الإصابة بأعراض التحاث وآثاره على الوعي. ولعلّ أول حالة تماثل سجلها التاريخ في العالم الإسلامي هي حالة مصر حيث أخذت تحاول التماثل مظهريا (الحث) مع القوى الغازية بعد أن (انتهت كل محاولات المقاومة الطويلة في العالم العربي إلى هزائم من الممكن تأريخها كالتالي: 1883 بالنسبة لمصر، فترة ما بين 1830 - 1911 بالنسبة للمغرب، 1919 بالنسبة للمشرق العربي)(4). وفي العادة فإن الوعي وبفعل ضغط الواقع يدخل في حالة من الخدر وعدم القدرة على تحديد الأولويات ولهذا فإن الإفراز الأولي لهذا الأمر هو اتساع الحديث عن النهضة والنهوض ولهذا فقد أعقب هذا الفشل في المقاومة دخول العالم العربي والإسلامي في فترة النهضة، و(تأتي بعد فترة النهضة فترة النضال المعادي للإمبريالية، وخلال القرن ستبرز خاصيتان وستتطوران في كل أنحاء العالم العربي مع وضوح أكثر أو أقل هنا وهناك. 1- سيمر الانبعاث بصعود طبقة جديدة (برجوازية المدن الصغيرة الحديثة) التي أنتجها اندماج العالم العربي في المدار الإمبريالي وستأخذ هذه الطبقة القيادة على حساب الطبقات القديمة المنهارة . 2- وسيعبر الانبعاث عن نفسه بعاطفة متعاظمة نحو الوحدة العربية(5). وهذه الحالة طبعاً تعبر عن نوع من الحث في البنى الاجتماعية والذي يعكس في طياته نوعاً من تحولات الوعي التي تتميز بالعجز عن تحديد الأولويات بدقة ولذلك فإن أهم ما يؤخذ على فكر النهضة بجميع مراحله وخصوصاً بداياته كونه (لم ينتج نسقاً نظرياً) تحدد وتعرف فيه موضوعاته. وكما قلنا يمكن الإشارة إلى أن (للانبعاث الغربي، للنهضة في القرن التاسع عشر مركزين رئيسيين هما مصر وسوريا لكن منذ القرن الثامن عشر قامت مصر مع علي بك بأول محاولة لتحديث الدولة. الأمر الذي أدى إلى استقلالها عن النير العثماني وقادت الظروف التي أعقبت حملة بونابرت إلى محاولة ثانية هي التي قام بها الباشا محمد علي) (6). ففي عالمنا المعاصر برزت ظاهرة التحاث مع حملة نابليون باعتبارها أجلى مصداق للإحساس بالتراجع والعجز أمام الغزو وما تلا ذلك الإحساس من مساع للرد على هذا العجز رداً سريعاً يشبع حاجات المجتمع لاستعادة الاستقلال ولهذا فإن هذه المحاولات ولدت مثقلة بهم التدافع ولم تستطع إدراك الفروق بين القوى الغازية التي كانت قد قطعت مخاضات طويلة ووصلت إلى ما وصلت إليه، بينما لا يمكن القطع بما يمكن أن يكون ملائماً لواقع الشعوب المسلمة. ولذلك ارتدّ الصراع مع الخصم إلى صراعات داخلية بعد أن اتهمت بعض الطبقات بعضها الآخر بالتسبب بالتراجع وأن الصراع سوف لن يحقق نتائجه ما لم يتم حسم الصراع الداخلي وقد قام محمد علي باشا في مصر بالتخلص من سيطرة العثمانيين لكنه استبدلها بسيطرة غربية لم تلبث أن صارت هي الحكم المسيطر على البلاد وقادت النهضة إلى تسهيل مهمة المستعمر بدلاً من أن تؤدي إلى طرده وعلى صعيد الثقافة فقد (انشعب الموقف من الأصالة والمعاصرة انشعاب الموقف نفسه من قضية التراث) (7). وشاهد أهل مصر لأول مرة النساء عاريات يتأبطن أذرع الرجال وقد أسسن عدداً من المواخير وبيوت الدعارة، وحين تراجعت الحملة فإن أنساقاً جديدة للسلوك والتفكير استمرت موجودة تستقي من استمرار التأثيرات الغربية وتواصل الاحتكاك بالغرب. ولأن هذه التأثيرات مرتبطة بالتحاث فإنها لم تكن في يوم ما مستقرة ومتواصلة إذ سرعان ما تتغير وتنقلب، ففي مطلع عصر النهضة الذي يؤرخ له عادة بعام 1798م عندما غزا نابليون مصر تجلت بشكل دعوات طالبت بالتغيير وساهمت في خلق مناخات ثقافية واجتماعية، لمجرد الانبهار بالنموذج الغربي (الطهطاوي: 1801 - 1873، وخير الدين التونسي: 1810 - 1899وآخرين) فشكلت أرضية وتمهيداً لقيام مركب اجتماعي سياسي - طبقة - كبديل للواقع القائم الذي باتت ضرورة تغييره قضية لا مناص منها. فهذه الطبقات التي انتمت بشكل هش وهامشي للثقافة الفرنسية كانت أول تجسيد لظاهرة الحث باعتباره الشكل المطلوب للتغيير الاجتماعي، وإنها الرد على حالة التداعي والتراجع في تلك الفترة. لكنه كان رداً كاذباً ومؤقتاً، لأنها لم تضع يدها على كل ملامح الأزمة بسبب عدم تخلصها من مؤثرات الصدام وبذلك تحولت إلى جزء من مضاعفات التردي، وعامل إعاقة لنشوء بديل حقيقي يرد على التردي. فالليبرالية الإصلاحية التي دعا إليها أبطال النهضة لم تكن بديلاً عن الديكتاتوريات التي أنتجها مسلسل التداعي الاجتماعي والسياسي في أغلب المجتمعات الشرقية، فصار الإصلاح ورقة تتذرع بها الديكتاتوريات وتحيط نفسها بمظاهر معينة تتماهى مع الشكل الغربي باعتباره أنموذج التقدم الوحيد، مما يعني نشوء حالة عجز عن التشخيص وهو خلل يصيب الوعي. فحث المظاهر الثقافية الغربية في تلك المرحلة أصاب الوعي بنوع من الخدر وعمل على تسويغ استمرار الديكتاتورية وأجّل نشوء معالم الثورة الحقيقية لأنه قدم بديلاً لها يساهم في تكريس التخلّف ويقوي من عوامل الإلحاق بالحضارة الغربية دون أن يقدم للمجتمع المرهق عناصر قوة حقيقية. ولهذا فإن الاتجاه الليبرالي الإصلاحي - الذي كان عقيدة مبشري النهضة - لم يستطع أن يصمد طويلاً ولكن لم تمض مدة طويلة حتى انتشر بديل آخر وهو الدعوة إلى الاشتراكية تم طرحه على أنه الملاذ الوحيد، وبالفعل ساد الاتجاه الجديد (الكواكبي: 1854 - 1903) وقد خاض هذا الاتجاه صراعاً ضد الأشكال الأخرى فصار يتجه إلى الصدارة مع اتساع القوة الحاثة في الحضارة الغربية. وفي مراحل لاحقة قامت انقلابات كان فاتحتها انقلاب 1949 في سوريا ثم انقلاب 1953 في مصر ثم انقلاب 1958 في العراق، وصار الفكر الاشتراكي هو القوة الأولى - تقريباً - في العالم الثالث. ولما بدا التصدع على الأنظمة الشمولية في العالم، فإن نوعاً من التراجع اقترن معه في العالم الثالث وسرعان ما حلت بدائل (ديمقراطية) لأنظمة كثيرة في العالم الثالث. ومع كل هذه التحولات التي تحصل في العالم الأول والثاني فإن إفرازات مشابهة تحث تبعاً لها في العالم الثالث، وهكذا تتوالى موجات الحث لترتدي في بداية ظهورها ثياب العصمة التي يسبغها عليها مفكرو العالم الثالث. فالديمقراطية مع كونها تمثل قناعة عامة في بلدان الغرب لم تر أحداً هناك يسبغ عليها صفة القداسة التي تسبع عليها في الجنوب. فإن الكثير من النقد يوجه للديمقراطيات الغربية وأنها في بلد المنشأ لا تزال متهمة بالعجز عن إقرار العدالة وإنها في أفضل حالاتها خففت من معاناة الإنسان ووفرت له بعض مستلزمات الرفاه. وهكذا يمكننا استنتاج وجود حالة معينة أصيلة في العالم الثالث نشأت إثر التراكمات التأريخية وقادرة على هضم أية أيديولوجية في وعائها الخاص، وبالتالي فإنها لا تفرز سوى ظواهر سطحية لا تمس أصل البنى والعلاقات والأسس التي قام عليها المجتمع، وبالتالي فهي لا تنتمي إلى الثورة والتغيير إلا بصورة شكلية وهامشية، ولهذا فإن البناء الاشتراكي كان في العالم الثالث بناءً مظهرياً يختلف عن المقابل في الأصل ونفس الشيء بالنسبة للنزعة الديمقراطية فإنها ليست سوى ديكتاتورية مقنعة، فهنا لا علاقة للأفكار وصحتها وخطأها بالواقع المبني بناءً محكماً يعتمد على التأريخ، فالإنسان الذي يعيش أنواع الضغوط والمعاناة صار يشعر بعظم الحاجة إلى التغيير، فتحمله هذه الحاجة إلى التحليق في سماء اللاوعي والحلم والخيال.. وهو عالم لا علاقة له بالعقل والأسباب والنتائج وبالتالي فإنه يلجأ إلى الاستجابة لظاهرة الحث. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نفسر دور النقد في العالم الثالث من حيث أنه يخضع إلى نفس المعادلة فيمنع أثناء التجربة ويمارس على نطاق واسع بعد انهيارها فيمسي مجرد تملق للتجربة البديلة، فهو إذاً ليس نقداً يهدف للبناء بل هو إقرار خاص خاضع لنمط العلاقات في المجتمعات المريضة والمتخلفة. كما إن الحوارات تقف وراءها السياسة أكثر مما يحفزها الفكر فعليها تحمل هموم السياسة، فدولة محمد علي ساهمت بشكل مباشر في خلق تيار فكري ينتمي إلى الليبرالية الإصلاحية. لأنها كانت محصلة التقاطع بين قوى تتصارع لتحقيق الغلبة في كل شيء. فالدولة العثمانية التي كانت عاجزة عن فرض هيمنتها، اكتفت بسلطة شكلية مثّلها محمد علي باشا وفرنسا التي لم تكن تريد الانسحاب من الشرق تحت تأثير ضربات الإنكليز، فكان الجميع قد رضوا بمحمد علي وبالليبرالية الإصلاحية كقاسم مشترك بينهم. وهكذا عبّر المثقف في تلك الحقبة عن طموحات السلطة محلياً وخارجياً وفي المراحل اللاحقة اكتظت الساحة بالطروحات الفكرية مع اتساع دائرة الحث مما زاد من التعمية والتعتيم على الرؤية حتى أننا لم نر تلك الولادة إلى اليوم.. فظاهرة الحث تؤثر ابتداءً بالوعي وتقوده إلى العجز عن اكتشاف معالم الواقع وتسمح بقيام بدائل زائفة تعطل قيام المشروع الحقيقي لأنها ترتبط بعالم آخر يظل يفرز تأثيراته باستمرار فيعيق الفعل الصحيح والمؤثر. ولكي ينتهي الأثر ومعالم التحاث فإننا لا بد أن ننفصل عن القطب المؤثر أو أن يتم ملء الفراغ الذي على أساسه تحصل الظاهرة وبالنسبة للانفصال عن القطب المؤثر فقد بات من المستحيل وقوعه لأنه صار يسير نحو التلاحم ويتحول إلى القرية الكونية الصغيرة، وإن أي حدث في العالم يمكن أن تنفعل به إجراءات أخرى بسرعة وذلك بسبب وسائل الاتصال السريعة والتي لا تزال تتقدم وتتطور وتفرض المزيد من الالتحام بين الحضارات. وعلى هذا الأساس فإن الحل سينحصر في الشق الثاني ويتحقق عبر ملء الفراغ، وإذا تأملنا في ظاهرة الحث فإنها تحدث حينما يكون الوعي في حالة استعداد للتلقي الذي أسست له مراحل الانبهار بقوة الآخر سواء القوة التقنية أو العسكرية أو الاقتصادية أو القوة في الوعي ومرجعيات الفكر، الأمر الذي يترتب عليه النقل والاستعارة والذي لا ينحصر في هذه المفردة أو تلك بناءً على الهضم والتمثيل داخل الجسم الحضاري بل لخلق قطيعة مع الذات واستنبات مرجعيات الآخر وأنماط وعيه للعالم والحياة ليأتي الحث كنتيجة مترتبة على هذا الأمر؛ إذ ما دامت الأسس موجودة فإن البناء الفوقي سينتقل تلقائياً بسبب التواجد في نفس الحيز، فهو الذي أسفر عن سرعة الاتصال وتحول العالم إلى قرية واحدة كما أسلفنا والذي يولد باستمرار سرعة الانفعال بتقلبات الوعي ما دامت أسس التفكير موجودة إلى جانب الاتصال. ولهذا فإن المشكلة ستنحصر في استنبات أسس تفكير مغايرة؛ إذ سوف لا يكون من المسلّم به تبني التطورات لعدم وجود أسس، فلكي يتم حث حالة معينة فكرية أو أي معلم آخر من معالم الثقافة فلا بد في البداية - حتى يتم الحث - من وجود تلك الأسس وحيث لا توجد هذه الأسس فإن عملية الانفعال ستكون غير ممكنة، فإذا فرضنا أن الحالة المحثوثة هي صرعة أزياء فإنها لا تنتقل إلا إذا كانت تتصف بحالة القوانين التي تحكم الذوق والجوانب الشرعية، وإذا كانت الحالة نظام سياسي فإنه أيضا سيكون من غير الممكن بناء نظام سياسي لا يستند إلى الحضارة وعلى الأقل سوف يتم تكييفه بالصورة التي تجعله منسجماً مع متبنيات الحضارة. إذن فالمطلوب إيقاظ البدائل الحضارية والتخلص من حالة التوقف التي أسفرت عن قيام حالة الفراغ التي تسببت بكل أنواع التردي بما فيها ظاهرة الحث، ولكي يمكن الانطلاق فلابد من العودة إلى البديل الحضاري المغاير، وهو لا يعدو التراث الحضاري وحين نسلّم بأن التراث هو البديل الوحيد المتاح فإنه أيضا لا يكون بديلاً ملائماً ما دام بديلاً متوقفاً إثر حالة الصراع الداخلي الذي أسفر عن معضلات غير قابلة للحل. فيكون المطلوب هو ثورة في التراث تنقله إلى بديل حي قادر على ملء الفراغ ويقدم الحلول لكل المعضلات التي تسوغ الاستعارة، والثورة في العادة لابد أن تشمل الأسس ومرجعيات التفكير وهذا الإدراك هو الذي قاد إلى الاستعارة. لكن البديل يجب أن يؤدي إلى التجديد من خلال نفس المنظومة الفكرية وليس باستعارة منظومة متكاملة. وإن ما يعين على إنجاز هذا الأمر هو أن الحضارة الأخرى وبحكم تطورها صارت هي أيضا تفكر بأمر من هذا النوع، ذلك أن الحركة المتسارعة والتراكم أسفر في النهاية عن الإحساس بضرورة تجاوز الثوابت التي قامت على أساسها حضارة الغرب، إذ بات واضحاً أنها لم تعد قادرة على مواكبة التطور، وعلى هذا الأساس فإن الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية تشتركان في حقيقة واحدة وهي ضرورة تجديد الأسس لتكون أكثر قدرة على التلائم مع النقلة الحضارية التي توشك أن تولد بعد ذلك. إن المستقبل هو مستقبل واحد، وإن الأساس الذي يسمح للحضارة الإسلامية بتجاوز الواقع القائم سيكون نفسه الأساس الذي تبنى عليه حضارة عالمية تجمع جميع أبناء البشر، لأن الإنسانية لم تعد قادرة على مواصلة ولادتها لواحات حضارية متباعدة وأن أية ولادة جديدة لابد أن تكون ولادة تجيب على مشكلات العالم أجمع وأن جميع ظواهر اختلال الوعي التي نجمت عن الصدام بين الحضارات سوف تزول. والمتأمل في أسس التجربة التي أطلق عليها - مع أحقية أفقها الحضاري - اسم (الحضارة الإسلامية) يرى أنها منيت بحالة من الازدواجية في الأدوار الأولى حيث أنها يفترض أن تكون قائمة على الوحي الإلهي وأن تكون مستهدية بهداه بصورة كاملة، غير أن هذا الأمر توقف بعد حين ليصنع الإنسان لنفسه بناءً خاصاً به يتماهى مع الوحي ويتستر به، وبمرور الزمن اتسع اجتهاد الإنسان على حساب الوحي ونجم عن هذا الأمر الانفصال بين الحياة والوحي فإن السياسة والاقتصاد والتربية في الغالب لا ترتبط بالوحي إلا بصورة شكلية وتسير وفق اجتهادات القيمين على التجربة لأن الوحي أقصي منذ البدء. ومن هذه الجهة فإن الإستقامة التي تتيح الانطلاق الجديد هي نفسها التي أسفرت عن الانطلاقة السابقة وتتلخص بفصل البشري عن الإلهي وهو يعني القضاء على الازدواجية فالازدواجية هي التي تولد بصورة تلقائية آليات التعطيل لأنها تعيق انطلاق الطاقات فالحضارة التي تقوم على النوازع البشرية المطلقة وتتعامل مع الإنسان بدون أية كوابح تؤدي إلى حالة من النمو والتراكم لأنها تختصر الطريق إلى الأهداف، لأنها لا تدقق كثيراً في الوسائل كما هو موجود في الحضارة الغربية التي امتلكت القدرة الاقتصادية من خلال استغلال جهود الفلاحين في مرحلة الإقطاع لخلق التراكم، وكذلك استغلال جهود العمال الذين كانوا بالأمس عبيداً ملحقين بالأرض، فقامت الثورة الصناعية ثم واصلت نفس الاستغلال ووجهت إلى الشعوب المستعمرة لنهب الثروات التي توفر لها القدرة على إنجاز التحولات الضرورية، بينما ظلت (الحضارة الإسلامية) مكبلة بالكثير من الظواهر الأخلاقية مما أعجزها عن مواكبة تطور الحضارة الغربية فتراجعت أمامها. ولهذا فإن الانطلاق يقوم أصلاً على القضاء على الازدواجية عن طريق العودة إلى الوحي؛ إذ لا يمكن للحضارة الإسلامية أن تجاري الحضارة الغربية حتى لو تبنت أسلوبها في إنجاز التحولات بسبب السبق، لكن يمكنها فقط ومن خلال الوحي أن تكون بديلاً عالمياً لأنه (الوحي) يعالج الخلل في العالم برمته ولا ينتسب إلى أية حضارة بعينها لأن الوحي منذ البدء موجه إلى الإنسان بما هو إنسان وغير موجه إلى إنسان بعينه. وهكذا فإن ظاهرة الحث ترتبط بعملية الثورة التي لابد للعالم الإسلامي من إنجازها لكي يعود إلى الحياة مرة أخرى وهي تقوم على نبش التراث وفرز البشري فيه عن الإلهي، وبإسقاط البشري المحدود الذي ولد في زمنه حتى يمكن الاعتماد على الإلهي وهو غير المحدود الذي يصلح لكل زمان ومكان وبدون هذا الفرز فإن العالم الإسلامي والعالم برمته سيظل يدور في حلقة مفرغة، وتبقى ظواهر اضطراب الوعي مستمرة ولا تفرز إلا المزيد من البؤس. |
|
الهـــوامـــش : |
|
(1) حوار الحضارات: روجيه غارودي، ترجمة الدكتور عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، باريس ط3 ص8. (2) المصدر السابق: ص8. (3) المجتمع الحديث في أبعاده الأساسية: مجموعة مؤلفين، فصل المجتمع الحديث لتيركاند، دمشق 1983م، ص31. (4) التطور اللامتكافئ: د.سمير أمين - ترجمة برهان غليون - سلسلة السياسة والمجتمع، بيروت 1980م، ط3، ص232. (5) نفس المصدر. (6) عبد الإله بلقزيز، مقدمات لتحليل الخطاب النهضوي العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد123، ص5. (7) التطور اللامتكافئ: مصدر سابق ص232. |
 لقد بدأت نزعات ( المركزة الغربية)
وميلها القوي منذ مطلع هذا العصر الذي اقترنت
بداياته مع ظهور المجتمع الحديث وتتجدد
الحداثة في نظرنا بمجموع ضروب الجدة التي
خلقتها حضارة الغرب منذ أن دخلت في طورها
التسارعي ولتتفق على تحديد بدايات هذا الطور
بين نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن
العشرين، أي في الفترة التي تم فيها الانتقال
من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، وتختلف
الآونة الصحيحة - إذا كان ثمة آونة - بحسب
البلد
لقد بدأت نزعات ( المركزة الغربية)
وميلها القوي منذ مطلع هذا العصر الذي اقترنت
بداياته مع ظهور المجتمع الحديث وتتجدد
الحداثة في نظرنا بمجموع ضروب الجدة التي
خلقتها حضارة الغرب منذ أن دخلت في طورها
التسارعي ولتتفق على تحديد بدايات هذا الطور
بين نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن
العشرين، أي في الفترة التي تم فيها الانتقال
من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، وتختلف
الآونة الصحيحة - إذا كان ثمة آونة - بحسب
البلد